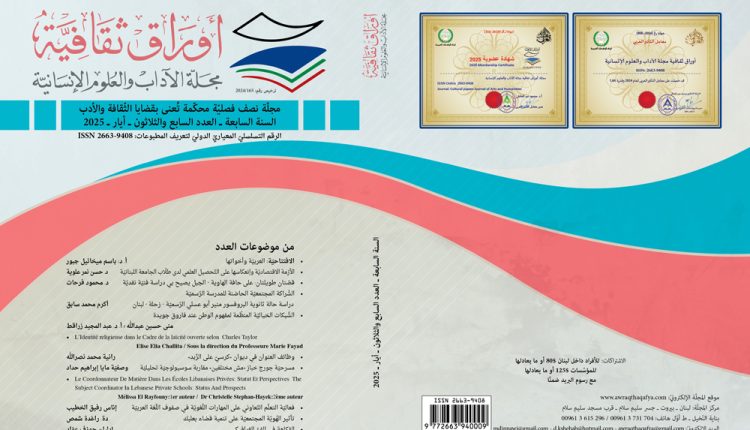عنوان البحث: دراسة تداوليّة في وصيّة الإمام الصّادق (ع) لعبد الله بن جندب في ضوء علمي البيان والبديع
اسم الكاتب: د. مريم حسن حجازي
تاريخ النشر: 2025/05/13
اسم المجلة: مجلة أوراق ثقافية
عدد المجلة: 37
تحميل البحث بصيغة PDFADOI: https://aif-doi.org/awraq/013706
دراسة تداوليّة في وصيّة الإمام الصّادق (ع) لعبد الله بن جندب في ضوء علمي البيان والبديع
“A Pragmatic Study of the Will of Imam Al-Sadiq (peace be upon him) to Abdullah ibn Jundab in Light of the Sciences of Rhetoric and Eloquence.”
Dr. Mariam Hasan Hijazi د. مريم حسن حجازي)[1](
تاريخ الإرسال:8-4-2025 تاريخ القبول:20-4-2025
الملخّص turnitin:20%
بما أنّ التّداوليّة تعدّ اليوم من العلوم المهمّة الّتي يجري اللّجوء إليها من أجل كشف النّصوص من خلال مقاربات تعتمد على بيان آليّات المنهج التّداوليّ الّذي يهتمّ بمباحث عديدة كالإقناع والحجاج، جرى تقديم هذه الدّراسة لتسليط الضّوء على الأبعاد التّداوليّة من خلال استثمار وصيّة الإمام الصّادق (ع) لعبد الله بن جندب، وذلك بعنوان “دراسة تداوليّة في وصيّة الإمام الصّادق (ع) لعبد الله بن جندب في ضوء علمي البيان والبديع” متوقّفة عند الوظيفة التّأثيريّة في المتلقّي الّتي حملها كلّ من علم البيان وعلم البديع. استُهلّ البحث بتمهيد يتوقّف عند الأغراض التّواصليّة الّتي يمكن أن يتوخّاها منتِج النّصّ من خلال الصّور البلاغيّة، بالإضافة إلى الإضاءة على طبيعة المدوّنة الّتي سبق ذكرها. بعدها بنيتِ الدّراسة على أساس مبحثين اثنين، يرتبط الأوّل بالآليّات التّداوليّة في ضوء علم البيان في وصيّة الإمام الصّادق (ع)، بينما يرتبط الثّاني بالآليّات التّداوليّة في ضوء علم البديع في الوصيّة نفسها. وفي نهاية البحث جمعت ما تيسّر جمعه من النّتائج في الخاتمة.
الكلمات المفتاحيّة: دراسة تداوليّة، البيان، البديع، التّشبيه، الاستعارة، الكناية، المحسّنات البديعيّة المعنويّة، المحسّنات البديعيّة اللّفظيّة، الطّباق، المقابلة، التّقسيم، الجمع، التّفريق، التّضمين، المحسّنات البديعيّة اللّفظيّة، السّجع، الالتفات، الجناس، الازدواج.
Summary
Since pragmatics is considered one of the most important fields of study today, used to analyze texts through approaches that rely on understanding the mechanisms of pragmatic methodology, which addresses various issues such as persuasion and argumentation, this study was presented to shed light on the pragmatic dimensions through the examination of the will of Imam Al-Sadiq (PBUH) to Abdullah bin Jundab. The study is titled “A Pragmatic Study of the Will of Imam Al-Sadiq (PBUH) to Abdullah bin Jundab in the Light of Rhetoric and Stylistics.” It focuses on the influence function on the recipient carried by both rhetoric (ilm al-bayan) and stylistics (ilm al-badiʿ).
The research begins with an introduction that explores the communicative purposes that the text producer may aim for through rhetorical figures, in addition to shedding light on the nature of the text being studied. The study is then divided into two sections: the first examines the pragmatic mechanisms in the light of rhetoric in Imam Al-Sadiq’s will, while the second looks at the pragmatic mechanisms in the light of stylistics in the same will. At the end of the study, the findings are summarized in the conclusion.
Keywords: Pragmatic Study, Rhetoric, Stylistics, Simile, Metaphor, Synecdoche, Figurative Stylistic Devices, Verbal Stylistic Devices, Antithesis, Parataxis, Classification, Union, Division, Embedding, Verbal Stylistic Devices, Parallelism, Shift, Puns, Redundancy.
تمهيد: إنّ حاجة الخطاب للبلاغة هي حاجة أساسيّة لا يمكن الاستغناء عنها، ذلك أنّه إذا كان الهدف من الخطاب هو تحقيق التّواصل مع المتلقّين، فلا بدّ عندئذٍ من استخدام أساليب معيّنة لأجل إقناعهم والتّأثير فيهم، وهذه الحاجة تعني بالضّرورة توظيف الصّور البلاغيّة وسواها من أساليب الإقناع. والجدير ذكره، أنّ البلاغة قد تحقّق التّأثير والاستمالة، لكنّها لن تصل إلى مرحلة الإقناع ما لم تترافق مع الحجج والمحاجّة. وهذا ما يتيح لها أن تتحوّل من غرضها الجماليّ، نحو أداء أغراض تواصليّة، وإنجاز مقاصد حجاجيّة، وإفادة أبعاد تداوليّة.
قبيل الانطلاق نحو مضامين هذه الدّراسة لا بدّ من تسليط الضّوء على طبيعة المدوّنة الّتي جرى انتقاؤها. فوصيّة الإمام الصّادق (ع) لعبد الله بن جندب تشتمل على وصايا نافعة وجليلة في شؤون متنوّعة، وهي تحمل في طيّاتها الكثير من الدّروس، والعبر الّتي يفيد منها المتلقّي بشكل يتخطّى حدود الزّمان والمكان اللّذين تنتمي إليهما هذه الوصيّة، وهذا ما حباني إلى اختيارها نظرًا لكونها شأن كلّ ما صدر من خطاب عن أهل البيت الأتقياء عليهم السّلام، تراثًا فكريًّا قيّمًا ينبغي للسّالك درب الحياة أن يقتدي بها وينتفع بما تقدّمه من إرشادات ومواعظ.
منهج البحث: يعتمد هذا البحث على المنهج التّداوليّ البلاغيّ الّذي يجمع بين النّظريّة التّداوليّة وعلوم البلاغة، وتحديدًا علميّ البيان والبديع، لتحليل وصيّة الإمام الصّادق (عليه السّلام) لعبد الله بن جندب. يقوم هذا المنهج على دراسة الخطاب في ضوء السّياق والمقام، والعلاقة مع المتلقّي، بهدف كشف الوظائف الإقناعيّة والتّأثيريّة للنّصّ. وقد سعى الباحث إلى توظيف علم البيان من خلال تحليل الأساليب البلاغيّة مثل التّشبيه والاستعارة والكناية لفهم الدّلالات العميقة، كما استعان بعلم البديع لدراسة المحسّنات اللّفظيّة والمعنويّة كالجناس والطّباق والسّجع، لبيان جماليّات النّصّ وفاعليّته في التّأثير على المتلقّي.
المبحث الأوّل: الآليّات التّداوليّة في ضوء علم البيان في وصيّة الإمام الصّادق (ع) لعبد الله بن جندب.
تمهيد: البيان لغةً يعني “ما بُيِّن به الشّيء من الدّلالة وغيرها، وبان الشّيء بيانًا اتّضح، فهو بيّنٌ. وكذلك أبان الشّيء فهو مبين، وأبنته أي أوضحته”(1). أمّا اصطلاحًا، فالبيان هو”أصول وقواعد يعرف بها إيراد المعنى الواحد، بطرق يختلف بعضها عن بعض في وضوح الدّلالة على نفس ذلك المعنى”)2(.
وفي هذا المبحث سيجري التّوقّف عند شواهد من وصيّة الإمام الصّادق (ع) لعبد الله بن جندب بغية الكشف عن الجانب التّداوليّ للصّور البيانيّة.
- التّشبيه: لغةً: “الشِّبه، والشَّبه: المِثل، والجمع: أشباه، وأشبه الشّيء الشّيء: ماثله، والتّشبيه: التّمثيل”(3). أمّا اصطلاحًا، فالتّشبيه هو”الدّلالة على مشاركة شيء لشيء في معنًى من المعاني أو أكثر، على سبيل التّطابق أو التّقارب لغرض ما”(4).
ينعقد التّشبيه بين طرفين: يسمّى أوّلهما المشبّه، والثّاني المشبّه به. وقد يحذف وجه الشّبه وأداة التّشبيه لتقريب صفات المشبّه من المشبّه به، ما يدفع المتلقّي إلى البحث عن وجه الشّبه الّذي يشكّل سمةً مشتركة بين المشبّه والمشبّه به. من هنا يمكن القول إنّ التّشبيه هو عقد علاقة مشابهة بين طرفين لاشتراكهما بصفة أو أكثر، بأداة ظاهرة تربط بينهما، أو تُحذف للمبالغة.
والجدير ذكره أنّ الأدباء والخطباء لم يستعملوا التّشبيه للحلية والتّزيين فحسب، بل كانوا يعون أنّ للتّشبيه قيمةً حجاجيّة كبيرة، إذ إنّه يقرّب المسافات بين المعاني المجرّدة والمعاني المحسوسة، ليجعل العقل يقبل العلاقات القائمة بين الأشياء. والمحاجج عندما يميل إلى التّشبيه، يرجو من ذلك إيصال الحجّة إلى ذهن المتلقّي، فيصوّرها بصورة بيانيّة تشبيهيّة، ليستوعبها المتلقّي مثلما يشعر بها هو، و”يدرك المتلقّي بالتّشبيه مقاصد المرسِل الّذي يحاول تثبيت حجّته باستمالة المتلقّي والتّأثير فيه”(5).
والتّشـابيه الواردة في المـدوّنة المخـتارة بمعظـمها تشابيه حجـاجيّة، إذ إنّ الغـاية منها إيصال الحجّة إلى ذهن المتلقّي، سواء أكان ينتمي إلى العصر الّذي كتبت فيه، أم إلى أيّ عصر في أيّ زمان ومكان. ومن الأمثلة على تلك التّشابيه ما يأتي:
– “من حسد مؤمنًا انماث الإيمان في قلبه كما ينماث الملح في الماء”.”شبّه الإمام الصّادق عليه السّلام في هذا الكلام، في إطار الحديث عن الحسد، الإيمان في القلب بالملح في الماء لوجود صفة مشتركة بينهما هي الانمياث أي الذّوبان، ما يعني أنّ صفة الحسد متى اصطبغ بها الإنسان، فإنّ مؤدّاها هو زوال الإيمان أي الضّلال. لقد أراد الإمام عليه السّلام من خلال هذا التّشبيه أن يدعو الإنسان إلى شكر الله على نعمه، والابتعاد من الحسد لأنّ فيه هلاكًا لصاحبه، وفي ذلك رغبة في إقناع المتلقّي في ضرورة تهذيب النّفس والصّلاح، والتّحلّي بسمة القناعة الّتي تورث صاحبها راحة وطمأنينة.
– “الماشي في حاجة أخيه كالسّاعي بين الصّفا والمروة، وقاضي حاجته كالمتشحّط بدمه في سبيل الله يوم بدر وأحد”.
تألّف هذا القول من تشبيهين متتاليين، فقد شبّه الإنسان الماشي في حاجة أخيه الإنسان بالسّاعي بين الصّفا والمروة، والإنسان القاضي لحاجة أخيه الإنسان بالمتشحّط بدمه في سبيل الله. ويعدّ هذان التّشبيهان من التّشابيه الحجاجيّة اللّافتة الّتي سطّرها المرسِل في وصاياه، إذ أراد من خلالهما إلقاء الحجّة على المتلقّين لئلّا يكونوا غير مبادرين إلى مساعدة إخوانهم، وهكذا يستشفّ المتلقّي من السّياق أنّ الإمام يحاول إقناعه بأهمّيّة خدمة الآخرين من حيث الدّافع والنّيّة والسّعي والإخلاص والعمل لما في ذلك من أجر وثواب عظيمين، وفي كلّ ذلك تأكيد على قيمة الإيثار “إذ يقدّم الإنسان غيره على نفسه من دون أن يكون ذلك لأغراض مادّيّة ودنيويّة”(6).
نستخلص من ذلك أنّ التّشبيه وسيلة حجاجيّة، يتوجّه به المحاجج إلى عقل المتلقّي، لينقله من الحالة التّصويريّة إلى الإقناع، ولذا عدّ من العناصر المهمّة، والفعّالة في الخطاب التّأثيريّ، وجزءًا لا يتجزّأ من بنية النّصّ الحجاجيّ.
- الاستعارة: الاستعارة لغة “رفع الشّيء وتحويله من مكان إلى آخر، يقال: استعار فلان سهمًا من كنانته، رفعه وحوّله منها إلى يده.” (7) أمّا اصطلاحًا، فاستنادًا إلى عبد القاهر الجرجانيّ “الاستعارة في الجملة أن يكون لفظ الأصل في الوضـع اللّغويّ معـروفًا، تدلّ الشّـواهد علـى أنّـه اختـصّ به حين وضع، ثمّ يسـتعمله الشّـاعر، وغير الشّاعر في غير ذلك الأصل، وينقله إليه نقلًا غير لازم، فيكون هناك كالعارية”(8). والاستعارة الحجاجيّة “تهدف إلى تغيير في الموقف الفكريّ أو العاطفيّ للمتلقّي”(9)، أي أنّ لها هدفًا محدّدًا وهو إحداث تغيير في مواقف المتلقّي، وهي نوع كثير الانتشار لارتباطها بمقاصد المتكلّمين، وبسياقاتهم التّخاطبيّة والتّواصليّة؛ ما يعني أنّ بنية الاستعارة تتجاوز الوحدة اللّغويّة المفردة، وتحدث التّفاعل بين طرفيها: المستعار والمستعار له. فالنّظرة التّداوليّة للاستعارة تعدُّها “وسيلة لغويّة تواصليّة، وتفسّرها على مستويين بلاغيّين: مستوى التّواصل والتّفاعل البشريّ، والمستوى الأدبيّ والفنّيّ”(10).
وهكذا، فإنّ الاستعارة لا تقتصر على الإمتاع فحسب، بل لها وظيفة أخرى، وهي الوظيفة الحجاجيّة الّتي تهدف إلى الإقناع، ولهذا السّبب حظيت الاستعارة باهتمام الحجاجيّين، فهم يعدُّون أنّها تمثّل “مركز الحجاج وأهمّ آليّاته البلاغيّة، نظرًا لما تحقّقه من نتائج إيجابيّة في تقريب المعنى إلى ذهن القارئ”(11).
لقد وردت الاستعارة الحجاجيّة في وصيّة الإمام الصّادق (ع) متباينة الأشكال والغايات بحسب مقاصد الخطاب، ومن الشّواهد على ذلك:
_ “إيّاكم والنّظرة فإنّها تزرع في القلب الشّهوة…”
في هذا القول شبّه صاحب الوصايا النّظرة بالإنسان، ثمّ حذف المشبّه به، وصرّح بالمشبّه، أي أنّها استعارة مكنيّة. عمد الإمام الصّادق عليه السّلام إلى هذه الاستعارة لثقته البالغة أنّ الاستعارة في هذا الموضع من السّياق، تكون أبلغ من الحقيقة، وأقوى حجاجًا، وأكثر وقعًا وتأثيرًا في المتلقّي، فأراد الإمام من هذه الاستعارة أن يلفت نظر المتلقّي إلى أنّ الإنسان الّذي ينظر إلى الأمور الّتي لا يجوز له النّظر إليها، فـ”إنّه في الواقع يكون كمن بذر في قلبه بذور الشّهوة، ونتيجة ذلك أنّ هذا الإنسان لن يصل إلى أهدافه العقلانيّة”. (12) إنّ الّذي يمعن النّظر في هذه الاستعارة أكثر، يجد أنّ المراد منها ذو دلالة أعمق، إذ يراد لفت نظر المتلقّي للوقوف عندها، والانتباه إلى محاذير عدم اجتناب النّظر إلى المحرّمات لأنّ ذلك كافٍ لوقوع الإنسان في الفتنة والانحراف عن المسير الصّحيح.
_ “لبس ثوب الاستهانة…”
أضـفى الإمام الصّادق (ع) عـلى المعنى المجرّد(الاستهانة) صفة حسّيّة وهي (الثّوب)، وغايـته مـن ذلـك تبسيط حالات لا تصمد أمام مقاومة التّحليل الذّهنيّ، ليلفت نظر المتلقّي إلى قيمة النّعم الّتي يمنحها الله للإنسان، إلّا أنّ الأخير يغفل عنها، ويستخفّ بها حتّى يصل لمرحلة أنّ الاستهانة بكلّ ما يرتبط بعلاقته باللّه تصبح لبوسًا له، لا ينزعه على الرّغم من الإعانة الّتي تتزامن مع التّكليف المنوط به. لقد وظّف الإمام هذه الاستعارة لتقوية المعنى، وزيادة تأثيره في المرسَل إليه. هذا التّعبير المجازيّ هو أشدّ وقعًا في نفس المتلقّي من التّعبير الحقيقيّ وعن مثل هذا يقول ميشيل لوجيرن Michel Logern: “إنّ للاستعارة الحاملة حكمًا قيّمة أثرًا في المتلقّي هو أشدّ قوّة من ذلك الأثر، الّذي يتركه فيه التّعبير عن نفس الحكم بواسطة الألفاظ المستخدمة على الحقيقة”(13).
من خلال ما تقدّم، اتّضحت أهمّيّة الاستعارة في وصيّة الإمام الصّادق (ع)، وقوّتها الحجاجيّة، وفضلها في إبراز المعاني. ونخلص إلى أنّ الاستعارة تعدّ من الوسائل اللّغويّة البيانيّة المهمّة الّتي يستند إليها المحاجج للوصول إلى أهدافه الحجاجيّة، بل إنّها تأتي في المقام الأوّل نظرًا لما يتمتّع به القول الاستعاريّ من قوّة حجاجيّة عالية، إذا ما قورن بالأقوال العاديّة.
- الكناية: الكناية لغةً: “أن تتكلّم بشيء وتريد غيره، وكنّى عن الأمر بغيره يكنّي كناية، يعني إذا تكلّم بغيره ممّا يستدلّ عليه”(14). أمّا اصطلاحًا، فهي “ترك التّصريح بذكر الشّيء إلى ذكـر ما يلزمه، لينتقل من المذكور إلى المتروك”(15).
والكناية أبلغ وأقوى حجاجًا من التّصريح، والمعنى الّذي يفهمه المتلقّي من قصد المحاجج بعد تدبّر وتفكّر، يكون أقوى تأثيرًا من المعنى الصّريح، لأنّه يخضعه إلى عمليّة عقليّة ذهنيّة، فالمحاجج عندما يكنّي يريد إشراك المتلقّي في العمليّة الحجاجيّة، ويدفعه إلى إدراك العمليّة الدّلاليّة التّلازميّة ما بين المعنى السّطحيّ الظّاهر(المكنّى به)، والمعنى الخفيّ الّذي يريد المحاجج التّوصّل إليه (المكنّى عنه)، ما يجعله يتوصّل إلى الفكرة الّتي يريدها المحاجج بنفسه. وهذا الأمر يجعل تقبّلها والاقتناع بها أقوى من التّصريح؛ من هنا، فإنّ الكناية تشكّل حجّة يتوجّه بها المحاجج إلى عقل المتلقّي، لينقله من التّعبير الكلاميّ الظّاهر إلى دلالة أعمق تردفها في التّداول، وهذا ما جعلها تستقطب انتباه البلغاء إليها. وقد ورد في كتاب “الأسلوب الكنائيّ في القرآن الكريم” أنّ الكناية “وسيلة قويّة من وسائل التّأثير والإقناع، ولها أثر كبير في تحسين الأسلوب”(16). ولذا نجد الكناية تحظى باهتمام الإمام الصّادق (ع)، فإذا رأى في موضوع ما من خطابه أنّ الكناية فيه أبلغ وأقوى حجاجًا من التّصريح عمد إليها. وللكناية أغراض تداوليّة عدّة أبرزها التّرغيب والتّرهيب، التّعمية، المبالغة، الزّجر، والتّعبير بلفظ حسن عن أمر قبيح… وفيما يأتي بعض الأمثلة على ذلك:
– “طوبى لمن جعل بصره في قلبه، ولم يجعل بصره في عينه.”
في معرض الإتيان بقصّة عن النّبيّ عيسى عليه السّلام يرويها لحواريّيه، يرد هذا الشّاهد الّذي ينقله الإمام الصّادق (ع)، وفي ذلك كناية عن أنّ الإنسان يعمد إلى كشف أخطاء الآخرين وعيوبهم من دون السّتر عليها. لقد عمد الإمام إلى هذه الكناية في هذا الموضع لأنّها أبلغ، وآكد، وأقوى حجاجًا من التّصريح، وهذه الكناية عندما تطرق ذهن المتلقّي، فإنّها تدفعه إلى إيجاد علاقة تلازميّة بين اللّفظ الظّاهر والمعنى الخفيّ، وهكذا يتوصّل الإمام إلى إشراك المتلقّي في النّصّ الحجاجيّ، ليخلص معه إلى تأكيد الحثّ على قبول توصياته وتوجيهاته من باب الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر، مؤكّدًا أنّ رصد سيّئات الآخرين وإذاعتها أمران مذمومان.
– “ألا ترى أنّ شمسه أشرقت على الأبرار والفجّار، وأنّ مطره ينزل على الصّالحين والخاطئين.”
كناية تحمل في غرضها التّداوليّ ترغيبًا للمتلقّي للصّفح والعفو عن الخاطئين، فالشّمس والمطر تجسّد حاجات ملحّة للحياة، يمنحها الله لعباده مهما أخطأوا، فهو الغفور الرّحيم. من هنا على البشر أن يعدُّوا من ذلك، وأن يتصرّفوا برأفة وعطف ورحمة مع من ارتكبوا الزّلّات. وهنا لا بدّ من الإشارة أنّ هذه الكناية تعمل على إيجاد علاقة تلازميّة بين اللّفظ الظّاهر والمعنى الخفيّ، وهذا المعنى المستتر لا يخلو من الحثّ على التّحلّي بسمة العفو “لكي يعفو عنّا خالق الوجود، إلى جانب وجوب تحصيل رضا النّاس”.( 17) وإشراك هذا المعنى مع المتلقّي كان يهدف إلى إقناعه بعظمة أن يكون الإنسان متسامحًا من غير أن يتملّكه الغيظ والشّحناء تجاه الآخرين.
يتبيّن من خلال ما تقدّم أنّ الإمام الصّادق (ع) قد علم أهمّيّة الكناية في الخطاب، ودورها الفعّال في التّلميح، ومدى تأثيرها على المتلقّي، لأنّها تشتمل على وجهي الحقيقة والكناية، ما يجعل المتلقّي يُعمل فكره، للوصول إلى ما يقوله المرسِل، ولهذا لجأ إليها الإمام في بعض المواضع في رسالته.
يُستخلص ممّا تقدّم في هذا المبحث إلى أنّ سحر البيان لا يأسر القلب فحسب، بل يجعل العقل متفاعلًا معه، باحثًا عن كنه أسراره، فإن اطمأنّ المتلقّي لنيّات المحاجج خضع لسحر البيان قلبًا وقالبًا. وهذا ما لمسناه من خلال دراستنا للوجه التّأثيريّ التّداوليّ للصّور البيانيّة في وصيّة الإمام الصّادق (ع) لابن جندب بالاستناد إلى أمثلة وشواهد واردة فيها عن التّشبيه والاستعارة والكناية.
المبحث الثّاني: الآليّات التّداوليّة في ضوء علم البديع في وصيّة الإمام الصّادق (ع) لعبد الله بن جندب.
تمهيد: لغةً: “البديع، بدع الشّيء، يبدعُه بدْعًا وابتدعَه: أنشأه وبدأه. والبديع: المبدع. وأبدعت الشيء: اخترعته لا على مثال”(18). أمّا اصطلاحًا، فقد شهدت لفظة البديع اهتمامًا كبيرًا من قبل البلاغيّين قديمًا وحديثًا، وتباين مفهومها من بلاغيّ لآخر. وقد ورد في “جواهر البلاغة” أنّ البديع “علم تُعرف به الوجوه والمزايا الّتي تزيد الكلام حسنًا وطلاوة، وتكسوه بهاء ورونقًا بعد مطابقته لمقتضى الحال، ووضوح دلالته على المراد”. (19) وكذلك جاء في معجم المصطلحات: “البديع يزيّن الألفاظ أو المعاني بألوان بديعيّة من الجمال اللّفظيّ أو المعنويّ، ويسمّى العلم الجامع بطرق التّزيّن”(20). وعليه، فإنّ علم البديع هو العلم الجامع للبدائع البلاغيّة المشتملة على المحسّنات البديعيّة، المعنويّة واللّفظيّة، من منثورات جماليّة في الكلام، ما يجعل الكلام أكثر حسنًا وبيانًا وتأثيرًا وإقناعًا.
وللبديع دور حجاجيّ يتوخّى به إقناع المتلقّي فـ”أساليب البيان مثل المقابلة والجناس والطّباق وغيرها، ليست اصطناعًا للتّحسين والبديع، وإنّما هي أصلًا للإبلاغ والتّبليغ”(21). ويعتمد المرسِل على علم البديع في إقناع المرسَل إليه بوجهة نظره، إذ يخرج المحسّن البديعيّ من دائرة الزّخرفة إلى دائرة أوسع هي الإقناع، فلا ينحصر دوره في وظيفته الشّكليّة وما تضفيه على الكلام من زخرفة وتزويق، إنّما له دور حجاجيّ يرمي إلى الإقناع، أمّا إذا لم يُنتج الخطاب استمالة للمخاطب، فـ”إنّ المحسّن البديعيّ يتمّ إدراكه باعتباره زخرفة، ويعود ذلك إلى تقصيره في أداء دور الإقناع.”(22)
ويمكن الوقوف عند الدّور التّأثيريّ الّذي يقوم به البديع في المدوّنة المختارة عبر تتبّعه من خلال المحسّنات البديعيّة المعنويّة واللّفظيّة، والتّوقّف عند بعض الشّواهد والأمثلة الّتي تستميل المتلقّي وتساهم في إقناعه بأفكار المرسِل.
- المحسّنات البديعيّة المعنويّة: هي الّتي يكون التّحسين فيها راجع إلى المعنى أوّلًا وبالذّات، وإن كان بعضها قد يفيد تحسين اللّفظ أيضًا، ومنها الطّباق، المقابلة، التّقسيم، الجمع، التّفريق، والتّضمين.
1.1. الطّباق: المطابقة لغةً تعني “الموافقة والتّطابق يعني الاتّفاق”(23)، ولكنّها اصطلاحًا تعدّ من المحسّنات المعنويّة، وتسمّى الطّباق والتّضادّ أيضًا، و”هي الجمع بين المتضادّين، أي معنيين متقابلين في الجملة”. (24)
وقد عمد الإمام الصّادق (ع) إلى استخدام واسع للطّباق الحجاجيّ في وصيّته الّذي يهدف إلى استمالة المتلقّي وإقناعه، وفي ما يأتي يرد جدولٌ يظهر بعض تلك الطّباقات:
| الطّباق الوارد |
| أنسوا- استوحشوا/ يوم- ليلة |
| حسنة-سيّئة/ الدّنيا- الآخرة |
| الجهل- علم/ من فوقهم- من تحت |
| يهلك- ينجو/ الثّواب- العذاب |
| اللّيل- النّهار/ ليلًا- نهارًا |
| يقبل- لا يقبل/ قدّمت- أخّرت |
| دنياه- آخرته/ عسر- يسرًا |
| تكبّر- التّواضع/ الغنى- الفقر |
| فوقك- دونك/ مدخله- مخرجه |
| الدّاء- الدّواء/ جاهلًا- عالمًا |
| العلماء- الجهّال/ تشتهون- تكرهون |
| مبتلى- معافى/ صل- قطعك |
نلاحظ بناء على ما تقدّم الاستعمال المكثّف لهذا المحسّن البديعيّ المعنويّ نظرًا لأهمّيّته في عمليّة الإقناع والتّأثير، لما له من قوّة في استمالة المتلقّين عبر صوره الحسّيّة، والمعنويّة الّتي تصوّر الواقع بمادّيّته أحيانًا، وتلامس المشاعر والعواطف أحيانًا أخرى، إضافة إلى جرسه المتناغم الّذي يشدّ الانتباه، وبالتّالي فإنّ الاستعانة بالطّباق كان كفيلًا بتوضيح المعنى، وخلق جوّ من التّأثير لدى المتلقّي دون أيّ تكلّف أو تصنّع.
ولمقاربة الأمر بشكل أوضح سيجري توضيح القيمة الحجاجيّة للطّباق من خلال المثلين الآتيين:
– “صل من قطعك، وأعـط من حرمـك، وأحســـن إلـى من أســـاء إليك، وسـلّم على من ســـبّك، وأنصـف من خاصمك، واعف عمّن ظلمك.”
هذا الشّاهد المأخوذ من الوصيّة جمع الكثير من المفردات المتناقضة في المعنى اللّغويّ، وهي جميعها طباقات إيجاب حقيقيّة بين أفعال أمر، وأفعال ماضية والّتي لها وظيفة حجاجيّة في هذا التّركيب، وهي صورة رائعة في الجماليّة، والدّور الحجاجيّ للطّباق هنا بارز، ولو كانت هذه المفردات منسلخة عن سياقها الّذي وردت فيه، لما كان لها أن تؤدي هذه الوظيفة الجماليّة الحجاجيّة الّتي تروم إبلاغ المتلقّين أنّ صرف النّظر عن التّصرّفات القبيحة للآخرين يشكّل قيمة عظيمة وسامية. لم تقف هذه الطّباقات المتتالية عند حدود التّوضيح للفكرة، إنّما تعدّتها لترك أثر عميق في المتلقّي غايته تلامس وجدانه وتحرّك كيانه؛ فيعي حقيقة ذلك النّظام القيميّ، والأخلاقيّ الّذي أرساه الإسلام فالتّصرّف الحسن في مقابل التّصرّف السّيّئ، الّذي يصدر من الغير. كلّ ذلك يؤكّد أنّ المنظومة القيميّة الإسلاميّة تعلي من شأن السّلوكيّات الإنسانيّة، وتعزّز النّاحية القيميّة لدى الإنسان.
– “طوبى لعبد لم يغبط الخاطئين على نعيم الدّنيا وزهرتها، طوبى لعبد طلب الآخرة وسعى لها.”
أدرج الإمام الصّادق عليه السّلام في هذا الكلام طباق الإيجاب بين “الدّنيا” و”الآخرة” كأداة لتحقيق مقصده المتمثّل في إبلاغ وإقناع المتلقّي أنّه ينبغي التّوجّه إلى الآخرة، وتجنّب الانبهار بالدّنيا، بما يتوافق وينسجم مع ما دعا إليه النّبيّ الأكرم (ص) في مواعظه، وكذلك أهل البيت عليهم السّلام. وهكذا يكون هذا الطّباق حجّة تدعم وجهة نظر المرسِل، للمساهمة في إفهام المتلقّي وتعميق فكره، وجعله يقتنع بأنّه ينبغي استصغار الدّنيا لكونها دارًا فانية، بينما الآخرة خير وأبقى. من هنا، فإنّه على الإنسان ألّا ينخدع بمغريات الدّنيا، ولا يتعلّق قلبه بها، بل التّعلّق بالآخرة لأنّها تجسّد السّعادة الأبديّة الدّائمة.
2.1. المقابلة: لغةً: أصل المقابلة عند اللّغويّين من “قابل الشّيء بالشّيء مقابلةً وقبالاً إذا عارضـه. فـإذا ضممت شيئًا إلی شيء قلت :قابلته به والمقابلة: المواجهة والتّقابل مثله.”(25) أمّا اصطلاحًا، فقد عرّف أحمد مصطفى المراغي المقابلة بقوله: “هي أن يؤتى بمعنيين متوافقين أو أكثر، ثمّ يؤتى بما يقابل ذلك، على سبيل التّرتيب”(26). وفي ما يأتي يرد جدول يُثبت فيه بعض ما ورد من مقابلة حجاجيّة في المدوّنة المنتقاة:
| المقابلة الواردة |
| إن رأى حسنة استزاد منها، وإن رأى سيّئة استغفر منها |
| والانا ولم يوال عدوّنا |
| قال ما يعلم وسكت عمّا لا يعلم |
| شوقًا إلى الثّواب وخوفًا من العذاب |
| لم ما قدّمت وعليك ما أخّرت |
| من قنع شبع، ومن لم يقنع لم يشبع |
| لا تكن بطرًا في الغنى، ولا جزعًا في الفقر |
| طوبى لمن جعل بصره في قلبه، ولم يجعل بصره في عينه |
| الخير كلّه في الجنّة والشّرّ كلّه في النّار |
ولإبراز القيمة الحجاجيّة للمقابلة، نورد شرحًا لمثلين حول المقابلة وفق السّياق الّذي ورد به كلّ منهما:
– “إن رأى حسنة استزاد منها، وإن رأى سيّئة استغفر منها.”
إنّ هذه المقابلة هي مقابلة كلمتين بكلمتين، إذ جاءت لفظة “حسنة” بمقابل لفظة “سيّئة”، ولفظة “استزاد” بمقابل لفظة “استغفر”. وقد عملت هذه المقابلة كحجّة تأكيديّة، يروم المرسِل من خلالها إقناع المتلقّي بفكرة مفادها أنّه “على كلّ إنسان أن يحاسب نفسه، فإن رأى توفيق الأعمال الصّالحة فعليه أن يسأل الله المزيد من هذا التّوفيق، وإذا رأى الزّلّات والمعاصي فعليه أن يستغفر الله لكي لا يبتلى يوم القيامة بالخزي.”( 27) وهكذا، فإنّه يترتّب على الإنسان أن يدقّق في أعماله، ويتفحّصها جيّدًا لدرجة أن يميّز فيما بينها، ويدرك العمل الصّالح من الطّالح، فيصدر بعد ذلك حكمًا على نفسه ما إذا كان سيداوم على فعل الخير أو يتراجع عن فعل قبيح يقوم به.
– “الخير كلّه في الجنّة والشّرّ كلّه في النّار.”
وردت هذه المقابلة في إطار الحديث عن السّعادة والشّقاء الحقيقين. إنّها مقابلة لفظتين “الخير والجنّة” بلفظتين”عزّ الشّرّ والنّار”. ولهذه المقابلة قدرة حجاجيّة على إقناع المتلقّي بأنّ الخير والشّرّ في الدّنيا نسبيّان، في حين أنّ الخير والشّرّ في الآخرة حقيقيّان. من هنا، فإنّ على الإنسان أن يعي بأنّ عليه أن يستفيد من خير الدّنيا لعمارة الآخرة، وأن يتجنّب شرورها لئلّا يُحرم من السّعادة الحقيقيّة الأبديّة، الّتي تقدّمها دار الآخرة الخالدة.
3.1. التّقسيم: وردت لفظة التّقسيم في المعاجم الغربيّة قديمًا وحديثًا في مادّة (قسم) فقد جاءت في أساس البلاغة “قسّم المال بينهم قسْمًا، وقسموه تقسيمًا واقتسموه وتقسّموه، وقاسمته المال مقاسمةً”(28). أمّا اصطلاحًا، فقد عرّف أبو هلال العسكريّ، التّقسيم بأنّه يتجسّد في “أن تقسم الكلام قسمة متساوية تحتوي على جميع أنواعه، ولا يخرج منها جنس من أجناسه.”(29)
والتّقسيم هو نوع من أنواع البديع التّداوليّ يخضع لآليات تشحذ الذّهن لإيجاد علاقـات بين أجزاء الكلام وفق قواعد منطقيّة، كعلاقة الكلّ بالجزء، أو خلاف ذلك، أو أجزاء مجموعة لأجزاء مجموعة أخرى، لتتشاكل معها بروابط دلاليّة أو منطقيّة أو غير ذلك.
والمدوّنة المختارة حافلة بالشّواهد على التّقسيم، وسأعمد إلى تبيان القيمة الحجاجيّة للشّاهدين الآتيين:
– “إنّما شيعتنا يعرفون بخصال شتّى، بالسّخاء والبذل للإخوان، وأن يصلّوا الخمسين ليلا ونهارًا. شيعتنا لا يهرّون هرير الكلب ولا يطمعون طمع الغراب… ”
ورد التّقسيم بشكل لافت في ما تقدّم من شاهد، فبعد أن بيّن المرسِل أنّ ثمّة خصالًا متنوعّة يتّسم بها الشّيعة، عرض طبيعة تلك الخصال. وفي هذا التّقسيم طاقة حجاجيّة واسعة، وذلك من أجل إقناع المتلقّي بشموليّة هذه الخصال وتكاملها سويًّا لأجل بناء فكرة أنّ الانتماء إلى الشّيعة ليس انتماء شكليًّا، بل يترافق مع سلسلة مزايا أبرزها الجود والعطاء وبسط اليد تجاه الآخرين، بالإضافة إلى “صلاة 51 ركعة في اللّيل والنّهار، والتّعبير بخمسين هو من باب التّغليب”(30). زد على ذلك، أنّ الشّيعة لا يبادرون إلى أذيّة الآخرين كما يفعل الكلب المفترس، ولا يجمعون من المال ما يزيد عن حاجتهم كما يفعل الغراب.
– “الإسلام عريان، فلباسه الحياء وزينته الوقار ومروءته العمل الصّالح وعماده الورع.”
في هذا المثال تقسيم، وقد استوفى الإمام الصّادق عليه السّلام المراد من كلمة “الإسلام” من خلال الكلمات الأربع الآتية: لباسه، وزينته، ومروءته، وعماده. لقد أمكن لهذا التّقسيم أن يؤدّي قوّة حجاجيّة كبيرة للدّلالة على الإحاطة بالسّمات الّتي ينبغي أن يتحلّى بها المسلم على عدِّها وحدة موحّدة. والأمر الجوهريّ الّذي أراد الإمام الصّادق عليه السّلام إقناع المتلقّي به هو أن يدرك الإنسان المسلم ما يفترض أن يتميّز به من حياء ووقار وعمل صالح وورع. وبذلك يكون هذا التّقسيم قد أدّى وظيفته على أكمل وجه، وهي إرساء المبادئ الواضحة والمتينة، الّتي تمكّن المرء من الاهتداء إلى الصّراط المستقيم الّذي يرسمه له الإسلام.
4.1. الجمع: لغةً: “جمع الشّيء عن تفرقة يجمعه جمْعًا، والجمع اسم لجماعة الناس، وجمعه جموع. والجمع مصدر قولك جمعت الشّيء”(31). أمّا اصطلاحًا، فقد جاء في الصّناعتين: “هو أن يجمع في كلام قليل أشياء كثيرة مختلفة أو متّفقة”(32).
ومن الشّواهد على الجمع في المدوّنة المنتقاة، والّتي تحمل في ثناياها قوّة حجاجيّة ما يأتي:
– “محفوفًا بالزّبرجد والحرير منجّدًا بالسّندس والدّيباج…”
جمع صاحب الوصايا في هذا الكلام أربع مفردات مختلفة عن بعضها البعض(الزّبرجد، الحرير، السّندس، والدّيباج)، لكنّها تشترك في كونها تندرج ضمن الأشياء الفاخرة من أحجار كريمة وثياب. كلّ ذلك لتّأكيد أنّ السّور الّذي سيبنى بين المؤمنين والمنافقين سيكون جزاء من عمل صالحًا، لذلك سوف يتزيّا بكلّ ما هو فاخر وأنيق من خيوط ثمينة وحجار كريمة وغيرها من الأمور الّتي شكّل احتشادها وجمعها ضمن الكلام الواحد وسيلة لإقناع المتلقّين بعظمة ذلك السّور وجماله.
– “من غشّ أخاه وحقّره وناوأه جعل اللّه النّار مأواه.”
في أثناء الحديث عن مسؤوليّات الإنسان المؤمن تجاه أخيه الإنسان، عمد صاحب الوصايا إلى حشد مفردات عديدة، تعبّر عن خداع الآخر لإقناع المرسَل إليه أنّ الّذي يحتقر الآخرين، ويقلّل من شأنهم ويخدعهم فمصيره الحتميّ العذاب الإلهيّ ومثواه النّهائيّ هو النّار.
5.1. التّفريق: لغةً: “الفرق خلاف الجمع، فرقه يفرقه فرْقًا، وفرّق للإفساد تفريقًا. والفرق الفصل بين الشيئين، والفِرْق: القِسم والجمع أفراق”(33). أمّا اصطلاحًا، ففي جواهر البلاغة: “هو أن يعمد المتكلّم إلى شيئين من نوع واحد، فيوقع بينهما تفريقًا وتباينًا يذكر ما يفيد معنى زائدًا فيما هو بصدده من مدح أو ذمّ أو غير ذلك من الأغراض”(34).
ومن الشّواهد على التّفريق المعتمد لغاية حجاجيّة في وصيّة الإمام الصّادق (ع) لابن جندب ما يأتي:
– “طوبى لمن جعل بصره في قلبه، ولك يجعل بصره في عينه.”
في هذا الكلام فرّق الإمام الصّادق عليه السّلام بين الإنسان الّذي يتأنّى في إصدار الأحكام والإنسان الّذي يصدر أحكامًا متسرّعة ومنفعلة، وذلك ليلفت انتباه المتلقّي إلى أنّه يجب السّعي لاجتناب الأحكام المنفعلة، والسّطحيّة والاعتماد على العقل الّذي يجمع الإدراكات الباطنيّة والعميقة. وهكذا يكون التّفريق قد ساهم بإقناع المتلقّي وإرشاده لضرورة التّحلّي بالعقلانيّة، والحكمة في الحكم على الأشياء وعدم الاكتفاء بالمشاهدات الظّاهريّة والحكم السّريع على أساسها.
– “لا تتصدّق على أعين النّاس ليزكّوك، فإنّك إن فعلت ذلك فقد استوفيت أجرك، ولكن إذا أعطيت بيمينك فلا تطلع عليها شمالك، فإنّ الّذي تتصدّق له سرًّا يجزيك علانية على رؤوس الأشهاد…”
عمد الإمام الصّادق (ع) في هذا الكلام في أثناء حديثه عن الصّدقة والإنفاق إلى التّفريق بين أمرين: العطاء علانيّة والعطاء سرًّا. فالتّصدّق أمام أعين الإنسان يُكسِب صاحبه أجرًا محدودًا، أمّا التّصدّق على نحو سرّيّ فإنّ له أفضل ثواب في الآخرة، لأنّها لا تقوم على الرّياء أو المباهاة.
وهكذا، فإن الإتيان بالتّفريق له طاقة حجاجيّة كامنة في طيّاته، تبصر النّور حال تلقّيها من المرسَل إليه الّذي يعي مسؤوليّته كفرد؛ متى طُلب إليه إبداء النّصيحة أو المشورة.
6.1. التّضمين: لغةً: “ضمّن الشّيء وبه ضمنًا وضمانًا: كفل به. وضمّنه إيّاه: كفّله. وضمّن الشّيء الشّيء: أودعه إياه كما تودع الوعاء المتاع”(35). أمّا اصطلاحًا فقد عرّف ابن الأثير التّضمين أنّه “أن يضمّ الشاعر شعره والنّاثر نثره كلامًا آخر لغيره قصدا للاستعانة على تأكيد المعنى المقصود”(36).
وللتّضمين من القرآن الكريم قيمة حجاجيّة كبيرة كونه المرجع الأوّل للمسلمين، والإتيان بآي حكيم هو وسيلة ناجعة للإقناع، واستمالة المتلقّي إلى المضمون الّذي يريد المرسِل إقناع المرسل إليه به، وكذلك فإنّ الأحاديث القدسيّة والأحاديث النّبويّة تعدّ مرجعًا يعتدّ به من المتلقّين فيسيرون بهديها، ويحذون حذوها، ويسترشدون بما تختزنه من تعليمات… كلّ ذلك من شأنه أيضًا أن يجذب المتلقّي، ويُحدِث تأثيرًا في قناعاته وأفكاره وآرائه، وفي ما يأتي جملة من الشّواهد المرتبطة بما تقدّم ذكره، والمأخوذة من وصيّة الإمام الصّادق (ع) لابن جندب مع تسليط الضّوء على دورها الحجاجيّ ضمن السّياق الّذي وردت به.
أوّلًا: التّضمين من القرآن الكريم: ﴿وَإِذا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آياتُهُ زادَتْهُمْ إِيمانًا﴾ ﴿وَعَلى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾:
يعبّر الإمام الصّادق (ع) من خلال الاستعانة بهاتين الآيتين عن سمات المؤمن الحقيقيّ، المؤمن الّذي لا يكون إيمانه ظاهريًّا فحسب، بل هو في تجدّد إيمانيّ مستمرّ ووسيلة ارتقائه في الهداية هي آيات القرآن الكريم الّتي تجعله يتقرّب من الله أكثر فأكثر. ومن سمات الإيمان الحقيقيّ أيضًا التّوكّل على الله، واليقين أنّ مفتاح الأمور جميعها بيد الله المحيط علمًا بكل شيء. هكذا، أمكن للمرسِل إقناع المتلقّي بالعلامات القلبيّة والباطنيّة الّتي تجعل الإنسان مؤمنًا إيمانًا ثابتًا وحقيقيًّا.
– ﴿لا خَلاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ […] يَوْمَ الْقِيامَةِ وَلا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ﴾ ضمّن الإمام الصّادق (ع) هذه الآية القرآنيّة وصيّته حين كان يتحدّث عن الأشخاص الّذين غفلوا عن صلاتهم بالنّوم والاستخفاف. جيء بهذا التّضمين لإلقاء الحجّة على المتلقّي لكي يكون عالمًا أنّ عاقبة تلك الغفلة؛ وذلك الاستخفاف العذاب الأليم وخسران الآخرة.
– ﴿لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم﴾ عند تعداد الامتيازات الّتي يحصل عليها أهل الشّيعة متى سلكوا طريق الاستقامة أورد الإمام الصّادق (ع) هذه الآية القرآنيّة في إشارة إلى النّعم الّتي ستحيط بهم من كلّ جانب. و”الجملة كناية عن تنعّمهم بنعم السّماء والأرض وإحاطة بركاتهما عليهم”(37)، وفي أبعاد هذه الوصيّة دعوة لأهل الشّيعة للاستقامة وعدم الانحراف عن درب الإيمان لأجل نيل الدّرجات العليا من الله عزّ وجلّ.
ثانيًا: التّضمين من الأحاديث القدسيّة والأحاديث النّبويّة: أدرج الإمام الصّادق (ع) في وصيّته حديثًا قدسيًّا وحديثًا نبويًّا وحديثًا عن والدة أحد الأنبياء في مواضع مختلفة لإعانته على إقناع المتلقّين، وفيما يأتي توضيح دلالة كلّ منها:
– قَالَ اللَّهُ جَلَّ وَعَزَّ فِي بَعْضِ مَا أَوْحَى: إِنَّمَا أَقْبَلُ الصَّلَاةَ مِمَّنْ يَتَوَاضَعُ لِعَظَمَتِي، وَيَكُفُّ نَفْسَهُ عَنِ الشَّهَوَاتِ مِنْ أَجْلِي، وَيَقْطَعُ نَهَارَهُ بِذِكْرِي، وَلَا يَتَعَظَّمُ عَلَى خَلْقِي، وَيُطْعِمُ الْجَائِعَ وَيَكْسُو الْعَارِيَ وَيَرْحَمُ الْمُصَابَ وَيُؤْوِي الْغَرِيبَ، فَذَلِكَ يُشْرِقُ نُورُهُ مِثْلَ الشَّمْسِ، أَجْعَلُ لَهُ فِي الظُّلْمَةِ نُورًا وَفِي الْجَهَالَةِ حِلْمًا، أَكْلَؤُهُ بِعِزَّتِي وَأَسْتَحْفِظُهُ مَلَائِكَتِي، يَدْعُونِي فَأُلَبِّيهِ وَيَسْأَلُنِي فَأُعْطِيهِ…
يعرض الإمام الصّادق (ع) في ما تقدّم من شاهد حديثًا قدسيًّا مرتبطًا بشروط قبول الصّلاة، وهي ذكر عظمة الله، والانقطاع عن الشّهوات، والمواظبة على ذكر الله، والتّواضع أمام العباد، والإنفاق على المحتاجين، ونتيجة مراعاة تلك الشّروط أن يصبح المؤمن من أصحاب البصيرة الباطنيّة فيسطع وجهه كالشّمس، ويحفظه الله بواسطة ملائكته. هذا الإتيان بالحديث القدسيّ من شأنه أن يقنع المتلقّي بما تقدّم من شروط، لئلّا يبقى أداء الصّلاة أداء ظاهريًّا فحسب.
– إِنَّ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ (ع) قَالَ لِأَصْحَابِهِ: أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ مَرَّ بِأَخِيهِ فَرَأَى ثَوْبَهُ قَدِ انْكَشَفَ عَنْ بَعْضِ عَوْرَتِهِ أَكَانَ كَاشِفًا عَنْهَا كُلِّهَا أَمْ يَرُدُّ عَلَيْهَا مَا انْكَشَفَ مِنْهَا، قَالُوا: بَلْ نَرُدُّ عَلَيْهَا، قَالَ: كَلَّا بَلْ تَكْشِفُونَ عَنْهَا كُلِّهَا فَعَرَفُوا أَنَّهُ مَثَلٌ ضَرَبَهُ لَهُمْ، فَقِيلَ: يَا رُوحَ اللَّهِ وَكَيْفَ ذَلِكَ، قَالَ: الرَّجُلُ مِنْكُمْ يَطَّلِعُ عَلَى الْعَوْرَةِ مِنْ أَخِيهِ فَلَا يَسْتُرُهَا، بِحَقٍّ أَقُولُ لَكُمْ إِنَّكُمْ لَا تُصِيبُونَ مَا تُرِيدُونَ إِلَّا بِتَرْكِ مَا تَشْتَهُونَ وَلَا تَنَالُونَ مَا تَأْمُلُونَ إِلَّا بِالصَّبْرِ عَلَى مَا تَكْرَهُونَ…
“ينقل الإمام الصّادق (ع) قصّة عن النّبيّ عيسى (ع) لكي يلفت أنظار أصحابه إلى هذه المسألة الأخلاقيّة”(38)، أي مسألة السّتر على الآخرين وعدم كشف عيوبهم. في الشّاهد الّذي تقدّم قصّة واضحة الأحداث، أراد النّبيّ عيسى (ع) من خلالها أن يعلّم أصحابه درسًا قوامه أنّه من حقّ المؤمن على أخيه المؤمن أن يستر عيبه من غير أن يعلنه من أجل حفظ سمعته بين النّاس. وبدوره أراد الإمام الصّادق (ع) أن يستعين بهذه القصّة ليفهم المتلقّي الدّرس نفسه نظرًا لأنّ عدم إذاعة الخطأ الصّادر عن الآخر يندرج ضمن إطار القيم والأخلاقيّات الّتي ينبغي أن يتحلّى بها الإنسان المؤمن.
– إِنَّ أُمَّ سُلَيْمَانَ قَالَتْ لِسُلَيْمَانَ (ع): يَا بُنَيَّ إِيَّاكَ وَالنَّوْمَ فَإِنَّهُ يُفْقِرُكَ يَوْمَ يَحْتَاجُ النَّاسُ إِلَى أَعْمَالِهِمْ.
ينقل الإمام الصّادق (ع) عن أمّ النّبيّ سليمان (ع) كلامًا مفاده أنّ كثرة النّوم تجعل الإنسان فقيرًا في النّهار، في الوقت الّذي يلزمه العمل كي لا يصبح معدمًا. والإتيان بهذا التّضمين جاء لإقناع المتلقّي أنّ هدر الوقت بالنّوم الكثير ما هو إلّا تعطيل للحياة وانشغال عن جوهرها وحرمان من الكمالات المعنويّة والإنسانيّة فضلًا عن المصالح الدّنيويّة.
لا بدّ من الإشارة هنا أنّ القرآن والحديث يمثّلان حجّة قويّة على المسلمين، إذ يخضع معظم النّاس إلى التّسليم بهما بوصفهما سلطة دينيّة قويّة، لذا لا يقوم أحدٌ من النّاس بالاعتراض عليها أو الشّكّ بها، بأيّ شكل من الأشكال، وهذا ما كان عاملًا مساعدًا للمرسِل لإثبات بعضٍ ممّا جاء به في وصيّته.
- المحسّنات البديعيّة اللّفظيّة: “هي الّتي يكون التّحسين بها راجعًا إلى اللّفظ أصالة، وإن حسنت المعنى أحيانًا كالجناس”(39)، “لأنّه إذا عبّر بلفظ حسن استحسن معناه تبعًا، وكذلك إذا كان المعنى حسنًا تبعه حسن اللّفظ الدّالّ عليه.”(40) ومن المحسّنات البديعيّة اللّفظيّة الّتي عمد الإمام الصّادق (ع) إلى استعمالها: السّجع، الالتفات، الجناس، والازدواج.
1.2. السّجع: لغة: “سجعَ يسجعُ سجْعًا: استوى واستقامَ، وأشبه بعضه بعضًا. والسّجع الكلام المقفّى، والجمع أسجاع وأساجيع”(41). أمّا اصطلاحًا فهو “تواطؤ الفاصلتين من النّثر على حرف واحد، وهو في النّثر كالقافية من الشّعر”(42). للسّجع أهمّيّة بالغة في فنون القول كافّة، جعلته يحتلّ “أرفع مراتب الكلام وأعلاها، وأجلّ علوم البلاغة وأسناها”(43). إذ لولا أهمّيّته البلاغيّة والحجاجيّة، لما وجدنا أنّ معظم فنون القول تحفل به، فلا تخلو منه خطبة أو رسالة أو وصيّة…
ويصدق هذا الكلام كذلك على المدوّنة المنتقاة، إذ إنّ بها العديد من الأمثلة عن السّجع، وما ذلك إلّا لعلم صاحب الوصيّة بدور السّجع في إقناع القارئ، وحمله على تصديق كلامه. ومن أمثلة توظيف السّجع في وصيّة الإمام الصّادق (ع) لابن جندب:
– “الشّجاع الأرقم والعدوّ الأعجم.”
– “ويل للسّاهين عن الصّلوات النّائمين في الخلوات المستهزئين باللّه وآياته في الفترات.”
– “تجاور الجليل في داره وتسكن الفردوس في جواره.”
– “لم يعدّ لكلّ بلاء صبرًا، ولكلّ نعمة شكرًا، ولكلّ عسرٍ يسرًا.”
إنّ السّجع في هذه الأمثلة، إذ يحدث في الكلام إيقاعًا موسيقيًّا يطرب الآذان ويأسر العقول والقلوب، فإنّه يمنحه كذلك بعدًا إقناعيًّا بفضل ما يحقّقه فيه من وظائف حجاجيّة، لعلّ أبرزها ثلاث وظائف هي:
- السّجع تسهيل لعمليّة حفظ الكلام وتذكّره، ودفع إلى العمل بمحتواه: إنّ السّجع إذ يرد في الكلام، فإنّه يحقّق فيه، بفضل توافق فواصله وانسجامها الصّوتيّ، تماثلًا صوتيًّا وإيقاعًا رنّانًا، يجعل النّفس تنجذب وتميل إليه كلّ الميل، ليس فقط بالإصغاء والسّماع، ولكن بحفظه وتمثّله. فحفظ الإنسان للكلام مدعاة لجعله قريبًا من القلب والعقل معًا، وكلّما كان الكلام قريبًا منهما كان مدعاة للفهم والتّأمّل والتّدبّر والعمل بمحتواه، والامتثال لما يأمر به، واجتناب ما ينهى عنه.
وفرق كبير بين الكلام المحفوظ وغير المحفوظ، ذلك أنّ تأثير الأول هو تأثير دائم ومستمرّ، لأنّ هذا الكلام يكون قابعًا في الذّهن، وقريبًا من القلب، وحافزًا بشكل دائم على إصابة مواطن النّفس، وفعل ما هو مطلوب منها، وذلك من شأنه أن يرفع من الطّاقة الحجاجيّة للكلام، ومن قدرته على الإقناع. أمّا تأثير الثّاني فيـكون آنيًّا سرعان ما قد يزول بانقضـاء الكلام أو نسـيانه، مـا قد يضعِف من قيمة هذا الكلام، وقدرته على تحقيق ما هو منشود منه.
وبناء على ذلك، يمكن القول إنّ السّجع إذ يرد في الكلام ويسهّل عمليّة حفظه، فإنّه يجعل هذا الكلام يحقّق أغراضه الحجاجيّة كما يظهر في التّرسيمة الآتية:
ب. السّجع إثارة لعواطف المخاطب بغرض استمالته إلى عالم الخطاب: يعدّ السّجع من “الفنون الأسلوبيّة الفطريّة، الّتي تؤثّر في النّفوس تأثير السّحر، وتلعب بالأفهام لعب الرّيح بالهشيم، لما يحدثه من النّغمة المؤثّرة، والموسيقى القويّة الّتي تطرب لها الآذان، وتهشّ لها النّفس، فتقبل على السّماع من غير أن يدخلها ملل، أو يخالطها فتور”(44). ولذلك فهو يعدّ عنصرًا حجاجيًّا مهمًّا، يساهم بشكل كبير في إثارة عواطف المخاطب واستمالته. فهو يعمل من خلال ما يمنحه الخطاب من ثراء موسيقيّ وإيقاع مطرب، ومتناغم على إثارة انفعالات المخاطب، وتأجيج عواطفه.
وإذا جرى تأمّل الأمثلة المسجوعة السّابقة الواردة في وصيّة الإمام الصّادق (ع)، فإنّنا نجد أنّ صاحب الوصيّة لم يوظّف السّجع المتكلّف، الّذي يستكرهه الطّبع وتمجّه الآذان، وإنما وظّف السّجع البليغ، الّذي تتشوّق إليه النّفس، فضلًا عن توظيف الأسجاع القصيرة المعتدلة التّراكيب. فهذه الأسجاع تمثّل بقلّة ألفاظها “أحسن وجوه السّجع”(45)، وأعلى درجات الحسن والبلاغة.
ولا شكّ أنّ بلاغة هذه الأسجاع وقصر فقراتها وتماثلها، واعتدال جملها وتناسقها، هو ما جعلها قادرة أكثر من غيرها على إثارة عواطف المخاطبين، وترغيبهم في الكلام وجذبهم إليه وتشويقهم له. وبالإثارة والتّشويق تتحقّق استمالتهم إلى عالم الخطاب، إذ إنّ الإثارة والتّشويق رافدان أساسيّان من روافد الحجاج.
ج. السّجع يحقّق الاتّساق الصّوتيّ للخطاب: إذا كان اتّساق النّصّ وترابط عناصــره يحــدث بفضل ما
يجمع بين هذه العناصر من علاقات معجميّة ونحويّة ودلاليّة، تتمثّل في الإحالة والاستبدال والرّوابط اللّغويّة والتّكرار والاتّساق المعجميّ والحذف… وغيرها، فإنّه يحدث كذلك بفضل آليّة لها هي الأخرى دور أساس في تحقيق تماسك النّصّ والتحام عناصره، ألا وهي التّماثل والتّناسق الموسيقيّ الّذي يجمع بين فواصل الكلام.
ويتحقّق الاتّساق الصّوتيّ في السّجع بفضل ثلاثة عناصر هي: اعتدال المقاطع، ووحدة حرف السّجع، ووحدة الوزن.
_ اعتدال المقاطع: حيث حرص صاحب الوصيّة على ألّا يوظّف إلّا المقاطع القصيرة المعتدلة الألفاظ والمتناسبة التّراكيب. ولتوضيح ذلك نورد المثال الآتي:
| تجاور | الجليل | في | داره |
| تسكن | الفردوس | في | جواره |
هذه المقاطع قد حقّقت باعتدال مقاطعها، وتناسب عدد كلماتها تناغمًا صوتيًّا وموسيقيًّا، حتّى صارت الجمل المتعدّدة، وكأنّها جملة واحدة لا يفصل بين عناصرها إلّا تلك الفواصل المتماثلة، وهو ما ساهم في تحقيق اتّساق الكلام وتلاحم عناصره.
_ وحدة حرف السّجع: يؤدّي حرف السّجع بدوره، من خلال ما يحدثه من تناغم موسيقيّ بين الفواصل، دورًا مهمًّا في تحقيق انسجام الكلام، على أنّ المهمّ الّذي يمكن تسجيله هو أنّ صاحب رسالة الحقوق لا يكتفي أحيانًا بالسّجع الّذي يقتصر فيه على الاتّفاق في الحرف الأخير على مستوى الفواصل فقط، وإنّما يجعل أحيانًا جلّ كلمات المقطع مسجوعة، ومن الأمثلة على ذلك: “لم يعدّ لكلّ بلاء صبرًا، ولكلّ نعمة شكرًا، ولكلّ عسرٍ يسرًا.” فلو تأمّلنا المثال للاحظنا السّجع بين”صبرًا” و”شكرًا” و”يسرًا” ‘ذا لم يظهر السّجع على مستوى الحرف الأخير فقط، إنّما في الحرفين الأخيرين من الكلمات.
_ وحدة الوزن: تؤدّي الفواصل، من خلال ترجيع مادّة صوتيّة معيّنة على نسب زمنيّة متقايسة، توازنات موسيقيّة تمنح بدورها الكلام انسجامًا صوتيًّا. فإذا كان التّوافق على مستوى عدد الكلمات وتسجيعها يجعل الكلام متلاحمًا ومنسجمًا، فإنّ تماثل الفواصل على مستوى الوزن يجعل هذا الانسجام أعمّ وأشمل، فتتساوى بذلك المقاطع وتتناسق. ويبرز هذا التّماثل خاصّة عندما تكون للفواصل نفس الحركات والسّكنات الصّوتيّة.
ومن الأمثلة على ذلك:
| الفواصل | وزنها |
| الأرْقم
الأعجم |
/0/0//
/0/0// |
| الصّلوات
الخلوات الفترات |
/0///0/
/0///0/ /0///0/ |
إنّ هذا التّشكيل الوزنيّ يحقّق، إضافة إلى تعادل الفقرات وقصرها ووحدة حروف السّجع فيها، اتّساق الكلام بمجمله حتّى تصير الكلمات على اختلاف حروفها وتباين معانيها وكأنّها تشكّل قطعة واحدة، وتصير الجمل على اختلاف بنائها وتعدّد تراكيبها وكأنّها جملة واحدة، فيصبح الخطاب، بكثرة الأسجاع الموظّفة فيه، جرسًا متناغما يقلّ مثيله في جمال العبارة وموسيقيّتها. ولا شكّ أنّ الخطاب المنسجم الأصوات، المعتدل المقاطع يكون مؤثّرًا في المخاطب أكثر من غيره، إذ يلذّ على السّامع، فتنشط لسماعه الآذان، وتتشوّق إليه النّفس، فتقبل على سماعه، وتنخرط في تأمّل معانيه، واستجلاء أغراضه ومراميه، فيتمكّن منها المعنى، ويثبت ما يجعل المتلقّي يميل إليه ويقتنع به.
2.2. الالتفات: هو من الأساليب البلاغيّة الّتي تفنّن فيها القدماء، لما فيه من خصائص، يمكن من خلالها استدراج ذهن المتلقّي إلى المعنى المقصود، وهو كغيره من الأساليب البلاغيّة الّتي لها جانب جماليّ، إلّا أنّ له دورًا مهمًّا في العمليّة الحجاجيّة. وقد جاء تعريفه على يد ابن المعتزّ بقوله: “الالتفات هو انصراف المتكلّم عن المخاطبة إلى الإخبار، وعن الإخبار إلى المخاطبة وما يشبه ذلك. ومن الالتفات الانصراف عن معنى يكون فيه إلى معنى آخر”. ( 46) وللالتفات أقسام عديدة، نبرز من خلال المثلين الآتيين دوره الحجاجيّ:
أوّلًا: الرّجوع من الخطاب إلى الغيبة
– “لا تقل في المذنبين من أهل دعوتكم إلّا خيرا، واستكينوا إلى الله في توفيقهم وسلوا التّوبة لهم، فكلّ من قصدنا ووالانا ولم يوال عدوّنا وقال ما يعلم وسكت عمّا لا يعلم أو أشكل عليه فهو في الجنّة.”
وقوامه أن يفهم المتلقّي أنّ هذا نمط المرسِل وقصده، حضر أم غاب، وأنّه في كلامه ليس ممّن يتلوّن أو يتصنّع، وقد أراد بالانتقال إلى الغيبة الإبقاء على المخاطب، فالغيبة أروح له، وبعد أن حذّر الإمام الصّادق عليه السّلام ابن جندب والمتلقّين من الإساءة إلى الشّيعة، وطلب إليهم دعوة الله بخضوع وخشوع والتماس أن يمنحهم التّوبة معتمدًا على ضمير المخاطب، ألفيناه يؤكّد من خلال ضمائر الغائب أنّ العفو الإلهيّ المتمثّل بالدّخول إلى الجنّة يكون من خلال الإقبال نحو ولاية أهل البيت عليهم السّلام، ورفض ولاية أعدائهم، والحديث بما هو معلوم، والاحتراز من الكلام بما ليس معلومًا، فضلًا عن السّكوت أمام الشّبهات.
إنّ أسلوب الالتفات في الانتقال من الخطاب إلى الغيبة، من خلال التّغيير في الضّمائر، يُظهر جليًّا الدّور الحجاجيّ، الّذي بواسطته يأسرُ المرسِل المرسَل إليه، فيحسّ هذا الأخير أنّه معنيّ كذلك بهذا الخطاب، ويتجاوب معه، ويتجدّد لديه النّشاط، فيكون بعد ذلك الفعل الإقناعيّ سهل المنال، لأنّ التّأثير قد حصل.
ثانيًا: الرّجوع عن الفعل المستقبل إلى فعل الأمر: “وإنّما يقصد إليه تعظيمًا لحال من أجرى عليه الفعل المستقبل، وتفخيمًا لأمره، وبالضّدّ من ذلك فيما أجرى عليه فعل الأمر”. ( 47)
ومن الشّواهد في المدوّنة المنتقاة عن الالتفات بالرّجوع عن الفعل المستقبل إلى فعل الأمر ما يأتي:
– “قد عجز من لم يعدّ لكلّ بلاء صبرًا ولكلّ نعمة شكرًا ولكلّ عسر يسرًا، صبّر نفسك عند كلّ بليّة…”
نلاحظ في هذا الكلام استعمال “يعدّ” و”صبّر”، ولم يقل في الثّانية “ومن لم يصبر” ليكون موازيًا له وبمعناه، وهذا يعني أنّ الإمام الصّادق عليه السّلام جاء بصيغيتن مختلفتين لئلّا يوازي بين المعنيين، فمن خلال اللّفظ الأوّل “لم يعدّ” أراد صاحب الوصايا أن يظهر للمتلقّي أنّ كلّ إنسان لم يتجهّز نفسه للتّحلّي بالصّبر والأناة عند البلاءات والكروب هو بمثابة الإنسان العاجز… ثمّ ينتقل بعد ذلك إلى اللّفظ الثّاني “صبّر”، الّذي يعبّر عن إرشاد ووعظ يوجّهه المرسل إلى المرسل إليه ليعي أن الصّبر أعظم الخصال، وبالتّالي ينبغي الاتّصاف به ليكون عونًا عند الشّدائد.
وهكذا يتّضح العدول عن اللّفظ الأوّل المستقبل “يعدّ” وجيء به على لفظ فعل الأمر “صبّر”. من هنا فإنّ أسلوب الالتفات في الانتقال من الفعل المستقبل إلى الأمر، يدفع بالمتلقّي إلى إعمال نظره، وحكّ قريحته، ثمّ لشدّ انتباهه وتوكيده، بالانتقال من صيغة إلى صيغة، ليكمل أمر الخطاب وتتفاوت درجته في الاحتجاج، ومنه الوصول إلى التّأثير وشدّ الانتباه، ليسهّل بعد ذلك إقناعه بما يمليه المرسل.
3.2. الجناس: لغة: الجنس الضّرب من كلّ شيء، وهو من النّاس ومن الطّير ومن حدود النّحو والعروض والأشياء جملة، والجمع أجناس وجنوس. ويقال: هذا يجانس هذا أي يشاكله”.(48) أمّا اصطلاحًا فهو عند أحمد مصطفى المراغي “تشابه كلمتين في اللّفظ مع اختلافهما في المعنى”. (49) والجناس نوعان: تامّ، وذلك حين يتّفق اللّفظان في هيئة الحروف ونوعها وعددها وترتيبها وأن يختلفا في المعنى، وناقص حين ينقص شرط من شروط الجناس التّامّ.
تنبّه العرب منذ القديم للوظيفة الحجاجيّة للجناس، فهو يعدّ من الأساليب البديعيّة الّتي تجذب السّامع، وتؤثّر في نفسه وتحدث فيها ميلًا إلى الإصغاء لما يعرض عليها ودفعها إلى قبوله وتمثّله.
إنّ الخطيب، إذ يحدث في الكلام إيقاعا قويًّا ورنّانًا تطرب له الآذان، وتهتزّ له النّفوس بفضل التّجاوب الموسيقيّ النّاجم عن تماثل الكلمات، فإنّه “يقصد اختلاب الأذهان، وخداع الأفكار، فيوهم أنّه يعرض على السّامع معنى مكرّرًا أو لفظا مردّدًا، لا يجني منه السّامع غير التّطويل والسّآمة، فإذا هو يروّع ويعجب، ويأتي بمعنى مستحدث يغاير ما سبقه، فتأخذ السّامع الدّهشة لتلك المفاجأة غير المتوقّعة”. (50) لاكتشافه لهذا المعنى الجديد الّذي لم يكن في حسبانه، ولوصوله إلى حقيقة لم تكن متوقّعة.
تعود حجاجيّة الجناس إلى تلك الدهشة والمفاجأة غير المتوقّعة التي تحدث في النّفس عند إدراكها للمعنى الجديد، ووقوفها على حقيقة الاختلاف الدّلاليّ الخفيّ بين اللّفظتين المتجانستين انطلاقًا من تشابههما الصّوتيّ ُ الظّاهر. فهذا الاكتشاف والإدراك هو ما يجعل المخاطب يقبل الكلام ويُقبل عليه، لأنّه يكون حينئذ هو من توصّل إليه بنفسه، وهو من وقف على حقيقته.
ونظرا لهذه الأهمّيّة الحجاجيّة، فقد استند الإمام الصّادق (ع) على الجناس بدوره، ومن أمثلة هذا التّوظيف لا للحصر: يزوّجه- يتوّجه/ تكبّر- تجبّر/ يشكر- يذكر/ العرق- الفرق وسواها من الشّواهد.
تعود حجاجيّة هذه الجناسات جميعها إلى ما أحدثته في الكلام من نغمة موسيقيّة بديعة وتشابه صوتيّ يطرب الآذان ويؤثّر في القلوب، ويحدث في النّفس ميلًا إلى التّلذّذ والإصغاء من جهة، وإلى دفعها المخاطب إلى الوقوف على حقيقة المعاني الكامنة وراء هذا التّشابه الصّوتيّ من جهة ثانية. ويتمّ هذا الوقوف من خلال قيام المخاطب بسلسلة من الانتقالات الحجاجيّة، والمرور عبر أربع وضعيّات هي:
إنّ هذه الانتقالات هي ما يعطي الجناس قوّة حجاجيّة، ويجعله قادرًا على إصابة مواقع العقل والقلب معًا. فهو، إذ يحدث في الكلام تشابهًا صوتيًّا واختلافا دلاليًّا، فإنّه يدفع بالمخاطب إلى القيام بالانتقالات الحجاجيّة السّابقة لكشف حقيقة هذا الاختلاف، وإدراك دلالاته وأبعاده. فيكون هو من توصّل بنفسه إلى هذا الاكتشاف. وهو من بلغ هذا الإدراك، الشّيء الّذي يجعله بعد ذلك يجد صعوبة في دحض أو إبطال ما توصّل إليه بنفسه. وهو ما يضمن “بداية الانخراط في دورة الكلام الحجاجيّة، وبداية الانصياع لمنطق الكلام، المؤذنة بحصول الإقناع”(51). إنّ البعد الحجاجيّ للجناس يكمن في هذا الاكتشاف، ذلك أن الجناس كلام ذو معنى واحد في الظّاهر، ومعنيين في الباطن، وعمليّة اكتشاف المعاني والانتقال بينها هي ما يكفل للجناس قوّته الحجاجيّة ويزيد من فعاليّة تأثيره في المخاطب.
4.1. الازدواج: لغة: ورد في لسان العرب: “ازدوج الكلام وتزاوج: أشبه بعضه بعضا في السجع أو الوزن، أو كان لإحدى القضيتين تعلق بالأخرى” أمّا اصطلاحا فهو “تقسيم الكلام إلى عبارات تكون كلّ اثنتين منها أو أكثر متساوية البعد من غير التزام بما يشبه القافية في الشّعر”. (52)
يعدّ الازدواج(أو التّوازن) وسيلة من وسائل الإقناع، تعمد إلى تحريك الوجدان والشّعور باعتباره” بنية إيقاعيّة جوهريّة ذات تأثير سمعي وعاطفي في المستمع”. (53) ويلجأ المحاجج إلى ھذه الوسيلة لمخاطبة وجدان وشعور المتلقّي، وجذب انتباھه إلى المقصود من الحجاج. فما يحدثه الازدواج داخل النّصّ من إيقاعات ونغمات وبخاصّة في أواخر الجمل المتتابعة، يكون وقعه على نفسيّة المتلقّي، وأثره بارز في توجيھه إلى جمل مقصودة دون أخرى داخل النّصّ، وھو ما يعكس قصد وعمد المحاجج إليه في تلك الجمل، ليثبت الازدواج منھجًا واستراتيجيّة مخطّطة ينحوھا المحاجج في نصوصه وخطاباته.
وقد احتشدت وصيّة الإمام الصّادق (ع) لابن جندب بالشّواهد حول الازدواج، ومنها:
– “لا إيمان إلّا بعمل، ولا عمل إلّا بيقين، ولا يقين إلّا بالخشوع.”
– “واجعل قلبك قريبًا تشاركه، واجعل عملك والدًا تتّبعه واجعل نفسك عدوًّا تجاهده.”
– “الصّمت زين لك عند العلماء، وستر لك عند الجهّال.”
بعد الوقوف عند هذه الأمثلة، يتبدّى لنا أنّ المرسِل لم يأت بها تكلّفًا إنّما وردت بما يكفي لإحداث الجمال في نفس المتلقّي لاستمالة مشاعره وأحاسيسه. والجدير ذكره أنّ الازدواج الّذي شهدناه تقاطع في معظمه مع التّكرار المضمونيّ، وهذا هو المستوى الأساسيّ الّذي تتفاعل فيه البنية والدّلالة وتشتغلان معًا.
يتّضح في نهاية هذا المبحث أنّ قيمة البديع التّداوليّة تمثّلت من خلال ما أورده الإمام الصّادق (ع) من محسّنات بديعيّة لفظيّة ومعنويّة أدّت دور الحجّة أو الدّليل في المدوّنة المنتقاة، فكان لها أبعد الأثر في إقناع المتلقّي بما ورد من مواعظ، ما يؤكّد أنّ البديع ليس إضافة جماليّة فنّيّة فحسب، إنّما يسعى لتحقيق الإقناع والتّأثير لدى المتلقّي.
الخاتمة: في ختام هذه الدّراسة لا بدّ من الإشارة إلى النّتائج الّتي أفضت إليها، وهي تتلخّص فيما يأتي:
إنّ توظيف الآليّات البلاغيّة على مستوى علم البيان وعلم البديع في الخطاب لم يعد محصورًا بغرض تزيينه أو تجميله، بل أصبح أكثر ارتباطًا وانسجامًا مع متطلّبات تداوليّة تستدعي هذا التّوظيف أكثر من غيره. وهذا ما دفع الإمام الصّادق (ع) إلى استثمار البيان والبديع أي اتّخاذ الصّور البيانيّة والمحسّنات البديعيّة اللّفظيّة والمعنويّة وسائل فاعلة في وصيّته لحمل المتلقّي على الاقتناع بما أورد من مواعظ وإرشادات. لقد احتلّت تلك الصّور والمحسّنات مساحة واسعة في وصيّة الإمام الصّادق (ع) لابن جندب، وكان لحضورها تأثيره القويّ بأوجه متعدّدة ومختلفة في الخطاب التّأثيريّ للمدوّنة. والبعد التّداوليّ يكمن في كون المرسِل لا يصرّح بالصّور بجميع مكوّناتها، بل يترك دائمًا فسحة شاغرة تدفع المتلقّي إلى إنتاج القسم المضمر من الصّورة، إضافة إلى أنّ البديع التّداوليّ قد خاطب ذكاء المتلقّي وثقافته، لذلك كان له الأثر الكبير أيضًا في إنتاج المعنى التّأويليّ. وهكذا يكون صاحب الوصيّة قد أشرك المتلقّي في إنتاج الدّلالة، ما يجعله يدرك الأبعاد التّداوليّة للخطاب.
الهوامش
[1] – محمّد بن مكرم أبو الفضل ابن منظور، لسان العرب، مادّة بين، ج 13، بيروت: دار صادر، 1997، ص67.
2- أحمد الهاشميّ، جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع، ط1، بيروت: المكتبة العصريّة، 1999، ص216.
3- محمّد بن مكرم أبو الفضل ابن منظور، المرجع نفسه، مادّة شبه.
4- عبد الرّحمن حسن حبنكة الميدانيّ، البلاغة العربيّة أسسها وعلومها وفنونها وصور من تطبيقاتها، ط1، دمشق: دار القلم، 1993، ص161.
5-حسين بوبلوطة، الحجاج في الإمتاع والمؤانسة لأبي حيان التّوحيديّ، الجزائر: منشورات كلّيّة الآداب والعلوم الإنسانيّة في جامعة الحاج لخضر، 2010، ص76.
6- محمّد تقي مصباح اليزدي، وصايا الإمام الصّادق (ع) للسّالك الصّادق، ترجمة عبّاس نور الدّين، بيروت: دار المعارف الحكميّة، 2018، ص162.
7 -عبد العزيز عتيق، في البلاغة العربيّة: علم البيان، بيروت: دار النّهضة العربيّة، 1998، ص361.
8- عبد القاهر بن عبد الرّحمن بن محمّد الجرجاني، أسرار البلاغة، جدّة: دار المدني، 1983، ص30.
9- عمر أوكان، اللّغة والخطاب، المغرب: إفريقيا الشّرق، 2001، ص133.
10 -عيد بليغ، “الرّؤية التّداوليّة للاستعارة”، مجلّة علامات، العدد 23(2005)، ص99.
11- نعيمة يعمرانن، الحجاج في كتاب المثل السّائر لابن الأثير، الجزائر: منشورات كلّيّة الآداب واللّغات في جامعة مولود معمري، 2012، ص 59.
12-محمّد تقي مصباح اليزدي، المرجع السّابق، ص255.
13 -M. Leguern, Métaphore et argumentation, Lyon: Presses Universitaires de Lyon, 1981, p70.
14- محمّد بن مكرم أبو الفضل ابن منظور، المرجع السّابق، مادّة كني، ج 15، ص233.
15- يوسف بن أبي بكر بن محمد بن علي السّكاكي، مفتاح العلوم، ط2، بيروت: دار الكتب العلمية، 1987، ص637.
16 -محمود السّيّد شيخون، الأسلوب الكنائيّ في القرآن الكريم، ط1، مصر: مكتبة الكلّيّات الأزهريّة، 1978، ص87.
17- محمّد تقي مصباح اليزدي، المرجع السّابق، ص271.
18- محمّد بن مكرم أبو الفضل ابن منظور، المرجع السّابق، مادّة بدع، ص143.
19- أحمد الهاشميّ، جواهر البلاغة، بيروت: المكتبة العصريّة، 2003، ص298-299.
20- محمد أحمد قاسم وآخرون، علوم البلاغة، طرابلس: المؤسّسة الجديدة للكتاب، 2003، ص52.
21 -عبد الهادي بن ظافر الشّهري، استراتيجيات الخطاب، مقاربة لغويّة تداوليّة، ط1، بنغازي: دار الكتاب الجديد المتّحدة، 2004، ص498.
22 -صابر الحباشة، التّداولية والحجاج، مدخل ونصوص، ط1، دمشق: صفحات للدّراسات والنّشر، 2008، ص51.
23 – محمّد بن مكرم أبو الفضل ابن منظور، المرجع السّابق، مادّة طبق، ج10، ص209.
24 -جلال الدّين محمّد بن عبد الرّحمن القزويني، الإيضاح في علوم البلاغة، بيروت: دار الكتب العلميّة، 1971، ص287.
25- محمّد بن مكرم أبو الفضل ابن منظور، المرجع السّابق، مادّة قبل، ج11، ص21.
26- أحمد مصطفى المراغي، علوم البلاغة، ط1، القاهرة: دار الآفاق العربيّة، 2000، ص382.
27- محمّد تقي مصباح اليزدي، المرجع السّابق، ص43.
28- محمود بن عمرو بن أحمد الزّمخشريّ، أساس البلاغة، مادّة قسم، بيروت: دار الكتب العلميّة، 1983، ص362.
29- أبو هلال الحسن بن عبدالله بن سهل العسكريّ، الصّناعتين، ط1، القاهرة: دار إحياء الكتب العربيّة، 1952، ص341.
30 -محمّد تقي مصباح اليزدي، المرجع السّابق، ص171-172.
31- محمّد بن مكرم أبو الفضل ابن منظور، المرجع السّابق، مادّة جمع، ص197.
32- أبو هلال الحسن بن عبدالله بن سهل العسكريّ، الصّناعتين، ط1، القاهرة: دار إحياء الكتب العربيّة، 1952، ص452.
33 -محمّد بن مكرم أبو الفضل ابن منظور، المرجع السّابق، مادّة فرق، ص169.
34- أحمد الهاشميّ، المرجع السّابق، ص37.
35- محمّد بن مكرم أبو الفضل ابن منظور، المرجع السّابق، مادّة ضمن، ص65.
36 -ضياء الدين ابن الأثير، المثل السّائر، بيروت: المكتبة العصريّة، 1995، ص328.
37 -السّيّد محمّد حسين الطّباطبائي، الميزان في تفسير القرآن، ج10، بيروت: مؤسّسة الأعلمي للمطبوعات، 1996، ص 38.
38- محمّد تقي مصباح اليزدي، المرجع السّابق، ص252.
39 -أحمد مصطفى المراغي، علوم البلاغة، ط1، القاهرة: دار الآفاق العربيّة، 2000، ص380.
40-عبد القادر حسين، فنّ البديع، ط1، القاهرة: دار الشّروق، 1983، ص33.
41- محمّد بن مكرم أبو الفضل ابن منظور، المرجع السّابق، مادّة سجع.
42- عبد الرّحمن حسن حبنكة الميدانيّ، البلاغة العربيّة أسسها وعلومها وفنونها وصور من تطبيقاتها، ج2، ط1، دمشق: دار القلم، 1993، ص503.
43 – يحيى بن حمزة العلويّ، الطّراز، ج3، العراق: مكتبة لسان العرب، 2002، ص28.
44 – الشحات محمد أبو ستيت، دراسات منهجية في علم البديع، ط1، 1994، ص110.
45- أبو هلال الحسن بن عبدالله بن سهل العسكريّ، الصّناعتين، ط1، القاهرة: دار إحياء الكتب العربيّة، 1952، ص263.
46 -عبد الله ابن المعتزّ، البديع، دمشق: منشورات دار الحكمة، 1967، ص58.
47- عبد العزيز عتيق، علم البديع، بيروت: المكتبة الشّاملة الحديثة، 1972، ص151.
48 – محمّد بن مكرم أبو الفضل ابن منظور، المرجع السّابق، مادّة جنس، ص215.
49 – أحمد مصطفى المراغي، علوم البلاغة، ط1، القاهرة: دار الآفاق العربيّة، 2000، ص414-415.
50- عبد الفتاح لاشين، البديع في ضوء أساليب القرآن، القاهرة: دار الفكر العربيّ، 1999، ص169-170.
51- عبدالله صوله، الحجاج في القرآن، ط2، بيروت: دار الفارابي،2007، ص637.
52- إلياس العسيس، الدّليل الموجز في اللّغة العربية وآدابها، ط1، زحلة: مكتبة الميدان، 2010، ص70.
53- ﻣحمّد العبد، “النّصّ الحجاجيّ العربيّ”، ﻣجلّة فصول، العدد 60(2002)، ص78.
المصادر والمراجع
- القرآن الكريم.
- ابن الأثير، ضياء الدين، المثل السّائر، بيروت: المكتبة العصريّة، 1995.
- ابن المعتزّ، عبد الله، البديع، دمشق: منشورات دار الحكمة، 1967.
- ابن منظور، محمّد بن مكرم أبو الفضل، لسان العرب، مادّة بين، ج 13، بيروت: دار صادر، 1997.
- أبو ستيت، الشحات محمد، دراسات منهجية في علم البديع، ط1، 1994.
- أوكان، عمر، اللّغة والخطاب، المغرب: إفريقيا الشّرق، 2001.
- بليغ، عيد، “الرّؤية التّداوليّة للاستعارة”، مجلّة علامات، العدد 23(2005).
- بوبلوطة، حسين، الحجاج في الإمتاع والمؤانسة لأبي حيان التّوحيديّ، الجزائر: منشورات كلّيّة الآداب والعلوم الإنسانيّة في جامعة الحاج لخضر، 2010.
- الجرجاني، عبد القاهر بن عبد الرّحمن بن محمّد، أسرار البلاغة، جدّة: دار المدني، 1983.
10.الحباشة، صابر، التّداولية والحجاج، مدخل ونصوص، ط1، دمشق: صفحات للدّراسات والنّشر، 2008.
- حسين، عبد القادر، فنّ البديع، ط1، القاهرة: دار الشّروق، 1983.
- الزّمخشريّ، محمود بن عمرو بن أحمد، أساس البلاغة، مادّة قسم، بيروت: دار الكتب العلميّة، 1983.
- السّكاكي، يوسف بن أبي بكر بن محمد بن علي، مفتاح العلوم، ط2، بيروت: دار الكتب العلمية، 1987.
- الشّهري، عبد الهادي بن ظافر، استراتيجيّات الخطاب، مقاربة لغويّة تداوليّة، ط1، بنغازي: دار الكتاب الجديد المتّحدة، 2004.
- شيخون، محمود السّيّد، الأسلوب الكنائيّ في القرآن الكريم، ط1، مصر: مكتبة الكلّيّات الأزهريّة، 1978.
- صوله، عبدالله، الحجاج في القرآن، ط2، بيروت: دار الفارابي،2007.
- الطّباطبائي، السّيّد محمّد حسين، الميزان في تفسير القرآن، ج10، بيروت: مؤسّسة الأعلمي للمطبوعات، 1996.
- العبد، ﻣحمّد، “النّصّ الحجاجيّ العربيّ”، ﻣجلّة فصول، العدد 60(2002).
- عتيق، عبد العزيز، علم البديع، بيروت: المكتبة الشّاملة الحديثة، 1972.
- عتيق، عبد العزيز، في البلاغة العربيّة: علم البيان، بيروت: دار النّهضة العربيّة، 1998.
- العسكريّ، أبو هلال الحسن بن عبدالله بن سهل، الصّناعتين، ط1، القاهرة: دار إحياء الكتب العربيّة، 1952.
- العسّيس، إلياس، الدّليل الموجز في اللّغة العربية وآدابها، ط1، زحلة: مكتبة الميدان، 2010.
- العلويّ، يحيى بن حمزة، الطّراز، ج3، العراق: مكتبة لسان العرب، 2002.
- قاسم، محمّد أحمد وآخرون، علوم البلاغة، طرابلس: المؤسّسة الجديدة للكتاب، 2003.
- القزويني، جلال الدّين محمّد بن عبد الرّحمن، الإيضاح في علوم البلاغة، بيروت: دار الكتب العلميّة، 1971.
- لاشين، عبد الفتاح، البديع في ضوء أساليب القرآن، القاهرة: دار الفكر العربيّ، 1999.
- المراغي، أحمد مصطفى، علوم البلاغة، ط1، القاهرة: دار الآفاق العربيّة، 2000.
- الميدانيّ، عبد الرّحمن حسن حبنكة، البلاغة العربيّة أسسها وعلومها وفنونها وصور من تطبيقاتها، ط1، دمشق: دار القلم، 1993.
- الهاشميّ، أحمد، جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع، ط1، بيروت: المكتبة العصريّة، 1999.
- اليزدي، محمّد تقي مصباح، وصايا الإمام الصّادق (ع) للسّالك الصّادق، ترجمة عبّاس نور الدّين، بيروت: دار المعارف الحكميّة، 2018.
- يعمرانن، نعيمة، الحجاج في كتاب المثل السّائر لابن الأثير، الجزائر: منشورات كلّيّة الآداب واللّغات في جامعة مولود معمري، 2012.
المصادر الأجنبيّة
- Leguern, M, Métaphore et argumentation, Lyon: Presses Universitaires de Lyon, 1981.
[1]– أستاذة في الجامعة الإسلاميّة- بيروت – لبنان – كلّيّة الآداب والعلوم الإنسانيّة – قسم اللّغة العربيّة.
Professor at the Islamic University of Beirut, Lebanon, Faculty of Arts and Humanities, Department of Arabic Language.E-mail: Hijazimariam304@gmail.com