عنوان البحث: تأثير الهُويّة المجتمعيّة على تنمية قضاء بعلبك
اسم الكاتب: راغدة شمص
تاريخ النشر: 2025/05/13
اسم المجلة: مجلة أوراق ثقافية
عدد المجلة: 37
تحميل البحث بصيغة PDFADOI: https://aif-doi.org/awraq/013707
تأثير الهُويّة المجتمعيّة على تنمية قضاء بعلبك
The impact of community identity on the development of Baalbek District
Raghida shamas راغدة شمص([1])
تاريخ الإرسال:6-4- 2025 تاريخ القبول:20-4-2025
ملخص Turnitin: 6%
يقدم هذا المقال إطارًا منهجيًّا لدراسة انتماء السكان وهويتهم المكانيّة وانعكاساتها على التنمية المستدامة، وقد جرى تحديد الرّموز وتقييمها في أربع نقاط أساسيّة: الرّموز المعنويّة الموزعة في عنواني الشّعور بالانتماء، التجذر ، أمّا الرّموز الماديّة فهي متعددة، وقد أثّرت كلّها على حدود الهُويّة. أمّا النّقطة الرّابعة فقد تناولت تأثير تلك الرّموز على التنمية المستدامة. وبحسب النتائج التي توصلنا اليها، فقد أدّى إهمال الهُويّة وعدم المساواة وضعف الانتماء الى المنطقة، الى ضعف الرّغبة في الاستثمار إذ إنّ غياب الشّراكة الحقيقيّة، وضعف التّعاون وضعف التّحويلات بسبب تراجع التّمسك بالمنطقة، وهذا ما يدفعنا الى تأكيد خطورة تراجع الانتماء في السياسات التنموية، وهذه الخطورة يمكن تجاوزها من خلال ترسيخ الهُويّة المكانيّة، ولا بدّ من إدخال قضايا الهُويّة في المشاريع التنموية كشرط أساسي من أجل تنمية القطاعات الاقتصاديّة كافة.
كلمات المفاتيح: الهُويّة المكانيّة، الانتماء، الرّموز، الهُويّة المجتمعيّة، النزوح.
Résumé
Cet article présente un cadre méthodologique pour étudier l’appartenance de la population, l’identité spatiale et leurs implications pour le développement durable.
Les symboles ont été identifiés et évalués selon quatre points fondamentaux : les symboles moraux sont répartis sous deux rubriques : le sentiment d’appartenance et l’enracinement, tandis que les symboles matériels sont nombreux et tous ont affecté les limites de l’identité. Le quatrième point abordait l’impact de ces symboles sur le développement durable. Selon nos conclusions, La négligence de l’identité, les inégalités et le faible sentiment d’appartenance à la région ont conduit à un faible désir d’investir, en raison de l’absence de véritable partenariat, d’une faible coopération et de faibles transferts de fonds en raison du déclin de l’attachement à la région. C’est ce qui nous incite à souligner le danger du déclin du sentiment d’appartenance dans les politiques de développement. Ce danger peut être surmonté en consolidant l’identité spatiale. Les questions d’identité doivent être intégrées dans les projets de développement comme condition préalable au développement de tous les secteurs économiques.
Mots-clés: identité spatiale, appartenance, symboles, identité communautaire, déplacement

المقدمة: تتميز المنطفة بتنوع ثقاي، يقوم على علاقات وتاريخ مشترك وثقافة وروابط عائليّة وممارسات تنفحهم بثقافة السّلف، وإرث الأجداد، ما ولد شعور السّكان بالإلفة والتّعلق بالمنطقة وإنشاء شبكة من التّفاعلات الاجتماعيّة بينهم والتّماسك والتّعاون، وهذه تُحرك جذور ثابتة ومستقرة وضاربة في التاريخ ، وتُعطي هُويّة إيجابيّة من أجل تنمية المنطقة.
الإشكاليّة
– تعيش المنطقة ويلات التّهميش بسبب السياسات التنموية غير العادلة، وزيادة الفروقات التنمويّة بين المنطقة والمناطق اللبنانيّة خاصة الخدمات الأساسيّة المتدهورة في الكمّيّة النوعيّة، ما أجبر البعض على الامتعاض من انتمائهم.
– وعلى الرّغم من التّغيّرات الكثيرة التي تشهدها المنطقة في سيرورتها بفعل العولمة، والانفتاح الاقتصادي وتحويلات المهاجرين، يشعر سكان المنطقة بالإهمال بسبب تردي مجالاتها الاقتصاديّة والمجتمعيّة، والثّقافيّة وتفاقم مشاكل الزراعة وضيق فرص العمل، هذا الواقع ضعضع ثقة السّكان بالجهات المعنيّة، وزعزع انتماءهم ومنع رغبتهم في الاستثمار.
ما هي مرتكزات الانتماء وكيف يمكن تفعيلها وكيف يمكنها تعزيز التنمية المستدامة للمنطقة؟
الفرضية
– يُعدُّ تفعيل الانتماء وتمكين ارتباط السكان بمكونات المنطقة الماديّة والمعنويّة من مرتكزات تشكيل هويتهم المهمّة.
– يُعدُّ استثمار قوة الشّعور بالانتماء نقطة انطلاق للتنمية، فهو يشجع السكان على تطوير بلداتهم من خلال التّعاون والهجرة الدّائريّة وجذب التّحويلات الماليّة، والاستثمار، علمًا أن البلدات جميعها تشترك في الأهداف، وتجمعها هموم كبيرة وتحديات على الرّغم من الاختلافات الثّقافيّة بينهم.
– وتُعدُ المساواة الحجر الأساسي في نجاح السياسات التنموية وإمكانيّة تطبيق القوانين، ما يجعل من الممكن إعادة بناء هُوية جماعيّة واستعادة الفخر، والمكانة مدفوعة باستراتيجيات البلديات التنموية.
أهمية الموضوع: تُعدُّ الهُويّة المكانيّة في بعدها المجتمعي من المواضيع المهمّة، يضع مداخل لمعالجة أزمة التنمية نظرًا لتأثيرها على القضايا الرئيسة، فهي تكتسب قيمة استراتيجيّة نتيجة سيطرة رموز ماديّة ومعنويّة على فضاء المنطقة تسمح بالتّحكم العملي فيه، تمنح تلك الرّموز قيمة للمنطقة عن طريق التّرويج لها وإعطائها علامة إقليميّة، وتقوي الانتماء المكاني لها وتحقق التواصل الاجتماعي والتّرابط والتّماسك.
الهدف: معرفة العناصر التي تشكل هُوية المجتمعات المحليّة والإقليمية، وتساهم في التعبئة الاجتماعيّة والسياسيّة، معرفة مدى تمثيل المعنيين في ترسيخ الشّعور بالانتماء، تشكيل هوية جديدة لمنطقة، تحديث العوامل الثّقافيّة الأهميّة السياسيّة والتّخفيف من التّحديات الاجتماعيّة.
- منهجية العمل
1.1. تعريف: الهُويّة المكانيّة كنوع من العلاقة بين الأفراد أو المجموعات والمواقع الجغرافيّة. هذا هو ما يسميه Relph الهُويّة المكانيّة. تتراكب فيها أربعة عناصر : الإحساس والشّعور بالانتماء، التاريخ والأحداث والرّمزيّة، وعلاقات معقدة بين سكان المنطقة، فيتفاعلون ويستثمرون من أجل تنمية المنطقة (Guigou, 2002) ترتبط الهُويّة بشكل أساسي بالانتماء، وبديناميات التّفاعل بين الثقافات، وتُعدُّ رافعة ونقطة انطلاق للتنمية في المنطقة، وتتعزز الروابط بين الأماكن والسكان معًا (كالدو، 1996، ص 285 وإدوارد ريلف (1986 -1976]
منهجيّة العمل: سـأتطرق نظريًّا الى العديد من الإشكاليّات المطروحة والمرتبطة بالهُويّة وبواقع السياسات التنموية في ظل عدم الاكتراث للهوية المكانيّة على الرّغم من الصِّلة الوثيقة بها، وهو ما يحتّم علينا التقيد بمستوى التحليل، وعدم الخوض في الاستبيانات التي تتطلبها دراسة الهُويّة، انطلقنا بجملة من التفسيرات والمقاربات أهمها:
– تغير ملامح الهُويّة، تفسيرات نظرية لطبيعة العلاقة بين المكان والتنمية، ومفاهيم الهُويّة تتبع تطور مفهوم الهُويّة ومقاربتها المنهجيّة في مرحلتي القديمة والحديثة من خلال عيّنة من الدّراسات.
تتشكل الهُويّة من خلال التّفاعل بين العناصر الماديّة والعناصر غير الماديّة مثل الديناميكيات الاجتماعيّة والثّقافيّة والاقتصاديّة والسياسيّة (لينش، صورة المدينة 1960) (رالف 1976). و تُعرَّف على أنها الخصائص الفريدة التي تميز منطقة عن أخرى (لينش، صورة المدينة 1960) (رالف 1976).كما ترتبط الهُويّة المكانيّة بتاريخ المنطقة وتراثها، فتعكس ذاكرة جماعيّة وخبرة مشتركة لسكانها (زوكين 1995). (Twigger-Ros and Uzzell 1996). تشمل الهُويّة مجموعة واسعة من الخصائص الفريدة والمشتركة، يعكس التركيز على السّمات المميزة والاعتراف بمجموعة كاملة من الخصائص، وما لا شك فيه أنّ الاتجاهات الاجتماعيّة والاقتصاديّة والتأثيرات الثّقافيّة العالمية تؤدي إلى خصائص مشتركة. وفي الوقت نفسه، تؤدي العوامل المحليّة مثل التاريخ والجغرافيا والثقافة إلى عناصر فريدة تساهم في تحديد الهُويّة المكانيّة (بورديو، 1984؛ كاستيلز، 1997). وهذا يعكس التقاء الخصائص المشتركة لهوية المنطقة، والتّفاعل بين التأثيرات العالميّة والمحليّة في تنمية المنطقة. يطور السّكان شعورهم بالانتماء، بسبب عوامل مختلفة مثل التطورات الاقتصاديّة والتّحولات الثّقافيّة، وهذا يساهم في انتشار هوية المنطقة، ويجب أن تكون السياسات قابلة للتكيف ومرنة لاستيعاب هذه التغيير

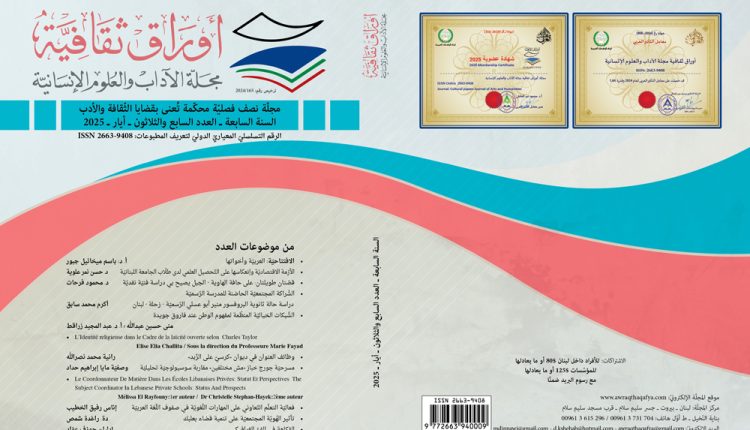
التعليقات مغلقة.