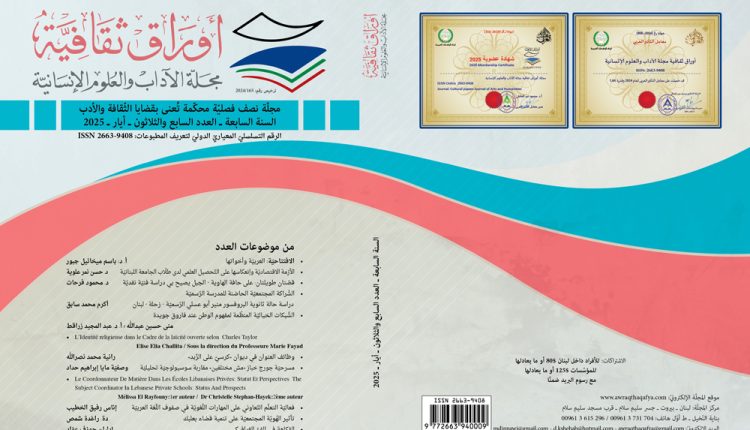عنوان البحث: وظائف العنوان في ديوان "كرسيّ على الزّبد"
اسم الكاتب: رانية محمد نصرالله
تاريخ النشر: 2025/05/13
اسم المجلة: مجلة أوراق ثقافية
عدد المجلة: 37
تحميل البحث بصيغة PDFADOI: https://aif-doi.org/awraq/013711
وظائف العنوان في ديوان “كرسيّ على الزّبد”
Fonctions du titre dans la collection “Une chaise sur du beurre”
رانية محمد نصرالله([1])Rania Mohammad Nassrallah
تاريخ الإرسال:16-4-2025 تاريخ القبول:28-4-2025
الملخص turnitin:4%
يحاول هذا البحث دراسة وظائف العنوان في ديوان “كرسيّ على الزبدّ” للشاعر محمد علي شمس الدّين”. لما يحتلّه العنوان من مكانةٍ في النّصّ الأدبي، فهو مصدر الأفكار النّازفة الّتي تتحد في بنية النّصّ، مكونةً فضاءً قادرًا على البوح، والانتشار في مفرداته. وقد جاء هذا البحث مقدمة للدخول في عالم “شمس الدّين” الإبداعي؛ إذ إنّ العناوين الّتي اختارها الشّاعر لقصائده، جاءت غنيّة بمضامين شعريّة مُعبّرة، تدل على تجربة تتوخى المفارقة، والرّؤيا اللّتين تشكلان جوهر الشّعر بسمو تعاليه، ونبل مقاصده.
الكلمات المفاتيح: سيميائيّة العنوان، الانزياح، الدّلالة، الرّمزية، الإيحاء
Le Resumé
cette recherche tente d’étudier les fonctions du titre dans le recueil “une chaise sur l’écume du poète “Mohammad Ali Shamseddine”, étant donné l’importance du titre dans le texte littéraire. Il est la source des idées jaillissantes qui s’intègrent dans lo structure du texte, formant un espace capable de se dévoiler et de se diffuser dans ses termes.
cette étude constitue une introduction 01 l’univers créatif de “Mohammad Ali shamseddine, car les titres qu’il ‘il a choisis pour ses poèmes sont riches en significations poétiques expressives, reflétant une expérience qui qui recherche l’ironie et la vision, lesquelles constituent l’essence même de la poésie par la noblesse de ses enseignements et la grandeur de ses intentions.
Mots-clés: sémiotique du titre, déplacement, signification, symbolisme, suggestion
مقدمة
اتجهت الدّراسات النّقديّة الحديثة إلى البحث عن مفاتيح نصيّة، تمكن المتلقّي من الإمساك بمراكز إنتاج المعنى في النّصّ الأدبي، أضف إلى تحديدها هويّة النّصّ، وطبيعة تشكلاته الفكريّة، بما يساعد في عمليّة التّأويل، ومحاولة فكّ مغاليق النّصّ، فكان البحث في العنوان والعتبات مثل: الغلاف، والإهداء، والحواشي، والمتن، وغيرها من هذه المفاتيح التي تشحذ ذخيرة المتلقّي التّأويليّة، وتستدعي ثقافته الفكرية، لتعثر على مخرج تأويلي مناسب، يفضي إلى معنى، يفصح عن أبجديات النص الإبداعي.
ترتكز قصائد الشّاعر “محمد علي شمس الدّين” على رؤيا، تمثّل وعيًا كتابيًا حركيًا، تنطلق من الحياة باتجاه الذّات، ومن الحضور إلى الوجود، وهذا ما يجعل القصيدة تنهض بوصفها فعلًا تحرّريًا مستندًا إلى الوعي، وإلى ذات مبدعها، أضف إلى أصالتها في خطابها مع الآخر. لقد نهج النّصّ الشعري الحديث منهما جعل من العنوان لازمة مهمة له تدل عليه، وتعبّر عنه، وتشير إليه، إذ حرص الشّاعر المعاصر على أن يكون العنوان مليئًا بالإيحاءات، والإشارات التي تُغوي المتلقّي وتأخذ بيده إلى متن النصّ، بوصفه صورة نفسيّة تعكس وجدان الشّاعر المنتقد، ورؤاه الفكريّة الخصبة، وتكشف مشاربه الثقافيّة، والفنيّة الّتي تشكّل في مجملها نصًّا مبدعًا، قابلًا للتأويل، والكشف المستمر.
وهذا لا يعني أن الشّعراء المعاصرين كانوا على سويّة واحدة في اختيارهم عناوين دواوينهم الشّعرية، أو قصائدهم، فهناك شعراء تقليديون في اختيارهم العنوان الذي يمتاز بطابعه الطارئ على النّص، ومهادنته للمتلقي، ومحدوديته الفكريّة الخالية من الإيحاءات، أضف إلى انسياقه في مواقف كثيرة لمناسبة القصيدة، وهناك شعراء مجددون في اختيارهم لعناوين دواوينهم أو قصائدهم، “إذ يمتاز العنوان بصداميته مع المتلقّي، وانفتاحه على فضاء اللّغة، فيكتنز بالدّلالة، ويمارس فاعلية الإغراء والاغواء معًا([2]).
عنوان العمل الأدبي هو الشّارة الأولى الّتي يُطالعها المُتلقّي، وقد يكون الدّافع للإقبال على النّصّ، أو الإحجام عنه، لذا أصبح يحمل أهمّيّة واضحة في الدّراسات النّقديّة الحديثة. وقد أصبح الشّاعر يفكر بهذه اللبنة لتسمية عمله “كما يفكر الوالدان في تسمية طفلهما”([3]).
ولعلّ هذا الاهتمام عائد إلى أمرين:
الأّول: إعطاء العمل الأدبيّ سمة ابداعيّة، تمنحه البقاء، فإبداع العنوان، وحسن تأليفه، وإعطاؤه خصائص إيحائيّة، تكشف النّصّ الّذي يليه، وتعمّق كينونته، أمور تعطي العمل الإبداعيّ وجودًا جديدًا، لا يقل أهميّة عمّا يمنعه النّصّ الرّئيس، “فالعنوان … ذو حمولات دلاليّة، وعلامات إيحائيّة شديدة التّنوع والثّراء، مثله مثل النصّ، بل هو نص مواز…”([4]) وقد يموت النّصّ، حين يخبو بريقه بين الأجيال، بينما يظل العنوان متألقًا بوصفه أيقونة “ثقافيّة تتجاوز حدود سياقه الأصلي.
الثّاني: يُشكّل العنوان نقطة انطلاق لدى القارئ، ينطلق منها إلى جسد النّصّ، فهو إضاءة لمحتوى النّصّ، والمدخل الأمين لولوج غير متعثر إلى فضاءاته، وكلما حمل العنوان مضمون النّصّ، وارتبط به كان مفتاحًا أجدى لفتح بنية القصيدة.
ومن ثمَّ فإنّ للعنوان وظائف كثيرة منها: “تعيين الأثر (العمل، النّصّ). والدّلالة على محتواه، وإعطاؤه قيمة، وجذب القارئ وإغراءه”([5]) وهذه الوظائف لا يستغنى عنها عند تحليل النّصّ، و”قد يفقد التحليل النّصّي كثيرًا من دلالاته إذا لم تؤخذ في الحسبان،”([6]) أمّا إذا أعطي القارئ العنوان، والنّصّ فإنّه سيستحث على خلق القصيدة.
والسؤال المطروح هنا: هل اهتمّ الشّاعر “محمد علي شمس الدين” بعناوين قصائده؟ وكيف بدت الذّات الشّاعرة في علاقتها مع الوجود من خلال هذه العناوين؟
تستوقفنا مسألة جديرة بالتّأمل في نظام العنونة عند “محمد علي شمس الدّين”، وتتمثّل في أنّ عنوان ديوانه ليس في الأصل عنوانًا لقصيدة فيه، وذلك ما يثير شهيّة التساؤل عن مسوّغات ذلك التوجه ودوافعه.
فهل قصد الشّاعر من ذلك وضع القارئ على صفيح ساخن من التوقّع، والدّهشة، والانتظار؟ أم أنّه يريد أن يضيف إلى عنونته علاقة أخرى مميزة؟ أم أنّ الشّاعر ينأى عن التّكرار، ويسعى إلى تكريس العنوان الّذي يزجي سائر العناوين تحت هيمنة دلالته؟
وأيًّا كانت الدّوافع، فإنّ “محمد علي شمس الدّين” جعل لنفسه نهجًا خاصًا في العنونة، كما أنّه ليس من الّذين يعنونون خبط عشواء قصد بلبلة الأفكار إنّما العنونة عنده ممارسة إبداعيّة، تتمسك بوهجها التّعبيريّ، وتحافظ على نسقها الدّلاليّ والجماليّ.
لقد أنجزت العنونة عند “محمد علي شمس الدّين” قيمتها الدّلاليّة الموازية لمتونها النّصيّة، وكانت عنده جهدًا معرفيًّا يستقرئ ما يعايشه، ليصنعه تجربة إبداعيّة، يعيد تكثيفها، وإنجاز مدلولها لاحقًا بعنوان هو حاضنة لتلك الرؤية التي أنجزت نفسها في تشكيل نصوصي مثير، ومن هذا المنطلق، فقد استوقفت اللّحظة التّأويليّة لعنونة الدّيوان ونصوصه تدارك الشاعر، فنُظر إلى منطلق العنونة بوصفه تبنيًا لموقف فكري يستنطقه الدّيوان عبر مرحليّة التّجربة، واستكناه الرّؤية التي أقام عليها “محمد علي شمس الدّين” قراءة الواقع من حوله شعريًّا .لذلك قد تكمن أهميّة هذه الدّراسة في توضيع، وظائف العنوان في قصائد ديوان “كرسيّ على الزّبد” وبيان دلالتها الفكريّة، وقيمتها الفنيّة بوصفها مكوّنًا مهمًّا في النّصّ الشّعري.
وضمن النّظام السيميائي للّغة، فإنّه يمكن بعث الوظائف التّالية للعنوان في قصائد ديوان “كرسيّ على الزّبد”.
أولًا – الوظيفة الانزياحيّة
إنّ دراسة العنوان بوصفه انزياحًا لغويًا، يسُهم في إدراك أبعاد النّصّ الشّعريّة، ومراميه الفنيّة، بل إنّه وسيلة فنيّة بالغة الأهميّة في إضفاء الشّعريّة على النّصّ من أول كلمة يتلقاها القارئ الذي يسعى جاهدًا لبلوغ اللّذة الفنيّة.
إذ “من الممكن جدًا أن يؤسس العنوان لشعريّة من نوع ما، حين يثير مخيلة القارئ، ويلقي به في مذاهب، أو مراتب شتى من التّأويل، بل يدخله في دوامة التّأويل، ويستقر كفاءته القرائيّة من خلال كفاءة العنوان الشّعريّة”([7]).
ولعلّ شعريّة العنوان الّتي يبدعها الشّاعر بإحداث الفجوة الدّلاليّة في التّركيب اللّغوي يظهر أثرها واضحًا في عمليّة التّلقي الّتي تسعى إلى سد ذلك المنحى التباعدي بين الألفاظ برؤى تأويليّة واضحة، تنقذ القارئ من الصدمة الّتي يسببها تركيب العنوان اللغوي، وتجعل منه منتجًا النص منذ لحظة التلقي الأولى.
يعكس: عنوان “كرسيّ على الزّبد” انزياحًا لغويًّا واضحًا، يمتاز بالصّداميّة، ومخالفة منطق الأشياء؛ فهذا العنوان الذي عنون به الشّاعر مجموعته يحتوي على بذرة الجدليّة (الحركة /السّكون). العنوان مؤلف من كلمتين اثنتين يربط بينهما حرف الجّر (على) الدال على المكانيّة، فكلمة (كرسي) مؤشر يدلنا على الثبات، وعدم الحركة، لأنّ الكرسي هو مقعد من الخشب ونحو لجالس واحد.
وهذا الجالس إمّا أن يكون قاصدًا الاستراحة، وإمّا أن يكون محكومًا بعمل يتطلب الجلوس على الكرسي، لكنّ الشّاعر خالف أفق توقع المتلقي عندما جعل الكرسيّ موضوعًا على الزّبد، فهذه الكلمة المفعمة بالحركة، والاضطراب تُفصح عن طبيعة الجلوس المحفوفة بالمخاطر بسبب عدم استقرارها على أرض صلبة. فالمتلقي الذي يتوقع من الكرسيّ أن يكون رمزًا للثبات والرسوخ، يجد نفسه أمام صورة متناقضة، إذ يوضع هذا الرّمز التّقليدي للاستقرار فوق عنصر سريع الزوال. يخلق توترًا دلاليًّا يخلخل يقين المعنى. ومن منظور سيميائي، يوظف الشّاعر هذا التّناقض ليبرز هشاشة كلّ استقرار مبني على أسس واهية، فيحيل العنوان إلى دلالة رمزيّة تتجاوز المشهد البصري إلى طرح فلسفي حول طبيعة الاستقرار في عالم متغيّر. وهكذا، يستفز القارئ لإعادة تأويل العلاقة بين السّلطة والهشاشة، الثبات والانجراف في سياقات مختلفة تمتد من البعد الاجتماعي إلى الوجودي.
يحمل عنوان “عكّاز على الزّبد” انزياحًا لغويًّا حادًا يتسم بالمفارقة، والصدام مع منطق الأشياء إذ يطرح العكّاز الّذي يفترض أن يكون أداة دعم واستناد، في قضاء منعدم الثبات. فبدلًا من أن يكون وسيلة للاتكاء والتّوازن، يصبح هذا السّياق رمزًا للهشاشة وعدم الجدوى، إذ يسند ذاته إلى الزّبد، ذلك العنصر الزائل سريع التّحول. هذه المفارقة لا تخلق فقط مشهدًا بصريًّا مستحيلًا، بل تكشف دلالة رمزيّة عميقة تعكس طبيعة الاستناد إلى ما لا يمكن الاتكاء عليه أصلًا، سواء أكان ذلك في البنية الاجتماعيّة، أو في التّجربة الإنسانيّة ذاتها، فيبحث الفرد عن ثبات موهوم وسط واقع متغيّر.
ومن منظور سيميائي، فإنّ هذا التّناقض لا يُعبّر فقط عن هشاشة الاتكاء، بل يكشف أيضًا وضعًا مأزقيًّا يتجاوز البعد الحسي إلى أبعاد فلسفيّة أكثر عمقًا، إذ تتلاشى الفواصل بين الدّعم والانهيار، وبين البحث عن التّوازن، والغرق في الفوضى بهذا يصبح العنوان ليس فقط تركيبًا لغويًّا غير مألوف، بل رؤية رمزيّة تعيد مساءلة مفهوم الاستناد ذاته، في عالم يتبدد فيه اليقين كما يتبدّد الزّبد فوق الماء.
ثانيًا – الوظيفة النّحوية
وهي وظيفة يحققها التّركيب النّحوي للعنوان بوصفه علاقة سيميولوجيّة دالة تختزل النّصّ لتحقيق أكبر قدر من الانسجام الفكري. فالعنوان جزء من التشكيل اللّغوي للنّصّ، يقيم تعالقه أفقيًّا، وعموديًا؛ لإنتاج الدّلالة، وتحفيز القراءة، واستثمار المساحة الجماليّة المعنية بأفق التّوقع، أضف إلى كونه “رسالة لغويّة، تُعرّف بهويّة النّصّ، وتحدّد مضمونه وتجذب القارئ إليه، وتغويه به”([8])
أوّل ما نقف عنده من القصيدة، هو العنوان لأنّ العنوان يُمثّل البطاقة الشّخصيّة للنّصّ، وهو أيضًا يمثّل ثريا النّصّ فمثلما تُضيء الثّريا فضاء البيت، فكذلك يضيء العنوان النّصّ للقارئ الّذي هو بصدد قراءته كان أوّل تجل للرّؤيا في عنوان قصيدة “مريض البحيرة ” العنوان عبارة مركّبة من مضاف ومضاف إليه ووظيفة الإضافة هنا أن تنسب المضاف إلى المضاف إليه. فما معنى أن ينتسب مريض ما إلى البحيرة؟
كلمة (مريض) تعريف بإنسان مصاب بالضعف والهوان والعلل، أمّا البحيرة فتُعدّ من الأماكن الخصبة، فهي حوض مائي داخلي محدود المساحة، محاط باليابسة من الجهات جميعها، فهل سيكون انتساب ذلك المريض إلى البحيرة انتسابًا للتخلص من الأسقام والأوجاع، وتحويله إلى إنسان معافى؟
ثالثًا –الوظيفة الانفعاليّة
للعنوان وظائف تعبيريّة، وانفعاليّة، وتأثيريّة، فالشّعر شعور وخيال وفعل وانفعال، وهو العتبة الأولى التي يواجهها القارئ، وربما تستوقفه وتثير سؤاله، بخاصة إذا كان العنوان محكومًا بظروف إبداعيّة، يتشابك فيها الذّاتي بالموضوعي والواقعي بالخيالي.
فعنوان “الصرخة” ذو دلالة خطابيّة، وانفعاليّة واضحة، ما يلفت النّظر في عنوان هذه القصيدة هو إيجازها في كلمة واحدة، فهو عنوان مراوغ، ذات طبيعة استكشافيّة، متحصنة بالرّؤى الّتي تعكس إحساسًا بدور الكلمة، ووظيفتها في شحن النّفس والتّأثير بها.
“الصّرخة” صوت ملفوظ، فإمّا أن يكون صوتًا لا دلالة له، إلّا على مرض أو تأفّف أو نحوهما، أو يكون كلامًا.
ويتفق علماء الأعضاء على أن الصّرخة أو الصّيحة هي صيحة صحّيّة، لأنّها تشير إلى مكان العلّة من جسد الإنسان لمعالجته، لذلك سمّوا السّرطان مرضًا خبيثًا لأنّه يخدع ولا يشعر به الإنسان، ولا يصيح منه إلّا بعد أن يفتك به، والصّرخة في هذا العنوان هي صرخة لمعاناة روحيّة ولا ندري أصحيّة هي أم مرضيّة؟
رابعًا – الوظيفة الرمزيّة
إن دراسة العنوان بوصفه نصًّا موازيًا، يختزن الفكرة، ويبعث الدّلالة، جعل منه بؤرة ذات قيمة إبداعيّة، ذلك أنّ كلّ نموذج نصّي، ويتضمن بعض القرارات الموجهة، ولا يتساوى النّموذج مع النّص الأدبي نفسه، بل يفتح طريقًا للوصول إليه، وحين نحلل نصًّا، فإنّنا لا نتعامل مع نص خالص، وبسيط، بل إننا نطبّق بالضرورة إطارًا مرجعيًّا، يُختَار من دون غيره للتحليل. ولمّا كان النّصّ في أحد أبعاده الدّلالية “لعبة من الدّلائل نفسها، بمعنى أن النّصّ يفتك لك الدلائل على وفق ثقافتك، وخلفياتك الفكريّة، والمعرفيّة، والجماليّة”([9])، فإنّ العنوان جزء من نسيج النص المسكوت عنه، يتسق معه وفق رؤى فكريّة خاصة.
واللّغة الشّعريّة ذات الطّابع الرّمزي أكثر إيحاءً وإغواءً للمتلقي الذي يحاول الإمساك بتفجراتها وتدفقاتها، وانسياباتها خارج نظام اللغة المعجمي؛ لتكون بذلك مفتاحًا رئيسًا لولوج عالم الشّاعر المثقل بالرّموز الّتي يكثر حضورها في الأحلام، والشّعر، والأساطير إذ يشير عنوان القصيدة الأولى من الدّيوان “عصفورة اسمها الحياة” إلى دلالة رمزيّة واضحة، تنتقل بالمتلقّي إلى عالم آخر، يريده الشّاعر، ويجنح إليه في أفكاره، هذا العنوان مركب تركيب الجمل الإسميّة، مبتدأه اسم نكرة (عصفورة)، وخبره جملة اسميّة (اسمها الحياة) يتضمن هذا العنوان التباسًا وجوديًّا في علاقة الحياة بالموت فهذه العصفورة الهاربة الآتية من غابة نائية لتبني في الأرض عُشًا ضئيلًا ماثل الشّاعر بينها وبين الحياة. فعن أي “حياة” تتحدث؟ وهل الحياة على الأرض هي بهشاشة هذه العصفورة؟ وفي إطار العلاقة بين الرّمز واللّغة في هذا العنوان، نجد أنّ الشّاعر قد اختار لغة “بسيطة”، ولكنّها متينة في الوقت نفسه، تقوم على إبداع ينبثق من رؤيا شاملة، تتجاوز الواقع، لتصل إلى كنه الوجود وجوهره.
الرّمز هو أحد أدوات بناء النّصّ الشّعري، ووسيلة المبدع للاتصال بالمتلقّي، وإشراكه في تجربته الشّعريّة، إذ يحمل أبعادًا نفسيّة وفنيّة واضحة تجعل اختياره يبتعد من التّعسف أو الاعتباط. “غيمة، يرى المتمعّن في عمق هذا العنوان أنّه يحمل بداية رموز الخصب والأمل، فالغيمة ليست مجرّد عنصر طبيعي، بل هي كيان يتجاوز معناها الظاهري إلى دلالات أعمق تستند إلى المخزون الثّقافي، والوجداني للإنسان.
لقد ارتبطت “الغيمة” منذ القدم بعناصر الحياة والتّفاؤل، فهي في المخيّلة الإنسانيّة إشارة إلى الخير والعطاء، إذ تحمل المطر الأنقى، والأعذب، والأصفى، لتمنحه للأرض كي تلد وتخصب، وتبعث فيها الحياة بعد الجفاف. لكنّها في الوقت ذاته، تحمل في جوهرها شيئًا من الغموض والتناقض، فهي كيان متحوّل، لا يستقر في مكان واحد، وقد تجلب المطر أو تمر عابرة بلا أثر، ممّا يضفي عليها طابعًا إشكاليًّا يسمح بتعدد التأويلات.
إنّ التنكير في العنوان “غيمة” يضفي على هذه الكلمة مزيدًا من الخصوصيّة والفرادة، إذ يحررها من المعنى التقليدي ويوجهها نحو تجربة خاصة يحملها النّصّ الشّعري. فلو قال الشّاعر “الغيمة” لأشار بذلك إلى مفهوم عام، أمّا استخدام “غيمة” بصيغة النّكرة فهو يجعلها فرديّة، متميّزة لها كيانها الخاص الّذي لا يتكرّر. إنّها ليست أي غيمة، بل غيمة محدّدة داخل التّجربة الشّعرية، قد تكون حلمًا، فكرة، حال وجدانيّة، أو حتّى رمزًا لحال الانتظار، والرّجاء، أو الخيبة والفقدان.
الغيمة أيضًا تتسم بالازدواجيّة في دلالتها، فهي من جهة رمز للحياة، والخصب عندما تمطر، لكنّها من جهة أخرى قد تكون رمزًا للحزن والاغتراب عندما تحجب الشّمس، أو تعبر السّماء من دون أن تمنع المطر، هذا التّناقض في جوهر الغيمة يمنحها ثراء دلاليًّا يمكن أن يتكيّف مع السّياق الشّعري الّذي ترد فيه، ما يعزّز من قيمتها الرّمزيّة، ويجعلها عنصرًا مفتوحًا على التّأويل.
بذلك، يتضح أنّ اختيار عنوان “غيمة” لم يكن عشوائيًّا، بل يحمل في طياته عمقًا رمزيًّا يرتبط بالتّجربة الإنسانيّة في مستوياتها المختلفة، ويثير فضول القارئ نحو استكشاف ماهيّة هذه الغيمة داخل النّصّ الشّعري، وما تحمله معها من معان، ودلالات تعكس جوهر التّجربة الشّعريّة.
يحمل عنوان “أغنية لأيلول” أبعادًا سيميائيّة عميقة تتجاوز معناه الظّاهري، إذ تتشكّل العلاقة بين كلمتيه من خلال شبه الجملة “لأيلول” الّتي تتعلق بخبر محذوف، ما يفتح المجال لتأويلات متعدّدة، فالأغنية قد تكون مهداة إلى أيلول أو مغنّاة فيه، أو مستوحاة منه، وهذا الغموض يضفي على العنوان طابعًا شعريًّا يجعل الزّمن يبدو بوصفه كيانًا حيًّا يستحق أن يُغنّى له، كما أن حذف الخبر يخلق فراغًا تأويليًا يسمح للمتلقي بإسقاط مشاعره وتجاربه على المعنى، ما يعزّز التّفاعل مع النّصّ.
في السّياق الرّمزي، يمثّل أيلول شهر التّحوّلات، إذ تنتقل الطّبيعة من الصّيف إلى الخريف، ويترافق ذلك مع دلالات الحنين، النّهايات الرّقيقة، والبدايات الجديدة. أمّا الأغنية، فهي وسيلة للتعبير عن المشاعر، وغالبًا ما ترتبط بالبوح والمناجاة. وعندما يقترن الصّوت (الأغنية) بالزّمن (أيلول)، تتشكّل دلالة وجدانية تُجسّد التّفاعل بين الإحساس الإنساني، والتّغيرات الزّمنية. كما أن التّنكير في “أغنية” يمنحها طابعًا عامًّا، يتيح لكل متلقّ أن يفسرها وفق حالة الشّعوريّة، ما يجعل العنوان فضاء مفتوحًا للمعاني المتعددّة التي تتأرجح بين الشّجن، والاحتفاء بجمال التّحول.
خامسًا – الوظيفة الاتصاليّة
تحاول هذه المقاربة السّيميائيّة للعنوان، تعميق بعض القضايا ذات الصّلة بموضوع النّصّ. وإيحاءاته الفنيّة، وذلك بما يكشفه العنوان من ديناميّة محفزة، تنفتح على آفاق شعريّة وفكريّة، تُسهم في إنتاج دلالة خصبة، تتجاوز كلّ التّوقعات المسبقة الّتي يحملها المتلقّي للنّصّ.
يحمل عنوان “سيرة إبراهيم” قوّة تأثيريّة لأكثر من سبب، فكونه بدأ بـ “سيرة، فهذا يشوّق المتلقّي لمعرفة هذه السّيرة، وكيف ستصاغ في قوالب شعريّة، ثم يجد لا نسب لإبراهيم”، وبذلك لم يُعط هُويّة شخصيّة.
وما أن يفتح المتلقي عينيه على القصيدة حتّى يجد العنوان مطابقًا لفحواها، فهي تروي قصّة “إبراهيم” الشّاب المقاوم الجنوبي.
وسيرة “إبراهيم” تنمو في آخرها نموًّا دراميًّا مشيرًا؛ إذ تبدأ بحدث النّهاية الشّهادة، ثمّ تعرض قصة أليمة لشاب مجاهد صابر، عاش مهمومًا، ويتيمًا، ومدافعًا عن وطنه، فمّا عرف الاستقرار لحظة، حتى قضى شهيدًا، ومظلومًا، وهكذا توزّع “إبراهيم” في الكون تاركًا أثره الدّموي، فجاء العنوان دالًا على مضمون القصيدة، ومرتبطًا بها ارتباطًا عضويًّا، معمقًا نظرة القارئ تجاهها.
خاتمة
من خلال هذه المحاولة لدراسة العنوان في شعر “محمد علي شمس الدين” يجد الدّارس أنّه نوّع في صياغة عناوينه، وتفاوتت بين المباشرة والإيحاء، لكنّها تكاد تكون غالبًا ملائمة مع البُنى الفنيّة لقصائده، “وإذا كان العنوان هو البؤرة الإيحائيّة الأولى للقصيدة”([10])، فإن عناوين “محمد علي شمس الدين” كانت مداخل موفّقة- غالبًا- وإضاءات للنصوص التي تليها.
إن اختيار “محمد علي شمس الدين” لعناوينه اعتمد على ثقافته الواسعة الّتي منحته مخزونًا كبيرًا من الأفكار المعبّرة عن رؤاه الشّعريّة، أضف إلى قدرته على اكتناه طاقات اللّغة التّعبيرية. وإيحاءاتها الفنيّة التي تجعل النّص أكثر قابليّة للتّأويل لقد أغنى “محمد علي شمس الدين” بعناوين قصائده متلقّيه عن قراءة كثير من نصوصه الشّعريّة، بعد ما أوجز الرؤية، وعمّق من الرؤيا، إذ تتحول المعرفة إلى حقيقة قائمة، تُشكّل نظامًا معرفيًّا، ومرجعيّة واضحة الدّلالة للواقع بكل انكساراته، ما أحال العنوان إلى فكر قاهر للحياة، تتمركز الدّلالة في أعماقه؛ لتبعث نصًّا شعريًّا برؤى فكريّة خصبة.
إنّ عناوين قصائد “محمد علي شمس الدّين” جاءت سؤالًا مُشرعًا محمّلًا بالإيحاءات، والإحالات، والتّأويلات، تمتح من معين تجربة الشّاعر الحياتيّة التي يغلب عليها الحزن، والألم، والقلق، فثمة إغواء محبب تحمله هذه العناوين يستفز المتلقّي لاستنطاقها وكشف رؤاها الفكرية، وتشكلاتها الفنيّة ما جعله يعكس في شعره بُعدًا إنسانيًّا واضحًا.
المراجع
- أبو مراد، فتحي: شعر أمل دنقل – دراسة أسلوبيّة، عالم الكتب الحديث، الأردن، (د.ط)، 2003م.
- حسين، خالد: في نظرية العنوان – مغامرة تأويلية -في شؤون العتبة النصية، التكوين للتأليف والترجمة والنشر، دمشق، ط 1 ، 2007م.
- شمس الدين، محمد علي: كرسي على الزبد، دار الآداب للنشر والتوزيع، بيروت، لبنان ، ط 1، 2018م.
- عيّاد شكري: مدخل إلى علم الأسلوب، دار العلوم للطباعة والنشر، الكويت، (ط 1)، 1982م.
- قطوس، بسام: سيمياء العنوان وزارة الثقافة، عمان، ط 1، 2001 م .
- المطوي، محمد الهادي: شعرية عنوان كتاب الساق على الساق فيما هو الفارياق ، مجلة الفكر، (المجلة 28 – العدد 3، الكويت ، 1999م.
- يحياوي، رشيد: الشعر العربي الحديث- دراسة في المنجز النّصّي، إفريقيا الشرق، المغرب، (د.ط)، 1998م.
1- طالبة دكتوراه في الجامعة الإسلاميّة – خلدة – لبنان – قسم اللغة العربيّة.
– Doctorant à l’Université islamique – Khaldeh – Liban – Département de langue arabe. Email: ranianasralah952@gmail.com
[2] – خالد حسين: فى نظرية العنوان مغامرة تأويلية في شؤون القبة النصية، التكوين للتأليف والترجمة والنشر، دمشق، ط 1، 2007 م، 176- 177.
[3] – شكري عيّاد: مدخل إلى علم الأسلوب، دار العلوم للطباعة والنشر، الكويت، ط1، 1982م، ص 74.
[4]– بسام مطوس: سيمياء العنوان، وزارة الثقافة، عمان، ط 1، 2001م، ص 37.
[5] – رشيد يحياوي: الشعر العربي الحديث – دراسة في المنجز النصي، إفريقيا الشرق، المغرب، (د.ط)، 1998م، ص 113.
[6] – رشيد يحينوي : الشعر العربي الحديث -دراسة في المنجز النّصي، م. س ، ص115.
[7] – بسام قطوس: سيمياء العنوان، م س، ص 38.
[8] – محمد الهادي المطوي: شعرية عنوان كتاب الساق على الساق فيما هو الفارياق، مجلة الفكر (المجلة 28 ، العدد 3)، الكويت، 1999م ، ص 457.
[9] – بسام قطوس: سيمياء العنوان، م س، ص 71.
[10] – فتحي أبو مراد: شعر أمل دنقل – دراسة أسلوبية، عالم الكتب الحديث، الأردن، (د. ط)، 2003 م، ص 66-67.