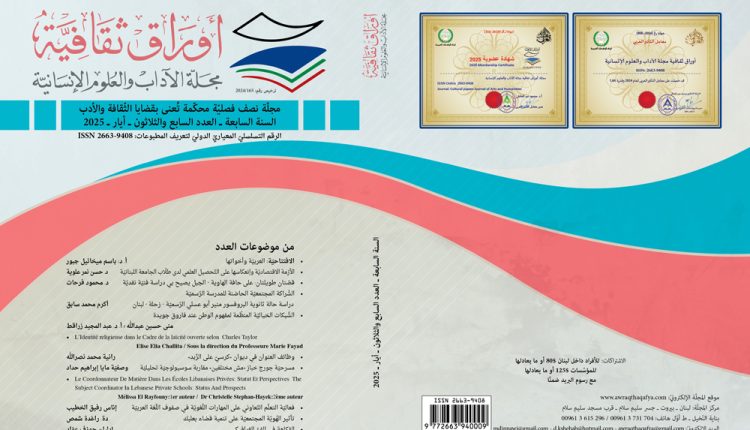عنوان البحث: بنية الأفعال في ديوان "كرسيّ على الزبّد"
اسم الكاتب: رانية محمد نصرالله
تاريخ النشر: 2025/05/13
اسم المجلة: مجلة أوراق ثقافية
عدد المجلة: 37
تحميل البحث بصيغة PDFADOI: https://aif-doi.org/awraq/013712
بنية الأفعال في ديوان “كرسيّ على الزبّد“
La structure des verbes dans le recueil “Une chaise sur du beurre“
رانية محمد نصرالله ([1])Rania Mohammad Nassrallah
تاريخ الإرسال:16-4-2025 تاريخ القبول:28-4-2025
الملخص turnitin:4%
ينبثق الخطاب الشّعري من بنيته اللّغويّة ، إذ تصبح مرتكزًا لكشف جمالياته، والقيم الّتي يتضمنها إذ المدخل الرئيسة لفهم أي نص هو لغته. من هنا كان هدف هذه المقاربة الإجابة عن الإشكاليّة إلى أي حد استطاع ” محمد علي شمس الدّين ” أن يجسّد تجربته الشّعرية عبر هذه البنية ؟ وقد أبانت عن نتائج أهمها: أسهمت الأفعال في إنتاج الدّلالة وانزاحت عن مألوف استعمالها الصّرفي، فجسّدت الصّراع بين الماضي والحاضر، كما تفوقت في الدّيوان أفعال المضارعة الدّالة على الحاضر والمستقبل نظرًا لنظرة الشّاعر التّأمليّة ، وسعيه إلى منح شعره صفة الديمومة، ما جعل نصّه يتجاوز الزّمن الآني نحو أفقٍ أرحب من الاستمراريّة والتّجدد. يضاف إلى ذلك تنويعه في دلالة الجمل الاسّمية والفعليّة، ما منح خطابه الشّعري حركيّة، وديناميكيّة أسهمت في إبراز تفاعل الذّات الشّاعرة مع واقعها المتحوّل.
الكلمات المفاتيح: بنية الأفعال،الماضي، المضارع،الدّلالة.
Résum
Le discours poétique émerge de sa structure Linguistique, qui devient an point d’ancrage pour révéler ses esthétiques et les valeurs qu’il véhicule, car la langue constitue de la dé principale pour comprendre tout texte. Ainsi, cette approche vise à répondre à la problématique suivante; dans quelle mesure “Mohammad Ali Chamseddine” a-t- il réussi à incarner son expérience poétique à travers atte structure?
L’étude a révélé plusieurs résultats, dont les plus importants sont que les verbes ont contibué à la production du sens et se sont détachés de leur usage morphologique habituel, incarnant ainsi le conflit entre le passé et le présent. De plus, les verbes au présent, exprimant le présent et le futur prédominent dans le recueil, reflétant la vision contemplative du poète ane dimension d’intemporalité. À ala s’ajoute sa variation entre les phrases nominales et verbales, conférant à son discours poétique ume dynamique et un mouvement qui mettent en lumière l’interaction du moi poétique avec une réalité en perpétuelle transformation.
Mots-clés : Structure du verbe, passé, présent, sens.
المقدمة
حين يبني الشّاعر نصّه اللّغوي، هو يبني عالمه الخاص الّذي يواجه من خلاله الواقع، “فيعيد صوغه واقعا فنيّا جديدا، بوساطة اللّغة الّتي تكمن شعريتها في كونها نظامًا من الدلالات، تخضع لتباين علاقاتها الدّاخلية، ولنسق تشكلها، وفق هذا النظام”([2]).
انطلاقًا من هذا، “لا يتحقق الشعّر إلاّ بقدر تأمّل اللّغة، وإعادة خلقها مع كلّ خطوة، وهذا يفترض تكسير هياكلها الثّابتة، وقواعد النحو، وقوانين الخطاب …”([3]) وهو أمر غير عبثي، ينسجم مع رؤية المبدع لنفسه، ويتلازم مع رؤيته للعالم من حوله. وبذلك، فإنّ “انتهاك قانون اللّغة المعياريّة – الانتهاك المنتظم – هو الّذي يجعل الاستخدام الشّعري للّغة ممكنًا، ومن دون هذا الإمكان لن يوجد شعر”([4]). إلّا أنّ انتهاك اللّغة المعياريّة ليس الخاصيّة الوحيدة الّتي تحدد لغة الشّعر، ذلك لأنّ اللّغة ترتبط بالنّظام (système) الخاص الذي يُكوّن النّصّ الشّعري. انطلاقًا من هذا، يكون لبناء الجملة دور في لغة الشّعر إذ إنّ “النّسيج النّحوي للشّعر يقدّم عددًا من الملامح البارزة الشّديدة الخصوصيّة الّتي تسم أدبًا قوميًّا معطى، ومرحلة متعددة، وجنسًا أدبيًّا خاصًا، وشاعرًا مفردًا، أو تسم أكثر من ذلك، أثرًا مفردًا. “([5])
والجملة، لدى معظم علماء الفلسفة، والمنطق والدّلالة، هي أدنى عنصر من الكلام الذي يؤدّي معنىً تامًّا ومركّبًا في آن واحد، وهي لدى علماء التّواصل صورة للفهم والإفهام. ومهمّة الباحث أمام الجملة تتمثّل في رصد طريقة بنائها، وكشف العلاقات بين عناصرها، وتحديد الوظيفة التي يشغلها كلّ عنصر من العناصر، والعلاقات اللّغوية الخاصّة بالوظائف، ثمّ تعيين النّموذج التّركيبي الّذي ينتمي إليه كلّ نوع من أنواع الجمل. إنّ بنية الخطاب الشّعري في ديوان “كرسيّ على الزّبد “لمحمد علي شمس الدّين” تنمّ عن فرادة ناتجة عن تلك الكفاءة اللّغويّة الفذّة الّتي تُترجم تلك الدّفقات الشّعوريّة المنبعثة من صدر الشّاعر، ولذلك سنقوم بدراسة بنية الأفعال في قصائد الدّيوان، لما لها من دور جوهري في بناء المعنى، وتشكيل الإيقاع الدّاخلي للنص. وسنسلط الضّوء على كيفيّة توظيف الشّاعر لأزمنة الأفعال وصيغها، من ماضٍ ومضارع وأمر، وعلى ما تحمله هذه البنى من دلالات زمانيّة، ونفسيّة تعكس أحوال الشّاعر، وتوجهات النّصّ. كما سأتناول تنوع الجمل بين الفعليّة والإسميّة، لما لذلك من أثر في إبراز التّوتر الدّلالي، والتّنوع الإيقاعي داخل النّصّ الشّعري.
أوّلًا – الأفعال
تتكوّن الجمل في النّثر أو الشّعر على حدٍّ سواء على الفعل وهي ثلاثة أضرب أو ثلاثة أنواع: الفعل الماضي، والمضارع، والأمر، والمجموعة الّتي بين أيدينا غنيّة وثريّة بهذه الأفعال.
- الفعل الماض: وهو “الكلمة الّتي تدلّ على حدوث شيء في زمن من الأزمنة، والماضي ما وقع قبل الزمان الّذي أتى فيه الفعل، ويكون مبنيًّا على الفتح معلومًا كان أو مجهولًا([6]). أي أنّ الفعل الماضي هو الفعل الذي حدث في زمن مضى، ويكون دائما مبنيًّا غير معربًا.
أكثر الشّاعر في ديوانه من استخدام الأفعال الماضية لما لها من دلالات وإيحاءات كثيرة، ويتضح ذلك في قوله : (الرمل)
” غيمة” نزلت من وراء الجبل
واستراحت على بعد مترين
من منزلي في الحديقة
كنت هيّأتُ لها مقعدًا
وكأسين لي ولها
و سريرا لنا واحدًا
آه ما أجمل هذي الحياة
إذا أنت أحسست
أنّ الطّبيعة أنثى”.([7])
في هذا النّصّ الشّعري، يوظّف الشّاعر الأفعال الماضية ليمنح تجربته طابعًا حكائيًّا يتجوز الوصف إلى استحضار لحظة شعريّة بدت وكأنّها حدثت فعلًا فباستخدامه أفعالًا “نزلت”، “استراحت” ، “هيأت”، “وضعت” يخلق الشّاعر تتابعًا زمنيًّا يوحي بتحقّت هذه اللّحظة المثاليّة، وكأنّها تجربة مكتملة عاشها بالفعل. هذا الاستخدام لا يضفي على النّصّ واقعيّة شعريّة فحسب، بل يحمّله بُعدًا وجدانيًّا فيه حنين ودفء، فالماضي هنا لا يشير إلى ما مضى وانتهى، بل ما تحقق في الوجدان، وما ترك أثرًا دائمًا في الروح كما أنّ البنية السّرديّة التي تنشأ من تعاقب الأفعال تسهم في جذب القارئ، وتعزز من حضور الذّات في مواجهة الطّبيعة الّتي تتجلى في النّصّ كأنّها أنثى حانية تشارك الشّاعر تفاصيله اليوميّة، ووجدانه العميق.
- الفعل المضارع: هو “ما دلّ على معنى في نفسه مقترن بزمان يحتمل الحال والاستقبال”([8]). توجد الكثير من الأفعال المضارعة في الديوان.
نذكر منها: قول “شمس الدّين” في قصيدته “عصفورة اسمها الحياة”: (الرمل)
“غدًا
ستنام الطّيور التي أيقظتنا
تنام على مهلها
حينها تضرب الرّيح وجهًا
ويطفو على الماء شيء هو الخوف
تأتين من غابة نائية
وتبنين في الأرض عشا ضئيلًا
غذا ستنام الطّيور
فنامي إذن”.([9])
نلاحظ في هذا المقطع وجود الأفعال المضارعة الدّالة على الحركيّة، والاستمراريّة، وهي تُساهم أيضًا في بناء دلالة هذا المقطع، فنجد الشّاعر يشير في هذه القصيدة إلى الالتباس الوجودي في علاقة الحياة بالموت، فوظّف الأفعال المضارعة لتعكس رؤيته للمستقبل. وخاصّة أن الفعل الأوّل جاء مسبوقًا بحرف “السين” الّذي يعد فعل للاستقبال بعد أن كان يحمل دلالة على الحاضر، وكأنّ الشّاعر يريد الهروب من الواقع المعاش في الزّمن الحاضر إلى المستقبل الغامض.
- فعل الأمر: هو الفعل الذي يحدث في زمن معين محدد لا علاقة له بالماضي، ولا يتجاوز المضارع، والأمر: “هو ما يطلب له حصول شيء بعد زمن التّكلم”.([10]) وهذا معناه أن الفعل يحدث مباشرة بعد انتهاء المتكلّم من الكلام.
لم يكتف “محمد علي شمس الدّين” من استخدام أفعال الأمر في “كرسيّ على الزّبد” إذ استخدمه سبعًا وسبعين مرّة، لأنّه لم يكن في حوار خارجي يستوجب ذلك، وإنّما انفعالات وأحاسيس داخليّة ذاتيّة قد لا تستدعي الأمر، إلّا من باب أغراض أخرى كالتّوسل، والاستعطاف، والالتماس. ومن أمثلة ذلك في الدّيوان . قوله في قصيدته “نصف شمس ويستريح الغريب”: (الرمل)
“آه يا صاحبي وأنت بعيدٌ زحرح نواحيك تنحني فيجيب
بين جفن السّماء وهي دموع والصبايا وهُنَّ نَدٌّ وطيب
مدّ كفيك واسترح وانتظرها نصف شمس ويستريح الغريب”[11]
خرج الأمر هنا إلى دلالة الالتماس. والالتماس “هو طلب الندّ من الندّ، والصّديق من الصّديق، وفي هذا الطّلب لا يكون الأمر أمرًا بمعناه الأصيل، وإنّها ينقلب الأمر الظّاهري إلى إلتماس رقيق”([12]) في هذه الأبيات، تتجلى أفعال الأمر بصيغة لیست آمرة بقدر ما هي نداء شجيّ يفيض بالحنين والشوق، فكأنّ الشّاعر يناجي الغائب لا ليأمره، بل ليرجوه عودة، أو حتّى حضورًا في الخيال. يقول “زحزح نواحيك”، “مدّ كفيك”، “استرح”، وكأنّ هذه الأوامر محاولات يائسة لإيقاظ الغائب من بعده، أو استحضاره عِبر الكلمات، تحمل الأفعال حركة شعريّة تملأ النّصّ حياة ودفئًا، وترسم مشهدًا حيًّا تتقاطع فيه مشاعر الانتظار مع رهافة الأمل. إنّها لغة قلبٍ متعب، يطلب الرّاحة، لا بسلطة آمرة، بل بحنين متأجج، ينتظر نصف شمس قد تحمل معها الطمأنينة أو الغائب الذي به تستريح الروح.
والجدول التالي يبين عدد الأفعال الواردة في الديوان
| القصائد | الفعل الماضي | الفعل المضارع | الفعل الأمر |
| عصفورة اسمها الحياة | 7 | 27 | 4 |
| سقط الإيناء على المساء | 17 | 9 | 4 |
| الصّرخة | 12 | 27 | 3 |
| حاشية على معلّقة “امرئ القيس” | 29 | 25 | 3 |
| مريض البحيرة | 18 | 13 | 1 |
| أنا منك الجوى | 8 | 4 | / |
| رسول “خولة” | 13 | 13 | 2 |
| قصيدة اليمام | 8 | 10 | 1 |
| يا بحر أقبل فقد شغَرَ البرّ | 18 | 11 | 3 |
| الجنّة | 13 | 20 | 2 |
| رسالة | 3 | 5 | 4 |
| هاجر | 1 | 7 | 2 |
| أحزان نوح | 3 | 8 | 2 |
| نصف شمس ويستريح الغريب | 4 | 5 | 5 |
| وضوء آدم | 2 | 7 | 3 |
| أرى على خرائب الوجود نور الله طافيًا | 9 | 13 | / |
| ليدُمْ إلى الأبد جمالك السّكران | 3 | 6 | 2 |
| عُكّاز على الزّبد | 1 | 6 | / |
| طرب | 0 | 5 | 4 |
| لن ترى البستان بعد اليوم | 9 | 12 | 5 |
| فم النّجوى | 4 | 7 | / |
| لا ترمِ بالسّهم | 5 | 6 | 3 |
| حكاية الشمع الّذي راح يضحك حتّى مات | 11 | 4 | 3 |
| ضنى المنشدين على غافيات السّواقي | 74 | 83 | 7 |
| حلم | 25 | 33 | / |
| أغنية إلى الجميل والنحيل | 7 | 11 | 1 |
| محمّد | 3 | 10 | 1 |
| غيمة | 5 | / | / |
| حادث 15 أكتوبر 2017 | 13 | 21 | 1 |
| غاب الّذي غاب | 9 | 12 | 1 |
| أغنية لأيلول | 1 | 5 | / |
| آه يا وردة عيني في الجزيرة | 7 | 8 | / |
| ماذا سنفعل بالياقوت | 10 | 7 | / |
| بلا مرسى | 11 | 21 | 2 |
| سيرة “ابراهيم” | 16 | 21 | 2 |
| الشنفري | 2 | 7 | / |
| على جبل الشيخ | 15 | 15 | / |
| سأحرس بابين كي تلعبي | 38 | 32 | 4 |
| المجموع | 435 | 544 | 77 |
من خلال هذا الجدول نلاحظ طغيان الأفعال المضارعة إذ نالت الحظ الأوفر، واحتلت المركز الأوّل في نسبة وجودها في الدّيوان يليه الفعل الماضي بينما يندر استخدامه لفعل الأمر، في اعتماد الشّاعر على الفعل المُضارع تكثيف لحال الاستمرار والدّيمومة، فالمضارع زمن مفتوح، لا ينغلق على لحظة محددة، بل يسبح في فضاء من التّجدّد والحركة، ما يعكس رؤية الشّاعر للحياة بوصفها تيّارًا لا يتوقف، تمامًا مثل “الكرسيّ على الزّبد” لا يستقر عليه أحد، الشّاعر يبدو مشغولًا بتوثيق لحظة العيش بكل ما فيها من تحوّل وانسياب، لا بإصدار أوامر أو تثبيت موقف .أمّا ندرة فعل الأمر، فتنمّ عن تواضع الذّات الشّاعرة، وامتناعها عن فرض رؤى أو توجيهات. هو شاعر لا يأمر، بل يتأمّل، لا يفرض، بل يحاور العالم والأشياء، في انكسار وجودي، وحس فلسفي ينأى عن السّلطويّة، حتّى في اللّغة، الأمر، بطبيعته، يحمل صيغة قاطعة، بينها “شمس الدّين” يتأرجع بين السّؤال والتّأمل بين الغياب والبحث، لا يسعى للحسم بل للغوص في المعنى المتحول. وهكذا، فإن طغيان المضارع وغياب الأمر يعكسان جوهر الرؤية الشّعرية في الدّيوان: شعر يتنفس في الزمن، لا يمسكه، ويهمس، لا يأمر.
ثانيًا – أنواع الجمل
إنّ لكلّ شاعر طريقته الخاصّة في اختيار تراكيبه اللّغوية مدفوعا من وحي تجربته الشّعرية، ومن المؤكّد أن كل تركيب أسلوبي في الخطاب يأتي استجابة لرؤية الشّاعر، وذلك “أنّ التّركيب اللّغوي هو الّذي يمنع الخطاب كيانه وخصوصيته”.[13] وهذه التراكيب هي الجمل، ويُعرّفها “ابن جني بقوله: وأما الجملة فهي كلام مفيد مستقل بنفسه، وهي ثلاثة أنواع: اسميّة، فعليّة، شبه جملة، وقد نوع “محمد علي شمس الدّين” في استعمالها.
- الجملة ا: هي مجموعة من ألفاظ مركبة تركيبًا صحيحًا ترتبط فيما بينها للتعبير عن مجموعة أحاسيس ومشاعر، “والجملة الإسميّة تفيد معنى ثابتًا، أي تفيد ثبوت الخبر للمبتدأ”([14]). والجملة الإسميّة لها دور في بناء القصيدة لدى “محمد علي شمس الدين” وهذا ما لاحظناه في بعض قصائد مجموعته “كرسيّ على الزّبد” ، ففي قصيدة “يا بحر أقبل فقد شغر البر”. يقول(المتدارك :
“إن في البحر برقا
وفي شفتينا نداء إلى الماء
يا بحر كن بيتنا وحمانا
وما أورثتنا حكايات جداتنا
من رحيل إلى جنة لا ترى
خَلْفَ هذا التراب القديم [15].
إن توظيف الجمل الاسميّة في هذه القصيدة يعد من الثبات والاستقرار الزمني، ويدل على قلق الذّات المبدعة، أو فوضى داخلية يحسّ بها الشّاعر، وتأزم الوضع في نفسيته انعكس على عالم أشعاره، فهو يريد اللّجوء إلى البحر، والاحتماء به، بعيدًا من حياة البر المؤلمة والمليئة بالحروب.
- الجملة الفعليّة: وهي “كل جملة يكون فيها المسند دالا على التّغيير والتّجدد”([16]) أو بعبارة أخرى هي الجملة الّتي “يكون المسند فيها فعلًا يدل على الحدث والحدوث سواء أكان متقدمًا على المسند أم متأخرًا عنه”([17]). ومن استعمالات “محمد علي شمس الدّين” هذا النوع من الجمل في شعره، كقوله: (الرّجز)
“أوقدت نارا كي ترى “ليلى” على مرآتها وجهي فلم تُبصر
سوى غبش الدخان
فأمرت ناري أن تنام وموقدي أن ينطفي
وبدأتُ أنظر في الظلام لعلّه ينشق عن شئٍ أضيء به ارتيابي
فرأيتها تمشي على خطّ الرّمال كأنها شمس الظهرة لا أقول
لمستها ومسحت عينيها بماء الورد أو قبّلتها وضممتها
حتى كأنّ الشّمس تدخل في ثيابي
لكنّ “ليلى”، وهي أجمل ما تكون بعيدة عني، دنت
وأكاد ألمس نهدها البدوي
ألمسه قريبا وهو يعلو ثم يهبط
خافقا كوجيب قلبي”([18])
هذه الأبيات تحتوي على الجمل الفعليّة، (أوقدت نارًا، فلم تبصر، فأمرت ناري، أن تنام…) فهذه الجمل تظهر حال الشّاعر المنهوك السعادة، وتبين وجعه المتواطئ مع الحياة إذ يعاني من الوحدة، والغربة، وألم الفراق، وهذه الجمل الفعليّة لها دلالة في بناء معنى القصيدة بشكل عام، ومعنى البيت بشكل خاص، وكلّها ساهمت في بناء الدّلالة، والرّبط بين أجزاء القصيدة.
الخاتمة: إن دلالة استخدام الأفعال في ديوان “كرسيّ على الزّبد” لـ “محمد علي شمس الدّين” تتجاوز البعد النحوي إلى أفق بلاغي وجمالي أوسع، إذ تصبح الأفعال – لا سيّما المضارعة – محورًا حيويًّا لفهم البنية الدلاليّة والوجدانيّة في شعره. فهذه الأفعال لا تعمل فقط على تحريك النّصّ، بل تكشف اضطراب الذّات الشّعرية، وتوترها المستمر بين الحلم والواقع، بين الفناء والتّشبث بما لا يطال.
وتظهر براعة الشّاعر في قدرته على تنويع الأسلوب بين الجمل الإسميّة والفعليّة، إذ تعكس الجمل الإسميّة حاله التأمليّة والسكونيّة، بينما تضخ الجمل الفعليّة – بأفعالها المتدفّقة – طاقة الحركة والتوتّر والتحوّل. ويأتي هذا التنويع ليعبّر عن رؤيته الوجوديّة المتقلّبة، إذ اللّغة نفسها تغدو كائنًا متحوّلًا، لا يستقر على معنى واحد، تمامًا كما لا يستقر “كرسيّ على الزّبد”.
وهكذا تكتسب الأفعال في هذا الديوان وظيفة شعريّة وبلاغيّة، إذ لا تحكي الواقع فحسب، بل تراوغ وتوحي وترتجف مع كل موجة من أمراج الذّات، وتبدو القصيدة، في جوهرها، فعلًا مستمرًا من الأسئلة والثلاشيات، لا يقين فيه ولا قرار، بل تيّار لغوي مفتوح، يعيد تشكيل المعنى في كل لحظة. ومن هنا تتجلى براعة “محمد علي شمس الدّين ” في تطويع البنية اللّغوية لتخدم رؤيته الوجوديّة العميقة، شاعرًا يرى في اللّغة والكتابة معادلًا للبحث الدّائم عن الذّات في عالم متحوّل وزائل.
المراجع
- البياتي، سناء حميد: قواعد النحو العربي، في ضوء نظرية النظم، دار وائل للنشر، ط 1، 2003 م.
- حمر العين، خيرة: جدل الحداثة في نقد الشعر العربي، منشورات اتحاد الكتّاب العرب، دمشق، (د. ط)، 1996 م.
- السد، نور الدين: الأسلوبية وتحليل الخطاب، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، (د.ط)، 2000 م.
- السراج، محمد علي: اللّباب في اللغة وآلات الأدب والشعر والصرف والبلاغة والعروض، دار الفكر، سوريا، ط1، 1963م.
- شمس الدين، محمد علي: ديوان كرسي على الزّبد، دار الآداب للنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، ط 1، 2018 م.
- شيخ أمين، بكري: البلاغة العربية في ثوبها الجديد، علم المعاني، دار العلم للملايين، 2003 م.
- الغلاييني، مصطفى: جامع الدروس العربية، تحقيق: أحمد جاد، دار الغد الجديد، القاهرة، ط 1، 2007 م .
- كوهين، جان: بنية اللّغة الشّعرية، تر: محمد الولي و محمد العمري، دار توبقال، المغرب، ط 1، 1986م.
- المخزومي، مهدي: في النحو العربي، (قواعد وتطبيق)، دار الرائد العربي، (د.ط)، (د.ت).
- موكاروفسكي، يان: اللغة المعياريّة واللّغة الشّعريّة، تر: ألفت كمال الرومي، مجلة فصول، القاهرة، مج 5، ع 1، 1984 م.
- النادري، محمد أسعد: نحو اللّغة العربيّة (كتاب في قواعد النّحو والصرف) المكتبة المصرية، بيروت، (د.ط)، 2002 م.
- ياكبسون، رومان: قضايا الشّعرية، تر: محمد الولي ومبارك هنوز، دار توبقال، المغرب، ط 1 ، 1988 م .
1- طالبة دكتوراه في الجامعة الإسلاميّة – خلدة – لبنان – قسم اللغة العربيّة.
– Doctorant à l’Université islamique – Khaldeh – Liban – Département de langue arabe. Email: ranianasralah952@gmail.com
[2] – خيرة حمر العين: جدل الحداثة في نقد الشعر العربي، منشورات اتّحاد الكتاب العرب، دمشق، (د.ط)، 1996 م، ص 131.
[3] – جان، كوهين: بنية اللغة الشّعرية، تر: محمد الولي ومحمد العمري، دار توبقال، المغرب، ط 1، 1986م، ص 176.
[4] – يان موكاروفسكي: اللّغة المعيارية واللّغة الشّعرية، تر: ألفت كمال الرّومي، مجلة فصول، القاهرة، مج 5، ع 1، 1984م، ص42.
[5] – رومان ياكسون: قضايا الشّعرية، تر: محمد الولي ومبارك هنّوز، دار توبيقال، ط 1، 1988 م، ص 73.
[6]– محمد على السراج : اللّباب في اللّغة وآلات الأدب، والنّحو والصّرف والبلاغة والعروض، دار الفكر، سوريا، ط1 ، 1963م، ص15.
[7] – محمد على شمس الدين: ديوان كرسي على الزّبد، دار الآداب للنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، ط 1، 2018 م، ص 133.
[8]– مصطفى الغلاييني : جامع الدروس العربية، تحقيق: أحمد جاد، دار الغد الجديدة، القاهرة، ط 1، 2007 م، ص 29.
[9] – محمد علي شمس الدين: ديوان كرسي على الزبد، م.س، ص 7.
[10] – محمد أسعد النادري: نحو اللّغة العربيّة (كتاب في قواعد النحو والصرف)، المكتبة المصرية، بيروت، (د.ط)، 2002 م، ص 15.
[11] – محمد على شمس الدين: ديوان كرسيّ على الزّبد، م.س ص74 – 75.
[12] – بكري شيخ أمين: البلاغة العربية في ثوبها الجديد، علم المعاني، دار العلم للملايين، 2003م، ص 103.
[13]– نور الدّين السّد: الأسلوبية وتحليل الخطاب، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، (د، ط)، 2000 م، ص 172.
[14] – سناء حميد البياتي: قواعد النّحو العربي في ضوء نظرية النظم، دار وائل للنشر، ط 1، 2003 م، ص 148.
[15] – محمد علي شمس الدين، ديوان كرسيّ على الزّبد، م.س، ص 58.
[16] – مهدي المخزومي: في النحو العربي، (قواعد وتطبيق)، دار الرائد العربي، (د.ط)، (د.ت)، ص 86.
[17] – سناء حمید البياتي: قواعد النحو العربي ، م.س ، ص 42.
[18] – محمد علي شمس الدين: ديوان كرسيّ على الزّبد، م.س، ص 121-122.