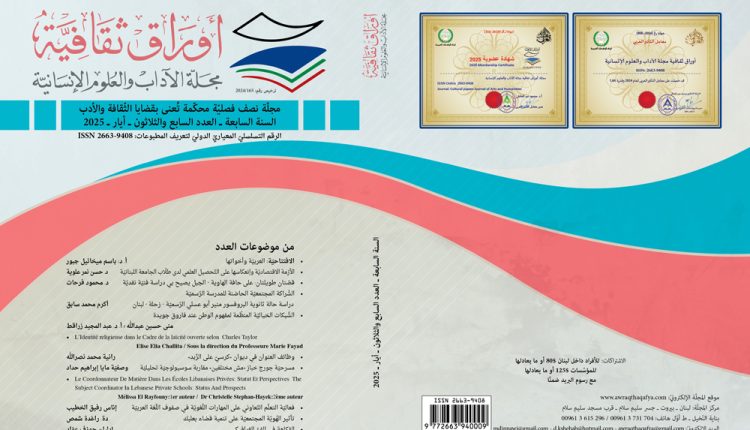عنوان البحث: العنف في المجتمع ظاهرة نفسيّة واجتماعيّة ذات جذور بيولوجيّة
اسم الكاتب: قاسم طالب
تاريخ النشر: 2025/05/13
اسم المجلة: مجلة أوراق ثقافية
عدد المجلة: 37
تحميل البحث بصيغة PDFADOI: https://aif-doi.org/awraq/013716
العنف في المجتمع ظاهرة نفسيّة واجتماعيّة ذات جذور بيولوجيّة
Violence in society a psychological and social aspect with biological roots
قاسم طالب([1]) Kassem Taleb
تاريخ الإرسال:11-4-2025 تاريخ القبول:23-4-2025
الملخص turnitin:11%
تتناول هذه المقالة المحددات الأساسيّة التي يمكن أن يشكل اعتمادها إطارًا فكريًّا ونظريًّا للحركات والجماعات الّتي تمارس الكراهيّة والعدوان، ويمكن من خلاله تصنيف العنف بأنواعه وممارساته المختلفة تصنيفًا متّسقًا مع المنظور النّفسي والاجتماعي متكاملًا مع ما تطرحه ابستمولوجيا العنف الطبيعي والوجودي.
تتضّمن هذه المقالة تحليلًا سوسيولوجيًا للعنف بوصفه من الموضوعات والقضايا الشّائكة في المجتمع. كما تتضمن طرحًا معياريًّا للعنف بوصفه الاجتماعي، السياسي والأيديولوجي، وبمحدداته الأكثر رواجًا: الشّرائط المعرفيّة، القوّة، الدّافع، الاستبداد، الإيديولوجيّة، غريزة الموت، وذلك من خلال النّظريات الّتي تناولت مفهوم العنف. أمّا ما تنتهي إليه هذه المقالة هو فتح كوّة في جدار أزمة متجددة تتولّد بشكل ذاتي، وتلقائي لإعادة النّظر في ما هو اعتباري مصدره العنف كحقيقة نفسيّة واجتماعيّة من جهة، وما هو معياري تحدده قواعد نظريّة سياسيّة وفلسفيّة من جهة أخرى.
الكلمات المفتاحيّة: العنف الوجودي، الإيديولوجيّة، غريزة الموت، الجماعات المتطرفة.
Abstract
This article deals with the basic components that might be used as a theoretical and mental field for the movements and communities that practice hatred and aggression, and based on it violence with its types can be classified in an antagonistic and complete way with the psycological and social point of view and with what is discussed by the natural and existential violence epistemology. This article includes a sociological analysis of violence as it is one of the most spread issues in the society.
In addition to that, it contains standrized suggestion about violence in its social, political, and ideological sides along with its most popular constituents as cognitive conditions, power, incentive, tyranny, ideology, and death instinct through the theories that dealt with the violence concept. As for the conclusion of this article, it isto open ahole in the wall of a self generating and self renewable dilemma in order to reconsider what is legally seen as a social and psycological fact from one side and what is standardized and believed to be based and identified by the political, philosophical and theoretical rules from the other side.
Keywords: Existential Violence, Ideology, Death Instinct, Extremist Groups.

المقدّمة
تطرح النّظرية الاجتماعيّة سؤالها الجوهري حول كينونة العنف وماهيته كظاهرة اجتماعيّة، فتغوص تحليلاً في أسبابه و مصادر شرعيته الاجتماعيّة. أما النّظرية السّياسيّة فهي معيارية بتركيبها، تبذل قصارى جهدها في كشف أشكال العنف وتنميطه معيارياً داخل أنماط السلطة والحكم والفعل السياسي. وإذا ما نظرنا إلى كلا النّظريتين سنجد مشهداً وهميّاً من التكامل في مسألة الشرعيّة، فالنّظريات الفيزيولوجيّة والنّفس اجتماعيّة تبحث عن شرعيّة السّلوك العنيف في أفعال ومعتقدات الجهات الفاعلة اجتماعيًّا، في حين أنّ النّظرية السّياسيّة تشكل مجالًا اختباريًّا معياريًّا للشّرعيّة ذاتها في المظهر السياسي. ولكن كيف يمكن للمعايير السّياسيّة أن تؤطر أفعالًا اجتماعيّة، ونفسيّة تفوقها تفاعلًا وتجليًّا وتدفع إلى تعديلها باستمرار؟ وهل هي تعكس ما يماثلها في الحقوق والمشاركة، أم أنّها تتخطاه نحو استراتيجيّات التّغلغل في المجتمعات والتّحكّم ببنيتها؟ إذن، وبموجب الشّكوك البحثيّة المُضمَرة فكلمّا تنامت الحركات العنيفة في الميدان الاجتماعي، بات لزامًا تفحص مستوى جنوحها نحو الممارسة السّياسيّة السلطويّة وفهم الدّوافع والنّزعات السائرة بها إلى صيرورتها النّظريّة.
العنف في النّظريات وحدة المفهوم وتعدد المظاهر
ظهر العنف منذ فجر التّاريخ، وهو ليس أمرًا طارئًا على السّلوك الإنسانيّ. فتاريخ الإنسانيّة حافل بالحروب والغزوات إذ تمت مواجهة العنف بعنف أشدّ فغلبت روح السّيطرة والاستبداد والهيمنة على عقليّة الأطراف المتنازعة في خلافاتها. وبهذه الصّورة عاشت الشّعوب دوّامة من الخوف والقلق الدّائم مخافة أن يتزعزع أمنها واستقرارها([2])، لقد انتقل الإنسان عبر التّاريخ من الحالة البدائيّة التي تطغى فيها الأنانيّة إلى الحالة المدنيّة. فحاول تأسيس نمط حياته على مبادئ أخلاقيّة وعقليّة تميّزه عن الحيوان إلّا أنّ العنف بقي حاضرًا في حياته وطوّر وسائله وأدواته بتطور العلم والتّقنيات([3]). وتنبض النّظريّات المتعاقبة في تقديم التّفسيرات المعقّدة لظاهرة العنف بأبعادها المتداخلة بعواملها النّفسيّة والاجتماعيّة المؤثّرة بشكل كبير على الأفراد والمجتمعات، فتفاوتت أشكال العنف بحسب هذه النّظريات بين العنف الجسدي، اللفظي والعاطفي. وقد تؤدّي تداعيات ممارسة هذه الأشكال العنيفة إلى آثار مدّمرة على الصّحة النّفسيّة والجسديّة للأفراد، فضلاً عن إحداث تغيّرات سلبيّة على المستوىيين الاجتماعي والاقتصادي([4])، لذلك يعدّ فهم الأسباب الجذريّة لهذه الظّاهرة أمرًا ضروريًا لتطوير استراتيجيّات فعّالة للحد منها. يؤكّد فريمان Freeman عبر نظرية السّلوك العدواني Aggression Theory أنّ العدوانيّة هي استجابة طبيعيّة للتّهديدات، أو للإحباطات الّتي يواجهها الفرد، وأنّ الأفراد يتعلّمون السّلوك العدواني من خلال التّفاعلات مع بيئاتهم الاجتماعيّة، أو من خلال المواقف الّتي تعزّز من الشّعور بالإحباط ذلك أنّ الشّعور بالفشل، والإخفاق يضع الإنسان بموقع ضعيف يحرّك لديه أواليّات الدّفاع، وهذا نمط من الاستجابة يحدث من دون مستوى الوعي والإدراك. يكتسب السّلوك العدواني أحيانًا بحسب “ألبرت باندورا”([5]) Albert Pandora عبر الملاحظة، والتّقليد كما أوضح في نظريّة التّعلم الاجتماعي Social Learning Theory فأنماط العنف التي يُروَّج لها عبر وسائل التّواصل، والألعاب الالكترونيّة تخلق لدى الفرد حالة من الاستغراق بواقع افتراضيّ عنيف يكسر حاجز التّصرف بعدوانيّة ويجعل من العنف أمراً مستساغ ذاتيًّا. يساهم التّوتر بين الطّبقات الاجتماعيّة والتّفاوت الاقتصادي في تفاقم العنف في المجتمعات، وينسجم ذلك مع ما طرحته نظرية الصّراع الاجتماعي Social Conflict Theory: إذ أكّد “روبرت ميرتون([6])” Robert Merton أنّ موجات العنف قد تكون استجابة للتّوتر النّاتج عن الفروق الاجتماعيّة والاقتصاديّة. عندما تشعر طبقة من الأفراد بالتهميش، أو أنّها عاجزة عن تحقيق أهدافها كما يليق من خلال الوسائل التّقليدية المشروعة يزداد شعورها بالضّغط النّفسي والغبن، فتلجأ إلى التّصرف بشكل عنيف كرد فعل للضغوط الاجتماعيّة المتزايدة. إنّ أفراد الطبقة المهمشة يعانون من مستويات عاليّة من التّوتر وهم أكثر عُرضة لأن يصبحوا عصبيين ويميلون إلى العنف والعدوان. وبحسب ميرتون يتكيّف أفراد المجتمع مع التّوتّر عبر أحد الأساليب الخمسة الآتية: أوّلًا: الإمتثاليّة حيث يعمل الفرد على تحقيق الأهداف المسموح بها ثقافياً عبر الأساليب المشروعة اجتماعيًّا. ثانيًا: الابتداعيّة فيعمل الفرد على تحقيق الأهداف المشروعة عبر أساليب غير مشروعة. ثالثًا: الطقوسيّة وبهذه الحالة يرفض الفرد الأهداف ويعمل وفق الاساليب المشروعة. رابعًا: الانسحابيّة وبهذه الحالة تُرفض الأهداف والأساليب على حدٍّ سواء، واستبدالها بمجموعة من الأهداف والأساليب الجديدة. كما تُبرز الدّراسات العلميّة دور العوامل البيولوجية التي تفسّر العنف كنتيجة لتفاعلات غير متوازنة في نظام كيمياء الدّماغ، خصوصًا تلك المتعلقة بالنّاقلات العصبيّة مثل “السيروتونين” و”الدوبامين”. ولقد أوضح الباحث “فيرنون كيلر” Vernon R. K. Keller في دراساته أنّ نقص السيروتونين قد يؤدّي إلى سلوكيٍّات عدوانيّة عنيفة تضعف القدرة على ضبط الانفعالات والتّحكّم بالمواقف الّتي تحمل مثيرات قويّة. ينتج العنف في بعض الحالات كردّ فعل ناتج عن التّنشئة العائليّة العنيفة، أو عن التّعرّض لمواقف اجتماعيّة مليئة بالتّوتر، والأفراد الّذين يتعرّضون لهذا النّوع من البيئات الاجتماعيّة، قد يتعلّمون أنّ التّصرف بعنف هو وسيلة للتّعامل مع المشاعر السّلبيّة ولا يوجد سبيل آخر أو بالحدّ الأدنى هو أقصر السّبل وأسرعها لتحقيق الأهداف. ومن زاوية التّحليل النّفسيّ العصبيّ قد تنشأ صراعات داخليّة في العقل الباطن، خاصّة في حالات الكبت أو الصراع بين الرّغبات المكبوتة والواقع. فوفقًا للنّظرية الفرويديّة، يتسبب الإحتكاك بين دوافع الفرد الدّاخليّة والواقع الخارجي في ظهور سلوكيّات عدوانيّة عنيفة كنتيجة لهذه الحالة الوجدانيّة. كما يرى “فرويد([7])” Freud أنّ مثل هذه الانفعالات الدّاخليّة، قد تتحول إلى عنف في حال عدم القدرة على حل هذه الصّراعات. يرتبط العنف باضطرابات الشّخصيّة Personality Disorders: فالأفراد الّذين يعانون من اضطرابات في الشّخصيّة مثل اضطراب الشّخصيّة الحديّة أو اضطراب الشّخصيّة المعاديّة للمجتمع Antisocial Personality Disorder يمكن أن يُظهروا سلوكيّات عدوانيّة عنيفة عند الشّعور بالخوف أو التّهديد. إنّ العنف في حالات مثل هذه يتفاقم بسرعة مفاجأة غير متوقّعة ويؤدّي إلى تصرفات دراماتيكية لا يمكن توقّعها، حيث يعاني الأفراد المصابون بهذه الاضطرابات بحسب الدّراسات التي تستند إلى الملاحظات السّريريّة، والتّحليل النّفسي من ضعف في التّحكم في الانفعالات وشدّة الشّعور بالتّهديد في المواقف التي يعتقدون أنّها تضرّ بهم([8]).
الدّينامية الاجتماعيّة للعنف
يؤدّي الاستبداد وضعف لغة الحوار واللجوء الى حلّ المشكلات بالفرض، والإلزام من الجهة التي تمتلك السّلطة والقوة الى سيادة لغة العنف، والغوغاء من دون احتساب وجهة نظر الأطراف المتنازعة. قد يعبّر العنف عن أزمة طارئة تؤثّر على الوعي الجمعي الذي يرى في العنف والبطش والاعتماد على القوة أسلوبًا تمهيديًّا يسبق أيّ عمليّة حوار أو تفاوض بمحاولة لإخضاع المجتمعات وكسر إرادتها وكي وعيها فتصبح أكثر قابليّة واستجابة لتقديم التّنازلات والمساومة على القضايا المركزيّة المحقّة، وتؤدّي الممارسات الأبويّة الفوقيّة وأنماط التّسلط التي تفرض الانصياع ولا تسمح بمناقشة الأفكار والرؤى السّياسيّة والفكريّة كما هو معروف عند بعض رجال الدين والفكر والثقافة إلى حالة من التململ والاستياء، يعبَّر عنها بسلوكيّات تتصادم مع قيم الانفتاح والدّيمقراطيّة([9]).
تفرض بعض الأعراف والتّقاليد الاجتماعيّة على الفرد أن يتبنّى موقفًا عنيفًا أحيانًا تجاه الآخر، فلا يستطيع الخروج على النّمط السّلوكي السّائد في محيطه الاجتماعي لا سيما في بعض القضايا التي تمس جوهر العادات والتّقاليد، فطبيعة التّوقعات الاجتماعيّة المترسّخة عبر تكرار الممارسات، وتبني النّتائج الصّادرة عنها مجتمعيًّا تسوّغ لممارسات تنافي العقل، والمنطق وتتعارض مع الفطرة الإنسانيّة. أحيانًا يشكل التّراث سلطة إرهابيّة تقمع أي مبادرة تجديديّة أو خطوة إصلاحيّة، ومن الوقائع التي تشجع على العنف، وتمهّد له غياب الخطاب الثقافيّ الذي يعمل وفق منظومة قيم جديدة لايساهم العنف في تشكيلها، وعدم تحرير مساحات كافيّة في العقل لممارسة قيم التّسامح ليعتاد الفرد على سلوك إجتماعيّ جديد خالٍ من العنف والتّحيزات المعرفيّة ونماذج السّلوك المتطرف التي تعقد إمكانيّة التعاقد الاجتماعي بما يضمن حقوق و مصالح جميع أفراد المجتمع ويرسخ أسس ومبادئ المواطنة. ولعل من الأسباب المؤدّية إلى السّلوكيّات المتطرفة، والأنانيّة الخاليّة من التّعقل والمجرّدة من الصفات الإنسانيّة هي الجهل بثقافة الآخر، ما يؤدّي إلى تبني موقفًا متطرفًا تجاهه فالنّاس أعداء ماجهلوا فعدم الاعتراف بالآخر والاستماع الى مختلف وجهات النّظر، وغياب المعرفة والاطلاع يسمح للشرائط المعرفيّة أن تعمل على تشكيل الأنماط التي تحرّض على العنف، وتختزل رؤيّة الأشياء والقضايا من منظور ذاتي متمحور حول الأنا ومنحاز إليها([10])، إنّ عدم قيام النّخب الفكريّة والثّقافيّة بدورها على مستوى تفكيك الخطاب الثّقافي القائم على العنف والتّهميش والهيمنة وضبط الخطاب التّحريضي عبر استنبات مفاهيم جديدة، والتّخلي عن مفاهيم أخرى، ترتبط بإيديولوجيّة تحرّض على العنف وتسّوغ استخدامه كالمقولات والمسلمات الدّينيّة والاجتماعيّة كل ذلك يدخل المجتمع في حلقة مفرغة من العنف والعنف المضاد([11]).
العنف في بعده النّفسيّ والاجتماعي
يغور العنف في الطبيعة البشريّة يخالطها، ويتلبس بها ويشير ” فرويد Freud” أنّ الإنسان كائن يختزل في أعماق ذاته الشّر، فالإنسان ميّال إلى إشباع حاجاته العدوانيّة على حساب بني جنسه، فعدوانيّة الإنسان الشّرسة قائمة بذاتها كاستجابة لإثارة تأتيها من الخارج، أو كوسيلة ضمن سياق الوصول الى هدف يكون من الممكن الوصول إليه بأساليب غير عنيفة فكلّما ضعفت القوّة الأخلاقيّة التي تحدُّ من هذه العدوانيّة صارت الظروف مؤاتية لكي تظهر بشكل تلقائي وتبرهن أنّ وراء الإنسان حيوان مفترس لا يقيم وزنًا لبني جنسه([12]). وهذه الطبيعة الحيوانيّة المتجذّرة في الإنسان تجعله يلجأ إلى العنف لحلّ النّزاعات والسّيطرة على الآخر. وللاستعاضة عن القوة العضليّة انبثق مفهوم الحقّ والقانون لضبط هذه الغريزة. فبعدما كان الحقّ حكرًا على شخص واحد يقهر به الآخرين صار ملك مجموعة من الضعفاء اتحدوا لمواجهة القوي، وقهره وهكذا يعدُّ الحقّ والقانون شريعة القوي([13]). يعدُّ “رينه جيرار”([14]) Rene Girard أنّ العنف يتولّد عن أمور أساسيّة ثلاث وهي تبدأ بتنافس الرّغبات الإنسانيّة مع ندرة موضوع الرّغبة، وثانيها المحاكاة في الرّغبات الإنسانيّة، ومعناه أنّ النّاس لا يرغبون بالشّيء لذاته بل لرغبة الآخرين به. وثالثًا الانتقام المؤجل كون للإنسان ذاكرة تخزن الهزيمة، فيتحين الفرصة للانتقام المؤجّل وكذلك تحدّث عن العنف المعدي الذي يمكن ان يؤدّي الى مذابح جماعيّة وينتشر كالعدوى بين النّاس([15]).
يرى جورج “بتاي”([16]) أنّ ممارسة العنف تفقد الإنسان الوعي بالنتائج المترتبة عن هذه الممارسة، فغريزة العنف استخدمت مختلف الأنماط، والمعارف بل كانت وما تزال تتوسل أحدث منتجات العلوم الفيزيائيّة كمرتكز لتطوير قدرتها على القتل والتّدمير، إنّ ما يسبق العنف أو يرافقه بأشكاله جميعها حالة من التّأزم والإنفعال والتّوتر ترافق الفعل، وأحيانًا يمارس العنف كرد فعل للثأر للنفس والكرامة، ويمارس المجرم العنف بشيء من اللامبالاة فتبدأ الحالة النّفسيّة المرافقة للعنف لديه بموجة محفزات شعوريّة، أو لاشعوريّة حول قضيّة ما ثمّ تتفاعل بتصورات وأحكام وقيم سابقة، أو فوريّة لتأزم الحالة وتتحول الى توتّر نفسيّ تصحبه موجة عصبيّة، تستولي على مشاعره وتقفز الى الخارج عبر حالات مختلفة كارتعاش الجسم أو توتر وحدّة الكلام وصدور ألفاظ جارحة، وقد ينتهي الإنسان الى قناعات متّسرعة في ظل التّأزم النّفسي([17]). يستجيب الإنسان لمشاعره أكثر وأسرع من استجابته لعقله، وذلك ما يمنع تحكمه باستجابته العنيفة على الرّغم من إرادته وقناعته بضرورة التّخلي عن العنف، يدرك الفرد الصّورة أو المركب الذي انتجته تصوراته المتراكمة عن ذاته وعلى أساسها يمارس دوره الاجتماعي ويتخذ مواقفه، أحيانًا تعكس ردة الفعل حجم الضرر النّفسي الذي لحق بالشّخص، ويمكن أن تنقلب الأوهام عن المستوى الثّقافي والمكانة الاجتماعيّة مع مرور الزّمن الى حقائق لا يطيق الفرد الاعتراف بخطئها فتأخذ الذّات بالتّضخم الى حدٍّ يفرض الشّخص لنفسه مواقع اجتماعيّة ومكانة علميّة مجرّدة وبعيدة من أيّ رصيد حقيقي، وقد تسبّب ذلك في وقوع كثير من أعمال العنف في المناطق التي تقطنها مجتمعات بدائيّة تعبّر فيها الأمور عن مستوى شخصياتهم وهندستها([18])، ويعتقد الممارس للعنف أنّه يمثل الشّرعيّة القانونيّة أو الدّينيّة ويتحرك ضمن هذه المساحة كما يعتقد أنّه على حقّ في متبنياته الفكريّة والعقديّة وأنّ الاخر باطل مطلقًا. ويعتقد البعض أنّ الإنسان الضّعيف هو صورة لغيره، ولا يتمكن من عيش ذاته ووجوده نظرًا لغياب القوة المطلوبة لتحقيق ذلك. ومن الأسباب النّفسيّة التي تساهم في انتشار العنف تعرض الأفراد لصدمات نفسيّة (Trauma) في مراحل مبكرة من حياتهم، ما قد يؤدّي إلى اختلالات في القدرة على التّحكم بالعواطف، وذلك يخلق بيئة مناسبة للعدوانية. تؤكد نظريّة “التّحليل النّفسي” التي قدمها سيغموند فرويد، أنّ النزاعات الدّاخليّة المكبوتة والاضطرابات النّفسيّة العصابيّة قد تؤدّي إلى تصرفات عنيفة. إضافة إلى ذلك، يمكن أن تساهم في تطوير سلوكيّات عدوانيّة. فأظهرت الأبحاث أنّ الأفراد الذين يعانون من اضطرابات مثل “اضطراب ما بعد الصّدمة” (PTSD) أو ” ثنائي القطب” قد يميلون إلى العنف كردّ فعل على مشاعر اليأس أو الألم النّفسي([19]).
تتداخل الأسباب النّفسيّة والاجتماعيّة للعنف بشكل معقّد، إذ يمكن أن يؤثّر الفقر والتّهميش الاجتماعي على الصّحة النّفسيّة للأفراد، ما يزيد من قابليتهم لتطوير سلوكيّات عدوانيّة. وفي المقابل، فإنّ الأفراد الذين يعانون من اضطرابات نفسيّة أو صدمات قد يصبحون أكثر حساسيّة للمحفزات الاجتماعيّة، ممّا يعزز احتمال رد فعلهم العنيف تجاه التوترات الاجتماعيّة([20]).
تشير الأبحاث إلى أنّ مستويات الفقر المرتفعة، وزيادة معدّلات البطالة قد تساهم بشكل كبير في ارتفاع معدلات العنف. عندما يشعر الأفراد بالحرمان من الفرص الاقتصاديّة أو الاجتماعيّة، قد يترسخ لديهم شعور بالغضب والاحتقان، ما قد يؤدّي إلى سلوكيّات عدوانيّة. إنّ التّمييز الاجتماعي العرقيّ، أضف إلى الضّغوط المرتبطة بالهُويّة الثّقافيّة أو الجنسيّة، يمكن أن تساهم في تكوين بيئة اجتماعيّة خصبة لنشوء العنف. قد تخلق هذه الضّغوط شعورًا بالعزلة والإحباط، ما يزيد من احتماليّة تصرّف الأفراد بشكل عدواني. يتعرّض الأطفال الذين ينشأون في بيئات عنيفة، سواء في المنزل أو في المجتمع، لسلوك عدواني متكرر في حياتهم وهو ما يعرف بـ “دورة العنف” وهو مفهوم يعكس كيف يمكن أن تنتقل السّلوكيّات العنيفة عبر الأجيال نتيجة للتّنشئة الاجتماعيّة السّيئة([21]).
العنف كما تدركه الجّماعات المتطرفة
تمارس الجماعات المتطرفة العنف التزامًا بأيديولوجيّات متطرفة تسعى إلى تحقيق أهداف سياسيّة، دينيّة، أو اجتماعيّة من خلال استخدام القوّة، والتّرهيب ضد جماعات معيّنة من النّاس أو مؤسسات تُعدُّ “العدو” أو “التهديد” وفاقًا لتّصورات تلك الجماعات المتطرفة. وتتنوع أشكال هذا العنف، بدءًا من الهجمات الإرهابيّة وصولًا إلى أعمال عنف مجتمعيّة أو صراعات مسلحة([22]). لا يتمحور العنف في هذا السّياق فقط حول الاستخدام المادي للقوة، بل يشمل أيضًا الأبعاد النّفسيّة، ويمكن أن يرتبط هذا العنف بالإيمان القوي لدى الأفراد الذين ينتمون إلى هذه الجماعات أنّهم يقاتلون من أجل “قضيّة عادلة” أو “مقدسة”، ما يجعل العنف في نظرهم مبررًا في سعيهم لتحقيق أهدافهم، سواء أكانت هذه الأهداف دينيّة أو سياسيّة([23]). ويُعدُّ العنف الممارس من العصبيّات من الأمثلة البيّنة على عنف الجماعات، والعصبيّة تشكّل منظومة تفكير وسلوك سياسيّ تساعد الأفراد على البقاء لذلك هي منظومة دفاعيّة تربطها روابط دم بدأت بالعشّيرة ثم انتقلت الى القبيلة ولا تزال تختزن في الذاكرة الجمعيّة، وتقوم العصبيّة على مبدأ أوحد هو الغلب مقابل الحريّة والعدالة في الدولة المدنية الحديثة ([24]).
ويقلب هذا النّوع من العنف الدّلالة والمعنى لدى شباب الظل المهمّش من الناحيّة الاجتماعيّة، ويعطيهم شيء من الاعتزاز الذّاتي المفقود لديهم ويقبلون على دور الأداة الذي يملأ كيانهم فتتحرك الجماعات الإرهابيّة تحت شعار المقدس. وهنا يصبح لديهم شعور من القداسة كونهم يدافعون عن شيء مقدس، وأخطر ما بالمقدس امتلاكه الحقيقة المطلقة التي لا تقبل النّقاش فهو اليقين وعين الصّواب. وقد يؤدي ذلك الى شيء من تضخم الأنا لديهم([25]) ما قد يجرد الدين كمجموعة من الشّعائر، والعقائد من دوره ومن مظهره الاجتماعي الاصلاحيّ الراقيّ، ففي معظم الأحيان يُخلط بين الدّين والتّدين الذي يعّبر عن علاقة فرديّة بالعقائد، والشّعائر لا تخلو من المشاعر( خشية، ذنب..) وتوضح بعض الدّراسات العلاقة بين نمط التدين والسّلوك العدواني مثل دراسة ” بكداش” إذ حدّدت ثلاثة أنماط للتدين وهي النّمط العقائدي، الشّعائري، والوجداني وأشارت النّتائج إلى وجود ارتباط قوي بين النّمط العائدي، والميل الى عدم التّسامح الذي يشير الى الميل، والاتجاه الى عدم قبول النّسبيّة في خطأ ما يعرف أنّه صحيح وصحة ما يعتقد أنّه خطأ لدى الآخر. يعفي المقدس الفرد من المساءلة الذاتيّة، والشّعور بالذّنب كونه يقوم بعمل نبيل، ويزيل كل الكوابت والحواجز امام انفجار العدوانيّة دون روادع او حدود فيتفنن في العدوانيّة ويعتبرالتّمثيل بالضّحايا اسلوب وطريقة لإثبات الذّات([26]). تتصف العصبيّة بالمرونة والقدرة على التّلون بلون المجتمع الموجودة به، وتتآلف مع الظروف وتقوم على افتراس بعضها البعض بالاستقواء بالغلب العددي والعسكري على العصبيات الأخرى، هناك عصبيات قوميّة دينيّة ومذهبيّة، ويمكن أن يتحوّل الدّين الى مجموعة عصبيات لذلك فإنّ محو العصبيات يأتي قبل محو الأميّة. فدولة العصبيّة لم تستطع أن تقدّم سوى حريات منقوصة، وعدالات غير متساوية وقوانين منحازة وفئوية فبمنطق العصبيات يوجد فئتين نحن وهم وكل من ليس منا فهو عدونًا([27]).
فغالبًا ما تروّج الجماعات المتطرفة لأيديولوجيّات متشددة تدعو إلى العنف كوسيلة لتحقيق التّغيير أيّ فرض التغيير بالقوّة في بعض الحالات، يعتقد أعضاء هذه الجماعات أنّهم ينفذون إرادة إلهيّة أو يدافعون عن “الإيمان الصحيح” ضد “العدو” الذي يجب القضاء عليه هذه الأيديولوجيات تجعل العنف أداة مشروعة، قد يستخدم الدين في تبرير العنف، حيث يُعتبر القتال ضد “الكفار” أو “الفساد” أمرًا واجبًا دينيًا([28]). تستخدم بعض الجماعات المتطرفة العنف لتحقيق أهداف سياسية محددة، مثل الإطاحة بالحكومات، إلغاء الأنظمة السّياسيّة القائمة، أو تحقيق استقلاليّة للجموع الإثنيّة أو الدّينيّة. في هذا السياق، يُعدُّ العنف وسيلة لتحقيق التّغيير السياسي أو الاجتماعي، خاصة في الحالات التي تُعتبر فيها الوسائل السلميّة غير فعّالة أو مُستبعدة([29]).
يؤدّي الشّعور بالعزلة أو التّهميش الاجتماعي، والإقصاء السياسي إلى الانضمام للجماعات المتطرفة فغالبًا ما يواجه هؤلاء الأفراد تجربة عدم الاعتراف بهم، ما يدفعهم إلى السّعي للحصول على هويّة قويّة من خلال الانضمام إلى مجموعة تعزز لديهم شعورًا بالقوة والانتماء. هناك أيضًا دور كبير للإنفعالات النّفسيّة مثل الإحباط والغضب النّاتج عن العنف الاجتماعي، أو الاقتصادي الذي قد يؤدي إلى رؤية العنف كوسيلة للخلاص أو للانتقام([30]) ، تظهر العصبيّة في سياقات متنوعة، سواء أكانت عرقيّة، دينيّة، ثقافيّة، أو حتى سياسيّة، وتُعبِّر عن الانتماء القوي إلى جماعة معيّنة والتّماهي مع قيمها ومعتقداتها. في هذا السّياق، يُعدُّ العنف وسيلة مشروعة أو ضروريّة لحماية هذه الهُويّة من تهديدات خارجيّة أو داخليّة، ما يؤدي إلى تبني العنف كأداة للتفوق أو الانتصار على الآخرين. يعدُّ الشّعور بالتّهديد تجاه الهُويّة الجماعيّة أحد الأسباب الرئيسة التي تساهم في العنف الملازم للعصبيّات، فعندما يشعر الأفراد أو الجماعات أن هُويّتهم مهددة من جماعات أخرى أو ثقافات مختلفة، يمكن أن ينشأ دافع قوي لاستخدام العنف كوسيلة للدفاع عن هذه الهُويّة. قد يكون هذا التّهديد حقيقيًا أو متخيلًا، ولكنّه يُحفِّز الجماعات على الرّد بالعنف([31]). تسعى الجماعات المتعصبة إلى فرض التّفوق على الآخرين باستخدام العنف كوسيلة لتحقيق السّيطرة على الأرض أو السّكان أو الموارد، وهذا العنف قد يتضمن أعمال قتل جماعي، تطهير عرقي، أو سياسات التمييز ضد الجماعات والآخر.
قد يتخذ العنف شكل حروب أهليّة أو صراعات مسلحة بين جماعات متعصبة، في هذه الحالات، تتوحد الجماعة بناءً على العصبيّة المشتركة، وتجد في العنف وسيلة لتأكيد هويتها وتعزيز روح الجماعة ضد “العدو” المزعوم. ويأتي هذا العنف مدفوعًا بالرّغبة في الانتقام لظلم تاريخي أو اجتماعي. تبرر العصبيات العنف باستخدام مبررات الانتقام، إذ يُعدُّ قتل أو إيذاء الآخر وسيلة للانتقام من المظالم أو الأفعال التي ارتكبت ضد الجماعة. يقوم الأفراد أو الجماعات المتطرفة في بعض الحالات بتبرير استخدام العنف كرد فعل على ما يرونه ظلمًا أو قمعًا. هذا النّوع من العنف يُنظر إليه على أنّه “ثورة” أو “نضال” ضد الأنظمة التي تُعدُّ فاسدة أو ظالمة إنّ الجماعات المتطرفة في هذه الحالات تُظهر نفسها كـ “محاربين من أجل الحرية”.([32])
أشكال العنف الممارس من الجماعات المتطرفة
تشمل أشكال العنف التي تمارسها الجماعات المتطرفة تنفيذ هجمات إرهابيّة تستهدف المدنيين أو المنشآت الحساسة بهدف نشر الرعب، والضغط على الحكومات أو الشّعوب بالإضافة الى التفجيرات الانتحاريّة، الهجمات المسلحة على الأماكن العامة أو المواقع الحكوميّة .مثل هذه الهجمات غالبًا ما تهدف إلى تحقيق أهداف سياسيّة أو أيديولوجيّة مثل إسقاط أنظمة سياسيّة، أو إحداث اضطرابات اجتماعيّة .إنّ العنف الموجه ضد جماعات معينة بناءً على الدّين أو العرق هو سمة من سمات الجماعات المتطرفة. هذا العنف قد يظهر في شكل تطهير عرقي أو ديني في محاولة لفرض سيطرة جماعة متطرفة أو إيديولوجيّة معيّنة([33]). في بعض الحالات، تقوم الجماعات المتطرفة بتشكيل ميليشيات مسلحة تقاتل ضد الحكومات أو القوات الأجنبيّة، كما هو الحال في بعض الحروب الأهليّة التي تشهدها مناطق من العالم. هذه الجماعات غالبًا ما تتبنى العنف في إطار مساعيها لتحقيق أهداف سياسية. وقد لا يقتصر العنف المتطرف على الأفعال المادية فقط؛ فالتّرويج للعنف عبر وسائل الإعلام أو الشّبكات الاجتماعيّة قد يكون له تأثير بعيد المدى. تروج الجماعات المتطرفة لأفكارها من خلال بث مقاطع الفيديو التي تظهر فيها أعمال العنف أو التحريض على أعمال إرهابيّة، ما يزيد من الانقسام الاجتماعي ويشجع على التّمرد([34]).
النتائج المترتبة على العنف المتطرف
يعاني الأفراد الذين يتعرضون للعنف المتطرف من صدمات نفسية شديدة، والاكتئاب. بالإضافة إلى ذلك، قد تكون هناك آثار دائمة على صحتهم العقلية والجسدية، أضف إلى فقدان حياتهم أو أفراد عائلاتهم([35]). يؤدي العنف المتطرف إلى تعزيز الانقسامات الاجتماعيّة والعرقيّة والدّينيّة، ما يزيد من حدة التّوترات في المجتمع. يؤدّي إلى تقويض الاستقرار السياسي، وتدمير البنية التّحتية، وزيادة القمع والتّشدد من الحكومات في محاولة للتّصدي لهذا العنف، ويمكن أن يؤدّي إلى تشويه الهّويات الثّقافيّة والمجتمعيّة، ويسهم في تصاعد الكراهية، وزيادة الفجوات بين مختلف الأطياف الاجتماعيّة وهذا يضعف استقرار المجتمعات، ويؤدّي إلى المزيد من الّتوترات والصّراعات الدّائمة. يؤدّي العنف الملازم للعصبيات إلى تفكك المجتمعات واستدامة النّزاعات الطّائفيّة والعرقيّة إنّ الجماعات المتعصبة التي تمارس العنف يمكن أن تهدّد الأمن السياسيّ للدول، وتقوض القانون والنّظام، وتؤدي إلى تفشي النزاعات الطائفيّة والعرقيّة. من هنا، يصبح محاربة هذه العصبيات ضرورة لحماية الاستقرار الوطني([36]).
يدمر العنف المتطرف الممتلكات والبنية التحتيّة الاقتصاديّة، ما يعيق النّمو والتّنمية الاقتصاديّة في المناطق المتأثرة. كما أنّ تكاليف الأمن والعمليّات العسكريّة لمكافحة الجماعات المتطرفة تؤثّر سلبًا على الاقتصاد الوطني. مواجهة العنف على مستوى النتائج والأسباب ينبغي على المجتمعات في كل زمان ومكان أن تأخذ مسافة من الأفكار المنتشرة، والمعتقدات السّائدة المروجة للعنف وانطلاقًا من فهم فلسفة ديكارت المبنيّة على الشّك فلا بد للإنسان المتنور أن يميز بين ما يمتلكه من أفكار، وما هو حقيقي وواقعيّ فمن أخطر الأمور أن تتلبس الأفكار والاراء المتداولة بثوب الحقيقة دون أي مجهود فكريّ ومنهجيّ على الاطلاق، ويؤكّد “باشلار([37])” Bechlard أنّ المعرفة الحقيقيّة رهن بالمعرفة العلميّة وللوصول إليها لا بدّ من التّخلي عن ما يسمّى الآراء أولًا. يتحدث كانط عن مفهوم الإكتفاء بمعنى الإقتناع والذي يكون إمّا ذاتيّ، وإمّا موضوعيّ ويفتقد الرأي للاكتفائين الذاتي والموضوعي، بينما مفهوم الإيمان فيه الاكتفاء الذّاتي، فالإنسان يكون مقتنع بأفكاره ومعتقداته ولديه يقين تام أنّها صحيحة لكن ذلك غير موضوعي وغير مقنع بالنسبة إلى الآخرين فكل اعتقاد فيه اكتفاء ذاتيّ، ولكن ليس فيه اكتفاء (اقتناع) موضوعيّ يقول ليبنيز صحيح ان الرأي ليس حقيقة علميّة لكن يبقى احتمال، واحتمال أن يبقى حقيقة يوماً ما، فالحقائق العلميّة الآنيّة كانت آراء في يوم من الأيام وبحسب “باسكال([38])” Pascal ليس العقل السّبيل الوحيد لإدراك الحقيقة فيمكن أن تدرك الحقائق بالشّعور، فللقلب مبرراته التي لا يدركها العقل وبغض النظر عن المسوغات التي تقدّم مجافاة للحقيقة كتبرير للعنف. فإنّ الحقيقة مطلوبة لذاتها لأنّها أساس الاخلاق فالكذب- الخداع- المجاملات- والنّفاق كلها ترتبط باخفاء الحقيقة فبعض الناس يدخلون السجون لعدم ظهور الحقيقة، فالدّفاع عن الحقيقة يعني الدّفاع عن المجتمع الأخلاقي. يقاتل ويدافع الإنسان عن عاداته كما لو أنّه يدافع عن ذاته، فهو متمسك بمعرفته السّابقة ويدافع عنها بشراسة فالشّرائط المعرفيّة تقطع الطريق على بناء معرفة جديدة، كما أنّ المعرفة الجديدة تحتاج الى قطيعة معرفيّة تشكل حدًا فاصلًا بين ماهو ماثل، ويوّلد إشكالات وما يطمح إليه المجتمع، ويشكل أسلوبًا جامعًا يمكّن من تعايش أطياف المجتمع جنبًا الى جنب. غالبًا ما يصدر العنف عن قناعات فكريّة، وعقديّة تشرعن ممارساته التي قد تصل إلى حد الإرهاب في أحيان كثيرة وليس بالضّرورة أن تكون تلك القناعات، والمسلمات خاضعة لمنطق العقل بل إنّ بصمات الخطاب الايديولوجي أكثر تجليًّا ووضوحًا في العقل الإرهابي، إنّ ممارسة العنف واستخدام القوة في الإسلام تجري وفق ضوابط خاصّة، وتطوقها خطوط حمراء ومساحات محرّمة واسعة، فهي قوة للدفاع عن النّفس والحقوق المشروعة لا يسمح معها بالاعتداءعلى العزل، والأبرياء من النّاس أو الإطاحة بالممتلكات العامة إذا يحتاج العنف الى مبرر شرعي.
التّوظيف السياسي للعنف
يعطي المجتمع الغربي للعقل والحوار قيمة مطلقة في حل القضايا التي تهم المجتمع، والدّولة قياسًا على الأجواء السائدة في بلاد الغرب، ولا يتفهم الضرورات التي تلجأ فيها الشّعوب الى القوة كالاحتلال والظّلم والاضطهاد بفعل ما يعيشه هذا الغرب من تضليل إعلاميّ، ولا يدرك عدم حياديّة الهيمنة الغربيّة تجاه الآخر، كما أنّ التّقدم الهائل في مجال العلم والتّكنولوجيا إضافة الى دعاوى الديموقراطيّة، وحقوق الإنسان والإعلام المتطور يشفع لهذه الدول المتطورة مادياً وحضارياً وليس ثقافياً في تناسي ما تقوم به من عنف وما تقترفه بحق الإنسانيّة جمعاء فهم يمارسون حقّ القوة بمعزل عن قوة الحق في كل مايخدم مصالحهم([39])، ويفرض سطوتهم ونفوذهم على مقدرات وثروات الشّعوب النّامية باعتماد مخططات تستهدف قيم هذه المجتمعات، وأسسها الحضاريّة ونزع الطّابع الإنساني والأخلاقيّ عنها. تعتمد بعض الحكومات الغربيّة في سياستها الخارجيّة مع العالم الثالث سياسة تختلف في أنماطها وسياقاتها عن السّياسة التي تنتهجها مع دول، وشعوب ترتبط معها أيديولوجيًّا أو اقتصاديًّا أوقوميًّا، وهذا اللون من السّياسات غير المتوازنة لا تحكمها مبادئ بقدر خضوعها للمصالح الأيديولوجيّة والاقتصاديّة، وقد يتحوّل العنف الى سلسلة من الأعمال الإرهابيّة تتخذ سلسلة غير محددة من التّمظهرات (تفجير – عمليات سطو…) تشوه المعالم الإنسانيّة والاخلاقيّة، والسّلوكية لفئة وشريحة محددة من المجتمع. أحيانًا يسود العنف والعنف المضاد سلوك أفراد شريحة من الناس، ولفهم أسباب العنف يجب مقاربة الأسئلة الممنوعة، واستنطاقها لا مجرد الدوران حولها ومحاولة الإجابة عليها في سياقها النّفسي والاجتماعي، والفلسفي في بعض الأحيان حتى يُقبض على الموضوع ما أمكن([40]).
يقول ماكس فيبر Max Weber إنّ الدّولة تحتقر إيقاع العنف الشرعيّ بينما يرى هوبّس Hobbs أنّ الإنسان أنانيّ أوجد الدّولة ليحمي نفسه من العنف، يُعدُّ عنف الدّولة من الأخطار التي عانت منها الشّعوب ولا تزال الدّولة ضرورة لايمكن الاستغناء عنها، وأنّه مركز السّلطة والقوّة والقرار وبحسب أرسطو لا يمكن الإستغناء عن الدولة، ويؤدّي عنف الدولة الى تخلف مجتماعاتها ثقافيًّا وحضاريًّا، وينغرس العنف عميقًا في لاوعي الشّعب بشكل يقضي فيه على خيارات تسوية الخلافات والقضايا المطروحة، ويحصرها في أسلوب واحد هو العنف كما تخلق السلطة من الأفراد كائنات عنيفة، ويصبح التّخلي عن العنف أمر يصعّب على العودة الى الحوار([41]).
الخاتمة
العنف الملازم للعصبيات هو ظاهرة معقدة ناتجة عن تفاعل بين عوامل نفسيّة واجتماعيّة، إذ تحفّز العصبيّة الجماعيّة الأفراد أو الجماعات على استخدام العنف كوسيلة للدفاع عن هويتهم أو فرض سلطتهم. يمكن أن يؤدي هذا العنف إلى عواقب وخيمة على الأفراد والمجتمعات، ويسهم في تصاعد الانقسامات الاجتماعيّة والسّياسيّة. ومعالجة هذه الظاهرة يتطلب فهمًا عميقًا للأسباب الكامنة وراء العصبية والبحث عن حلول اجتماعيّة وسياسية لتقليل تأثيراتها
قد يأتي العنف كردّ فعل على موضوع معين ويجيب كارل ماركس عن ذلك باعتبار العنف ليس غريزة في الإنسان بل ظهور الملكية الخاصة التي ولدت انقسام في الطبقات الاجتماعيّة واتخذت عبر التّاريخ اشكالا تتلاءم مع النظام الاقتصادي السائد فالعنف اخذ شكل صراع طبقي ادى الى تغيير البنية الاجتماعيّة وكان الصراع عبر التّاريخ بين طبقة مستغلة واخرى مستغلة وكانت الملكية الخاصة سبب للعنف وإذا انتفت سينتفي العنف، يقول علماء الاجتماع ان الإنسان العنيف هو إنسان خائف.
إنّ الخوف الفردي على الهُويّة الدّينيّة نابع من عدم تمكن الدّولة من دمج الهُويّات الفرديّة في هويّة وطنيّة جامعة. عندما يغيب دور الدولة ينتقل الى حلقة أضعف مثل القبيلة، والعشيرة التي تمارس العنف بدل الدّولة لتوفير الأمن لأفراد الدّولة يتحدث هيكل عن المنطق في التّاريخ أي الترابط بين أحداث الماضي، والحاضر فالأمور بحسبه تسير وفق ضرورات وقوانين تسمى قوانين الجدل ثم عمل كارل ماركس Karl Marx على تطوير هذه القوانين وهي 3 القانون الأول قانون صراع الأضداد والقانون الثاني قانون تحول الكم الى كيف والقانون الثالث قانون نفي النفي. ينشأ عن الصراع حركة وطاقة وينتهي الأمر بالصراعات الى احداث تحولات.
الهوامش
- أنظر ماجد الغرباوي في كتابه تحديات العنف الفصل الاول (ص7 )
- أنظرسليمان، د. سمير، الصّراع الحضاري والعلاقات الدولية، 2000 م، دار الحق ، بيروت، ص 32.
- See Daniel, E. Valentine. 1996. Charred Lullabies: Chapter in an Anthropology of Violence.
- عالم نفس كندي، حاصل على قلادة العلوم الوطنيّة في مجال العلوم السّلوكيّة
- عالم إجتماع أمريكي (1910- 2003).
- مؤسس علم النفس التحليلي، وهو نمساوي من أصل يهودي (1856-1939
- See Bousield, Derek, and Jonathan Culpeper. 2008. (eds.) Special Issue 4/2. Journal of Politeness
- شريعتي، د. علي، إسلام شناسي (جامعة مشهد)، (بالفارسيّة)، ج1، ص28
- أنظر حمودي، عبدلله، إضاءة انتروبولوجيّة في حوار معه ، في العدد 55 من مجلة فكر ونقد، المغربيّة.
- انظر مصدر سابق
- أنظر فرويد، سيغموند، سيكولوجية العدوان، ترجمة عبدالكريم ناصيف، 1986، دار منارات للنشر، عمان ص 86.
- أنظر ماجد الغرباوي في كتابه تحديات العنف مصدر سابق ص73
- ناقد، وأديباً، وفيلسوف، وأستاذاً في جامعة جونز هوبكينز
- See Kohlberg, L. (1981). Essays on moral development: Vol. 1 , the philosophy of moral development. New York: Harper and Row
- شخصيّة أدبيّة وفكريّة فرنسيّة (1897- 1962)
- المصدر نفسه
- أنظر حمودي، عبدلله، إضاءة انتروبولوجيّة
- أنظر قطب، خليل، سيكولوجية العدوان، مكتبة الشباب، القاهرة، ص 115
- المصدر ذاته، ص116
- أنظر ماجد الغرباوي في كتابه تحديات العنف الفصل الاول ص142
- حنفي، د. حسن، الحركات الدينية المعاصرة، الكتاب الخامس ضمن منظومة الكتاب والدّولة ، مكتبة مدبولي، ص 108.
- أنظر حنفي، د. حسن، الحركات الدينية المعاصرة، مصدر سابق ص 110.
- أنظر حجازي، مصطفى، التّخلف الاجتماعي مدخل الى سيكولوجية الإنسان المقهور، 2005، المركز الثقافي العربي، المغرب، ص64
- المصدر نفسه
- أنظر الحاج، عزيز، بإسم الله يقتتلون، 2006، موقع إيلاف الالكتروني
- أنظر حجازي، مصطفى، التّخلف الاجتماعي مدخل الى سيكولوجية الإنسان المقهور، مصدر سابق، ص 67.
- أنظر الحاج، عزيز، بإسم الله يقتتلون مصدر سابق
- أنظر سليمان، د. سمير، الصّراع الحضاري والعلاقات الدولية مصدر سابق ص 122.
- أنظر لال، زكريا، العنف في عالم متغير،٢٠٠٧: مكتبة الملك فهد، الرياض، ص 97 .
- المصدر نفسه
- أنظر ماجد الغرباوي في كتابه تحديات العنف ، مصدر سابق، ص178
- أنظر للكاتب التسامح ومنابع اللاتسامح فرض التّعايش بين الاديان والثقافات، 2006 ، مركز دراسات فلسفة الدين ، بغداد، ص 83.
- المصدر نفسه ص 84 .
- أنظر ماجد الغرباوي في كتابه تحديات العنف ، مصدر سابق، ص182.
- أنظر حجازي، مصطفى، التّخلف الاجتماعي مدخل الى سيكولوجية الإنسان المقهور، مصدر سابق، ص 82.
- أنظر سليمان، د. سمير، الصّراع الحضاري والعلاقات الدولية، مصدر سابق ص 63.
- المصدر نفسه، ص 65 .
- أنظر سليمان، د. سمير، الصّراع الحضاري والعلاقات الدولية مصدر سابق ص 116
المراجع العربيّة
الدّراسات والمقالات
- الحاج، عزيز. (2006). باسم الله يقاتلون، موقع إيلاف الكتروني.
- حمودي، عبدلله. (2015). إضاءة انتروبولوجية، مجلة فكر ونقد، العدد 55 ، ص: 69 -89 .
- شريعتي، علي. (1979). إسلام شناسي، الجزء الأول، ص: 28
الكتب
- حجازي، مصطفى. (2005). التخلف افجتماعي مدخل غلى سيكولوجيّة الإنسان المقهور، المغرب: المركز الثقافي العربي، ص64 .
- حنفي، حسن. (2003 ). الحركات الدّينيّة المعاصرة ، مصر: دار السّاقي، الجزء السّادس.
- الغرباوي، ماجد.(2009). تحدّيات العنف، لبنان: دار المعارف للمطبوعات
- سليمان، سمير. (2000). الصراع الحضاري والعلاقات الدوليّة، بيروت ، دار الحق.
- فرويد، سيغموند.(1986). سيكولوجية العدوان، عمان: دار منارات، ص: 86.
- قطب، خليل. (2008). سيكولوجية العدوان، القاهرة: مكتبة الشّباب، ص: 115.
10-لال، زكريا. (2007). العنف في عالم متغير ، الرياض: مكتبة الملك فهد.
المراجع الأجنبيّة
- Ahmed, Sara. 2004. he Cultural Politics of Emotion. Edinburgh: Edinburgh University Press.
- Anchimbe, Eric, and Richard Janney. 2011. “Postcolonial Pragmatics: An Introduction.” Journal
of Pragmatic
- Ariel, Mira. 2010. Deining Pragmatics. Cambridge: Cambridge University Press.
doi: 10.1017
Books
- James Gilligan. (1997) . Violence: Reflections on a National Epidemicو Vintage Books.
- Randall Collins.(2008). Violence: A Micro-sociological Theory
Princeton University Press
- Adrian Rain.(2013). The Anatomy of Violence: The Biological Roots of Crime , Pantheon.
- Hannah Arendt.(1970). On Violence, Brace & World
[1] – طالب دكتورة في المعهد العالي للدكتوراه في الجامعة اللبنانيّة الآداب والعلوم الإنسانيّة والاجتماعيّة – قسم علم النفس.
PhD student at the Higher Institute of Doctorate at the Lebanese University – Department of PsychologyKassemtal1@gmail.com E-mail:
[37]– فيلسوف فرنسي قدّ الكثير من الأفكار في مجال الابستمولوجيا
[38]– فيزيائي ورياضي وفيلسوف (1623-1662) اشتهر بتجاربه على السّوائل .