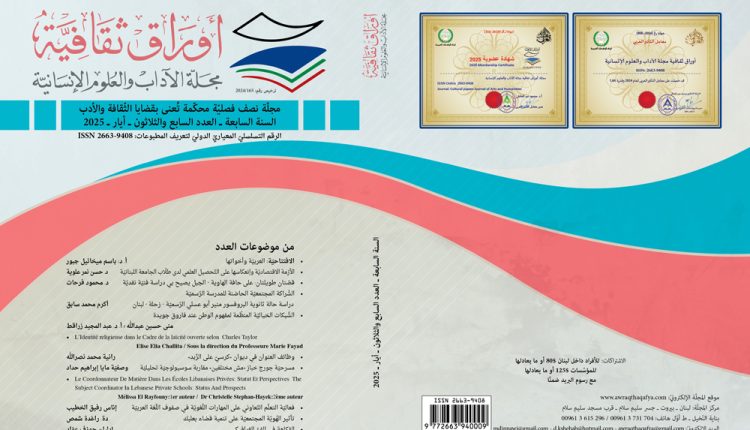عنوان البحث: قصّتان طويلتان: على حافة الهاوية – الجبل يصيح بي دراسة فنيّة نقديّة
اسم الكاتب: د. محمود فرحات
تاريخ النشر: 2025/05/13
اسم المجلة: مجلة أوراق ثقافية
عدد المجلة: 37
تحميل البحث بصيغة PDFADOI: https://aif-doi.org/awraq/013720
قصّتان طويلتان: على حافة الهاوية – الجبل يصيح بي
دراسة فنيّة نقديّة
Two long stories: On the Edge of the Abyss – The Mountain Shouts to Me
A critical art study
Dr. Mahmoud Farhat د. محمود فرحات([1] )
تاريخ الإرسال:28-4-2025 تاريخ القبول:10-5-2025
الملخّص turnitin:4%
لقد عرف العرب وغيرهم من الأمم الفنون الأدبيّة، ومارسوها في حياتهم اليوميّة، وعبّروا في بعضها عن واقعهم ومعاناتهم وأمجادهم، فكان الشّعر، وكانت الحكمة، وكانت الخطابة، وكانت القصة أحد أبرز الفنون التي استخدمها الإنسان تعبيرًا عن تجاربه الحياتيّة، وكل ما يتعلق بالمواقف والقيم الخلقيّة، فعرفت الشّعوب السّردية، وبعد ذلك فنّ الرّواية، ذلك أنّ “السمات المميّزة للنوع الجديد لا تنبثق من العدم” (إبراهيم، 1994، ص6).
استنادًا إلى ذلك انطلق البحث للتّعرف إلى الفن الروائي الحديث، انطلاقا من دراسة فنية نقدية لرواية “قصتان طويلتان: على حافة الهاوية – والجبل يصيح بي، للكاتب الإيراني محمد رضا بايرامي.
وقد تناولتُ في هذا البحث دراسة الجوانب الفنيّة المتعلقة بعلاقات الترتيب وعلاقات الديمومة في الرواية، وانطلقتُ بعدها لدراسة الشّخصيّة في هذه الرواية استنادًا إلى ثلاثة محاور: “فهي إمّا أن تأتي كشخصيّة رئيسة، أو ثانويّة، أو تقتصر على وظيفة مرحليّة”.
فبدت شخصياتُ بايرامي شخصياتِ إنسانيةً متنوّعةً بتنوّعِ الشخصياتِ الحقيقيّة، تعكس واقعَ المجتمعِ بكل أبعادِه، حاملةً بين طياتِها الأبعادَ الإنسانيةَ وتقلباتِها، فظهر منها الشّخصيّة الجاذبة والشّخصيّة المرهوبة الجانب والتي ارتبطت بالمكان ارتباطًا وثيقًا يعكس العلاقة بين المكان ونفسيّة الشّخصيّة.
إضافة إلى دراسة المكان في هذا العمل الروائي بما يحمله من رموز وأبعاد وانعكاس لتطلعات الشّخصيّات في هذه الرواية، فظهر المكان في هذه الرواية كما في الرواية الحديثة، أكثر من مجرد خلفيّة للأحداث، ليصبح عنصرًا سرديًّا حيويًا له أبعاد رمزيّة ونفسيّة وجماليّة.
وهكذا، يكون هذا البحث قد تناول هذه الرواية من جوانب فنية تُعَدّ من أسس العمل الروائي: علاقات الترتيب والديمومة وعلاقتها بالزمان، والشخصيات انطلاقا من أفعالها وتطلعاتها، والمكان وما يحمله من أبعاد.
الكلمات المفاتيح: العمل الروائي – الفن القصصي – الفضاء الروائي – فضاء الرواية – العناصر البنائية في العمل الروائي – المكان الرمز – المكان مرآة نفسيّة للشّخصيّة.
Abstract
Arabs, along with other nations, have long been familiar with various literary genres, practicing them in their daily lives and using them as a means to express their realities, struggles, and glories. Poetry, wisdom literature, and storytelling were among the most prominent literary forms through which humans conveyed their life experiences and moral values. Among these literary genres, the story emerged as a key genre used to represent personal and societal events. Eventually, this narrative tradition evolved into the novel, for as Ibrahim (1994, p. 6) notes, “the defining characteristics of the new genre do not emerge from void.”
Building on this idea, the present study explores the modern art of the novel by conducting a critical and artistic analysis of “Two Long Stories: On the Edge of the Abyss – The Mountain Calls at Me”, written by Iranian author Mohammad Reza Bayrami.
This research focuses on the technical aspects of the novel, particularly examining the plot and the setting, and how they function within the temporal structure of the work. It then delves into the characterization, analyzing the characters in three categories: main characters, secondary characters, and those who serve a transitional function within the narrative.
Bayrami’s characters are revealed to be deeply human and diverse, mirroring the variety found in real people. They reflect the complexities of society in all its dimensions, bearing the full range of human emotion and transformation. Among them, we find both charismatic and intimidating figures, each strongly tied to a place, in a way that underscores the profound connection between physical setting and psychological depth.
The study also investigates the role of place in the novel, emphasizing its symbolic, emotional, and aesthetic significance. As in most modern fiction, place in this work is not merely a background for events but becomes a vital narrative element, reflecting the characters’ aspirations and internal states.
In conclusion, this study analyzes the novel through foundational literary elements: plot, setting, the development and function of characters, and the role of place, all of which combine to shape the novel’s structure and meaning.
Abstract
Novel – Narrative Art – Novelistic Space – Novel Space – Structural Elements in Novelistic Work – Symbolic Place – Place is a Psychological Mirror of the Character
المقدمة
قد تكون الرواية هي الحياة نفسها، كونها تناولت، وعبر الزّمن، موضوعات حضاريّة تتعلق بالصراع الحضاري حينًا، وبالحوار الحضاري حينًا آخر. كما تتعلق بالواقع بمختلف وجوهه سواء في ما يتعلق بالنواحي الاجتماعيّة، أو السياسيّة، أو التّاريخيّة، أو القيميّة، أو الإنسانيّة بكل ما تحمل هذه الكلمة من معانٍ. فالرواية كما جاء في كتاب بنية الشكل الروائي لحسن بحراوي “ظلت خلال القرنين السابع والثامن عشر تحتل مرتبة ثانوية في سلم الأنواع، فلم يكن يعترف بها آنذاك بصفتها نوعًا أدبيًّا يطال الشّعر والمسرح الموروثين عن عهد النّبالة…حتى إننا لا نجد ناقدًا، أو فيلسوفًا يتصدى لإعداد قانون لهذا القادم، وطوال ما يقارب القرنين ظلت الرواية طليقة من كل قيد وتنمو في كل اتجاه”(بحراوي، 1990، ص 11). وإنّ فن الرّواية فنٌّ يعنى بتصوير الحياة، وهذا ما يفرض تمتعه بحرية كاملة لكي يكون صحيحًا ومعافى، “فهو يحيا على الممارسة وجوهر الممارسة هو الحرية”(جيمس، 1971، ص 77). والمقصود بالحرية هنا حرية الخيال عند المؤلف. وهذا ما رأيناه ولمسناه في رواية “قصتان طويلتان” للروائي محمد رضا بايرامي.
والرواية كفن يتصف بخصائص تجعل القارئ يعتقد أنّه يعيش في عالم واقعي مع أنّ هذا العالم متخيل، فالروائي يبدع هذا العالم ليقدم لنا الحياة بصورة فنيّة، هي وليدة خيال رحب محلل. فحتى الإسهاب في ذكر التفاصيل في الرواية يقتضي صنيعًا فنيًّا، “فكل كلمة، وكل حركة، وكل جملة، تشترك في إحداث نغمة ما، لها دلالتها، ولا تحسبن التفاصيل في الرواية مجرد ملء فراغ، ولكنها ميزة الرواية حقاً خاصة وأن الرواية تجسد ذاكرة الأمم، وقيمها، وتاريخها، وتنقل سلبياتها، وأطماع ناسها، كما تنقل روائعهم، ومثالياتهم. فتمهّد الطريق إلى التغيير، والانتقال من واقع إلى واقع، أو تبعث على الاندفاع إلى الأمام رغبة في عدم الرجوع إلى واقع مرير مخز أحيانًا، وهذا جزء ما سعى إليه الكاتب بايرامي.
وهذا وغيره من الحقائق يكسب العمل الروائي أهميته، أضف إلى ذلك أن الفن القصصي فن يخدم العملية التعليمية، والتربوية من ناحية أيضا، ﴿لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَىٰ وَلَٰكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ (سورة يوسف، الآية 111)، وهذا ما أثبته القرآن الكريم الذي ساق في ثناياه قصص الأنبياء في تفاصيلها لتستقى منها الدروس والعبر، فتأخذ منحى إرشاديًّا تربويًّا يسهم في بناء الإنسان، وخير مثال على ذلك قصة سيدنا يوسف (ع). وهذا الجانب شديد الظهور عند بايرامي إذ إنّ تصرف الطبيب خير دليل على ذلك، وكذلك الأم والعم وجلال.
المنهج المتّبع
إن دراسة الرواية وتحليل الخطاب فيها يستدعي المنهج البنيوي أو ما يعرف بالمنهج السّردي، ذلك المنهج الذي يتعاطى مع النص الأدبي انطلاقًا منه. بعيدًا من التاريخ، وعلم النّفس، وعلم الاجتماع، ولعل جهود فرديناند دي سوسير كانت السباقة لتأسيس المدرسة البنائية على صعيد اللغة أولًا، ومن ثم على صعيد العلوم الإنسانيّة كلّها، ” فقد أسس هذا العالم مدرسة لغوية حديثة تعد نموذجًا رائدًا للعلوم الإنسانيّة، وقدرتها على أن تصبح علومًا دقيقة” (فضل،1958، ص 60). “وبعد ذلك نشأ تيار الشّكّليين الروس الذي دعا الناقد إلى مواجهة الآثار الأدبيّة نفسها لا ظروفها الخارجيّة التي أدت إلى إنتاجها” (أنطون،2006، ص27).
ويمكّنني هذا المنهج من دراسة بناء الرّواية استنادًا الى الدّراسات الحديثة التي تبتعد من الطريقة التّقليديّة؛ لأن هذا المنهج لا يبالي بغير النّص، فالظروف، والمؤشرات الخارجيّة، وحياة المؤلف أمور تهملها البنيويّة الأدبيّة، ولا تهتم لها خلال الدراسة، والتحليل، وبما أن الدراسات البنيوية الحديثة تنطلق من العمل نفسه فإن هذه الرواية ستكون في هذا البحث نقطة البدء وخاصة في ما يتعلق علاقات التّرتيب والدّيمومة والشّخصيات والمكان، “فالمنهج البنيوي ينصرف الى الشيء ذاته يفحصه مستقلًا عن أي شيء آخر” (شلش،د. ت، ص8). وهكذا فإنّه يتيح للروايات نفسها أن تتحدث، وتنطق بما فيها من فنيات، فمن خلاله نترك للنص وحده أن يتكلم، فلا شيء سوى النّص، نبحث داخله عن بنية شاملة ذات دلالة.
قصتان طويلتان: على حافة الهاوية – الجبل يصيح بي
العمل الرّوائي الذي بين أيدينا والذي يحمل عنوان “قصتان طويلتان”: على حافة الهاوية – الجبل يصيح بي، للكاتب الإيراني محمد رضا بايرمي، نُشرت هذه الرواية العام 2017 وتضم قصتين طويلتين تعكسان أسلوب بايرامي المتميز في السرد، إذ يمزج بين الواقعيّة والتّأملات الفلسفيّة مع تسليط الضوء على الجانب الإنساني والتّجارب الإنسانيّة العميقة.
فالأولى بعنوان على حافة الهاوية، وهي تحمل أبعادًا إنسانيّة اجتماعيّة ، وقد أدّى القدر دورًا كبيرًا فيها، كاد يصل بعائلة إلى حافة الهاوية، إذ إنّ ظروف الحياة القاسية كانت السّبب في ذلك لولا بعض الأمور التي شكّلت العامل المساعد لهذه العائلة، وهي تتمثل بالابن جلال الذي بدا إنسانًا لا يرضى الاستسلام ويسعى للمواجهة بكل ما أوتي من مقومات فكريّة وجسديّة، وكذلك الأم التي وإن بدت بسيطة إلّا أنّها ظهرت امرأة حريصة على عائلتها تفكر بعواقب الأمور، وكذلك العم إسحاق الذي الذي وقف إلى جانب العائلة وإلى جانب أخيه في أزمته المرضية محاولًا أن لا تصل الأمور إلى حافة الهاوية. إلّا أنّ اللافت أن القدر ساق بعض الأمور إلى حافة الهاوية، وتوقف في بعضها على الحافة لتعود العائلة وتلتقط أنفاسها متحدية المصاعب مواجهة الظروف الص~عبة.
أمّا القصة الثانية التي حملت عنوان الجبل يصيح بي، فقد شخّص الرّوائي في هذا العنوان الجبل، وجعله يملك إحساسًا وإدراكًا، وحواس، فالصياح لا يكون إلا بعد إدراك وبعد معاناة شديدة، فأن يصيح بك الجبل وكل ما حولك من جماد فهذا يعني أن الأمور وصلت إلى أكثر من حافة الهاوية.
وبذلك فإنّ العنوان الثاني هو نتيجة للعنوان الأول، فالوصول إلى حافة الهاوية جعل كل شيء حول جلال والعم إسحاق يعيش معاناتهما ومعاناة العائلة، ويدرك عظم المصائب التي يمرون بها في هذا المجتمع الريفي وفي هذه الظروف الصعبة التي كانوا يعيشونها، إلّا أنّهم لا يستسلمون ولا يصلون إلى مرحلة اليأس، إنّما يبقى الأمل موجودًا في النّفوس لأن الحياة حسب رأي الرّاوي تتطلب ذلك، وتتطلب وجود هذه النفسيات.
علاقات الترتيب وعلاقات الدّيمومة في الرّوايّة: إنّ الأحداث في الزّمن الموضوعي الطبيعي تُرتّب أصلًا انطلاقًا من الماضي إلى الحاضر فالمستقبل، لكن الروائي يضطر للجوء إلى مايسمى انزياح السرد، فينزاح السرد عن مسار الزّمن الحقيقي للقصة، لتترتب الأحداث وفاق رؤية الراوي وانطلاقًا من منظوره الخاص الذي يسعى من خلاله إلى تشكيل القصة بأحداثها تشكيلًا فنيًّا، وهذا التّرتيب الجديد هو ما يطلق عليه علاقات الترتيب أي “التقنيات السّرديّة التي بانزياحها ضمن السّرد تشكّل الزمن الروائي، الذي يفارق زمن الأحداث”(أنطون، 2006، ص 312).
وهذا ما أطلق عليه د.عبد المجيد زراقط “نظام ترتيب الأحداث وإقامة الحبكة” (زراقط، 1999، ص 705).
وهذه التّقنيات يلجأ إليها الروائي لكي تساعده على تشكيل حبكة النص القصصي، فيعيد تشكيل الأزمنة وفاق تقنيات متعددة، كالاستباق والاسترجاع والمشهد..
أمّا في ما يتعلق بعلاقات الدّيمومة، فمن الطبيعي أن إيقاع السّرد تقنية تدرس حركة السّرد من خلال عدة تقنيات، ومن البدهي أن يتطابق أو يتفاوت تتابع الأحداث مع الترتيب الطبيعي لأحداثها، “فقد يتناسب حجم تلك الأحداث مع طول عرضها أو لا يتناسب“ ( بكر، 1998، ص 54)، وهذا ما ينتج عنه تبطيء للسرد أو تسريع له، لأن طبيعة السرد في عالم الكتابة الروائيّة تفرض ترتيب الأحداث بشكل تتابعي، حتى ولو حصلت في الواقع في الزمن نفسه، وهكذا، “فإن التطابق بين زمن السّرد وزمن القصة المسرودة لا نجد له مثالًا إلّا في بعض الحكايات العجيبة القصيرة“ (الحمداني، 1990، ص 73)، ومن هنا كان التّمييز بين زمن السّرد وزمن القصة بأحداثها، إذ إنّ زمن القصة يخضع للتتابع المنطقي للأحداث بينما لا يتقيد زمن السّرد بهذا التتابع المنطقي (الحمداني، 1990، ص 73) فإذا كان التتابع المنطقي للأحداث يتخذ شكل :
1 2 3 4 5، وهذا ما يعرف بالتّتابع المنطقي، فإن زمن السّرد قد يتخذ نفس التّسلسل والتتابع أحيانًا، وهذا ما يطلق عليه “حركة التّوازن المثالي“ (بكر، 1998، ص 53)، وقد يتخذ تتابعًا آخر كالشكل الآتي :
5 4
وهكذا يحدث ما يُسمى “مفارقة زمن السّرد مع زمن القصة“ (الحمداني، 1990، ص 73)، وهذا أمر طبيعي لأنّ الرّوائي لا يمكنه أن يسرد كل الأحداث دفعة واحدة، فيروي جزءًا ويؤجّل آخر، ويختصر في وصف مشهد ما، ويوسع في مشهد آخر، وهذا ما أطلق عليه حسن بحراوي في كتابه بنية الشكل الروائي “تسريع السّرد“ (بحراوي، 1990، ص 145).
تلك التقنيّة تندرج تحتها تقنيتا الوقفة الوصفيّة والسّرد المشهدي، وهذا ما أكّده د. عبد المجيد زراقط (1999) بقوله: “يدرس إيقاع السّرد الروائي من خلال التقنيات الآتية: التلخيص – الثغرة – الوقفة – المشهد“ (ص 707 – 708).
في ما يتعلق بعلاقات الترتيب وعلاقات الديمومة، فإنّنا نرى أن الكاتب يزاوج في هذا العمل بين السرد والوصف، ويلجأ الى الحوار بشكل واضح وجلي، فيجعل شخصيته تخرج من الواقع لتعيشه وتنقل تفاصيله اليومية بشكل لافت، فيعكس هذا الحوار أمورًا كثيرة ويكشف خبايا كثيرة تتعلق بالنّفسيات والمجتمع والواقع وما يعانيه الناس في هذه الحقبة التّاريخيّة في هذه المنطقة.
وهو في الواقع لم يلجأ في علاقات الترتيب إلى الاستباق ولا إلى الاسترجاع الاستذكاري على الرّغم من ما يمثله كل من هاتين التقنيتين من قيمة سرديّة في ما يتعلق بعنصر التّشويق القصصي، إلّا أن الكاتب ذهب إلى أبعد من ذلك في هذا المجال فترك العمل الروائي يسير وفاق الخط الزمني الحقيقي للحياة، بعيدًا من هذه التقنيات.
أمّا علاقات الدّيمومة والتي تتعلق بالتمييز بين زمن السّرد وزمن القصة بأحداثها، فزمن هذه القصة يخضع للتتابع المنطقي للأحداث وكذلك زمن السّرد، وهكذا بدا التتابع المنطقي للأحداث يتخذ شكل:
1 2 3 4 5، وهذا ما يعرف بالتتابع المنطقي، فزمن السّرد يتخذ نفس التسلسل والتتابع أحيانًا، وهذا ما يطلق عليه أيضًا: “حركة التّوازن المثالي“ (بكر، 1998، ص 53).
إلّا أنّ الملاحظ أن الكاتب لجأ إلى تقنيتي الوصف المشهدي، وأحيانًا قليلة لجأ إلى تسريع السرد، وبما أنّ الكاتب اعتمد بشكل واضح تقنية الوصف المشهدي، فقد برز الحوار في الرّواية كتقنية أساسيّة، لم يخل فصل من فصولها من سيطرة الحوار على تقنيات هذا العمل الرّوائي. وإذا كانت الخلاصة تلخيص عدة حوادث أو سنوات في مقاطع محدودة، أو في صفحة وصفحات قليلة، بعيدًا من تفاصيل الأشياء فإنّ المشهد الوصفي الحواري هو تركيز وتفصيل للأحداث بكل دقائقها، لذلك فإن المشهد الحواري يعدُّ من التّقنيات التي تعطل السّرد ، فتظهر من خلال هذه التقنية الشّخصيات أمام القارئ وكأنّها على المسرح تتحرك وتتنافس وتتحاور، إذ يشاهد القارئ القصة وكأنّها مسرح عليه الشّخصيات وهي تتحرك، وخاصة عندما يكون الخطاب مباشرًا ويتناوب مع السّرد للأحداث، ( التفت الطبيب إلى أمي وقال: غطيه باللحاف و…. ثم خرجوا من المخدع، وبدأت أمي ترتيبه، وانشغل الطبيب وعمي إسحاق… طيب أيها الطبيب)
سكت العم إسحاق، نظر الطبيب إلى أمي التي بدا عليها أنّها تخشى أن تسأله عن أحوال أبي، مم يشكو؟ خفض الطبيب صوته وقال:
ماذا عساني أن أقول…. لماذا لم تأخذوه إلى الطبيب حتى الآن؟؟
اصفر وجه أمي، التفت العم إسحاق، وحملق إلى فم الطبيب….
فالمشهد الحواري الذي تقوم عليه هذه الرّواية بكل فصولها والذي يسيطر عليه الخطاب المباشر في مواضع كثيرة يمنح القارئ إحساسًا بالمشاركة في الحدث، ويجعل الشّخصيّة تتكلم وتعبّر عن مكنوناتها من خلال استعمال هذا الأسلوب المباشر والذي يجعل القارئ يشعر بوجود الشخصيات على مسرح الأحداث، ما يؤدي إلى تفاعل أكثر عمقًا.
دراسة الشّخصيّة في الرواية
وكما هو معروف فإنّ الشّخصيّة عنصر أساس في عمليّة القصّ، تقوم بدور كبير في حركة السّرد القصصي، ويمكن أن تكون شخصيّة رئيسيّة محوريّة لها حضورها الفعّال، ويمكن أن تكون شخصيّة ثانويّة تؤدّي دورًا من خلال ما حدث وفي حيّز زماني ما، فتعكس على هذا المكان، أو الزّمان بعدًا ما، ودلالة معيّنة، تكتسب خصوصيتها من خلال أحداث تتعلّق بالشّخصيّة، أو من خلال مواقف، وتصرّفات، وحوارات… فلذلك يمكن أن تتفاوت الشّخصيّة من “حيث مركزيتها، وهامشيتها… وفي حركتها… أو ثباتها… وكذلك من حيث تجانسها الذّاتي، أو عدم تجانسها (بكر، 1998، ص 50).
إنّ للشّخصيّة دورًا أساسيًّا في بناء العمل الروائي، لذلك، “يميل معظم النّقاد المحدّثين إلى أن الشّخصيّة عنصر مهمّ من عناصر الفن القصصي”(عبد الله، د. ت، ص 66). فالفن القصصي يقوم على عناصر تشكل أساس القصّ”(العيد، د. ت، ص 26). فكل قص يفترض وجود قاص / راوٍ- وجود سامع / قارىء – وجود مايقصّه القاصّ”. فالقاص يقدم الأحداث كما يراها هو من وجهة نظره، ومن وجهة منظوره الروائي ، والقصّ يفترض علاقة بين راوٍ ومرويٍّ له، وهذا الأمر “يفترض وجود شخص يروي وشخص يُروى له، أي وجود تواصل بين طرف أول، يُدعى راويًا، أو ساردًا أو قاصًّا، وطرف ثانٍ، يُدعى مرويًّا له، أو قارئًا له”(bourneuf et ouellet: 1981, p 181). ولكن هذه الأحداث التي يقدمها الراوي بحاجة إلى من يفعلها ويحرك الصراع فيها، وهذا العنصر هو الشّخصيّة، أو الشّخصيّات التي لا تتحرك من دون حيّز مكاني ، وحيّز زماني.
فدراسة الشّخصيّة في العمل القصصي تتطلب الوقوف على أفعال الشخصيات، وتفكيرها، وأهدافها، وطموحاتها، لأن هذه الأفعال هي التي تكشف مزايا الشّخصيّة، وخباياها، “فإذا كان النّقد الشكلاني ممثّلًا في أبحاث “فلا ديمير بروب– “الذي يعد من منظري الأدب المهمين، ومن الدارسين الروس في الأدب الشّعبي (الفولكلور)”- (العدد 2858، 30،7،2014، فلاديمير بروب ومورفولوجيا الحكاية الشّعبيّة، 10، 11،2014، http://almothaqaf.com/index.php/books/882791.html) على الخصوص، ونقد علم الدّلالة المعاصر، ممثّلًا في أبحاث “الجيرداس جاليانغريماس” “الذي يعدالمؤسس الفعلي للسيميائيات السّرديّة والذي أكمل ما بدأه فلاديمير بروب بتجاوز المستوى السّطحي للنص إلى المستوى العميق.(حسين أبو عسري، 26، آذار، 2014، سيميائية الشّخصيّة الرّوائيّة، 12، 8، 2014، http://www.oudnad.net/spip.php?article1066) فقد حاولا معًا تحديد هوية الشّخصيّة في الحكي بشكل عام من خلال مجموع أفعالها، من دون صرف النظر عن العلاقة بينها وبين مجموعة الشّخصيّات الأخرى التي يحتوي عليها النص، فإن هذه الشّخصيّة قابلة لأن تحدّد من خلال سماتها ومظهرها الخارجي”(الحمداني، 1991).
ويؤكد آخرون أن لتحديد هوية الشّخصيّة مصادر أخرى، لذا، “لجأ بعض الباحثين إلى طريقة خاصة في تحديد هوية الشّخصيّة الحكائيّة، تعتمد محور القارئ، لأنّه هو الذي يكوّن بالتدرج _ عبر القراءة – صورة عنها، ويكون ذلك بواسطة مصادر إخبارية ثلاثة: – مايخبر به الرّاوي. – ماتخبر بها الشّخصيّة ذاتها – ما يستنتجه القارىء من أخبار عن طريق سلوك الشخصيات.
وهكذا فإن الشّخصيّة تعدُّ جزءًا أساسيًّا لأي عمل روائي، ودراستها تكون من خلال حواراتها، وأفعالها، وماتخبر به، ومايستنتجه القارىء نتيجة أفعالها وسلوكياتها، “فطبيعة الأحداث هي المتحكّمة في رسم صورة الشّخصيّة وإعطائها أبعادها الضروريّة والمتحكمة “(بحراوي، 1990، ص 208). من هنا ضرورة دراسة الشّخصيّة الروائية التي “تعدُّ محضّ خيال يبدعه المؤلف لغاية فنية محددة يسعى إليها”(بحراوي، 1990، ص213).
وشخصيات هذه الرواية محدودة لم ينوع الراوي فيها كثيرا واقتصرت على الأم وجلال الابن والعم إسحاق وقاشقا، كشخصيات رئيسة في الرواية، ثم هناك شخصيات أخرى ومنها الطبيب، الأب الحاج حيدر، الفتاة الصغيرة صدف، ورفاق جلال، إيلدار، وسرحان بيك….
نلجأ في دراستنا هويّة الشّخصيّات إلى التّصنيف الّذي وضعه النّاقد الأدبي البلغاري “تودوروف”، وهو ينبّه إلى إمكان تصنيف الشّخصيّات استنادًا إلى أهميّة الدّور الّذي تقوم به في السّرد، فإنّه يجعلها على ثلاثة محاور: “فهي إمّا أن تأتي كشخصيّة رئيسة، أو ثانويّة، أو تقتصر على وظيفة مرحليّة”(بحراوي، 2009، ص 226).
توزعت الشّخصيّات الرئيسة بين الزوجة الأم، والابن جلال، والعم إسحاق، والطبيب، فقد شغل كل منها جزءًا كبيرًا من القصتين، باستثناء الطبيب الذي شغل جزءًا كبيرًا من الجزء الأول، وظهر بمظهر الطبيب الذي يمتهن مهنة الطب كرسالة، فيبتعد من الاستغلال، ويجازف بحياته ويغامر في سبيل أداء واجبه بكل مهنيّة وصدق والأم التي شغلت في الجزأين مكان الشّخصيّة المحورية هي والابن جلال، والعم إسحاق، فقد أظهر كل منهم أهمّيّة الأسرة المترابطة والتربية السليمة، والقدرة على مواجهة المصاعب وتحدي الكل الصعاب في الحياة بعيدًا من التّشاؤم والاستسلام، كم أظهر كل منهم متانة العلاقة الأسريّة، وأهّميّة التماسك في الأوقات الصعبة قبل الوصول إلى حافة الهاوية. وهكذا تعلقت بهذه الشخصيات أحداث كثيرة، منها مايتعلق بالوضع الاجتماعي، ومنها مايتعلق بالوضع العائلي، والتطلعات الشّخصيّة .
أما الشخصيات الثانوية فتوزعت بين مجموعة من الشخصيات كان أبرزها الابنة صدف التي مثلت البراءة وطهارة والشّخصيّة التي تحتاج إلى رعاية دائمة، ورفاق جلال الذين لم يصلوا إلى ما وصل إليه من قدرة على تحمل المسؤوليّة والوعي، وقد عكس الراوي من خلال جلال ورفاقه تنوع الشّخصيات الشّبابيّة في الوعي وتحمل المسؤوليات، وبرزت شخصية سرحان بيك التي أبرز من خلالها الوجه السلبي للشخصية الإنسانية في الطمع والأنانية والاستغلال، فقد استغل حاجة العائلة بعيًا من كلّ ما يمت إلى القيم والاجتماعيات من علاقة.
وهناك شخصيات اقتصر دورها على وظيفة مرحلية، إلّا أنّها أدّت دورًا في إظهار ما يريده الكاتب، فالشّخصيّات الشّبابيّة سلط من خلالها الضوء على واقع الشّباب وتنوع تفكيرهم بين شخصيات واعية وأخرى ضائعة، وكذلك عكس من خلال الطبيب الدور الإنساني والوجه الإيجابي للصورة الإنسانيّة، في المقابل ظهرت شخصية سرحان بك في آخر الرواية ليؤكد من خلالها على الوجه الآخر للإنسانيّة، والذي يقابل الوجه البشري الإيجابي لها، وقد تمثّل بشخصيّة الطبيب وعم جلال والزوجة وجلال.
الملاحظ أن الصفات الخارجية للشّخصيات تبدو ضئيلة مقارنة بالصفات النّفسيّة التي تتبدى من خلال الأفعال والأحداث، وما تنطق به الشخصيات من كلام يعكس نفسيتها وما تنطوي عليه، ولذلك فإن الحوار أدّى دورًا كبيرًا في هذه الرواية .
سنقدم في ما يلي كشفًا لحقيقة الشخصيات وفق التصنيف الذي اعتمده حسن بحراوي في كتابه بنية الشكل الروائي ( الفضاء – الزّمن – الشّخصيّة ) خلال دراسته للرواية المغربية، يقول :
إن التيبولوجية التي نقترحها كإطار للعمل على الشّخصيات في الرواية ستتركب من ثلاثة نماذج … ونسميها الأساسية والنّماذج الكبرى، وهي: نموذج الشّخصيّة الجاذبة، ونموذج الشّخصيّة المرهوبة الجانب”. (بحراوي، 2009، ص 267).
من الشخصيات الجاذبة في هذه الرواية والتي سلط الراوي عليها الضوء من خلال كلامها ومواقفها ظهرت شخصية كلٌّ من الأم وجلال وشخصية الطبيب ، فلكل منهما مقدرته على أن يكون شخصيّة جاذبة، فالأم تظهر الشّخصيّة الحنونة الواعية الحريصة على مصلحة العائلة والتي تحافظ على عهود الزوجية، وهذا يتبدى من خلال علاقتها بزوجها المريض ووقوفها إلى جانبه في أزمة مرضه، ومن خلال علاقتها بأولادها وحرصها على متابعة تعلمهم، وكذلك من خلال تفكيرها المنطقي، فهي لا ترضى أن تمدّ يدها إلى أحد عندما كانت العائلة تمر بظروف اقتصاديّة صعبة، فتخلت في هذا الوقت عن عاطفتها وقررت بيع حصان زوجها على الرّغم من ما له من قيمة معنوية، وعلى الرّغم من ما يمثله هذا الحصان من أهمية في ما يتعلق بعلاقته بزوجها. إلّا أنّها فضلت بيعه من أجل قوت أولادها وتعليمهم، حتى لا تحتاج المساعدة من أحد.
أما بالنسبة إلى جلال فقد ظهر شخصية جاذبة من خلال وعيه المبكر وقدرته على تحمل المسؤوليات، بعلاقته بأمه وعمه وأخته التي وقد كان حريصًا عليها، وكذلك من خلال بعده عن الضياع الذي يعيشه الكثير ممن هم في سنه.
إضافة إلى الطبيب الذي بدا شخصية تتمتع بقمة الصفات الإنسانيّة من خلال علاقته بالمريض، وتعامله معه بعيدًا من الاستغلاليّة، وبعيدًا من الأنانيات التي يعيشها الكثيرون من الناس، وينتهزون الفرص المؤاتية من أجل المكاسب المادية، وهذا ما لم يفعله الطبيب مع والد جلال ، بل أتى بكل طيبة خاطر على الرّغم من كل المصاعب والمشقات التي واجهتهما في طريقهما إلى منزل المريض.
أما في ما يتعلق بالشّخصيّة المرهوبة الجانب، فقد ظهرت شخصية سرحان بك الذي استغل حالة الضعف التي تمر بها العائلة، فبدا شخصية انتهازية يستغل حاجات الناس ليضع شروطه القاسية، فعندما عرض عليه “قاشقا”، على الرّغم من أنّه يملك حصانين، قرر شراءه عندما عرف أنه ما من أحد يشتري في هذه الظروف، والأسوأ من ذلك الهدف الذي لأجله قرر شراءه، (ذبحه من أجل إطعامه لكلابه.)
لقد أظهر الكاتبُ من خلال شخصياتِه وتنوّعِها الوجهين الإيجابي والسلبي للحياة، فسلط الضوء من خلال الشخصيات الشبابيةِ على التنوعِ الفكريِ لديهم والذي يعكس المستوى الفكريَّ لدى الشّباب في كل زمان ومكان، ومقابلُ الطبيبِ الذي يمثّلُ الوجهَ المشرقَ للحياة ظهر سرحان بك ليؤكدَ وجود الوجهِ الآخرِ للإنسانية. والملاحظُ أن الصفاتِ الخارجيةَ للشخصياتِ تبدو ضئيلةً مقارنةً بالصفات النّفسيةِ التي تتبدّى من خلال الأفعالِ والأحداثِ وما تنطق به الشخصياتُ من كلام يعكس نفسياتِها وما تنطوي عليه.
وهكذا بدت شخصياتُ بايرامي شخصياتِ إنسانيةً متنوّعةً بتنوّعِ الشخصياتِ الحقيقية، تعكس واقعَ المجتمعِ بكل أبعادِه، حاملةً بين طياتِها الأبعادَ الإنسانيةَ وتقلباتِها.
أما في ما يتعلق بالمكان فقد ظهر مكان يحمل أبعادًا رمزية تتعلق بوجود الإنسان وتطلعاته، أكثر ما هو مكان للعيش، فبدا المكان متماهيا مع الزمان عاكسًا تطلعات الشخصيات.
المكان في الرّواية
بالعودة إلى عناصر الفن الروائي نجد أن المكان عنصر أساسي فيها، ونجد أنه ” يتماهى إلى حدّ بعيد مع الزمان، فالقصة رحلة في الزمان والمكان على حد سواء ” (قاسم، 1984، ص 74).
وبما أن الأحداث لايمكن أن تجري في العدم، كان لا بدّ من عنصر المكان الذي تجري فيه الأحداث، “وحركة الشّخصيات والحوار فيما بينها، عبر الزمن، لايمكن أن توجد من دون أماكن تجري فيها الأحداث، وهذه الأماكن هي مايعرف بالمسرح القصصي”(أيوب، 1977، ص 134). وعندما نتحدث عن فن الرواية نذكر كلمة الأماكن بصيغة الجمع، ” لأنّه لايمكننا أن نتحدث عن مكان واحد في الرواية، بل إن صورة المكان الواحد تتنوّع بحسب زاوية النظر التي يلتقط منها. وفي بيت واحد، قد يقدم الراوي لقطات متعدّدة تختلف باختلاف التركيز على زاوية معينة … إن مجموع هذه الأمكنة، هي ماريبدو منطقيًّا أن نطلق اسم: فضاء الرواية. فالمقهى، أو المنزل، أو الشارع، أو الساحة، كل واحد منها يعدُّ مكانًا محددًا، ولكن إذا كانت الرواية تشمل هذه الأشياء كلّها، فإنها جميعًا تشكل فضاءها.” (لحمداني، 1990، ص 63).
فالمكان والزّمان عنصران أساسيان، لا بدّمن التماهي والتلازم بينهما في الفن الروائي، فهذان العنصران، بتلازمهما، يفترضان عنصرًا آخر، وهو عنصر البشر، ” فروح الزّمان والمكان هم البشر، وهما متلازمان، ونرى من إشارات هذا التلازم عدم ثبات المكان إذ إنّه متحول أبدًا عبر الزّمن (إبراهيم، د. ت، ص 8). “والمكان لايمكنه أن يقوم بمعزل عن تجربة الإنسان، أو خارج الحدود التي رسمها له” (بحراوي،2009، ص 89).
فهو، أي المكان الروائي، ” يتشكّل من أمكنة الرواية وأشيائها والعلاقات التي تقوم بين هذه الأماكن والأشياء والشخصيات نتيجة جريان أحداث الرواية” (معدراني، 2011 – 2012، ص310).
فالمكان في الرواية هو المساحة التي تفصل بين الشّخصيات بعضها عن بعض، وهو الذي يفصل بين القارئ وعالم الرواية، إذ إنّ هذه المساحة هي التي تنتقل بالقارئ إلى عوالم مختلفة وأماكن متنوعة، ” فالقارئ بالإمساك بهذا المجلد ينتقل من موضوعه إلى عوالم شتّى، إلى روسيا تولستوي، إلى باريس بلزاك، إلى قاهرة محفوظ، إلى عالم خيالي من صنع كلمات الروائي نفسه.” (قاسم، 1984، ص 74).
والفضاء المكاني يظهر من خلال الأشياء المحسوسة، وهو يختلف عن الزّمن في طريقة تجسيده، فهو يمثل الخلفية التي تقع فيها الأحداث، أمّا الزمان فيتمثّل في الأحداث وتطوّرها. إضافة إلى ” أن أسلوب تقديم الأشياء هو الوصف، بينما أسلوب تقديم الأحداث وعرضها هو السّرد، لأنّ الزّمن يرتبط بالأحداث والأفعال” (قاسم، 1984، ص 76).
يوظّف المكان الرواية توظيفا جماليًّا في خدمة محور العمل القصصي، ويوظّف توظيفًا معنويًّا، فيضفي على النّص القصصي دلالات وإيحاءات، فيكون له وظائف كثيرة، فمن خلال دراسته تكتشف أوضاع المجمتعات، وأوضاع البشر، ونفسياتهم، وطباعهم.
لذلك، يُعدُّ المكان أحد العناصر البنائيّة الجوهريّة في العمل السّردي، إذ يشكّل الحاضنة التي تتحرك فيها الشّخصيات وتتكشّف من خلالها الأحداث، ويتحوّل في كثير من الأحيان من إطار محايد إلى عنصر دلالي ورمزي يعكس حالات الشخصيات وتحولاتها النّفسيّة والاجتماعيّة. وفي روايات محمد رضا بايرامي، يحتلّ المكان موقعًا مركزيًا، نظرًا لارتباطه بالهوية والانتماء والمعاناة.
فالهاوية في قصة على “حافة الهاوية” ليست فقط مكانًا فيزيائيًا، بل تحضر بوصفها رمزًا للضياع، وللخطر والانهيار الدّاخلي للشّخصيّة، كما تمثل لحظة الانهيار النّفسي والتّردد بين الحياة والموت.
أمّا الطبيعة الوعرة والجبليّة التي تقع فيها القصة فتُمثّل العزلة، والصّراع الداخلي، وتعكس حالة التمزق والاقتراب من الحافة النّفسيّة والعاطفيّة، ما يجعل المكان مرآة نفسيّة للشّخصيّة.
تعكس الجغرافيا القاسية حالة التيه والقلق، وعدم الاستقرار النفسي لدى الشّخصيّة المحورية التي تعاني من الضغوط والقلق الوجودي، “لم تزل الثلوج تتساقط من جرف الهاوية وتصطدم بالصخور فتتبعثر… سيطر عليّ الارتباك وتهت عدوًا من هذا المكان إلى ذاك. أتشبث بالثلوج! أرنو في كل جانب، وكل ذلك بلا جدوى، فلا شيء يُرى”. في هذا الكلام يُعبّر المكان عن حالة الضياع والارتباك التي تعيشها الشّخصيّة، فتتجلى الهاوية كرمز للانهيار النفسي والتّشتت الداخلي.
والحدود الفاصلة بين المكان الخارجي (الهاوية) والمكان الداخلي (الذات) تتداخل لتصنع معادلة سردية تقوم على الانهيار أو النجاة.
إذن، “الهاوية” لا تُفهم فقط كمكان، بل كموقف وجودي وشعوري: يقف البطل على حافة خيارات مصيرية، ويعيش على تخوم التهلكة والانبعاث.
أمّا في قصة “الجبل يصيح بي”، فإنّ الجبل ليس مجرد تضاريس، بل هو كائن حي يصرخ وينادي، وكأنه يطلب من الشّخصيّة أن تواجه مصيرها، أو تسترد ذاتها. فهو يحضر كرمز للثبات والشموخ، لكنه في الوقت نفسه يصبح فضاءً للعزلة والمكاشفة، فصوت الجبل ليس صوتًا خارجيًّا، إنّما هو نداء داخلي يدعو الشّخصيّة إلى المواجهة، ليمثل بداية تحوّل في وعي الشّخصيّة.
والصعود إلى الجبل يمثل رحلة تطهير وانفصال عن العالم، وبحث عن إجابة أو خلاص، فهو مكان للعزلة، ولكنها العزلة المثالية التي تؤدي إلى فهم الوجود والعثور على إجابات تمثل الخلاص.
وكأن هذا المكان في هذه الرواية يُنتج حالة “صوفية” أو “شبه صوفية”، حيث تتلاشى الحدود بين الذات والكون.أمّا في ما يتعلق بالصياح الذي يصدر من الجبل، فإن له دلالات ميتافيزيقية: هل هو صوت الذات؟ أم صوت الماضي؟ أم نداء المصير؟
فهو، أي الجبل، يصبح مكانًا لـلاستدعاء لا فقط للمأساة، وأيضا هو مكان للأمل أو البداية الجديدة.
فالحافة والجبل يقدمان معاني متعددة متناقضة، لكنها تكمل معنى الحياة، فالسقوط والصعود، الخوف والاكتشاف. فالمكان في هذه الرواية ينتج المعنى ولا يكتفي بوصفه فقط، فإذا كانت الحافة تعني اقتراب النهاية، فإنّ الجبل يعني العزلة بهدف الصعود لاكتشاف المعرفة والحقيقة الإنسانية بكل تفاصيلها. فالكاتب استثمر اللغة الوصفيّة ببراعة ليجعل المكان رمزًا يرتبط بالشّخصيّة وما يتداخل فيها من معاني وأفكار ورؤى.
الخاتمة
نرى أن المكان في هذه الرواية كما في الرواية الحديثة، لم يعد مجرد خلفيّة للأحداث، بل أصبح عنصرًا سرديًّا حيويًا له أبعاد رمزية ونفسية وجمالية. في رواية “قصتان طويلتان“، التي تجمع بين “على حافة الهاوية“ و”الجبل يصيح بي“، يشكّل المكان محورًا مركزيًا في السرد، ويضطلع بدور فعّال في تشكيل الشخصيات، وبلورة المعنى، وإيصال الرسالة الإنسانيّة والوجوديّة التي يسعى المؤلف إلى إيصالها.
أخيرًا، إنّ هذه الروايةَ بشخصياتِها وأحداثِها وفضائِها تنطلقُ من واقعِ بيئة معينة، عاكسةً همومَ ناسِها ومعاناتِهم وتطلعاتِهم، حاملةً دروسًا وعبرًا في الحياة، تجعل القارئَ شريكًا مشاركًا، يقلقُ ويتفاءلُ، يفخرُ حينًا ويأسفُ حينًا آخر، يأخذُه إلى ذلك حوارُ الشّخصيات وأحداثُها، وطريقةُ السرد المثالي في هذه الرواية.
فهذه الرواية بجزأيها تشكل تجربة سرديّة عميقة تنفذ إلى جوهر الإنسان المعاصر في صراعه مع القلق، والانتماء، والمصير. فمن خلال قصتي “على حافة الهاوية“ و”الجبل يصيح بي”، يعالج الكاتب قضايا وجودية بأسلوب تأملي يتقاطع فيه الواقع بالرّمز، والنّفس بالمكان، والتّجربة الفردية بالهمّ الإنساني العام.
لقد استطاع “بايرامي” أن يحمّل المكان دلالات غنية، ويجعل من الجغرافيا الوعرة خلفية تعكس تشققات النفس وهواجسها، وأن يستخدم الشخصيات بوصفها أصواتًا للبحث، والانكسار، والنهضة. كما تتكثف في النصوص ثنائية السقوط والصعود، حيث الهاوية والجبل لا يعكسان الطبيعة فقط، بل حالات الاضطراب أو النضج أو الخلاص.
في النهاية، إن هذه الرواية لا تنطق باسم فرد فقط، بل تُعبّر عن جيل يحيا في تخوم القلق، ويبحث عن صوته بين ضجيج العالم الخارجي وصدى الذات. وهي بهذا تمثل إسهامًا بارزًا في الرواية الحديثة التي باتت قادرة على الوصول إلى القارئ العالمي بلغتها الإنسانية العميقة وأسئلتها الكونيّة.
المصادر
- القرآن الكريم
- بايرامي، محمد رضا، قصتان طويلتان: على حافة الهاوية – الجبل يصيح بي، معهد المعارف الحكمية.
المراجع
- أنطون، إيلي، البناء الروائي ودلالاته عند يوسف حبشي الأشقر، أطروحة دكتوراه في الآداب، إشراف الأستاذ الدكتور وليم الخازن، جامعة القديس يوسف.
- أيوب، نبيل، الطرائق إلى نص القارئ المختلف, نظريات ومقاربات، حلب، بيروت، دار المكتبة الأهلية، ط1، 1997.
- بحراوي، حسن، بنية الشّكل الرّوائي: الفضاء، الزمن، الشّخصيّة، بيروت: المركز الثّقافي العربي.
- بكر، أيمن، السرد في مقامات الهمذاني، القاهرة: الهيئة المصريى العامة للكتاب، 1998.
- الخوري، سامي، كتاب كليلة ودمنة، دار الجيل، ط1، 2005.
- سليمان، نبيل ، الرواية العربية المعاصرة، رسوم وقراءات.
- شلش، علي ، نشأة النقد الروائي في الأدب العربي الحديث، القاهرة، مكتبة غريب، ط1.
- صلاح فضل، نظرية البنائية في النقد الأدبي، بيروت، دار الآفاق الجديدة، ط2، 1985.
- عبد المجيد زراقط، في بناء الرواية اللبنانية( 1972-1992)، ج1، دائرة منشورات الجامعة اللبنانية، بيروت 1999.
- عبدالله، إبراهيم، المتخيل السردي، مقاربات نقدية في التناص والرؤى والدلالة، بيروت: المركز الثقافي العربي.
- العيد، يمنى، تقنيات السرد الروائي في ضوء المنهج البنيوي، بيروت دار الفارابي، ط1.
- قاسم، سيزا, بناء الرواية, مقاربات نقديةلثلاثية نجيب محفوظ، القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1984.
- لحمداني، حميد, بنية النص السردي, بيروت، الدار البيضاء، المركز الثقافي العربي.
لحمداني، حميد، النقد الروائي والأيديولوجيا: من سوسيولوجيا إلى سوسيولوجيا النص الأدبي، ط1، بيروت، الدار البيضاء، المركز الثقافي العربي.
- معدراني, هدى، الخطاب الروائي في الرواية اللبنانية (1992- 2005)، أطروحة أعدت لنيل شهادة الدكتوراة اللبنانية في اللغة العربية وآدابها، إشراف د. عبد المجيد زراقط
http://almothaqaf.com/index.php/books/882791.html)
http://www.oudnad.net/spip.php?article1066)
[1] – أستاذ مساعد في قسم اللغة العربية وآدابها في الجامعة اللبناني، وأستاذ محاضر في الجامعة اللبنانيّة الدّوليّة .
Assistant Professor in the Department of Arabic Language and Literature at the Lebanese University, and Lecturer at the Lebanese International University. Email: mahmoudfarhat197@gmail.com