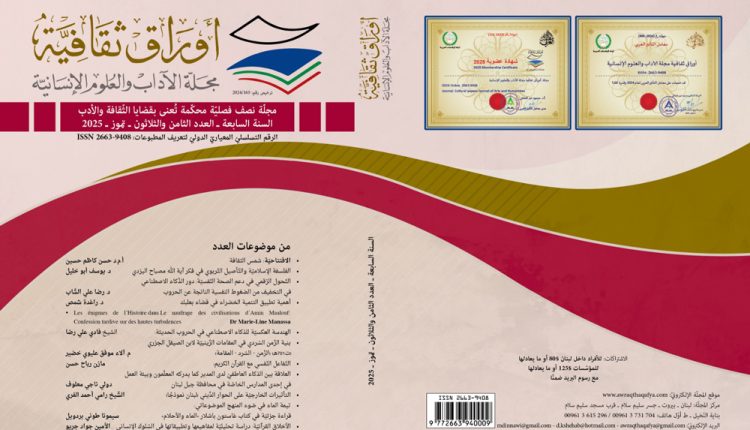عنوان البحث: أهمية تطبيق التنمية الخضراء في قضاء بعلبك
اسم الكاتب: د. راغدة شمص
تاريخ النشر: 2025/07/16
اسم المجلة: مجلة أوراق ثقافية
عدد المجلة: 38
تحميل البحث بصيغة PDFADOI: https://aif-doi.org/awraq/013803
أهمية تطبيق التنمية الخضراء في قضاء بعلبك
The importance of implementing green development in Baalbek District
د. راغدة شمص([1])DR.Raghida shamas
تاريخ الإرسال:22-6-2025 تاريخ القبول:3-7-2025
الملخص
يهدف هذا المقال الى الاهتمام بمفاهيم التنمية الخضراء واهمية تطبيقها في منطقة بعلبك نظرًا لما تمتلكه من موارد طبيعية، خاصة في الطاقة والزّراعة ، المشروعات الحرفيّة، السياحة والمياه والنقل، جرى تحديد واقعها ومتطلبات اكتسابها، والاستخدام الأمثل للموارد، والحدّ من التّدهور البيئي، قدمت الدّراسة نتائج عبر منهجيّة SWOT التي اعتمدتها، الى جانب تحليل الأثر البيئي والحاجات من خلال تفعيل نقاط القوة والفرص، وتقليل تأثير نقاط الضعف والتهديد. واقترحت الاستراتيجيّة إطار عمل يمكن تكييفه مع خصوصيّة المنطقة ومراحل التنمية فيها.
وخلصت النتائج الى تأثيرها القوي على تمويل التنمية، وأهميتها في توليد النمو الاقتصاديّة مع ضمان استمرار الأصول الطبيعيّة، وتقلِّل من الفقر من خلال اقتصاد شامل تُستخدَم فيه الموارد بكفاءة، ويدعم خدمات النظم البيئيّة ويتعلق الأمر بأصحاب المصلحة والمؤسسات العامة والمستهلكين والسّلطات المحليّة.
كلمات المفاتيح : التنمية الخضراء، الاقتصاديّة الأخضر، الاستثمار الأخضر، النمو، التنمية المستدامة
résumé
Cet article vise à se concentrer sur les concepts de développement vert et l’importance de leur application dans la région de Baalbek, compte tenu de ses ressources naturelles, notamment dans les domaines de l’énergie, de l’agriculture, de l’artisanat, du tourisme, de l’eau et des transports Sa réalité et ses besoins d’acquisition ont été identifiés, ainsi que l’utilisation optimale des ressources et la réduction de la dégradation de l’environnement. L’étude a présenté les résultats à travers la méthodologie SWOT qui a été adoptée, en plus d’une analyse d’impact environnemental Et les besoins en étudiant les forces et les opportunités, et en réduisant l’impact des faiblesses et des menaces. La stratégie proposait un cadre qui pourrait être adapté aux spécificités de la région et à ses stades de développement Les résultats ont conclu qu’il a un fort impact sur le financement du développement et son importance dans la génération de croissance économique tout en assurant la durabilité des actifs naturels et en réduisant la pauvreté grâce à une économie verte,
Les résultats ont conclu qu’il a un fort impact sur le financement du développement et qu’il est important de générer de la croissance économique tout en garantissant la durabilité des actifs naturels et en réduisant la pauvreté grâce à une économie verte dans laquelle les ressources sont utilisées avec une grande efficacité. Les services écosystémiques sont soutenus par les parties prenantes, les institutions ,les consommateurs et les autorités locales.
Mots-clés : développement vert, économie verte, investissement vert, croissance.
المقدمة
تمتاز المنطقة بوجود مناطق ريفيّة متنوعة بفضل تنوع مواقعها الجغرافيّة، ما سمح بوجود تنوع بيئي واجتماعي ثقافي وعمراني بالإضافة إلى التّنوع في الاقتصاد المحليّ والبيئات التراثيّة التي تمثل في مجموعها مقومات جاذبة للمنطقة. تشهد منذ التّسعينيات نموًا في أنشطتها الاقتصاديّة، ولدت ضغوطًا على البيئة علمًا أنّها لا تفي بحاجات السكان، ويشكل تطبيقها في المنطقة لبنة التنمية المستدامة في المنطقة ويحقق الأهداف المرجوة لها.
الإشكاليّة: يسود المنطقة حالة من عدم الاستقرار في الطاقة، والسّلع الأساسيّة التي تتفاقم مع التّوترات الجيوسياسيّة وتهديدات التّجارة العالميّة وظرفيّة الأزمات والطّاقة والأمن الغذائي والأزمة الاقتصاديّة في لبنان، في ظل التّمدد العمراني والاستخدام الجائر للموارد الطبيعيّة وتزايد الملوثات، وتردي الأوضاع الاجتماعيّة، وتراجع منسوب المياه الجوفيّة ومعدلات الأمطار، ما يتطلب تنويع الإنتاج وزيادته.
– كيف يمكن توفير الموارد الطبيعيّة وتنويع الإنتاج الذي يتطلب قدرًا أكبر من الطاقة؟
– ما هي المجالات التي يمكن العمل بها في المنطقة، والتّحديات التي تواجهها والفرص المتاحة لكلّ منها؟
– ما ھي متطلبات مواءمة القطاعات الاقتصاديّة والبيئيّة مـع شـروط تحقیـق التنمیـة المسـتدامة والتّحـوّل نحو تنمية خضراء وضمان المنافسة؟
الفرضيّة
– ما زال بالإمكان التّصدي لتلك المشكلات من خلال تطوير الموارد، ووقف تدهورها عبر استخدام الممارسات الخضراء التي تفترض الاستفادة من التّجارب والتنمية الموجهة من البلديّات، المصلحة العامة، والتّخطيط للمجال الجغرافي للمنطقة.
– إنّ تتكيف اســتراتیجیّات تطوير القطاعات الاقتصاديّة مـع أهداف التنمیة المستدامة، والانتقال إلى التنمية الخضراء عبر استخدام الابتكار التكنولوجي الذي يفترض أن يتكيف مع الظروف والأولويات المحليّة.
– بسبب تداخل القطاعات وتشابكها، لا يمكن تطبيق التنمية الخضراء بالوقت الحاضر في ظل التّردي البيئي الراهن في المنطقة إلّا من خلال بناء آلية متكاملة تشمل قطاعات الاقتصاديّة جميعها، وتبدأ بالقطاعات الأكثر ضررًا بيئيًّا وأكثر ارتباطًا بالقطاعات الأخرى، بغية الإسراع في عمليّة التّحول نحو التنمية الخضراء.
أهميّة الموضوع: ھـي التنمیـة المستدامة ولكن بمقاربة مختلفة، وتغییر في الأولویات والتي تتمثل فی ما یلي:
– تعد التنمية الخضراء من آليات تحقيق التنمية المستدامة المهمّة، وتشكل فرصة لتطبيق تقنيات متقدمة تحافظ على البيئة والتنوع البيولوجي والأمن الغذائي، وتأمين فرص العمل والحدّ من الفقر وتحقيق الرّفاهيّة، وتساهم في الاستفادة من الموارد المتجددة.
– دور قطاع السیاحة في تحریك النّشاطات الاقتصاديّة في إطار تأمین طلب السّیاح على السّلع والخدمات
– التعرف إلى التنمية الخضراء ومرتكزاتها المهمّة ومجالاتها في المنطقة، والتعرف إلى الطّاقة المتجددة ومصادر ومدى تقبل السّكان لتسعيرها ولقيمتها البيئيّة وكيفيّة تسويقها ومدى استعدادهم للتّحول إليها.
– فتح نافذة جديدة على التمويل الدّولي، وآفاق استثماريّة جديدة للقطاع الخاص، وبناء مقترحات استراتيجيّة نحو التنمية الخضراء للمعنيين وجدوى تطبيقها، تحديد الأثر السّلبي لممارسة السياسات الاقتصاديّة على البيئة.
– یشكل قطاع السّلع والخدمات البیئيّة إحدى ركائز بناء استثمارات بیئیّة على المدى القریب، خدمات اجتماعیّة أفضل على المدى البعید وتوجیه الأنشطة الزّراعيّة الصّناعيّة نحو مشروعات صدیقة للبیئة.
أهداف الدّراسة: بناء على إشكاليّة الدّراسة وأهميتها ، تتحدد الأهداف بما يلي:
- التعرف إلى مفهوم التنمية الخضراء واستعراض أبرز التّجارب الدّوليّة، والاقتصاديّة في هذا المجال وكيفية الإفادة منها إضافة الى استعراض أبـرز الجهود المحليّة والتّحديّات التي تواجه المنطقة.
- استكشاف عناصر المنطقة ومقوماتها ومدى فاعليتها، ودورها فى جذب السّياحة بما يوفر لها أبعاد مستدامة، واستنباط مجموعة من الركائز الأساسيّة والمؤثرة على تفعيل التنمية.
- تبني استراتيجيّة تنمويّة تلبي الحاجات بكفاءة اقتصاديّة أكبر، تسمح بزيادة الاستثمارات الخضراء و بتأهيل المشاريع الصّغيرة بوصفها المحرك الرئيس للتنمية لخضراء وتنمي المهارات.
- إدراك قيمة الرأس المال الطبيعي والحفاظ عليه، والاستثمار فيه، تغييـر المسـار الذي تنتهجه المنطقة في التّعامل معه، وتحقيق تطور في مجال الطاقة والغذاء واستقلاليّة بمواصفات بيئيّة جيدة.
- تخفيض التّكاليف على الأسر ذوي الدّخل المحدود من أجل تلبية حاجاتهم (مياه،كهرباء، تدفئة،…) وإشراكهم في الخدمات الأساسيّة.
- القسم النّظري
1.1. تعاريف التنميّة
أ- التنمية المستتدامة: التنمية عمليّة اقتصاديّة اجتماعيّة سياسيّة ثقافيّة بيئيّة شاملة، ورفع مستوى حاجات الإنسان الأساسية والثانوية ونوعيتها في المدى القريب والبعيد، تتميز بالاستمراريّة في مداها والتّكامل في أبعادها والشّموليّة في مناطقها والتّوازن البيئي الذي ينظم استخداماتها، وتستوجب استتدامتها التغلب على عقبات كثيرة، وتحديات من أهمها القضايا البيئيّة، ولا يمكن الاستمرار بالتنمية من دون أخذ الأبعاد البيئيّة بالحسبان، ولا يمكن الاهتمام بالبيئة والتّوقف عن التنمية، بل يجب التّوفيق بين التنمية والبيئة عن طريق إدارة الموارد الطبيعيّة في سياسات وخطط التنمية، يأخذ فيها الاقتصاد الأخضر بعدًا بيئيًّا، ويعد آلية أساسيّة في التنمية.
ب- التنمية الخضراء: تعبّر التنمية الخضراء عن النّمو الاقتصادي، والأمن الاجتماعي والإدارة المستديمة للأصول المحليّة والطبيعيّة والثقافيّة والحفاظ على التنوع البيولوجي، والحدّ من الآثار السلبيّة للتنمية على البيئة، وذلك بتوجيه الاسـتثمارات الخاصة نحو رفع كفاءة الموارد وإنتاجيّة الطّاقة والمياه، وخفض النّفايات والتلوث والقدرة على خلق فـرص عمل جديدة إضافيّة ودعم ذوي الدخل المنخفض. وعليه، فالتنمية المستدامة تحدُّ من المخاطر البيئيّة، بينما التنمية الخضراء تحقق التنمية من دون أن يؤدي ذلك إلى التّدهور البيئي. ويُعد الاهتمام بالتنمية الخضراء والنّظر نحو الاقتصاد الأخضر نشاطًا اقتصاديًّا صديقًا للبيئة وأحد سبل تحقيق التنمية المستدامة (مؤتمر ريو دي جنيرو) يلزم حكومات الدّول بتطبيق نمو اقتصادي عادل ومستدام.
ج- دوافع تطبيق التنمية الخضراء في المنطقة
– تتأثر التنمية في المنطقة بالعوامل الخارجيّة السّلبيّة أكثر من الإيجابيّة، بسبب انعدام المرونة لقطاعاتها الانتاجيّة وهشاشة هيكليّة بنيتها الاقتصاديّة، والعجز في مقوماتها وارتفاع معدلات البطالة والفقر وأزمة توفير الطاقة وارتفاع عدد الأسر قليلة الدّخل.
– إمكانيّة تحول المشروعات الصغيرة والمتوسطة نحو الاقتصاد الأخضر وإمكانيّة الاستفادة من التّجارب
– تشكل حجر الأساس فــي عمليــة التنمية : ترى المنطقة نفسها مجبرة على تطبيق التنمية الخضراء نظرًا لتوفر المقومات والإمكانيّات وذلك من أجل النّهوض بالصّحة، والتّعليم والبنية الأساسيّة وتحقيق العدالة وتنمية قدراتهم على الإنتاج الزراعي، واستصلاح الأراضي وتوفير المياه وتنفيذ مشاريع تنمويّة حرفيّة ريفيّة
وتشجيع الاستثمار في رأس المال الطبيعي، والقضاء على الفقر وتحسين الرّفاه وخلق فرص عمل.
– يساعد التّحول نحو الاقتصاد الأخضر في نقل المنطقة إلـى اتجـاه جديد في التنمية يضـمن الاسـتدامة في البيئة بجانب الاقتصاد، ويعمل على تطوير الانتاجيّة وذلك بسبب عدم قدرتها على التأثير القوي والمباشر في البيئة السياسيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة، ومن أجل زيادة دور البلدات لا بدَّ من إعادة تشكيل الأنشطة الاقتصاديّة لتكون أكثر مساندة للبيئة والتنمية الاجتماعيّة وتكون شاملة لكل المناطق.
د- مؤشرات التنمية الخضراء والمجالات التي يمكن أن تعتمدها
انطلاقا من دوافع تطبيق تنمية الخضراء، فإنّ التنمية تشمل البلدات جميعها، تعتمد في الصّناعة والاستثمار والزراعة على طاقات جديدة ومتجددة ومستدامة، مع اعتماد الأولويات المحليّة للمنطقة، ومع ذلك تواجه التنمية الخضراء تحديات كبيرة على الصّعيد الاقتصادي والتنظيمي والتكنولوجي، الأمر الذي استلزم البحث عن الفرص ونقاط القوة للاستفادة منها ومن التّهديدات، ونقاط الضّعف لمواجهتها بالحلول المناسبة.
يمكن حصر المجالات الأساسيّة والهيكليّة للتنمية الخضراء في المنطقة والتي يمكن تطبيقها وإدارتها في: الطاقة المتجددة التي تعدُّ مجالًا مهمًّا، السّياحة المستدامة، إدارة النّفايات، التكنولوجيا الخضراء، الإدارة المستدامة للاراضي الزراعيّة والتّخفيف من أثر التّصحر، إدارة المياه، النقل المستدام، العمارة الخضراء.
2.1. اعتمدت في تحليل المعطيات على مرحلتين
– SWOT : هي اختصار لترتيبات مختلفة لكلمات “نقاط القوة” و”نقاط الضعف” و”الفرص” و”التهديدات”. ومن خلال تحليل البيئة الخارجيّة (التهديدات والفرص)، والبيئة الدّاخليّة (نقاط الضعف والقوة)، مكنني استخدام هذه الطريقة من وضع استراتيجيّات للتنمية الخضراء من خلال الاستفادة القصوى من نقاط القوة والفرص، التّغلب على نقاط الضعف وإدارة التهديدات.
– تحليل الاحتياجات الرئيسة بناء على الخطة الرّباعيّة، وصياغتها كعناصر يمكن تحقيقها.
– تحليل الأثر البيئي: تحقيق الأهداف استراتيجيّة جديدة، أو نجاحات استرتيجيّة يمكن التوسع فيها.
– بيستل: يستخدم لتحليل عوامل البيئيّة لأي قطاع يأخذ بالحسبان ستة مجالات للتنميّة وهي:
العوامل الاجتماعيّة وتشمل الدّيموغرافيّة والعادات، العوامل السياسيّة وتشمل تدخل الحكومي إضافة الى العوامل الاقتصاديّة والعوامل التكنولوجيّة، العوامل البيئية والعوامل القانونيّة، استفدت منها بالنّحو الذي يفيد المقال.
- واقع المجالات التي يمكن تطبيق التصنيع الأخضر في المنطقة
1.2. المجال البيئي
1.1.2. الطاقة المتجددة
أ- واقع الطاقة المتجددة في المنطقة: بات استخدام الطاقة الأحفوريّة في المنطقة مضنٍ بسبب الفساد الإداري انخفاض الدّخل وارتفاع سعر فاتورة المولدات، وقصور أداء شبكة الكهرباء العامة.
إن استفحال تلك المشاكل كان دافعًا أساسيًّا لتسريع وتيرة الاعتماد على الطاقة المتجددة، كونها تشكّل الأداة المحركّة لتأهيل القطاعات كافة خاصة البنى التحتيّة وقطاع الزراعة والحرف والنّقل والسياحة والمياه وغيرها. وبذلك، تمتلك المنطقة فرصة ذهبيّة، لوضع استراتيجيّة لتنويع مصادرها المتاحة خاصة مع منافسة الطاقة المتجددة، وهذا يفتح المجال لخفض كلفة الكهرباء وزيادة تنافسيّة القطاعات المحليّة، وحماية البيئة. زاد في السّنوات الأخيرة نسبة الاعتماد على الطاقة المتجددة، وتفاوتت نسبتها بين القطاعات، بسبب كلفتها المرتفعة في القطاعات الإنتاجيّة، في الزراعة والحرف. وما زالت عشرات الأسر تعاني من فقر الطاقة.
أنواع الطاقة القائمة
الطاقة الشّمسيّة: تستقبل المنطقة كميات كبيرة من أشّعة الشّمس التي يمكن الاستفادة منها عن طريق تركيب الألواح الإلكترونيّة ما يساهم في تخفيف العبء على قطاع المحروقات.
ب- طاقة الرياح: بفضل وجود العديد من النسافات، زيادة سرعة الهواء، وعليه، تعد مصدرًا بديلًا للطاقة، ومن شأنه تنمية الاقتصاد وتمتاز بتقنياتها المتطورة تعمل ذاتيًّا لا تحتاج الى صيانة مستمرة أو وقود.
2.1.2. واقع التنمية العمرانيّة الخضراء: يكون العمران في المنطقة عفويًّا على حساب المساحات الخضراء، الى جانب تدهور المباني القديمة والتّراثيّة الدّاعمة للهُويّة والانتماء وتلويثها للمشهد العام، وهذه المشاكل يمكن معالجتها وتحويلها الى فرص للتنمية العمرانيّة الخضراء وفق ثلاثة نقاط:
أ- التعمير العفوي: يتفاعل السكان مع بيئتهم وفاق الاستفادة المثلى من الأرض، يمثل العمران العفوي نوعًا من الاستثمار، ما يساعدهم في جعل تجمعاتهم العمرانيّة قانونيّة تفي باحتياجاتهم ومتطلباتهم الاجتماعيّة والثقافيّة، ماديًا وروحيًا، يتميز:
– الاكتفاء الذاتي: تضمين استخدام التكنولوجيا والموارد المحليّة بما يدعم احتياجاتهم اليوميّة المتغيرة.
– التّكامل مع البيئة: هو شراكة متكاملة بين سكان المنطقة وأماكنهم، ما يؤکد أهمّيّة استعادة المبادئ والقيم الاجتماعيّة العفوية التقليديّة برؤية جديدة. لکي تکون البيئة الحضرية الحديثة مستدامة اجتماعيًا.
ب – الفراغات العمرانية يتكون طابع وهوية أي مكان في المنطقة من تفاعل السكان مع فراغاتها العمرانيّة، فمن خلالها يتذكرون أماكنهم، وقد أدى إهمالها الى هجرها وتشوهها وفقدانها لوظيفتها خاصة الفراغات التاريخيّة منها، خاصة وأن المخطط التوجيهي لبعلبك العام 2009 لم يتطرق إليها.
ج- المباني الخضراء التي بدأت تنمو: تتمثل في البلدة من خلال العلاقة ما بين السّكان والبيئة، واستخدام مواد معاد تدويرها في البناء، ومتناسقة مع التّصميم، يضع السكان وضع الحجر المقصوب بدل الدّهان، يستخدمون الطّاقة النّظيفة في التبريد والتّسخين، تستكمل أحيانًا باستخدام العوازل الحراريّة للأسقف والجدران الدّاخليةّ، كما تُحصَد المياه من خلال تجميع مياه الأمطار عن السّطوح، وتجميعها في خزانات تُنشاء أثناء بناء المباني. تجميع المواد القابلة للتدوير في كمبوست في الحدائق التابعة لها.
3.1.2. المياه: تعد الموارد المائيّة مركزًا أساسيًّا في التنمية الخضراء لارتباطها المباشر بالقطاعات الزّراعيّة والصناعيّة والبيولوجيّة والاجتماعيّة، تعد المنطقة هي من أكثر المناطق اللبنانيّة فقرًا بالمياه، حيث المسار التّنازلي لكميات المياه المتاحة فيها ، يمكن حصر المشكلة في ثلاث نقاط:
– الجانب البيئي: ضعف كمية مياه المصادر المائيّة على الرّغم من تعددها فأغلبها ينابيع موسميّة، وبعضها لا ينبع في السّنوات التي تقل فيها الأمطار عن معدلها العام، وجفاف بعضها الآخر بشكل كلي.
– الجانب المؤسساتي: غير فاعلة في تأمين مياه الشّبكة، تُصَان بطريقة تلقائيّة أي بعد حصول العطل تعاني من نقص في عدالة التّوزيع أو عدم توفر شبكة مياه بالأصل، وقد بلغ متوسط فاقد المياه حوالى 70% ما بين اهتراء وتسريب للشّبكة، والتّعديات عليها وأخطاء في الفوترة وعدم الدّقة في العدادات؛ إضافة الى عدم توفر شبكة لمياه الصرف في معظم البلدات؛ ما يؤدي الى تلويث المياه السّطحيّة والجوفيّة.
– الجانب الثقافي للأسر: تُهدر المياه أمّا في الاستخدامات المنزليّة أو في ري المساحات التّابعة للمنازل.
4.1.2.النفايات
يُتخلص من النفايات داخل الأحياء بشكل كاف، ويُفعل الاقتصادي الدّائري الذي يقوم على تدوير المنتجات ضمن نمطين مع الفرز المنزلي: إرجاع المواد القابلة للتحلل الى الأرض مثل الأسمدة الناتجة عن المواد العضويّة في مساحات المنازل، وإعادة تدوير المواد القابلة للتدوير من خلال إعادة استخدام المواد بعد نقلها.
2.2. الاقتصاد الاخضر
تواجه التنمية الاقتصاديّة بالمنطقة تحديات كثيرة، أهمها الإهمال، الفقر القديم، والاضطرابات الاقتصاديّة خاصة أحداث سوريا، وأزمة الحدود وإغلاق المعابر، إضافة الى تدفق الآف اللاجئين الى المنطقة، وقد أعقب ذلك جائحة كورونا وأزمة المصارف وأموال المودعين. كبّد هذا الواقع خسائر اقتصادية فادحة بالمنطقة. للجانب الاقتصادي ببيئة المنطقة عدة أشكال هي: المياه الجوفيّة الزراعة والغابة الحرجية والمراعي وأدى استخدامها المفرط إلى تدمير المنظومة البيئيّة، بينما تحمي التنمية الخضراء البيئة من التدهور.
1.2.2. السياحة
– السياحة الخضراء في إطار التنمية الخضراء: تعد موردًا تنمويًّا مهمًّا، توفر عشرات الوظائف، وتؤمن العملة الصّعبة، وتحسن المستوى المعيشي في المنطقة كونها تدخل في الدّورة الاقتصاديّة، وتؤدي دورًا في جذب الاستثمارات مع الحفاظ على الإرث الطبيعي والتّاريخي. وتعد خيارًا استراتيجيًّا لتثمين الاقتصاد، وتحدُّ من الأثر السّلبي للسّياحة وتنمي المساحات الخضراء في البلدات.
العوامل المشجعة للسياحة الخضرء في المنطقة
– الموقع الاستراتيجي لمنطقة تحدها ثلاث محافظات تمكّن السّائح من التّجول بين السّاحل والدّاخل، بمسارات يستمتع السّائح خلالها بالمناظر الخضراء الجميلة مثل طريق المنيطرة، الأرز، القبيات.
– تتنوع مناخي كبير جدًا بين مناخ جبلي رطب، مناخ داخلي جاف، ومناخ شبه صحراوي، وتضم المنطقة عناصر سياحيّة متعددة، تشمل مواقع سياحيّة أثريّة مدرجة على لائحة التراث العالمي، ومواقع طبيعيّة تتفرد فيها على مستوى لبنان.
– تتميز المنطقة بغنى المنطقة بالمواقع السّياحيّة وتنوعها، إذ تتلاءم بيئتها للسياحة بمختلف أنواعها جبليّة وريفيّة، رياضيّة وبيئيّة واستكشافيّة، وتتميز بالعديد من المواقع الأثريّة التي تؤرخ القيمة التّاريخيّة العالميّة للمنطقة والمصنفة من الآثارات المهمّة في العالم خاصة هياكل بعلبك وأعمدتها وأدراجها ومعابدها.
– تتميز بغناها الثقافي مثل تنوع الأديان واحتوائها على رموز مقدسة وأثرية لأتباع تلك الدّيانات، العادات والتقاليد والفنون، وتنوع الأنشطة الحرفيّة الغذائيّة وغير الغذائيّة، الرياضة وتبادل الثقافات والبساطة والسّعر المناسب لأغلب السّياح وعي السكان لتنمية السياحة، ورغبتهم في استقبال السياح وبيع منتجاتهم.
المشاريع السياحيّة البيئيّة التنمويّة المهمّة
تتميز بلدات المنطقة باختلاف خصائصها السياحيّة وتنوعها وتشمل:
سياحة الطعام والشّراب Culinary Tourism: فن وتقاليد الطبخ، بيت الضيافة الصفيحة البعلبكيّة، الكشك.
أنشطة ترفيهيّة: الاستمتاع بمناظر الدّارات، التجول داخل المحميات والتعرف إلى التنوع الحيواني والنباتي داخلها، والشّلال وتدفق المياه في اليمونة والعاصي، المحميات، بيئة مناسبة للأنشطة الرياضيّة.
أنشطة بيئة: تسلق الجبال موسم قطاف الكرز الجبلي المتأخر، المشمش، والتّفاح الجبلي، تمتد من حزيران لغاية أيلول، في المدّة التي تنشط فيها حركة السياحة ومهرجانات بعلبك الدّوليّة ويزيد التّسوق.
سياحة دينية: تستقطب: بعض المقامات الدّينيّة تستقطب زوارًا من خارج لبنان مثل مقام السّيدة خولة ومقامات أخرى تستقطب من خارج المنطقة وأهمها: القديسة رفقا.
السّياحة التراثيّة Heritage Tourism: الأبنية القديمة والأبنية التراثيّة: تهتم بالتراث العمراني وتحافظ عليه، من خلال التوافق العفوي المترابط مع البيئة والاستغلال الأمثل لمصادر البيئة الطبيعيّة.
2.2.2. ضعف البنية الصناعيّة على الرّغم من أهميتها في الاقتصاد الأخضر
واقع القطاع الصناعي في المنطقة: تعد الصناعة أحد المقومات الأساسيّة للتنمية، توجد في المنطقة عشرات المشروعات الصغيرة، تلقى المشروعات الغذائيّة أهمية كبيرة نظرًا لصيتها المحليّ والمناطقيّ، وتشمل معامل الألبان والأجبان بشكل أساسي، تعتمد المنطقة على الموارد المحليّة الأوليّة خاصة الحليب والفواكه والخضراوات ما يساهم في خفض التكلفة الإنتاجيّة، تحتاج لمساحات صغيرة وتراعي احتياجات السّوق وتلبي جزء منها، وتتكيف معها بسرعة، تساهم في رفع المستوى المعيشي.
3.2.2. الزراعة والتنمية الخضراء
إنّ إنتاجيّة أكبر مع استخدام أقل للموارد مثل المياه، ومبيدات الآفات والوقود الأحفوري أمر أساسي للتنمية الخضراء. تعزز الاستهلاك المستدام للموارد الطبيعيّة وتحسن إنتاج القطاع الزراعي، وتشمل:
– استخدام البذور البلديّة وحفظ عدد كبير من سلالات وأصناف تتميز بها المنطقة: في ظل التنوع الكبير للتضاريس والمناخات المحليّة، يعاد زرعها لتجديدها مرّة كـل خمـس سنـوات، ويُنشاء بنك جيني في تل عمارة الذي يعدُّ الأكثر أهمّيّة في الشّرق الأوسط، فهي تشكّل المكونات الأساسيّة للمادة الوراثيّة للمحاصيل، وتحافظ على استدامتها من خلال قدرتها على الصمود أمام التغيرات المناخيّة والبيولوجيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة.
– بالنسبة إلى الأشجار الحرجيّة: يجري حاليًّا عمليّة تحريج علمية واسعة، تسمح بالتأقلم بشكل أفضل مع التّير المناخي، من أجل بناء مخزون استراتيجي من بذور الأشجار الحرجيّة، مع توفير أكبر تنوّع جيني ممكن لها، أحيانًا يُحصَل على شتول من الخارج من دون معرفة إذا كانت مطابقة للمخزون الجيني اللبناني.
– استخدام بذور عالية الجودة: يرغب المزارعون ببذور لديها سمات الجودة الغذائيّة، ويمكنها مقاومة الأمراض والجفاف وارتفاع درجة الحرارة والملوحة، وتفرض إدارتها التنوع بين الأصناف وتحسينها لتزيد من إنتاجيّة المحاصيل، من أجل الحصول على عوائد أفضل.
– الري الذكي: تُستخدم المياه بكفاءة ومنع فقدان المياه والتّخفيف من استهلاكها، من خلال جدولة الري باستخدام نظم استشعار الرطوبة، ويمكن التّحكم فيه من خلال تطبيق على الهاتف الذكي. ويحدد النّظام أفضل وقت للري، ومدة الري، وكمية المياه اللازمة كلفة ُنظم التّحكم لمساحة 6 دونم 7000 $ .
– إنتاج طاقة خاليّة من التّلوث: من أجل تجفيف المحاصيل أو تدفئة المساكن والحظائر والبيوت الزراعيّة، توفير المياه السّاخنة، توليد الطاقة لتشغيل المعدات الزّراعيّة ومضخات المياه؛ الإضاءة.
– الرّي بمياه الصّرف الصّحّيّ غير المعالجة على الرّغم من توفر محطة تكرر: تحتوي مياه الصّرف الصّحي على مغذيات قد تفيد الزراعة، لكن يقتضي الاستخدام السّليم لمياه الصّرف الصّحّي مراعاة بعض الاعتبارات مثل سلامة إعادة الاستخدام؛ علمًا أنّ إعادة استخدام مياه الصّرف الصّحي هي من الحلول الممكنة للتّكيف مع آثار تغير المناخ، يمكن استخدامه في الزراعة، والري الحضري.
– إعادة استخدام النُّفايات العضويّة هي طريقة مستدامة وصديقة للبيئة في إدارة النّفايات: هي نظام تسميد مصمم لإدارة النفايات العضويّة، وهو نظام محكم الإغلاق لإبعاد خطر جذب الآفات وانتشارها. وتصل سعته إلى 20 كيلوغرام. يحافظ على الرّطوبة ومنع الأمراض ويحسن السّماد العضوي الخصائص الفيزيائيّة والكيميائيّة والبيولوجيّة للتربة، ويزيد من إنتاجيتها.
– تخصيص مساحة معيّنة في الأراضي الشّاغرة أو سطوح المباني: تزرع الخضروات في ألواح بلاستيكيّة معاد تدويرها، وحدة تسميد للتخلص من المخلفات الغذائيّة لاستخدامها كأسمدة طبيعيّة في الألواح الأيكولوجيّة، تسمح لهم بالحصول على منتجاتهم وبيع الفائض.
– استخدام مصدر مهمّ للتّسميد بواسطة الدّيدان: وطريقة سريعة لمعالجة النّفايات العضويّة من المصدر مجددة للتربة تساهم في استعادة جودتها، وتعزيز الأمن الغذائي في المنطقة يعزز نمو النّبات، يزيد مساميّة التربة يقي من الأمراض النباتيّة، يقلص الحاجة إلى الأسمدة الكيميائيّة؛ يحسن احتباس المياه والتهوية.
- تحليل المعطيات باسخدام الخطة الرباعية swot والاحتياجات والأثر البيئي
- البيئة الطبيعية
1.1.3. تحليل معطيات البيئة الطبيعيّة
| – تنوع كبير في المناخات المحليّة وتعدد الأنظمة البيئية فيها، وتنوع كبير في الغطاء الحرجي و تمتلك المنطقة أهمّية مكانيّة وجغرافيّة كبيرة لقربها من محافظات.
– وجود العديد من المحميات الطبيعيّة والدارات ذات الهُويّة المكانيّة ومراقبة دورية لمأموري الأحراج من أجل حمايتها. – مناطق رعوية واسعة تستقطب المزيد من رؤوس الماشية ، تؤمن حاجة المنطقة من لحوم وألبان. – وجود دراسات حول بعض المكبات منها مكب الكيال. |
نقاط القوة |
| – عدم الاستفادة من الموقع وضعف الاستقطاب من الأقضية المجاورة.
– انقراض العديد من الأنواع الحرجيّة، تدهور الغطاءات الحرجيّة والرّعويّة والزراعيّة. – زيادة الحمولة الرّعويّة للمراعي والقضاء على أنواع حرجيّة عبر رعي براعمها مع زيادة عدد المواشي رؤوس في ظل النقص الكبير في مأموري الأحراج. |
الضعف |
| – وجود جمعيات مهتمة بالثروة الحرجية إضافة الى وجود مشاتل للتحريج.
– وجود مئات الأشجار الحرجية المثمرة يمكن تطعيمها لتشكل فرصة لحماية الأحراج ولاستقطاب الزائرين. – وجود بنك لحفظ الأنواع الحرجية في تل عمارة. |
الفرص |
| – تنامي ظاهرة التّصحر وتأثيرات التّغير المناخي على الغطاء النباتي.
– تمدد عمراني كبير واستمراريّة المشاكل البشريّة، واستفحالها خاصة القطع والرعي الجائر في ظل عدم وجود مخطط توجيهي يحدد استخدامات الأراضي. – ضعف تطبيق القوانين والاستقواء بالزعيم. |
التهديدات |
2.1.3. تحليل الاحتياجات الرئيسة وتحليل الأثر البيئي
ض+ت: تؤدي المشاكل الطبيعيّة واستفحال مشاكل التمدد العمراني الرّعي والقطع الى تدهور مساحات واسعة من المساحات الحرجيّة، وانقراض العديد من الأنواع وسط عدم تطبيق القوانين والمحسوبيّات، ولا بدَّ من إحياء تلك الأنواع بجهود اتحادات البلديات وتوفر بنك البذور والشّتول، أو اختيار أصناف قريبة واقتصاديّة، وبشكل مدورس حتى لايؤثر ولا يتأثر اختلاف سرعة نمو الأشجار المَنوي تحريجها على الأشجار الموجودة، وكذلك من أجل الحفاظ على التّنوع الحيوي أو إعادة ما يمكن استرجاعه، مع ضرورة اعتماد طرق مختلفة في تقنيات التحريج فتُنشاء الجلول بأنواعها أو الأكياس في الانحدارات المتوسطة وحصر الطرق ذات الكلفة الأعلى نسبيًّا مثل طريقة البراميل في الانحدارات الشّديدة.
ف+ ق: الاستخدام الأمثل للأراضي من أجل توسيع المساحات الخضراء
– الاستفادة من تنوع بيئات المنطقة وتنوع أشجارها الحرجية في السياحة، وتكريس الهُويّة المكانيّة والجميلة وتشجيع العلاقات مع الجوار حيث نقاط التّشابه، والاختلاف بالبيئة والثقافة والمستويات الاقتصاديّة والاجتماعيّة.
– التّوسع الزراعي: زيادة المساحات المزرعة عن طريق زراعة الأراضي المتروكة، استصلاح الأراضي الحرجيّة المتدهورة بشكل كلي والقريبة من مصادر المياه، وزراعتها بأشجار مثمرة بريّة بنفس الأنواع المحيطة بها مثل الإجّاص البري، المشمش البري، اللوز البري، السّماق ومن ثَمَّ تطعيمها، ويعتمد أصحاب البساتين الطريقة نفسها وذلك من أجل تأصيلها حتى تتمكن من مقاومة العوامل البيئية.
2.3.تحليل معطيات البيئة العمرانيّة
| – وجود علاقات بين البلدات ما أدى الى نمو عمراني على طول المحاور الرئيسة.
– نمو عمراني عفوي في معظم النّويات، ومحيطها يسهل التخطيط إضافة الى تنوع أشكال التجمعات العمرانية في المنطقة . – تحتفظ النويات بالاستمراريّة على الرّغم من التّغيرات التي طرأت إضافة الى وجود مبان عمرانيّة قديمة تراثية يمكن الاستفادة منها. – توجه حالي لبعض الأسر الى بناء مساكن تتلاءم الى حد كبير مع المساكن الخضراء. |
نقاط القوة |
| – تمدد عمراني حديث متسارع.خاصة على الأراضي الزراعية التي تشكل مصدرًا أساسيًّا للدخل.
– يعيق صطفاف المباني عملية التجدد النسيج القديم المقترن بتغيير الفراغ العمراني. – إهمال المباني القديمة والفراغات العمرانيّة، وعدم دعم الحرف، طبيعة الاستخدام خدمي وليس استثماري، الاعتماد على المنح الخارجيّة في عمليات التّرميم، ضعف التسويق على أنّها أبنية سياحيّة ، نقص المشاركة في القرارات المتعلقة باستخدام المبنى. – ضعف الموارد الذاتية للبلدات، ومكبات عشوائيّة ونقص كبير في عمليات التخلص منها ورداءة البنى التحتيّة. – غلاء أسعار العوازل الحرارية إضافة الى عدم معرفة الكثيرين بها. |
نقاط الضعف |
| – وجود مساحات سفحيّة واسعة متروكة يمكن استغلالها في التّوسع العمراني، وجود فراغات عمرانيّة، ونمو أفقي للمباني يمكن الاستفادة منها عبر التكثيف الافقي والعامودي.
– وجود قطع أراضٍ سكنية غير موزعة وغير مستغلة، يمكن اعتماد كثافات سكانيّة حسب نوع الحي وموقعه، ويمكن اعتماد النمو العامودي في المباني خارج النويات والمناطق الأثرية. – انقطاعات ضئيلة كنها لكثيرة في بعلبك بسبب المباني المهدمة والأراضي الخالية بمكن تأهيلها للاستخدامات العامة. – قانون 646 يقضي بالزام وضع سخان شمسي وألواح للطاقة الشمسيّة في رخصة البناء في لبنان . – رغبة ربات المنازل بمساكن تقل مساحتها عن 200م2 كي يسهل تنظيفها، ما يعطي فرصة لوضع العوازل الحرارية ويوفر مساحات زراعية. – وجود المجلس البلدي واشراكهم في القرار وادراج المشاريع الحضريّة . |
الفرص |
| – تعدد المحاور يهدد بمزيد من التمدد العمراني على الغطاء النباتي.
– تزيد المحسوبيات من الشرخ بين المجتمع بسبب عدم العدالة في تطبيق القانون. – تفاقم مشكلة التمدد بسب عدم وجود مخططات والتي تكون أسهل قبل إشغال الأراضي. |
التهديداتت |
2.2.3. تحليل الاحتياجات الرئيسة وتحليل الأثر البيئي
ض+ ت: يهدد النّسيج العمراني في النويات بطمس الهُويّة المكانيّة لها بفعل الإضافات العشوائيّة، ما يساعد على فكّ الارتباط بها تدريجيًّا، لذا يجب تأهيلها وفاق الأهمّيّة التاريخية والمكانية لها حتى يقلّ التشابه بين الفراغات ويزيد الإحساس بالمكان، ويجب ضبط التوسع العمراني الذي يزيد مشكلات نقص الخدمات ومساعدة السكان لإنشاء مساكن خضراء عبر قروض ميسرة في ظل ضعف الدخل.
قوة+ فرص
النّمو العمراني العفوي والتكثيف العمودي والأفقي للعمران، يوفر مساحات يمكن استثمارها في التنمية الخضراء تتركز في مناطق السفحيّة للبلدات ذات الاطلالة الواسعة وغير المستغلة، وهي أقرب الى النويات من التجمعات التي تتنامى حاليًّا في السّهل، من أجل الحفاظ على الغطاء النباتي من التّمدد العمراني بعد وضع مخطط توجيهي، يساعد التوسع على تلاحم البلدات من الجهة السّفحيّة، وتعزيز العلاقات بين أهلها والحفاظ على الأراضي الزّراعيّة والحرجيّة من التمدد العمراني.
– تصمم الطرقات الثانوية بحسب النمط العمراني السّائد، وبما أنّ النّمط السائد في البلدات جميعها هو شعاعي، فيكون الطريق الدّائري هو الأنسب لربط الطرقات الفرعيّة جميعها المتجهة في كلّ الاتجاهات ومنعًا للازدحام في النّويات والتّخفيف من التمدد العمراني، كذلك يبدأ الطريق المقترح في بعلبك من عين بورضاي وينتهي في المدخل الشّمالي، علمًا أنّه يمكن توسيع الطرقات الفرعيّة الواقعة ضمن الطريق المقترح وتأهيلها على أن يكون بيئة وافرة الظلال طوال الیوم.
– استحداث فراغات عامة جديدة ومناطق خضراء وساحات انتظار السيارات وغيرها من المساحات العامة، حماية المناظر الطبيعية من حدائق عامة تكون ذات اطلالة واسعة وقريبة من السكن وسهل الوصول اليها.
– ضرورة الحفاظ على المباني القديمة وتأهيلها وترميمها من قبل مختصين، فهي مبنية بالطين الذي يمتص الرطوبة الزائدة والروائح ولها الامكانية في تراكم الحرارة والتبريد على مدّة طويلة.
1.3.3. تحليل معطيات قطاع الطاقة المتجددة
| تعتمد 60%من الأسر الطاقة الشّمسيّة بحسب شركات توزيع الألواح.
– توفرالكفاءات في مختلف التّخصصات. – يمكن بيع الفائض عن الحاجة لشبكة الدولة في حال جرى تنظيمها والحصول بقيمتها على كهرباء مجانية أثناء التغييم. – يمكن استعادة رأس مال المستثمر في الزراعة خلال مدّة ثلاث سنوات تبعًا لمردود المحصول ثم تخفض انتاجيتها بعد العشرة سنوات ويترواح متوسط عمر الطاقة عادة بين 10 و15 سنة. – الانفاق على الطاقة البديلة ورضاهم عنها. – الاستثمار في مشاريع مربحة ، مع وجود حوافز تشجيعية للاستثمار فيها منها التقسيط والقروض الميسرة. – تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار فى تكنولوجيات الطاقة المتجددة. |
نقاط القوة |
| – التقنين وعدم دفع الفواتير وتهريب الوقود. انخفاض دعم الدّولة للطاقة، مع عدم وجود معلومات كاملة عن قطاع الطاقة في المنطقة
– يمكن أن يؤثر الغبار والتّغييم والحرارة التي تزيد عن ال30 درجة صيفًا على أداء الألواح. – لا يوجد تكنولوجيا رقميّة تتعلق بالمبانى التى تعتمد على الطاقة الكهربائيّة فى التدفئة والتسخين والتبريد والإنارة كما أن تكنولوجيات البطاريات الحاليّة غير كافية لتحقق إمكانيّة التخزين الموسمى للطاقة الكهربائيّة الشمسيّة على نطاق واسع. – نقص المهارات والقدرات الملائمة لتركيب تكنولوجيات الطاقة وتشغيلها وصيانتها، – تكاليف الحلول المتاحة خارج الشّبكة من خلال الشبكات المصغرة مرتفعة للتجمعات العمرانيّة البعيدة إضافة الى ارتفاع التّكلفة الاستثمارية الأوليّة لمنظومة إنتاج الطاقة الشمسيّة. – الحاجة لتعزيز الكوادر البشرية المتخصصة. |
نقاط الضعف |
| – توافر مصادر الطاقة المتجددة الأولية بصورة واسعة غير مستغلة، خاصة الطاقة الشّمسيّة، وطاقة الرياح والوقود الحيوي يمكن أن تسد الفجوة بين العرض والطلب على الكهرباء.
– الطلب المتزايد على الطاقة الشّمسيّة والدّعم المقدم من الدول المانحة لانشاء بنى تحتية. – يشجع موقع المنطقة على استخدام مصادر الطاقة. – تجارب ناجحة في مشاريع الطاقة الشّمسيّة التي صممت للبلدات. – تزايد الطلب على الطاقة البديلة للتوسع في المشاريع الزراعيّة. |
الفرص |
| – ضعف التصنيع والبحث والابتكار المحلي في بناء وتركيب منظومة الخلايا الضوئية.
– ارتفاع التكلفة الاستثمارية لمشروعات الطاقة الشّمسيّة، وتحديات فنية تتعلق بالجوانب الفنية لتشغيل وصيانة الاجتماعيّة هزة والمعدات وتنظيفها ، وكذلك التخزين. – ضعف تنافسيّة الطاقة المتجددة مع وجود دعم الحكومة للطاقة الأحفورية. |
التهديدات |
2.3.3. تحليل الاحتياجات الرئيسة وتحليل الأثر البيئي
ض+ت: المشاكل التقنية والبيئيّة التي تؤثر على الطاقة، وارتفاع كلفتها وضعف الابتكار والبحث بشأنها، ولا بد من تأهيل الكوادر المحليّة المختصة وتشجيع تصنيعها، وتنويعها حتى تتلاءم مع الظروف البيئة.
ف+ق: صغر السّوق وتدني القيمة الشّرائيّة، وتباعد المسافات بين البلدات والتّجمعات العمرانيّة تشكل تحديًّا في الكلفة، والجدوى الاقتصاديّة من إنشاء بنية تحتيّة لتوفير الاحتياجات على غرار كهرباء زحلة وجذب الاستثمارات الخارجيّة. وتعزيز التعاون بين البلديات.
زادت- في المقابل- الطاقة المتجددة من إيرادات شركات الخاصة، وتؤمن عشرات الوظائف، ووفرت على الأسر ما لا يقل عن 70% من فاتورة الكهرباء مع تأمين الكهرباء بشكل متواصل، وفتحت المجال للاستثمار في التّصنيع وفي الزراعة، وساهمت في استكمال الدورة الاقتصاديّة كما تخفّض تكاليف إمدادات شبكة الكهرباء، ولا بدَّ من التّواصل مع الوزارت المرتبطة بقطاعات الصّناعة، والزّراعة والنّقل والسّياحة والمياه لتحديد المناطق التي سيزيد فيها الطلب على المياه حاليًّا ومستقبلًا.
تعزيز قدرات التّصنيع المحلي في مجال البطاريات، والمحوّلات في اطار الميزة التنافسيّة التكنولوجيّة وتطوير قطاع الخدمات التّابع لها.
إنشاء مخامر بيوغاز محصورة التّجارب، لقيت نجاحًا في مؤسسة جهاد البناء، هذا يساهم في تفعيل الزراعة المستدامة وصحة الإنتاج الزراعي وسلامته والتّقليل من تلوث المياه.
وذلك عبر انتاج السّماد العضوي للزراعات العضويّة، وإنتاج الطاقة الحراريّة والأعلاف والغذاء الميكروبي، تعتمد على فضلات المزارع الحيوانيّة، علمًا أنّه بالإمكان استخدام النُّفايات المنزليّة. تشكل المكبات ومياه الصّرف الصحي فرصة لاستخدامها.
– تعد سرعة الرّياح الموجودة في المنطقة مناسبة لإقامة مزارع رياح لإنتاج الطاقة الكهربائيّة، وتزيد سرعة الرّياح عند الممرات الجبليّة في بلدات اليمونة، عيناتا، الحدث.
-التّشجيع على استخدام المركبات الكهربائيّة داخل مدينة بعلبك لتأمين هواء نظيف للسياحة، وذلك عبر الإعفاءات الجمركيّة.
4.3.1. السّياحة البيئيّة وتعزيز السياحة العامة
| – ذخر المنطقة بالأماكن التراثيّة المدرجة ضمن التّراث العالمي في بعلبك والهرمل، وجود العديد من الأبنية ذات الطابع الريفي.
– تشمل المنطقة عشرات الأماكن ذات الطبيعة الخلابة والمعروفة على صعيد لبنان منها المحميّات، الدّارات، العاصي، الأربعين..) – وجود مناطق تراثيّة أخرى يمكن الاستفادة منها، والتّرويج لها كوجهة سياحيّة مع وجود شبكة من الطرقات وإن كانت بحاجة للتّطوير أكثر. – وعي واهتمام سكان المنطقة بتنمية السياحة الرّيفيّة كوسيلة لتنمية مناطقهم، وخلق مناصب عمل دائمة وتنويع مداخيلهم ورغبتهم باستقبال السّياح، والتّعريف بمناطقهم وبيع منتجاهتم الحرفيّة. -تعدد النشاطات التقليدية والحرفية الداعمة للسياحة كصناعة السّجاد، الفخاريات المأكولات التقليدية.. |
نقاط القوة |
| – محدودية التمويل والدّعم من الخارج، عدم رغبة المستثمرين في الاستثمار بالسّياحة الرّيفيّة ضعف فاعليّة المنظمات، أو تعاونيّات متخصصة في السّياحة التّضامنيّة، وبالأحداث الثقافيّة والتّاريخيّة للمنطقة، ووجود عجز كمي ونوعي في التّجهيزات، انخفاض مستوى البنية التّحتيّة السّياحيّة.
– قلة الاهتمام بأماكن كشفيّة، على الرّغم من التّنوع البيئي وثراء المنطقة بالغطاءات الحرجية -وجود مظاهر التّحضر كالأبنية الحديثة، يؤدي الى البعد عن المظهر الريفي إضافة الى عدم ترميم المباني القديمة التّراثيّة. – تسويق ضعيف للسياحة والافتقار الى المهرجانات الدّوليّة التي تسمح بعرض الفلكلور المحلي مع عدم وجود يد عاملة مؤهلة لممارسة النّشاط السياحي، والنّشاطات المرافقة له، كالتّسويق. |
نقاط الضعف |
| – امكانية استقطاب استثمارات أجنبية ،فرص اطلاق أشكال سياحيّة.
– وجود جمعيات بيئية ، واعلانات عن بعض الاماكن السياحيّة، ومشاركة للقطاع الخاص في السياحة. – وجود مساحات يمكن الاسفتادة منها في المناطق ذات الوجهة السياحيّة، إمكانيّة استغلال الأبنية القديمة. |
الفرص |
| – توسيع الأنشطة السياحية بما لا يتلاءم وغير منتظم مع المناطق البيئية.
– العجز في دمج مجتمع المنطقة مع السياحة البيئية والصناعة السياحية – عدم وجود قوانين مرتبطة بالسياحة في المنطقة وهذا ما يؤثر على التخطيط السياحي للمنطقة – ضعف التنسيق وغالبا ما يكون غائبا بين الجهات المعنية في المواقع السياحية، غياب الوعي بالسياحة الخضراء ةعدم الاهتمام بها، التخييم العشوائي، ضعف التسويق |
التهديدات |
2.4.3. تحليل الاحتياجات الرّئيسة وتحليل الأثر البيئي
ض+ ت: لا يزال القطاع السّياحي في المنطقة يراوح مكانه، بسبب غياب السياسة التّسويقيّة، وضعف التّمويل له مع غياب التخطيط له، كما أنّه لم يحظَ بالاهتمام الكافي من القطاع الخاص ومن الدولة، ما جعل النتائج المحققة منه أقل من حجم الموارد المتوفرة على الرّغم من أهميتها.
ف+ ق: يسمح غنى المنطقة بالتّراث الطبيعي والحضاري، والتّاريخي استقطاب الزائرين من لبنان والخارج للسياحة بمختلف أشكالها، وتنوعها بين البلدات وقرب المسافة بينها، من خلال:
– يحفز السّمات الريفيّة والطبيعيّة، ويُثمّن التّراث الحضاري والتّاريخي يحفز التفاعلات بين الأنشطة، وجذب السّياح وقضاء مدّة من الزّمن مقابل دفع مستحقات النّقل والإقامة، والإطعام وشراء المنتجات الزّراعيّة والحرفيّة، وتفعيل المشاريع السياحيّة الصّغيرة بقروض ميسرة ومشاركة القطاع الخاص.
– إنشاء مسار درب بعلبك الهرمل يعد رافدًا اقتصاديًّا واجتماعيًّا مهمًا للتنمية وتتمكن المرأة من العمل، خاصة وأن الخدمات السياحيّة تقدم من سكان المنطقة أنفسهم، يصار خلالها الى إنشاء عدة مسارات فرعيّة تربط المواقع السياحيّة المهمّة في المنطقة، يقضي السّائح عدة أيام يجول عدة أماكن سياحيّة بحسب المسار الذي يختاره.
– ربط المنتج الزراعي بالمنتج السياحي، فهما متكاملان من خلال مساهمتهما في دخل الأسر، ويسمح ربطهما ببعض تحسين الصناعة السياحيّة وتنمية المنطقة.
– عدّ التراث العمراني للمنطقة مصدرًا لاستدامة العمران فيها على المستوى الرمزي، والتّشكيلي والرّوحي والثقافي وذلك عن طريق تكامل ركائزه الثلاث فيها :المجتمع البيئة والاقتصاد فيجري في:
– البحث عن مصادر لتمويل عمليات الترميم للأبنية التراثيّة، وإشراك المجتمع المدني في ذلك، بشكل يحافظ على الخصوصيّة المحليّة، ويحرك الحنين نحو الماضي ويطوعه ليعبّر عن الحداثة بأشكالها المختلفة.
– ربط الوظيفة العمرانيّة والمعماريّة بذكريات المنطقة القديمة والتي تجسد أحداث وحقبٍ تاريخيّة، وشخصيّات لها تأثيرها، فهي تنمي التعلق بالمكان وتجذر هويّة السكان.
1.5.3. تحليل القطاع الحرفي في إطار التنمية
| – وجود العديد من المصانع الغذائيّة ذات السّمعة المناطقيّة (مزارع اللقيس، شمص، ..) تتميز بتنوعها وتزايد أعدادها ومرونتها واستجابتها لحاجات السوق بأسعار مقبولة.
– توفر مساحات شاسعة مخدومة بالخدمات الأساسيّة، ويمكن استغلالها لإقامة المشاريع، علمًا أن سعرها يقل عن المدينة. |
نقاط القوة |
| – غياب الثقة ما يؤدي إلى ظهور مشاكل بين الممولين أو الجهات المانحة إضافة الى عدم وجود سيولة ماليّة كافية، الشّروط الصعبة لمصادر التمويل، نقص الإدخار، مقابل انخفاض القدرة الشّرائيّة لدى سكان المنطقة. تدني الاستثمارات العامة في قطاع التكنولوجيا.
– ضعف المنافسة اتجاه البضائع المستوردة، إضافة الى سيادة المنتج الواحد وتقليد المستثمرين بعضهم، ما يعرضهم للمنافسة بين بعضهم ومن الخارج في ظلّ عدم امتلاك التكنولوجيا اللازمة – البعض يواجه مشكلة النظرة الاجتماعيّة لعمل المرأة وإدارتها للمشاريع العلاقات الشّخصيّة، إضافة الى ضعف البنيان الصناعي الذي يعكس قلّة الحرفيين والعاملين في هذا المجال. |
نقاط الضعف |
| – اهتمام المانحين في المشاريع الإنتاجيّة وتوجد جمعيات تعنى بتطوير الحرف اليدويّة.
– سهولة الاتصال والتّواصل والشّبكات الإلكترونيّة ووجود إعلانات لها. – زيادة الطلب على المنتجات التي كانت تعد سابقًا في المنزل ليصبح هناك رغبة بشرائها. – الانتماء المكاني الكبير لسكان المنطقة واللحمة الكبيرة بينهم وعودة المتقاعدين الى المنطقة ووجود عشرات المهاجرين ورغبتهم بالاستثمار. – وجود أكثر من 40% من النّساء غير عاملات ويرغبن بعمل خاص. – لا يوجد خسارة من جراء التّحول نحو اقتصاد أخضر، لأنّه لا يوجد مشاريع تقليدية حتى تُستبدَل بتقنيات سليمة وبيئيّة. |
الفرص |
| – ضعف الإمكانات الماديّة للمستثمرين، وحرمان المشروعات من بعض الامتيازات مثل الإعفاءات الضريبيّة أو الجمركيّة ما يدفعها للعمل بشكل غير رسمي.
– عدم قدرتها على مواكبة التطورات التكنولوجيّة، كونها أنشئت لتلبية احتياجات السوق المحليّة، ما يجعلها غير قادرة على منافسة المنتجات المستوردة ذات الجودة العالية. – محدودية التّسويق لأنّ معظم المشروعات القائمة تتحكم فيها نسبة النزوح والقدرة الشرائيّة ومنافسة. |
التهديدات |
2.5.3. تحليل الاحتياجات الرئيسة وتحليل الأثر البيئي
ت + ض: صعوبة تكامل محال الحرف اليدويّة في القرى مع المصانع الكبيرة البعيدة منها في مدينة بعلبك، وتدهور البنية التّحتية وصعوبة توفير الطّاقة والمياة وارتفاع معدلات النزوح ما يؤدى إلى ضعف السّوق، الى جانب انخفاض مستوى الدّخل وسط منافسة المنتجات الأجنبية وعدم كفاية رأس المال لتمويلها.
ف+ ق: تطوير مستمر للعمليات الصناعيّة والخدمات، وتقليل استهلاك الموارد الطبيعيّة، ومنع تلوث الهواء والنبات والماء عند المنبع، وخفض كميّة المخلفات المتولدة، وذلك لتقليل المخاطر وتشجيع الابتكار والتنافسية الاقتصاديّة، وإيجاد فرص عمل جديدة في إطار التنمية الخضراء.
– المساهمة في تحسين رفاهية السكان وصحتهم وتعزيز الأمن البيئي والمائي والغذائي والطاقوي، رفع كفاءة استغلال الموارد الطبيعية وجلب أنواع جديدة من التكنولوجيا الخضراء وتكنولوجيا تدوير النّفايات.
1.6.3. التّحليل الرباعي لقطاع الزراعة
| – تؤمن الأسر جميعها 80% من حاجاتها الغذائيّة من المنطقة ( خضراوات، فاكهة….)
– استخدام محدود للمبيدات والأسمدة التي تُؤمَّن بالعملة الصّعبة، والحفاظ على المياه الجوفيّة من التلوث بهما، تعزيز التّربة على حفظ المياه بحوالى الضعف لاستخدامها في وقت الجفاف،القدرة على حماية التّربة من الانجراف، ذلك أن استخدام الأسمدة يحتاج الى مزيد من المياه الجوفيّة. – تطبيق أساليب الزّراعة العصرية، ووسائلها لزيادة الإنتاجيّة والري بالتنقيط للتكيف مع شحّ الموارد المائية + استصلاح الأراضي. – يحافظ على فرص العمل الحاليّة ويحفز فرص جديدة في التوسع والتّسويق، والتّصنيع والخدمات خاصة مع ارتفاع أسعار المنتجات العضويّة مقارنة بمثيلتها. – قرب مناطق الإنتاج من سوق بعلبك، ما يساعد في خفض كلفة النّقل، توافر بعض التّقنيات الحديثة والتّعاون ما بين القطاع العام والخاص في المشاركة في المعارض الزراعيّة التّسويقيّة . – يوجد عدد من المتخصصين الزراعيين والخبراء والمدارس الزّراعيّة. – وجود معاصر للزيتون، ووجود معصرة لزيت العصفر، وأخرى لزيت اللافندر . – التّوسع في الزراعة أدى الى وجود أنشطة غير زراعيّة، تجارة الأعلاف، الحبوب، خدمات بيطريّة. |
نقاط القوة |
| – زراعة أكثر من موسم واللامبالاة في تدهور تربة الأرض التي يستئجار غالبًا.
– المنافسة الشّديدة من قبل المنتجات غير العضويّة، عدم توفر دعم لها ونقص التّمويل لها ولكيفيّة تأصيلها إضافة الى تدني ثقة المستهلك حيال جودتها. – إغراق السّوق بالبذور المهجنة والمحـسنة، وإنتاجيّة البذور البلدية المتدنيّة وعدم الدعم المالي. – استخدام مياه الصرف الصحي في الزراعة، مما تسبب في تلوث البيئة – تطورات بطيئة في علوم وتكنولوجيا تربية النباتات ونظم تأصيل البذور، وضعف التمويل وقله الموازنات المرصودة للبحوث الزراعيّة. – ضعف البنى التحتيّة عامة وتردد أصحاب المال للاستثمار في المنطقة، تراجع عشوائي فى الدعم الموجه للقطاعات الزراعيّة، ما أفقدها القدرة على الصمود والمنافسة وأضعف قدرتها على التّغذيّة |
نقاط الضعف |
| – توفر بنك البذور البلديّة في مصلحة البحوث الزّراعيّة في تل عمارة الذي يعد أكبر بنك بذور في الشّرق الأوسط.
– إمكانيّة اعتماد زراعات لا تواجهها منافسة، ولا تحتاج الى أسمدة نسبيًّا مثل الزعفران. – التّوجه نحو الزراعة العضويّة، والزراعة الذّكيّة مناخيًّا والزراعة الحافظة. – الاتفاقيّات التّجارية مع الدّول العربية، والإعفاء الجمركي لمنتجات المنطقة والعلاقة الطيّبة معهم. هناك إمكانيّة لبيع المنتجات في محالات كبيرة ذات علاقة في بيروت. وزيادة العمالة السّورية. – اهتمام القطاع الخاص بنشر التقنيات الحديثة، والمضي بمشاريع الحصاد المائي. – توفر مساحات من الأراضي الخصبه للبحوث في الزراعات العضوية والحافظة. |
الفرص |
| الجفـاف والتـّصحر تراجع كميات الأمطار السّنويّة، والتّغيريّة الشّهرية للحرارة وموجات الصّقيع والحرّ المتكررة، والاستفادة من المياه الجوفيّة، ما يضع موسم الزراعة أمام مخاطرة كبيرة.
– التهريب على الحدود والمنافسة الشديدة من المنتجات السّوريّة. – زراعة البذور البلديّة ليست مربحة في أغلب الخضروات تقوم الأسر بزراعتها للمساعدة لكونها ذات طعم مميز وتزرع مـرة بالـسنة، وكذلك لا تحتاج إلى مياه ري، تعد موروثًا تقليـديًّا |
التهديدات |
2.6.3. تحليل الاحتياجات الرّئيسة وتحليل الأثر البيئي
ت+ ضعف: – يدفع غياب خطة للتنمية الزّراعيّة في المنطقة، وغياب التّنسيق بين الجهات المعنيّة، وعدم تطوير المشاريع الزّراعيّة أو الغذائيّة أو دعم الدولة، انخفاض العائد من الأراضي الزّراعيّة وضعف التّمويل الى ترك بعض الأراضي بورًا والى ارتفاع البطالة واضطرار الكثير للعمل خارج المنطقة.
– ضعف التّقدم التقني في مجال التعبئة والفرز ميكانيكي، ما يلحق الضرر بالمنتجات الموضبة وخسائر تقدربين 15- 20% من قيمتها الاجتماعيّة ماليّة إضافة الى ضعف الخدمات الزّراعيّة المساندة.
ف+ نقاط القوة: – استخدام التكنولوجيا وأصناف وسلالات مناسبة للتغيرات المناخيّة والعمل على أقلمتها وزيادة الإنتاجيّة، التوسع في الزراعة العضويّة.
– تكريس سياسات تساعد صغار المزارعين على استعمال التقنيات الحديثة في الري لتخفيف من هدر المياه،
– اعتماد الأسمدة الطبيعيّة واستكمالها بالأسمدة الكيماويّة من أجل زيادة خصوبة التّربة وتخفيف انجرافها.
– اعتماد زراعات جديدة لا تلقى منافسة، ويمكن تسويقها عبر شركات أجنبية مثل اللافندر أو الزّعفران الذي يمكن زراعته بين أشجار البساتين، والتّوسع في زراعة العصفر، التي لقيت نجاحًا كبيرًا لدى مزارعيها.
– يمكن اعتماد الزراعة الحافظة في أماكن الدّولينات في السّفوح الجبليّة، والحيّزات الصّغيرة لصعوبة حصادها، فتترك في الغالب بورا، وكذلك في المساحات البعليّة.
– نقص النفقات عند استخدام البذور البلديّة، فتُعدُّ مقاومة للآفات الزراعيّة تحافظ على البيئة وصحيّة للجسم، وتخزن البذور للمواسم التالية، وهي مقاومة للأمراض وسهلة التداول بين المزارعين يمكنهم تشخيص أمراضها ولديهم مقدرة على إنتاجها، لهذه البذور بعد تاريخي وتعدُّ إرثًا زراعيًّا يرتبط بالتراث.
1.7.3. التّحليل الرّباعي للبيئة الاجتماعيّة والتنمية الخضراء
| – مجتمع شاب في تكوينه الهرمي، وارتفاع نسبة الشباب في سن العمل.
– نسبة كبيرة من المثقفين والجامعيين. – تماسك المجتمع في العادات والتّقاليد والتّمسك بهوية المنطقة. – تمسك المجتمع بجذور المنطقة وحضارتها والتغني بمناظرها الخضراء والرغبة في العيش فيها. |
نقاط القوة |
| – ارتفاع معدلات الفقر والبطالة + ثقافة العيب أمام بعض أنواع المهن خاصة القديمة.
– تغير في أنماط المعيشة ومصادر الدّخل والإقبال على الوظيفة الحكوميّة خاصة السّلك العسكري – تردٍ اقتصادي يفضي الى أزمات ذات طابع مطلبي (الخدمات والرّواتب والبنى التحتيّة..) ويُضعف فرص الاستثمار وتقوية الجذور وتحسين المشهد البصري ومن ثم السياحة الخضراء. – تغيرات اجتماعية سلبيّة متوقعة بحكم تردي الوضع الاقتصادي. |
نقاط الضعف |
| – الاستقرار السياسي والأمني.
– التّحويلات بالعملة الصعبّة التي يؤمنها المهاجرون من الخارج، تصل نسبتهم في بعض البلدات الى 15% من إجمالي السكان كما في البلدات المسيحيّة فضلًا عن مئات الموظفين الذين يتقاضون رواتبهم بالدولار من مؤسسات خاصة. – خبرة في بعض الحرف العريقة وإمكانيّة إحيائها. |
الفرص |
| – النقص و زيادة الحاجة الى الخدمات العامة.
– النّزوح والهجرة من المنطقة. |
التهديدات |
– 1.8.3. التّحليل الرباعي لقطاع المياه
| – تعدد مصادر المياه، وجود نهر العاصي والأربعين. إضافة الى عشرات الينابيع الدّائمة والموسميّة بعضها بعيد عن مصادر التلوث.
– تزيد سماكة الثلوج وتفوق كمية الهطولات1000ملم في المناطق الجبليّة التي تزيد ارتفاعاتها عن ال2000م، وتعدُّ خزين مهم لمنطقة، فهي تغذي الينابيع وعشرات الآبار. – العديد من البلدات لديها شبكات مياه شرب حديثة إضافة الى وجود محطة لتكرير مياه الصرف. – تطبيق أساليب الزّراعة العصريّة خاصة في الرّي ووجود نظام تعرفة لخدمات المياه للمنازل. – وجود مديرية لإدارة المياه في المنطقة اضافة الى جهود البلديات واتحاداتها. |
نقاط القوة |
| – قلّة المصادر المائيّة الطبيعيّة، والتّعدي على مصادرها وتلوث الكثير منها وعدم وجود خطة مدروسة لحماية الموارد المائيّة. عدم كفاءة استخدام مياه الأمطار.
– زيادة الطلب على المياه، تناقص متوسط نصيب الفرد من المياه وتنافس على المياه بين القطاعات المستدامة للمياه، هدر المياه في الاستخدامات المنزليّة أو التّجاريّة الاستخدام الجائر للمياه الجوفيّة. – اهتراء وقدم العديد من شبكات المياه وضعف آلية التحكم في الفاقد، غياب ترشيد استهلاك المياه وكفاءة استخدام المياه في الري ومنع تلوثها، ضعف الوعي العام بضرورة تنمية الموارد المائيّة – استخدام 85 %من إجمالي الموارد المائيّة المتاحة سنويًّا في الزراعة لمساحات كبيرة من المحاصيل الشّرهة للمياه كما أنّ معظم المزارعين الصغار يعتمدون على أسلوب الرّي (بالغمر( – شبكة الصرف الصّحي لا تغطي أكثر من 10% وهي غير معالجة في الاستخدام الزّراعي على الرّغم من وجود محطة تكرير. – ضعف التّنسيق والمشاركة بين المؤسسات المعنيّة، وبين جهات التخطيط التنموي والاقتصاديّة والاجتماعيّة ما أدى الى فشل ادارة المياه. |
نقاط الضعف |
| – التّحكم المسبق في الجريان السطحي للحؤول دون حدوث الفيضانات من خلال اقامة مشاريع تجميع المياه والمسارب مثل بركة اليمونة و وجود امكانية تطوير مصادر المياه خاصة عبر الحصاد المائي المنزلي والزراعي.
– تغيير سلوك السكان عقب انقطاع المياه والاضطرار الى دفع ثمن مياه الصهاريج ، مما دفعهم الى بناء الخزانات المياه والاقتصاديّةتصاد في الاستهلاك واللجوء الى مصادر متجددة للمياه والطاقة. – الّتطور التكنولوجي وتقنيات متطورة لمراقبة مستوى المياه الجوفية ( تل عمارة د. ناجي). – وجود تصور مبدئي من قبل البلديات للمخطط المفترض من أجل معالجة المياه العادمة. |
الفرص |
| – التّصحر والتّغيرات المناخيّة ومخاطر الجفاف، وتدني منسوب بعض الأبار الجوفيّة ومحدوديّة الموارد الماليّة، ما يشكل تحديًّا لتنفيذ الاستراتيجيّات في الوزارات جميعها.
– ضعف التواصل بين قطاع المياه والقطاعات الأخرى وتداخل الصلاحيات بين وزارة الطاقة والبلديات والوزارات. – وجود نقص في بعض الكفاءات البشريّة لتحقيق الأهداف الاستراتيجيّة. -التكلفة العالية لتشغيل شبكة الصرف الصّحي. |
التهديدات |
2.8.3. تحليل الاحتياجات الرئيسة وتحليل الأثر البيئي
أ- ت+ ض: – الزام السكان بالتراخيص، وتحديد عدد الآبار في الأماكن المسموح الحفر فيها، والتفتيش عن مصادر أخرى مثل إنشاء برك اصطناعيّة، وإنشاء خزانات وتنظيم مياه الشّبكة والرّي. وحفر وتجهيز وتشغيل آبار جديدة.
– تلويت المياه العادمة المياه الجوفيّة والسّطحيّة والزراعة، لا بدَّ من رفع نسبة المخدومين بشبكات الصّرف الصّحي، وتشغيل محطة إيعات وإنشاء محطات معالجة أخرى، ووضع المعايير الملائمة بيئيًّا وماليًّا وتكنولوجيا لها وإشراك القطاع الخاص في ذلك.
– تنمية العرض من دون ترشيد الطلب، ولا بدَّ من تغيير سلوكيات الاستهلاك، وتطوير الوعي المجتمعي وتعزيز مبدأ الدفع مقابل الخدمة.
ب- ف+ ق: – تتطلب التنمية الخضراء في قطاع المياه تقليل كمية مياه الري عبر اعتماد عدة أساليب وهي:
– مراقبة مصادر المياه كمًّا ونوعًا عبر الاستفادة من الكوادر البشريّة الموجودة، واستخدام التّقنيات والتكنولوجيّة الأحدث لمراقبة وفحص المياه الجوفيّة والسّطحيّة.
– التوسع في استخدام المياه العادمة المعالجة في الري، واعتماد الأصناف الزّراعيّة التي تتطلب كميّة محدودة من المياه. وتوسيع المساحات التي تروى بالمياه المعالجة.
– الاستفادة من عمل المؤسسات في التطور التكنولوجي، واستغلال الاهتمام الدولي في استقطاب التّمويل لمشاريع قطاع المياه. زيادة الموارد المائيّة، رفع كفاءة استخدام الموارد المائيّة.
– الاستفادة من المنح الأجنبية ودعم الأسر في إنشاء مشاريع حصاد المياه لزيادة الكمية المتاحة بقروض ميسرة، وذلك من أجل تجميع المياه من السّطوح ومن مياه الشبكة عند الاكتفاء منها أثناء التقنين.
الخلاصة
شهدت المنطقة منذ التّسعينيات نمو اقتصاديًّا ملحوظًا نسبيًّا، ورافق ذلك استنزاف الموارد الطبيعيّة وعلى الرّغم من التأكيد على التنمية المستدامة، إلّا أن الاستخدام للموارد الطبيعيّة قد ازداد بشكل كبير، فهي تعاني من مشاكل تنموية في القطاعات المتشابكة جميعها مع بعضها، ما يجعل التنمية فيها تدور في حلقة فارغة من الجدوى. وبما أن موضوع التنمية الخضراء من الموضيع المهمّة وفي بداية مراحله في المنطقة، لا يمكن تغطية جوانبه جميعها في مقال واحد، لذلك تناول الجوانب الأكثر تأثيرًا وبدأ العمل بها وهي الطاقة، المياه، النقل، النُّفايات، العمران، السّاحات الخضراء زراعة وغطاء طبيعي، المشاريع الصّغيرة والسياحة الخضراء.
تراعي التنمية الخضراء سلامة البیئة وتحافظ على قيمة الاقتصاد، تستخدم المواد المحليّة وتجعلها ملائمة لمتطلبات الثقافة المحليّة، ويظهر كفاءتها في استهلاك الطاقة والمياه واختيار الأصناف المحليّة، والمباني الخضراء والاقتصاد الأخضر في الزّراعة والسّياحة والمشروعات الصغيرة، وعليه لا بدّ من خضرنة القطاعات الملائمة وتغيير أنماط الاستهلاك غير المستدامة، وتشجيع الاستثمار ودعم الاقتصاد من خلال ضمان الاستدامة الماليّة، وتعزيز توجه المنطقة نحو التنمية الخضراء وضمان التّعاون بين البلديات، واتحاداتها والجهات الأهليّة والحكوميّة والقطاع الخاص مع إعادة هيكلة الصناعات القائمة بشكل يجعلها أقل تأثيرًا على البيئة، وتحقيق استهلاك وانتاج مستديمين، وإدماج الوعي بالتنمية الخضراء.
المراجع
1- حليمة قريشي، الابتكارات لبيئية والتكنولوجيا الخضراء، 2018،مجلة العلوم الاقتصاديّة.
2- رجاء سالم، خولة حسن، الاقتصاديّةتصاد الاخضر طريق نحو التنمية، 2020، كلية الزراعة، بغداد.
3- رجاء صبحي علام، الابتكار ومنافسة الطاقة المتجددة في مصر، 2019، معهد التخطيط القومي.
4- سلطة الطاقة والموارد الطبيعية، الاستراتيجية الشاملة لقطاع الطاقة، 2016،
5- صيفي حسنية، آليات التكنولوجيا الخضراء دورها في تحقيق التنمية المستدامة، 2020، جامعة قاصدي.
6- عبد الحميد بن مسغانم، الطاقة لخضراء التنمية المستدامة، 2019، مجلة الاستراتيجية والتنمية.
7- مؤتمر الأمم المتحدة، اتاحة فرص النمو الأخضر، 2023، جنيف
– PNUE , 2012, L’économie verte dans le contexte du développement durable8
NUE 2012a.The Business Case for the Green Economy Sustainable – Return9
SOMMER, A. 2012. Managing Green Business Dissertation, Leuphana Universität -10
-Stefan Giljum et autres ,2012, LA CROISSANCE VERTE 11
– دكتوراه من المعهد العالي للدكتوراه في الجامعة اللبنانيّة الآداب والعلوم الإنسانيّة والاجتماعية – قسم الجغرافيا [1]
Doctorat de l’Institut Supérieur de Doctorat de l’Université Libanaise des Lettres, des Sciences Humaines et Sociales – Département de Géographie. Email: Rag.hida@hotmail.co