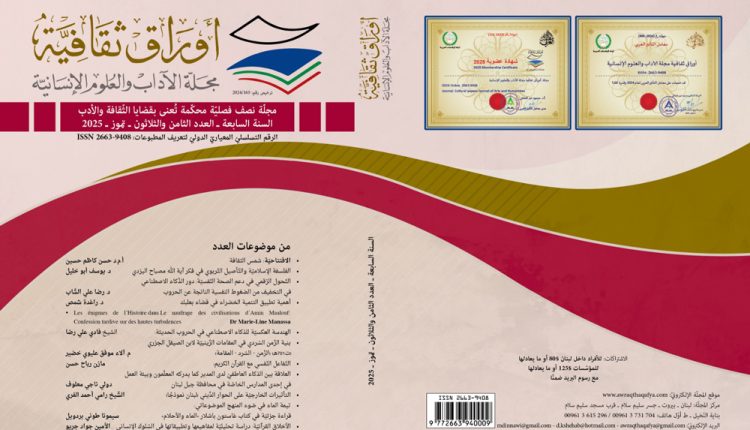عنوان البحث: بنية الزّمن السّردي في المقامات الزّينبيّة لابن الصيقل الجزري (ت701هـ) (الزّمن – السّرد – المقامة)
اسم الكاتب: م. آلاء موفق عليوي خضير
تاريخ النشر: 2025/07/16
اسم المجلة: مجلة أوراق ثقافية
عدد المجلة: 38
تحميل البحث بصيغة PDFADOI: https://aif-doi.org/awraq/013805
بنية الزّمن السّردي في المقامات الزّينبيّة لابن الصيقل الجزري (ت701هـ)
(الزّمن – السّرد – المقامة)
Time Basic in narrative assay at Zaynisim Theme for Ibn Sakeel Alizry (701 H) (Time-Narrative-Theme)
Alaa Muwaffaq Aliwi Khader م. آلاء موفق عليوي خضير([1])
تاريخ الإرسال:18-6-2025 تاريخ القبول:5-7-2025
الملخص
اختص هذا البحث لدراسة جانب من التّراث القديم في ضوء منظور نظريّة نقديّة حديثة معاصرة؛ ذلك في إطار تقديم رؤية جديدة للنّص التّراثي عن طريق دراسة بنيّة الزّمن السّردي في المقامات لابن الصّيقل الجزري (ت701هـ).
وقد جاء البحث في قسمين: درس القسم الأول زمن السّرد في الماضي والحاضر والمستقبل، أمّا القسم الثاني: فقد خصص لدراسة زمن السّرد في السّرعة والبطء.
الكلمات المفتاحيّة: الزّمن، السّرد، المقامات الزّينبيّة، ابن الصيقل الجزري
Abstract:
This thesis has been taken a but the old heritage in Arabic literature, and according to the modern critical theory, in form to get new conception for the writing text in heritage or folklore by writing about time basic in narrative assay at Zaynisim Theme for Ibn Sakeel Alizry (701 H).
And this thesis had been divided fro two sections, first section taken anout narrative time in past in future or in current time. While the second section explained the narrative time as faster or retarding.
Keywords: Time, Narration, Al-Maqamat Al-Zainiyya, Ibn Sakeel Alizry
المقدمة
يُعدُّ فنُّ المقامة شكل من أشكال الفنون الجديرة بالاهتمام لكونه مرحلة من مراحل القصة القصيرة، وقد أردت أن أدرس جانب من جوانبه رفدًا للمكتبة الأدبيّة بما هو مفيد، فجاء اختيار هذا الموضوع وهو: (بنية الزّمن السّردي في المقامات الزّينبيّة لابن الصّيقل الجزري –ت701هـ-)، وعن طريق الخوض في مضامين المصادر والمراجع الأدبيّة ذات الصلة بالموضوع؛ تقرر دراسة الموضوع، وهو بحثٌ في التّراث القديم من منظور نظريّة نقديّة معاصرة. وقد انصب اهتمام البحث على دراسة بنية الزّمن السّردي في المقامات على أساس التقسيمات الناشئة عن الاختلاف في ترتيب الأحداث في القصة، وترتيبها في السّرد لتوضيح البنية الزّمنية لتلك النصوص.
وجاءت تقسيمات البحث على قسمين:
درستُ في القسم الأول (المستوى الأفقي): أيّ ترتيب الأحداث في السّرد في الماضي والحاضر والمستقبل، عن طريق توظيف تقنيتي الاسترجاع والاستباق.
أمّا القسم الثاني فتناول دراسة (المستوى العمودي): أي دراسة الإيقاع القصصي في السّرعة والبطء في سرد الأحداث، وقد شمل الحركات السّردية الأربع (الحذف، الخلاصة، الوقف، المشهد).
المدخل
يُعد الزّمن عنصر بنائي مهم في النّص الأدبي؛ ذلك لتأثيره في العناصر الأخرى المكونة للنص، لذلك اهتم الخطاب النّقدي الحديث بتقنية الزّمن اهتمامًا كبيرًا، لأنّه عنصر جوهري، وأساس مؤطر لفنون الأدب عمومًا، إذ يشغل حيّزًا مميزًا في آليات البناء الخاصة بأجناس الأدب بعامة والسّرد بخاصة([1]) . ويُعد الشّكلانيون الرّوس من النقاد الأوائل المهتمين بمبحث الزّمن في نظريّة الأدب، فميزوا بين المتن الحكائي والمبنى الحكائي، إذ عرّف توماشفسكي Tomashevsky المتن الحكائي، أنّه مجموع الأحداث المتصلة في ما بينها والتي يقع إخبارنا بها خلال العمل، وهي تخضع لمبدأ السببيّة فتراعي نظامًا وقتيًّا معيّنًا، أمّا المبنى الحكائي فيتألف من الأحداث نفسها إلّا أنّه يراعي نظام ظهورها في العمل، كما يراعي ما يتبعها من معلومات تعينها للمتلقي([2]). وقد بيّن تودوروف على خلفيّة هذا التّمييز بين المتن الحكائي والمبنى الحكائي، أنّ لكل حكي أدبي مظهرين متكاملين، فهو قصّة وخطاب في آنٍ واحد([3])، وانتج ثنائيّة زمن القصة والخطاب التي انطلق جيرار جنيت Gerard Genetteعلى أساس المقارنة بينهما، فأقام تصنيفًا ثلاثيًّا في مستويات الزّمن السّردي على أساس العلاقة بين (القصة – الخطاب)، ويشمل هذا التّصنيف:
- النّظام: ويضم تقنيتي (الاسترجاع) و(الاستباق).
- المدة: ويضم تقنية (التّلخيص، الحذف)، و(المشهد ، الوصف).
- التّواتر (التكرار): أي (العلاقات بين قدرات تكرار القصة وقدرات تكرار الخطاب ([4])(*).
وخُصص هذا البحث لدراسة بنية الزّمن في نصوص المقامات الزّينبيّة لابن الصّيقل، إذ نتج عن الاختلاف بين زمن القصة وزمن الخطاب نوعان من الأزمنة، هما:
- زمن السّرد في الماضي والحاضر والمستقبل.
- زمن السّرد في السّرعة والبطء([5]).
أولًا: زمن السّرد في الماضي والحاضر والمستقبل في (المقامات الزّينبيّة لابن الصيقل الجزري)
نظرًا لعدم التزام الراوي في (زمن الخطاب) إيراد التّسلسل الطبيعي والمنطقي للأحداث الذي التزم به (زمن القصة)، وهو الزّمن الحقيقي الواقعي الذي تستغرقه أحداث القصة، يؤدي ذلك إلى حصول التفاوت بين الزّمنين، ويترتب على هذا الاختلاف بين الزّمنين (المفارقة الزّمنيّة) وهي: “دراسة التّرتيب الزّمني لحكاية ما مقارنة نظام ترتيب الأحداث أو المقاطع الزّمنيّة في الخطاب السّردي بنظام تتابع هذه الأحداث أو المقاطع الزّمنيّة نفسها في القصة“([6]).
ولا يمكن للراوي أن يروي في آن واحد ما يحدث هنا وهناك، ولأكثر من شخصيّة، فنظام زمن الخطاب لا يمكن أن يكون موازيًا تمامًا لنظام زمن التّخييل، وينجم عن استحالة التوازي إلى الخلط الزّمني الذي نميز فيه بداهة بين تقنيتين سرديتين، هما: الاسترجاعات أو العودة إلى الوراء، والاستقبالات أو الاستباقات([7]).
- الاسترجاع
وهي “مفارقة زمنيّة تعيدنا إلى الماضي بالنسبة إلى اللحظة الرّاهنة“([8])، ويتشكل من مقاطع استرجاعيّة لأحداث مرتبطة بمدّة سابقة على بداية السّرد؛ لأنّها استذكار لحدثٍ ماضٍ عن الحدث الذي يحكى، وتكون رواية هذا الحدث في لحظة لاحقة لحدوثه([9])، أيّ هناك تباعد معقول بين زمن القصة وزمن سردها. وقد قسم جيرار جنيت الاسترجاع الخارجي والاسترجاع الدّاخلي والمزجي([10])، وقد حفلت النّصوص موضع البحث باسترجاعات مختلفة، منها الاسترجاعات الخارجيّة وهي التي تظل سعتها كلّها خارج سعة الحكاية الأولى، فوظيفتها الوحيدة هي إكمال الحكاية الأولى عن طريق تنوير القارئ بخصوص هذه السّابقة أو تلك، فهي قد تتداخل في أي لحظة مع الحكاية الأولى([11]). ويتمثل ذلك في المقامة اللاذقيّة، إذ يُسترجع عن طريق عودة الراوي إلى الماضي، فيبدأ حكايته باستدعاء الذكريات الماضية التي كانت سببًا في هجرته؛ لإنارة الجوانب المظلمة من حياة شخصيّة أبي القاسم (الراوي)، الذي استهل المقامة قائلًا: “نويتُ مفارقةَ اللاذقيةِ، والأقرانِ المُماذِقيَّة([12])، لغَلبةٍ غلباء، وسنةٍ شهباءَ([13])،…، وكنت في تلكَ المجاعاتِ، وتهافتِ الجماعاتِ، صاحب صبيةٍ، ومصاحب صَبْوةٍ وصبَيةٍ،…، فحينَ نجِمَ دخان خضرائها، وانجم دخان غبرائها،…، منحتها مُرَّ الطلاقِِ، ونفحتُها بانطلاق المطلاق،….”([14]). كما تجسدت في بعض النّصوص الاسترجاعات الدّاخليّة التي هي استرجاع يتطلبه ترتيب القَّص لمعالجة الأحداث المتزامنة في القصة بما يستلزمه تتابع النّص، إذ يترك الرّاوي الشّخصيّة الأولى ويعود إلى الوراء ليصاحب الشّخصيّة الثانية([15]).
يسترجع الراوي في المقامة الحلوانيّة حادثة هجوم جماعة أبي نصر المصري (بطل المقامات) على القافلة التي أراد الرحيل معها، إذ تتبع تلك الجماعة حتى وصل إلى أماكن مراحهم، وبعدها التقى بأميرهم، واستعطفه بغية استرجاع ما سلب منه، قائلًا: “…، شيد الله معالي الأمير الأروع،….، وجليةُ قِصَّتي، وعدم إساغةِ غُصَّتي، أننّي رحلتُ بهذه القافلةِ، قافلًا لطلوع السّعادة الأفلة،…، فابتزَّني زَنْد وقيعتِك الجَرْساءِ([16])، وساعِدُ سريتك الخرساءِ، جُلَساء تحوى الأصباح والإمساء، ولا تهوى إلى الإساءةِ مَعْ مَنْ ساءَ، ادّخرتُها لجلاءِ الناظر،…”([17]). يستمر الراوي في وصفه لتلك الحادثة، وما سلب منه إذ يقطع الرّاوي التواصل الزّمني للأحداث ويعود بذاكرته إلى الماضي القريب، فيعمد إلى استرجاع الأحداث الماضية المتعلقة بسلب أسفاره ومدى حزنه وألمه عليها، وكل ذلك ماضٍ لاحق لبداية المقامة التي تبدأ أحداثها برحلته إلى حلوان، وتنقله بين مجالس السَّمر والمحاوراتِ، ومن ثم بين معاناتهُ وشوقهِ إلى الشّام التي قرر الرَّحيل إليها. لقد كان لتقنية الاسترجاع بنوعيه الخارجي والدّاخلي الأثر الواضح في تلك المقامات، إذ يمكننا عدُّها بمجملها استرجاع كبير لما جاء به راوي تلك المقامات على وفاق ترتيب خاص في نصوصه، ويتضح ذلك بما استفتح به تلك المقامات بصيغة الفعل الدّال على الماضي، وقد أثرى الراوي باستعماله لتقنية الاسترجاع اللحظة القصصيّة بكل ما قد يكون سابقًا عليها، كذلك إضاءة الجوانب المظلمة من حياة الشّخصيّات.
- الاستباق
هو عمليّة سرديّة معاكسة لعمليّة الاسترجاع، إذ ينطلق الراوي باتجاه المستقبل في استباقه للأحداث، أمّا في استرجاعه للأحداث يعود بنا باتجاه الماضي، فهو “سرد ما سيحدث لاحقًا والذي يدمج في الحكي قبل أن تقع الأحداث الممهدة لما سيأتي“([18]). وقد اختلفت درجة تواتر تقنية الاستباق بين الأعمال القصصيّة الكلاسيكيّة، فيكون ظهورها نادرًا([19])، وأمّا في الأعمال القصصيّة المعاصرة ازداد استعمالها؛ بسبب الفكرة المستقبليّة التنبئيّة، كما في رواية “البحث عن الزّمن الضائع” لمارسيل بروست، إذ كان استعمال الاستباق فيها استعمالًا ربَّما لا مثيل له في تاريخ الحكاية([20]). كما يكثر استعمال هذه التقنية السّرديّة في أشكال السّرد المتمثلة في (الترجمة الذاتيّة والقص المكتوب بضمير المتكلم)، فهي أحسن ملاءمة للاستباق من أيّة قصة أخرى؛ لأنّ “طابعها الاستعادي المصرح به بالذّاتِ، يرخَّص للسّارد في تلميحات إلى المستقبل، ولاسيما إلى وضعه الراهن“([21]). وتختلف الاستباقات في كيفيّة ظهورها في الحكايات، فقد تأتي بشكل حلم أو نبوءة، أو افتراضات بشأن المستقبل([22]). ولا تختلف تقسيمات الاستباق عن تقسيمات الاسترجاع، إذ يقسمها جيرار جنيت على قسمين استباقات خارجيّة وداخليّة.
فنجد في المقامة النيسابوريّة استباقًا خارجيًّا، وهو الاستباق الذي يصلح للدفع بخط عملٍ ما إلى نهايته المنطقيّة فوظيفته ختاميّة في أغلب الأحيان([23])، إذ حصل الاستباق عبر (توقعات) إحدى الشّخصيات للقادم من الأحداث، إذ قدم أبو نصر المصري توقعاته لمستقبل ولده الذي أراد العمل في كتابة الإنشاء عند الملوك، قائلًا له: “يا بُنَّي لقد رُمْتَ مسلكًا وعرًا، لا ترى الرّاحةُ([24]) فيها الرّاحةَ إلا نزرًا، مشحونًا بالشّحوبِ، معصوبًا بعصائب الحُوبِ([25])، تفتري على سالكهِ الأوغادُ، وتقتري أثر هفواته الأضدادُ، وتفري([26]) أديمَ عِرضهِ الحسّاد ويقرى([27]) مخدومَهُ الإسآدُ، وتسري إلى نضاله الآسادُ([28])، ويشري أدم إجلاله الأيسادُ، اللهم إلّا أن تكون ذا براعة مشهورةٍ، وبلاغةٍ مسجورةٍ، ومهارة فاخرةٍ،…”([29])،
هذا الاستباق هو الحدس بما ستؤول إليه الأحداث من خلال خبرته وسعة رؤيته للأمور؛ إذ يُجري المصري لأبنه اختبارًا لقدراته في كتابة الإنشاء، فيثبت الولد حسن أسلوبه وذكائه وجدارته، فيعجب المصري بذلك ويتفاءل بمستقبل ولده ، قائلًا له: “أفادك الله بامتياح عيني، وأعاذك من عيون البشر وعيني، فلقد أثريت قراحي بهذا اقتراحي،…، فأنت أحقُّ من لعلمِهِ الرجالُ كَعِمتْ([30]) ولآدابهِ الرجالُ عُكِمَتْ([31])، وعليه قَدِمَتِ الرياسةُ وسلَّمَت وإليه تقدَّمتِ السياسةُ وسُلَّمَتْ، ولنقصِ حظِّهِ الورَى تظلَّمَتْ، ومن أشبَهَ أباه فما ظلمتْ“([32]). إنّ الاستباق الذي ورد في هذا النّص هو استباقٌ خارجي يقع خارج المدى الزّمني للمحكي الأول، سعيًا من الراوي لشدّ المتلقي وتشويقه لمتابعة نهاية القصة، وإن لم تتحقق تلك التنبؤات على مساحة سرد الأحداث في المقامة، إذ جعل نهاية النّص نهاية مفتوحة على عدة احتمالات لم يفصح عنها السّرد.
أمّا الاستباقات الدّاخليّة فهي على العكس من الاستباقات الخارجيّة، فهي تقع داخل الحدّ الزّمني للمحكي الأول([33])، كما في المقامة الطوسيّة، إذ يتمثل بما توقع المصري حدوثه، ذلك عندما استمر القوم باستثارته واختبار قدرته الفنيّة والبيانيّة، فيجيب على من اقترح عليه أن يعيد رسالته نظمًا، جوابًا فيه نظرة مستقبليّة للأحداث، قائلًا: “وأيمنُ الله عندي صرام([34]) لخِلالِ([35]) خِلالِكَ، وضرام لإضرام سَيَالِ سؤالك، وانسكابٌ لانبساط راحك، وشهابٌ لإحراق شياطين اقتراحك،…”([36]). هنا يعرف المصري من خلال حدسه وتوقعه مصير الأمور، فهو ذو ثقة بنفسه وقدراته، وحدث ما توقعه بالفعل وحصل على ما يريد؛ لأنّه نال إعجاب الحاضرين وحقق إقبالهم عليه، “فأحضروا لحكمه المحضير([37])، واستحضروا لَهُ النضير([38])، وشكروا لفظه المشتار، وجاؤوا إليه بما اشارَ ليشتار، فبادر إلى انهائه،…”([39])، إذ تحقق فعلًا ما توقعه في مدّة زمنيّة قصيرة. إذًا ما يناسب الاستباق هو الراوي العليم ذو الرّؤيّة المجاوزة لماضي الحدث ومستقبله، وتبدأ في تحريك هذه العناصر بحسب مقتضياتها، وجذب اهتمام المتلقي وفضوله واستثارة ذكائه([40]) .
ثانيًا: زمن السّرد في السّرعة والبطء، (الإيقاع القصصي) في المقامات الزّينبيّة:
وتتضح لنا من خلال دراسة العلاقة بين زمن القصة وهو الزّمن الذي يقاس بالثواني والدّقائق والسّاعات والأيام والشّهور والسّنين، وزمن الخطاب الذي يقاس بعدد سطور النّص وفقراته وعدد صفحاته([41])، وجود علاقة نسبيّة بينهما، وتسمى هذه العلاقات الإبطاء أو الإسراع؛ لأنّها تحدد السّرعة السّردية([42])، وتحدد أهمّيّة الإيقاع القصصي القائم على معدل الزّمن.
واطلق جيرار جنيت Gerard Genette تسمية (الحركات السّرديّة) على أشكال السّرد المرتبطة بقياس سرعة السّرد أو بطئه، وتتضمن أربعة أشكال هي: (الخلاصة، الوقفة، المشهد، الحذف)([43])، وهذه الحركات تتوزع على بعدين، الأول: يعمل على تسريع القصّ بالاعتماد على تقنيتي (الخلاصة والحذف)، أمّا الثاني: فيعمل على إبطاء القصّ بالاعتماد على تقنيتي (الوقفة والمشهد).
وسأحاول في الصفحات اللاحقة من هذا البحث أن أبين أَثر كل من هذين المظهرين في تسريع النص وتبطئته في نصوص موضع البحث.
- تسريع القصّ
- الخلاصة
الخلاصة أو ما تسمى أحيانًا بـ(المجمل أو الإيجاز)([44])، وهي “الصيغة المثلى التي يلجأ إليها الكاتب عادة لاختزال أحداث كثيرة في سطور قليلة“([45])، أي يسرد الراوي أحداث ووقائع يفترض أنها جرت في سنوات أو أشهر أو ساعات، ويختزلها في صفحات أو أسطر أو كلمات قليلة من دون التعّرض لتفاصيلها([46]). ويؤتى بالخلاصة لتحقيق مجموعة أمور نصيّة سرديّة، ولعل أهمّها هو الاجتياز السّريع لمدة زمنيّة غير قصيرة في بضع أسطر أو فقرات([47]). وقد وردَ التّلخيص في مقدمات نصوص المقامات لابن الصّيقل الجزري، إذ يمّر الراوي مرورًا سريعًا، مختزلًا تفاصيل قد لا تشكل أهمّيّة في مسار الأحداث، من ذلك ما نلحظه في المقامة الأمديّة، إذ قال الرّاوي: “زمني ([48]) زمام الزّمن الزّنيم، يومَ نوم جِفَنْ الأشَرِ النُّويم، بعد إسعاف العديم،…، بألم مرضٍ ممدود المعارج مسدود المناهج فلما عزَّني رعيلُ ([49]) ذلك الإعلال، …، جعلتُ أخبُّ في بيداء داءِ الدَّنفِ، وأعُبُّ من ماء دأماء ذيالك الجنف([50])، حتى عُدْتُ بعد لَبْسِ سربال السُّعودِ وامتطاء سناسن سعد السّعود أنادم الأمراض،…”([51]). عمل الراوي بما قدمه من ملخص عن مدّة حياته، وبشيء من الإيجاز والبساطة إحاطة المتلقي بتغيّر أحواله وتحولات الزّمان، فبعد ما كان عليه من النّعيم والرّخاء أصبح يقاسي الظروف الصعبة لما يعانيه من الامراض.
وأمّا في المقامة النّصيبيّة فيستعمل الخلاصة في تقديم شخصيّة جديدة دخلت مسار الأحداث وأثرت في عمليّة الرّبط بين مشاهد المقامة، وهي شخصيّة الوصيف، قائلًا:”…، فبينما أنا أعالجُ بعالج السَّموم([52]) السُّموم، وأمارج([53]) بمارج تلك الهُمومَ الهموم([54])، إذ خطر بخاطري المكدود خِلٌّ خالٍ مِنْ قَرَن قرينه المَقدودِ، فحملني وعكةُ الملل وصكة([55]) الغلل، على أن اطعن درئة([56]) الحنادس([57])،…، فصحبتُ وصيفًا يُوجزُ بإسهابِ وصفه الواصف، ويعجز عن إدراكه ريحُ المَراوحِ القاصِفُ، ولما ركعتُ لأبوابه([58])، وأطعْت الأمل في إيقاظ بوّابه تلقَّاني ببشر شُموسُه مشرقَةٌ، وبِرِّ كؤوسُهُ مُفْهِقةٌ([59])، وجَعَلَ يُذاكرني بنفائسِ أسمارهِ ويُذكرُني محاسنَ سُمّارهِ، …”([60]). لقد قدّم الرّاوي هذه الشّخصيّة بصورة مختصرة بما يخدم المشهد السّردي.
- الحذف
وهو ما يترجم أحيانًا بـ(القفز)([61])، ويقصد به الحركة السّرديّة التي يستعملها الرّاوي لتسريع السّرد، عن طريق حذف مدّة زمنيّة طويلة أو قصيرة من زمن الوقائع، مع الإغفال التّام لكلّ أحداث هذه المدّة الزّمنيّة، فهو “الشّكل السّردي الذي يسقط جزءًا من الحدث، أو المادة الوقائعيّة الخام في النّص، مكتفيًا بالإشارة إليه بصورة ظاهرة أو ضمنيّة حينما ينتقل بنا السّارد، أو الراوي من مدّة زمنيّة إلى أخرى، من دون ذكر أي شيء عن كيفيّة تحقق الحدث“([62]).
وينقسم الحذف إلى قسمين: الأول الحذف الصّريح، والثّاني الحذف الضّمني.
فالحذف الصريح (المذكور): وهو حذف يشير به الكاتب إلى مدة محذوفة (محددة أو غير محددة) إلى ردح الزّمن الذي يحذفه([63])، من ذلك ما نجده من حذف واضح مقداره شهرين أو أقل، وهي المدّة التي استغرقها وصيف المصري في إيصال كتاب القاسم للمصري وإيابه بالجواب، فيقول الرّاوي: “…، وأودعته يوم الوداع، كتابًا يشهدُ بشدةُ رداعِ([64]) ذلك الصُّداع، فما انسلخ مَسْكَ سَلْخ شهرين، ولا نضخ ماءُ عيون العَينِ، حتى وصلَ بجوائهِ البريدُ، واتَّصلَ بوصولهِ، ما كنتُ أريدُ، ففضضتُ إحكام خِتامهِ، ووقفتُ على إحكامِ أولهِ وخِتامهِ،…”([65]).
نلحظ في هذا النّص تسريعًا للسّرد عن طريق التّجاوز عن كلّ تفاصيل مدة ذهاب وإياب حامل الرسالة، فلم يُشار إليها؛ بوصفها نوعًا من أنواع الزّمن المزيف فهي لا تشكّل أهمّيّة في بنية النّص.
أمّا الحذف الضّمني فهو حذفٌ لا يُصرّح به في النّص، إنّما يكون مفهومًا يستدل عليه من خلال فجوة في التّسلسل الزّمني، أو قطيعة في مساق الأحداث المذكورة([66])، وذلك معناه أنّ الحِقب “الزّمنيّة المحذوفة غير واضحة تحتاج إلى التّمعن لتحديدها“([67])، وتكون هذه وظيفة المتلقي الذي يستخلص هذا النّوع من الحذف في النّذص من خلال ما يتركه الحذف الضّمني في النص من ثغرات. ونلمس هذا النّوع من الحذف في المقامة الآمديّة، إذ كان الراوي يعاني من السَّقم فأخذ المصري في علاجه، فيقول الرّاوي: “…، ثم أنَّه شرع لرفع شُرع الإعلال وشُرب حمأة طينة ذاك الخبال فزال عنَّي بجودة علاجه، ومداومة انعياجه([68])، ما أعاني من المرض، ومصاعب العرض، ولم يزل مدة ذلك المقام، والرُّسوب في سيب ذلك السّقام، ينشُرُ حُسْنَ حُزونهِ والسّهول، ويطوي الطمع عن وطن همتي المأهول“([69]). يتجسّد الحذف الضّمني بحذف مدة زمنيّة من دون ذكرها في النّص؛ إنّما يستدل عليها من خلال إشارات موحيّة تدل على وجود حيزٍ زمنيٍّ حُذِف؛ لتسريع السّرد في المقامة، فعبر عنه بـ(لم يزل مدة ذاك المقام)، وهي مدّة غير معلومة. وقد يتداخل الحذف بنوعيه مع الخلاصة في بعض النّصوص، ومن أمثلة تداخل الحذف الصّريح مع الخلاصة، ما يتضح في المقامة الرّسعنيّة، إذ عمد الراوي إلى تلخيص مكثف للظروف التي مرّت على الشّام، وفي مدة زمنيّة غير محددة، قائلًا: “أناخَ بالشّام برهة من الأعوام، جمالات جَدْب بشرت([70]) أديم الجمام([71])، ونَشَرَت سرابيل السَّغبِ على طرف الثمام([72])، وأجزلت وساوس الإعدام وأهزلت بها معالم الإعلام، حتى بلغت القلوب الحناجر([73])،…”([74]).
نلحظ زيادة تسريع السّرد من خلال الحذف لتلك المدة غير القليلة، فهي (برهة من الأعوام) إذ قدم الراوي خلاصة موجزة عن الظروف القاسية في تلك المرحلة، فأسهم التّداخل السّردي بين الحذف والخلاصة في اختزال أحداث القصّة. وأمّا في المقامة الواسطيّة، فقد تداخل الحذف الضّمني مع الخلاصة إذ عمد الراوي إلى إيجاز مدّة زمنيّة من حياة الشّخصيّة عن طريق حذف زمني، يدخل ضمن هذا الإيجاز الملخّص، إذ يتولى زمام السّرد المصري، قائلًا للقاضي: “أيَّد الله سُطَا سَيْفِكَ العَمْري، وشيَّدَ ربع عِزِّ عدلِك العُمَري،…، أُنهِي إلى وَلِيِّ إفضالِكَ، وجلي إجلالِكَ، أنَّني وَلدْتُ هذا الغُلام، الماهر العُلامَ([75])، وعَلَّمْتُهُ الكلامَ، وثقفتُهُ مُذْ قَامَ حتى استقامَ، فحينَ شَبَّ في شِبابِهِ، ودَبَّ لَهَبُ هبابه، جعل يحصبني([76]) بشنيعِ مُنازعته ويَضْرُبني بقطيع مقاطعتهِ، …”([77]). لقد اشتركت تقنية الحذف مع الخلاصة في هذا النّص للقفز بالسّرد، وذلك بإسقاط مدّة الحساب التي بدأها من ولادة ابنه إلى مرحلة وصوله الشّباب، وبمقابل تلك السّرعات، كان للإبطاء في زمن القصّ، دور في كسر رتابة السّرد، عن طريق المشاهد الحواريّة التي عملت على تصوير الواقع المتغير، إذ أَسهم الوصف على إحداث نوعٍ من التأني في تدفق السّرد؛ لتمدّد زمن الخطاب على حساب زمن القصة، فتسنّى تأمل الذّوات والأشياء واستبطانها. وقد كثر استعمال تقنية الحذف في النّصوص المدروسة، ذلك نظرًا إلى أهمّيّة هذه التقنيّة في تسريع السّرد القصصي، والتّقدم بالأحداث إلى الأمام، واجتياز التفاصيل الجزئيّة التي لا تشكل أهمّيّة في نظام الأحداث.
ب- إبطاء القَصّ
- الوقفة([78]): وهي حركة سرديّة تعمل على تعطيل مسار الأحداث المتنامية إلى الأمام، فالوقفة هي اختلال زمني غير سردي، تتعلق بالمقاطع التي تتوقف فيها الحكاية وتغيب عن الأنظار، أمّا الخطاب فيستمر([79])، الأمر الّذي جعل من “الطول الذي يستغرقه القصّ يفوق بما لا يقاس مدّة زمن الوقائع، حتى أنّ هذه المدة تكاد تعادل الصفر“([80]). وقد يعلّق الرّاوي سير الأحداث ليقف عند وصف الأشياء فيراها كونه شاهدًا، يُلغي الزّمن، ليصطحب المتلقي لمعاني حالة مشتركة من التّفاعل، أو قد يعتمد ويرتبط بلحظة أو سلسلة من اللحظات التي قد لا تسهم في تبطئة الحكاية([81]).
كما لا يحدث توقف في المبنى الحكائي عندما تلجأ الشّخصيات ذاتها إلى التأمل في المحيط، فيأتي الوصف ذاتيًّا أقرب إلى مشهد منه إلى الوصف([82]).
ويحقق الوصف عدّة أهداف سرديّة منها “التّولج اللطيف في الموقف الملائم للحدّ من غلواء جريان الحدث وسرعته، وللتسلط على مشاهد معينة لجعل المتلقي يلتفت إليها“([83])، إلى جانب وظيفته الجماليّة التّزينيّة كذلك التّفسيريّة([84])، فهي تكشف حياة الشّخصيّة النّفسيّة وتشير إلى مزاجها وطبعها، فالمقاطع الوصفيّة تخدم بناء الشّخصيّة ولها أثر مباشر أو غير مباشر في تطور الحدث، وعندما يقف الوصف عند التفاصيل الصغيرة تكون وظيفته إيهاميّة([85]). وقد تعدّدت الأوصاف الواردة في نصوص المقامات الزّينبيّة، وعن طريق عدّة مظاهر أساسيّة أسهمت إلى حدٍّ كبير في إيقاف حركة الزّمن السّردي، فمنها ما جاء في وصف المكان، أو وصف الشّخصيّة، وكذلك وصف الأشياء الذي ورد بصورة بسيطة وضئيلة جدًا في النّصوص، ولعل ذلك نتيجة لضيق الحيز النّصي في المقامات.
وورد هذا النّوع من الوصف في بعض النّصوص عبر ما رصدته عين الراوي من صور الأشياء التي يشاهدها؛ ليقف على تفصيلاتها الدّقيقة، وينتج عن ذلك إيقاف أو تبطئة مسار زمن السّرد في الحكاية، ويتوضح ذلك في المقامة الشّاخيّة، إذ يقوم الراوي بإيقاف عجلة تتابع السّرد؛ وذلك عن طريق وصفه للحذاء الذي احتذاه في رحلته والمطيّة التي امتطاها في رحلته، قائلًا: “فحين أظلم مُحيّا الحظِّ الناقصِ، وعظُمَ ضَرْعُ التضرُّعِ القانصِ، بادرتُ إلى احتِذاءِ سبتيةٍ([86]) فتية، وامتطاءِ حربّيةٍ أبيةٍ“([87]) .
نلاحظ تداخل الوصف مع السّرد، بعد أن أنجز الوصف وظيفته الأساسيّة، لتوسيع مساحة القصّ السّردي؛ لتجميد زمن الحكايّة، وإيقاف التّطور الخطي للحدث الروائي، ثم يعود الرّاوي ليصف الرّقعة التي أعطاها له المصري، قائلًا: “وحين ولّت ألوية الظُّلَمِ السودِ، وكرّتْ كتائبُ الشّفق المنعدم البنودِ، ناولني رقعةً سنَّم([88]) مُطَي وطيِّها، واحكم الصاقَ غطي طيَّها“([89]). وفي ما يتعلق بوصف المكان الذي يعمل على تعطيل حركة الزّمن في الحكاية، فإنّه يؤدي دورًا أساسيًّا في النّص الحكائي، كونه يمثل الفضاء الذي تجري فيه الأحداث وعلى أرضيته تؤدي الشّخصيات أدوارها، فالوصف المكاني “يشغل منطقة سردية مهمة تضفي شيئًا من الإحساس بالطمأنينة على الرّاوي، وهو يعمد في كثير من الأحيان إلى تعطيل الحركة السّردية لتفعيل منطق المشهد الوصفي للمكان“([90]).
ومن ذلك ما نلحظه في المقامة المصريّة، إذ يعمد الراوي إلى إيقاف التتابع الطبيعي للأحداث في المقامة، فعندما وصل مصر بدأ بوصفها، كونها المكان الذي تدور فيه الأحداث وتنطلق نحو ذروتها، فيقول الراوي: “…، حتى ولجناها([91]) بعد مفارقةِ الأنيس، بكرة يومِ الخميسِ، والبلدُ زاهٍ بزهو الاريجِ، والزَّبُد طامٍ بتلاطم الخليج، والقَصْفُ يرفلُ بالرَّفل([92]) النبيلِ، والروضُ يثنى على انثيال تنويل النَّيل، والجو يبرئ حرارة الغليل،…
| فكأنَّها في القَدْرِ دُرةُ غائصٍ وكأنها في الحُسنِ شَمسُ ظهيرةٍ |
وكأنها في الرَّيحِ ريحُ العَبْهَرِ([93]) تُجلاَ على بدرِ السماءِ الانورِ…”([94]) |
اعتمد الرّاوي في وصفه لمصر على التّصوير من خلال اتكائه على التّشبيهات المركّبة؛ ليخلق صورةً مليئة بالحيويّة والحركة، فإنّ الوقفة الوصفيّة تمطط الزّمن السّردي، وتجعله وكأنّه يدور حول نفسه.
وأمّا وصف الشّخصيّة في نصوص المقامات الزّينبيّة فقد شكلت مظهرًا أساسًا من مظاهر الوصف التي اعتمدها الراوي؛ ليسهم في إيقاف حركة الزّمن السّردي أو التخفيف من حدة التتابع السّردي للأحداث. وقد عمد الراوي في بعض النّصوص إلى وصف الصفات الماديّة الخّارجيّة للشّخصيات، وفي نصوص أخرى اتجه إلى رصد الصّفات المعنويّة، وفي أحيان أخرى يتابع إيراده للأوصاف عن طريق الجمع بين الوصفي المادي والمعنوي، من ذلك ما نلمسه في المقامة المجديّة الفارقيّة، عندما أشار بعض الأصحاب إلى مجالس أحد الفضلاء والنّهل من فضل علمه، فيسأل القاسم عن الرّجل المشار إلى نباهته، فيجيبه أحدهم قائلًا: “شيخٌ ظاهرٌ الثَّطَطِ([95])، بارزُ القطط([96])، مرتعش البنان، منتعشُ الافتنان، تتدفق بحار الحكم من معانيه، ويتخلَّقُ بأخلاق المفاخرةِ من يُدانيه، لا يُحلُّ مالَهُ بُطُونَ الروّاجبِ، ولا يخلُّ مدى الأزمنةِ بظهورِ الحَسَنِ الواجبِ، ولم ندرِ بأيَّ المدرِ دارَهُ، ولا مِنْ أي الشَّجَرِ خُرقَتْ ثمارهُ ولم نُمَكِّنْهُ من الإرقالِ([97])، مُذْ نزلَ عن ناقتهِ المِرقَالِ“([98]).
يعمد الرّاوي في هذا النّص إلى إيقاف سير الأحداث جزئيًّا، ثم استئنافها من جديد، بعد أن استطاع التّعرف إلى حامل هذه الصّفات وهو زميله المصري صاحب المكايد.
2- المشهد : وهو حادثة معيّنة تحدث في مدّة زمنيّة محددة، ويستغرق المشهد حيزًا من الوقت بالقدر الذي لا يكون فيه أيّ تغيير في المكان أو قطع في استمراريّة الزّمن([99])، إذ تتطابق في هذه الحركة مدّة زمن الوقائع مع المدّة المستغرقة على مستوى القول([100])، أي يتعادل فيه الزّمنان([101])، لكن هذه المساواة هي اصطلاحيّة لا حقيقيّة، ذلك استنادًا لتنبيه النّاقد (جيرار جنيت Gerard Genette) ، بعدم إغفال الفرق بين مدّة الحوار الحقيقي الفعلي والعبارات المعبرة عنه في النّص الحكائي، فالحوار الواقعي الذي يمكن أن يدور بين أشخاص معينين، قد يكون بطيئًا أو سريعًا، بحسب الظروف، مع مراعاة لحظات الصّمت أو التكرار، ما يجعل الاحتفاظ بالفرق بين زمن السّرد وزمن القصة قائمًا على الدوام([102]).
ويؤدي المشهد وظيفة معاكسة لوظيفة الخلاصة، إذ يشاهد القارئ القصّة وكأنّها مسرح يتبع عليه الشّخصيات وهي تتحرك، وأمّا في الخلاصة فيتجه المتلقي إلى الراوي ويستمع إلى صوته([103]).
ويعطي المشهد للقارئ “إحساسًا بالمشاركة الحادّة في الفعل، إذ إنّه يسمع عنه معاصرًا وقوعه كما يقع بالضّبط وفي لحظة وقوعه نفسها، لا يفصل بين الفعل وسماعه، سوى البرهة التي يستغرقها صوت الرّوائي في قوله، لذلك يستخدم المشهد اللحظات المشحونة. ويقدم الرّاوي دائمًا ذروة سياق من الأفعال وتأزمها في مشهد“([104]). وقد يكون للمشهد قيمة افتتاحيّة عندما يدل على دخول شخصيّة موضع جديد، أو أن يأتي في نهاية فصل ليوقف مجرى السّرد فتكون له قيمة اختتاميّة([105]).
ويقسم (بيرسي لوبوك Percy Lubbock) المشهد على قسمين:
الأول: مشهد تصويري (غير درامي)، يعتمد على الوصف المسهب للأحداث.
الثاني: مشهد درامي، يعتمد على “مسرحة” الحدث وتقديم الشّخصيّة في إطار المشهد الدّرامي الكلّي([106]). ويحتجب الرّاوي في هذه الحركة الزّمنيّة؛ ليترك الشّخصيات تتحاور في ما بينها بلهجتها ومستوى إدراكها([107])، إذ يُعدُّ الحوار من أكثر الطرق مناسبة لتزويد المشهد بالمساعدات الوصفيّة والتّحليليّة والإخباريّة التي يتطلبها([108]).
وقد وجدنا أنّ أغلب نصوص المقامات، قد بنيت على أساس تعاقب المشهد بنوعيه (الحواري والتّصويري)، ففي المقامة النّيسابوريّة يحرص الراوي في الاستهلال على تقديم مشهد تصويري وصفي عن طريق وضعه وحالته النّفسيّة عند وصوله إلى مدينة نيسابور ليلًا، وقد أغلقت أبوابها، قائلًا: “…، فتوخيتُ المبيتَ بين الأشجار، بعد حطَّ الشّجار([109])، ثم إنّي نضيتُ لباس الإيجاسِ([110])، ومضيتُ إلى المِهراسِ([111])، مُضِيَّ الهرماسِ، فتكرَّعت([112])، للركوع بعد كسر سلامي([113]) الجزع والكُوع([114])، ثم ملتُ إلى المطيّة فامجدتُها([115]) وانسللت الى العَيَبةِ([116]) فشدَدُتها وحين احجمتْ جحافلُ حامَ، وحالفَ الحذَر ذلكَ الالتحامَ، جعلتُ أجولُ بينَ الشجيرِ([117])، خاليًا من المُخاتل والشّجيرِ، فلم يَمْضِ وهنٌ من الظلام، أو تبسَّمَ ثغرُ القَمرِ تحت اللثامِ، فتجردتْ حُلائلُ الروح، وغرَّدتْ ورقُ الحمائم على الدوح“([118]).
اعتمد الرّاوي في تطوير السّرد المشهدي على استعمال التّصوير؛ لإيضاح وتفسير ما يغمض على القارئ، وحمله على المشاركة في تلك الظروف ليحقق بذلك النزعة المشهديّة. ويعقب هذا المشهد التصويري مشهدًا حواريًّا متمثلًا بالحوار الذي جرى بين المصري وابنه، إذ يقف الراوي جانبًا، ويسلّم قيادة السّرد للشّخصيات نفسها، فيقول الولد لأبيه: “يا أبت لقد سئمت السِّفار([119])، واجتويت([120]) السُّفار،…، فهل ترى حَزامُة حوبائك، وتُرى على أرائك، بأن أصير بأجويّة الملوك، بعد اقتناء السابح والمملوك، متوشحًا بوشاح الوشاء ([121]) مترشحًا إلى كتابة الإنشاء، فإنّها رتبة جليلةٌ، ومرتبةٌ نبيلةٌ فقال له: يا بُنيَّ لقد رُمْتَ مسلكًا وعرًا،…، فقال له: إنّي وبكَ لعقابُ هذا اللَّوح وعذابُ هذه الحنَّانة الدَّلُوحِ([122])، وسُرحوب([123]) هَذا المضمارِ([124])،…، فقال له: يا بني لا تكُ ممَّنْ يَطَّبْيهِ طَبَعُه، ويطغيه طمعه،…، وها أنا مقترحٌ عليك ومجترحٌ لديكَ، فإن أنتَ ضاهيتَ ما ابتدعهُ وأتيتَ بمثل ما اخترعه، علمتُ أنّك ممّن يعومُ بُعباب هذا الحَبَابِ([125])،…، فقال له : تالله لأنهضنَّ بهذا الفادح،…”([126]).
تتعاضد في هذه المقامة المشاهد التّصويريّة والحواريّة معًا، لتجعل المتلقي يسمع ويرى الشّخصيات وهي تتحرك وتتحاور، وكأنّه يشاهد ذلك على خشبة المسرح.
ونلحظ أن هذا التّدرج في المشاهد وتنوعها يشكل البنية الأساسيّة التي قامت عليها أغلب النّصوص(*)، وقد تخللها كثير من الاسترجاعات وجمل ومقاطع وصفيّة، تعمل على إبطاء التتابع السّردي للأحداث فالمشهد يؤدي دور “بؤرة زمنيّة أو قطب جاذب لكلّ أنواع الأخبار والظروف التّكميليّة“([127])، سواء أكان الحوار الواقعي أو التخييلي بطيئًا أو سريعًا حسب طبيعة النّص السّردي، مع مراعاة لحظات الصّمت أو التكرار، ما يجعل الاحتفاظ بزمن الحوار وزمن القصة قائمًا في النص.
وهذا ما يتضّح جليًّا في المقامة الجزيريّة، إذ يبدأ الراوي بقصة رحلته إلى الجزيرة العمريّة والتقائه برفيقه المصري، وبعد مصافحته، بدأ المشهد الحواري بينهما، وينقل الرّاوي ذلك المشهد قائلًا: “ثم قال لي: إلامَ تركبُ التلاتل([128])، وتصحب المخاتل وتقلق المقاتل،…، فقلت له: إلى أنْ ينشرَ مَيْتُ إفاقتي، وتطوى من أجزاع الجَزَع دروُع فاقتي،…، فقال لي: بلغني ما تعطرتْ، بذكره الأكنافُ، وتشَّوفَتْ بصنوفِ أوصافه الأصناف،…، من وصف الجزيرة العمريّة([129])، وأرجَ أخلاق قومها الشِمَّرية،…، فحمَلني الشوقُ،…، على أن أتضمخ بصعيدها، …، فقلت له: متى تخذت المجرةُ للكرم جسورًا،…، فقال لي: سبحان من سلب سناحِسِّكَ السليمِ،…، ثم قال لي: هل لك في الموافقة إليها، وكثرة نثار هذه الأثنيّة عليها، لأُنسَيكَ مُرَّ انقطاع الرّضاعِ، بحلاوةِ ارتفاع هذا الإيضاع، فقلت له: من لي بأنْ أحمل تراب شراكِكَ، ولو نشِبتُ في شَطَنِ أشراكِكَ وأنسلك في عِلاط([130]) عيالك، ولو رميتُ بسلاط([131]) اغتيالك“([132]). انكشف في هذا المشهد الحواري عمق الشّخصيات، وتطلعاتها وأفكارها وأهدافها من الرّحلة إلى تلك المدينة، واتضحت حالة القلق والتّخوف لدى القاسم من مرافقة المصري، وبعد هذا المشهد الحواري يعمد الراوي إلى وقفة وصفيّة تسهم في إيقاف حركة الزّمن، ذلك بوصفه للمدينة وسكانها، ثم يعقب ذلك مشهد تصويري يصور فيه المجلس الذي ضمهم، قائلًا: “فطفقت تدور لدينا فواكه مفاكهاتهم، وتسير إلينا مناسم مناسماتهم، ونحن نمرح في مروج افتنانهم ونمرح،…”([133]). وقد يعمد الراوي عن طريق بعض المشاهد إلى تصوير الشّخصيات وأفعالهم وتحولات نفوسهم وانقلابها، وهذا ما نلمسه في المقامة الأهوازيّة، إذ يستعطف المصري وعجوزه القوم ببديع الإشارات والعبارات، إلّا أنّ القوم لم يكترثوا ولا تحركت مشاعرهم فينقل الراوي ذلك المشهد التصويري، قائلًا: “…، ثمَّ إنَّهم مكثُوا ليُحلَّ لهم وكاء، أو ينهل عليهم وعاءٌ، فما ألبَّ([134]) بهم لبابةٌ([135])، ولا انصبَّ من صَوْبِهم صُبابةٌ، فلمّا رأى الشيخُ أنْ قد أورق شجرُ إخفاقهم، وأورقَ صائدُ تملُّقِ إملاقهم،…، وأنَّ عيونَ إعطائهم مقطوعة الأهراق،…، أنسلَّ سرابُ قلقهِ الرَّقَراق، وسَلَّ سيوفَ السَّدَمِ لَهْمَهَمَةِ همّهِ المُهراق، وقال: يا اعنّة العطايا، وأسَّنةَ الهدايا، وأخران الليانِ، واخوانَ الخِوانِ، وحسّادَ الآكل،…، هلا تنظرون بعين طالما اكتَحَلتْ بأثمد الغواية وتسمعون بأُذن قلّما امتلأت بماعون التلاوة، فترشحونَ لشيخٍ اشتغل بإفاله عن احتفاله، وبَحزقِ احتيالهِ عن مخادنةِ اختيالهِ، وعن كثرة عياله، بتتابع اعواله…”([136]). نجد في هذا النّص أن أحداث القصة لم ينقلها السّرد التقليدي، وإنما كان ذلك عن طريق استعادة المشهد بتفاصيله الدّقيقة، وقد بين جملة من التفاصيل عبر ما نقله من كلام الشيخ مع الجماعة والصفات التي نعتهم.
لقد استعمل الراوي تقنية المشهد بنوعيه الوصفي والحواري؛ للحدّ من رتابة السّرد التقليدي للأحداث، وكشف الوقائع بتفاصيلها الدقيقة للمتلقي، قد أسهم في إبطاء حدة التتابع السّردي.
الخاتمة: لقد خلص البحث في بنية الزّمن في المقامات الزّينبيّة لابن الصّيقل الجزري إلى استجلاء العلاقة بين زمن القصة وزمن الخطاب من خلال علاقتين هي (زمن السّرد في الماضي والحاضر والمستقبل)، ودُرس عبر تقنيتي الاسترجاع والاستباق. لقد اعتمد بناء الزّمن في النصوص على تقنية الاسترجاع بنوعيه الخارجي والدّاخلي، إذ شغلت مساحة غير قليلة قياسًا بحضور تقنية الاستباق في النّصوص المدروسة، فكثيرًا ما تستذكر الشّخصيات من حياتها الماضية، واستذكار الوطن والأحداث والوقائع، وبوسائل متنوعة، وتحقيقًا لغايات متعددة. ولم تقتصر الاسترجاعات على شخصيات محددة في النّص، بل شمل العديد من الشّخصيّات الرئيسة أو الثانوية في النص.
أمّا ما يتعلق بتقنيّة الاستباق، فقد كانت الغلبة للاستباقات الدّاخليّة مقارنة بالاستباقات الخارجيّة، واختلفت وظيفتها في النّصوص، فمنها ما كانت وظيفتها تمهيديّة تمهد للآتي من الأحداث، أو قد تكون وظيفتها ختاميّة تدفع بالأحداث نحو النهاية. أمّا العلاقة الثانية فهي (زمن السّرد في السّرعة والبطء)، وقد اعتمد المؤلف على توظيف التقنيات الأربعة، وهي: الخلاصة والحذف في تسريع القَصّ، وأمّا لإبطاء القص فقد استعمل (الوقفة والمشهد) لتحقيق ذلك. أمّا في ما يخص تقنيتي (الخلاصة والحذف)، فقد ركز الراوي على تكثيف المعلومات والأحداث المهمة، والابتعاد من التّفاصيل التي لا يؤثر تجاوزها على مسار الأحداث، وفي ذلك تحفيز لذهن المتلقي في معرفة وفهم الأحداث على الرّغم من المدّة الزّمنيّة التي ترك الراوي ذكرها، تسريعًا للسرد، وترشيقًا للنص. وأمّا ما يتعلق بإبطاء السّرد في النّص، فقد شكّل الوصف النسبة الأكبر من تلك التوقفات التي تحصل أثناء السّرد، إذ لم يقتصد الراوي جهدًا في وصف شخصيات وأماكن الأحداث، وفي أحيان قليلة وصف الأشياء. وبالنسبة إلى المشهد فقد بنيت معظم نصوص المقامات على أساس تعاقب المشهد بنوعيه الحواري والتّصويري، وقد أسهم ذلك في إبطاء الحكي.
وما لاشك فيه أنّ لجوء المؤلف إلى استعمال المشهد بنوعيه، مستغنيًا بذلك عن التقريريّة والأسلوب المباشر؛ إبعادًا للسأم عن المتلقي، وإشراكه في التفاصيل وكأنّه يشاهد ذلك أمام عينيه.
الهوامش
[1]– وزارة التربيّة – مديرية تربية بغداد – الكرخ الثالثة.
Ministry of Education – Baghdad Education Directorate – Karkh 3.Email: alaamufaq999@gmail.com
[1]– ينظر: آليات بناء الزمن في القصة القصيرة المصرية في الستينات، هيثم الحاج علي: 38-39.
[2]– ينظر: نظرية المنهج الشكلي (نصوص الشكلانيين الروس): 180.
[3]– ينظر: تحليل الخطاب الروائي: 30.
[4]– ينظر: خطاب الحكاية: 45- 168.
*- يرى بعض النقاد أن التواتر لا يخص زمن القص، إنما يخص مسألة الأسلوب السردي الروائي؛ ينظر: تقنيات السرد الروائي: 111.
[5]– البناء الفني في الرواية العربية في العراق (بناء السرد): 62.
[6]– خطاب الحكاية: 47.
[7]–ينظر: الشعرية: 48.
[8]– المصطلح السردي: 25.
[9]– ينظر: الفضاء الروائي عند جبرا إبراهيم جبرا: 104.
[10]– ينظر: المصدر نفسه: 60.
[11]– ينظر: خطاب الحكاية: 60- 61.
[12]– المماذقيّة: المماذقة: ضد المخالصة، ينظر: لسان العرب، مادة (مذق).
[13]– شهباء: مجدبة، لا يرى فيها مطر ولا خُضرة، ينظر: المصدر نفسه ، مادة (شهب).
[14]– المقامات الزينية، المقامة الثالثة: 111- 112.
[15]– ينظر: المصدر نفسه : 41.
[16]– الجرساء: الأصيلة، ينظر: لسان العرب، مادة (جرس).
[17]– المقامات الزينية، المقامة الثامنة: 173- 174.
[18]– نظرية المنهج الشكلي: 189.
[19]– ينظر: بناء الرواية: 43.
[20]– ينظر: خطاب الحكاية: 76.
[21]– خطاب الحكاية: 76.
[22]– ينظر: نظرية المنهج الشكلي: 189.
[23]– ينظر: خطاب الحكاية: 77.
[24]– الراحة: السالك، والثانية ضد التعب، ينظر: لسان العرب، مادة (روح).
[25]– الحوب: الحزن والوحشة، ينظر: لسان العرب ، مادة (حوب).
[26]– تفرى: تمزق وتشقق، ينظر: المصدر نفسه ، مادة (فرا).
[27]– يقرى: يطعن فيربى به، ينظر: المصدر نفسه ، مادة (قر).
[28]– الإساد: عظم وطال. الآساد: الفساد. الأيساد: الإغراء، ينظر: المصدر نفسه ، مادة (أسد).
[29]– المقامات الزينية ، المقامة الثالثة عشرة: 216.
[30]– كعمت: اخرست، ينظر: لسان العرب، مادة (كعم).
[31]– عكمت: صرفت، ينظر: المصدر نفسه ، مادة (عكم).
[32]– المقامات الزينية، المقامة الثالثة عشرة : 222.
[33]– ينظر: خطاب الحكاية: 77.
[34]– صرام: قطع، ينظر: لسان العرب، مادة (صرم).
[35]– خلال: الفساد في الامر، والثانية خصالك، ينظر: المصدر نفسه، مادة (خلل).
[36]– المقامات الزينية، المقامة الثانية: 104.
[37]– المحضير: فرس محَضير: شديد العدو، ينظر: لسان العرب، مادة (حضر).
[38]– النضير: الذهب، ينظر: المصدر نفسه، مادة (نضر).
[39]– المقامات الزينية، المقامة الثانية: 106.
[40]– ينظر: بنية القصص الصوفي: 136.
[41]– ينظر: خطاب الحكاية: 102.
[42]– ينظر: نظرية السرد من وجهة النظر إلى التبئير: 125.
[43]– ينظر: خطاب الحكاية: 108- 109.
[44]– ينظر: خطاب الحكاية: 109؛ ينظر: تقنيات السرد الروائي: 127.
[45]– أساليب السرد في الرواية العربية، د. صلاح فضل، دار سعاد الصباح، الصفا- الكويت، ط1، 1992: 21.
[46]– ينظر: بنية النص السردي: 76؛ ينظر: تقنيات السرد الروائي: 128.
[47]– ينظر: بناء الرواية (دراسة مقارنة): 56.
[48]– زمني : شدني، ينظر: لسان العرب، مادة (زمن).
[49]– رعيل: جماعة الخيل، ينظر: لسان العرب، مادة (رعل).
[50]– الجنف: الميل والانحراف ، ينظر: المصدر نفسه، مادة (جنف).
[51]– المقامات الزينية ، المقامة الثلاثون: 381- 382.
[52]– السموم: الريح الحارة، الثانية : المنخران والفم والاذنان، ينظر: لسان العرب، مادة (سمم).
[53]– أمارج: أضيع، مارج: اختلط واضطرب، ينظر: المصدر نفسه، مادة (مرج).
[54]– الهموم: الناقة الحسنة المشية، الثانية: جمع (الهم) وهو الحزن، ينظر: المصدر نفسه، مادة (همم).
[55]– صكة: شدة، ينظر: المصدر نفسه، مادة (صكك).
[56]– درئة: أي دفعه الليالي، ينظر: المصدر نفسه، مادة (درأ).
[57]– الحنادس: ليالٍ شديدة الظلمة، ينظر: المصدر نفسه، مادة (حندس).
[58]– أبوابه: غاياته، ينظر: المصدر نفسه، مادة (بوب).
[59]– مفهقة: المملوة، ينظر: المصدر نفسه، مادة (فهق).
[60]– المقامات الزينية، المقامة الثامنة والعشرون: 363- 364.
[61]– وتترجم أيضًا بـ (القطع) و(الثغرة)، ينظر: تقنيات السرد الروائي: 125؛ ينظر: بنية النص السردي: 77.
[62]– تقنيات الزمن في السرد القصصي من زمن التخييل إلى زمن الخطاب: 27.
[63]– ينظر: خطاب الحكاية: 117- 118.
[64]– رداع: أثر، ينظر: لسان العرب، مادة (ردع).
[65]– المقامات الزينية، المقامة التاسعة (العمادية الاربلية) : 181.
[66]– ينظر: خطاب الحكاية: 118- 119، ينظر: المصطلح السردي: 72.
[67]– سردية النص الادبي، د. ضياء غني لفتة، عواد كاظم، دار الحامد للنشر والتوزيع ، عمان- الاردن، ط1، 2011: 59.
[68]– انعياجه: انعطافه، ينظر: لسان العرب، مادة (عجج).
[69]– المقامات الزينية، المقامة الثلاثون: 383.
[70]– بشرت: قشرت، ينظر: لسان العرب، مادة (بشر).
[71]– الجمام : الراحة، ينظر: المصدر نفسه، مادة (جمم).
[72]– الثمام: نبت ضعيف قصير لا يطول، ينظر: المصدر نفسه ، مادة (ثمم).
[73]– سورة الاحزاب، الاية 10، قوله تعالى: ] وبََلَغَتْ القُلُوب الحَنَاجِر [ .
[74]– المقامات الزينية ، المقامة الحادية عشرة: 197.
[75]– العلام: الداهية الجري، ينظر: لسان العرب، مادة (علم).
[76]– يحصبني: يرجمني، ينظر: المصدر نفسه، مادة (حصب).
[77]– المقامات الزينية، المقامة الثالثة والثلاثون: 412- 413.
[78]– وتسمى أيضا (الاستراحة)، ينظر: تقنيات السرد الروائي: 126.
[79]– ينظر: نظرية السرد من وجهة النظر إلى التبئير : 127.
[80]– تقنيات السرد الروائي: 126.
[81]– ينظر: خطاب الحكاية: 112.
[82]– ينظر: بنية النص السردي، د. حميد لحمداني: 77.
[83]– في نظرية الرواية: 258.
[84]– ينظر: بنية النص السردي: 79.
[85]– ينظر: بناء الرواية (دراسة مقارنة): 82.
[86]– سبتية: نعال لاشعر عليها، ينظر: لسان العرب، مادة (سبت).
[87]– المقامات الزينية، المقامة العاشرة: 187.
[88]– سنمَ: علا، ينظر: لسان العرب، مادة (سنم).
[89]– المقامات الزينية، المقامة العاشرة: 191.
[90]– المغامرة السردية: 88.
[91]– ولجناها: دخلناها، ينظر: لسان العرب، مادة (ولج).
[92]– الرَّفل: جرُّ الذيل، ينظر: المصدر نفسه ، مادة (رفل).
[93]– العبهر: النرجس والياسمين، ينظر: لسان العرب ، مادة (عبهر).
[94]– المقامات الزينية، المقامة السابعة عشرة: 262.
[95]– الثَّطط: القليل شعر الحاجبين، ينظر: لسان العرب، مادة (ثطط).
[96]– القطط: الشعر شديد الجعودة، ينظر: المصدر نفسه ، مادة (قطط).
[97]– الارقال: الارتفاع والشموخ، المرقال: الناقة المرقال: المسرعة، ينظر: لسان العرب ، مادة (رقل).
[98]– المقامات الزينية ، المقامة الثالثة والعشرون: 316- 317.
[99]– ينظر: الفضاء الروائي عند جبرا ابراهيم جبرا: 135.
[100]– ينظر: بنية السرد في القصص الصوفي: 227.
[101]– ينظر: أساليب السرد في الرواية العربية: 21.
[102]– ينظر: بنية النص السردي: 78؛ ينظر: بلاغة الخطاب وعلم النص: 278.
[103]– ينظر: الفضاء الروائي عند جبرا ابراهيم جبرا: 137.
[104]– بناء الرواية (دراسة مقارنة): 65.
[105]– ينظر: شعرية الخطاب السردي: 112.
[106]– ينظر: صنعة الرواية، بيرسي لوبوك، ترجمة عبد الستار جواد، دار الرشيد، بغداد، الطبعة الاولى، 1981: 71- 72؛ ينظر: الفضاء الروائي عند جبرا: 137.
[107]– ينظر: بنية القصص الصوفي: 227.
[108]– ينظر: عالم القصة: 267.
[109]– الشجار: عود الهوج أو مركب اصغر منه، ينظر: لسان العرب، مادة (شجر).
[110]– الإيجاس: وقع في نفسه الخوف، ينظر: المصدر نفسه، مادة (وجس).
[111]– المهراس: حجر مستطيل منقور يتوضأ منه. الهرماس: من اسماء الاسد، ينظر: المصدر نفسه، مادة (هرس).
[112]– تكرعت: تطهرت للصلاة، ينظر: المصدر نفسه، مادة (كرع).
[113]– سلامى: عظام الاصابع في اليد والقدم، ينظر: لسان العرب، مادة (سلم).
[114]– كوع: طرف الزند الذي يلي أصل الابهام، ينظر: المصدر نفسه، مادة (كوع).
[115]– امجدتها: اعلفتها، ينظر: المصدر نفسه، مادة (مجد).
[116]– العيبة: ما يجعل فيه الثياب، ينظر: المصدر نفسه، مادة (عيب).
[117]– الشجير: الوادي كثير الشجر، الثانية: الغريب والصاحب، ينظر: المصدر نفسه، مادة (شجر).
[118]– المقامات الزينية، المقامة الثالثة عشرة: 214.
[119]– السفار: كثرة السفر، الثانية: الزمام والحديدة التي يخطم بها البعير ليذل وينقاد، ينظر: لسان العرب، مادة (سفر).
[120]– اجتويت: كرهت ، ينظر: المصدر نفسه ، مادة (جوا).
[121]– الوشاء: جمع “الوشى” وهو من الثياب معروف، ينظر: المصدر نفسه، مادة (وشا).
[122]– الدلوح: السحابة تدلح في مسيرها من كثرة مائها كأنها تتحرك انخزالاً، ينظر: المصدر نفسه ، مادة (دلح).
[123]– سرحوب: الفرس الطويل، ينظر: المصدر نفسه، مادة (سرحب).
[124]– المضمار: غاية الفرس في السباق، ينظر: لسان العرب، مادة (ضمر).
[125]– الحباب: معظم الماء، ينظر: المصدر نفسه: مادة (حبب).
[126]– المقامات الزينية، المقامة الثالثة عشرة: 215- 217.
*- ينظر لمزيد من الاطلاع: المقامات الزينية: المقامة السادسة عشرة: 249، المقامة الرابعة والعشرون: 323، المقامة الثالثة والثلاثون: 411.
[127]– خطاب الحكاية: 121.
[128]– التلاتل: الصعاب الشديدة، ينظر: لسان العرب: مادة (تلل).
[129]– الجزيرة العمرية: هي جزيرة ابن عمر، بلدة فوق الموصل، أول من عمرها الحسن بن عمر بن خطاب التغلبي وتحيط بهذه الجزيرة دجلة إلا من ناحية واحدة شبه الهلال، ثم عمل هناك خندق أجرى فيه الماء فأحاط بها من جميع جوانبها بهذا الخندق، ينظر: معجم البلدان: مج2: 138.
[130]– علاط: خيط ، ينظر: لسان العرب، مادة (علط).
[131]– سلاط: جمع “سلط” وهو النصل لا نتوء فيه : ينظر: المصدر نفسه، مادة (سلط).
[132]– المقامات الزينية، المقامة التاسعة والاربعون : 572- 573.
[133]–المصدر نفسه: 574.
[134]– ألب: أنساق وأسرع، ينظر: لسان العرب، مادة (ألب).
[135]– لبابة: الاستجابة، ينظر: المصدر نفسه، مادة (لبب).
[136]– المقامات الزّينيّة، المقامة الأربعون: 489- 490.
المصادر
– القرآن الكريم
- أساليب السّرد في الرّواية العربيّة، د. صلاح فضل، دار سعاد الصباح، الصفا- الكويت، ط1، 1992.
- آليات بناء الزمن في القصة القصيرة المصرية في الستينات، هيثم الحاج علي، جامعة حلوان، كلية الاداب، (د. ط)، 2005.
- بلاغة الخطاب وعلم النص، د. صلاح فضل، عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب- الكويت، 1992.
- بناء الرواية (دراسة مقارنة لثلاثية نجيب محفوظ) ، د. سيزا احمد قاسم، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1984.
- البناء الفني في الرواية العربية في العراق، بناء السرد، د. شجاع مسلم العاني، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد- العراق، 1994.
- بنية السرد في القصص الصوفي (المكونات والوظائف والتقنيات)، د. ناهضة ستار، من منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق- سوريا، 2003.
- بنية النّص السّردي (من منظور النقد الادبي)، د. حميد لحمداني، المركز الثقافي العربي للطباعة والنشر، بيروت- لبنان، ط1، 1991.
- تحليل الخطاب الروائي (الزمن- السرد- التبئير) سعيد يقطين، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء- المغرب، ط4، 2005.
- تقنيات السرد الروائي في ضوء المنهج البنيوي، د. يمنى العيد، دار الفارابي، بيروت- لبنان، ط3، 2010.
- تقنيات الزمن في السرد القصصي من زمن التخييل إلى زمن الخطاب، عواد علي، مجلة الأديب المعاصر، بغداد، العدد (44)، 1992.
- خطاب الحكاية (بحث في المنهج) جيرار جنيت، ترجمة: محمد معتصم، عبد الجليل الأزدي، عمر حلمي، الهيئة العامة للمطابع الأميرية، المجلس الأعلى للثقافة، ط2، 1997.
- سردية النص الأدبي، د. ضياء غني لفتة والدكتور عواد كاظم لفتة، دار الحامد للنشر والتوزيع، عمان- الأردن، ط1، 2011.
- شعرية الخطاب السردي، محمد عزام، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، 2005.
- صنعة الرواية، بيرسي لوبوك، ترجمة: عبد الستار جواد، دار الرشيد للنشر، بغداد- العراق، ط1، 1981.
- عالم القصة، برناردي فوتو، ترجمة محمد مصطفى هدارة، دار الكتب، القاهرة، بالاشتراك مع مؤسسة فرانكلين، نيويورك للطباعة والنشر، 1969.
- الفضاء الروائي عند جبرا ابراهيم جبرا، د. إبراهيم جنداري، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد- العراق، ط1، 2001.
- في نظرية الرواية (بحث في تقنيات السرد)، د. عبد الملك مرتاض، سلسلة عالم المعرفة، ع 240، الكويت، 1998.
- لسان العرب، أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور الافريقي المصري، دار صادر، بيروت- لبنان، ط3، 2004.
- المصطلح السردي (معجم مصطلحات)، جيرالد برنس، ترجمة: عابد خزندار، مراجعة وتقديم: محمد بربري، المجلس الأعلى للثقافة، ط1، 2003.
- معجم البلدان، شهاب الدين ابي عبد الله ياقوت الحموي، دار صادر للطباعة والنشر بيروت، 1957.
- المغامرة السردية (جماليات التشكيل القصصي)، سوسن هادي جعفر، دار الثقافة والاعلام، الشارقة- دولة الامارات، ط1، 2010.
- المقامات الزينية، أبي الندى معد بن نصر بن رجب البغدادي الجزري (701هـ)، دراسة وتحقيق د. عباس مصطفى الصالحي، دار المسيرة، ط1، 1980.
- نظرية السرد (من وجهة النظر إلى التبئير)، مجموعة مقالات، ترجمة: ناجي مصطفى، منشورات الحوار الاكاديمي والجامعي، الدار البيضاء، ط1، 1989.