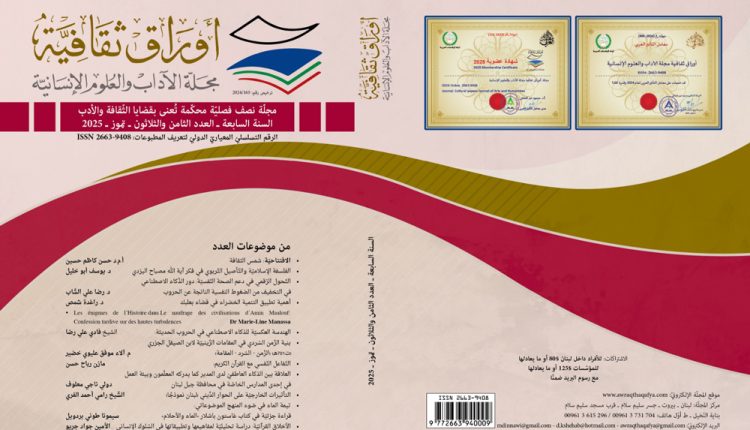عنوان البحث: أسباب أخطاء القراءة الجهريّة عند متعلمي المرحلة الأساسيّة العليا، بين التشخيص ومقترحات العلاج
اسم الكاتب: حنين حسن الحاج علي
تاريخ النشر: 2025/07/16
اسم المجلة: مجلة أوراق ثقافية
عدد المجلة: 38
تحميل البحث بصيغة PDFADOI: https://aif-doi.org/awraq/013808
أسباب أخطاء القراءة الجهريّة عند متعلمي المرحلة الأساسيّة العليا، بين التشخيص ومقترحات العلاج
Causes of reading aloud errors among upper primary school students: Diagnosis and treatment suggestions
Hanin Hassan al hajj Ali حنين حسن الحاج علي[1]
تاريخ الإرسال؛21-5-2025 تاريخ القبول:2-7-2025
ملخّص
تهدف هذه الدّراسة إلى تشخيص أسباب أخطاء القراءة الجهريّة عند متعلّمي المرحلة الأساسيّة العليا، وتحليلها من جانبين لغوي وتعليمي، وصولًا إلى رؤية علاجيّة. استخدمت الباحثة المنهج الوصفي التّحليلي، وطبّقت العيّنة على طلّاب من صف السّابع الأساسي، إذ أظهرت النّتائج في أنّ أبرز الأخطاء تمثّلت في اللفظ غير الصّحيح لمخارج الحروف، وضعف التّشكيل، ومواطن الوقف والابتداء، والنّبر، والتّنغيم. وتعود أسباب هذه الأخطاء إلى ضعف الفهم القرائي، ونقص البرامج التّدريبيّة للمعلّمين، وغياب العلاج الفردي للمتعلّم. وقد خلص البحث إلى عدّة توصيات تعزز من فاعليّة العمليّة التعليميّة للقراءة الجهريّة.
الكلمات المفتاحيّة: أخطاء القراءة، القراءة الجهريّة، القراءة الإنسيابية، المرحلة الأساسيّة، علاج ضعف القراءة.
Abstract
This study aims to diagnose the causes of reading aloud errors among upper primary school students, analyze them from both linguistic and educational perspectives, and arrive at a therapeutic vision. The researcher used a descriptive analytical approach and applied the sample to seventh-grade students. The results showed that the most common errors were incorrect pronunciation of letters, weak diacritics, weak stops and starts, stress, and intonation. The causes of these errors are attributed to poor reading comprehension, a lack of teacher training programs, and the absence of individualized treatment for learners. The study concluded with several recommendations to enhance the effectiveness of the teaching process of reading aloud.
Keywords: reading errors, reading aloud, fluid reading, primary school, treatment of reading impairment
المقدّمة
تعدّ القراءة من الوسائل المهمّة التي يستطيع الإنسان بوساطتها أن يتصل بغيّره من الناس الذين تفصل بينهم المسافات الزّمانيّة والمكانيّة. وهي التي تنقل ثمرات العقل البشري، وأنقى المشاعر التي عرفها عالم الصفحة المكتوبة. فهي وسيلة تمكّن الأفراد والمجتمعات من الاطلاع على نتاج العقل البشري في مختلف العصور والاتصال بتراثه، واكتساب المعرفة والثقافة. ولها دور في توسيع دائرة معارف الفرد وتزويده بأنواع مختلفة من الحقائق التي تتصل به وبالعالم الذي يعيش فيه. إنّ القراءة عمليّة فكريّة ترمي إلى فهم القارئ وتفاعله مع النّص، والانتفاع بما يفهم في مواجهة المشكلات والمواقف الحياتيّة، فلم تعد القراءة عمليّة يراد بها إيجاد الصّلة بين الكلام والرّموز الكتابيّة، ولم تعد عناصرها مقتصرة على المعنى الذّهني واللفظي الذي يؤديه الرّمز المكتوب، بل صارت ترتكز على أسس جديدة في ضوء ذلك التّغير، وهي التعرّف والنطق، والفهم، والنقد، والتّفاعل، وحلّ المشكلات، والتّصرف في المواقف الحياتيّة.
فالقراءة إحدى المهارات اللّغوية التي تسهم في إمداد الفكر الإنساني بأسس الإبداع، إذ يعيش الإنسان بالقراءة حياة الحاضر والماضي معًا، فيعيش بالقراءة عصورًا وأزمانًا بعيدة ممتدة يشارك أهلها معارفهم وخبراتهم ويستوحي منها، ومما أبدعته عقولهم إبداعاته الجديدة([2]).
وتُعدّ القراءة الجهريّة من الأدوات المهمّة لاكتساب المعرفة والثقافة، والاتصال بثمرات العقل البشري، ووسيلة من وسائل النّمو الاجتماعي والعلمي بالنسبة إلى كلّ من الفرد والمجتمع، ويرتبط نجاح التلميذ وتفاعله خلال عمليّة التّعليم بنجاحه في القراءة.
كما “إنّ تعلّم القراءة يدخلنا إلى عالم الكلمة المكتوبة الذي لا غنى عنه في الولوج إلى الحضارة المعاصرة؛ فإنّ فعل القراءة يكسبنا ويمكننا التّركيز على اثنتين منها تشكلان الأساس الذي لا غنى عنه في كل تعلّم مستقبلي وفي سائر مناحي حياتنا وهما: مهارة الإصغاء ومهارة التّحدث”([3]).
وتتمثل أهمّيّة القراءة الجهريّة في عدّة جوانب هي: الجانب اللّغوي والجانب التّربوي والجانب النّفسي والجانب الاجتماعي. والقراءة ليست مهارة واحدة وإنّما هي مجموعة من المهارات منها: قراءة الكلمات قراءة صحيحة من النّاحية الصرفيّة (بنية الكلمة) ومن النّاحية النحويّة (حركة إعراب آخر الكلمة) وذلك بحسب موقعها من الجملة، وتغيّر نبرة الصّوت بحسب المعنى كالاستفهام، والتّعجب، وبحسب الطلاقة في القراءة.
وتعتمد القراءة الجهريّة بشكل كبير على النّطق؛ فالنّطق الصّحيح للحروف والكلمات دليل واضح على حسن إدراكها، بالإضافة إلى توصيل المعلومات إلى المستمع بصورة تتيح له تتبع المعاني، وبذلك يكون الاتصال اللّغوي بين القارئ والمستمع بنجاح. وعلى الرّغم من الأساليب والطرائق المتعددة إلّا أنّنا نجد الأخطاء في القراءة الجهريّة عند العديد من المتعلمين، وخصوصًا في المرحلة المتوسطة، وفي تجسيد الكلمة وصورتها ونطقها بالشّكل السّليم، وفي حذف بعض الكلمات عند القراءة، وفي عدم قراءة الحروف بمخارجها الصّحيحة. ومن خلال العمليّة التعلميّة التي نواجهها كمعلّمين، لاحظنا وقوع الكثير من المتعلّمين بالعديد من الأخطاء أثناء قراءتهم الجهريّة، إذ يعجزون عن أداء القراءة المستوفية لشروطها، وهذا ما ينتج عن عدم قدرة التلاميذ على فهم النّص، وإدراكهم معناه، ما يزيد من ارتباكهم وينعكس على ثقتهم بأنفسهم.
يُعدُّ تدريب الأطفال على المهارات الأساسيّة في القراءة، واستخدام استراتيجيّات قرائيّة متعدّدة ومتنوّعة في صفوف المدرسة الابتدائيّة أمرًا حيويًّا في اكتساب وتوظيف مهارات القراءة والكتابة في المراحل الدّراسية اللاّحقة، وتعد مؤشرًا قويًّا على نجاحهم أو فشلهم في إتقان مهارات القراءة والكتابة في المراحل العمرية. ويستمد البحث الحالي أهميته من محاولته إضافة لبنة جديدة إلى ما قدّمه الآخرون، وهي توجيه اهتمام المعلّمين والمشرفين التربويين أيضًا إلى الإجراءات المنظمة في عمليّة تشخيص الأخطاء في القراءة الجهريّة وفاق قائمة تحليل الأخطاء القرائيّة، واتخاذ القرارات المناسبة عند وضع برامج علاجيّة لتلك الأخطاء، واختيار أفضل الطّرائق والأساليب التي تساعد في تنمية مهارة القراءة الجهريّة عند المتعلّمين.
مشكلة البحث وأسئلته: نشير في هذا السِّياق إلى أنّ “القراءة هي المدخل الإلزامي للثقافة، فالأميّ هو من لا يتمكّن من الإفادة من نتاج الحضارة بسبب جهله للقراءة والكتابة كوسيلتين للمشاركة في استهلاك ما تبدعه العقول وما تدوّنه الأقلام”([4]). و”على الرغم من أنّ القراءة الجهريّة لها أهدافها، ووظائفها على امتداد الصفوف الدّراسيّة من المرحلة الابتدائيّة، إلّا أنّ الكثير من المعلّمين يواجهون صعوبات في تدريسها”([5]). لذلك يواجه التّلاميذ أزمة في القراءة، إذ يعانون صعوبات قرائيّة متعدّدة الأنواع، ويمكن أن ترجع هذه الأزمة إلى عوامل شتى بصريّة وعصبيّة وسمعيّة ونطقيّة وعقليّة وعاطفيّة واجتماعيّة وثقافيّة.
وتحدّدت مشكلة البحث في الإجابة عن الأسئلة الآتية:
- ما هي المشكلات القرائيّة التي تواجه متعلمي المرحلة الأساسية العليا؟
- ما هي الأسباب الكامنة وراء الأخطاء القرائيّة عند المتعلّمين؟
- ما هي المقترحات العلاجيّة المناسبة لمشكلات القراءة عند المتعلّمين؟
مصطلحات البحث
القراءة: تُعرّف القراءة في الاصطلاح التّربوي المعاصر، “أنّها عمليّة عقليّة تفاعليّة تشمل تفسير الرّموز المكتوبة، وتوظيفها في مواقف الحياة”([6]).
القراءة الجهريّة: تعرّف القراءة الجهريّة أنّها “قدرة الطالب على ترجمة رموز الكتابة إلى أصوات ينطقها، وقدرته على استيعاب وفهم ما يقرأ. فالقراءة الجهريّة تقوم على أربعة عناصر، هي: رؤية العين للمادّة المقروءة، والإدراك الذِّهني للصّورة المقروءة، ونطق المادة المقروءة، وإدراك معنى المقروء وفهمه”([7]).
الانسيابيّة في القراءة: “هي القدرة على القراءة الجهريّة الصّحيحة والسّريعة والتّعبيريّة. وتتحدد السّرعة المطلوبة في القراءة الجهريّة بمئة وخمسين كلمة في الدّقيقة الواحدة لكلّ من أتقن القراءة أو التعلم في كل ثانية من الزّمن”([8]).
أهداف البحث: يسعى هذا البحث إلى تحقيق الأهداف الآتية:
التعرّف إلى المهارات الأساسية في القراءة./ استخدام استراتيجيات قرائيّة متعددة ومتنوعة./ توجيه اهتمام المعلّمين والمشرفين التربويين أيضًا إلى الإجراءات المنظمة في عمليّة التعليم.
أهمّية البحث: يحاول هذا البحث إضافة لبنة جديدة إلى ما قدّمه الآخرون في توجيه اهتمام القائمين على تأليف مناهج اللّغة العربية ومعلّميها، في معالجة المشكلة القرائيّة إذ يعمل على دعم المهارات الأساسيّة للقراءة الجهريّة، وتوجيه اهتمام المعلّمين والتربويين أيضًا إلى الإجراءات المنظمة في عملية تشخيص الأخطاء في القراءة الجهريّة وفق قائمة تحليل الأخطاء القرائيّة، واتخاذ القرارات المناسبة في وضع برامج علاجيّة لتلك الأخطاء.
منهج البحث
– اعتمدت هذه الدّراسة على المنهج الوصفي التّحليلي، من خلال وصف الأخطاء الجهريّة عند المتعلّمين وتحديدها وتحليلها، واتخاذ القرارات المناسبة في وضع برامج علاجيّة.
– صُمِّمَ اختبار قراءة جهريّة من نص أدبي مع بطاقة ملاحظة، فشملت العيّنة أربعين طالبًا وطالبةً من الصّف السّابع من مدرسة حكوميّة، كما أجريت مقابلات مع معلّمين مختصّين في تعليم اللّغة العربيّة.
أدوات البحث: بطاقة ملاحظة لتحديد الأخطاء (نطق صحيح لمخارج الحروف – تنغيم- وقف- إدغام…)
أولًا: مفهوم القراءة الجهريّة
القراءة الجهريّة عمليّة لغويّة صوتيّة تهدف إلى نقل المعنى من النّص إلى المستمع من خلال النطق السّليم، إذ تتطلب القراءة الجهريّة نطقًا لغويًّا يعبّر عن مادة مكتوبة بصوت مسموع، فيحصل هذا النطق بسرعة ودقّة من دون حذف أو إبدال أو إضافة أو تكرار لحرف أو لكلمة أو لجملة، فتخرج الحروف من مخارجها، ونطق الحركات القصار والطوال بطولها المناسب، والتّعبير عن علامات التّرقيم، والالتزام بالضبط الصّرفي والنّحوي في نطق المفردات والجمل. فالقراءة الجهريّة: “هي التعرّف إلى الرّموز المطبوعة، وفهمها ونطقها بصوت مسموع مع الدّقة، والطلاقة وتجسيد المعاني”([9]).
تعدّ القراءة من العمليّات العقليّة والنفسيّة واللّغويّة المهمّة التي يمارسها الإنسان، إذ إنّها تتجاوز كونها عمليّة نطق رموز إلى كونها نشاطًا تفاعليًّا بين القارئ والنّص، فالقراءة هي فعل إدراكي يتطلّب الفهم والإدراك والتّفسير والتأويل والنقد. و”تكمن القدرة على استيعاب النّص المقروء في فهم معانيه وفي إدراك أبعاده وفي السّامع أنّ القارئ يفهم ما يقرأه ويعبّر عن هذا الفهم بطريقة تسهّل على السّامع فهم النّص المسموع. فالقارئ هو في الوقت عينه سامع وهو يقرأ لنفسه ولغيره وعليه أن يفهم ما يقرأه وأن يُفهِمه للآخرين وهذا هو الهدف الأوّل للقراءة الجهريّة“([10]). أمّا الهدف الثّاني فيتمثّل بقدرته على ربط معاني النّص بما يعرفه حوله، وتجنيد ذاكرته في استحضار المعاني الكامنة في ذهن القارئ والمتعلّقة بموضوع القراءة.
ثانيًا: مهارات القراءة الجهريّة الأساسيّة
تحتاج السّرعة في القراءة إلى تدريب مستمرّ، لأنّها تتطلّب من الطّالب أن تقع عينه في كلّ حركة لها على أكبر عدد من الكلمات، فكلما زاد عدد الكلمات التي تتعرف إليها العين في كلّ حركة زادت السّرعة في القراءة، في حين أنّ الوقت الذي يستغرقه الطالب في إعادة بناء الكلمة في ذهنه، ثمّ الانتقال إلى الكلمة التي تليها من دون أن يترك مدّة زمنيّة واضحة بينهما مع مراعاة المهارات القرائيّة الأخرى هي مهارة ينبغي للطلاب إجادتها والعمل على تطويرها وتحسينها. ومن المهارات الأساسيّة للقراءة الجهريّة ما يأتي:
1- مهارة تطبيق قواعد اللّغة العربيّة: عدم الوقوع في الخطأ اللّغوي وذلك عن طريق التطبيق الآلي السّريع لكل قواعد اللّغويّة التي تعلّمها في دروس القواعد ومارسها في القراءة.
2- المهارة الأدائيّة: وتظهر في التّنغيم السّليم للجمل ومكوّناتها، وعلى التّطبيق الصّحيح لقواعد النّبر للمفردة وللجملة ومكوّناتها، وعلى تطبيق قواعد الفصل والوصل والتّفخيم والتّرقيق والوقف العربي، و”تقوم المهارة الأدائيّة على التّنغيم السّليم للجمل ولمكوّناتها، وعلى التّطبيق الصّحيح لقواعد النّبر للمفردة وللجملة ولمكوّناتها، وعلى تطبيق قواعد الفصل والوصل والتّفخيم والترقيق والوقف العربي”([11]).
3- مهارة استثمار المعارف المتحصّلة حول نص القراءة: فهي تدلّ على مدى ثقافة القارئ وعلى قدرته على ربط مكتسباته بالنّص المقروء([12]).
ثالثًا: أخطاء القراءة الجهريّة: ولتحقيق أهداف الدّراسة، اعتمدت الباحثة مجموعة من الأدوات البحثيّة التي تساعد في تشخيص أخطاء القراءة الجهريّة، وقد اعتمدت الصّف الأساسي السّابع وذلك لأنّه يمثّل مرحلة مفصليّة تعلّميّة، والوقوف على أسبابها تمهيدًا لتقديم معالجة مناسبة. وقد تنوّعت أدوات البحث لتشمل:
- اختبار تشخيصي لأخطاء القراءة الجهريّة:أُعِدَّ اختبار يتكوّن من نصّين مناسبين لمستوى الصّف الأساسي السّابع، مع معايير دقيقة لتقويم الأداء القرائي، اشتملت على: الطلاقة، وضبط الحركات، وسلامة النّطق، واحترام علامات التّرقيم، والتّعبير الصّوتي والتّنغيم، ثمّ طُلِب من كل تلميذ قراءة النّصوص المعيّنة بشكل فردي قراءة جهريّة أمام الباحثة وسُجِّل الأداء صوتيّا لمراجعته وتحليله لاحقًا.
- تطبيق الأدوات وضبط صدقها وثباتها:أعدّت الباحثة بطاقة تتضمّن مؤشّرات لأبرز الأخطاء القرائيّة الشّائعة، لتوثيق نوع الخطأ وتكراره إذ رافقت كلّ قراءة بطاقة مستقلّة تُملأُ لحظة الأداء، ثم جُمِعت النتائج لتحليل نمط الأخطاء وتكرارها، وقد أُجري الاختبار على عيّنة البحث المكوّنة من أربعين طالبًا وطالبة من الصّف السّابع من مدرستين حكوميّتين، لملاحظة أخطاء القراءة الجهريّة لتحقيق تمثيل متوازن، وجرى التّنسيق مع الإدارة المدرسيّة لتخصيص أوقات محددة لتطبيق الأدوات، مع الحرص على توفير جو هادئ بعيد من التوتر أو الضّغوط الصفّية.
- ضبط صدق وثبات الأدوات: عُرِضت أدوات الدّراسة على مجموعة من المحكّمين من أساتذة اللّغة العربية، وطرائق التدريس للتأكد من صدق المحتوى، كما طُبِّق اختبار القراءة الجهريّة مرّتين بفاصل زمني 30 يومًا لحساب معامل الثبات، ما ضمن موثوقيّة النتائج.
- بطاقة ملاحظة الأداء القرائي الجهري: صُمِّمت بطاقة الملاحظة، إذ حوت أبرز الأخطاء في القراءة الجهريّة عند المتعلّمين والتي تُعدّ من أهدافها المهمّة، وقد عُرضت على مجموعة من الزّملاء في التّعليم الثّانوي وعدِّهم لجنة من المحكّمين ضمن طرائق التدريس.
البطاقة الأولى:
الصف: الأساسي السابع التاريخ: 13/2/2025 اسم الباحث:
مدة الملاحظة: 55 دقيقة عدد الطلاب: 40 طالبًا وطالبة.
عنوان النّص المقروء: وادي الدّلب_ من محور أدب الرّحلة.
الجدول الأوّل: فيه تقييم للأهداف الآتية: الطلاقة، النّطق الصحيح، التّعبير الصّوتي والتّنغيم، الضبط الإعرابي.
جدول رقم(1): تقييم الأهداف، المجموعة الأولى شعبة أ
| اسم التلميذ شعبة أ
|
الطلاقة
|
النطق الصحيح | التعبير الصّوتي
|
التنغيم
|
الضبط الاعرابي | المجموع
|
النسبة المئوية |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | ||
| 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | 36 |
| 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 60 |
| 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 | 28 |
| 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 40 |
| 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | 36 |
| 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 40 |
| 7 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 11 | 44 |
| 8 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 7 | 28 |
| 9 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | 32 |
| 10 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | 36 |
| 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 40 |
| 12 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 32 |
| 13 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | 32 |
| 14 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 12 | 48 |
| 15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 60 |
| 16 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 7 | 28 |
| 17 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 | 36 |
| 18 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9 | 36 |
| 19 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 7 | 28 |
| 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 40 |
البيانات الأساسيّة لجدول رقم (1):
عدد التلاميذ 20. المعدّل الحسابي: 9.5/25.
المجموع الكلّي للعلامات 190. النسبة المئويّة العامّة: 38%.
جدول رقم(2): تقييم الأهداف، المجموعة الأولى شعبة ب
| اسم التلميذ شعبة ب | الطلاقة
|
النطق الصحيح
|
التعبير الصّوتي
|
التنغيم
|
الضبط الاعرابي | المجموع
|
النسبة المئويّة |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | ||
| 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 40 |
| 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 11 | 44 |
| 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | 36 |
| 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 40 |
| 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 40 |
| 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 11 | 44 |
| 7 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 16 | 64 |
| 8 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 9 | 36 |
| 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 40 |
| 10 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 11 | 44 |
| 11 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 12 | 48 |
| 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 40 |
| 13 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 11 | 44 |
| 14 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 13 | 52 |
| 15 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 14 | 56 |
| 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | 36 |
| 17 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 10 | 40 |
| 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 40 |
| 19 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 11 | 44 |
| 20 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 12 | 48 |
البيانات الأساسيّة لجدول رقم (2):
عدد التلاميذ 20. المعدّل الحسابي:10.5/25.
المجموع الكلّي للعلامات 210. النسبة المئويّة العامّة: 42%.
تحليل بيانات علامات الشّعبتين في ملاحظة القراءة الجهريّة ودراستها:
احتُسب المعدّل الحسابي لمجموع درجات الطلاب في الشّعبتين معًا وبلغ 10 نقاط، ما يعكس متوسط أداء المتعلّمين في الاختبار، إذ بلغت النّسبة المئويّة 40% والتي تعبّر عن مستوى منخفض نسبيًّا في الأداء القرائي الجهري. وانخفاض المعدّل والنّسبة يدل على أنّ غالبيّة الطلاب يواجهون صعوبات في القراءة الجهريّة، كما كان من الواضح وجود فروق فرديّة بين الطلاب، بعضهم قد يكون قريبًا من المستوى المطلوب، في ما يعاني آخرون من مشكلات أكبر، وهو ما يقتضي استخدام استراتيجيّات تعليميّة فرديّة لمعالجة هذه الفروقات.
تكرار القياس: كُرر القياس مرّتين بفارق زمني مدّته 30 يومًا، وقد لوحظ تباين بسيط في العلامات بين التّطبيقين، ما يدل على تغيّر طفيف في الأداء فكانت الفروق غير كبيرة، ما يعزز وجود ثبات نسبي في الأداة.
البطاقة الثانية:
الصف: الأساسي السابع التاريخ: 13/3/2025 اسم الباحث:
مدة الملاحظة: 55 دقيقة عدد الطلاب: 40 طالبا وطالبة.
عنوان النّص المقروء: ذكريات لا تنسى_ محور السيرة الذاتيّة.
الجدول الثّاني: فيه تكرار تقييم للأهداف الآتية: الطلاقة، النطق الصحيح، التعبير الصّوتي والتّنغيم، الضبط الإعرابي.
جدول رقم (3): تقييم الأهداف، المجموعة الأولى شعبة أ
| اسم التلميذ | الطلاقة
|
النطق الصحيح | التعبير الصّوتي
|
التنغيم
|
الضبط الاعرابي | المجموع
|
النسبية المئوية |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | ||
| 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 32 |
| 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 14 | 56 |
| 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | 32 |
| 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 11 | 44 |
| 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | 36 |
| 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 12 | 48 |
| 7 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 10 | 40 |
| 8 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 | 32 |
| 9 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | 32 |
| 10 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 28 |
| 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 11 | 44 |
| 12 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | 36 |
| 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | 36 |
| 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 11 | 44 |
| 15 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 13 | 52 |
| 16 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | 32 |
| 17 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 10 | 40 |
| 18 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9 | 36 |
| 19 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 32 |
| 20 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 9 | 36 |
البيانات الأساسيّة لجدول رقم (3):
عدد التلاميذ 20. المعدّل الحسابي:9.5 /25.
المجموع الكلّي للعلامات190. النسبة المئويّة العامّة: 38%.
جدول رقم (4): تقييم الأهداف، المجموعة الثّانية شعبة ب
| اسم التلميذ | الطلاقة
|
النّطق الصحيح | التعبير الصّوتي | التنغيم
|
الضبط الاعرابي
|
المجموع
|
النسبة المئوية |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | ||
| 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 11 | 44 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 40 |
| 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | 32 |
| 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 11 | 44 |
| 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | 36 |
| 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 40 |
| 7 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 15 | 60 |
| 8 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 10 | 40 |
| 9 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 11 | 44 |
| 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 40 |
| 11 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 11 | 44 |
| 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | 36 |
| 13 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 11 | 44 |
| 14 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 12 | 48 |
| 15 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 13 | 52 |
| 16 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | 32 |
| 17 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 36 |
| 18 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 | 36 |
| 19 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 40 |
| 20 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 11 | 44 |
البيانات الأساسيّة لجدول رقم (3):
عدد التلاميذ 20. المعدّل الحسابي: 10.85/25.
المجموع الكلّي للعلامات217. النسبة المئويّة العامّة: 43%.
تحليل ودراسة بيانات علامات الشّعبتين في ملاحظة القراءة الجهريّة بفارق زمني 30 يومًا
احتُسِب المعدّل الحسابي لمجموع درجات الطلاب في الشّعبتين معًا وبلغ 10.13 نقاط، ما يعكس متوسط أداء المتعلّمين في الاختبار، إذ بلغت النسبة المئويّة 40.3%، ويشير تقارب النتائج مع نتائج التّطبيق الأوّل إلى وجود ثبات زمني مقبول في أداء الأداة، إذ لم تتغيّر النتائج بشكل عشوائي، بل حافظت على الاتجاهات نفسها. وتُظهر نتائج التّطبيق الثاني أنّ أداة الملاحظة تتمتع بدرجة جيّدة من الثبات، ما يتيح اعتمادها كأداة موثوقة في تقويم الأداء القرائي الجهري وتفسير الفروق بين المتعلّمين بدقّة. وقد أظهرت الاختبارات الإحصائيّة أنّه لا توجد فروق دالة إحصائيّة عند معدل0,05 >a بين الملاحظتين التي حصلت بفارق زمني 30 يومًا. ويتبيّن من خلال جمع النتائج عامّة بفارق شهر واحد بينهما أنّ النّسبة العامّة المئويّة لأداء تلاميذ الصّفين في القراءة الجهريّة بلغت 40.2% من المجموع، وهي نسبة متدنّية تعكس وجود قصور ملحوظ في المهارات القرائيّة الأساسيّة لديهم، ويشير هذا الضّعف واضح في الطلاقة والدّقة والفهم التّعبيري، ما يستدعي تدخّلًا تربويًّا، وتؤكّد النتائج الحاجة إلى اعتماد برنامج علاجي فعّال، مع التركيز على التكرار والمتابعة و الأثر، وتدلّ هذه النتائج على أنّ الأخطاء القرائيّة ليست فردية، بل ظاهرة عامّة ضمن العيّنة، ما يفرض تطوير آليّات التقويم المستمر والدعم التربوي.
رابعًا: نتائج الدّراسة ومناقشتها
بلغ معامل كرونباخ الفا لبطاقة الملاحظة (0,87)، وهي قيمة تدلّ على مستوى ثبات جيد جدًا، ما يشير إلى أنّ أداة الدّراسة تتسم بالاتساق الدّاخلي والموثوقيّة العالية، ويمكن الاعتماد على نتائجها في تحليل أخطاء القراءة الجهريّة عند تلاميذ المرحلة الأساسية. ومن خلال تحليل بيانات جدول الأخطاء كمّيًّا ونوعيًّا، لكشف مشكلات القراءة الجهريّة، وأسبابها، والمقترحات العلاجيّة المناسبة.
أولًا: الإجابة عن السؤال الأول ما هي المشكلات القرائيّة التي تواجه متعلّمي المرحلة الأساسيّة العليا؟
من خلال تحليل بطاقتي الملاحظة المطبّقتين بفارق زمني قدره 30 يومًا، تبيّن أنّ نسبة كبيرة من المتعلمين لم يتمكّنوا من تحقيق الأهداف الأساسيّة للقراءة الجهريّة، السّابقة الذكر، وأنّ أكثر أخطاء القراءة الجهريّة شيوعًا بين المتعلّمين كانت:
ضعف في ضبط الحركات والتّشكيل: عدم التمييز بين الفتح والضم والكسر، إضافة إلى إهمال علامات الإعراب.
التّوقف الخاطئ وسط الجمل: القراءة من دون فهم، وسوء استخدام الوقف والابتداء.
عدم استخدام التنغيم المناسب: ورتابة الصوت وغياب الإنفعال، فلا يميّز بين حوار أو مشاعر. عدم الالتزام بعلامات الترقيم.
قراءة مترددة وتفتقر للطلاقة: التوقف المتكرّر والتلعثم، القراءة المتقطّعة أو البطيئة.
وقد ظهر ذلك جليّا في انخفاض معدلات القراءة الجهريّة عند أفراد العيّنة، إذ لم يتجاوز الأداء العام أكثر من 30%.
ثانيًا: الإجابة عن السؤال الثاني ما هي الأسباب الكامنة وراء الأخطاء القرائيّة عند المتعلمين؟
يتوقف إتقان اللّغة العربية واكتساب مهاراتها على القراءة الكثيرة المتنوعة، ولكن يلحـظ عجز الطالب عن الانطلاق فيها وعزوفهم عنها، وعجزهم عن المواقف التي ينتهي عندها المعنى، وعــدم قــدرتهم علــى تلخــيص مــا يقـرأون، وتمثــل المعنــى فـي أثنــاء القــراءة، وهناك عوامل ثلاثة تؤدي إلى ظهور هذا الضعف وهي: المعلّم والمتعلم والمادة التّعليميّة، وهي التي تترك بصماتها على بعض المتعلّمين والمتمثّلة في الإحباط والعجز الذين قد يستسلمون لهما في النهاية.
- أسباب تعود إلى المعلّم: ومن أشكال الممارسات الخاطئة للمعلّمين([13]):
- عدم تدريب المعلّم للطالب في الصّف الأوّل تدريبًا كاملًا على تجريد الحروف وقلّة اهتمامه بذلك.
- قلّة اهتمام المعلّم بتدريب الطالب في الصّف الأول على التّحليل والتركيب، وعدم قدرته على تشخيص العيوب القرائيّة وصعوبتها.
- تجاهل المعلّم تصويب أخطاء الطالب القرائيّة في أثناء التدريس، وعدم رصده لها.
- عدم تنويع المعلّم الأنشطة والطرائق أثناء القراءة، فيعتمد على أسلوب نمطي متكرر.
- قلّة اهتمامه بتزويد تلاميذه بالمادة القرائيّة الإضافية الإثرائيّة التي تزيد قاموسهم اللّغـوي وتجذبهم للقراءة.
- ندرة وقوفه على مدى الاستعداد القرائي والمحصول اللّغوي للتلاميذ في الصف الأول.
- قلّة اهتمامه بمعرفة مستوى التلاميذ اللّغوي وبقياس قدراتهم في بداية السنة الدّراسيّة.
- ندرة التزام المعلّمين التّحدث باللّغة العربية الصّحيحة في تدريسهم.
- أسباب تعود إلى التلميذ نفسه([14]): من الحقائق عدم إجادة الطلاب للقراءة وانصرافهم عن حصصها وإهمالهـم لهـا، ومـن المفروض منه أن تكون هناك أسباب لهذه الظاهرة منها:
- الحالة الصحية الجيدة: إذ تساعد على ارتفاع مستوى الحيويـّة والفاعليـّة فـي النّـشاط التّعليمي والقرائي، فالتّأخر في النطق أو ضعف البصر أو ضعف السمع، يؤدي إلى بطء التّلميذ في القراءة فتقلّ حصيلته اللّغوية وتقل إجادته للقراءة.
- القدرة العقليّة (الاستعداد العقلي): إن نسبة الذكاء العام والقدرة على تذكر صور الكلمـات تؤثر على التعلّم.
- الحالة الاجتماعيّة والاقتصاديّة: إذ إنّ فقدان أحد الأبوين، أو السكن غير المناسـب، أو مادية المترديّة أو الأمّية عند الأب أو الأم تؤثر كثيرًا في اهتمام التلاميذ بالقراءة، وقد يكون سوء الحالة الاجتماعيّة والاقتصاديّة حافزًا لبعض التّلاميذ لتحدي مثل هذه الظرف والتغلّب عليهـا.
- ضعف الدّافعيّة والرّغبة في القراءة بخاصّة وفي العلم بعامّة، واهتزاز القناعة بهما.
- ضعف معجم الطالب اللّغوي وضحالة خبراته.
3- أسباب تعود إلى الكتاب، هذه الأسباب والمهم([15]): قد توضع بعض الكتب وتقرر من دون أن تجرّب على عيّنات من التّلاميذ، وقد يـضعها مؤلفـون بعيدون من البيئة المدرسيّة، فلا يرون ما يراه من يتعامل مع التّلاميذ.
- إنّ الكتب التي توضع للقراءة تثبت عند حدّ لا يتجاوز في موادهـا، مـع حاجـاتهم للتطـوّر باستمرار.
- خلو بعض الكتب من الموضوعات التي يميل إليها التّلميذ والتي تثير فيـه الرّغبـة والـشّوق للقراءة.
- قد تكون بعض الموضوعات في كتب القراءة فوق طاقة التّلميذ العقليـّة، وهـي لا تتناسـب وقدراته العقليّة.
– الجانب الشكلي المادي للكتاب في الخط والصور والأناقة والإخراج.
– التأليف من حيث إسناده إلى غير المتخصّصين، وقليلي الخبرة في هذا الميدان.
– قلة إجراء التعديلات أو التطور على الكتاب برغم الملاحظات الكثيرة التي يبديها المعلّمون.
– بعض موضوعات الكتب غير شائقة، والمثيرة لرغبة التلاميذ، ولا تلبّي حاجاتهم ولا تناسـب مستواهم وفوق طاقاتهم.
4- أسباب تعود إلى ما يتعلق بطبيعة اللّغة العربية، ومن هذه الأسباب المهمّة:
إنّ اللّغة العربيّة تُعدُّ من اللّغات الصّعبة في طريقة كتابتها، ورسم حروفهـا وفـي علومهـا، ومزاحمة اللّغة العاميّة للغة الفصيحة في البيت والشّارع والمؤسسات، وتأثير اللّغـات الأجنبيـة سلبًا في الطالب.
ثالثًا: الإجابة عن السّؤال الثالث ما هي المقترحات العلاجيّة المناسبة لمشكلات القراءة عند المتعلّمين؟
بعد دراسة بطاقة الملاحظة، خلص البحث إلى حاجة لتدخّل تربويٍّ شاملٍ، لحلّ المشكلات القرائيّة الجهريّة، يقوم على خطط تراعي حاجات المتعلّمين وظروفهم، وقد خلصت الباحثة إلى مجموعة من المقترحات العلاجية أبرزها:
1- تفعيل المهارات الأساسيّة في القراءة من خلال
– إجراء تقييم تشخيصي شامل لمهارات القراءة.
– تصميم وحدات دعم تعليمي تركّز على تمكين المتعلّمين من التهجئة، وضبط الحركات، والتّمييز بين الأصوات المتقاربة (كالذّال والزاي، أو التّاء والطاء).
– تدريب على القراءة المتكرّرة والمسموعة لتحسين الطلاقة والنّغمة الصوتيّة.
2- التّنويع في استراتيجيات التّدريس
– توظيف استراتيجيات تعلّم نشط (مثل القراءة التّشاركيّة، والتّمثيل القرائي، والتّعلّم القائم على المشروع) و دمج الوسائل السّمعيّة والبصريّة في دروس القراءة لرفع مستوى الانتباه والدّافعيّة.
– استخدام أنشطة لغويّة تحاكي الواقع وتربط القراءة بالحياة اليوميّة.
3- تمكين المعلّمين
– تدريب المعلّمين دوريًّا حول طرائق علاج صعوبات القراءة الجهريّة.
– توفير دليل للمعلّمين يحتوي على نماذج قرائيّة، وتغذية راجعة فعّالة.
– التّعاون مع الاختصاصيّين التربويّين لمساعدة بعض المتعلّمين ذوي الصعوبات الحادّة من خلال وضع خطط فرديّة.
4- الدّعم النّفسي والتّحفيز
– خلق صفّ آمن خالٍ من السّخرية أثناء القراءة.
– تشجيع المتعلّمين على المحاولة من خلال تقديم التّغذية الرّاجعة الإيجابيّة.
– تقديم بطاقات تشجيعيّة و شهادات تقدير للمتعلمين على تقدّمهم في القراءة.
5- تفعيل دور الأسرة
– توجيه للأهل حول أهميّة القراءة في المنزل.
– تبليغ الأهل عن تقدّم أولادهم، واقتراحات عمليّة للدّعم المنزلي.
– توجيه الأهل على القراءة اليوميّة المنزليّة المشتركة بينهم وبين الطفل.
6- إغناء البيئة القرائيّة المدرسيّة
– إنشاء مكتبة صفّية داخل كل صفّ.
– تفعيل الأنشطة القرائيّة تحت عناوين مشجّعة.
– تقديم نصوص قرائيّة ممتعة تناسب اهتمامات المتعلّمين وعصرهم.
خاتمة البحث: إنّ علاج مشكلات القراءة يتطلّب تضافر الجهود بين المعلّم، والمتعلّم، والإدارة، والأسرة. وهذه المقترحات لا تشكّل وصفة جاهزة، بل هي مداخل قابلة للتكيّف بحسب السّياقات الصفّية المختلفة، ولن يكون للمتعلم أن يتقدّم في تعلّمه إلّا إذا مرّ من هذا الطريق الضيّق الذي يفتح له باب التّعلّم، والتقدّم المستمر فيه إذا أحسن تقوية مهاراته القرائيّة بالمطالعة المستمرّة التي تصبح من العادات اليوميّة المحمودة عند المتعلّمين والتي لا مفرّ من الاقبال عليها إذا أردنا مجتمعنا أن يكون بين المجتمعات المتقدّمة في هذا الزّمن المتسارع تقنيّا وعلميّا وحضاريّا.
المصادر والمراجع
- زايد فهد، خليل، أساليب تدريس اللّغة العربية بين المهارة والصعوبة، الأردن، ط1، (2006)، ص 54-55.
- شحاتة، حسن، تعليم اللّغة العربية بين النظرية والتطبيق. مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، (1989)، ص17.
- الصيّاح، أنطوان، تعلّميّة اللّغة العربية، دار النهضة العربية، بيروت، (2008)، ص 63.
- الصيّاح، أنطوان تقويم تعلّم اللّغة العربيّة، دار النهضة العربيّة، بيروت، (2009)، ص10.
- الصياح، أنطوان تعلمية اللّغة العربية في المرحلة الابتدائية، دار النهضة العربية، بيروت، ط1، (2014) ص49- ص77.
- عاشور راتب قاسم، والحوامدة محمد فؤاد، أساليب تدريس اللّغة العربية بين النظرية والتطبيق، عمان، دار المسيرة للنشر والتوزيع، ط2 (2007) ص 105.
- عاشور، راتب، والحوامدة، محمد فنون اللّغة العربية وأساليب تدريسها بين النظرية والتطبيق، دار عالم الكتب الحديث، اربد، (2009) ص 30.
- العبيدي، علي، أسباب تدني مستوى القراءة والكتابة في المدارس الابتدائية من وجهة نظر المشرفين والمشرفات التربويين في محافظة بغداد في العراق. مجلة البحوث التربوية والنفسية، عدد 32، (2012) ص 107-144.
- مدكور، علي احمد، مناهج التربية: أسسها وتطبيقاتها. دار الفكر العربي، القاهرة، (2008) ص141.
- المعتوق، أحمد محمد، الحصيلة اللّغوية: أهمّيتها، مصادرها وسائل تنميتها، عالم المعرفة، العدد 212، المجلس الوطني للثقافة والفنون والادب الكويت، (1996) ص 121.
- الملا، بدرية سعيد علاج التأخر في القراءة الجهريّة في المرحلة الابتدائية، رسالة دكتوراه، (غير منشورة)، جامعة عين شمس مصر (1985) ص25.
[1] – طالبة دكتوراه في الجامعة الإسلاميّة- بيروت- لبنان – قسم اللّغة العربيّة .
PhD student at the Islamic University, Department of Arabic Language.Email: haninhajali1980@gmail.com
[2] – أحمد محمد المعتوق، الحصيلة اللّغويّة: أهمّيتها، مصادرها وسائل تنميتها، عالم المعرفة، العدد 212، المجلس الوطني للثقافة والفنون والادب الكويت، (1996) ص 121.
[3] – أنطوان صيّاح، تعلمية اللّغة العربية في المرحلة الابتدائية. دار النهضة، بيروت، (2014). ص 49.
[4] – أنطوان صيّاح، تعلّميّة اللّغة العربية، دار النهضة العربية، بيروت، (2008)، ص 63.
[5] – بدرية سعيد الملا، علاج التأخر في القراءة الجهرية في المرحلة الابتدائية، رسالة دكتوراه، (غير منشورة)، مصر، جامعة عين شمس1985 ص25.
[6] – حسن شحاتة، تعليم اللّغة العربية بين النظرية والتطبيق. مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، (1989)، ص17.
[7] – راتب عاشور، ومحمد الحوامدة فنون اللّغة العربية وأساليب تدريسها بين النظرية والتطبيق، دار عالم الكتب الحديث، اربد، (2009) ص 30.
[8] – أنطوان الصياح تعلمية اللّغة العربية في المرحلة الابتدائية، بيروت، دار النهضة العربية، ط1، (2014) ص 77.
[9] -علي احمد مدكور، مناهج التربية: أسسها وتطبيقاتها. دار الفكر العربي، القاهرة، (2008) ص141.
[10]– أنطوان صيّاح، تقويم تعلّم اللّغة العربيّة، دار النهضة العربيّة، بيروت، 2009، ص 58.
[11] _ صيّاح المرجع نفسه ص 59.
[12]– صيّاح، المرجع نفسه، ص 59.
[13] – زايد، فهد خليل أساليب تدريس اللّغة العربية بين المهارة والصعوبة، الأردن، ط1، (2006)، ص 54-55.
[14] – العبيدي، علي، أسباب تدني مستوى القراءة والكتابة في المدارس الابتدائية من وجهة نظر المشرفين والمشرفات التربويين في محافظة بغداد في العراق. مجلة البحوث التربوية والنفسية، عدد 32، (2012) ص 107-144
[15] – راتب قاسم عاشور، ومحمد فؤاد الحوامدة، أساليب تدريس اللّغة العربية بين النظرية والتطبيق، عمان، دار المسيرة للنشر والتوزيع، ط2 (2007) ص 105.