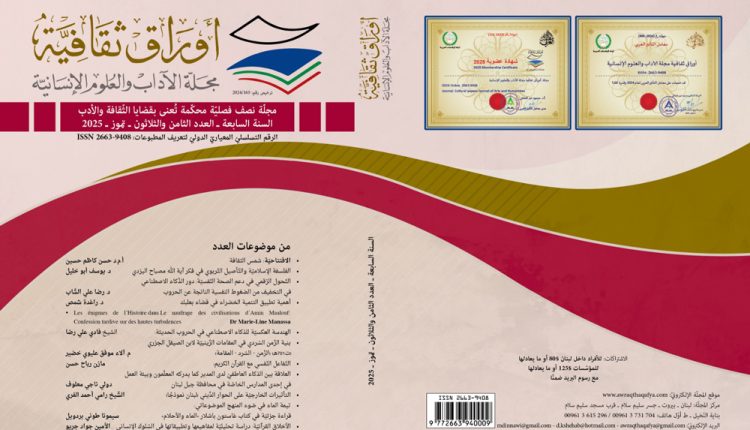عنوان البحث: تيمة الماء في ضوء المنهج الموضوعاتي: قراءة جزئيّة في كتاب غاستون باشلار "الماء والأحلام"
اسم الكاتب: سيمونا طوني بردويل
تاريخ النشر: 2025/07/16
اسم المجلة: مجلة أوراق ثقافية
عدد المجلة: 38
تحميل البحث بصيغة PDFADOI: https://aif-doi.org/awraq/013809
تيمة الماء في ضوء المنهج الموضوعاتي: قراءة جزئيّة في كتاب غاستون باشلار “الماء والأحلام”
Le thème de l’eau à la lumière de la méthode thématique: une lecture partielle de «L’eau et les Rêves» de Gaston Bachelard.
سيمونا طوني بردويل([1])Simona Tony Bardawil
تاريخ الإرسال:24-5- 2025 تاريخ القبول:4-7-2025
الملخص
يُعدّ المنهج الموضوعاتي أحد المناهج النقديّة المعاصرة التي تتبع التّيمات الكبرى والصغرى في العمل الأدبي. وإنّ لهذا المنهج أصول تعود إلى الفلسفة الظاهراتيّةphenomenologie التي تأسست على يد الفيلسوف الألماني أدموند هوسرل Edmund Husser. وقد تغذى المنهج الموضوعاتي من أفكار غاستون باشلار Gaston Bachelard الذي يُعدّ المصدر النظري الأبرز لمفهوم النقد الموضوعاتي ومصطلحاته، وقد انطلق هذا المنهج من تحليلاته للصورة الشّعريّة والخيال، وتطور في سياق بيئة نقديّة فرنسيّة منذ ستينيات القرن العشرين.
وتهدف هذه الدّراسة إلى قراءة موضوعاتيّة لتيمة الماء بصفتها هاجسًا مهيمنًا في كتاب غاستون باشلار في “الماء والأحلام”. ويسعى هذا البحث القصير إلى إبراز وبشكل موجز كيفيّة اشتغال هذا المنهج على تحليل الصور المتكررة للماء في الخيال الشعري والإنساني. إضافةً إلى تبيان ما تحمله من معانٍ رمزية ونفسية عميقة، وذلك من خلال مقاربة موجزة لأبرز مظاهر حضور هذه التيمة في نصوص الكاتب.
الكلمات المفتاحيّة: المنهج الموضوعاتي _ تيمة _ النقد الموضوعاتي _ الصورة الشّعرية.
Résumé
La critique thématique est l’une des approches critiques contemporaines qui s’intéresse à l’étude des thèmes majeurs et mineurs dans une œuvre littéraire. Cette méthode trouve ses origines dans la phénoménologie, une école philosophique fondée par le philosophe Allemand Edmund Husserl. La critique thématique s’est également nourrie des idées de Gaston Bachelard, considéré comme la principale référence théorique de ce courant critique et de ses concepts fondamentaux. Cette approche s’est développée à partir des analyses de Bachelard sur l’image poétique et l’imaginaire, dans le contexte critique français des années 1960.
Cette étude vise à proposer une lecture thématique de la thématique de l’eau, en mettant en lumière la manière dont la méthode thématique permet de révéler les significations symboliques associées à l’eau, telles qu’explorées par Gaston Bachelard dans son ouvrage L’eau et les rêves. Cette brève recherche cherche à montrer de façon succincte comment cette méthode fonctionne dans l’analyse des images récurrentes de l’eau dans l’imaginaire poétique et humain, tout en soulignant les significations symboliques et psychologiques profondes qu’elles véhiculent, à travers une approche synthétique des principales manifestations de ce thème dans les textes de l’auteur.
Les mots-clés: la méthode thématique – thème – la critique thématique – l’image poétique.
مقدّمة
يشكل النّقد الموضوعاتي في معجم المصطلحات الأدبيّة جزءًا من النّقد الجديد في فرنسا. وتعمل هذه الورقة البحثيّة على إبراز أثر المنهج الموضوعاتي في كشف العالم الخيالي ودلالاته العميقة في النّص الأدبي، مع التّركيز على تيمة الماء كما حلّلها غاستون باشلار في كتابه الماء والأحلام. وتأتي هذه الدّراسة في سياق المحاولات الأكاديمية الجادة لإعادة الاعتبار لهذا المنهج الذي كثيرًا ما عرف عزوفًا في النّقد العربي المعاصر على الرّغم من أهمّيته في قراءة التّيمات في النّصوص. وكما تهدف هذه الدّراسة إلى إظهار أهمّيّة النّقد الموضوعاتي والحديث عن إجراءاته وآلياته الإجرائيّة في تحليل الصور والرموز ودلالاتها النّفسيّة والخياليّة، وبخاصة لدى غاستون باشلار في اجتزاءات من كتابه “الماء والأحلام”.
- مفهوم الموضوعاتيّة
تعدّدت مفاهيم الموضوعاتيّة بسبب اختلاف وجهات نظر رواده، إذ تعود أصول هذا المنهج إلى النقد الجديد في فرنسا، إذ يعدّ النّقد الموضوعاتي فرعًا من فروعه. وهو منهج في القراءة يسعى إلى دراسة الثوابت الموضوعاتيّة، وإبراز إنسجام العالم الخيالي للنّص مع المقصديّة العميقة للكاتب، إضافةً إلى تتبع “الموتيفات”([2]) في الأعمال الأدبي. وحتى نتمكن من فهم النّقد الموضوعاتي لابدّ من التّطرق إلى الجذر الأصلي للموضوعاتيّة، وهو الموضوع من الناحية اللغويّة والاصطلاحيّة.
- المفهوم اللغوي جاء في لسان العرب لابن منظور تحت مادة (و ض ع) قوله: “وضع الوضع ضد الرّفع وضعه وضعًا وموضوعًا، وأنشد ثعلب بيتين فيهما: موضوع جودك ومرفوعه عنب بالموضوع ما أضمره ولم يتكلم به. والمرفوع: ما أظهره وتكلم به”([3]).
ما يهمّنا في هذا السّياق هو أن الموضوع، وإن لم يُصرّح به بشكل مباشر، فإنّه كامن أو مضمر، ولا يظهر إلا من خلال إبرازه والتعبير عنه. إنّ الموضوع موجود في خلفيّة القول، لكنه يحتاج إلى رفعه إلى السّطح ليغدو واضحًا ومُدركًا.
وفي هذا المعنى لا يختلف صاحب القاموس المحيط كثيرًا عن تعريف ابن منظور، إذ يورد صيغة “مفاعلة” من الجذر نفسه عندما يقول: “وضعه، يضعه وضعًا وموضوعًا: حطّه، والمواضعة: الموافقة، ومنه: أواضعك الرأي، أي أطلعتك عليه”([4]).
ويلاحظ أنّ التّعريفين السّابقين وتعريف ابن دريد القائل: “الوضع: أن تضع الشيء وضعًا، وقال قوم: وضع يوضع، وامرأة واضع إذا ألقت قناعها، وشاة واضع إذا ولدت”([5])، يشتركون كلّهم في دلالة هذا الجذر على وجود شيء ما، يحتاج إلى إظهار.
تتّفق هذه التّعريفات جميعها في دلالتها على أن “الوضع” يشير إلى وجود شيء في هيئة معينة، يتطلّب كشفه أو إبرازه، وهو ما ينسجم مع الفكرة القائلة إنّ الموضوع لا يكون حاضرًا بوضوح إلّا إذا رُفع من حالة الكمون إلى حالة الظهور.
أمّا في اللغة الأجنبيّة، فتشير بعض التّعريفات إلى تطور دلالة هذه المفردة عبر الزّمن. ففي قاموس le nouveau littré إلى أن كلمة موضوع مشتقة من الكلمة اللاتينيّة thema، والمنحدرة من الإغريقيّة بالرسم ذاته، بمعنى ما نقدمه أو نضعه Ce qu’on dépose. وأيضًا أشارت جاكلين بيكوش في قاموسها التأثيلي إلى أنّ كلمة(thème) كانت تدل، في القرن الثالث عشر، على المعاني التي تعبّر عنها كلمة (sujet)، مثل: المادة، الفكرة، المحتوى، القضية، أو المسألة، كما تُقابلها في العربية. ثم شهدت الكلمة تطورًا دلاليًا خلال القرنين الرابع عشر والخامس عشر، فأصبحت تُستخدم للدّلالة على: الامتحان المدرسي (composition scolaire)، وكذلك الترجمة (traduction) وفي وقت لاحق، دخلت الكلمة مجال علم التّنجيم منذ القرن السادس عشر، قبل أن تنتقل إلى حقلَي الموسيقى واللغة في القرن السابع عشر، إذ ظهرت أيضًا الكلمة المشتقة (thématique) – أي “الموضوعاتيّة” – في القرن نفسه([6]).
ويبدو أنّ هذه الدّلالة الشّاملة لكلمة “موضوع” – والتي تتضمّن الفكرة والقضية والمسألة، كما أُشير سابقًا – هي التي دفعت النّقاد إلى توظيفها في إطار دراساتهم النّقديّة. ومن هنا قيل:
“الموضوع هو المبدأ الذي تلتقي عنده المفاهيم جميعها التي تشكّل أسس المنهج الموضوعي، ولعل الإشارة إلى أنّ الموضوعيّة هنا لا تعني الحياد فحسب، بل تُنسب إلى الموضوع(thème) نفسه، ليست سوى توكيد على مركزية هذا المفهوم وكونه في صدارة المفاهيم الأخرى[7]“.
- المفهوم الاصطلاحي
تعدّدت مفاهيم الموضوعاتيّة تبعًا لاختلاف روادها، واختلاف الفلسفات التي استندوا إليها في بناء هذا المنهج. ويمكننا في هذا السّياق تقديم بعض المفاهيم التي تُبرز طبيعة النقد الموضوعاتي وأصوله. فقد نشأ هذا المنهج في إطار الفلسفة الظاهراتيّة la phénomenologie التي أسسها الفيلسوف الألماني إدموند هوسرل، وتغذى لاحقُا على أفكار غاستون باشلار الذي يُعد المصدر النّظري الرئيس لمفهوم ومصطلح النقد الموضوعاتي. وقد نما هذا المنهج وتطور ابتداءً من ستينيات القرن العشرين في بيئة نقديّة فرنسيّة بالأساس.
ويتجلى ارتباط المنهج الموضوعاتي بالفلسفة الظاهراتيّة في تركيزه على فكرة أنّ كل وعي هو وعي بشيء ما. فالكتابة تُعد تعبيرًا عمّا يعتمل في الفكر من آراء وهواجس نابعة من الوعي بالفكرة أو القضية أو الموضوع الذي تتوجه إليه الكاتبة.
وقد سعى رامان سلدان Raman Seldonإلى تعريف المنهج الموضوعاتي انطلاقًا من أعمال من يُطلق عليهم نقاد مدرسة جنيف، إذ أشار إلى أنّ هذه المدرسة التي ضمت في مرحلتها الأولى ميشيل ريمون وألبير بيجوين بوليه، وفي مرحلتها الثانية جان بيار ريشار، جان ستاروبنسكي، وهيليلز ميلر، قد رفضت النّزعة الشّكليّة لصالح قراءة تتوخى كشف التّجربة الدّاخليّة الكامنة في النّص والتي لا تنجلي إلّا عبر الاتحاد الوجداني بين النّاقد، واللاشعور النّصي، في محاولة للقبض على تجربة المؤلف التي يبثها النّص والوعي الخلاق للكاتب لحظة الكتابة([8]).
فنقاد مدرسة جنيف أو نقاد الوعي يعتمدون في الأساس على المدخل الوجودي الأنظولوجي، وقد قسمهم الناقد رامان سلمان إلى اتجاهين:
أولاً: اتجاه يُمثله كل من ميشيل ريمون وألبير بيجوين بوليه.
ثانيًا: واتجاه ثانٍ يمثله كل من جان بيار ريشا وجان ستاروبنسكي وهيليز ميلر.
وكذلك يبين النّاقد رامان سلدن أهمّيّة الدّور الذي يؤديه القارئ الواعي في فهم النّص الأدبي، إذ يرى أنّ الاكتفاء بتحليل النّص في استخدامه الخاص للغة، قد يُسهم في كشّف توجهات الكاتب في لحظة الكتابة أو ما بعدها، لكن ذلك لا يكفي لفهم العمق الحقيقي للنص. فبحسب سلدن، فإنّ القارئ الواعي، عبر نوع من الاتحاد الوجداني مع لاوعي النص – وليس لاوعي المبدع – يستطيع أن يكتشف “شيفرة” خاصة، وهي البنية التي تربط بين إبداعات الكاتب المختلفة وتشكل نسيجًا داخليًا متماسكًا لأعماله. من هنا برز مفهوم “الموضوعاتيّة” أو “التيميّة”، والذي يشير إلى حضور صورة أو فكرة متكررة ومتفردة تميز أعمال كاتب معين. وقد استخدم الناقد ج. ب. ويبرJean Paul Weber هذا المصطلح بشكل انطباعي ليعبّر به عن السمة الملحة أو النغمة الخاصة التي تتكرر في نتاج المؤلف([9]).
أمّا النّاقد سعيد علوش، فقد قدّم تعريفًا أكثر دقة وإجرائيّة للموضوعاتيّة، إذ عدَّها تحديدًا نقديًا يتعامل مع وحدات نصّية ذات طابع تركيبي موحّد، حتى وإن لم تتطابق في عناصرها بشكل مباشر، بشرط وجود تداخل شكلي أو دلالي بين تلك الوحدات. وبهذا يصبح التّحليل الموضوعاتي أداة فعالة للكشف عن البنية العميقة للنصوص، وعن الرؤية التي تحكم مجمل إنتاج الكاتب.
ومن ما سبق، يمكننا أن نقول إنّ المقاربة الموضوعاتيّة تُركز على استخلاص الفكرة العامّة، وتتبّع التّيمات المسيطرة في النّص. ولا يتحقّق هذا إلّا من خلال قراءة صغرى وقراءة كبرى، وهو ما ذهب إليه جميل حمداوي في توضيحه للأسس التي ينبغي عليها هذا المنهج، إذ يقول إنّ المقاربة الموضوعاتيّة ترتكز على استخلاص الفكرة العامّة أو الرّسالة المهيمنة التي ينطوي عليها النّص الأدبي، سواء تمثلت في رهان دلالي محدد أو بنية معنويّة تتكرر، وتتجلى عبر العمل. ويكون ذلك من خلال تتبع النّسق البنيوي للنص وشبكاته التّعبيريّة، سواء من خلال التّوسيع والتّمطيط أو عبر الاختصار والتّكثيف. كما تسعى هذه المقاربة إلى كشف ما يمنح النص وحدته العضوية والموضوعية، ويضمن له الاتساق والانسجام والتّنظيم الدّاخلي([10]) .ومن ثم يكمل جميل حمداوي شارحًا عن شروط تحقق المقاربة الموضوعاتيّة إذ يتحدث عن أن لا يمكن للمقاربة الموضوعاتيّة أن تكشف الفكرة المهيمنة أو التّيمة المحورية في النّص إلّا من خلال المرور بمرحلتين أساسيتين: تبدأ أولًا بقراءة دقيقة ومتأنية تُعرف بالقراءة الصّغرى، ثم تنتقل إلى القراءة الكبرى التي تستوعب أبعاد النص ككل. وتستلزم هذه العمليّة فهم الجنس الأدبي الذي ينتمي إليه النّص، والتّعرف إلى حيثياته المناصّية والمرجعيّة. وتتطلب تفكيك النّص إلى حقول معجميّة وجداول دلاليّة تُبنى على إحصاء تكرار الكلمات والعبارات والصور، بهدف كشف العناصر المتكررة التي تشكل نسيج العمل الإبداعي. ولهذا، تعتمد هذه المقاربة على رصد الكلمات المفتاحيّة، والصور الملحّة والعلامات اللغويّة البارزة والرّموز الدّالة، ثم تأويلها في ضوء بنيتها داخل النص.
ولكن هذه ليست فقط تعاريف الموضوعاتية بل هناك تعاريف عدّة، اختلفت هذه التعاريف باختلاف تصورات النقاد لهذا المنهج وزوايا الرؤية التي تستجيب لدراساتهم، ومن هنا يؤكد الناقد حميد الحميداني هذا الاختلاف بقوله:” إن هناك مشكلة أساسية قائمة في تحديد ما يقصد بالمنهج الموضوعاتي thématique؛ méthode لأنّ هناك اختلافًا كبيرًا بين نقاد الأدب ومنظريه في هذا المجال؛ فهم لا يتفقون
على تسمية واحدة خلافًا لماهو حاصل بالنسبة إلى المناهج الأخرى؛ كما أنّهم لا يتفقون أيضا على ممثلي هذا الاتجاه: وبعضهم يضم هذا المنهج إلى كل المناهج التي تعتمد التأويل
interpretation explication”[11])).
- الأسس الفلسفية للموضوعاتيّة
تُعدّ الفلسفة الظاهراتية المرجعيّة الأساسيّة للنقد الموضوعاتي، جنبًا إلى جنب مع الفلسفة الوجوديّة. وقد انطلق رواد هذا الاتجاه من الفكرة الجوهريّة القائلة بأن “الوعي هو دائمًا وعي بشيء ما”. وسيسعى هذا المقطع إلى توضيح العلاقة التي تربط بين الفلسفة الظاهراتيّة والنقد الموضوعاتي.
وتشكّل فلسفة إدموند هوسرل الخلفيّة النّظريّة التي أسّست محاولات النقديّة والتي تبنّت ما يُعرف بالطرح الظاهري للأدب. وقد ساهم أيضًا في ترسيخ هذا التوجه عدد من الفلاسفة الظاهراتيين الوجوديين، مثل مارتن هايدغر وجان بول سارتر . ويُعدّ كل من جان بيير ريشار، جان روسيه، جان ستاروبينسكي، إميل ستايغر، جورج بوليه، وغاستون باشلار من أبرز من تأثروا بهذا المنحى الفكري، بالإضافة إلى رولان بارت في مرحلته الأولى، إلى جانب أسماء أخرى كـ جان بول سارتر ورومان إنغاردن.
وما يجمع بين هؤلاء المفكرين في المرجعيّة الفلسفيّة، هو الإيمان بمركزيّة الوعي، وإن اختلفت زوايا الرؤية بينهم. فالفلسفة الظاهراتيّة تقوم على البحث في “مشكلة وعي الإنسان بذاته وبالعالم المحيط به”([12])، بينما كانت الفلسفة الدّيكارتيّة، على سبيل المثال، تبدأ من وعي الإنسان بذاته لتصل لاحقًا إلى وعيه بالعالم، كما يتجلى في مقولة ديكارت Decarte الشهيرة: “أنا أفكر، إذن أنا موجود”([13]). أمّا الظاهراتيّة فترى أن “الوعي هو دائمًا وعي بشيء ما”، ما يعني أن وعي الذات لا يتحقق إلا من خلال انفتاحها على العالم.
وقد رأى بول ريكورPaul Ricoeur أنّ هذه الفكرة تمثل إحدى النتائج المهمّة التي أسهمت بها الفلسفة الظاهراتيّة، إذ إنّها أسست لرؤية فلسفيّة جديدة حول العلاقة بين الذّات والعالم، وهو ما انعكس بوضوح في تطبيقات النّقد الموضوعاتي. لذلك فإن المفهوم الرئيس في الفلسفة الظواهريّة هو:مفهوم قصيدة الوعي، والتي تؤكد المبدأ المثالي الذاتي. أي لا يمكن الحديث عن الموضوع بمعزل عن الذّات، إذ إنّ العلاقة بين الفلسفة الظاهراتيّة والنّقد الموضوعاتي علاقة وثيقة. لذا، ليس من المستغرب أن يُنسب “المنهج” إلى الفلسفة التي ينتمي إليها في بعض الطروحات النّقديّة. ويظهر هذا التداخل بوضوح في كتاب دليل الناقد الأدبي، فيُستخدم مصطلح “النقد الظّاهراتي” أو “الفينومينولوجي” للدلالة على هذا التوجه النقدي([14]).
ولذلك ومن البديهي أن تنشأ علاقة متينة بين أي منهج نقدي وأصوله الفلسفيّة، إذ تشكل هذه الأصول الإطار النّظري الذي يغذي آليات المنهج ويوجه مساره. فلا وجود لعلم مستقل بذاته من من دون خلفيّة فلسفيّة تؤسس لمبادئه، وتضع قواعده الإجرائيّة، وتحدد آلياته التّطبيقيّة. ومن تلك الأسس تنطلق مسيرة تطور المنهج، تدريجيًا، نحو مزيد من النّضج والاتساق.
وفي هذا السّياق، نرى أن الفلسفة الظاهراتيّة قد أسهمت، من خلال توجهها الخاص، في إعادة إمكانيّة تذوق النصّ الأدبي بوصفه مشروعًا دلاليًا وجماليًا. فهي تلتقي مع نظرية التّلقي في منح المتلقي دورًا فعالًا، ليس فقط في قراءة النّص، بل في استكماله من خلال سدِّ الفراغات وملء الفجوات، سواء أكان النص شعرًا أم نثرًا. كما تتيح الظاهراتيّة مجالًا واسعًا لتأويل النّصوص بطرائق متعددة، وفاقًا لقصدية القارئ وإدراكه.
وقد أكد كل من إدموند هوسرل ومارتن هايدغر أنّ الوعي، في جوهره، هو وعي بشيء ما، لذلك كانت مهمة تحديد الوعي عندهم من أي مظاهر قبليّة سمة أساسية في النقد الظاهراتي. فهذه الفلسفة تسعى إلى تحويل الوعي من انشغاله بالموجودات الغيبيّة (النومين) إلى الاهتمام بالظواهر المحسوسة (الفينومينن)، عبر فعل قصدي واعٍ ينقل “الأنا” من موقع التّعالي المسبق إلى مستوى الشّعور والإدراك المباشر. ومن هذا التّحول نشأت رؤى نقديّة ومنهجيّة جديدة في مقاربة النّص الأدبي، بوصفه كيانًا دلاليًا وجماليًا لا يكتمل إلا بالقراءة واعية وفاعلة تملأ فجواته وتستكمل بنيته النّصيّة([15]).
ومن هنا يمكن القول إن الظاهراتيّة قد أعادت الذات المبدعة، وكرّست مشروعيتها في تفسير العالم من خلال قصدية الإدراك. كما أسهمت في ترسيخ فكرة أنّ النّص لا يتحقق تمامًا بمؤلفه فقط، بل يتمّ عبر التّفاعل النشط مع المتلقي، وهي البذور الأولى لما ستعرف لاحقًا بنظريّة التلقي.
ج- التجربة الموضوعاتية لغاستون باشلار في كتابه “الماء والأحلام”.
يُعد غاستون باشلار أحد أبرز المفكرين الذين منحوا للخيال الأدبي مكانة مركزية، رابطًا بين التّجربة الذّاتيّة والرّمزيّة وبين الصور الشّعريّة الأولى التي تتولد في وعي الكاتب والقارئ على حدّ سواء. ففي كتابه” الماء والأحلام”“، يقدّم باشلار تجربة نقديّة فريدة من نوعها، إذ يعالج تيمة الماء لا بوصفه عنصرًا ماديًّا، بل بصفته صورة جوهريّة تتغلغل في عمق النّفس الإنسانيّة وتستثير أشكالًا من الخيال الحالم المرتبط بالهدوء، والذّوبان، والانسياب، بل والموت أحيانًا. إنّ هذه المقاربة الموضوعاتيّة تسعى إلى كشف البعد الحلمي والرّمزي للصور، من خلال العودة إلى التّجربة الحسيّة الأولى للذات في علاقتها بالعناصر الطبيعيّة. وسيقوم هذا الجزء بالبحث بشكل موجز عن تيمة الماء وفق المنهج الموضوعاتي.
ففي كتاب “الماء والأحلام” لا يتعامل باشلار مع الماء بصفتها عنصر طبيعي فحسب، بل يدرسه بوصفه صورة خياليّة تتعدد دلالاتها بين العمق النّفسي والرمز الشعري. ومن خلال هذا التناول، يصبح الماء حاملاً لمجموعة من القيم الشّعورية والرّمزيّة التي تعبّر عن حالات إنسانيّة متباينة، من الصّفاء إلى الذّوبان، ومن الحياة إلى الموت.
1 – تيمة الماء بصفته مرآة للنّفس والذاكرة: قراءة في صورة المياه، ففي هذا النص:
“يا مرآة!
يا ماء بردك السأم في إطارك الجامد
كم مرّة وطيلة ساعات مكدّر
من الأحلام وباحثًا عن ذكرياتي التي هي
كمثل الأوراق…
لكن يا للهول! خلال مساءات، في ينبوعك القاسي…”([16]).
لا يُقدّم الماء في هذا المقطع بصفته مجرد عنصر طبيعيّ، بل يتحول إلى رمز مركزي في المخيلة. الحقل المعجمي للمياه في هذا المقطع “يا ماء، ينبوع.. الجامد…”، المياه الجاريّة، الينابيع، والمياه الربيعيّة تظهر تجسيدًا للحياة، للنقاء والطهارة والشباب والذكرى الجميلة. إنّها الماء التي تحمل دلالة الحلم و الانبعاث، وترتبط بالصور الإيجابيّة في لاوعي الإنسان. وفي المقابل، الماء الراكد، كما في قنوات مدينة بريج([17]) Bruges، والتي يشير إليها باشلار عبر تحليل رودانباخ، الماء الذي يعكس الحزن، والعزلة والوجود المأزوم. إنّه ماءٌ يدل على ركود الحياة وغياب الحركة، إذ يصبح فضاءً للانعكاس الدّاخلي والرّكون إلى الذات.
وكذلك تقدّم صورة الماء هنا بوصفها مرآة تعيد الذّات إلى ذاتها، وتضعها في مواجهة مباشرة مع أعماقها. يُصبح الماء الراكد مثل مرآة رودانباخ، يعكس ما تخفيه الحياة الرّاكدة في تلك المدينة ويحوّل الماء إلى سطح عاكس للهواجس والأحلام والصّراعات الدّاخليّة. وتتصل أيضًا بالنّرجسيّة، إذ يُشار إلى الشّروط الموضوعيّة للنّرجسيّة، فيكون الماء هو الفضاء الذي يُهيىء الحلم النّرجسي. إذن، الماء كمرآة تمنح الذّات فرصة التّحديق في ذاتها، والغوص في انعكاسها، هذا ما يوصل إلى الشّعور بالوحدة و الاغتراب. هنا، اتصل الموضوع تيمة الماء مع حقله المعجمي بالرّغبة في الانكفاء على الذّات والهّروب إلى عالم من الصور الحالمة.
إذن الماء هنا لا يرد بوصفه صورة عابرة، بل بوصفه تيمة متكررة عبر الحقل المعجمي الذي يحمل دلالات نفسيّة ووجوديّة عميقة، تكشف علاقة الإنسان بذاته وعالمه عبر المخيلة الشعريّة.
وفي مقطع آخر من كتاب باشلار، تتجلى تيمة الماء من منظور موضوعاتي بوصفها صورة متكررة تحمل دلالات نفسيّة، شعريّة، وطفوليّة عميقة، تنبع من المخيلة الحلميّة للذات الإنسانيّة.
“تبدو كمثل ثغثغة الموجة
وتُجيب الحوريات:
نحن نوشوش، ونسقسق،
زنرفرف من أجلك”
(فاوست الثاني، المشهد الثاني، نهر البينيه)([18])“.
يرتبط الماء هنا بالسّواقي، الينابيع، والشّلالات، وكلها صور تنبث منها النّداوة والبهجة الصّاخبة. هذا ما يجعل الماء نقية قبل أن تشوبها تعقيدات الوجود. الحقل المعجمي للمياه الضّاحكة والسواقي الشّاخرة، ترمز إلى براءة الأطفال وإلى ما يسميه باشلار اللغة الطفولية للطبيعة فتنطق الطبيعة بأبسط تعبيراتها الحسيّة وأصدقها. والماء لا يحمل في هذا المقطع فقط موضوع البراءة والطفولة، بل هناك حضور لموضوع المياه الغابية والمياه الخفيّة، إذ يكمل باشلار متحدثًا عن المياه التي تحضر في الوعي قبل أن تحضر بالصوت: “نسمعها قبل أن نراها”([19]). وهنا صدى للحظة اليقظة التي تخرج من عالم الأحلام، فيتحول صوت الماء إلى نداء للطبيعة الحيّة وإلى علامة على الانبعاث والحياة الجديدة. هذه “اليقظة الطبيعية”([20]) التي ترمز إلى الولادة المتجددة وإلى لحظة اتحاد الذات بالطبيعة الخالدة.
يتعالق حضور الماء في المقطع السّابق مع الحلم الشعري والأسطوري. إنّ الموجة تشبه ب”ثغثغة وجيب الحوريات”، والسّواقي تغدو أغنية إيقاظ. هكذا يكون الماء هو الحامل لحنين الإنسان إلى الأسطورة، إلى الطفولة الكونية، وإلى لحظة اتحاد الحلم بالواقع.
ففي ضوء المنهج الموضوعاتي، لا يظهر الماء في هذا المقطع بصفته عنصر طبيعي فحسب، بل بصفته موضوعًا مركزيًّا يعبّر عن البراءة، الحلم، الولادة، والحنين إلى الطفولة الأولى. ويتبدى الماء بوصفه تيمة تكشف المخيلة الحالمة والوجدانية التي ترى فيه رمزًا للانبعاث والتّجدد، وللاتحاد مع الطبيعة الحيّة، وهو ما ينسجم مع مقاصد باشلار في تحليله للصور المائية بوصفها امتدادًا للمخيلة الشعريّة.
الخاتمة
يُعد المنهج الموضوعاتي أحد المناهج النقديّة التي تهتم بدراسة الثّيمات أو الموضوعات الكبرى المتكررة في النصوص الأدبيّة، مثل الماء، النار، البيت، الليل وغيرها، وذلك من خلال تتبّع دلالاتها الرّمزيّة والنّفسيّة في سياق التّجربة الإنسانيّة. وقد شكّل هذا المنهج أداة مهمة لكشف عمق الصورة الأدبيّة وارتباطها بالمخيال الفردي والجمعي.
في هذا السّياق، يُعد غاستون باشلار من أبرز من اعتمدوا المنهج الموضوعاتي، غير أنّه لم يكتف بتطبيقه بصيغته التّقليديّة، بل عمل على تطويره ودمجه برؤية فلسفيّة وظاهراتيّة عميقة، جعلت منه وسيلة لاستكشاف العلاقة بين الخيال والعناصر الطبيعيّة. ففي تحليلاته لتيمة الماء كما في “ماءو الأحلام” كشف باشلار طاقة الخيال المرتبطة بالعنصر المائي، وكيف تعبّر هذه الصور عن حالات نفسيّة وشعريّة تتجاوز ظاهر النّص.
وهكذا، قدّم باشلار نموذجًا فريدًا في النّقد الموضوعاتي، لا يقتصر على التّصنيف أو التّفسير، بل يُعيد بناء الصورة الشّعرية انطلاقًا من تأمل فلسفي في جوهر الخيال،هذا ما يجعل من منهجه تجربة فكريّة وجماليّة قائمة بذاتها.
المصادر والمراجع
- ابن منظور: لسان العرب، تر:عبد السلام هارون، ج8، دار صادر، بيروت، 1412ه، مادة وضع.
- أبو الطاهر: القاموس المحيط، ج3، دار الملايين، بيروت، دت.
- جميل حمداوي: المقاربة النقدية الموضوعاتية، ط1، مكتبة المثقف، 2015م.
- سعيد علوش: النقد الموضوعاتي، ط1، منشورات شركة بابل للنشر والطباعة، 1990م.
- غاستون باشلار: الماء والأحلام: دراسة عن الخيال والمادّة، تر علي إبراهيم، مدرسة دراسات الوحدة العغربية، بيروت، 2007م، ص23-45.
- محمد السعيد عبدلي: البنية الموضوعاتية في عوالم نجمة لكاتب ياسين، أطروحة دكتوراه، قسم اللغة العربية وآدابها، جامهة الجزائر، 2003م.
- محمد سالم: الأسس الفلسفية لنقد ما بعد البنيوية، كلية الآداب، جامعو الموصل، 2002م.
- يوسف وغليسي:
- التحليل الموضوعاتي للخطاب الشّعري، ط1، جسور للنشر والتوزيع، الجزائر، 2017م.
- النقد الجزائري المعاصر من اللانسونية إلى الألسنية، إصدارات رابطة إبداع الثقافية، الجزائر، 2002م.
- مناهج النقد الأدبي، ط1، جسور، الجزائر، 2009م.
- UNESCO World Heritage center “ Historic Center of Brugge”
Https://whc.unesco.org/en/list/996(تشرين الأوّل 2025)
1-طالبة دكتوراه في الجامعة الإسلاميّة- بيروت- لبنان- قسم اللغة العربيّة.
-PhD student at the Islamic University – Beirut – Lebanon – Department of Arabic Language .Email: simonabardawil@hotmail.com
[2] – الموتيفات تعني الموضوعات أو التيمات المتكررة. يوسف وغليسي: التحليل الموضوعاتي للخطاب الشعري، ط1، جسور للنشر والتوزيع، الجزائر، 2017م، ص17.
[3]– ابن منظور: لسان العرب، تر: عبد السلام هارون، ج8، دار صادر بيروت، 1412ه ، مادة وضع، ص401.
[4] – أبو الطاهر مجد الدين: القاموس المحيط، ج3، دار الملاين ، بيروت، ص94.
[5] – أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد: جمهرة اللغة، ج3، مكتبة المثنى، بغداد، دت، ص20.
[6] – إميل ليتري: قاموس le litre، 1881.
[7] – يوسف وغليسي: التحليل الموضوعاتي للخطاب الشعري، م.س، ص20.
[8] – حسين تروش: مفهوم الشعر وتجلياته الموضوعاتية عند محمود درويش، ط1، مركز الكتاب، عما، دت، ص 33-34.
[9] -سعيد علوش: النقد الموضوعاتي،ط1، منشورات شركة بابل للنشر والطباعة ، المغرب، 1989م، ص06.
[10] – جميل حمداوي: المقاربة النقدية الموضوعاتية، ط1، مكتبة المثقف، 2015م، ص10.
[11] -جميل حمداوي: المقاربة النقدية الموضوعاتية، م.س، ص 28.
[12] -محمد سعيد عبدلي: البنية الموضوعاتية في عوالم نجمة لكاتب ياسين، قسم اللغة العربية، جامعة الجزائر 2، 2003م، ص36.
[13] – م.ن، ص36.
[14] – يوسف وغليسي: النقد الجزائري المعاصر من اللآنسونية إلى الألسنية، إصدارات رابطة إبداع الثقافية الجزائر، 2002م، ص69-70.
[15] – من قول جورج طرابيشي عن مفهوم الوعي: “إن كل إدراك لمُدرك، وكلّ وعي هو وعي بشىء ما، وكل فكر تسديد للنظر إلى ظاهرة، وإن للوعي قصيدة تطابقها في الوجود معقولية تعطي هذا اوجود معنى بالنسبة إلى الفكر.
جورج طرابيشي: معجم الفلاسفة، ط3، دار الطليعة، بيروت، 2006م، ص712.
[16] – غاستون باشلار: الماء والأحلام: دراسة عن الخيال والمادّة، تر علي إبراهيم، مدرسة دراسات الوحدة العغربية، بيروت، 2007م، ص23-45.
[17] – م.ن، ص 44.
مدينة بريج هي مدينة فرنسية تقع في الإقليم الفلمنكي، وتعرف بلقب ” فينيسيا الشمال”، وذلك بفضل قنواتها المائية التي تخترق المدينة، وتضفي عليها طابعًا شاعريًا متفردًا. (تشرين الأوّل 2025)
UNESCO World Heritage center “ Historic Center of Brugge”
Https://whc.unesco.org/en/list/996
[18] – غاستون باشالار: الماء والأحلام، م.س، ص 58-59.
[19] – غاستون باشلار: الماء والأحلام، م.س، ص 58-59.
[20] – م.ن، ص59.