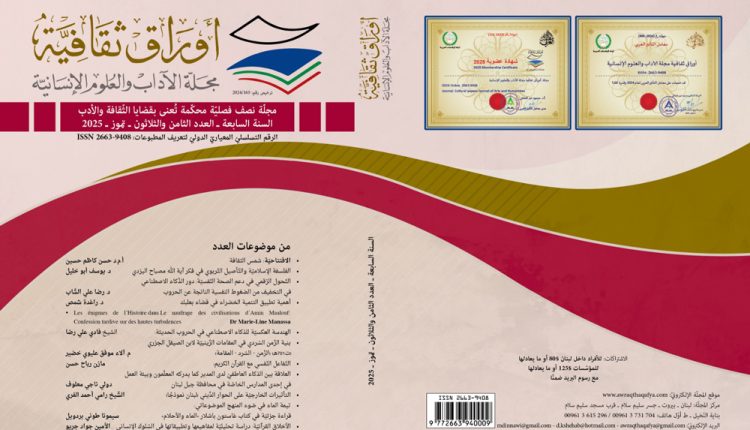عنوان البحث: دراسة إحکام وتشابه الآية 7 من سورة آل عمران وفاقًا لرؤية آية الله معرفة
اسم الكاتب: د. داود اسماعیلی، حمیدة گلی، علي رضا نجات بخش
تاريخ النشر: 2025/07/16
اسم المجلة: مجلة أوراق ثقافية
عدد المجلة: 38
تحميل البحث بصيغة PDFADOI: https://aif-doi.org/awraq/013817
دراسة إحکام وتشابه الآية 7 من سورة آل عمران وفاقًا لرؤية آية الله معرفة
A study of the rules and similarities of verse 7 of Surah Al Imran according to the view of Ayatollah Ma’rifa
Dr. Davoud Esmaely (Responsible writer) د. داود اسماعیلی )[1](
Hamideh Goli حمیدة گلی)[2](
Alireza Nejat Bakhsh علي رضا نجات بخش)[3](
تاريخ الإرسال:6-5-2025 تاريخ القبول:13-6-2025
الملخص
إنَّ السعي لفهم ماهیة الآيات المحكمة والمتشابهة في القرآن الكريم كان ومازال هاجسًا لدی الباحثين في الدّراسات القرآنيّة ويُعَدُّ هذا الموضوع من المباحث التفسيرية المعقَّدة في علوم القرآن، وهو مبدأ أرساه القرآن ذاته وأشار إليه في الآية السّابعة من سورة آل عمران. وقد قدَّم المفسرون آراءً متباينة ومتعددة في تفسير هذه الآية، إلى حد يمكن عدّ هذه الآية نفسها من الآيات المتشابهة. بناءً على ذلك، يُطرح السؤال التالي: بالنظر إلى وجهات النظر المختلفة، وخصوصًا مع التّركيز على رأي الباحث القرآني المعاصر آية الله معرفة ونظريته حول “التّشابه العارضي”، هل تُعد هذه الآية من الآيات المحكمة أم من الآيات المتشابهة؟ تعتمد هذه الدراسة على المنهج الوصفي- التّحليلي فتتناول تحديد المفاهيم اللغويّة لمصطلحات “المحكم”، و”المتشابه”، و”المبهم”، إلى جانب استعراض التّطورات التاريخيّة لمفهومي “الإحكام” و”التّشابه”. تخلص الدّراسة إلى أنَّ الآية السابعة من سورة آل عمران التي تقسّم الآيات إلى محكمة ومتشابهة، قد وقعت بنفسها في التّشابه العارضي، كما أنَّها تنطوي على إبهام في تعبيري “الراسخون في العلم” و”التأويل”.
الکلمات المفتاحيّة: المحكم، المتشابه، الآية 7 من سورة آل عمران، التأويل، الراسخون في العلم.
Abstract
The quest to understand the nature of the decisive and ambiguous verses in the Holy Quran has been and continues to be a preoccupation for researchers in Quranic studies. This topic is considered one of the complex interpretive discussions in Quranic sciences. It is a principle established by the Quran itself and referred to in the seventh verse of Surat Al Imran. Commentators have offered diverse and varied opinions on the interpretation of this verse, to the point that this verse itself can be considered an ambiguous verse. Accordingly, the following question arises: Given the different viewpoints, and particularly focusing on the opinion of contemporary Quranic scholar Ayatollah Ma’rifa and his theory of “accidental similarity,” is this verse considered a decisive verse or an ambiguous verse? This study adopts a descriptive-analytical approach, defining the linguistic concepts of the terms “decisive,” “ambiguous,” and “ambiguous,” while also reviewing the historical developments of the concepts of “decisive” and “ambiguous.” The study concludes that verse 7 of Surat Al Imran, which divides verses into clear and ambiguous verses, itself falls into incidental similarity. It also contains ambiguity in the expressions “those firmly grounded in knowledge” and “interpretation.”
Keywords: clear, ambiguous, verse 7 of Surat Al Imran, interpretation, those firmly grounded in knowledge.
بيان المشكلة
لقد قام الباحثون في الدّراسات القرآنيّة منذ القدم، استنادًا إلى الآية السابعة من سورة آل عمران: ﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ﴾ بتقسيم آيات القرآن الكريم إلى فئتين: المحكمة والمتشابهة، معتقدين أن هذه الآية تُصرّح بوضوح بوجود آيات متشابهة إلى جانب الآيات المحكمة التي تُعدّ أساس القرآن الكريم. وتشير الآية إلى أن بعض أصحاب القلوب المريضة يسعون من خلال تأويل غير صحيح لهذه الآيات إلى إثارة الفتنة ونشرها.
يعتقد هؤلاء الباحثون أنّ الآيات المحكمة هي الآيات الواضحة والصّريحة التي بفضل منطوقها ومضمونها الثابت والمستقر، تُمكِّن السّامع من فهم رسالتها بوضوح والإدراك الواعي لواجبه تجاهها. أما الآيات المتشابهة فهي تفتقر إلى هذه الخاصيّة، ما يؤدي إلى ارتباك المستمع وتشوش فكره عند مواجهتها. وبالنظر إلى الاختلافات التفسيريّة حول المعاني اللغويّة للمصطلحات الواردة في الآية السّابعة من سورة آل عمران مثل “المحكم” و”المتشابه” و”التأويل” و”الواو” و”الراسخون في العلم” وما يترتب على ذلك من التباس في فهمها الصحيح، يبرز التّساؤل الآتي: هل تُعدّ هذه الآية نفسها، بناءً على التّصنيف الذي قدمته، من الآيات المحكمة أم من الآيات المتشابهة؟
تعتمد هذه الدّراسة في الإجابة عن هذا التّساؤل على استعراض آراء الباحثين في الدّراسات القرآنيّة حول تحديد ماهيّة الآيات المحكمة والمتشابهة، ثم تركّز بشكل خاص على رؤية الباحث القرآني المعاصر آية الله معرفة، فتتبنى رؤیته التي تقوم على مفهوم التشابه العارضي.
خلفيّة البحث: أُلِّف العديد من المقالات حول موضوع المحكم والمتشابه ومن بينها:
– المحكم والمتشابه من منظور ابن برجان بقلم حامد نظر بور، نُشر في خريف العام 2020 في مجلة أبحاث القرآن والحدیث إذ يعتمد الباحث على المنهج الوصفي والتحليلي لدراسة رؤية ابن برجان حول مفهومي المحكم والمتشابه.
– المعنى الدلالي للمحكم والمتشابه في الآية السّابعة من سورة آل عمران کتبه مجيد حيدريفر، نُشر في صيف العام 2016 في مجلة الدّراسات التفسیریّة. يستعرض الكاتب معايير تحديد المحكم والمتشابه، ثم يُخضع الآراء جميعها للنقد، ليقدِّم في النّهاية الرؤية التي يراها الأكثر صوابًا.
– “نظرة في تصنيف آيات القرآن إلى محكم ومتشابه وتوضيح تأويل المتشابه بقلم علي رضا سبحاني إقبالي، نُشر في خريف العام 2016 في مجلة فلسفه الدين، فيتناول الكاتب تحليلًا لمفاهيم المحكم والمتشابه والتأويل بشكل متكامل.
لكن معظم المقالات في مجال المحكم والمتشابه قد تناولت تفسير مفهوم هذين المصطلحين، ولم يُنشر حتى الآن أي مقال يناقش ما إذا كانت الآية السّابعة من سورة آل عمران محكمة أم متشابهة. لذلك، تُعدّ هذه الدّراسة من أولى الكتابات التي بعد فحص الآراء المختلفة، تتناول تحديد ما إذا كانت هذه الآية محكمة أو متشابهة.
- التّعريف بمفهوم كلمتي “المحكم” و “المتشابه”
كلمة “المحكم” تعني حفظ الشيء من الفساد والتّلف والتغيير (الفراهيدي، 1409: 1/411). الجذر الأصلي لهذه الكلمة يعني “المنع”، وكلمة “الحكم” تدل على المنع من الظلم (ابن فارس، 1404: 2/91). أمّا “المتشابه” فهي مشتقة من مادة “شِبه” و”شَبَه” وتعني المشابهة أو المثل، وتستخدم كلمة “المتشابه” للإشارة إلى الأشياء التي يشترك جزء منها مع الجزء الآخر في التّشابه. “الشبه” هو نوع من المعدن الذي يتميز بتركيبه الخاص، ويصبح لونه مائلًا إلى الذهبي، ما يجعله يشبه الذّهب (الفراهيدي، 1409: 2/866). مادة “ش، ب، ه” لها أصل واحد يدلّ على التّشابه والتّقارب في اللون والصفة، ويُقصد بـ “شَبَه” المجوهرات التي تشبه الذهب (ابن فارس، 1404: 3/243). يمكن أن تُفهم المتشابهات على أنّها أشياء متشابهة أو مماثلة (الجوهري، 1428: 2/1632).
بين المفسّرين، تُنُاوِل مفهوم آيات المحكم والمتشابه بطرق متنوعة. يُعدُّ المحكم من الآيات التي تكون معانيها واضحة وسهلة الفهم، ولا يُلجأُ إلى آيات أخرى لفهمها. وقد نُقِل عن ابن عباس العديد من الآراء حول آيات المُحكَم، ومن ضمنها أنّ الآيات المحكمة هي: الآيات النّاسخة، والآيات المتعلقة بالحلال والحرام، والحدود، وآيات الميراث، وكل الآيات التي يجب الإيمان بها والعمل بموجبها (السيوطي، 1416: 1/641).
أمّا بالنسبة إلى طبيعة التّشابه، فقد قدم المفسرون أربعة آراء مختلفة، وهي كالآتي:
الرأي الأول: يعتقد بعض المفسّرين من دون التّمييز بين مجال التأويل؛ وفهم القرآن أنّ التشابه يعني عدم قابليّة فهم الآيات، ويؤكدون أنّ معاني هذه الآيات لا يعلمها إلا الله. ومن الأمثلة الواضحة على هذه الآيات هي الحروف المقطعة في بداية السور التي لا يمكن فهمها أو تحليلها (ابن حزم، 1405: 1/534).
الرأي الثاني: في هذا الرأي، يفرّق المفسّرون بين مجال التأويل وفهم مدلولات المتشابهات، ويعرفون التشابه بعدم قابليّة تأويل الآيات. ويعتقدون أنّ الآيات المتشابهة تتضمن مضامين غيبيّة وغير قابلة للإدراك مثل وقت وقوع القيامة وعلامات وقوعها، خروج الدّابة وحقيقة الروح، وما إلى ذلك (السيوطي، 1416: 1/640؛ الزرقاني، 1416: 2/272). ومن جهة أخرى، بخلاف الرأي السّابق، فإنّ الحروف المقطعة في بداية السّور قابلة للفهم (الطبري، 1409: 1/74).
الرأي الثالث: يرى بعض المفسّرين أن تشابه الآيات قابل للفهم ولكنه في الوقت نفسه صعب، ومع ذلك يمكن حلّه من خلال الجهود العلميّة والبحث في الأدلة العقليّة والنقليّة (الغزالي، بدون تاريخ: 1/106؛ الماوردي، بدون تاريخ: 1/369).
الرأي الرابع: في النهاية، يرى الفريق الرابع مفهومًا عامًا للتشابه يشمل جميع الحالات المذكورة أعلاه (ابن تيمية، من دون تاريخ: ص 101-102؛ سيد رضي، 1406: ص 9 و13؛ الراغب الأصفهاني، 1404: ص 254؛ الفخر الرازي، 1415: 7/174-175).
أغلب المتكلمين الإسلاميّين يعرفون التّشابه في سياق صفات الله وأحوال العالم الغيبي والتي تتعلق بالشّكوك والمشاكل العقليّة (الطبري، 1420: 3/175؛ المسعودي، 1409: 4/224-223). أمّا علماء أصول الفقه، فقد نظروا إلى مفهوم التّشابه بشكل عام، وعرّفوه على أنّه الشّكوك والأخطاء التي تنشأ بسبب عوامل مثل الاشتراك والغموض والإجمال. هؤلاء العلماء يشيرون في معاني المحكم والمتشابه إلى تقسيم أنواع دلالة الألفاظ على المعاني، کالفخر الرازي الذي يقسم الألفاظ أربعة أنواع: النّص، الظاهر، المجمل، والمؤول. ويصنف الأنواع الأولين على أنّهما محكمتان، بينما يصنف الأنواع الأخيرين على أنّهما متشابهتان (الرازي، 1420: 7/139). بينما الأصوليون الحنفيّون يرون أن المحكم هو اللفظ الذي لا يمكن نسخه أو تغييره، ويكون معناه واضحًا، بينما يرون أنّ الآيات المتشابهة هي الآيات التي لها معنى مخفي وغير قابل للوصول إليه (التهانوي، بدون تاريخ: 2/1441-1437). في هذا السّياق، الأدباء أيضًا نظروا إلى التّشابه بمفهوم عام وعدُّوا أنّ التّشابه مرادف للمشكلة. فهم يرون أن أصل التشابه هو التشابه اللفظي الظاهري بين لفظين مع اختلاف معانيهما، وأنّ هذا التّشابه اللفظي قد يؤدي إلى خطأ في الفهم فيصبح من الصّعب التّمييز بين المعاني. ومع ذلك، يعدُّون الآيات التي تحتوي على تعقيد أو غموض معنوي آيات متشابهة، حتى وإن لم يكن هذا التعقيد ناتجًا عن التّشابه اللفظي (ابن قتيبة، بدون تاريخ: ص 101-102).
- المفهوم التاريخي للمحكم والمتشابه
قد ذُكر أن هناك آراء متنوعة حول مفهوم المحكم والمتشابه، وهذه الآراء قد تطورت تاريخيًا في الفكر الإسلامي. أولى هذه الآراء ظهرت في مدّة ما بعد النّزول ومن خلال تفسير القرآن بين المفسرين من الصحابة والتّابعين. وفاقًا لوجهة نظرهم، مع الإشارة إلى محكميّة آيات سورة الأنعام (153-151) والإسراء (23) بوصفهما محكمتين و ناسختين. (الطبري، 1420: 3/172؛ الرازي، 1417: 2/592؛ النحاس، 1408: 1/344). نتيجة لذلك، أُطلِق مصطلحي المحكم والمتشابه في تفسيرهم على مفهوم الناسخ والمنسوخ أيضًا. ومع ذلك، فإنّ فهم السّلف لمفهومي المحكم والمتشابه كان متأثرًا إلى حدٍّ كبير بالأحاديث والروايات. لذلك، كان لديهم المحكم على أنّه الآيات التي توضح الحلال والحرام ولم يحدث فيها نسخ، والمتشابه هو فواتح السور التي كانت تشبه لليهود. (الفراء، بدون تاريخ: 1/190)
أمّا بالنسبة إلى آراء المتأخرين حول هذين المفهومين فهي تختلف عن آراء السابقين ومنها:
– عبارات المحكم هي التي تحتوي على أحكام لا يقبل معها أي احتمال أو لبس، لذلك يُعدُّ “أم الكتاب” أي أصل الكتاب، بينما العبارات المتشابهة يمكن أن تختلط مع بعضها البعض وتقبل العديد من الاحتمالات، ولذلك يجب الرجوع إلى المحكمات. (الزمخشري، 1407: 1/337-338)، الثاني هو ما لا يشوب لفظه ولا معناه أي شبهة أو لبس، أمّا المتشابه فهو ما يكون تفسيره صعبًا لأنّه يشبه غيره، سواء في اللفظ أو في المعنى. (الراغب الأصفهاني، 1412: 1/255) والثالث يمكن القول إنّ القاسم المشترك بين النّص و الظاهر والذي هو المعنى الراجح، يُعدُّ محكمًا، بينما القاسم المشترك بين المجمل والمؤول، والذي هو المعنى غير الراجح، يُعدُّ متشابهًا. (الرازي، 1412: 7/139). أمّا في القرن الرابع عشر، فقد ظهرت آراء جديدة من المغنيّة، الطباطبائي والمعرفة: المغنيّة يرى أن المحكم لا يحتاج إلى تفسير لأنه واضح دلالته على المعنى والمقصود، ولا يتسع للتّأويل أو التّخصيص أو النّسخ. والمتشابه هو نفس المنسوخ. (المغنيّة، 1424: 2/11-12) أما الطباطبائي فيرى أن الآيات المتشابهة هي التي لا يدرك المتلقي مرادها ومقصودها بمجرد سماعها، ويحتاج لفهمها إلى الرجوع إلى المحكمات، وعندها تصبح هذه الآيات المتشابهة محكمة. (الطباطبائي، 1417: 3/22-23) أمّا المعرفة فيعرف المحكم أنّه كل قول واضح وقاطع لا مجال فيه للشك أو الخطأ، بينما المتشابه هو من جذر “شبه” الذي يعني “مثل” و”شبه”، وهذا التشابه يسبب الشك واللبس (معرفة، 1999: ص 271-272).
- التعريف بمفهوم كلمة “المبهم”
المقصود من “المبهم” عند مفسري القرآن هو الآية القرآنيّة التي لا يُصرَّح فيها بالأشخاص أو الأشياء، ويُشار إليها فقط باستخدام ضمير أو تعبير مثل “من” أو “الذي”، ما يستدعي تفسيرًا لفهمها بشكل صحيح مثل تعبير “قال رجلان” في الآية 23 من سورة المائدة: ﴿قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يخَافُونَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ﴾، وأيضًا في الآية 100 من سورة النساء: ﴿وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾. الآيات “المبهمة” تحتاج إلى تفسير لإزالة الغموض، بينما الآيات “المتشابهة” تحتاج إلى تأويل لفهم التشابه، ولذلك يوجد فرق بين التشابه والإبهام. المتشابه هو ما يكون معناه غامضًا، وقد غطاه غبار من الإبهام، بمعنى آخر، التشابه لا يكتفي بإخفاء المعنى على اللسان أو في الفعل، بل يثير الشّكوك والرّيبة؛ ولذلك يحتاج إلى إزالة الإبهام والتّخلص من الشكوك والإيهام. أما في “المبهم”، فقط المعنى مخفي وغير واضح، ولكنه لا يثير الشكوك ولا يسبب التّردد. (معرفة ، 2013: 3/ 22)
من عوامل الإبهام يمكن الإشارة إلى ما يلي:
- تعقيد وعدم ألفة الكلمات: إن كلمات القرآن الكريم تأتي من قبائل مختلفة من العرب بهدف بناء لغة موحدة؛ ولهذا السبب، فإنّ بعض الكلمات كانت خاصةً بقبیلة ما وغير مألوفة للقبائل الأخرى مثل كلمة “صلد” التي تعني صافٍ في لغة هذيل؛ وكلمة “إملاق” التي تعني الجوع في لغة لخم.
- الإشارات العابرة التي تأتي في وسط الكلام والتي يتطلب فهمها معرفة العادات والرسوم المتعلقة بنزول الآية وقراءة التاريخ من جديد؛ مثل “نسيء” في الآية: ﴿إِنَّمَا النَّسىِءُ زِيَادَةٌ فِى الْكُفْرِ يُضلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُواْ يَحُلُّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا لِّيُوَاطِئُواْ عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيُحِلُّواْ مَا حَرَّمَ اللَّهُ زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْكَفِرِينَ﴾. (التوبة/37)
- التّعبيرات العامة التي تحمل عدة معانٍ والتي لا يمكن فهم مرادها إلّا بالرّجوع إلى المتخصصين؛ مثل “دابة” في سورة النمل: ﴿وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ﴾. (النمل/82)
- الاستعارات العميقة التي تتطلب الكثير من البحث والتفكير للوصول إلى حقيقتها. مثل الآية: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِيِ الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا﴾. (الرعد/41) (معرفة، 2013: 3/25-22)
بناءً على ما ذُكر، يجب أن نأخذ في الحسبان أنّ التّشابه، وأسباب نشوئه مع الغموض وأسباب حدوثه في النّص يحتاجان إلى التّفريق والتأمل، أولاً لكي لا يُخلَط بين غموض وتشابه الآيات، وثانيًا لكي تُحلَّل الآيات التي تحتوي على عوامل الغموض والتّشابه من كلا الجانبين.
4- دراسة آراء مختلفة حول الكلمات الرئيسية في الآية 7 من سورة آل عمران
4-1- التأويل: في المعنى الاصطلاحي للتأويل، هناك اختلاف بين المفسرين والعلماء في العلوم القرآنيّة؛ هذا الاختلاف يعود إلى ثلاثة توجهات رئيسة في ما يتعلق بطبيعة التأويل:
التوجه الأول: يعدُّ بعض العلماء التأويل مشابهًا للتفسير في طبيعته، ويُعدُّ من باب المعنى والدلالة اللفظية، وقد اختار بعض العلماء مثل أبو عبيد القاسم بن سلام وثعلب هذا المعنى للتأويل. (السيوطي، 1416: 2/ 1189)
التوجه الثاني: يعدُّ التّأويل متعلقًا بالحقائق العينيّة والمصاديق الخارجيّة المرتبطة بمعاني الألفاظ. ابن تيمية هو أول من يطرح هذا المعنى للتأويل. (ابن تيمية، 1426: 1/241-242)
التوجه الثالث: يرى هذا التوجه أن التأويل يتعلق بالمعاني الباطنيّة، والحقائق والرموز المخفية التي تتجاوز مجال دلالة الألفاظ. (أسعدي/ طيب حسيني، 2011: ص 166)
4-2- “الواو” في عبارة “والراسخون في العلم”: من الماضي إلى الحاضر، اختلف الباحثون في القرآن حول نوع “الواو” في عبارة “والراسخون في العلم”. بشكل عام، یوجد رأيان رئيسان بين المفسرين: الرأي الأول أن “الواو” في عبارة “والراسخون في العلم” هي واو استئناف، ووفاقًا لذلك، فإنّ تأويل المتشابهات في القرآن لا يعلمه إلّا الله. وفي هذا السّياق، تحدثوا عن الراسخين في العلم بوجهين مختلفين:
أ: يعدُّ الراسخون في العلم مؤمنين بآيات المتشابه على الرّغم من عدم علمهم بها. وقد تبنّى هذا الرأي الصّحابة، التابعون، الفراء، والنّحويون. (الفراء، 1980: 1/191؛ آلوسي، 1405: 2/181؛ الفخر الرازي، 1320: 7/145). ب: عند قبول واو الاستئناف، لا يلتزمون بمعنى الآية بناءً على الروايات، بل يثبتون علم الآخرين بالآيات المتشابهة من خلال أدلة أخرى. من أبرز مؤيدي هذا الرأي الراغب الأصفهاني والسيد المرتضى. (الطباطبائي، 1417: 3/42)
الرأي الثاني هو أن “الواو” في هذه العبارة عاطفة، وبناءً على ذلك، فإن تأويل الآيات المتشابهة هو من اختصاص الله تعالى وكذلك الراسخين في العلم. (الزمخشري، 1407: 1/338؛ ابن عاشور، 1420: 3/24؛ النحاس، 1428: 1/144)
4-3- “الراسخون في العلم”: “الراسخون في العلم” في هذه الآية لهم مكانة خاصة، لذلك وفاقًا لنوع “الواو” الذي يراه المفسرون، قُدِّم رأيان حول معناه. وفاقًا للرأي الأول، وبالنظر إلى أن “الواو” عاطفة، فإن الرسوخ في العلم يحتوي على بعد إيجابي، ما يعكس قوّة وتعميق الراسخين في علمهم، وبالتالي فإن علمهم يأتي إلى جانب العلم الإلهي. (الزمخشري، 1407: 1/338؛ ابن عاشور، 1420: 3/24؛ النحاس، 1428: 1/144) أمّا في الرأي الثاني، وبالنظر إلى أن “الواو” استئنافيّة، فإنّ هذه الكلمة تحمل بعدًا سلبيًا، ما يعني أنّ الراسخين في العلم، على الرغم من عظمتهم ومقامهم العلمي، لا يدخلون في مجال تأويل الآيات، بل يقتصرون على الإيمان العام. (فراء، 1980: 1/191؛ الآلوسي، 1405: 2/181؛ الفخر الرازي، 1420: 7/145)
4-4- مصاديق “الراسخون في العلم”: في القرآن يأتي القول: ﴿لَّكِنِ الرَّاسِخُونَ فيِ الْعِلْمِ مِنهُمْ وَ الْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَ مَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَ الْمُقِيمِينَ الصَّلَوةَ وَ الْمُؤْتُونَ الزَّكَوةَ وَ الْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ أُوْلَئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا﴾(النساء/162). وبالنظر إلى سياق الآيات، يُفهم أن الراسخين في العلم هم العلماء الأمناء، والمتعهدون من أهل الكتاب الذين وصفهم الله بذلك. ولكن المفسرين استنادًا إلى الروايات المختلفة قد أشاروا إلى مصداقين لهذا الوصف. في روايات أهل السنة، هذا الوصف يطلق على بعض الصحابة مثل ابن عباس وزيد بن ثابت الذين اشتهروا بعلمهم القرآني. (الطبري، 1409: 3/183؛ ابن أبي حاتم، بلا تاريخ: 2/599؛ الحاكم النيشابوري، بلا تاريخ: 3/536). أما في الروايات الشيعية، فيُطلق هذا الوصف فقط على النبي وأهل بيته (ع). (الكُليني، 1413: 1/245؛ الصفار، 1404: 223؛ الحويزي، 1412: 1/313)
- 5. المتشابه والمبهم من وجهة نظر آية الله معرفة
قسّم معرفة آيات القرآن ثلاث فئات: “محكم، متشابه ومبهم”، وكتب قائلًا: إنّ المحكمات هي الآيات التي معانيها صريحة وواضحة وتعبّر عن مدلول ومعنى واحد (معرفة ، 1415: 3/ 6). وأمّا المتشابه فهو “القول أو الفعل الذي يكون أمره غامضًا، أي أنّ هذا القول أو الفعل له ظاهر يثير الشك، على الرّغم من أنّه من الممكن أن يكون هناك حقيقة وراءه لا شك فيها. لهذا السّبب يتبع أهل الانحراف المتشابهات من الشّريعة، ويؤولون هذه الآيات وفاقًا لمصالحهم الفاسدة”. وبالتالي، فإنّ المتشابه هو ما يكون معناه غامضًا وتغطيه غباشة من الإيهام، لذلك يحتاج المتشابه إلى إزالة هذا الغموض وكذلك إلى دفع هذا الإيهام (معرفة، 1415: 3/ 12-11). ويعدُّه معرفة بناءً على الاصطلاح القرآني، لفظًا يحتمل معاني متعددة ويثير الشكّ والرّيبة، ولهذا فإنّ المتشابه لديه القدرة على التفسير الصحيح كما لديه أيضًا القدرة على التفسير الفاسد (معرفة ، 1415: 3/ 6).
وهو في النهاية، بقبول وجهة نظر الراغب، يعتقد أن “المتشابه هو الآيات التي يصعب تفسيرها بسبب التّشابه اللفظي أو المعنوي مع آيات أخرى” (الراغب، 1374: 2/ 299). ومع ذلك، فإنّه يؤمن بوجود نوعين من التشابه الأساسي والعرضي في القرآن؛ وفاقًا لرأيه، فإنّ التّشابه العرضي هو ذلك التّشابه الذي نشأ بسبب المناقشات الجدليّة والكلاميّة والفلسفيّة اليونانيّة بين المسلمين، بينما التّشابه الأساسي هو الذي نشأ بشكل طبيعي بسبب قصر اللفظ واتساع المعنى، إذ إنّ الكلمات العربيّة في الأصل قد صيغت لنقل معاني قصيرة وسطحيّة، ولا تتسع لنقل معاني عميقة وواسعة. لذلك، فإنّ القرآن لأجل بيان المعاني السامية، اضطر إلى اتباع طرق الكناية والمجاز والاستعارة، ما أدى إلى وجود التشابه في بعض الآيات (معرفة ، 2006: ص 145-144). بناءً على هذه النظرية، يمكن القول إنّ التّشابه الأساسي قد نشأ بشكل طبيعي منذ نزول القرآن، ولكن التّشابه العرضي قد نشأ في تلك الآيات التي لم تكن متشابهة في بداية الإسلام، ولكنها أصبحت متشابهة بعد ظهور المناقشات الجدلية والمشكلات الكلامية في القرون التالية، وفي أعقاب المنازعات العلميّة. أما بالنسبة إلى “المبهم”، فهو كلام غير واضح يحتاج إلى تفسير لإزالة الغموض عنه. وفيما يتعلق بالفرق بين “المتشابه” و”المبهم” يكتب: “المتشابه يحتاج إلى تأويل، بينما المبهم يحتاج إلى تفسير، لأنّ في المبهم لا يوجد تشابه، ولا يوجد موضع شك أو شبهة. أمّا في المتشابه، فإنّ هناك غموضًا وكذلك شبهة، ولإزالة الغموض يحتاج إلى تفسير ولإزالة الشّبهة يحتاج إلى تأويل.” (معرفة ، 2013: 3/ 23-22) ويُعدُّ معرفة العلاقة بين التشابه والابهام من نوع “العموم والخصوص من وجه”. (معرفة، 2013: 3/ 25)
بالنّظر إلى النّقاط السّابقة حول تفسير بعض الكلمات الرئيسة في الآية السّابعة من آل عمران، وما ذكره المفسرون عن هذه الكلمات واختلاف آرائهم، يمكن القول إنّ احتماليّة المعاني المختلفة تثير الشك والريبة. وهذا يشير إلى أن الآية، بالإضافة إلى الغموض الناتج عن التّعبيرات العامة والمعاني المتعددة لاصطلاحي “التأويل” و”الراسخون في العلم”، تُعد مثارًا للشك والريبة أيضًا. لذلك، فإنّ الآية السّابعة من آل عمران هي آية متشابهة ومبهمة في الوقت نفسه، وهذه المعاني المختلفة ظهرت في القرون التالية نتيجة للصراعات العلمية والنزاعات الكلاميّة. على سبيل المثال، تأثير الخلافات الكلاميّة في تحليل نوع “الواو” واضحٌ ويمكن الوصول إليه بسهولة. لذا، بعد تحليل الآراء المختلفة حول المحكم، المتشابه، والتأويل يشير معرفة بناءً على ظاهر الآية إلى أن علم تأويل الآيات المتشابهة لا يختص بالله تعالى كما يرى في تحليله الأدبي أن كون “الواو” في الآية استئنافيّة يتناقض مع غرض نزول الآيات أو يكون أمرًا عبثيًا، لأنه إذا كانت آيات القرآن قد نزلت بهدف الهداية، فإنّ إغلاق علم تأويل هذه الآيات عن البشر يُعدّ نقضًا لهذا الهدف. وبعبارة أخرى، وجود الآيات المتشابهة مع فرض اختصاص علم تأويلها بالله تعالى يؤدي إلى عبثية هذه الآيات. (معرفة، 2013: 3/ 63-62)
مقابلًا للسيد المرتضى، الذي أكد استئناف “الواو” باستخدام الأدلة الكلامية، فإنّه كان يعتقد أيضًا بناءً على الأدلة اللغويّة بعاطفيّة “الواو”، ولكنه رجح رأي استئناف “الواو” وأوضح أنّ الراسخين في العلم لا يعلمون تأويل المتشابه كما هو، بل إن تأويل المتشابه بتفاصيله وتحديداته المخصوصة لا يعلمه إلا الله. وذلك لأن المتشابهات تحمل أوجهًا متعددة، وللتوافق مع الحق، يذكرون التأويلات جميعها وفاقًا للأدلة العقليّة، ولا يتوجهون بالضرورة إلى المعنى الأصلي من الله بشكل قاطع إذ إنّ الشّخص الذي يتبع الأدلة لا يرغب في تفسير ما يتناقض مع أدلته، بل يذكر بعض الأوجه التي يمكن تأويلها بما يتناسب مع الحق. (السيد المرتضى، 1994: 1/ 418). من وجهة نظره، فإن آيات القيامة هي من الآيات المتشابهة؛ ولذلك، وبالنظر إلى أن “الواو” في الآية استينافية، فإن تأويل القيامة ووقت يوم القيامة، ومقادير الثواب والعقاب، ووصف الحساب وما إلى ذلك، لا يعرفها إلا الله، وتفصيل وتحديد المتشابهات هو من اختصاص الله فقط. وهو يرى أن علم الإمام محدود بالأحكام والحكومة والمسائل السياسية، ولا يعلم يوم القيامة. (السيد المرتضى، بلا تاريخ: 2/29)
بناءً على ما تبيّن أعلاه، يمكن عدُّ هذه الآية التي تُعدّ منقسمة آيات محكمة ومتشابهة، على أنها تحتوي على تشابه عرضي.
الخاتمة
لقد تحول مفهوم المحكم والمتشابه وتغير معناه في كل عصر طوال تاريخ الفكر الإسلامي. ففي مرحلة بعد نزول القرآن، طُبِّق على مفهوم النّسخ والتّبديل وكانت آراء السّلف حول المحكم والمتشابه متأثرة في الغالب بالأحاديث. أما آراء المتأخرين فقد توسعت في هذا المجال. وبالنظر إلى هذه الاختلافات في الآراء والتفسير، يمكن استخلاص معاني متنوعة من الآية السابعة من سورة آل عمران. بناءً على رؤية آية الله معرفة حول آيات المحكم والمتشابه، ونظريته في التشابه العرضي، الذي نجم عن المناقشات الجدلية والكلامية بين المفكرين المسلمين، يمكن عدُّ هذه الآية من الآيات المتشابهة العرضية.
المصادر
القرآن الكريم
- الآلوسي، محمود، روح المعاني، بيروت: دار إحياء التراث العربي، 1405هـ
- ابن أبي حاتم، تفسير ابن أبي حاتم، صيدا: مكتبة العصرية، بدون تاريخ
- ابن تيمية، أحمد، مجموع الفتاوى الكبرى، بيروت: مكتبة الرشد، 1426هـ
- ابن فارس، أحمد بن فارس، معجم مقاييس اللغة، قم: مكتب الإعلام الإسلامي، 1404هـ
- ابن عاشور، محمد الطاهر، تفسير التحرير والتنوير، بدون مكان: مؤسسة التاريخ، 1420هـ
- أسعدي، محمد، طيب حسيني، محمود، بحث في المحكم والمتشابه، طهران: مرکز بحوث للحوزه والجامعة، 2011
- بورمحمدي، سيدة راضية وسهراب مرويتي وإبراهيم إبراهيم، تحليل السيد المرتضى حول العارفين بالتأويل بناءً على الآية 7 من سورة آل عمران من منظور أدبي وكلامي، مجلة التأويلات القرآنيّة، 2020، الصفحات 31-17
- جوهري، إسماعيل بن حماد، تاج اللغة وصحاح العربية، بيروت، دار العلم للملايين، 1407هـ
- حاج إسماعيلي، محمد رضا ومطيع، مهدي وكياني زهره، تحليل الآراء المعاصرة في تفسير الآية المحكمة والمتشابهة، الدّراسات القرآنيّة، 2013، صفحات 74-49
- حويزي، عبد علي بن جمعة، نور الثقلين، قم: إسلاميان، 1412هـ
11-حيدري عارف، أعظم، دراسة المحكم والمتشابه من منظور السيمانتيكا، قم: نشرات أديان، 2011
12-الراغب الأصفهاني، حسين بن محمد، مفردات ألفاظ القرآن، بيروت: دار القلم، 1412هـ
13-زمخشري، محمود بن عمر، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقوال في وجوه التأويل، بيروت: دار الكتاب العربي، 1407هـ
14-السيوطي، جلال الدين، الاتقان في علوم القرآن، بيروت: ابن كثير، 1416هـ
15-صفار، محمد بن حسن، بصائر الدرجات، قم: مكتبة آية الله مرعشي، 1404هـ
16-طباطبائي، محمد حسين، الميزان في تفسير القرآن، بيروت: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، 2011هـ
17-الطبرسي، فضل بن حسن، مجمع البيان في تفسير القرآن، طهران: ناصر خسرو، 1993
18-الطبري، محمد بن جرير، جامع البيان في تفسير القرآن (تفسير الطبري)، بيروت: دار المعرفة، 1412هـ
19-الطوسي، محمد بن حسن، التبيان في تفسير القرآن، بيروت: دار إحياء التراث العربي، 2010
20-فخاري، سعيد، محكم و متشابه، نسخ و قراءات من وجهة نظر آية الله معرفة
21-الفخر الرازي، محمد بن عمر، التفسير الكبير (مفاتيح الغيب)، بيروت: دار إحياء التراث العربي، 1420 هـ
22-الفراهيدي، خليل بن أحمد، العين، قم: هجرة، 1409 هـ
23-قهاري كرماني، محمد هادي، ملاحظات على آراء آية الله معرفة حول المتشابه، بحوث علوم القرآن والحديث، جامعة الزهراء، 2018، صص 208-178
24-محمد رشيد رضا، تفسير القرآن الحكيم الشهير بتفسير المنار، بيروت: دار المعرفة، 1414 هـ
25-معرفة، محمد هادي، التمهيد في علوم القرآن، طهران: منظمة الدعاية الإسلامية، 1415 هـ
26-______________، العلوم القرآنيّة، قم: مؤسسة التمهيد، 1999
27-النحاس، أبو جعفر، معاني القرآن الكريم، مكة: جامعة أم القرى، 1428 هـ
28- نكونام، جعفر، تفسير دلالي لآية المحكم والمتشابه، بحث ديني، 2008، صص 66-39
-[1] أستاذ مساعد فی قسم علوم القرآن والحدیث جامعة أصفهان، إیران.
Assistant Professor in the Department of Qur’anic and Hadith Sciences, University of Isfahan, Iran.Email: d.esmaely@theo.ui,ac.ir
[2] – خریجة ماجستیر قسم علوم القرآن والحدیث جامعة أصفهان إیران.
MA graduate, Department of Quranic and Hadith Sciences, University of Isfahan, Iran
Email: hh.1363. hamide@gmail.com
[3] – طالب دکتوراه فی علوم القرآن والحدیث جامعة أصفهان، إیران
PhD student in Quranic and Hadith Sciences, University of Isfahan, Iran,Email: nejat.7922@gmail.com