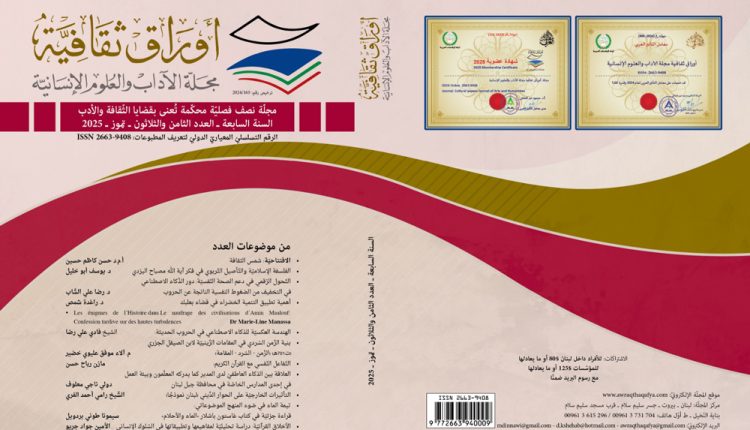عنوان البحث: الإمام الهادي وتأويلاته لسورة العنكبوت دراسة تفصيليّة
اسم الكاتب: عبد الفتاح نجم عبد الله علي
تاريخ النشر: 2025/07/16
اسم المجلة: مجلة أوراق ثقافية
عدد المجلة: 38
تحميل البحث بصيغة PDFADOI: https://aif-doi.org/awraq/013818
الإمام الهادي وتأويلاته لسورة العنكبوت دراسة تفصيليّة
Imam Al-Hadi and his interpretations of Surat Al-Ankabut: A detailed study
Abd al-Fattah Najm Abdallah Ali عبد الفتاح نجم عبد الله علي([1])
تاريخ الإرسال:18-4-2025 تاريخ القبول:26-6-2025
الملخص
يهدف هذا البحث إلى دراسة تأويلات الإمام علي بن محمد الهادي (عليه السلام) لسورة العنكبوت، من خلال جمع الروايات المنقولة عنه وتحليلها وفاق المنهج الإمامي في التّفسير. ركّزت الدّراسة على البعد العقدي والتأويلي في هذه الروايات، لا سيما ما يتصل بموضوعات مثل الابتلاء، النّفاق، التّوحيد، والولاية، مع بيان كيف قدّم الإمام تأويلاً يتجاوز الظاهر إلى المعنى الباطني المرتبط بالموقف الإيماني والتكليف الفردي والجماعي.
اعتمد البحث على مصادر أصيلة في التّفسير الروائي الشّيعي، كـ”تفسير القمي”، و”تفسير العياشي”، و”بصائر الدّرجات”، و”الكافي”، وصُنِّفت الروايات المتعلقة بسورة العنكبوت ثم حلِّلت ضمن إطار عقدي يتماشى مع رؤية الإمامة للقرآن بوصفه نصًا مستمر المعنى.
أظهرت النتائج أن تأويلات الإمام الهادي (عليه السلام) تعكس فهمًا عميقًا لمفاصل السورة، وتوظفها لإثبات أصول الدين، خصوصًا التوحيد والإمامة، كما تفسر شخصيات ومواقف قرآنيّة بالإشارة إلى معاصري الإمام أو إلى أهل البيت (عليهم السلام).
خلصت الدّراسة إلى أن التّأويل عند الإمام ليس تأويلاً لغويًا أو عقلانيًا صرفًا، بل هو كشف المعنى الواقعي المرتبط بالهداية، وهذا يكشف طابع خاص للقراءة الإماميّة للقرآن.
توصي الدّراسة بمزيد من التّوسع في تأويلات الأئمة لسور أخرى، وبناء دراسات موضوعيّة تعتمد منهجًا تحليليًا يعيد تأصيل علم التفسير في ضوء المدرسة الإماميّة.
الكلمات المفتاحيّة: الإمام الهادي، تأويل، سورة العنكبوت، المنهج الإمامي، التفسير الروائي
Abstract
This study aims to examine the interpretations of Imam Ali ibn Muhammad al-Hadi (peace be upon him) on Surah Al-Ankabut by collecting and analyzing the narrations attributed to him, based on the Imami exegetical methodology. The focus is on the theological and interpretive dimensions of these narrations, especially concerning themes such as trial, hypocrisy, monotheism, and divine guardianship (wilayah), highlighting how the Imam offered an interpretation that transcends the literal meaning toward the inner meaning connected to faith commitment and individual and collective responsibility.
The research relied on primary sources in Shi’a narrative exegesis, including Tafsir al-Qummi, Tafsir al-Ayyashi, Basa’ir al-Darajat, and Al-Kafi. The narrations related to Surah Al-Ankabut were classified and analyzed within a doctrinal framework consistent with the Imami view of the Quran as a text of ongoing meaning.
The findings show that the interpretations of Imam al-Hadi (peace be upon him) reflect a profound understanding of the key themes of the Surah. These interpretations were used to affirm the core principles of religion, especially monotheism and Imamate, and they reinterpreted Quranic characters and events as referring to the Imam’s contemporaries or to Ahl al-Bayt (peace be upon them).
The study concludes that the Imam’s interpretive approach is neither purely linguistic nor rational but is rather a disclosure of the real meaning tied to guidance. This reveals a distinct character of the Imami reading of the Quran.
The study recommends further research into the interpretations of other Surahs by the Imams and the development of analytical studies that reestablish the science of exegesis in light of the Imami school.
Keywords: Imam al-Hadi, interpretation, Surah Al-Ankabut, Imami methodology, narrative exegesis.
المقدّمة
اهتمت مدرسة أهل البيت (عليهم السلام) بتفسير القرآن الكريم، لا بوصفه نصًا لغويًا فقط، بل بوصفه مصدرًا للمعرفة العقديّة والهداية العمليّة، مرتبطًا بمقام الإمامة وولاية أهل البيت. وقد ورد في الحديث القدسي: “مثل أهل بيتي فيكم مثل سفينة نوح، من ركبها نجا، ومن تخلف عنها غرق“ (الكليني، 1985، ص 185). وتُعد تأويلات الأئمة جزءًا أساسيًّا من هذا التراث، كونها تبيّن باطن الآيات وتربطها بمصاديقها الواقعيّة، لا سيما في ما يتعلّق بالإيمان والنفاق والابتلاء، وهي الموضوعات التي تتجلى بوضوح في سورة العنكبوت.
قال تعالى: ﴿أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لا يُفْتَنُونَ﴾ (العنكبوت: 2). تمثل هذه الآية مدخلًا لفهم السورة من منظور الإمتحان الإلهي، الذي تكشف الروايات أنّه يُستخدم لتمييز الصادق من المدعي. في ضوء هذا، جاءت تأويلات الإمام علي بن محمد الهادي (عليه السلام) لتقدّم فهمًا تأويليًّا خاصًا لهذه السورة، من خلال ربطها بمفاهيم التوحيد، الإخلاص، النفاق، والولاية.
هذا البحث يتتبّع التأويلات المنسوبة إلى الإمام الهادي (عليه السلام) في سورة العنكبوت، من خلال المصادر التفسيريّة والرّوايات المعتمدة في المدرسة الإماميّة، ويحللها وفق المنهج التّحليلي والعقدي. تهدف الدّراسة إلى بناء فهم أعمق للتأويلات القرآنية التي وردت عن الإمام، وبيان موقعها ضمن النّسق التأويلي الإمامي العام، وكيفيّة ارتباطها بالمفاهيم الأساسية في العقيدة الشيعيّة، وبالواقع التّاريخي والسياسي لعصر الإمام.
من خلال هذا المسعى، يسهم البحث في كشف البعد التأويلي في خطاب الإمام الهادي (ع)، ويبرز دوره في التفسير المرتبط بالإمامة، وفق رؤية توحيديّة-عقدية منسجمة مع القرآن الكريم وهدي أهل البيت.
مشكلة البحث:على الرّغم من الأهمية العلميّة والرّوحيّة الكبرى للإمام علي بن محمد الهادي (عليه السلام) في الفكر الإمامي، لم تُفرد دراسات أكاديميّة تحليليّة مستقلة تتناول تأويلاته القرآنيّة، خصوصًا ما ورد منها في سورة العنكبوت التي تُعد من السور ذات الطابع العقدي والابتلائي الواضح.
سورة العنكبوت تتناول موضوعات مركزية مثل:
- صدق الإيمان تحت ضغط الابتلاء
- مظاهر النفاق والكفر
- التوحيد الخالص
- العبرة من مصير الأمم السابقة
وقد وردت عن الإمام الهادي (عليه السلام) روايات تفسيريّة وتأويليّة لهذه السورة، لكنّها بقيت متفرقة في بطون كتب التفسير والحديث، من دون دراسة تفصيليّة شاملة تكشف أبعادها العقديّة والتأويليّة، ومن دون توظيف منهج علمي يربط بين الرواية القرآنيّة والسّياق العقائدي.
تنطلق المشكلة من هذا النقص، وتتمثل بالسؤال الآتي: ما هي دلالات وتأويلات الإمام الهادي (عليه السلام) لسورة العنكبوت، وكيف تعكس هذه التأويلات المنهج الإمامي في فهم النص القرآني؟
ويتفرع عن ذلك أسئلة فرعيّة:
- كيف صنّف الإمام الهادي آيات السورة في الابتلاء والولاية والتوحيد؟
- ما العلاقة بين تأويلاته والواقع العقدي والسياسي الذي عاشه؟
- ما الفرق بين هذه التأويلات وبين الفهم الظاهري للسورة؟ هذه الأسئلة تشكّل محور البحث، وتُبرز الحاجة إلى دراسة تأصيليّة علميّة متخصصة تجمع الروايات وتفكك بنيتها التأويليّة ضمن منهج تحليلي.
أهمية البحث: تنبع أهمية هذا البحث من عدة جوانب علميّة ومعرفيّة وعقديّة:
- أهميّة شخصيّة الإمام الهادي (عليه السلام): الإمام العاشر من أئمة أهل البيت، وكان له دور معرفي بارز في عصر اشتدت فيه الضغوط السياسية والعقائدية، ومع ذلك نُقلت عنه روايات تفسيريّة لم تُدرس باستقلال.
- كشف بعد مهمل في الدّراسات التفسيريّة: تأويلات الإمام الهادي (عليه السلام) لسورة العنكبوت لم تُجمع ولم تُحلل منهجيًا، على الرّغم من أنّها تمثل امتدادًا لخط التأويل الإمامي الذي يجمع بين ظاهر النص وباطنه.
- أهميّة سورة العنكبوت من النّاحية العقديّة: السورة تتناول قضايا أساسيّة مثل:
- صدق الإيمان وفتنة الابتلاء
- النفاق ومصير المكذبين
- العبرة من التاريخ الرباني
هذه القضايا تُعد مركزية في البناء العقائدي الإمامي، ما يجعل تأويل الإمام الهادي لها ذا قيمة تفسيريّة خاصة.
- تعزيز منهج التفسير الروائي التحليلي: البحث يسهم في تأصيل فهم التفسير الروائي داخل الإطار العلمي المعاصر، من خلال تحليل النصوص، وربطها بالسياق العقائدي والفكري.
- توسيع مجال البحث في علوم القرآن عند أهل البيت (عليهم السلام)
يفتح هذا البحث مجالًا أمام دراسات أخرى مماثلة لسور مختلفة وتأويلات معصومين آخرين، ويساعد في بناء تراكم علمي داخل هذا الحقل المعرفي التخصصي. - الإفادة في الدراسات القرآنية والعقدية والحديثية معًا: لأنّه يجمع بين دراسة الآية، والرواية، والخطاب العقدي، في نموذج تطبيقي على سورة كاملة. بهذا يكون البحث مساهمة علمية لتوثيق وتحليل أحد أوجه التفسير الإمامي المهمل.
أهداف البحث
- جمع وتأصيل الروايات التأويلية: توثيق جميع الروايات المنسوبة إلى الإمام علي بن محمد الهادي (عليه السلام) في تفسير أو تأويل سورة العنكبوت من المصادر المعتمدة في المدرسة الإمامية.
- تحليل مضامين التأويلات: دراسة محتوى الروايات تحليليًا لكشف أبعادها العقدية والمعرفية وربطها بمفاهيم مركزية في الفكر الإمامي مثل:
- التوحيد
- الابتلاء
- النفاق
- الولاية
- تصنيف التأويلات بحسب الموضوع: تصنيف الروايات وفق محاور السورة الأساسية (عقديّة، اجتماعيّة، تاريخيّة، روحيّة)، لفهم طريقة الإمام في تفكيك بنية السورة.
- بيان المنهج التأويلي للإمام الهادي (ع): توضيح الخصائص المنهجيّة التي اعتمدها الإمام في تأويل الآيات، وتحديد موقع هذا المنهج ضمن مدرسة التفسير الروائي الإمامي.
- إبراز العلاقة بين التأويل والنص القرآني: توضيح كيف يرتبط التأويل بالمستوى الباطني للمعنى من دون أن يعارض ظاهر النص، ما يؤكد انسجام التأويل الإمامي مع النّص القرآني.
- مقارنة تأويل الإمام بالتّفسير الظاهري: إبراز الفروقات بين فهم الإمام للنّص وبين الشروح الظاهريّة الشائعة، ما يسلط الضوء على البعد الخاص للتفسير الإمامي.
- تقديم نموذج تطبيقي لمنهج التفسير عند أهل البيت: يوفّر البحث تطبيقًا عمليًا يمكن اعتماده في دراسة تأويلات بقية الأئمة لسور قرآنية أخرى ضمن مشروع بحثي أوسع.
حدود البحث
- الحدود الموضوعيّة: يقتصر البحث على تأويلات الإمام علي بن محمد الهادي (عليه السلام) لسورة العنكبوت فقط، ولا يتناول باقي تفسيراته لسور أخرى، ولا تفسير السورة من أئمة آخرين.
- الحدود النّصيّة: تشمل الدّراسة الروايات التأويليّة المنسوبة مباشرة أو بالواسطة إلى الإمام الهادي (عليه السلام)، وتُستثنى الروايات غير الموثقة أو غير المنسوبة له بوضوح.
- الحدود المذهبية:يعتمد البحث على المصادر التفسيريّة والحديثيّة الإماميّة، مثل:
- تفسير القمي
- تفسير العياشي
- بصائر الدرجات
- الكافي
ولا يشمل تفاسير أهل السنة أو الاتجاهات الكلامية والفلسفية الأخرى.
- الحدود الزّمنيّة: تركز الدّراسة على الروايات التي ظهرت أو جُمعت في القرون الهجريّة الثلاثة الأولى، وتنتهي بالمصادر المدونة حتى نهاية القرن السادس الهجري.
- الحدود المنهجيّة: يتبع البحث المنهج الاستقرائي في جمع الروايات، والتحليلي في تفسيرها، مع بعض المقارنات المنهجيّة عند الحاجة، ولا يعتمد على المناهج اللغوية أو الفلسفيّة المجردة. هذه الحدود تهدف إلى ضبط نطاق البحث وتحقيق دقة في التحليل والتوثيق ضمن إطار تخصصي واضح.
منهجي ة البحث: يعتمد البحث على مجموعة من المناهج العلميّة المتكاملة، وهي:
- المنهج الاستقرائي: يُستخدم في تتبع الروايات المنسوبة إلى الإمام الهادي (عليه السلام) في تفسير سورة العنكبوت، من خلال استقراء المصادر التفسيريّة والحديثيّة الإماميّة، واستخراج النصوص ذات الصلة بدقة وتوثيقها.
- المنهج التحليلي: من خلاله يُحلَّل محتوى الروايات التأويلية لمعرفة أبعادها العقدية، وشرح المفاهيم التي تتضمنها، مثل: التوحيد، النفاق، الولاية، الابتلاء. التحليل لا يقتصر على المعنى الظاهري، بل يمتد إلى المستوى العقائدي العميق الذي يُعبّر عنه الإمام في تأويله للنص.
- المنهج المقارن: يُستخدم عند الحاجة لمقارنة تأويل الإمام الهادي (عليه السلام) مع بعض التفاسير الظاهرية أو المأثورة من مدارس أخرى، لإبراز الخصوصية المنهجية للتفسير الإمامي.
- المنهج الموضوعي: تُصنّف الروايات التأويليّة بحسب الموضوعات الكبرى التي تتناولها السّورة، وتحلَّلُ ضمن محاور محددة تساعد على إبراز بنية التّأويل في فكر الإمام.
- المنهج التوثيقي: يعتمد البحث على التوثيق الدّقيق للروايات المنقولة، في المصدر، السند، ودرجة الاعتماد عليها في المدرسة الإماميّة، لتأكيد صحة النتائج المستخلصة.
يسعى البحث باستخدام هذه المناهج، إلى تقديم دراسة متكاملة في جمع وتأصيل وتحليل تأويلات الإمام الهادي (عليه السلام) ضمن إطار علمي رصين.
الدّراسات السّابقة
- دراسة محمد هادي معرفت: قدّم الباحث في كتابه تفسير أهل البيت: عرض وتحليل، عرضًا عامًا لمنهج الأئمة (عليهم السلام) في التّفسير، وبيّن كيف يتعامل أهل البيت مع القرآن تأويليًا بربط الباطن بالظاهر. ومع ذلك، لم يتناول الإمام علي بن محمد الهادي (عليه السلام) أو تفسيره لسورة العنكبوت بشكل خاص (معرفت، 1998، ص 212).
- دراسة عبد الهادي الفضلي: ركّز الباحث في كتابه القرآن عند الإمام الصادق (ع)، على المدرسة التأويليّة للإمام الصادق (عليه السلام)، مبرزًا دوره في بيان المعاني الباطنية للنص القرآني. لكنه لم يتوسّع ليشمل الأئمة الآخرين كالإمام الهادي، ولا تأويلاته للسور المختلفة (الفضلي، 2001، ص 66).
- دراسة محمد باقر الأنصاري: يُعد كتاب الإمام الهادي (ع): حياته، علمه، ومواقفه لمحمد باقر الأنصاري من المصادر المباشرة التي تناولت شخصية الإمام، وقد أشار إلى بعض روايات الإمام الهادي (عليه السلام) في أبواب علميّة مختلفة، منها التفسير. لكن العرض جاء مختصرًا من دون تحليل أو تصنيف منهجي للروايات التأويلية (الأنصاري، 2005، ص 131).
- مقالة في مجلة دراسات قرآنية – قم: نشرت المجلة مقالة بعنوان أثر الأئمة في تفسير القرآن، استعرضت الدور العام للأئمة في التفسير، وذكرت تأويلًا واحدًا منسوبًا للإمام الهادي (عليه السلام)، دون تقديم تحليل أو بناء نظري متكامل (مجلة دراسات قرآنية، 2012، ص 91).
المبحث الثاني: التعريفات والمفاهيم الأساسيّة
• تعريف التأويل لغة واصطلاحًا
أولًا: التأويل لغة: ورد لفظ “التأويل” في اللغة من مادة (أ-و-ل) التي تدل على الرجوع والعودة. جاء في لسان العرب لابن منظور أن التأويل هو “الرجوع إلى الأصل” (ابن منظور، 1994، ج1، ص 213). ويُقال: “أوّل الشيء تأويلاً” أي أرجعه إلى مقصده الحقيقي أو مآله.
التأويل لغةً يعني:
- إعادة الشيء إلى غايته أو نهايته
- تفسير الكلام بما يحتمل معاني متعددة
- الإيضاح بعد الإبهام
ثانيًا: التأويل اصطلاحًا
اختلف العلماء في تحديد دقيق لمعنى التأويل في الاصطلاح بسبب تداخل المفاهيم بين المفسرين، والمتكلمين، وأهل الحديث، والفلاسفة، لكن يمكن تحديد أبرز الاستخدامات ضمن المدارس الإسلاميّة:
- عند المفسرين: يعني التأويل: تفسير الآية بما هو أعمق من ظاهرها، سواء أكان ذلك عبر بيان مجاز، أو كشف معنى باطني، أو تطبيق الآية على مصاديق غيبيّة أو مستقبليّة.
- عند أهل البيت (عليهم السلام): التأويل هو كشف الباطن الإلهي للآية، المرتبط بمقام الهداية والعلم الخاص. فقد ورد في حديث عن الإمام الباقر (عليه السلام)”: “إنّ للقرآن ظاهرًا وباطنًا، ولكل آية حد، ولكل حد مطلع” الكليني، 1985، ج2، ص 599.
- التّمييز بين التفسير والتأويل
- التفسير: بيان المعنى الظاهري للنص.
- التأويل: الكشف عن المعنى الباطني أو الغائي المرتبط بعقيدة أو حدث أو شخص.
خلاصة: التأويل في اللغة هو الرّجوع والانتهاء، أمّا في الاصطلاح القرآني – خاصة عند أهل البيت (عليهم السلام) – فهو علم خاص يتعلق بباطن النص ويمثّل بعدًا معرفيًا وعقديًا لا يتوقف عند ظاهر اللفظ.
المبحث الثاني: التعريفات والمفاهيم الأساسية
• التأويل في الفكر الإمامي: يمثل التأويل أحد الركائز المعرفيّة الأساسية في الفكر الإمامي. لا يُفهم التأويل عند الأئمة (عليهم السلام) بوصفه اجتهادًا لغويًا أو رأيًا شخصيًا، بل هو كشف المعنى الباطني للآيات، يقوم به المعصوم بوصفه المتصل علميًا وروحيًا بالوحي.
قال تعالى: ﴿وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ﴾ (آل عمران: 7). فوفق تفسير أهل البيت، الراسخون في العلم هم الأئمة الذين يملكون علم الكتاب، وهم وحدهم القادرون على بيان باطنه (الطباطبائي، 1997، ج3، ص 24).
مبادئ التأويل في الفكر الإمامي:
- التّأويل علم خاص لا يملكه إلا المعصوم: يُروى عن الإمام الصّادق (عليه السلام): “القرآن نزل بإياكِ أعني واسمعي يا جارة“، أي أنّ كثيرًا من آياته تخاطب ظاهرًا جهة، لكن المقصود بها جهة أخرى في الباطن (الكليني، 1985، ج1، ص 215).
- للقرآن بطون متعددة: التأويل لا يقف عند معنى واحد؛ كل آية لها طبقات من المعاني. الإمام الباقر (عليه السلام) قال: “إن للقرآن بطنًا، وللبطن بطنًا، وله ظهر، وللظهر ظهر“ الصفار، 1983، ص 212).
- التأويل مرتبط بالإمامة والولاية: كثير من الآيات تُؤوَّل لتكشف مصاديق تخص أهل البيت أو أعداءهم، مثل تأويل آيات النفاق أو آيات الولاية.
- الوظيفة العقدية للتأويل: ليس غرض التأويل في الفكر الإمامي هو التفسير الأكاديمي أو التحليلي، بل هو كشف حقائق العقيدة الإيمانية، وتثبيت مفاهيم التوحيد، والنبوة، والولاية.
خصائص التأويل الإمامي:
- قائم على روايات المعصوم.
- يعالج البعد الغيبي للنّص.
- يُسقِط النصوص على مصاديق زمانيّة وشخصيّة.
- لا يتناقض مع الظاهر بل يضيف إليه بعدًا أعمق.
بذلك يُعد التأويل عند الأئمة (عليهم السلام) أداة لفهم البنية العقدية للقرآن، وهو جزء من علم خاص لا يناله إلا المطهرون كما ورد في قوله تعالى: ﴿إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ * فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ * لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ﴾ (الواقعة: 77–79).
المبحث الثاني: التعريفات والمفاهيم الأساسيّة
• الفرق بين التفسير والتأويل: تميّز الفكر الإمامي بين التفسير والتأويل في المنهج والمصدر والوظيفة. على الرّغم من استخدام المصطلحين أحيانًا بالتّبادل، إلّا أنّ الدّراسة الدّقيقة للنصوص والروايات توضح الفروق الجوهرية بينهما.
أولًا: التفسير
- تعريفه: هو بيان معنى الآية ضمن السياق اللغوي والظرف التاريخي، والوقوف عند ظاهر النص.
- وظيفته: شرح الألفاظ، وتوضيح الأسلوب، وبيان سبب النزول، وربط الآيات بالمفردات اللغوية والنحوية.
- خصائصه
- يعتمد على اللغة، والسّياق، والتاريخ.
- يمكن للمفسر المجتهد أن يباشره.
- يركّز على ظاهر النّص.
- المثال: تفسير قوله تعالى: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾ (الكوثر: 2)، أي: صلّ لله صلاة العيد وانحر الأضحية (الطبري، 2001، ج30، ص 302).
ثانيًا: التأويل
- تعريفه: هو كشف باطن النص ومعانيه الغيبيّة والعقديّة التي لا يُدركها إلا المعصوم. وهو تفسير خاص قائم على العلم اللدني المرتبط بالإمامة.
- وظيفته: بيان مقاصد النص في مستويات أعلى من الظاهر، وربطه بمصاديق تاريخيّة أو عقديّة غير مباشرة.
- خصائصه
- لا يُباشره إلا المعصوم أو من أخذ عنه.
- يتناول المعاني الباطنيّة.
- يُسقط الآية على أحداث أو أشخاص بصفتهم مصاديق تأويليّة.
- المثال: تأويل نفس الآية: الإمام الباقر (عليه السلام) قال: “النحر: رفع اليدين حذاء الأذنين في التكبير“ (الكليني، 1985، ج3، ص 321). وهو تأويل لا يتضح من ظاهر النص.
الفرق الجوهري
| الجانب | التفسير | التأويل |
| المصدر | اللغة والعرف والعلم | المعصوم والعلم الخاص |
| المعنى | الظاهر | الباطن |
| الوظيفة | بيان المعنى المباشر | بيان المصاديق الخفية |
| الأداة | العقل والاجتهاد | العلم الإلهي والعصمة |
| من يمارسه | العلماء والمفسرون | الأئمة (عليهم السلام) |
المبحث الثاني: التعريفات والمفاهيم الأساسية
• مكانة الإمام الهادي (عليه السلام) العلمية والتفسيرية: الإمام علي بن محمد الهادي (عليه السلام) هو الإمام العاشر من أئمة أهل البيت، وُلد في المدينة سنة 212 هـ، وتوفي في سامراء سنة 254 هـ. عُرف بلقب “النقي” و”الهادي”، وامتاز بعلمه الواسع وثباته في ظل ظروف سياسية معقّدة فرضها الحكم العباسي في مرحلته المتأخرة.
مكانته العلميّة
- وراثة العلم الإلهي: أهل البيت (عليهم السلام) في الفكر الإمامي هم ورثة علم النّبوة، والإمام الهادي (عليه السلام) هو امتداد حيّ لهذا المقام. رُوي عن الإمام الصادق (عليه السلام): “نحن ورثة العلم، ومعدن الحكم، وموضع الرسالة“ (الكليني، 1985، ج1، ص 399). هذه الوراثة تعني أن الإمام يحمل علم الكتاب ظاهرًا وباطنًا.
- شهادات العلماء المعاصرين له: كانت تُعرض على الإمام مسائل فقهيّة وعقائديّة وفلسفيّة معقدة، فكان يجيب عنها بدقة. وكان كبار الفقهاء والمحدّثين في عصره يطلبون رأيه في المسائل الغامضة، ما يدل على مركزه العلمي البارز (الأنصاري، 2005، ص 88).
- دوره في مواجهة الانحراف العقائدي: واجه الإمام تيارات فكرية مثل الواقفة، والمجسّمة، والغلاة، وقدّم ردودًا علمية رصينة دافعت عن صفاء العقيدة الإمامية، منها رسائله العقديّة في التوحيد وصفات الله، والتي نقلها الصدوق والطوسي في كتبهم العقديّة.
مكانته التّفسيريّة
- التّفسير بالرواية لا بالرأي: الإمام الهادي (عليه السلام) سار على نهج آبائه في تفسير القرآن بالرواية عن النبي (ص) أو علم الإمامة، ورفض التفسير بالرأي أو الهوى، كما رُوي عنه: “من فسّر القرآن برأيه فقد كفر“ (الصفار، 1983، ص 148).
- تأويلات قرآنية دقيقة: له عدد من التأويلات التفسيرية في الآيات التي تتعلق بالإمامة، والنفاق، والتوحيد، والابتلاء، وكلها تنسجم مع البنية التأويلية للفكر الإمامي. مثال ذلك تأويله لآية: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ﴾ (العنكبوت: 10) أنّها نزلت في من يُظهر الولاء ظاهريًا لكنه ينهار عند الابتلاء، وتُسقط على بعض أهل النّفاق من خصوم أهل البيت.
- تأصيل مفاهيم عقديّة عبر التأويل: استخدم الإمام التأويل لتثبيت أصول الدين كالتّوحيد والعدل والإمامة، وربط الآيات بمصاديقها التاريخية والعقدية، وهي طريقة منهجيّة في المدرسة الإماميّة.
الفصل الثاني: سورة العنكبوت في البنية القرآنيّة
المبحث الأول: البناء العام للسورة
أولًا: أسباب النزول: ورد في بعض كتب التفسير أن سبب نزول الآيات الأولى من سورة العنكبوت كان متعلقًا بحال المؤمنين الذين تعرّضوا للفتنة والابتلاء، بعد إعلان إيمانهم في مكة.
ذكر السيوطي أن قوله تعالى: ﴿أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ﴾ نزلت في بعض الصحابة الذين أُوذوا بسبب إسلامهم (السيوطي، 2001، ص 225).
ورُوي عن ابن عباس أن هذه الآية نزلت في عمّار بن ياسر وصهيب وبلال وغيرهم من الذين ثبتوا تحت التعذيب، وهي إشارة قرآنيّة إلى أن الإيمان لا يُقبل إلّا بعد امتحان (الواحدي، 1991، ص 401).
ثانيًا: المقاصد العامة للسورة
سورة العنكبوت من السور المكية التي تحمل طابعًا عقديًا واضحًا، وتهدف إلى معالجة مفاهيم مركزية في بناء الإنسان المؤمن. أبرز مقاصدها:
- بيان سنة الابتلاء في حياة المؤمنين، وتأكيد أن الإيمان لا يكتمل من دون فتنة وتمحيص.
- إظهار بطلان الشّرك من خلال مقارنته بضعف العنكبوت الذي ضرب الله به مثلاً لأهل الباطل.
- سرد قصص الأنبياء كنوح، وإبراهيم، ولوط، وموسى، لتثبيت المؤمنين وربطهم بجذور النبوة.
- التذكير بوعد الله ونصره، وأن العاقبة للمتقين.
- كشف طبيعة المنافقين، وتحذير المؤمنين من الضعف أمام المجتمع أو السلطة. السورة تربط العقيدة بالواقع، وتؤسس لثبات المؤمن أمام الضغوط والتهديدات الاجتماعية.
ثالثًا: البناء الموضوعي للآيات
يمكن تقسيم آيات السورة إلى وحدات موضوعيّة متسلسلة تخدم هدفها العقدي:
- الافتتاح بالابتلاء والإيمان (الآيات 1–11): تبدأ السورة بتوضيح حقيقة الفتنة كجزء من سُنن الإيمان.
- عرض النماذج التاريخية للابتلاء (الآيات 12–40): تتوالى فيها قصص الأنبياء الذين واجهوا أقوامهم بثبات، مثل نوح، وإبراهيم، ولوط.
- دحض الشرك وضرب المثل بالعنكبوت (الآيات 41–43): المثل الذي يكشف ضعف الاعتماد على غير الله.
- التّحذير من التقليد الأعمى والركون للمجتمع (الآيات 44–52): دعوة للعقل والتأمل بدلًا من الاتباع الأعمى.
- خاتمة السورة بالأمر بالهجرة والثبات (الآيات 53–69): تثبيت للمؤمنين، وبشارة للمجاهدين بأن الله معهم. البنية متماسكة، تتصاعد من بيان المفهوم، إلى ضرب الأمثال، إلى عرض النماذج، ثم إلى التوجيه العملي، ما يجعلها نموذجًا متكاملًا لسورة عقديّة إصلاحيّة.
المبحث الثاني: المضامين العقديّة والروحيّة في السورة
أولًا: الابتلاء والتمحيص
تفتتح السورة بطرح واضح لقضية الابتلاء كجزء من مسار الإيمان: ﴿أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ﴾ (العنكبوت: 2).
الابتلاء هنا ليس طارئًا، بل هو قاعدة إيمانية يُمتحن بها الناس لتمييز الصادق من المدّعي. وقد أكّد الإمام علي (عليه السلام) أن “البلاء للولاء كالنار للذهب” (الريشهري، 2000، ص 514). توضح السورة أن الفتنة لا تنفي الإيمان بل تصقله، وأنها سنة جارية في كل زمان، كما ورد في قصص نوح وإبراهيم ولوط.
ثانيًا: التوحيد ومظاهر الشرك
تُظهر السورة التوحيد كمرتكز عقدي محوري، وتكشف بطلان الشرك بأساليب متنوعة:
- العقل: ﴿وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَرْزُقُهُمْ﴾ (العنكبوت: 17).
- التجربة التاريخيّة: من خلال عرض مصائر المشركين السابقين.
- المثل: ﴿مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنكَبُوتِ…﴾ (العنكبوت: 41). يُوصف الشّرك بالضعف والانهيار، ويفتقر لأي سند واقعي، بينما التوحيد يُربط بالعلم والهداية والبصيرة.
ثالثًا: موقف المؤمن من الفتنة
السورة تُحدّد مواقف الناس من الفتنة:
- من يثبت: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ﴾ (العنكبوت: 9).
- من ينهار: ﴿فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ﴾ (العنكبوت: 10). تؤسس السورة لوعي إيماني يجعل الثبات تحت الضغط مقياسًا للإيمان الحقيقي، وتربط الصبر بالهجرة، والجهاد، وبذل النّفس.
رابعًا: مصير الظالمين
السورة تعرض مصائر متعددة لأمم كذّبت الرسل، مثل:
قوم نوح، قوم إبراهيم، ثم قوم لوط، ومدين، وقوم عاد، وثمود.
النتيجة في كل نموذج: دمار، وانهيار، وعذاب.
قال تعالى: ﴿فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ…﴾ (العنكبوت: 40)، وهو تعبير صريح عن عدالة إلهيّة لا تُفرّق بين الأمم، بل تُقيم العقوبة على أساس الكفر والظلم.
الظالم في رؤية السّورة هو:
- من يكذّب بالحق.
- من يفتن المؤمنين.
- من يناصر الباطل ويُظهر الإيمان كذبًا.
خلاصة المضامين: سورة العنكبوت تضع منهجًا عقديًا يربط بين العقيدة والسلوك، بين القول والفعل، وتؤسس لمجتمع الإيمان الذي يتجاوز الابتلاء، ويتشبث بالتّوحيد، ويرفض الشّرك والنفاق، وينتظر مصيرًا وعد الله به المؤمنين دون انحراف أو ضعف.
الفصل الثالث: التأويلات المنسوبة إلى الإمام الهادي (عليه السلام)
المبحث الأول: جمع الروايات التأويليّة من المصادر
أولًا: مصادر التفسير الإمامي التي ذكرت تأويلات الإمام: لم يُخصَّص كتاب مستقل في تراث الإماميّة يجمع تفسير الإمام علي بن محمد الهادي (عليه السّلام)، إلّا أنّ تأويلاته وردت في مصادر متفرقة، نذكر من أهمها:
- تفسير العياشي (القرن الثالث الهجري): جمع روايات تفسيريّة عن أهل البيت، ويُعد مصدرًا أوليًا.
- بصائر الدّرجات للصفار (توفي 290هـ): يُركّز على علوم الأئمة، ويحتوي على تأويلات عالية المضامين.
- الاختصاص للمفيد (توفي 413هـ): احتوى على روايات عقدية وتفسيرية نقلها عن الأئمة.
- تفسير القمي (القرن الثالث الهجري): نسب فيه القمي روايات تفسيرية إلى الأئمة، وإن لم تكن مسندة بدقة دومًا.
- الكافي للكليني (توفي 329هـ): تضمن أبوابًا مرتبطة بالتوحيد والفتن، والتي ورد فيها تفسير بعض الآيات بشكل تأويلي. غالبًا ما تُنقل الروايات دون سند مباشر، لكن يُستفاد منها بقرينة السّياق والعرض المستمر داخل الخط الإمامي في التفسير.
ثانيًا: طرق نقل الروايات وتوثيقها
تعتمد الدّراسة على منهج الرواية المقبولة وفاق الضوابط الآتية:
- السند المتصل أو المسند عبر الثقات: تُقدَّم الروايات المسندة مباشرة إلى الإمام الهادي أو عبر ثقاة من الرواة.
- القبول عند علماء الإماميّة: يُؤخذ بالروايات التي قبلها الفقهاء والمحدثون القدماء مثل الصدوق، والكليني، والصفار، والطوسي.
- انسجام المضمون مع العقيدة الإماميّة: إذا كان مضمون الرّواية منسجمًا مع الخط العام لأهل البيت، فيُقبل من باب الاعتبار ولو لم يكن بسند صحيح كامل.
- عدم معارضة القرآن أو الحديث القطعي: تُستبعد الروايات التي تخالف نصًّا قرآنيًا محكمًا أو حديثًا متواترًا.
ثالثًا: عرض نصوص الروايات المتعلقة بالسورة
في ما يلي بعض الروايات التأويليّة المنسوبة للإمام الهادي (عليه السّلام) والمتعلقة بسورة العنكبوت، كما وردت في مصادر الإمامية:
- الرواية الأولى: في قوله تعالى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ﴾ (العنكبوت: 10). ورد عن الإمام الهادي (عليه السلام): “هم قوم نافقوا، وكانوا يُظهرون حبنا، فلما ابتُلوا تراجعوا، وقالوا: هذا بلاء عظيم، كأنه عذاب من الله، فتركوا الأمر“.
- الرواية الثانية: في قوله تعالى: ﴿مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ﴾ (العنكبوت: 41)
قال الإمام: “هم الذين أعرضوا عن ولايتنا، واتخذوا أئمة غيرنا، فلا يجلبون لهم نفعًا ولا يدفعون عنهم ضرًا“ المصدر: بصائر الدرجات، ص 212. - الرواية الثالثة: في قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ﴾ (العنكبوت: 9). جاء عنه (عليه السلام): “هم شيعتنا، ثبتوا على الحق في الفتنة، فكان جزاؤهم معنا في الآخرة“ ( تفسير العياشي، ج2، ص 254.)
المبحث الثاني: تصنيف التأويلات حسب موضوع الآية
تُظهر تأويلات الإمام علي بن محمد الهادي (عليه السلام) تنوّعًا في المضمون العقدي والروحي، وهي لا تقتصر على المعاني الظاهرة للنص، بل تتجاوزها إلى تحديد المصاديق الواقعية، والربط بين النص والواقع التاريخي أو العقائدي. وبالاستقراء، يمكن تصنيف هذه التأويلات ضمن أربعة محاور رئيسية:
أولًا: تأويلات مرتبطة بالآيات العقديّة
هذه التأويلات تعالج مفاهيم مركزية مثل الإيمان، الابتلاء، التوحيد، والجزاء، وتقدّم قراءة عقدية تنسجم مع منهج أهل البيت في ربط العقيدة بالفعل والسلوك.مثال: قوله تعالى: ﴿وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ﴾ (العنكبوت: 6)
جاء عن الإمام الهادي (ع): “الجهاد في طاعة الله، وثبات المؤمن على ولايتنا، هو جهاد النفس الذي ينجو به الإنسان“ التأويل: يربط الجهاد بالتكليف العقدي، لا القتال وحده، ويُسقِط الآية على الإخلاص في الولاية.
ثانيًا: تأويلات مرتبطة بأهل البيت (عليهم السلام)
هذه التأويلات تُسقط الآيات على مصاديق من الأئمة أو شيعتهم، وتُظهر مكانتهم في القرآن باعتبارهم حملة العلم والهدى. مثال: قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ﴾ (العنكبوت: 9)
قال الإمام: “هم شيعتنا، الذين ثبتوا على ولايتنا في زمن الفتنة، فاستحقوا أن يُقرنوا بنا في الجنة“.التأويل: يُعطي للآية مصداقًا واضحًا في الولاية والولاء.
ثالثًا: تأويلات تتعلق بالمنافقين وأعداء الدّين
غالبًا ما تكشف هذه التأويلات عن أشخاص أو تيارات ناصبت العداء لأهل البيت، وتُظهر كيف يُصنَّف المنافق ضمن النص القرآني. مثال: قوله تعالى: ﴿فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ﴾ (العنكبوت: 10)
قال الإمام: “هم من أظهروا الإيمان خوفًا، ثم رجعوا عند أول ابتلاء، فكانوا أشد ضررًا من أعدائنا الظاهرين“
التأويل: يُسقِط الآية على فئة مدعية للإيمان تخون عند الفتنة، وهي سمة للمنافقين المعروفين في تاريخ الصراع مع أهل البيت.
رابعًا: تأويلات تتعلق بالمستقبل والغيب
بعض الروايات تتحدث عن مصاديق مستقبلية أو معانٍ غيبية لا تتضح من ظاهر النص، وتدل على علم خاص بالإمام. مثال: قوله تعالى:﴿وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ﴾ (العنكبوت: 11)
جاء في تأويله: “يكون ذلك عند قيام القائم منا، حيث يُظهر الله كل مدّعٍ على حقيقته“ التأويل: يربط الآية بمرحلة الظهور، ويجعل من التمييز بين الإيمان والنفاق حدثًا مستقبليًا ظاهرًا.
الفصل الرابع: التّحليل العقدي والتأويلي لتأويلات الإمام
المبحث الأول: خصائص التأويل عند الإمام الهادي (عليه السلام)
تأويلات الإمام الهادي (عليه السلام) تُظهر منهجًا عقديًا راسخًا قائمًا على اتصال علمي وروحي بالوحي، لا يقتصر على شرح المعنى الظاهري للآيات، بل يكشف أبعادها الباطنيّة ومقاصدها العميقة المرتبطة بالهداية والولاية. ويمكن تلخيص أبرز خصائص هذا المنهج التأويلي في ثلاث نقاط مركزية:
أولًا: الربط بين الظاهر والباطن
لا يُهمل الإمام ظاهر الآية، بل يُثبت معناها الظاهري ثم يُجاوز إلى معناها الباطني. التأويل ليس نفياً للظاهر بل تعميق له. مثال: في قوله تعالى: ﴿مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ﴾ (العنكبوت: 41)، يقر الإمام بمعنى الآية الظاهري المتعلق بالشّرك، ثم يربط الباطن بمن أعرض عن ولاية أهل البيت واتبع أئمة الجور، مشبّهًا ذلك ببيت العنكبوت من حيث الضعف والانهيار (الصفار، 1983، ص 212).
هذا الربط يُظهر أن المعنى الباطني لا يُلغِي الظاهر، بل يُكمله ويُسلّط عليه ضوءًا جديدًا يُثبّت المعنى ويُوجّه الفكر نحو مصداقه الحقيقي.
ثانيًا: بيان مصاديق أهل الحق والباطل
يتميّز منهج الإمام الهادي (عليه السلام) في التأويل بقدرته على تحديد المصاديق الواقعية للنصوص. الآيات لا تُترك عامة، بل تُسقَط على شخصيات أو فئات معينة، تُجسّد الخير أو الشر، الإيمان أو النفاق. مثال: قوله تعالى: ﴿فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ﴾ (العنكبوت: 10)، أوّله الإمام في أشخاص أظهروا الإيمان وادّعوا الولاء، ثم انقلبوا عند الفتنة، فكانوا في الباطن من أعداء الخط الرسالي رغم مظهرهم الديني (المفيد، 1993، ص 279).
هذه المصاديق تُرسّخ في عقل المؤمن مواقف واضحة، وتؤكد أن النص القرآني ليس مجرّدًا بل موجّهًا وحيًّا.
ثالثًا: تفسير الآيات من زاوية الإمامة والولاية
الإمام الهادي (عليه السلام) يُعيد توجيه المعنى القرآني نحو محوريْن:
- إثبات الإمامة كامتداد للنبوة
- كشف الانحراف عن الولاية بوصفه مصدرًا للضلال. مثال: في تأويل قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ﴾ (العنكبوت: 9)، أشار الإمام إلى أن المقصود هم الشيعة المتمسكون بالولاية في زمن الفتنة، فيكون الإيمان الصادق مقرونًا بولاء أهل البيت، لا بالقول المجرد أو العمل الظاهري (العياشي، 1991، ج2، ص 254).
بهذا يؤسس الإمام لمبدأ قرآني محوري في الفكر الإمامي، وهو أن الولاية شرط في القبول الإلهي، وأن الآيات تتحدث عن ذلك وإن لم تُصرّح بالأسماء.
المبحث الثاني: أثر تأويلات الإمام على الفهم الإمامي للسورة
تأويلات الإمام علي بن محمد الهادي (عليه السلام) لا تُفسر سورة العنكبوت تفسيرًا تقليديًا، بل تُعيد بناء فهم عقدي شامل لها. وهي تُقدِّم قراءة إمامية مترابطة تُبرز العلاقة بين النص القرآني والواقع الإيماني، وتُظهر دور الإمام في توجيه الوعي الديني نحو الولاء، والثبات، والبصيرة. وتتمثل أبرز آثار هذه التأويلات في المحاور الآتية:
أولًا: تعزيز مفهوم الابتلاء كوسيلة للتمييز بين المؤمن والمنافق
سورة العنكبوت تبدأ بآيات توضح أن الإيمان لا يُقبل إلا بعد الفتنة. تأويل الإمام الهادي (عليه السلام) يُثبّت هذا المعنى ويمنحه بعدًا واقعيًا من خلال إسقاطه على فئة محددة من الناس الذين أظهروا الإيمان ثم ارتدوا عند المحنة.
الرواية: في تفسير الآية ﴿فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ﴾ (العنكبوت: 10)، قال الإمام: “هؤلاء ممن تظاهر بالحب، فلما ابتُلوا انكشف نفاقهم“ المفيد، 1993، ص 279. الأثر العقدي: هذه القراءة تُرسّخ في العقيدة الإمامية أن الثبات على الولاية هو المعيار الحقيقي للإيمان، لا مجرد التلفّظ أو الانتماء الظاهري.
ثانيًا: توضيح موقع أهل البيت (عليهم السلام) في الآيات
الإمام لا يقرأ الآيات بمعزل عن مقام أهل البيت، بل يُبرز ارتباط النص بمصاديق الولاية والإمامة، ويُعيد توجيه معنى الإيمان نحو الولاء الواقعي.
الرواية: في قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ﴾ (العنكبوت: 9)، ورد عن الإمام: “هم شيعتنا المخلصون، ثبتوا معنا حين خذلنا الناس“ العياشي، 1991، ج2، ص 254.
الأثر العقدي: يرسّخ أن “العمل الصالح” يشمل التمسك بالإمامة، وأن “الإيمان” لا يتمّ من دون ولاية أهل البيت، وهو ركن مركزي في العقيدة الإمامية.
ثالثًا: البعد الغيبي في تأويلات الإمام
يتضمن تأويل الإمام إشارات إلى أحداث مستقبلية أو حقائق غيبية، تدل على علم لدني خاص لا يتوفر لغير المعصوم، وتُبيّن أن بعض الآيات لا تنكشف مصاديقها إلا بمرور الزمن.
الرواية: في تأويل قوله تعالى: ﴿وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ﴾ (العنكبوت: 11)، قال الإمام: “يظهر ذلك في زمن القائم منا، حيث يتمايز الناس على الحقيقة“ الصفار، 1983، ص 213.
الأثر العقدي: يربط الآيات بالظهور المهدوي، ويُبرز أن القرآن حي، يرتبط بالزمن والتاريخ، وأن تأويله يتجلى في مراحل متقدمة من الوعي الإيماني والتمحيص الإلهي.
الفصل الخامس: مقارنة وتحليل ختامي
المبحث الأول: مقارنة بين التأويل الإمامي والتفسير الظاهري
يُظهر التأويل الإمامي للنص القرآني اختلافًا جوهريًا عن التفسير الظاهري الذي يعتمد غالبًا على اللغة، والسياق التاريخي، والمأثور الظاهري. في هذا المبحث تُستعرض أمثلة تطبيقية من سورة العنكبوت تُظهر الفرق بين المدرستين، ثم يُوضّح كيف تؤثر هذه الرؤية في الفهم العقدي والمعرفي للنص.
أولًا: أمثلة من آيات مختارة
الآية الأولى:﴿فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ﴾ (العنكبوت: 10)
- التفسير الظاهري:تفسير الطبري يرى أن الآية تتحدث عن المؤمن الضعيف الذي إذا تعرّض للأذى في سبيل الله، عدَّ ذلك أشد من عذاب الله نفسه، فترك الدين (الطبري، 2002، ج20، ص 178).
- التأويل الإمامي: الإمام الهادي (ع) يُسقِط الآية على فئة منافقة تظاهرت بالإيمان والولاء، لكنها كشفت حقيقتها عند أول اختبار، فظهر باطنها الفاسد (المفيد، 1993، ص 279).
الآية الثانية: ﴿مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنكَبُوتِ﴾ (العنكبوت: 41)
- التفسير الظاهري: فسرها الفخر الرازي بأنها مثال على ضعف الشرك، لأن العنكبوت تبني بيتًا ضعيفًا لا يقي من شيء، كما أن الشرك لا يجلب نفعًا ولا يدفع ضرًا (الرازي، 1999، ج21، ص 85).
- التأويل الإمامي: في رواية عن الإمام الهادي، هذه الآية تُشير إلى من أعرض عن ولاية أهل البيت واتبع أئمة الجور، فجعل لنفسه ولاءً باطلًا لا ينفعه في الدين (الصفار، 1983، ص 212).
ثانيًا: الفروقات في الرؤية والتأويل
| الجانب | التفسير الظاهري | التأويل الإمامي |
| المصدر | اللغة والمأثور والسياق | علم الإمام وعصمته ومقامه |
| الأسلوب | شرح معنى مباشر | كشف المعنى الباطني وربطه بالمصاديق |
| المضمون العقدي | عام ومجرّد | محدد ومرتبط بالولاية والإمامة |
| الغاية | الفهم اللغوي والتربوي | الهداية عبر مصاديق حقيقية وعقدية |
ثالثًا: نتائج الفهم المختلف للنص القرآني
- في التفسير الظاهري: يُركَّز على الهداية العامة، والموعظة الأخلاقيّة، والتاريخ الديني، من دون تحديد مصاديق دقيقة، ما يترك النص مفتوحًا للاحتمالات والتأويلات الشّخصيّة.
- في التأويل الإمامي: يُوجَّه النص نحو البنية العقدية الصحيحة، وربطه بالواقع التاريخي للأئمة وخصومهم، مما يثبت الحق ويكشف الباطل، ويُخرج الآية من المجاز إلى المصاديق.
- في الأثر الإيماني: التأويل الإمامي يُعمّق الالتزام بالولاية، ويجعل من كل آية موقفًا عمليًا يربط الفرد بالمشروع الإلهي المتمثل في الإمامة.Bottom of Form
المبحث الثاني: النتائج والتوصيات
أولًا: أبرز النتائج المستخلصة
- الإمام الهادي (عليه السلام) مارس دورًا تأويليًا واعيًا ومقصودًا: تأويلاته لا تتعلق بتفسير لغوي، بل تكشف عن باطن النص ومصاديقه الواقعية المرتبطة بالعقيدة، والولاء، والتمحيص.
- سورة العنكبوت تحتل موقعًا محوريًا في الفهم الإمامي للعقيدة: تبيّن السورة سنة الابتلاء، وتُظهر الفرق بين الإيمان الظاهري والحقيقي، وقد أبرز الإمام ذلك بوضوح.
- التأويلات المنسوبة للإمام الهادي (عليه السلام) تندرج في أربعة محاور
- التأويل العقدي
- إسقاط النص على أهل البيت وشيعتهم
- كشف النفاق والارتداد
- الربط بين الآيات والغيب والمستقبل
- المنهج التأويلي للإمام قائم على التوازن بين الظاهر والباطن: لا يلغي المعنى الظاهري بل يُكمّله بمصداق يربط النص بالعقيدة والسلوك.
- الفهم الإمامي للنص القرآني يختلف جوهريًا عن التفسير الظاهري: تُقدّم مصاديق واضحة ومحددة تتجاوز الشرح اللغوي إلى تحديد الموقف العملي والإيماني.
ثانيًا: مساهمة البحث في التفسير الإمامي
- يُعد أول دراسة تفصيليّة مستقلة تجمع تأويلات الإمام الهادي (عليه السلام) لسورة واحدة كاملة.
- يُسلّط الضوء على الجانب التأويلي في شخصيّة الإمام، ويُعيد موقعه ضمن سلسلة الأئمة المفسرين.
- يُقدّم نموذجًا تطبيقيًا للفهم العقدي القرآني وفق المدرسة الإماميّة.
- يُظهر كيف يُستخدم النص القرآني في ترسيخ مفاهيم الإمامة والولاية والتّمحيص الواقعي للمؤمنين.
ثالثًا: توصيات لمزيد من الدراسات
- إجراء دراسات مستقلة لسائر تأويلات الإمام الهادي (عليه السلام):مثل تأويله لسور أخرى كيس، والأنفال، والقصص، وتحليلها ضمن الإطار العقدي.
- توسيع البحث إلى تأويلات باقي الأئمة (عليهم السلام) بشكل تخصصي: وتخصيص كل دراسة لسورة معينة، مع توثيق الرّوايات وتحليلها منهجيًا.
- إعداد موسوعة تحليلية لتأويلات أهل البيت (عليهم السلام):تجمع التّأويلات المتفرقة، وتُصنّفها موضوعيًا، مع فهرسة عقديّة وفكريّة.
- مقارنة شاملة بين التفسير الإمامي والرؤى التفسيريّة الأخرى: خصوصًا في السّور التي تتضمن مفاهيم الولاية، النفاق، الابتلاء، والغيب.
- إدخال هذا النمط من الدّراسات في مناهج التعليم العالي: خاصة في كليات علوم القرآن والدراسات العقديّة، لما فيها من تأصيل للفهم التفسيري المعتمد على روايات المعصومين.
المصادر
القرآن الكريم
- ابن منظور، م. ب. م. (1994). لسان العرب (ج1، ص 213). بيروت: دار إحياء التراث العربي.
- الأنصاري، م. ب. (2005). الإمام الهادي (ع): حياته، علمه، ومواقفه. قم: مركز الأبحاث العقائدية.
- الريشهري، م. (2000). ميزان الحكمة (ج1، ص 514). بيروت: دار الحديث.
- الزركشي، ب. ع. (1988). البرهان في علوم القرآن (ج1، ص 238). القاهرة: دار المعرفة.
- الصفار، م. ب. ع. (1983). بصائر الدرجات (ص 148، 212–214). قم: مكتبة آية الله المرعشي.
- الطباطبائي، م. ح. (1997). الميزان في تفسير القرآن (ج3، ص 24). بيروت: مؤسسة الأعلمي.
- الطبري، م. ج. (2001). جامع البيان في تأويل آي القرآن (ج30، ص 302). بيروت: دار الفكر.
- الطبري، م. ج. (2002). جامع البيان في تأويل آي القرآن (ج20، ص 172–185، ص 178). بيروت: دار إحياء التراث العربي.
- العياشي، م. ب. م. (1991). تفسير العياشي (ج2، ص 253–256). طهران: المكتبة العلمية.
- الفضلي، ع. ه. (2001). القرآن عند الإمام الصادق (ع). بيروت: دار المرتضى.
- الفاضل اللنكراني، م. ف. (1997). تفسير نور الثقلين (ج4، ص 313–320). قم: مؤسسة النشر الإسلامي.
- القرضاوي، يوسف. (1996). مدخل لدراسة السور القرآنية (ص 119–124). القاهرة: مكتبة وهبة.
- الكليني، م. ب. ي. (1985). الكافي (ج1–ج3). طهران: دار الكتب الإسلامية.
- القمي، ع. (2008). تفسير القمي. بيروت: دار الأضواء.
- المفيد، م. ب. ن. (1993). الاختصاص (ص 278–280). قم: جماعة المدرسين.
- الواحدي، ع. ح. (1991). أسباب النزول (ص 401). بيروت: دار الكتب العلمية.
- السيوطي، ج. ب. د. (2001). الدر المنثور في التفسير بالمأثور (ج6، ص 225). بيروت: دار الفكر.
- الرازي، ف. (1999). التفسير الكبير (ج21، ص 85). بيروت: دار إحياء التراث العربي.
- مجلة دراسات قرآنية. (2012). “أثر الأئمة في تفسير القرآن”. مجلة دراسات قرآنية، (11)، 85–96.
- معرفت، م. ه. (1998). تفسير أهل البيت: عرض وتحليل. قم: مركز النشر الإسلامي.
[1]– قسم الإلهيات والمعارف الإسلاميّة جامعة الشهيد رجائي لتدريب المعلمين
-Department of Theology and Islamic Knowledge, Shahid Rajai University for Teacher Training. Email: Abdelfattahnajm@st.tu.edu.iq