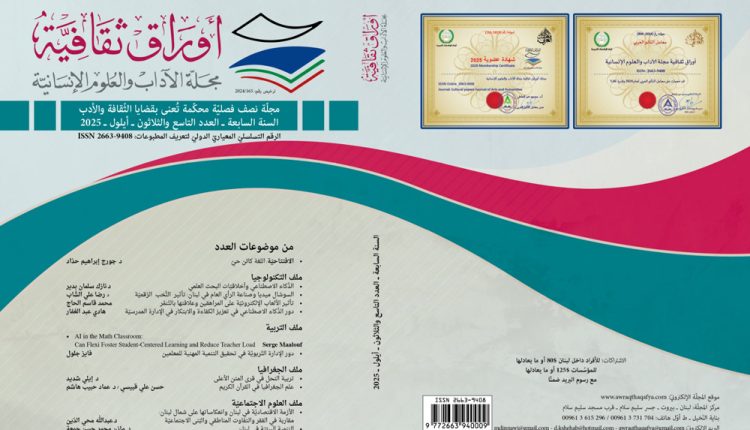عنوان البحث: الزّمن والشّعور في قصيدة "يا ستّ الدّنيا يا بيروت" لـ"نزار قباني"
اسم الكاتب: د. نعيمة حسين شكرون
تاريخ النشر: 2025/09/15
اسم المجلة: مجلة أوراق ثقافية
عدد المجلة: 39
تحميل البحث بصيغة PDFADOI: https://aif-doi.org/awraq/013907
الزّمن والشّعور في قصيدة “يا ستّ الدّنيا يا بيروت” لـ”نزار قباني”
Time and Feeling in the Poem “O Lady of the World، O Beirut” by Nizar Qabbani
Dr. Naima Hussein Shakroun د. نعيمة حسين شكرون)[1](
تاريخ الإرسال: 6-8-2025 تاريخ القبول: 18-8-2025
الملخص
تشكّل قصيدة “يا ست الدّنيا يا بيروت”([2]) لنزار قباني نموذجًا شعريًا فريدًا يتقاطع فيه الزّمان بالشّعور، وتتداخل فيه الذّات الشّاعرة مع المدينة/الرّمز، فتغدو بيروت انعكاسًا لانكسار الذّات والتّوق للخلاص. إنّ دراسة الزّمن والشّعور في هذا النّص تسعى إلى سبر أغوار التّجربة الشّعريّة، من خلال تتبّع انسياب الزّمن وتحوّلاته، وتمثّلات الشّعور من خلال بنية رمزيّة وشكل تعبيري مشحون بالحنين، والأسى، والرّغبة في الانعتاق.
الكلمات المفتاحيّة: نزار قباني، يا ست الدّنيا يا بيروت، بيروت، الحرب الأهلية اللبنانيّة، الزّمن الشّعري، الشّعور، سيمياء العنوان، الحالة الشّعورية، الأنا والآخر، صورة المدينة، الرمز، الأسطورة، الذاكرة الجمعية، الانتماء والهويّة، اللغة الانفعالية.
Résumé
Le poème «Ô dame du monde, ô Beyrouth» de Nizar Kabbani se présente comme un modèle poétique singulier où le temps et le sentiment s’entrecroisent, et où la voix poétique se fond dans la ville/ symbole. Beyrouth y apparaît comme le miroir de la fracture intérieure et de l’aspiration à la rédemption. Cette étude، centrée sur l’articulation du temps et du sentiment dans le texte, se propose d’explorer en profondeur l’expérience poétique en suivant le flux et les mutations temporelles, ainsi que les manifestations affectives, au sein d’une architecture symbolique et d’une forme expressive imprégnée de nostalgie, de douleur et d’élan vers la libération.
Mots-clés
Nizar Kabbani, Ô dame du monde, ô Beyrouth, Beyrouth, guerre civile libanaise, temps poétique, sentiment, sémiotique du titre, état émotionnel, moi et l’autre, image de la ville, symbole, mythe, mémoire collective, appartenance et identité, langage émotionnel.
إشكاليّة البحث
تشكّل قصيدة “يا ستّ الدّنيا يا بيروت” لنزار قباني نموذجًا شعريًا مركّبًا تتقاطع فيه الأبعاد الشّعوريّة والزّمنيّة داخل نسيج لغوي رمزيّ كثيف. فالقصيدة لا تكتفي بتوصيف كارثة بيروت، بل تحوّلها إلى مرآة داخليّة تعكس تمزّق الذّات وتشوّش الزّمن وفقدان المعنى.
من هنا تنبثق إشكاليّة هذا البحث والتي يمكن صياغتها على النّحو الآتي:
كيف تتجلى العلاقة بين الزّمن والشّعور في قصيدة “يا ستّ الدّنيا يا بيروت”؟
وإلى أيّ حدّ استطاع نزار قباني أن يعبّر، من خلال البنية الرّمزيّة والصّور الشّعريّة، عن انهيار الزّمن النّفسي وتشظّي الشّعور في ظل الحرب والخذلان؟
وتتفرّع عن هذه الإشكاليّة جملة من الأسئلة الفرعيّة:
- ما هو التّصور الذي يقدّمه نزار قباني عن الزّمن في القصيدة، وكيف يتوزع بين الماضي والحاضر والمستقبل؟
- كيف تتشكّل البنيّة الشّعوريّة للنّص؟
3.ما الدّور الذي تؤديه الرّموز والصّور الشّعريّة في تجسيد هذا التّوتر بين الزّمن والشّعور؟
فرضيّة البحث
ينطلق هذا البحث من فرضيّة أساسيّة مفادها أنّ قصيدة “يا ست الدّنيا يا بيروت” لنزار قباني تبني رؤيتها الشّعريّة من خلال تضافر عنصرين مركزيين هما: الزّمن والشّعور، إذ يتموضع الزّمن في بنية القصيدة بوصفه إطارًا دلاليًا متشظيًا يتقاطع فيه الماضي والراهن والمستقبل، في حين يُعاد تشكيل الشّعور بوصفه بنية دلاليّة معقّدة تتراوح بين الانتماء والخذلان، الأمل واليأس، والحبّ والخراب.
وتفترض الدّراسة أنّ هذا التّداخل البنيوي بين الزّمن والشّعور لا يكتفي بالتّعبير عن واقع المدينة المتأزم فحسب، بل يُعيد إنتاج بيروت كرمز شعري متعدّد الدّلالات، تتقاطع فيه الذات الشّاعرة مع الجماعة، والتّاريخ مع العاطفة، واللغة مع الذاكرة. ومن هنا، فإنّ فهم دلالات الزّمن والشّعور في القصيدة يُفضي إلى كشف طبيعة الرؤية الوجوديّة والجماليّة التي تحكم بناء النّص، وتحولاته التّعبيريّة والدّلاليّة.
أهمية البحث
تنبع أهمية هذا البحث من كونه يتناول قصيدة مفصليّة في التجربة الشّعريّة لنزار قباني، تمثل انعكاسًا شعريًا عميقًا لتحولات مدينة بيروت في لحظة تاريخيّة حرجة من الحرب الأهليّة، فتتداخل الأبعاد الذاتيّة بالجمعيّة، والسياسيّة بالوجدانيّة. وتكمن الأهميّة الفكريّة والمعرفيّة للبحث في مقاربته للقصيدة من منظور مزدوج يتكئ على تحليل عنصريّ الزّمن والشّعور، بوصفهما مكوّنين جوهريين في تشكيل البنية الدّلاليّة والانفعاليّة للنص.
وتسهم هذه الدّراسة في كشف كيفيّة تحويل الزّمن الشّعري إلى أداة لتوثيق الذاكرة والانكسار، وعن دور الشّعور في التعبير عن الاغتراب الفردي والجمعي داخل سياق المدينة الجريحة. وتكتسب هذه المقاربة أهمّيّة إضافيّة من خلال اعتمادها على المنهج التداولي الذي يفتح أفقًا جديدًا لفهم علاقة الذات الشّاعرة بالمدينة المتشظية، وتشكّل الوعي الشّعري تجاه المكان والحدث والهُوية.
وتأتي أهمية البحث أيضًا من سعيه إلى إضاءة الجماليات التّعبيرية والرّمزيّة التي تنطوي عليها القصيدة، وإلى إبراز البنية الشّعوريّة للخطاب الشّعري العربي الحديث، بوصفه خطابًا يتجاوز البُعد الجمالي إلى الوظيفة التوثيقيّة والوجدانيّة في آنٍ معًا.
أهداف البحث
يهدف هذا البحث إلى تحليل العلاقة بين الزّمن والشّعور في قصيدة “يا ست الدّنيا يا بيروت” لنزار قباني، من خلال تتبع تشظيات الزّمن بين الماضي والحاضر والمستقبل، واستكشاف تجليات الشّعور الفردي والجمعي في سياق المدينة المدمّرة والمحبوبة. ويسعى إلى كشف الأبعاد الرّمزيّة للزّمن في النّص، ودوره في تشكيل البنية الشّعوريّة وتحميلها كثافة وجدانيّة وتاريخيّة. ويركز البحث على تحديد وظيفة الانفعال والعاطفة في الخطاب الشّعري، من خلال تحليل صوت الشّاعر وموقفه من الحرب والانتماء والاغتراب، إضافةً إلى دراسة سيميائيّة العنوان وشخصنة بيروت بوصفها أنثى، بما يحمله ذلك من إسقاطات شعوريّة وزمنيّة معقّدة. كما يطمح البحث إلى مقاربة تحولات الشّعور بالذات والآخر عبر منظور تداولي تأويلي سيميائي يربط البنية الشّعريّة بالسياق الثقافي والتاريخي للقصيدة.
المنهج المتبع في الدّراسة
يعتمد هذا البحث على المنهج التداولي التأويلي، وهو منهج يجمع بين تحليل البنية اللغوية والدّلالية للنص([3])، وبين تأويل المقاصد الشّعورية والسّياقات التّواصليّة والرّمزيّة، ” فاللغة وما تحمله من معنى تهدف إلى ممارسة التّأثير الفعلي في غيرنا، بالإضافة إلى الفهم والتّمثيل، فمن بدون لغة لن نستطيع التّأثير في الآخرين، فهي جزء من نشاط وطريقة حياة”([4]).
ويقوم هذا المنهج على تتبّع التّفاعل بين الشّاعر والنص والمتلقي، “فمهمة التّداوليّة أن تتيح صياغة شروط إنجاح العبارة”([5])، ولا يتوقف الأمر عند هذا الحدّ، إنما تُوظَّف اللغة في سياقاتها الزّمنية والشّعورية، مثل التّأثير في الآخرين وحملهم على تغيير مواقفهم، “وهذا الفعل يقتضي الاستشارة وتبادل الآراء والأخذ بوجهات النّظر المختلفة”([6]).
ويولي التّداول اهتمامًا خاصًا للتّفاعل في هذا البحث من خلال تمثّل الزّمن وتجلّي الشّعور عبر اللغة الشّعريّة، بما في ذلك استعمال الرّموز، والإيحاءات، والصّور البيانيّة، وتشكيل بنية الخطاب.
كما يستفيد البحث من أدوات السيميائيّة الشّعريّة لتحليل دلالات العنوان والرموز، ومن أدوات التحليل النفسي– الوجودي في فهم تمزقات الذّات وتشظي الشّعور عبر الزّمن، ولأنّ القصيدة مشبعة بالتوتر الشّعوري والتّحولات الزّمنيّة، كان لا بدّ من منهج قادر على التقاط البعد الانفعالي والسّياقي للغة، فالمنهج التّداولي يعمل على ربط البنية النّصيّة بالحالة الوجدانيّة للذات الشّاعرة، انطلاقً من أسئلة محوريّة تشكل نسيجًا للتداول من خلال الإجابة على الأسئلة الآتية: “من يتكلّم؟ وإلى من يتكلّم؟ ماذا نقول بالضّبط حين نتكلّم؟ كيف نتكلّم بشيء ونريد قول شيء آخر؟ هل يمكننا أن نركن إلى المعنى الحرفي لقصد ما؟”([7]) ما يتيح تأويلًا أكثر عمقًا لتجربة بيروت، وإبراز سيمياء الزّمن والشّعور ضمن خطاب شعري يتجاوز المعنى المباشر إلى المعنى التأويلي المركّب، الذي يرتكز على مبادئ ” تحكم تأويل العلامات…انطلاقًا من سياق القول والظّروف”([8]).
أولاً: الزّمن والشّعور
يتأسّس التوتر الجمالي والمعنوي في القصيدة على جدليّة الزّمن المتشظي، والشّعور المتحوّل، ولأنّ فهم التّجربة الشّعريّة يستوجب تموضعًا نظريًا صلبًا، ينبغي الإضاءة على هذين المفهومين من منظور أدبي وفلسفي، مع تمظهرهما في هذه القصيدة.
تعريف الزّمن
عرّف ابن منظور الزّمن أنّه: “اسم لقليل الوقت وكثيره. والزّمن والزّمان (العصر)، والجمع أزمن وأزمنة، وزمن زامن: شديد، وأزمن الشيء: طال عليه الزّمان، والاسم من ذلك الزّمن والزّمنة، وأزمن في المكان: أقام له زمانًا، والزمان يقع على الفصل من فصول السنة، ويقع على مدة ولاية الرجل وما أشبهه”([9]).
الزّمن هو الوقت الذي نقيس به ماضينا وحاضرنا ومستقبلنا، إنّه الثانية والدّقيقة والسّاعة واليوم والليل والنّهار والشّهر والسّنة والعقد والقرن والأجل والأمد…
ولقياس الزّمن مواقيت تختلف وتتعدد، هو الحركة الفاعلة في الوجود، ولا يمكن للإنسان أن يعيش خارج إطاره، فمعه يتغير ويتفاعل ويتحول، يرتبط به أشدّ ارتباط، ولا يفصله عن آلة الزّمن إلا الموت، وحتى بعد الموت يؤرخ لوفاته.
وفي النصوص الأدبية، لا يُنظر إلى الزّمن بوصفه مجرد تسلسل كرونولوجي للأحداث، بل بوصفه بنية شعريّة قابلة للتشكيل والانزياح. الشّعر لا يحاكي الزّمن الواقعي، بل يعيد خلقه وفق منطق داخلي خاص: في لحظة قد يمتد الزّمن ويتكثّف، وفي لحظة أخرى ينكسر ويتجزأ، فـالزّمن في الشّعر هو زمن يصنعه الشاعر، مخالفًا فيه الزّمن الطّبيعي الذي لا يخرج عن تلك الخطّية المعهودة، إذ “أصبح الشّعر هو الإنسان ذاته في استباقه العالم الرّاهن، وتوقّع العالم المقبل”([10])
وفي الشّعر، يغدو الزّمن أكثر ذاتيّة وتأويلًا، فيتجلّى كذاكرة، وكأمل، فهو “مغامرة في الكشف والمعرفة، ووعي شامل للحضور الإنساني”([11]).
ومع تجارب الشّعر الحديث، لم يعد الزّمن محايدًا، بل أصبح جزءًا من المعاناة الإنسانيّة والوعي القومي والوجودي، فتتوالد الأزمنة في النّص الشّعري من داخل الذّات، لا من خارجه، والماضي يستعاد لا كتأريخ، بل كحنين أو حسرة، والحاضر يُعاش بقلق ورفض، وأمّا المستقبل فيُستشرف بأمل ضئيل أو تشاؤم كلي، فـ” الشّاعر العربي المعاصر لا يكتب في فراغ، بل يكتب ووراءه الماضي وأمامه المستقبل”([12]).
في قصيدة “يا ست الدّنيا يا بيروت”، نُلاحظ هذه الأبعاد كلها: إذ تتأرجح القصيدة بين ماضٍ جميل، وحاضر مدمَّر، ومستقبل غامض، فينقسم الزّمن ذاته بين زمنيّة مدينة وزمنيّة شعور، بين الذاكرة والحسّ المباشر.
تعريف الشّعور
الشّعور من الفعل “شعر”: أي أحسّ، والشّعور يتعلّق إلى حدّ كبير بالحالة النّفسيّة للإنسان، وهو ذلك الجزء من العمليّات العقليّة التي نحسّها، وندركها، ونعيها، وعادة ترتبط بحالة وجدانية انفعاليّة([13])، والشّعور يختلف ويتراوح ما بين الحبّ والكره والبغض والألم والغضب والنّدم…
وتدفّق الشّعور حالة وجدانيّة تصاحب الفرد في لحظات تترك فيه أثرًا وتجعله يتفاعل مع محيطه ومع مؤثرات معينة طغت على كيانه، فيتدفّق السّيل الشّعوري ومضات شتّى تختلف وتتباين.
ويرتبط الشّعور في الشّعر بجملة من العمليّات المعقّدة: الإدراك، الانفعال، التّخييل، والتّعبير. ولا يمكن اختزال الشّعور في كونه “عاطفة”، بل هو تجربة وجدانية–جمالية، تصوغها الذات ضمن بنية لغويّة مشحونة، تكشف رؤيا الشّاعر الشّخصيّة الفريدة([14]).
والشّعور هو تَجسيدٌ للعالم في الذات، أيّ أنّ الإنسان لا يشعر فقط، بل يندمج في شعوره، ويمنحه شكلًا حسّيًا أو لغويًا أو رمزيًا. وفي الشّعر، يتحول الشّعور إلى نصّ حيّ ينبض بالذّات والجماعة، “وعندما يتحدث الشّاعر إلى ذاته من خلال صفاء معرفته بها، فإنَه يصل بحديثه إلى الآخرين، كلّ الآخرين”([15]).
ومن منظور تداولي، يرتبط الشّعور بالزّمن بشكل عضوي، فالحنين يرتبط بالماضي، والألم والخسارة بالحاضر، والرجاء أو اليأس بالمستقبل.
وهذا الربط يُمكّننا من قراءة البنية الشّعوريّة للقصيدة كخريطة وجدانيّة–زمنيّة، تتقاطع فيها الذّكريات بالانفعالات، والمصائر بالعواطف.
ثانيًا: سيمياء العنوان – بيروت والأنثى والرّمز
يُعد العنوان في النص الشّعري الحديث بوابة تأويليّة، فـ”لا تكون إرادة العنوان أو مقصديته إلا من خلال إرادة المبدع صاحب النّص”([16]). وهو يحمل كثافة دلاليّة لا تقل أهمّيّة عن جسد النّص، وقد يختصر في ألفاظه القليلة فكر النّص، وحالته النّفسيّة، وتمثّلاته الزّمكانيّة، “هو لافتة دلاليّة ذات طاقات مكتنزة، ومدخل أوّلي لا بدّ منه لقراءة النّص”([17]).
في قصيدة “يا ست الدّنيا يا بيروت”، يؤدي العنوان دورًا مركزيًا في صياغة أفق القراءة، من خلال ما يطرحه من شحنات رمزيّة وشعوريّة، ترتبط بمفهومي الزّمن والذات، فالتركيب اللغوي للعنوان “يا ست الدّنيا يا بيروت” يحمل طابعًا نِدائيًا مزدوجًا:
- “يا ست الدّنيا”: تركيب نِدائي يفيد التّبجيل، ويُشحن بعاطفة مُفرطة.
- “يا بيروت”: نداء مباشر إلى المدينة، تتماهى فيه المكان بالأنثى، والأنثى بالرّمز. والنّداء المكرّر يوحي بانفعال داخلي مُتصاعد، ويشي بانكسار الذّات أمام رمزيّة بيروت. فالتكرار ليس للتأكيد فقط، بل هو صرخة وجوديّة تستنجد بالمدينة–الرّمز. والوظيفة السّيميائيّة لحرف النداء “يا” تظهر الاستعطاف المحمل بشحنات عاطفيّة مليئة بالانفعال والرجاء، تستكمل مع المنادى “ست الدّنيا” في إشارة إلى التّمجيد والتّبجيل (تأنيث رمزي)، مع بوح صارخ واعتراف بالحبّ والتّقديس، مضاف إليه نداء “يا بيروت” في إشارة سيميائيّة إلى التّعيين المكاني مشجونًا بالرّمز الشّعوري الذي يصوّر الحنين والألم والاستدعاء.
وبيروت ليست فقط مدينة جغرافيّة، بل هي صورة استعاريّة للأنوثة العربيّة، وللهُويّة الجماعيّة المجروحة. وهي تُمثّل:
- المرأة – العشيقة: الحسناء الفاتنة التي أحبّها حدّ الوجع.
- المرأة – الأم: التي احتضنت الجميع، ثم انهارت، وتُركت تنزف.
- المرأة – الضحيّة: المذبوحة على مذبح الحرب.
وعبارة “ست الدّنيا” تشير إلى المرأة الأجمل، والأرفع، والأكمل، وهكذا كانت قبل الحرب الأهلية:
- عاصمة الجمال والحريّة.
- ملتقى المثقفين العرب.
- مركز إشعاع ثقافي وحضاري.
لكن المفارقة أنّ الشاعر يُعيد هذا التوصيف بعد سقوط المدينة في الحرب، ما يمنح العنوان طابعًا مريرًا: إذ إنّ “ست الدّنيا” لم تعد كذلك، بل صارت أنقاضًا ومعاناة.
وتجدر الإشارة إلى أنّ العنوان يحمل شفرات تؤسّس لقراءة العلاقة المعقّدة بين الزّمن والشّعور في القصيدة:
- زمن العنوان: يحيل إلى الماضي المُشرِق (بيروت كـ”ست الدّنيا”)، لكنه يُقال في لحظة خراب، ما يُنتج مفارقة شعوريّة.
- شعور العنوان: يتراوح بين التّمجيد والانكسار، بين الحبّ والخذلان، ويؤسّس لشعور متأرجح يطغى على كامل النص.
وبذلك يكون العنوان “مفتاحًا شعريًّا” يُدخل القارئ في قلب التّجربة الشّعريّة، ويمهّد له الخطاب الزّمني المتشظي، والمزاج الشّعوري المعقّد الذي يحكم بنية القصيدة، إذ يشكّل العنوان “يا ست الدّنيا يا بيروت” بنية رمزيّة مركّبة، تقوم على تأنيث المكان وتقديسه، ثم الانكسار أمامه.
إنّ سيمياء العنوان لا تكتفي بدور تمهيدي، بل تؤدّي وظيفة تأويليّة مركزيّة، تفتح أمام القارئ أفقًا تأويليًا غنيًا يتقاطع فيه الزّمن بالشّعور، واللغة بالرمز، والذّات بالمدينة. ومن هنا، فإنّ العنوان يُمثّل قصيدة مختزلة، تنبئ منذ البدء بأنّ ما سيُقال في النّص ليس رثاءً لمدينة، بل مرآة لهُويّة ممزّقة وزمن ضائع.
ثالثًا: التّشظّي الزّمني بين الماضي والحاضر والمستقبل
يبدأ الشّاعر قصيدته باستفهام يليه أفعال ماضية تتوالى وتتواتر وتظهر هول ما حلّ ببيروت، إنّه يشبهها بامرأة جميلة فاتنة أسيء إليها بـ”من”. والأفعال الماضية هي: “باع – صادر – قصّ – ذبح – شطب – ألقى ماء النار – سمّم – رشّ الحقد”.
هذه الأفعال مقترنة بـ”من” الاستفهاميّة، ومن اسم استفهام للعاقل يحمّل فيه الشّاعر الإنسانَ المجهول الهُويّة هول ما حلّ ببيروت وبأساورها وخاتمها وضفائرها وعينيها ووجهها وشفتيها.
هذه الأفعال تدلّ على الخيانة والغدر والإساءة والموت، وتحمل في مضامينها الأذى، فبيروت كامرأة تئن وتتألّم وتعاني وتحتضر بسبب ما أقدمت عليه مجموعة من المتهورين الغادرين، وليس بسبب شخص مفرد بعينه :
“ها نحن أتينا… معتذرين.. ومعترفين
أنّا أطلقنا النار عليك بروح قبلية..
فقتلنا امرأة..كانت تدعى الحرية”
فالماضي يستكمل مع: “أتينا – أطلقنا – فقتلنا” لينهي الشّاعر مأساة بيروت بالقتل.
ويغيب الماضي عن بداية المقطع الثاني، ينتقل إثره الشّاعر إلى الحاضر مع الأفعال المضارعة: “نتكلم (3) – يفكر (3)- نتلاقى”. وتوالي هذه الأفعال يصوّر حالة الصّدمة التي يعيشها الناس المرتكبون وخصوصًا عندما اقترنت ب”ماذا” و”من”: ماذا نتكلم؟ – من كان يفكّر أن نتلاقى…”. كأنّ الفاعل والمقترف أحسّ بفعل النّدامة وحاول أن يلقي باللوم على الضحيّة “بيروت”:
“من أين أتتك القسوة يا بيروت،
وكنتِ برقّة حوريّة؟
لا أفهم كيف انقلب العصفور الدوري
لقطة ليل وحشية..
لا أفهم أبداً يا بيروت
لا أفهم كيف نسيتِ الله..
وعدتِ لعصر الوثنية”
بيروت تعرّضت لتلك الأهوال بسبب قسوتها، فهي أصبحت كالقطّة الوحشيّة بعد أن كانت كالعصفور الدّوري، لا بل يحمّلها أوزارًا ثقالًا ويحمل عليها، لقد نسيت الله وعادت لعصر الوثنيّة، ذلك كله هو ماض قريب سبب لها هذا الأذى وأحالها إلى الموت.
وفي المقطع الثالث يستجدي الشّاعر بيروت في فعل الأمر “قومي” وفي ذلك دلالة على الانبعاث بعد الموت كعشتار، كقصيدة ورد، أو كقصيدة نار، فبيروت تتخطّى الزّمان والمكان: “لا يوجد قبلك شيء..بعدك شيء…مثلك شيء..
أنت خلاصات الأعمار”.
والانبعاث من أجل كل شيء، ومن أجل الحبّ والشّعراء والخبز والفقراء، فبيروت مدينة الجميع، الحبّ يريدها، وحتّى الرّب يريدها.
ولا ذنب لها إن دفعت ضريبة حسنها كالحسناوات.
وفي المقطع الرابع يربط الشّاعر قيامة بيروت ببقاء الكثير: “العالم – نحن – الحب”:
“قومي من نومك..
يا سلطانة، يا نوارة، يا قنديلًا مشتعلًا في القلب
قومي كي يبقى العالم يا بيروت..
ونبقى نحن..
ويبقى الحب..”.
ويستكمل الشّاعر وصف الحاضر المخزي مع التوقف عند مفردة زمنيّة: “الآن” يحدّد معها الآثام التي ارتكبها الفاعلون “نحن”:
“الآن عرفنا ما معنى..
أن نقتل عصفورًا في الفجر
الآن عرفنا ما معنى..
أن ندلق فوق سماء الصّيف زجاجة حبر
الآن عرفنا..
أنّا كنّا ضدّ الله..وضدّ الشّعر”.
لقد وصل الأمر بـ”نحن” إلى حدّ الكفر والإلحاد “كنا ضدّ الله”، وتجدر الإشارة إلى أنّ عطف “ضد الشّعر” على “ضدّ الله” غايته السموّ بالشّعر والارتقاء به إلى مرتبة الألوهيّة.
ويستكمل الشّاعر وصف الحاضر في المقطع الخامس باعتراف بفعل الخطأ وارتكاب الجريمة والدّنس وكأنّ الفاعلين كالبدو الرّحّل الأميّين، القتلة، شهود الزور، وذلك كلّه يسجل اعترافًا أمام الله، تلك هي خطيئتهم، لم ينصفوها، ولم يعذروها، ولم يفهموها، هديتهم لها سكين، والآن عرفوا ماذا اقترفت أيديهم، يقول الشاعر:
“نعترفُ الآنَ ..
بأنّا لم ننصفْكِ .. ولم نعذُرْكِ .. ولم نفهمْكِ ..
وأهديناكِ مكانَ الوردةِ سِكّينا …
نعترفُ أمامَ اللهِ العادلِ …
أنّا راودناكِ ..
وعاشرناكِ ..
وضاجعناكِ ..
وحمّلناكِ معاصينا ..
ولا ريب أنّ هذا الاعتراف هو الحقّ :
“الآنَ عرفنا .. أنَّ جذوركِ ضاربةٌ فينا ..
الآنَ عرفنا .. ماذا اقترفتْ أيدينا” ..
ويستكمل الحاضر في المقطع السّابع مع الفعل المضارع “يفتش” الذي تكرر ثلاث مرات:
“الله يفتش في خارطة الجنّة عن لبنان
والبحر يفتّش في دفتره الأزرق عن لبنان
والقمر الأخضر..
عاد أخيرًا كي يتزوج من لبنان..”
وتستكمل الاعترافات:
“نعترف الآن..
بأنّا كنّا ساديين، ودمويين..
وكنّا وكلاء الشيطان”.
وتتوالى حركة الزّمن في نهاية المقطع السابع مع :
“قومي من تحت الردم، كزهرة لوز في نيسان
قومي من حزنك..
إنّ الثورة تولد من رحم الأحزان
قومي إكراماً للغابات..
وللأنهار..
وللوديان..
قومي إكراماً للإنسان..
إنّا أخطأنا يا بيروت..
وجئنا نلتمس الغفران”.
وقعت الحادثة، وحلّ الموت، والفاعلون يظهرون الندم والجزع أمام الفظائع التي ارتكبوها، وهم لذلك جاؤوا يعتذرون، ويلتمسون الغفران لعلّ ذلك يمحو خطاياهم ويعيد بيروت إلى سابق عهدها، إلى الحياة، كزهرة لوز في نيسان إكرامًا للغابات وللأنهار وللوديان، وحتى للإنسان، تلك هي القيامة في أسمى تجلياتها، وذلك هو مأمول الشّاعر في ثورة تولد من رحم الأحزان، ولا يكترث الشّاعر، كما يبدو لنا في المقطع الثّامن إن كانت بيروت مجنونة ونهر دماء وفوضى وجوع كافر، وشبع كافر، ولا يكترث إن كانت بيروت الظلم والسّبي والقاتل والشّاعر. فهو لا يزال يحبها ويعشقها إن ذبحته من الشّريان إلى الشّريان، ولا يزال يحبّها على الرّغم من حماقات الإنسان.
ويختم الشّاعر قصيدته بقوله: “لماذا لا نبتدئ الآن؟”، وهي صرخة يطلقها لكي يغيّر الحاضر المؤلم، ليطلّ على المستقبل بنافذة أمل وبريق حياة ليعدَّ أنّ كلّ ما حلّ ببيروت كان ماضيًا وإن موتًا، فالقيامة تعيد إليها مجدها وتبتدئ من نقطة اللاشيء واللاعودة، فالآن هي البداية، والماضي يجب أن يُطوى ويُنسى في دعوة مفتوحة على غدٍ مرسومٍ بريشة المتلقّي فتتجلى بأبهى صورها.
في قصيدة “يا ست الدّنيا يا بيروت”، لا يسير الزّمن وفق خطيّة تقليديّة، بل يُعاد تشكيله في بنية شعريّة تميل إلى التفتّت والتّشظي. الزّمن هنا ليس إطارًا سطحيًا للأحداث، بل جوهرًا شعوريًا ينعكس في اللغة والصورة والرمز، وتُعبّر القصيدة عن انهيار زمنيّ داخليّ، يوازي انهيار المدينة، ويحوّلها من مركزٍ للضوء والجمال إلى مسرح للدّمار والعنف، ومن هنا، تُصبح حركة الزّمن في النّص حركة داخليّة للذات، لا مجرّد ترتيب خارجي للوقائع، فالماضي حنين إلى الفردوس المفقود، فيُستحضَر الماضي بوصفه زمنًا ذهبيًّا، حيث بيروت المثالية جميلة، ونضرة، وفاتنة، لقد كانت مرآة الحضارة العربيّة ، ومساحة للحريّة، والثقافة، والحب.
بهذا الاسترجاع الحنيني، لا يُعبّر نزار عن ماضٍ حقيقيّ بالضرورة، بل عن زمن متخيَّل، يُعيد من خلاله بناء صورة المدينة كحبيبة لا تُنسى، وكأنثى لا تُعوَّض.
والشّعور الملازم لهذا الماضي هو الأسى والحنين، وهناك حزنٌ ناعم يُرافق استذكار الزّمن الجميل، لكنه محمّل بالإدراك الحادّ أنّ هذا الزّمن قد انتهى، فالحاضر لحظة خراب وانهيار لأنّ بيروت تحترق وتغدو الحرب والسياسة فيها خرابًا للمدينة وللشّعور معًا.
واللحظة الحاضرة في القصيدة ليست مجرّد مشهد وقتي، بل زمن مأزوم تعيش فيه الذّات الشّاعرة حالة من الصّدمة، والفقد، والانفصال عن المعنى، ويظهر الزّمن الحاضر كنوع من الفراغ الرّوحي، يصاحبانه الخذلان والمرارة وهما الشّعوران الطاغيان، فالأمل يتلاشى أمام الاختناق النّفسي والمشهد الدّموي للمدينة، وكأنّ الحاضر ليس زمنًا منفصلًا، بل سقوطًا جماعيًا تتورّط فيه الجماعة والمدينة معًا.
ومن خلال الانتقال المتكرّر بين الأزمنة، يتشكّل ما يمكن تسميته بـالبنية الدّائريّة المفتّتة، فالزّمن في القصيدة ليس تسلسليًا، بل نفسيًا، وتتكرّر اللحظات وتُعاد، لا بوصفها ذكرى، بل كـجروح لا تندمل إذ إنَّ اللغة الشّعريّة تُعيد تشكيل الزّمن وفاق منطق الشّعور، لا منطق الواقع.
تكشف قصيدة “يا ست الدّنيا يا بيروت” وعيًا زمنيّا متشظّيًّا، لا يسير من الماضي إلى المستقبل بشكل خطيّ، بل يتنقّل كأنفاس داخليّة مضطربة. والمكان – بيروت – ليس منفصلًا عن هذا الزّمن، بل هو تجليّه الماديّ والشّعوريّ. وبين الحنين إلى الماضي، والخذلان من الحاضر، والريبة من المستقبل، ترتسم خريطة شعوريّة عميقة تعبّر عن انهيار الأنا، وتشظي الوعي، وسقوط الهُويّة في زمن الخراب، يتعامل نزار قباني مع الزّمن بوصفه تجربة شعوريّة لا خطًا زمنيًا تقليديًا، فيتنقّل بين ماضٍ مفعم بالجمال والحرية، وحاضر مثقل بالنّدم والدّمار، وتوق إلى مستقبل مخلّص. الزّمن في القصيدة مكسور، يدور في حلقة من التكرار المؤلم، إذ لا يُمحى الماضي بل يُستعاد بشعور جماعي بالذّنب، ويتجسد ذلك في تكرار كلمة “الآن” التي تكشف إدراكًا متأخرًا للفاجعة. وبينما يعكس ضمير “نحن” الزّمن الجمعي المرتبط بالخطيئة الجماعيّة والصمت والتواطؤ، يمثل ضمير “أنا” زمنًا داخليًا حميمًا، مشبعًا بالحب والحنين والكتابة. وتمتدّ استعارة النّوم والموت إلى بُعد أسطوري، يجعل الزّمن في القصيدة مفتوحًا على إمكان القيامة، كأنّ الشّاعر يرفض التّسليم بموت بيروت، ويرجو بعثها من جديد خارج دائرة الألم والتاريخ، كقصيدة نار تُكتب للحبّ والخبز والحياة.
رابعًا: بيروت و”نحن” – الحالة الشّعوريّة الجمعيّة
تمثّل قصيدة “يا ست الدّنيا يا بيروت” خطابًا لا يتوقّف عند التجربة الفرديّة للشّاعر، بل يتجاوزها إلى ما يمكن تسميته بـ”الشّعور الجمعي”. فالمتكلم في القصيدة لا يتحدث باسمه وحده، بل باسم جماعة مجروحة، منكوبة، مهزومة. إن ضمير “نحن” الذي يتكرر في النص لا يُستخدم اعتباطًا، بل هو بناء شعوري–سياسي يعكس تماهيًا عميقًا بين المدينة والذات الجماعية.
من أبرز ما يلفت في هذه القصيدة، انتقال الشّاعر من خطاب الأنا إلى خطاب الجماعة:هذا التصريح لا يحمل فقط انكسارًا ذاتيًا، بل اعترافًا ضمنيًا أنّ بيروت ليست وحدها من سقط، بل سقط معها الجميع. وهذا التحوّل من “أنا” إلى “نحن” يُشكّل تحوّلًا من تجربة شخصية إلى مأساة قوميّة.
- بيروت و”نحن”:
تظهر بيروت في هذه القصيدة متلقّيًا يعي ما يحصل حوله، إنّها الأنثى التي يخاطبها الشّاعر بصيغة “نحن”، ويظهر الخطاب المباشر في جمل النداء “يا ست الدّنيا يا بيروت” وفي ضمائر المخاطب: “أساورك – خاتمك – ضفائرك – عينيك – وجهك – عليك”. وبيروت ليست امرأة عادية، إنّها ست الدّنيا ومروحة الصّيف والوردة الجوريّة، واللؤلؤة والسُّنبلة والأقلام والأحلام والأوراق الشّعريّة، وإنّها الحوريّة والعصفور الدوري، وقطة ليل وحشيّة، هي عشتار، وكقصيدة ورد وقصيدة نار، هي خلاصات الأعمار وحقل اللؤلؤ وميناء العشق وطاووس الماء، هي أحلى الملكات، سلطانة، نوّارة، قنديل مشتعل في القلب، وأحلى لؤلؤة أهداها البحر، هي الوعد الأول، جوهرة الليل وزنبقة البلدان.
ويظهر الفاعلون من خلال ضمير المتكلم الجمع “نحن”، وتتّضح صفاتهم في اسم الاستفهام الوارد قبل الأفعال الماضية، فهم من باع ومن صاد، وقصّ، وذبح، وشطب، وألقى ماء النار، هم من سمّم ماء البحر، ورشّ الحقد، هم المعتذرون والمعترفون أنّهم أطلقوا النّار عليها فقتلوا الحرية.
هم الذين لوثوا سماءها، وكانوا ضدّ الله، وضدّ الشّعر، هم كالبدو الرحل، هم المغتصبون الغادرون الجاهلون الأميون، هم القتلة والغدر وشهود الزور، كانوا يغارون من جمالها وحسنها، ولذلك آذوها واستبدلوا الوردة بالسكين، يظهرون الندم بعدما أقرّوا باقتراف المعاصي والآثام، فالدّنيا بعد بيروت ليست تكفيهم، ولا شيء يعادل بيروت، فجذورها ضاربة فيهم، يعترفون بأنّهم ساديّون ودمويّون ووكلاء الشيطان.
بيروت هي المتلقي، و”نحن” المرسل، والعلاقة بين المرسِل والمرسَل إليه أشبه بعلاقة بين امرأة ومجموعة من الرجال تعاونوا على اغتصابها حتى الموت، وبعد ذلك أظهروا النّدم الشّديد على ما اقترفوا، ولكنّ هذا الندم لا ينفي عنهم صفة الاتّهام والغدر والخيانة، إذ يظهر الشّاعر صفات ال”نحن” في حركة تصاعديّة تبدأ من “باع” إلى “ذبح”. وبيروت ذنبها أنّها امرأة جميلة تتألّق حسنًا وبهاءً بضفائر ذهبيّة وعينين خضراوين وشفتين رائعتين يخلع عليها كلّ صفات الجمال والوداعة والسكينة والطّهر.
خامسًا: بيروت و”الأنا” – الحالة الشّعورية الفردية
إذا كان ضمير “نحن” في القصيدة يُعبّر عن الشّعور الجمعي المرتبط بالمصير العربي المشترك، فإنّ حضور ضمير “الأنا” يعكس لحظة شعوريّة ذاتيّة خالصة، يتكشّف فيها تمزّق الذّات الشّاعرة بين الحبّ والغضب، بين الحنين والخذلان، وبين الرّغبة في الانتماء والرّغبة في الانفصال. وتغدو بيروت في هذا السّياق مرآة للأنا المجروحة، الجريحة، المتأرجحة بين الإخلاص والرفض.
وتحضر “الأنا” في القصيدة بوصفها ذاتًا متورطة في العلاقة مع بيروت، لا من موقع المحايد، بل من موقع العاشق المُحب والمصدوم. فالعلاقة ليست سياسيّة فحسب، بل عاطفية وجودية:
” ما زلتُ أحبُّكِ يا بيروتُ المجنونهْ ..
يا نهرَ دماءٍ وجواهرْ ..
ما زلتُ أحبُّكِ يا بيروتُ القلبِ الطيّبِ ..
يا بيروتُ الفوضى ..
يا بيروتُ الجوعِ الكافرِ .. والشّبعِ الكافرِ ..
ما زلتُ أحبُّكِ يا بيروتُ العدلِ ..
في البداية، تأتي الأنا وهي تُخاطب بيروت بصوتٍ مفعمٍ بالتقديس والانتماء، كما لو أنها تحاكي امرأة أحبّها إلى حدّ الذوبان. هذه الأنا تسترجع لحظات الفرح، الأمان، الجمال،
ولكن الحب لا يدوم، فمع تصاعد مشهد الخراب، تتحوّل الأنا إلى كائن مصدوم ومرتبك، يتساءل إن كانت بيروت التي أحبّها لا تزال نفسها. وتبدأ الذات بمحاسبة بيروت، بل بمساءلتها وجوديًا:
من أينَ أتتكِ القسوةُ يا بيروتْ،
وكنتِ برقّةِ حوريّهْ؟
لا أفهمُ كيف انقلبَ العصفورُ الدوريُّ..
لقطّةِ ليلٍ وحشيّهْ..
لا أفهمُ أبداً يا بيروتْ
لا أفهمُ كيف نسيتِ اللهَ..
وعُدتِ لعصرِ الوثنيّهْ..
وتحمل الأنا معها بقايا الماضي، وتتحدث عن بيروت كما كانت، وتشتاق إلى تلك الصورة التي لم تعد موجودة، وهذا الحنين يخلق توتّرًا داخليًّا يُلازم الشّاعر طوال القصيدة:
لا يوجدُ قبلكِ شيءٌ.. بعدكِ شيءٌ.. مثلكِ شيءٌ..
أنتِ خلاصاتُ الأعمارْ..
يا حقل اللؤلؤِ..
يا ميناءَ العشقِ..
ويا طاووسَ الماءْ..
الحبُّ يريدكِ.. يا أحلى الملكاتْ..
والربُّ يريدكِ.. يا أحلى الملكاتْ..
يا سُلطانةُ، يا نوَّارةُ، يا قنديلاً مشتعلاً في القلب
ومع تصاعد صورة الدّمار، يتحوّل الحنين إلى نوع من الخذلان المرير، إذ تشعر الأنا بأنها خُدعت، أو أنّ المدينة التي أحبّتها تغيّرت جذريًّا، ولم تعد تحتويها كما في السّابق:
ماذا نتكلّمُ يا بيروتْ..
وفي عينيكِ خلاصةُ حزنِ البشريّهْ
وعلى نهديكِ المحترقين.. رمادُ الحربِ الأهليّهْ
ماذا نتكلّمُ يا مروحةَ الصّيفِ، ويا وردتَهُ الجوريّهْ؟
من كانَ يفكّر أن نتلاقى – يا بيروتُ – وأنتِ خرابْ؟
من كانَ يفكّر أن تنمو للوردةِ آلافُ الأنيابْ؟
من كانَ يفكّر أنَّ العينَ تقاتلُ في يومٍ ضدَّ الأهدابْ؟
إنّ هذا التوتر يجعل الأنا في حالة انكسار دائم، تتأرجح بين رغبة في الاستمرار في الحب، وحاجة إلى الفكاك، في هذه القصيدة، فبيروت ليست فقط موضوعًا خارجيًا للأنا، بل تتحوّل إلى مرآة شعوريّة ووجوديّة، ترى الذات فيها نفسها، فالذات ترى في سقوط المدينة سقوطًا لذاتها، وفي جرحها جرحًا داخليًا لا يُشفى. وهذا الاندماج العاطفي يجعل من بيروت نموذجًا للتمزّق الداخلي الذي تعيشه الذّات الشّاعرة.
وعلى الرّغم من التماهي مع المدينة، تنمو في القصيدة لحظة شعوريّة حرجة تبدأ فيها الأنا بمحاولة الانفصال عن بيروت، كأنّها تحاول النّجاة من الحب نفسه:
من أينَ أتتكِ القسوةُ يا بيروتْ،
وكنتِ برقّةِ حوريّهْ؟
لا أفهمُ كيف انقلبَ العصفورُ الدوريُّ..
لقطّةِ ليلٍ وحشيّهْ..
الانفصال هنا ليس كراهية، بل وسيلة للنجاة من انهيار الذات. إنّه محاولة لحماية ما تبقّى من الأنا في وجه الانهيار الكامل.
يتّضح لنا أنّ “الأنا” في القصيدة ليست ذاتًا محايدة تراقب بيروت من بعيد، بل ذات مأزومة، متورطة، عاشقة ومصدومة. وتنتقل هذه الأنا من موقع الاندماج التام مع المدينة إلى حافة الانفصال عنها، تحت وطأة التغيّر، والانهيار، والخذلان. بيروت هنا ليست فقط مدينة، بل مرآة للذات التي تعاني من فقدان الثقة بالواقع، والزّمن، والرمز. وبهذا، تُجسّد الأنا في النّص التّجربة الشّعوريّة الفرديّة المتقاطعة مع الجرح الجماعي، في لغة مشحونة ومضطربة تعكس الاضطراب العميق في الدّاخل الإنساني.
في قصيدة “يا ست الدّنيا يا بيروت”، يصوغ نزار قباني ملحمة شعريّة تنبض بالوجع الإنساني، وتستحضر المدينة/ الأنثى/ الحريّة ككائنٍ مقدّس جُرّدت من بهائها، فغدت ساحةً للخراب، ومرآةً تعكس شقاء الإنسان العربي وتمزّقه الداخلي.
سادسًا: بين الأنا والنّحن: ازدواجيّة الخطاب الشّعري
يتأرجح الخطاب في القصيدة بين ضمير المتكلم المفرد “أنا” الذي يجسّد الشاعر الإنسان، المتألم، المتأمل في الخراب بروح فردية حانية، وضمير الجمع “نحن” الذي يعكس الوعي الجمعي ووطأة المسؤولية الجماعية.
- “أنا” في النص صوت وجداني، حميم، يرتبط ببيروت كأنها جزء من ذاته، فيخاطبها بوصفها:
“يا سنبلتي، يا أقلامي، يا أحلامي، يا أوراقي الشّعريّة…”
- أما “نحن” فهي ضمير الاعتراف، صوت المذنبين الذين شهدوا الدمار بصمت أو تواطؤ، ويجلجل صداه في بيتٍ موجع:
“فقتلنا امرأةً كانت تُدعى الحرية…”
هذا التناوب في الضمائر يخلق توازنًا دراميًا يُثري النص، ويعكس مأزق الذات العربية المتأرجحة بين الحب والخذلان، بين الحلم والخيبة.
سابعًا: دلالات الرموز وعلاقتها بالزّمن والشّعور
تتّسم قصيدة “يا ستّ الدّنيا يا بيروت” بثقل رمزيّ كثيف، يتجاوز مستوى اللغة الظاهرة إلى عالم الإيحاء والتأويل، فالرّمز”معناه الإيحاء، أي التّعبير غير المباشر عن النّواحي النّفسيّة المستترة التي لا تقوى على أدائها اللغة في دلالتها الوضعيّة”([18]). فكل مفردة، وكل صورة، وكل استعارة في القصيدة تنطوي على بُعد زمني وشعوري، إذ تتجلى الرّموز كوسائط تعبّر عن تمزق الزّمن الدّاخلي للشّاعر وتشظي شعوره حيال المدينة، والحرب، والانتماء، والخذلان.
وتظهر الرموز بصور مختلفة:
الرمز الأنثوي في تمثيل بيروت: من الجمال إلى الاغتصاب
في قصيدة “يا ست الدّنيا يا بيروت”، يقدّم نزار قباني صورة رمزيّة شديدة الكثافة لبيروت عبر تمثيلها بامرأة فاتنة، ذات جمالٍ أخّاذٍ، تجمع بين الأنوثة الطاغية والمكانة الملكيّة. فهي “أحلى الملكات” و”السّلطانة” المتزينة بأساوير الياقوت، ذات عينين خضراوين، وشفتين مثيرتين، ما يجعلها رمزًا للمدينة المزدهرة، المتألقة، المشتهى جمالها من الجميع. غير أنّ هذا الجمال، بدل أن يكون مصونًا، تحوّل إلى فريسة للرغبة والافتراس.
فالمدينة الأنثى تُغتصب رمزيًا على يد الطامعين فيها، فتُراوَد وتُعاشَر وتُضاجَع، في صورة قاتمة للعنف السياسي والطائفي والجسدي الذي عانته بيروت في ظل الحروب والانقسامات. يتجلى هذا التدهور في انتقال المدينة/المرأة من حالة الرفاهيّة إلى حالة الجنون والضياع، فتحمل معاصيهم، و”تنسى الله”، وتعود إلى “عصر الوثنيّة”. هذه العودة ليست مجرد نكوص ديني، بل دلالة على انحطاط قيمي ووجودي، وانفصام في هوية المدينة.
تتجاوز سيميائيّة الأنثى هنا الجسد والجمال، لتصير رمزًا للمدينة التي كانت معشوقة الجميع، لكنها دُنّست بسبب الشّهوات السياسيّة والتّدخلات الخارجيّة. فبيروت التي كانت “ستّ الدّنيا”، تحوّلت بفعل العنف إلى امرأة مغتصبة ومجنونة، تحمل في أحشائها آثار الخطيئة، وتكابد فقدان الروح الإلهيّة التي كانت تميزها.
الرّموز الجغرافيّة: بيروت بين الجمال الطبيعي والمكانة الكونيّة
يستحضر نزار قباني في قصيدته “يا ست الدّنيا يا بيروت” سلسلة من الرّموز الجغرافيّة التي تضيء الموقع الطبيعي والكوني لبيروت بوصفها مدينةً استثنائيّة الجمال والمكانة. فالمدينة تظهر من خلال صور مثل: مروحة الصيف، أحلى لؤلؤة أهداها البحر، السنبلة، جوهرة الليل، زنبقة البلدان، زهرة لوز في نيسان، حقل اللؤلؤ، طاووس الماء، القنديل المشتعل. هذه الصور لا تقدم وصفًا مباشرًا للمدينة، بل توظّف الرّمزيّة الجغرافيّة والطبيعيّة لتجعل من بيروت كائنًا مشعًّا، يجمع بين العذوبة المناخيّة، والثّراء الطبيعي، والجاذبيّة السّاحرة.
تشير هذه الرّموز إلى خصائص جغرافيّة دقيقة: فـ”مروحة الصّيف” تحيل إلى مناخ بيروت المعتدل المنعش، و”أحلى لؤلؤة أهداها البحر” تعكس موقعها الفريد على ساحل المتوسط، حيث تبدو وكأنّ البحر ذاته قد أنجبها كتحفة. أمّا “السنبلة” و”النوارة” و”زهرة لوز في نيسان” فترمز إلى خصب الأرض وربيعها الدّائم، في حين أنّ “جوهرة الليل” و”القنديل المشتعل” تستحضران إشراق المدينة ليلاً، لا كمدينة فقط بل ككوكب مضيء في الجغرافيّا العربيّة.
تغدو بيروت، من خلال هذه الرّموز، أيقونة طبيعيّة متكاملة: فهي الخير في السّنبلة، والبركة في حقل اللؤلؤ، والنّور في القنديل، والبهاء في طاووس الماء، والجمال في زنبقة البلدان. وبهذا، تتحول المدينة إلى كائن جغرافي وشعري في آن، تحضر في قصيدة نزار قباني لا كمجرد مدينة على الخريطة، بل كجوهر طبيعي وإنساني وروحي في قلب العالم العربي.
الرّموز التّاريخيّة: بيروت بين الذاكرة والخلود
في قصيدة “يا ست الدّنيا يا بيروت”، يوظّف نزار قباني مجموعة من الرّموز التّاريخيّة التي تمنح بيروت بعدًا زمنيًا متجذرًا في الوجدان. إذ يصفها أنّها “الوعد الأول” و”الحب الأول” و”خلاصات الأعمار”. هذه التّعابير ليست مجرّد استعارات رومانسيّة، بل تُعبّر عن علاقة وجوديّة متشابكة بين الذّات الشّاعرة والمدينة.
فالـ”وعد الأول” يستحضر لحظة التأسيس، والحلم البكر، وبداية الارتباط بالمدينة، وكأنّ بيروت كانت أول مدينة تمنح الشّاعر معنى الانتماء والانتظار. أمّا “الحب الأول”، فهو إشارة إلى العلاقة العاطفيّة والحنينيّة التي لا تنسى، إذ غالبًا ما يكون الحب الأول أكثر رسوخًا في الذاكرة الوجدانية، وهو ما يضفي على بيروت طابعًا لا يُمحى مهما توالت المدن والقصائد.
أما عبارة “خلاصات الأعمار”، فهي ذروة الرّمزيّة الزّمنيّة، إذ تجعل من بيروت خلاصة للتّجارب، ومختصرًا للحياة، ومكانًا يُختزن فيه الزّمن كلّه: الماضي والطفولة، الحنين والخيبة، الرّجاء والانكسار. وهكذا تصبح بيروت حاضنة للزّمن الوجودي، لا مجرد مدينة تتغير بتغير العقود، بل كيان يختزن روح الإنسان العربي وتاريخه الشّخصي.
بهذه الرّموز، يرفع نزار قباني بيروت من موقعها الجغرافي إلى مقام الرّمز الزّمني الخالد، إذ تتقاطع فيها اللحظات الأولى للحب والوعد والحنين، وتتحوّل إلى مرآة تختزل الحياة ذاتها.
الرّموز الأسطوريّة
تتجلى الرّموز الأسطوريّة في قصيدة “يا ست الدّنيا يا بيروت” بوصفها حوامل دلاليّة غنيّة، تستدعي الميثولوجيا الشّرقيّة والغربيّة لتأطير تجربة المدينة–الأنثى. تتلبس بيروت صفات الكائن الأسطوري من خلال عبارات مثل: “أطلقنا النار عليكِ بروح قبلية”، “يا وردته الجورية”، “عدتِ إلى عصر الوثنية”، “يا عشتار”، “نحبك كالبدوي الرحّل”، وغيرها من الصّور الرّمزيّة التي تُموقع المدينة في فضاء أسطوري مشحون بالتقديس والانتهاك.
يرتقي الشّاعر بصورة بيروت إلى مصاف الإلهات القديمات، إذ تستدعي صورة “عشتار” – إلهة الحب والخصب والحرب ([19]) التي تنهض ثم تُسقط، تُبجَّل ثم تُغتصب، وتُحب ثم تُغدر.
وفي هذا السياق أيضًا، تتداخل صورة بيروت المجنونة مع الرّمز الأسطوري، فجنونها لا يُقرأ إلّا بوصفه نتيجة لانتهاك قدسيتها. لقد تحولت من مدينة مضيئة إلى مدينةٍ مسلوبة، ومن معشوقة متوَّجة إلى امرأة منتهَكة. فنسيت الله، وعادت إلى عصر الوثنيّة، فحملت معاصي من راودوها واغتصبوا هويتها. هنا تلتقي القصيدة مع سرديّات الأسطورة التي تصور الإلهات حين يسقطن تحت سطوة الطغيان الذّكوري، كما في مأساة إنانا أو ميثولوجيا الإلهات المغضوبات.
إنّ هذه الرموز تُظهر بيروت ككائن أسطوري متحول، تتقاذفه الأهواء بين الجمال والدّمار، بين القداسة والتّدنيس، لتصبح مرآة تعكس لا فقط واقعها، بل أيضًا الواقع العربي برمّته، في انحداره وانفصامه القيمي والحضاري.
الرّموز الشّعريّة: بيروت منبع الإلهام ومهد القصيدة
في قصيدة “يا ست الدّنيا يا بيروت”، تحضر بيروت ليس فقط كجغرافيا أو أنثى أو تاريخ، بل ككائن شعري خالص، يتجلّى في رموز شعريّة كثيفة مثل: الأقلام، الأوراق، المحابر، أكياس المخمل، قصيدة الورد، بيروت الشّاعر. هذه الرّموز تؤسس لعلاقة عضويّة بين بيروت والشّعر، تجعل من المدينة مصدر الإلهام، وفضاء الخلق، ومنبع القصيدة النابعة من أعماق الوجدان.
يشير الشاعر إلى “القصائد المخبّأة في أكياس المخمل” كاستعارة لخصوصية الشّعر الذي يُكتب عن بيروت، فليست هي مجرد موضوع شعري عابر، بل هي قصيدة خالدة، تُخزّن بعناية كما يُحفظ الكنز النّفيس. أمّا “قصيدة الورد”، فهي تمثيل جمالي للمدينة نفسها، وكأنّ بيروت ليست فقط ملهمة الشّعراء، بل قصيدة مزهرة تتفتّح في سماء الشّعر العربي. ويستمر الحقل الرّمزي في استحضار الأقلام والمحابر، لتصوير حيويّة الكتابة حين تكون بيروت موضوعها، فالأقلام تنتفض، والمحابر تفيض، وتتحول اللغة إلى أداة عشق ومقاومة. فبيروت، في هذا السّياق، لا تُكتب فقط، بل تُحيا بالشّعر، ويغدو وجودها نفسه قصيدة، والوحي المتدفق من جمالها ودمائها وحنينها، هو ما يمنح القصائد صدقها ونبضها، فالشّعر “استشعار، حدس، انتظار، رؤية…إنّه الكينونة نفسها منشئة نفسها في القول الشّعري”([20]). وهكذا، تتحوّل بيروت في المخيال الشّعري لنزار قباني إلى كلمة عليا، ورمز شعري مطلق، تنبع منه أعذب القصائد، وتُسكب فيه أسمى الكلمات، ويصير الشّعر حين يُكتب عنها طقس حب وعبادة، وملحمة عشق وبطولة.
الخاتمة
إنّ قصيدة “يا ستّ الدّنيا يا بيروت” لنزار قباني ليست مجرد مرثية لمدينة تنهار تحت وطأة الحرب، بل هي أيضًا سفرٌ شعريٌّ عميق في الزّمن والشّعور، فيتقاطع التاريخ الشخصي بالشّأن الجمعي، وينفجر الوجدان تحت ضغط الخراب، والخيانة، والانهيار.
فمن خلال التّتبع الدّقيق لبنية النص، تبيّن أن الشّاعر يبني عالمه الشّعري على تشظٍّ زمني واضح، تتداخل فيه الأزمنة وتتناوب بين الماضي الزاهي، والحاضر الكارثي، والمستقبل الغامض. ولم يكن هذا التشظي مجرد تقنيّة سرديّة، بل هو انعكاس مباشر للحالة النفسية والشّعورية التي يمر بها الشّاعر، إذ يتبدّى الزّمن النّفسي كزمن منكسر، فاقد للاتجاه، تمامًا كما هو حال المدينة التي تسكنه. أمّا من جهة الشّعور، فقد تجلّت القصيدة كمنظومة وجدانيّة معقدة، تتراوح بين الحنين، والغضب، والانكسار، والتّحدي. ونجح نزار قباني، عبر أدواته الشّعريّة والرّمزيّة، في تحويل هذه المشاعر إلى بنيّة دلاليّة متكاملة تعبّر عن مأساة الذات والعالم. وقد ساعد في ذلك توظيفه الدّقيق للرموز التي لم تكن محايدة أو مجرّدة، بل محمّلة بزخم دلالي يتقاطع مع الذاكرة، والسياسة، والجسد، واللغة، لقد أظهر تحليل العنوان، والرّموز، والتّحولات الزّمنية، أنّ بيروت في القصيدة لم تعد فقط مكانًا جغرافيًا، بل أصبحت كائنًا شعوريًا، ورمزًا للخذلان، والأنوثة الجريحة، والوطن المغتصب. وبيروت هنا ليست فقط مدينة تموت، بل أيضًا حلم عربي يتهاوى، وزمن حضاري ينكسر، ولغة تُهان. من هنا، يمكن القول إنّ هذه القصيدة تُجسّد نموذجًا فنيًا لقصيدة الأزمة، فتنصهر التّجربة الذّاتيّة بالشّعور الجمعي، ويصبح الشّعر مساحةً للتوثيق العاطفي، والتفكيك الزّمني، والتعبير عن هويّة مأزومة. إنّها قصيدة تقول ما لا يُقال، وتبكي ما لا يُبكى، وتستعيد عبر الحنين ما لا يمكن استعادته.
المصادر والمراجع
المصدر
- قبّاني، نزار. إلى بيروت الأنثى مع حبّي. بيروت: منشورات نزار قباني، ط1، 1978.
المراجع العربية
- أدونيس. زمن الشّعر. لبنان: دار السّاقي، ط7، 2012.
- أيوب، نبيل. النّقد النّصّي 2. لبنان: مكتبة لبنان ناشرون، ط1، 2011
- ابن منظور، جمال الدين محمد بن مكرم. لسان العرب. بيروت: دار صادر، ط1، ج13.
- أرميكنو، فراسواز. المقاربة التّداولية. ترجمة سعيد علوش. الرباط: مركز الإنماء القومي، 1986.
- بوجادي، خليفة. في اللسانيات التّداولية، مع محاولة تأصيلية في الدرس العربي القديم. الجزائر: بيت الحكمة للنّشر والتوزيع، ط1، 2009.
- الخال، يوسف. الحداثة في الشّعر. بيروت: دار الطليعة، ط1، 1978.
- ختام، جواد. التّداولية أصولها واتّجاهاتها. دار كنوز، الأردن، ط1، 2016
8.العلاق، علي جعفر. الشّعر والتّلقّي، دراسات نقديّة. عمّان: دار الشّروق للنّشر والتّوزيع، ط1، 1997.
9.غنيمي هلال، محمد. الأدب المقارن. القاهرة، ط9، 2008.
10.قطوس، بسام. سيمياء العنوان. عمّان: وزارة الثقافة، ط1، 2001.
11.فاضل، عبد الواحد علي. عشتار ومأساة تموز. دمشق: دار الأهالي، ط1، 1999.
12.فانوس، وجيه. محاولات في الشّعري والجمالي. بيروت: اتحاد الكتّاب اللبنانيين، 1995.
13.فان دايك، تين. النص والسياق، استقصاء البحث في الخطاب الدلالي والتداولي. ترجمة عبد القادر قنيني. المغرب: لا ط، 2000.
14.الموسوعة العربيّة. arab-ency.com.
المراجع الأجنبيّة
- Heidegger، Martin. Chemins qui ne mènent nulle part. Idées 1962. Paris: Gallimard، nouvelle édition، 1987.
[1] -أستاذ مساعد في الجامعة اللبنانيّة – كليّة الأداب والعلوم الإنسانيّة –بيروت- لبنان
Assistant Professor at the Lebanese University – Faculty of Arts and Humanities – Beirut Lebanon – Email: naimahchakaroun@gmail.com –
[2]– قبّاني، نزار، إلى بيروت الأنثى مع حبّي، منشورات نزار قباني، بيروت – لبنان، ط1، 1978 ص309 – 327
[3] – بوجادي، خليفة، في اللسانيات التّداولية، مع محاولة تأصيلية في الدرس العربي القديم، بيت الحكمة للنّشر والتوزيع، الجزائر، ط1، 2009،ص123
[4]– أرميكنو، فراسواز ، المقاربة التّداولية، تر، سعيد علوش، مركز الإنماء القومي، الرباط، 1986، ص23
[5]– دايك، فان، النص والسياق، استقصاء البحث في الخطاب الدلالي والتداولي، تر، عبد القادر قنيني، المغرب، لا ط، 2000، ص 292
[6] -ختام، جواد، التّداولية أصولها واتّجاهاتها، دار كنوز، الأردن، ط1، 2016، ص15
[7]– أرمينكو، فراسواز، المقاربة التّداولية، ، ص11
[8] -أيوب، نبيل، النّقد النّصّي2، مكتبة لبنان ناشرون، لبنان، ط1، 2011، ص239
[9] إبن منظور، جمال الدين محمد بن مكرم، لسان العرب، دار صادر- بيروت، ط1،ج13،ص199.
[10] أدونيس، زمن الشعر، دار السّاقي، لبنان، ط7، 2012، ص180
[11] أدونيس، زمن الشعر، م.س، ص180
[12] أدونيس، زمن الشعر، م.س، ص 181
[13]– الموسوعة العربيّة، arab-ency.com
[14]– الخال، يوسف، الحداثة في الشعر، دار الطليعة، بيروت، ط1، 1978، ص81
[15]– فانوس، وجيه، محاولات في الشعري والجمالي، إتحاد الكتّاب اللبنانيين، بيروت، 1995، ص81
[16]– قطوس، بسام، سيمياء العنوان، وزارة الثقافة، عمان، الأردن،ط1، 2001، ص31
[17]– العلاق، علي جعفر، الشعر والتّلقّي، دراسات نقديّة، دار الشّروق للنّشر والتّوزيع، عمّان الأردن، ط1، 1997، ص173
[18]– غنيمي هلال، محمد، الأدب المقارن، القاهرة، ط9، 2008، ص 315
[19] -عبد الواحد علي، فاضل، عشتار ومأساة تموز، دار الأهالي، دمشق، ط1، 1999، ص25
-[20] Heidegger Martin, Chemins qui ne mènent nulle part, idées 1962, paris, gallimard, nouvelle édition,1987,p.237