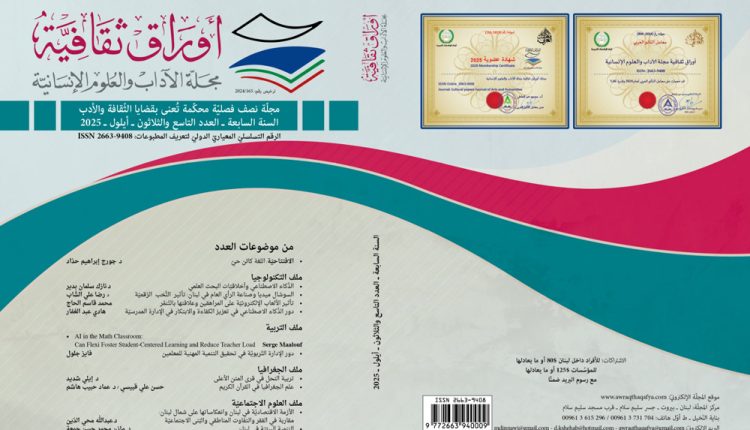عنوان البحث: إدمان وسائل التّواصل الاجتماعي: الآثار النّفسيّة والسّلوكيّة على الأفراد والحلول المقترحة
اسم الكاتب: د. حسين ناصر
تاريخ النشر: 2025/09/15
اسم المجلة: مجلة أوراق ثقافية
عدد المجلة: 39
تحميل البحث بصيغة PDFADOI: https://aif-doi.org/awraq/013910
إدمان وسائل التّواصل الاجتماعي: الآثار النّفسيّة والسّلوكيّة على الأفراد والحلول المقترحة
Social Media Addiction: Psychological and Behavioral Effects on Individuals and Proposed Solutions
Dr.Houssein Nasserد. حسين ناصر)[1](
تاريخ الإرسال:10-8-2025 تاريخ القبول:19-8-2025
الملخص:
يهدف هذا البحث إلى دراسة وتحليل ظاهرة إدمان وسائل التّواصل الاجتماعي وتأثيراتها المتعددة على الأفراد. يتناول البحث حجم المشكلة من خلال استعراض بيانات إحصائيّة حول معدلات استخدام الهواتف الذّكيّة، ويحلّل الأسباب الكامنة وراء هذا الإدمان، مثل آليات الدّوبامين والمقارنة الاجتماعيّة. ويستعرض البحث الآثار السّلبيّة لهذا الإدمان على مختلف جوانب حياة الفرد، بما في ذلك الصّحّة النّفسيّة، والتّحصيل الأكاديمي، والعلاقات الاجتماعيّة. وفي الختام، يقدم البحث مجموعة من الحلول العمليّة والاستراتيجيات التي تساعد الأفراد على التحرر من هذا الإدمان واستعادة السّيطرة على حياتهم.
الكلمات المفاتيح: إدمان التّواصل الاجتماعي–استخدام الهواتف الذّكيّة- أليات الدّوبامين-المقارنة الاجتماعيّة- الصّحّة النّفسيّة- التحصيل الأكاديمي- العلاقات الاجتماعيّة-استراتيجيات التحرر من الإدمان- وسائل التّواصل الاجتماعي.
Abstract:
This research aims to study the phenomenon of social media addiction and its multiple effects on individuals. It addresses the magnitude of the problem through statistical data on smartphone usage rates and analyzes the underlying causes of this addiction, such as dopamine mechanisms and social comparison. The research also reviews the negative effects of this addiction on various aspects of an individual’s life, including mental health, academic achievement, and career path. Finally, it presents a set of practical solutions and strategies to help individuals break free from this addiction and regain control over their lives.
Keywords: Social media addiction – smartphone use – dopamine mechanisms – social comparison – mental health – academic achievement – social relationships – addiction recovery strategies – social media.
1. المقدمة
شهد العالم ثورة رقميّة غير مسبوقة جعلت وسائل التّواصل الاجتماعي جزءًا أساسيًّا من الحياة اليوميّة لمليارات الأشخاص. هذه المنصات لم تعد مجرد أدوات للتواصل، بل أصبحت مصادر رئيسة للمعلومات والترفيه. ومع ذلك، فقد أدّى الاستخدام المفرط لهذه الوسائل إلى ظهور ظاهرة “الإدمان الرّقمي”، والتي تُعرّف بالاعتماد النّفسي والسّلوكي على التّفاعل المستمر مع هذه التّطبيقات. تشير الدّراسات الحديثة إلى أنّ السّلوك الإدماني تجاه وسائل التّواصل الاجتماعي يشبه في التأثيرات العصبيّة إدمان المواد المخدرة، فتُفعَّل دوائر المكافأة نفسها في الدّماغ عبر إفراز الدوبامين. هذا الإدمان ينتشر بين الفئات العمريّة جميعها، ويؤثر سلبًا على الصّحّة النّفسيّة، والأداء الأكاديمي، والعلاقات الاجتماعيّة. يسعى هذا البحث إلى تقديم إطار تحليلي للآثار النّفسيّة والسّلوكيّة المترتبة على هذه الظاهرة، بالإضافة إلى استعراض استراتيجيات فعالة للتعامل معها.
2. أهمية البحث
تكمن أهمية هذا البحث في تناوله لظاهرة إدمان وسائل التّواصل الاجتماعي التي أصبحت جزءًا أساسيًّا من الحياة اليوميّة لمليارات الأشخاص. ومع ذلك، فقد أدّى الاستخدام المفرط لهذه الوسائل إلى ظهور “الإدمان الرّقمي” والذي يؤثر سلبًا على الصّحّة النّفسيّة، والأداء الأكاديمي، والعلاقات الاجتماعيّة. ويمكن إيجاز أهمّيّة البحث في النقاط الآتية:
- فهم ظاهرة الإدمان: يساهم البحث في فهم ظاهرة إدمان وسائل التّواصل الاجتماعي، وتحليلها وأسبابها الكامنة.
- تحديد الآثار السّلبيّة: يسلط الضوء على الآثار السّلبيّة لإدمان وسائل التّواصل على جوانب متعددة من حياة الفرد، مثل الصّحّة النّفسيّة، والتّحصيل الأكاديمي، والعلاقات الاجتماعيّة.
- تقديم حلول عمليّة: يقدم البحث مجموعة من الحلول والاستراتيجيات العمليّة التي تساعد الأفراد على التّحرر من هذا الإدمان.
3. أهداف البحث: يهدف هذا البحث إلى تحقيق الأهداف الآتية:
- دراسة ظاهرة إدمان وسائل التّواصل الاجتماعي وتحليلها: يهدف البحث إلى دراسة هذه الظاهرة وتأثيراتها المتعددة على الأفراد.
- تحليل أسباب الإدمان: يتناول البحث الأسباب الكامنة وراء الإدمان، مثل آليات الدّوبامين والمقارنة الاجتماعيّة.
- استعراض الآثار السّلبيّة: يستعرض البحث الآثار السّلبيّة لإدمان وسائل التّواصل الاجتماعي على جوانب مختلفة من حياة الفرد، بما في ذلك الصّحّة النّفسيّة، والتّحصيل الأكاديمي، والعلاقات الاجتماعيّة.
- اقتراح حلول واستراتيجيّات: يقدم البحث مجموعة من الحلول العمليّة، والاستراتيجيّات التي تساعد الأفراد على التّحرر من هذا الإدمان واستعادة السيطرة على حياتهم.
- توعية الأفراد: يهدف البحث إلى زيادة وعي الأفراد بوجود مشكلة “الإدمان الرقمي” ، وتقديم خطوات عمليّة للتعامل معها.
4. مشكلة البحث
في ظل الانتشار الواسع لوسائل التّواصل الاجتماعي وتحوّلها إلى جزء لا يتجزأ من الحياة اليوميّة، برزت ظاهرة إدمان هذه الوسائل كقضية تستحق الدّراسة والتّحليل. على الرّغم من الفوائد التي تقدمها هذه المنصات في التّواصل والحصول على المعلومات، فإنّ الاستخدام المفرط لها قد أدى إلى ظهور سلوكيّات إدمانيّة تؤثر سلبًا على الأفراد في مختلف جوانب حياتهم. بناءً على ذلك، ويمكن تحديد مشكلة البحث من خلال طرح السؤال الرئيس الآتي:
ما هي الأبعاد النّفسيّة والسّلوكيّة لإدمان وسائل التّواصل الاجتماعي، وما هي الحلول والاستراتيجيّات المتاحة للحدّ من آثاره السّلبيّة على حياة الأفراد؟
وتتفرع منه الأسئلة الفرعيّة الآتية:
- ما هي الآليات النّفسيّة والبيولوجيّة التي تجعل وسائل التّواصل الاجتماعي إدمانيّة، وما مدى تشابهها مع آليات إدمان المواد المخدرة والقمار؟.
- ما هي الآثار السّلبيّة لإدمان وسائل التّواصل الاجتماعي على الفرد، وكيف تختلف هذه التأثيرات عبر المجالات المختلفة؟.
- كيف يؤثر هذا الإدمان على الصّحّة النّفسيّة، وما هي العلاقة بينه وبين الشّعور بالوحدة والقلق والاكتئاب؟.
- ما هو تأثير الإفراط في استخدام وسائل التّواصل الاجتماعي على التّحصيل الدّراسي والإنتاجيّة في العمل؟.
- كيف يساهم الإدمان الرّقمي في ضعف التّواصل الواقعي وتدهور جودة العلاقات الأُسريّة والاجتماعيّة؟.
- ما هي الحلول والاستراتيجيّات العمليّة التي يمكن للأفراد اتباعها للحدّ من إدمان وسائل التّواصل الاجتماعي واستعادة التوازن بين الحياة الواقعية والعالم الافتراضي؟.
5. فرضيات البحث
بناءً على الإطار النظري والدّراسات السّابقة، يرتكز هذا البحث على مجموعة من الفرضيّات التي تسعى إلى اختبار العلاقة بين إدمان وسائل التّواصل الاجتماعي وأثره على الفرد، و يفترض هذا البحث ما يلي:
- الفرضية الأولى: هناك علاقة إيجابيّة بين إدمان وسائل التّواصل الاجتماعي وتدهور الصّحّة النّفسيّة للأفراد.
- الفرضيّة الثانية: يؤثر إدمان وسائل التّواصل الاجتماعي سلبًا على الأداء الأكاديمي والإنتاجيّة في بيئة العمل.
- الفرضيّة الثالثة: تؤدي الآليات النّفسيّة والبيولوجيّة، مثل إفراز الدّوبامين، إلى تعزيز السّلوك الإدماني تجاه وسائل التّواصل الاجتماعي.
- الفرضية الرّابعة: يمكن أن تساعد في إيجاد استراتيجيات وحلول عمليّة، مثل إيقاف الإشعارات وتحديد حدود زمنيّة للاستخدام، في الحدّ من إدمان وسائل التّواصل الاجتماعي واستعادة التوازن في حياة الأفراد.
6. منهج البحث
يعتمد هذا البحث على منهج وصفي تحليلي من خلال استعراض مجموعة من الأدبيات وتحليلها، والدّراسات السّابقة حول ظاهرة إدمان وسائل التّواصل الاجتماعي. يجمع البحث بين البيانات الإحصائيّة من مصادر موثوقة والتّحليل النظري للآليات النّفسيّة والبيولوجية المرتبطة بالإدمان. ويهدف هذا المنهج إلى فهم الأسباب، وتحديد الآثار، واقتراح حلول عملية لمشكلة إدمان وسائل التّواصل الاجتماعي.
7. الإطار النّظري والدّراسات السّابقة
تُظهر الدّراسات الحديثة ارتفاعًا كبيرًا في معدلات استخدام الهواتف الذّكيّة ووسائل التّواصل الاجتماعي. أظهرت دراسة أجرتها شركة الأبحاث الأمريكيّة dscout العام 2016 أنّ الشّخص العادي يلمس هاتفه الذّكي حوالى 2,617 مرة يوميًا، بينما يرتفع هذا الرّقم إلى 5,427 مرة يوميًا لدى المستخدمين المصنفين كمُدمنين. وتُبيّن بيانات GlobalWebIndex (GWI) لعام 2024 أنّ متوسط الوقت الذي يقضيه الأفراد يوميًا على الإنترنت هو 6 ساعات و36 دقيقة.
يُقارن العلماء إدمان وسائل التّواصل الاجتماعي بإدمان المخدرات والقمار، وهي مقارنة تستند إلى أسس علميّة، تؤكد أنّ هذه التّطبيقات مصممة لتكون إدمانيّة (Andreassen, 2015). يُفرَز الدوبامين، وهو مادة كيميائيّة في الدّماغ مرتبطة بالمكافأة، عند الحصول على إعجاب أو تعليق، ما يعزز الرّغبة في التّكرار المستمر للتّصفح (Brown & Davis, 2020). ومن منظور اجتماعي، أوضحت دراسة لـ (Błachnio et al., 2016) أنّ المقارنة الاجتماعيّة على وسائل التّواصل الاجتماعي تُعد عاملًا رئيسًا في تدهور الصّحّة النّفسيّة. فمن خلال مشاهدة “أفضل” لحظات حياة الآخرين، تتزايد مشاعر عدم الرضا عن الذات، ما يؤثر سلبًا على تقدير الذات ويزيد من أعراض الاكتئاب.
وفي ما يلي عرض لبعض الدّراسات العربيّة التي ركزت على أبعاد متعددة لإدمان وسائل التّواصل الاجتماعي:
- دراسة عبد الرازق (2020): العلاقة بين إدمان وسائل التّواصل الاجتماعي والوحدة النّفسيّة والقلق الاجتماعي. ركزت هذه الدّراسة على عينة من طلاب الجامعة، وهي شريحة عمريّة حرجة في استخدام وسائل التّواصل الاجتماعي. نتائجها لها دلالات مهمة:
- الشّعور بالوحدة النّفسيّة: أظهرت النتائج وجود ارتباط قوي، ومباشر بين مقدار الوقت الذي يقضيه الطلاب على وسائل التّواصل الاجتماعي ودرجة شعورهم بالوحدة. هذا يعني أنّه كلما زاد إدمانهم، زاد شعورهم بالوحدة، ما يشير إلى أنّ التّفاعلات الافتراضيّة قد تكون بديلًا غير كافٍ للعلاقات الحقيقيّة.
- القلق الاجتماعي: أشارت الدّراسة إلى أن المدمنين على وسائل التّواصل الاجتماعي غالبًا ما يجدون صعوبة في التّفاعلات الاجتماعيّة وجهًا لوجه. يمكن أن يكون هذا نتيجة لعدة عوامل، منها:
- الخوف من الحكم: على الإنترنت، يمكن للفرد أن يتحكم في مظهره وصورته، ما يجعله يشعر بالقلق عندما يواجه الآخرين في الحياة الواقعيّة فلا يمكنه التّحكّم في ردود أفعالهم.
- المهارات الاجتماعيّة الضعيفة: الاعتماد المفرط على التّواصل الإلكتروني، قد يضعف المهارات الاجتماعيّة الأساسيّة اللازمة لبناء علاقات عميقة وحقيقيّة.
- دراسة القرني (2023): العلاقة بين إدمان وسائل التّواصل الاجتماعي والأمن النّفسي: ركزت هذه الدّراسة على طلاب المرحلة الثانوية، وهي فئة عمريّة حساسة جدًا لمفاهيم الهُويّة والقبول.
- الأمن النّفسي: عرفت الدّراسة الأمن النفسي أنّه شعور الفرد بالثقة في نفسه وقدراته، إلى جانب شعوره بالقبول من محيطه من دون خوف. أظهرت النّتائج أن إدمان وسائل التّواصل الاجتماعي له تأثير سلبي كبير على هذا الشّعور.
- التأثيرات السّلبيّة: حددت الدّراسة عدة آليات تؤدي إلى تدهور الأمن النّفسي:
- المقارنات الاجتماعيّة السّلبيّة: يتعرض المراهقون بشكل مستمر لصور “الحياة المثاليّة” لأقرانهم على الإنترنت، ما يجعلهم يقارنون أنفسهم بشكل غير واقعي ويشعرون بالنّقص.
- التّعرض للتّنمر الإلكتروني: يمكن أن يصبح المراهقون ضحايا للتنمر والتّعليقات السّلبيّة، ما يؤثر بشكل مباشر على ثقتهم بأنفسهم وشعورهم بالأمان.
- الحاجة إلى التّحقق الخارجي: يعتمد المراهقون المدمنون بشكل كبير على عدد الإعجابات، والتّعليقات لتحديد قيمتهم الذاتية، ما يجعل شعورهم بالأمان هشًا ومرتبطًا بآراء الآخرين.
- دراسة كرزي وفحل (2021): إدمان وسائل التّواصل الاجتماعي وتأثيره على التّحصيل الدّراسي. تُظهر دراسة كريزي وفحل (2021) أنّ هناك علاقة مباشرة، وسلبيّة بين الاستخدام المفرط لوسائل التّواصل الاجتماعي والأداء الأكاديمي. هذه العلاقة تُفسر من خلال عدة آليات:
- تشتت الانتباه: يتعرض الطلاب المدمنون على وسائل التّواصل الاجتماعي إلى تدفق مستمر من الإشعارات والتنبيهات، ما يشتت تركيزهم أثناء الدّراسة أو المحاضرات. هذا يؤثر سلبًا على قدرتهم على استيعاب المعلومات وتذكرها.
- سوء إدارة الوقت: يقضي الطلاب أوقاتًا طويلة على هذه المنصات، ما يقلّل من الوقت المخصص للدّراسة، إعداد الواجبات، أو التّحضير للامتحانات. هذا يؤدي إلى تأخير في إنجاز المهام الأكاديميّة وتراكمها، ما يزيد من الضغط والتوتر.
- انخفاض جودة النّوم: استخدام الهواتف الذّكيّة، ووسائل التّواصل الاجتماعي قبل النوم يؤثر على جودة النّوم وكميته، ما يقلل من قدرة الطلاب على التركيز والتّعلم في اليوم التالي.
كما وبينّت الدّراسة وجود تأثيرات للإدمان على مواقع التّواصل الإجتماعي على الإنعزال الاجتماعي. إذ يميل الطلاب المدمنون على وسائل التّواصل الإجتماعي إلى الانفصال عن العلاقات الواقعيّة، فيعطون الأولويّة للعالم الإفتراضي ويهملون العلاقات في الحياة الواقعيّة.
- دراسة بونقار (2023): واقع إدمان الشباب للإنترنت: دراسة نظريّة. تُقدم الدّراسة منظورًا نظريًا مهمًا يفسر سبب إدمان الشّباب للإنترنت. بدلًا من النّظر إلى الإدمان كمجرد سلوك سيء، تراه كاستجابة لحاجات نفسيّة عميقة.
- الهروب من الواقع: تُشير الدّراسة إلى أنّ الإنترنت، وتحديدًا المجتمعات الافتراضيّة ووسائل التّواصل الاجتماعي، يُنظر إليه كـ ” ملاذ آمن” من ضغوط الحياة اليوميّة. الشّباب الذين يواجهون مشاكل في الأسرة، ضغوطًا أكاديميّة، أو صعوبات اجتماعيّة، يجدون في العالم الافتراضي وسيلة للهروب. في هذا العالم، يمكّنهم بناء هوية جديدة، الحصول على القبول، وتجنب المواجهات الصّعبة في الحياة الواقعيّة. هذا الاتجاه الإيجابي تجاه الإنترنت كأداة للهروب هو ما يجعلهم ينغمسون فيه بشكل متزايد، ما يؤدي إلى الإدمان.
- البحث عن الهُويّة والقبول: يُعدّ الإنترنت مساحة للشّباب لتجربة هويات مختلفة، والبحث عن القبول الذي قد يفتقدونه في محيطهم الاجتماعي الحقيقي. فـ “الإعجابات” و”التّعليقات” تصبح مؤشرات على القيمة الذّاتية، ما يدفعهم إلى السّعي المستمر للحصول عليها، وهذا السّعي قد يتحول إلى إدمان.
- دراسة محبوبي وإبراهيم (2024): واقع إدمان الشّباب للإنترنت: دراسة نظريّة. تؤكد هذه الدّراسة أنّ إدمان الشّباب للإنترنت ليس مجرد سلوك عشوائي، بل هو نتيجة لـ “اتجاهات إيجابيّة“ عميقة لديهم نحو العالم الرّقمي. هذا المفهوم يفسر لماذا يصبح الإنترنت جذابًا جدًا لدرجة الإدمان.
- الهروب من الواقع: ينظر الشّباب إلى الإنترنت كملاذ آمن للهروب من ضغوط الحياة الواقعيّة، مثل المشاكل الأُسريّة، أو الضغوط الدّراسيّة، أو القيود الاجتماعيّة.
- بناء الهُويّة: توفر المجتمعات الافتراضيّة مساحة للشّباب، لتجربة هويات مختلفة والحصول على القبول الذي قد يفتقدونه في محيطهم الحقيقي.
وتشير الدّراسة الى أنّ استخدام الشّباب للإنترنت يعدُّ ننظرهم أداة للتّحرر، والإفلات من سلطة المجتمع القهريّة. إذ توفر المنصات الرّقميّة مساحة لهم للتّعبير عن آرائهم وأفكارهم بحريّة، بعيدًا من القيود الاجتماعيّة التّقليديّة التي قد تفرضها الأسرة أو المجتمع. وتساعدهم هذه المنصات على بناء علاقات وتكوين صداقات مع أشخاص من خلفيات ثقافيّة مختلفة، ما يوسع آفاقهم ويفكك الحواجز التي يفرضها عليهم المجتمع الواقعي.
تُقدم الدّراسات السّابقة إطارًا تحليليًا متكاملًا لفهم ظاهرة إدمان الإنترنت ووسائل التّواصل الاجتماعي لدى الشّباب. يمكن تجميع نتائجها ضمن محورين رئيسين: الأسباب الكامنة والآثار المترتبة، ما يكشف علاقة سببيّة دائريّة تتفاقم فيها المشكلة بمرور الوقت.
- العوامل السّببيّة: دوافع نفسيّة واجتماعيّة
تتفق الدّراسات التي تناولت العوامل المسببة للإدمان، مثل دراسة بونقار (2023) ودراسة محبوبي وإبراهيم (2024)، على أنّ الإدمان ليس مجرد سلوك عشوائي، بل هو نتاج اتجاهات إيجابيّة عميقة تجاه العالم الرّقمي. يُنظر إلى الإنترنت كأداة للهروب من ضغوط الواقع، سواء أكانت مشاكل أُسريّة، أو إخفاقات أكاديميّة، أو قيودًا اجتماعيّة.
- الهروب النّفسي: تُشير الدّراسات إلى أنّ المجتمعات الافتراضيّة، توفر ملاذًا آمنًا للشّباب للتّحرر من سلطة المجتمع القهريّة، إذ يمكنهم التّعبير عن الذّات بحريّة وبناء هويات بديلة.
- الحاجة إلى التّحقق: يُفسّر الانغماس في هذه العوالم بالبحث عن القبول، والتّقدير الذي قد يفتقده الشّباب في حياتهم الواقعيّة. فالإعجابات والتّعليقات تُصبح مؤشرات للقيمة الذاتيّة، ما يُعزز من سلوك الإدمان.
- الآثار المترتبة: تدهور الصّحّة النّفسيّة والأداء الأكاديمي
تُكمل الدّراسات الأخرى الصورة بإظهار أنّ هذا السلوك الهروبي، يؤدي إلى عواقب سلبيّة مباشرة وغير مباشرة على جوانب متعددة من حياة الشّباب.
- الآثار النّفسيّة: تُثبت دراسة عبد الرّازق (2020) وجود علاقة إيجابيّة بين إدمان وسائل التّواصل الاجتماعي وزيادة الوحدة النّفسيّة والقلق الاجتماعي. وتدعمها دراسة القرني (2023) التي تُشير إلى أنّ الإدمان يؤثر سلبًا على الأمن النّفسي للمراهقين، عبر تعريضهم للمقارنات الاجتماعيّة السّلبيّة والتنمر الإلكتروني، ما يضعف ثقتهم بأنفسهم.
- الآثار الأكاديميّة: تُوضح دراسة كريزي وفحل (2021) العلاقة المباشرة بين الإدمان وتدهور التّحصيل الدّراسي. فالتشتت المعرفي الناتج عن الإشعارات المستمرة، وسوء إدارة الوقت، وتأثيره السّلبي على جودة النّوم، كلها عوامل تساهم في ضعف الأداء الأكاديمي والانعزال الاجتماعي.
بناء عليه، يُمكن استخلاص أنّ هذه الدّراسات تُسلّط الضوء على حلقة مفرغة من الأسباب والعواقب. فالشّباب الّذين يلجؤون إلى الإنترنت كمهرب من الضّغوط الواقعيّة، يجدون أنّ هذا المهرب يُفاقم من مشاكلهم النّفسيّة، ويُقلّل من قدرتهم على مواجهة التّحديات الواقعيّة، بما في ذلك التّحصيل الأكاديمي. هذا التداخل بين العوامل السببيّة والآثار المترتبة، يُؤكد أن إدمان الإنترنت ليس مجرد سلوك سطحي، بل هو ظاهرة معقدة تتطلب نهجًا شاملًا لفهمها ومعالجتها.
6. التأثيرات السّلبيّة لإدمان وسائل التّواصل
يُعدّ إدمان وسائل التّواصل الاجتماعي ظاهرة معقدة تتجاوز مجرد الاستخدام المفرط، لتُحدث تأثيرات سلبيّة عميقة في حياة الأفراد. يمكن تصنيف هذه التّأثيرات ضمن محاور رئيسة، تشمل الجانب الأكاديمي والمهني، والصّحّة النّفسيّة، والعلاقات الاجتماعيّة.
- التأثيرات الأكاديميّة والمهنيّة
يُؤثر الاستخدام المفرط لوسائل التّواصل الاجتماعي بشكل مباشر على الأداء الأكاديمي والإنتاجيّة المهنية. وفاقًا لدراسة Samaha & Hawi (2017)، يقلّل هذا الإدمان من القدرة على التركيز المعرفي، فيتشتت انتباه الأفراد بشكل مستمر بسبب الإشعارات والتّنبيهات. وهذا التّشتت يُعيق قدرتهم على استيعاب المعلومات والمهام المعقدة. ويؤدي الإفراط في استخدام هذه المنصات إلى سوء إدارة الوقت، ما يُقلّل من السّاعات المخصصة للدّراسة أو إنجاز المهام المهنيّة، ويُؤثر سلبًا على جودة العمل المُقدّم.
- التأثيرات على الصّحّة النّفسيّة
يُساهم إدمان وسائل التّواصل الاجتماعي في تدهور الصّحّة النّفسيّة بشكل كبير. تُشير دراسةSmith (2021) إلى أنّ المقارنة الاجتماعيّة تُعدّ عاملًا رئيسًا في زيادة معدلات القلق والاكتئاب. فعندما يتعرض الأفراد بشكل مستمر لـ “اللحظات المثاليّة” من حياة الآخرين، تتزايد لديهم مشاعر عدم الرضا عن الذّات والشّعور بالنّقص. كما أنّ الحاجة المستمرة للتحقق الخارجي من خلال الإعجابات والتعليقات تُضعف الثقة بالنفس وتجعل القيمة الذاتيّة للفرد هشة، ما يُؤدي إلى تقلبات مزاجيّة مرتبطة بالقبول الافتراضي.
- التّأثيرات على العلاقات الاجتماعيّة
على الرغم من أنّ وسائل التّواصل الاجتماعي تهدف إلى تعزيز الروابط الاجتماعيّة، إلّا أنّ إدمانها يؤدي إلى تأثير عكسي تمامًا. إذ يتسبب هذا الإدمان في ضعف التّواصل الواقعي، وانخفاض جودة العلاقات الأُسريّة والاجتماعيّة. يميل الأفراد المدمنون إلى إعطاء الأولويّة للتّفاعلات الافتراضيّة على حساب العلاقات الحقيقيّة وجهًا لوجه، ما يُقلّل من الأنشطة الاجتماعيّة الواقعيّة ويزيد من مشاعر الانعزال. هذا الانفصال عن العالم الحقيقي يُفقد الأفراد فرصة بناء علاقات عميقة وداعمة، ما يُفاقم من مشاعر الوحدة التي قد تكون السّبب الأصلي لجوئهم إلى العالم الافتراضي.
7. الحلول والاستراتيجيات
تُشكل ظاهرة إدمان وسائل التّواصل الاجتماعي تحديًا سلوكيًا يتطلب استجابة منهجيّة قائمة على الأدلة. يمكن تبني مجموعة من الاستراتيجيات العمليّة التي تُسهم في استعادة السّيطرة على السّلوك الرّقمي، وتقليل الاعتماد على هذه المنصات.
- إدارة التنبيهات وتعزيز التركيز المعرفي
تُشير الأبحاث في علم النّفس المعرفي إلى أنّ التنبيهات المستمرة من التّطبيقات تُعدّ من أبرز عوامل تشتيت الانتباه. يُنصح بـإيقاف جميع الإشعارات غير الضروريّة، باستثناء الضروريّة منها. هذا الإجراء يُساعد على تقليل عدد المرات التي يُلتقط فيها المستخدم هاتفه بشكل لاإرادي، ما يُعزز من القدرة على التركيز، ويُقلّل من الجهد المعرفي اللازم للعودة إلى المهام الأساسيّة.
- تطبيق تقنيات الوعي الذّاتي السّلوكي
تُعدّ التقنيات التي تُعزز الوعي الذاتي فعالة في كسر الأنماط السّلوكيّة الإدمانيّة. يُمكن للمستخدمين تطبيق “قاعدة الخمس ثوانٍ”، والتي تتضمن العدّ التنازلي قبل الاستجابة لدافع استخدام الهاتف. هذه اللحظة من الوعي تُعطي الفرد فرصة لتقييم الحاجة الحقيقيّة لاستخدام التطبيق، ما يُضعف الاستجابة الشّرطيّة المرتبطة بالإدمان.
- وضع حدود زمنيّة وتنظيم الاستخدام
يُعدّ تحديد الحدود الزّمنيّة للاستخدام اليومي خطوة محوريّة. يُمكن استخدام تطبيقات المراقبة الرّقميّة المدمجة في أنظمة التّشغيل لتحديد أوقات محددة للاستخدام، أو لحظر التّطبيقات تلقائيًا عند تجاوز الحدّ المسموح به. هذه الإجراءات تُحوّل الاستخدام من سلوك غير واعٍ إلى قرار واعٍ ومُتحكّم فيه.
- الانخراط في أنشطة بديلة مُعزّزة
تُعدّ الاستراتيجيّة الأكثر فعاليّة للحدّ من الإدمان هي استبدال السّلوك الإدماني بأنشطة بديلة مُنتجة وواقعيّة. يُنصح بتخصيص الوقت الذي كان يُقضى على وسائل التّواصل الاجتماعي في ممارسة الهوايات، والأنشطة الرّياضيّة، وتطوير المهارات. كما أنّ الانخراط في التّفاعلات الاجتماعيّة وجهًا لوجه يُعزز من جودة العلاقات الحقيقيّة، ويُقلّل من الشّعور بالوحدة، ويُقلّل من الدّافع للجوء إلى العالم الافتراضي.
- الحدّ من جاذبيّة المنصات الرّقميّة
تُصمّم واجهات المستخدم لزيادة تفاعل المستخدمين. يُمكن مواجهة هذا التّأثير من خلال تعديلات بسيطة على الهاتف. على سبيل المثال، يُساعد تفعيل وضع الشّاشة بالأبيض والأسود على جعل المحتوى أقل جاذبيّة، كما أنّ إخفاء أيقونات التّطبيقات في مجلدات فرعيّة أو في صفحات متأخرة يُقلّل من سهولة الوصول إليها، ما يُعطي المستخدم فرصة لإعادة التّفكير قبل الاستخدام.
8. التوصيات
في ضوء النتائج التي توصّل إليها هذا البحث حول ظاهرة إدمان وسائل التّواصل الاجتماعي وآثارها النّفسيّة والسّلوكيّة، يمكن تقديم التوصيات الآتية:
- على المستوى الفردي:
- الالتزام بتحديد حِقبٍ زمنيّة محددة يوميًا لاستخدام وسائل التّواصل الاجتماعي، مع الاستعانة بتطبيقات أو أدوات تقنية تساعد على مراقبة وضبط مدة الاستخدام.
- الانخراط في أنشطة بديلة ذات قيمة مضافة مثل ممارسة الرياضة، والقراءة، وتطوير المهارات الشّخصيّة، بما يسهم في الحد من الانشغال المفرط بالعالم الافتراضي.
- إيقاف الإشعارات غير الضروريّة، وتقليل عدد التّطبيقات النشطة على الهاتف بهدف الحدّ من المشتتات وتحسين التركيز.
- على المستوى الأُسري والمجتمعي:
- تعزيز ثقافة الوعي الرّقمي من خلال حملات توعويّة موجهة لفئات مختلفة، خاصة المراهقين والشّباب، تركز على مخاطر الإدمان الرّقمي وأساليب التّعامل معه.
- تشجيع الأُسر على تخصيص أوقات يوميّة أو أسبوعيّة خالية من الأجهزة الإلكترونيّة لتعزيز التّفاعل الواقعي وتقوية الرّوابط الاجتماعيّة.
- على المستوى التّعليمي والمؤسسي:
- إدماج موضوعات التربية الرّقميّة، وإدارة الوقت، والوعي بالمخاطر النّفسيّة للتكنولوجيا في المناهج التّعليميّة والبرامج التّدريبيّة.
- توفير ورش عمل ودورات تدريبيّة للطلاب والعاملين حول الاستخدام المتوازن للتقنيات الحديثة، وأساليب الحدّ من آثارها السّلبيّة.
- التّوصيات البحثيّة المستقبليّة:
- إجراء دراسات ميدانيّة على عيّنات واسعة لقياس نسب انتشار الإدمان الرّقمي في السّياق المحلي ومقارنة نتائجه مع السياقات العالميّة.
- دراسة العلاقة بين إدمان وسائل التّواصل الاجتماعي ومؤشرات محددة مثل الذّكاء العاطفي، وجودة النوم، ومستوى الرضا عن الحياة، والأداء الأكاديمي، والإنتاجيّة.
- بحث أثر الإدمان الرّقمي عبر متغيرات ديموغرافيّة كالعمر، والجنس، والمستوى التّعليمي لتحديد الفئات الأكثر عرضة للمخاطر.
- تصميم برامج تدخلية تجريبية وتنفيذها، تهدف إلى الحدّ من الإدمان الرقمي، مع متابعة فاعليتها على المدى القصير والبعيد.
إنّ التوصيات المقدمة تُشكل إطارًا متكاملًا يرتكز على مبادئ العلاج المعرفي السّلوكي (Cognitive Behavioral Therapy: CBT)، فتتناول ظاهرة إدمان وسائل التّواصل الاجتماعي من جوانبها جميعها.
- على المستوى الفردي: تُركّز التوصيات على تعديل السّلوكيات الشّخصيّة والوعي الذاتي. من خلال تنظيم الوقت وإدارة المشتتات مثل الإشعارات، يُصبح الفرد أكثر تحكمًا في تصرفاته. كما أن الأنشطة البديلة تعمل على استبدال السّلوك الإدماني بآخر صحي ومُنتِج.
- على المستوى الأسري والمجتمعي: تُشجع التّوصيات على تغيير البيئة الاجتماعيّة المحيطة بالفرد. حملات التوعية والأوقات الخالية من الأجهزة تُعزز الوعي الجماعي، وتُقوّي الروابط الاجتماعيّة الواقعيّة، ما يُقلّل من الحاجة للهروب إلى العالم الافتراضي.
- على المستوى المؤسسي والتّعليمي: تُقدم التوصيات حلولًا هيكليّة تضمن استدامة التغيير. عبر إدماج التربية الرّقميّة في المناهج وتقديم ورش عمل تدريبيّة، يُزوَّد الأفراد بالمهارات اللازمة للتّعامل مع التكنولوجيا بشكل متوازن وواعٍ منذ الصغر.
- على المستوى البحثي: تُشير التوصيات إلى أهمّيّة توسيع نطاق البحث العلمي لفهم أعمق لظاهرة الإدمان. قياس الانتشار ودراسة العلاقات بين الإدمان ومتغيرات نفسيّة واجتماعيّة، بالإضافة إلى تصميم برامج تدخليّة، يُعزز من القدرة على تطوير حلول فعالة ومبنيّة على الأدلة.
9. الخاتمة
يمثل إدمان وسائل التّواصل الاجتماعي تحديًا معقدًا يتجاوز كونه مجرد ظاهرة تقنية، إذ أصبح واقعًا نفسيًا وسلوكيًا مؤثرًا في أنماط حياة الأفراد والمجتمعات على حدّ سواء. لقد بيّن هذا البحث أنّ الاستخدام المفرط لهذه المنصات لا ينتج فقط عن رغبة شخصيّة في التّواصل أو الترفيه، بل هو نتاج تصميمات تقنية مدروسة تستهدف دوائر المكافأة في الدّماغ، ما يعزز السّلوك الإدماني ويجعل الانفصال عنها أمرًا بالغ الصعوبة.
أظهر البحث أنّ الآثار السّلبيّة للإدمان الرقمي تتجلى في مجالات متعددة، تشمل الصّحّة النّفسيّة، من خلال ارتفاع معدلات القلق والاكتئاب والشّعور بالوحدة، إضافة إلى تراجع التّحصيل الأكاديمي وانخفاض الإنتاجيّة في بيئات العمل، أضف إلى ضعف جودة العلاقات الاجتماعيّة وتآكل الروابط الواقعيّة بين الأفراد. هذه النتائج تدقّ ناقوس الخطر بشأن ضرورة التّدخل المبكر للحدّ من انتشار الظاهرة.
أكّد البحث أنّ مواجهة الإدمان الرّقمي تتطلب استراتيجيّة شموليّة متعددة المستويات، تبدأ بوعي الفرد بمشكلته، مرورًا بدور الأسرة في التّوجيه والمتابعة، وانتهاءً بجهود المؤسسات التّعليميّة والمجتمعيّة في بناء ثقافة رقميّة رشيدة. ومن هنا، تبرز أهمية تفعيل الحلول العمليّة التي عرضها هذا البحث، مثل تحديد أوقات الاستخدام، وإيقاف الإشعارات، واستبدال الأنشطة الرّقميّة بأخرى واقعيّة، إلى جانب إطلاق حملات توعويّة مستمرة.
وإدراكًا للطبيعة المتغيرة والمتسارعة لعالم التكنولوجيا، فإنّ معالجة هذه الظاهرة ليست حلًّا لمرة واحدة، بل هي عمليّة مستمرة تتطلب المتابعة والتقييم المستمرين، وتطوير أدوات ووسائل جديدة تتناسب مع التطورات التقنيّة، وأساليب الجذب التي تبتكرها المنصات الرّقميّة. وفي هذا السّياق، تمثل الأبحاث المستقبليّة عنصرًا محوريًا في فهم أعمق لآثار الإدمان الرّقمي واقتراح تدخلات أكثر فعاليّة، بما يضمن تحقيق توازن صحي ومستدام بين العالمين الواقعي والافتراضي.
- القرني، منصور مسفر. (2023). إدمان شبكات التّواصل الاجتماعي وعلاقته بالأمن النفسي. المجلة الأكاديمية للأبحاث والنشر العلمي، 49، 112-130.
- بونقار، نجاح. (2023). واقع إدمان الشباب للإنترنت: دراسة نظرية. مجلة الآداب والعلوم الاجتماعية، 15(1)، 45-60.
- كريزي، وفحل. (2021). إدمان مواقع التّواصل الاجتماعي وعلاقته باضطرابات النوم لدى طلبة جامعة اليرموك. مجلة العلوم التربوية والنّفسيّة، 2(1)، 89-105.
- عبد الرازق، أسامة حسن جابر. (2020). إدمان وسائل التّواصل الاجتماعي وعلاقته بالشعور بالوحدة النّفسيّة وسمات القلق الاجتماعي لدى طلاب الجامعة. المجلة الدولية للعلوم الإنسانية والاجتماعية، 14، 210-241.
- رفيق، محبوبي، و بلعادي، إبراهيم. (2024). واقع إدمان الشباب للإنترنت: دراسة نظرية. مجلة دراسات إنسانية واجتماعية، مج13, ع1، 333 – 346. مسترجع من http://search.mandumah.com/Record/1443353
- Andreassen, C. S. (2015). Online social network site addiction: A review of theoretical and empirical evidence. Addiction Research & Theory, 23(1), 1–20.
- Błachnio, A., Przepiorka, A., & P & (2016). The relationship between Facebook addiction and self-esteem: The moderating effect of social comparison. In Proceedings of the 2nd International Conference on Social Computing and Social Media. Springer.
- Brown, L., & Davis, K. (2020). The dopamine effect: Social media and brain reward systems. Neuropsychology Today, 8(2), 15–29.
- dscout. (2016). What Are the Most Touched Phones in the World?
- GlobalWebIndex. (2024). Social media usage statistics. Retrieved from https://www.globalwebindex.com.
- Hawi, N. S., & Samaha, M. (2017). The effect of social media addiction on academic performance. Computers in Human Behavior, 69, 437–442.
- Ryan, T., Chester, A., Reece, J., & Xenos, S. (2014). The uses and abuses of Facebook: An exploratory study of the effects of social comparison and envy on mental well-being. Computers in Human Behavior, 33, 133–139.
- Smith, J. (2021). Social media addiction: Causes and consequences. Journal of Digital Behavior, 12(3), 45–60.
أستاذ مساعد في الجامعة اللبنانيّة ـ بيروت- لبنان- معهد العلوم الإجتماعيّة-[1]
Assistant Professor at the Lebanese University – Institute of Social Sciences- Beirut – Lebanon -. Email:Houssein.nasser@ul.edu.lb