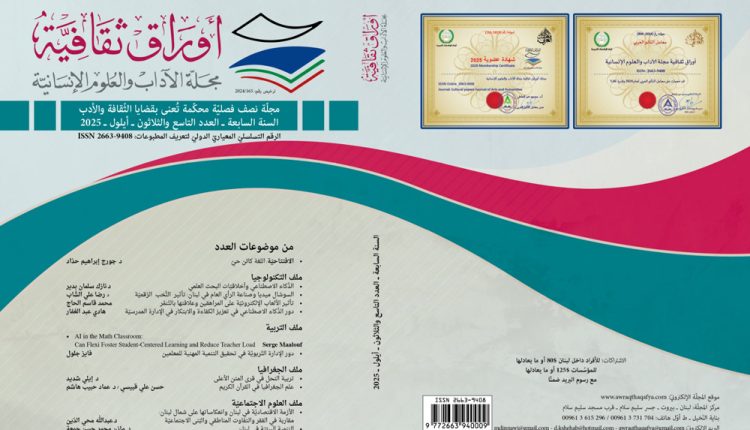عنوان البحث: نقض القرار 194 والفِقرة 11 منه: قراءة قانونيّة نقديّة
اسم الكاتب: حسين محمود رمال
تاريخ النشر: 2025/09/15
اسم المجلة: مجلة أوراق ثقافية
عدد المجلة: 39
تحميل البحث بصيغة PDFADOI: https://aif-doi.org/awraq/013914
نقض القرار 194 والفِقرة 11 منه: قراءة قانونيّة نقديّة
A Critical Legal Review of UN Resolution 194 and its Article 11
Hussein Mahmoud Ramml حسين محمود رمال([1])
تاريخ الإرسال:22-8-2025 تارخ القبول:6-9-2025
الملخص يتناول هذا البحث القرار 194 الصادر عن الجمعيّة العامة للأمم المتحدة في كانون الأول/ديسمبر 1948، مع تركيز خاص على الفقرة 11 منه المتعلقة بحقّ العودة للاجئين الفلسطينيين. يقدّم البحث قراءة قانونيّة نقديّة، تبرز أنّ القرار جاء في سياق سياسي مهيمن من القوى الكبرى، ولم يشكّل التزامًا ملزمًا على إسرائيل بالعودة أو التّعويض، بل أسهم عمليًا في تكريس الاحتلال عبر طابعه التّوصوي غير الملزم. كما يوضح البحث كيف استُخدم القرار كأداة سياسيّة أكثر منه نصًا قانونيًا قابلاً للتنفيذ، وهو ما جعل الفقرة 11 محل جدل واسع منذ صدورها حتى اليوم.
الكلمات المفتاحيّة: القرار 194 – الفقرة 11 – حقّ العودة – القانون الدّولي – فلسطين.
Abstract
This research addresses UN General Assembly Resolution 194 of December 1948, focusing specifically on Article 11 concerning the Palestinian refugees’ right of return. The paper provides a critical legal reading, highlighting that the resolution emerged within a political context dominated by major powers and did not constitute a binding obligation on Israel to implement return or compensation. Instead, it contributed to legitimizing the occupation due to its non-binding nature. The study also explains how Resolution 194 has been used more as a political tool rather than a legally enforceable text, which has led Article 11 to remain a point of dispute until today.
Keywords: UN Resolution 194 – Article 11 – Right of Return – International Law – Palestine
المبحث الأول: نقض القرار 194 والفقرة 11 منه – قراءة قانونيّة نقديّة
المقدمة: شكّل القرار 194 الصّادر عن الجمعيّة العامة للأمم المتحدة في 11 كانون الأول/ديسمبر 1948 محطة أساسيّة في مسار القضية الفلسطينيّة، وخصوصًا في ما يتعلّق بمصير اللاجئين الفلسطينيين الذين هجّرتهم العصابات الصّهيونيّة بعد نكبة 1948. فقد نصّت الفقرة 11 منه على حقّ اللاجئين في العودة إلى ديارهم في أقرب وقت ممكن، وتعويض من لا يرغب بالعودة. وعلى الرّغم من أنّ هذا النّص بدا للوهلة الأولى وكأنّه انتصار لحقّوق الفلسطينيين، إلّا أنّه في العمق حمل الكثير من الغموض والمطبات القانونيّة والسياسية([2]).
إشكاليّة البحث: تقوم على السؤال الآتي: هل يشكل القرار 194 سندًا قانونيًا حقّيقيًا لحقّ العودة، أم أنّه مجرد نص سياسي رمزي استُخدم لتكريس الاحتلال بدل إنهائه؟
للإجابة، يعتمد البحث منهجًا تحليليًا نقديًا يدرس:
- الظروف التي أحاطت بصدور القرار.
- طبيعة القرار في الإلزاميّة القانونيّة.
- الفقرة 11 وما تحمله من إشكالات.
- مواقف الدّول والمنظمات من القرار.
- مقارنة مع نصوص القانون الدّولي الأشد قوة.
أهمّيّة البحث: تكمن في أنّه لا يكتفي بإعادة عرض القرار، بل يقدّم قراءة نقديّة معمقة تبرز نقاط ضعفه وقصوره، ويؤكد أنّ حقّ العودة يجب أن يستند إلى قواعد قطعية في القانون الدّولي، لا إلى توصيات سياسية عامة.
الفصل الأول: الظروف السياسيّة لصدور القرار
صدر القرار 194 في سياق بالغ التّعقيد. يوم كانت الحرب العربيّة–الإسرائيليّة الأولى في أوجها، وقد أعلنت إسرائيل قيام دولتها في أيار/مايو 1948، في ما كان مئات آلاف من الفلسطينيين قد طُردوا من قراهم ومدنهم. المجتمع الدّولي وجد نفسه أمام كارثة إنسانيّة غير مسبوقة في المنطقة، لكنّه في الوقت ذاته كان تحت تأثير ميزان القوى الذي مالت كفته لمصلحة القوى الغربيّة الدّاعمة لإسرائيل(2)
الجمعيّة العامة حاولت من خلال القرار 194 أن تُظهر نفسها كوسيط “حيادي”، فشكّلت لجنة التوفيق الدّولية، وأقرت مبدأ العودة والتعويض. إلّا أنّ صياغة القرار جاءت ملتبسة، إذ ربطت العودة بعبارة “الراغبون بالعيش بسلام مع جيرانهم”، ما فتح الباب أمام إسرائيل لتفسير النص كما تشاء([3]).
تكشف الظروف التي أحاطت بالقرار أنّه لم يكن وليد قناعة راسخة بحقّ الفلسطينيين، بل نتاج مساومات دوليّة أرادت تهدئة الموقف من دون إغضاب إسرائيل.
المبحث الأول: الطبيعة القانونيّة للقرار
لا يرقى القرار 194 من الناحية القانونيّة إلى مرتبة الإلزام، لأنّه صدر عن الجمعيّة العامة لا عن مجلس الأمن. والجمعيّة العامة، وفق ميثاق الأمم المتحدة، لا تُصدر قرارات ملزمة للدول، بل توصيات لها طابع سياسي وأخلاقي.
هذا ما جعل إسرائيل ترفض القرار منذ البداية، مؤكدة أنها غير ملزمة به. في المقابل، تمسك العرب والفلسطينيون بالقرار كمرجعيّة دوليّة لحقّ العودة، عادّين أنه يشكل اعترافًا ضمنيًا بهذا الحقّ. لكن هذا التّمسك لم يغير حقّيقة أنّ القرار يفتقر إلى القوة التّنفيذيّة. أضف إلى أنّ هذا القرار لا ينصف حقّ العودة لشّعب أخرج من أرضه بالقوة.
تمثل الطبيعة التّوصويّة للقرار أحد نقاط ضعفه المهمّة. فالحقّ الذي يفترض أن يكون قطعيًا ومطلقًا جرى ربطه بتوصية قابلة للتّجاهل، ما أضعف الموقف الفلسطيني واللبناني معًا. ([4])
المبحث الثاني: الفقرة 11 – قراءة في النص
نصت الفقرة 11 من القرار على أنّ “اللاجئين الراغبين في العودة إلى ديارهم، والعيش بسلام مع جيرانهم يجب أن يُسمح لهم بالعودة في أقرب وقت ممكن”، وأن يُعوَّض على من لا يرغب بالعودة.
هنا تكمن عدة إشكالات:
- اشتراط الرّغبة في “العيش بسلام مع الجيران“: صياغة فضفاضة سمحت لإسرائيل بالقول إنّ اللاجئين يشكلون تهديدًا أمنيًا، وغير مؤهلين للعودة([5]).
- الخلط بين العودة والتّعويض: القرار أعطى إسرائيل ذريعة للقول إنّ التعويض بديل عن العودة، مع أن القانون الدّولي يعدُّ العودة حقّا أصيلًا لا بديل عنه.
- غياب آلية التنفيذ: لم يحدد القرار وسيلة لإلزام إسرائيل بتنفيذه، ما جعله نصًا بلا قوّة عمليّة.
بدت الفقرة 11 ظاهريًا وكأنّها انتصار للاجئين، لكنّها في الحقّيقة نصّ حمال أوجه، سمح لإسرائيل بالتّهرب من التزاماتها. وأعطت إسرائيل صلاحيّة السّماح لمن يريد العودة من عدمها ما كرس الاحتلال أمرًا واقعًا.
المبحث الثالث: لجنة التوفيق الدّولية
لتنفيذ القرار 194، أنشأت الجمعيّة العامة لجنة التوفيق الدّوليّة (UNCCP). لكن هذه اللجنة لم تتمكن من تحقّيق أيّ تقدّم يُذكر. فإسرائيل رفضت التّعاون معها، والدول الكبرى لم تمارس ضغطًا حقّيقيًا لإنجاح مهمتها([6]).
أصدرت اللجنة عدة تقارير أكّدت فيها استحالة تنفيذ العودة من دون تعاون إسرائيلي، وأوصت بحلول بديلة مثل التعويض وإعادة التوطين. وبذلك، تحولت اللجنة من أداة لتثبيت حقّ العودة إلى أداة لتصفية هذا الحقّ.
عجزت لجنة التوفيق عن أن تبرهن أنّ القرار 194 كان منذ البداية ورقة سياسيّة أكثر منه أداة قانونيّة ملزمة. فهو بالأصل قرار معطل ذاتًا لعلة الفقرة 11 منه التي كرست الاحتلال وجعلت التّعويض جهوي وتوطين اللاجئين حيث هم.
الفصل الثاني: المواقف الدّوليّة من القرار 194
منذ صدوره القرار، انقسمت المواقف الدّوليّة حوله. فالدّول الغربيّة التي كانت أساسًا من أشدّ الدّاعمين لإسرائيل في مرحلة تأسيسها، تعاملت مع القرار بوصفه مجرد توصية سياسيّة تهدف إلى تهدئة الغضب العربي والإسلامي. الولايات المتحدة، على سبيل المثال، أعلنت في أكثر من مناسبة دعمها “المبدئي” لحقّ العودة، لكنها لم تمارس أي ضغط حقّيقي على إسرائيل لتنفيذه([7]).
أمّا الاتحاد السوفياتي آنذاك، فقد أيد القرار بوصفه يعكس مبدأ حقّ الشّعوب في تقرير المصير، لكنه لم يتخذ إجراءات عمليّة. ومع مرور الوقت، تراجعت الأولويّة الدّولية لملف اللاجئين، إذ طغت الحرب الباردة على اهتمامات القوى الكبرى، وصارت قضية العودة ورقة في لعبة التّوازنات الدّوليّة([8]).
كشفت المواقف الدّولية أنّ القرار كان منذ البداية رهينة الحسابات السياسية الكبرى، ولم يحظَ أبدًا بإرادة تنفيذ حقيقيّة.
المبحث الأول: الموقف الإسرائيلي
إسرائيل رفضت القرار 194 منذ اللحظة الأولى، حاسبة أنّه يتعارض مع طبيعة الدّولة اليهوديّة التي أرادت إنشاءها. فعودة مئات آلاف الفلسطينيين كانت ستُهدد الأغلبيّة اليهوديّة التي سعت الحركة الصّهيونيّة لتكريسها. لذلك، حسبت الحكومات الإسرائيليّة المتعاقبة أنّ العودة “مستحيلة” لأسباب أمنيّة وديمغرافيّة، واقترحت بدلًا منها تعويضات ماليّة أو توطين اللاجئين في الدّول العربيّة([9]).
واستخدمت إسرائيل صياغة الفقرة 11 لمصلحتها، فاشترطت أنّ اللاجئين يجب أن يثبتوا استعدادهم “للعيش بسلام مع جيرانهم”، وحسبت أنّ الفلسطينيين، بصفتهم طرفًا في الحرب، لا تتوافر فيهم هذه الشروط. وبذلك، حوّلت النص من اعتراف بالحقّ إلى أداة للنفي. والفقرة ذاتها ساعدت الاحتلال على التملص من أي التزام.
أثبت الموقف الإسرائيلي أنّ القرار لم يكن سوى ورقة سياسيّة، لأنّ الطرف الأساسي المعني به أعلن بوضوح رفضه منذ البداية، من دون أن يلقى أيّ عقوبة دوليّة. أولاها سحب الإعتراف بالدّولة الإسرائيليّة لأنّ شرط الاعتراف هو القبول بقرار التّقسيم 181/1947 والقرار 194/1948 والفقرة البتراء 11 منه.
المبحث الثاني: الموقف العربي
تمسك العرب والفلسطينيون على الضفة الأخرى، بالقرار 194 كمرجعيّة أساسية. فجامعة الدول العربيّة أدرجته في بياناتها وخططها، وعدّته السند الدّولي الوحيد الذي يقرّ بحقّ العودة. بالنسبة إلى الفلسطينيين، كان القرار اعتراف ضمني من المجتمع الدّولي بظلم ما جرى، ولذلك صار جزءًا من الهُويّة الوطنيّة الفلسطينيّة([10]).
غير أنّ هذا التمسك لم يغيّر من واقع أنّ القرار بلا آلية تنفيذ. وبمرور الوقت، بدأت بعض الدّول العربية، تحت ضغوط سياسيّة واقتصاديّة، تُظهر استعدادًا لقبول حلول وسط تشمل التعويض أو التوطين الجزئي، الأمر الذي أضعف الموقف الموحد. تمسّك العرب بالقرار 194 شكّل عنصر قوة رمزيًّا، لكنه بقي محصورًا في إطار الخطاب السياسي، من دون أن يتحوّل إلى ورقة ضغط عمليّة على المستوى الدّولي. فالقرار أصلًا خالٍ من الوضوح لجهة حقّ العودة لا بلّ أنّ التّعويض هو الأبرز من تمويل التوطين يتجه نحو الدولة العربيّة بحسب صفقة القرن 2019.
المبحث الثالث: الموقف اللبناني
لبنان كان من أكثر الدّول العربيّة تمسكًا بالقرار 194، ليس فقط من باب التضامن مع الفلسطينيين، بل من منطلق مصلحته الوطنية. فقبول التوطين كان سيعني تغييرًا جذريًا في تركيبته السكانية والطائفية، ما يهدد نظامه السياسي القائم على التوازن بين الطوائف([11]). لذلك، أعلن لبنان في كل المحافل الدّوليّة أنّ الحل الوحيد هو عودة اللاجئين، وأنّ أي مشروع للتوطين يُعدُّ تهديدًا مباشرًا لسيادته. هذا الموقف انسجم لاحقّا مع الدستور اللبناني بعد تعديل الطائف (1990)، الذي نص بوضوح على رفض التوطين.
يعكس الموقف اللبناني من القرار 194 تقاطعًا بين مصلحة وطنيّة داخليّة ومبدأ قانوني دولي، ما جعل لبنان أكثر تشددًا من غيره في رفض أي بديل عن العودة. والفقرة 11 من القرار 194/1948 تستهدف لبنان لجهة التوطين بإغرائه بالمال بسبب وضعه الاقتصادي المرهق انطلاقًا من عبارة التعويض التي جاءت بها الفقرة 11 من القرار 194.
الفصل الثالث: قصور القرار 194
بعد مرور أكثر من سبعين عامًا على صدور القرار، لم يُنفذ منه شيء، والسّبب الجوهري هو قصوره البنيوي:
- غياب الإلزاميّة القانونيّة: القرار توصية فقط، ما أتاح لإسرائيل تجاهله دون عقاب([12]).
- الصياغة الغامضة: عبارة “الراغبين بالعيش بسلام” استخدمت ذريعة للرفض.
- الخلط بين العودة والتعويض: فتح الباب أمام حلول بديلة عن العودة.
- غياب آلية التنفيذ: لجنة التوفيق عجزت عن فرض أي التزام.
لم يكن القرار 194 أداة لحماية اللاجئين، بل ورقة لامتصاص الغضب الدّولي. بل يمكن القول إنّه ساهم في إدامة الأزمة، لأنّه أعطى انطباعًا بوجود “حلّ” بينما الواقع كان العكس. إطالة أمد الاحتلال وتمكينه من التّوسع في فلسطين ودول الجوار بطريقة أو بأخرى.
المبحث الأول: القرار 194 في ضوء القانون الدّولي لحقّوق الإنسان
عند النظر إلى القرار 194 بالمقارنة مع نصوص القانون الدّولي لحقّوق الإنسان، يتضح القصور بشكل أكبر. فالمادة 13 من الإعلان العالمي لحقّوق الإنسان (1948) تنص بوضوح على أنّ “لكل فرد الحقّ في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده، والعودة إليه”([13]). كذلك نصّت المادة 12 من العهد الدّولي الخاص بالحقّوق المدنيّة والسياسيّة (1966) على أنّ “لكلّ فرد حريّة مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده، ولا يجوز حرمان أحد تعسفًا من حقّ الدخول إلى بلده”([14]).
هذا يعني أنّ العودة ليست مجرد حقّ سياسي مرتبط بمفاوضات، بل حقّ فردي غير قابل للتصرف. ما يعني إنّ الاكتفاء بالقرار 194 كمرجعيّة لحقّ العودة يُعدّ تنازلًا، لأنّ نصوص حقّوق الإنسان توفر أساسًا أقوى وألزم قانونيًا.
إذا قورن القرار 194 بالإعلان العالمي والعهد الدّولي، يظهر أنّه أضعف بكثير، بل وأقلّ حماية للاجئين. وهو ما يفرض إعادة توجيه الخطاب الفلسطيني، واللبناني نحو هذه النّصوص القطعيّة بدل التمسك الأعمى بالقرار 194.
المبحث الثاني: القرار 194 في ضوء القانون الدّولي الإنساني
إلى جانب حقّوق الإنسان، يبرز القانون الدّولي الإنساني كإطار أكثر قوة لحماية حقّوق اللاجئين. فالمادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة (1949) تنص على أنّه “لا يجوز النقل القسري الجماعي أو الفردي للأشخاص المحميين من الأراضي المحتلة إلى أراضي دولة أخرى”([15]).
هذا النص ينسف عمليًا أي مشروعية للتوطين، لأنّه يعدُّ استمرار بقاء اللاجئين خارج وطنهم نتيجة تهجير قسري جريمة دوليّة. وبذلك، فإنّ العودة ليست خيارًا سياسيًا، بل واجب قانوني على الدّولة التي هجّرتهم.
مقارنة مع القرار 194، يظهر أنّ الأخير لا يرتقي إلى هذا المستوى من القوة. إذ لم يُعدُّ التّهجير جريمة، ولم يفرض عقوبات أو إجراءات على من يمنع العودة.
يصبح القرار 194 في ضوء القانون الدّولي الإنساني، مجرّد خطوة ناقصة، بل ربما معيقة، لأنّه حوّل القضيّة من حقّ مطلق إلى خيار تفاوضي.
المبحث الثالث: نقد تفصيلي للفقرة 11 – شرط “العيش بسلام“
اشترطت الفقرة 11 أنّ اللاجئين العائدين يجب أن يكونوا “راغبين بالعيش بسلام مع جيرانهم”. هذه العبارة استخدمتها إسرائيل لتقول إنّ اللاجئين يشكلون تهديدًا أمنيًا، ولا يمكن إعادتهم([16]).
لكن من منظور القانون الدّولي، هذا الشرط غير مقبول. فحقّ العودة حقّ فردي مطلق، لا يُشترط بموقف سياسي أو نية مفترضة. بل إنّ حرمان لاجئ من العودة بسبب “اتهام جماعي” يتعارض مع مبدأ المسؤوليّة الفرديّة، ويشكل تمييزًا جماعيًا باطلًا.
الأخطر أنّ هذا الشّرط فتح الباب أمام إسرائيل لإفراغ النّص من مضمونه. فبدل أن يكون القرار حماية للاجئين، صار أداة لنفي حقّهم، بحجة الأمن والسلام.
يجعل اشتراط “العيش بسلام” في الفقرة 11 القرار نصًا مضللًا، لأنّه منح إسرائيل المبرر القانوني لرفض العودة، وأعفاها من أي التزام فعلي.
المبحث الرابع: نقد تفصيلي للفقرة 11 – الخلط بين العودة والتعويض
تحدثت الفقرة 11 عن العودة والتعويض معًا. غير أنّ الصياغة أوحت وكأنّ التّعويض بديل عن العودة. وهذا ما استغلته إسرائيل لتطرح حلولًا مالية بدل السماح بعودة اللاجئين([17]).
لكن القانون الدّولي يفرّق بوضوح: العودة حقّ أصيل، والتّعويض حقّ إضافي يكمل العودة ولا يلغيها. فالمادة 8 من الإعلان العالمي لحقّوق الإنسان تنص على حقّ كل فرد في الحصول على تعويض عادل عند انتهاك حقّوقه. لكن هذا لا يعني أنّ التعويض يحلّ محلّ الحقّ الأساسي.
أساءت صياغة الفقرة 11 للقضية، لأنّها فتحت الباب أمام حلول بديلة، بينما الأصل هو العودة. وبهذا المعنى، يمكن القول إنّ القرار 194 لم يحفظ الحقّ، بل قزّمه إلى مجرد خيار مالي.
المبحث الخامس: نقد تفصيلي للفقرة 11 – غياب آليات التنفيذ
أبرز ثغرة في القرار 194 هي غياب أي آلية إلزاميّة للتّنفيذ. فالنص لم يحدد جدولًا زمنيًا، ولا إجراءات عقابيّة ضد إسرائيل في حال الرّفض، ولا جهة مسؤولة عن الإشراف على العودة.
لجنة التوفيق (UNCCP) التي أنشأها القرار لم تكن تمتلك صلاحيات تنفيذيّة، بل اقتصرت مهمتها على الوساطة ورفع التقارير. ومع الرفض الإسرائيلي الكامل والتقاعس الدّولي، أصبحت اللجنة مجرد مؤسسة شكلية بلا جدوى([18]).
غياب آليات التنفيذ جعل القرار نصًا بلا روح. فهو أشبه ببيان أخلاقي لا بأداة قانونيّة، ما أتاح لإسرائيل أن تلتف عليه بسهولة، وللمجتمع الدّولي أن يتنصل من مسؤوليته.
الفصل الرابع: المواقف الدّولية المقارنة – بين النص والواقع
على الرّغم من أن القرار 194 صار جزءًا من الخطاب الأممي الرّسمي بشأن القضية الفلسطينيّة، إلّا أنّ تنفيذه ظلّ مرهونًا بمواقف الدول الكبرى. الولايات المتحدة، منذ الخمسينيات، تعاملت معه كـ “توصية أخلاقيّة” وليس التزامًا قانونيًا، واقترحت حلولًا بديلة مثل إعادة توطين اللاجئين في الدّول العربية مع تعويضات ماليّة([19]). أمّا الاتحاد الأوروبي، فقد أبدى دعمًا لفظيًا للقرار، لكنه ركّز عمليًا على مقولة “الحلول الواقعيّة” التي تبتعد من العودة الشّاملة.
على الجانب الآخر، ظلّت معظم الدول العربية متمسكة بالقرار بوصفه السند الوحيد لحقّ العودة، غير أنّ هذا التّمسك لم يترافق مع خطوات عمليّة، خاصة بعد توقيع اتفاقيّات سلام منفردة كاتفاقيّة كامب ديفيد (1978) التي همّشت موضوع اللاجئين([20]).
يكشف القرار أنّ القوى الكبرى ساهمت في تفريغه من مضمونه عبر ترويج بدائل عنه. وهذا ما تجلى في اتفاق أوسلو العام 1993 برعاية الولايات المتحدة الأميركيّة إذ رُحِّل هذا الاتفاق حقّ العودة إلى المرحلة النهائيّة من دون أي التزام إسرائيلي أو أيّ ضمانة دوليّة في هذا الصدد.
المبحث الأول: أثر القرار 194 على اللاجئين الفلسطينيين
منذ 1948 حتى اليوم، بقي ملايين اللاجئين الفلسطينيين يعيشون في المنافي، معظمهم في الأردن، لبنان، سوريا، إضافة إلى الضّفة الغربيّة وقطاع غزة. وعلى الرّغم من التّمسك السياسي بالقرار 194، إلّا أنّ أوضاعهم المعيشيّة لم تتحسن جذريًا([21]).
اللاجئون في لبنان، على سبيل المثال، يُعدُّن من أكثر الفئات حرمانًا، وعاشوا في مخيمات مكتظة تفتقر إلى البنية التّحتيّة الأساسيّة. هذه المعاناة المستمرة دفعت كثيرًا من الباحثين إلى القول إنّ القرار 194 لم يكن سوى حبر على ورق، لأنّه لم يُترجم إلى تحسين أوضاعهم أو ضمان عودتهم([22]).
لم يحقّق القرار 194 للاجئين سوى “وهم الأمل”. فبينما ظلّوا يتمسكون به كرمز لحقّهم، ظلّ المجتمع الدّولي يتعامل معه كملف مؤجل. وقبول العرب والفلسطينيين بهذا القرار يسجل عليهم وليس لهم.
المبحث الثاني: موقف لبنان من القرار 194
تبنّى لبنان القرار كمرجعيّة أساسيّة في خطابه السياسي والدّبلوماسي. لكنه تعامل معه بحذر شديد. فبينما كان يطالب بعودة الفلسطينيين إلى ديارهم، كان في الوقت نفسه يرفض أي مشروع يؤدي إلى توطينهم في أراضيه. هذا الموقف انسجم مع خصوصيّة النظام اللبناني، الذي يرى في التوطين خطرًا وجوديًا([23]).
كررت الوفود اللبنانيّة في الأمم المتحدة دائمًا أنّ “العودة هي الحلّ الوحيد العادل”، وأنّ أي محاولة لتوطين الفلسطينيين في لبنان تعني انتهاكًا صارخًا للدستور والسيادة الوطنيّة. (لا توطين لا تجزئة لا تقسيم) ومع ذلك، فإنّ اعتماد لبنان على القرار 194 كمرجعية أساسية جعله عرضة لانتقادات داخلية، بوصف أنّ القرار ضعيف قانونيًا([24]).
يتمسك لبنان بموقف من القرار الّذي يُعدُّ كرمز دولي، لكنه في الواقع يعتمد أكثر على دستوره وقوانينه الوطنية كخط دفاع حقّيقي ضد مشاريع التوطين. وخاصة بعد صفقة القرن بعد 2019 حيث خطر التوطين صار داهمًا ويجب الحذر منه.
المبحث الثالث: مقارنة مع الموقف الأردني والسوري
اتخذ الأردن موقفًا مختلفًا. فبعد منحه الجنسيّة الأردنيّة لمعظم اللاجئين الفلسطينيين، بدا وكأنّه يقبل عمليًا بحل التّوطين الجزئي، وإن ظلّ يطالب نظريًا بحقّ العودة([25]). سوريا من جهتها رفضت التوطين بشكل مطلق، لكنها في الوقت نفسه منحت الفلسطينيين حقّوقًا اجتماعيّة واسعة، بما فيها العمل والتعليم، من دون أن تعطيهم الجنسيّة.
هذه المواقف تعكس اختلافًا في مقاربة القرار 194: لبنان رأى فيه تهديدًا لديمغرافيته، الأردن استعمله كورقة تفاوضيّة، وسوريا استثمرته سياسيًا ضد إسرائيل من دون القبول بأي بدائل.
تُظهر المقارنة الإقليمية أنّ القرار لم يوفّر مرجعيّة موحدة، بل فُسّر بشكل مختلف حسب مصلحة كل دولة، ما زاد من هشاشة الموقف الفلسطيني.
الفصل الخامس: القرار 194 كأداة لتكريس الاحتلال
على الرّغم من أنّ القرار صُوّر كاعتراف بحقّ العودة، إلّا أنّ مضمونه العملي سمح لإسرائيل بتكريس احتلالها. فقد استغلت إسرائيل الغموض في النّصوص لرفض عودة اللاجئين، وفي الوقت نفسه استخدمت لجنة التوفيق كغطاء لمشاريع إعادة التوطين.
جعل القرار 194 المجتمع الدّولي يظن أنّ القضية “محسومة قانونيًا”، بينما الواقع أنّ الحقّ ظلّ معلّقًا من دون تنفيذ([26]). بل يمكن القول إن القرار ساهم في تمييع القضية، وهنا يكمن خطره وقد وفّر غطاءً سياسيًا لغياب الحلَّ العملي.
كان هذا القرار خطوة إلى الوراء أكثر منه إلى الأمام. فبدل أن يكرّس حقّا مطلقًا، حوّله إلى ملف تفاوضي مفتوح، ما مكّن إسرائيل من الاستفادة من الوقت لتثبيت وقائع الاحتلال والاستيطان. فالفقرة 11 منه تعطي إسرائيل هامش المناورة في التفاوض.
الفصل السادس: القرار 194 في المفاوضات الحديثة
بعد توقيع اتفاقية أوسلو (1993)، دخل القرار 194 مرحلة جديدة من الاستخدام السّياسي. فقد أدرجته القيادة الفلسطينيّة ضمن ملفات “الحلّ النهائي”، إلى جانب القدس والمستوطنات والحدود. غير أنّ إدراجه لم يكن من موقع القوة، بل من باب التّمسك بالحدّ الأدنى المتاح([27]).
عدّت إسرائيل، في المقابل أنّ ذكره في أوسلو لا يعني القبول به، بل مجرّد إدراج رمزي قابل للتفاوض. ومع مرور الوقت، تراجع الحديث عن “العودة الشّاملة”، وحلّ مكانه خطاب “العودة المحدودة” أو “التّعويض”، خصوصًا في مفاوضات كامب ديفيد الثانية (2000) وخارطة الطريق (2003)([28]) . لم يقوّ إدخال القرار 194 في مسار التّفاوض من مكانته، بل أضعفه أكثر، إذ جعله جزءًا من مساومات سياسيّة بدل أن يكون حقّا مطلقًا غير قابل للتفاوض.
المبحث الأول: القرار 194 و”خطة كلينتون“
طرح الرئيس الأميركي بيل كلينتون في العام 2000، ما عُرف بـ “معايير كلينتون” لحلّ النزاع الفلسطيني–الإسرائيلي. تضمنت الخطة بنودًا تخص اللاجئين، لكنها لم تنص على العودة الكاملة. بل اقترحت خمسة خيارات: العودة إلى الدولة الفلسطينيّة المستقبليّة، العودة إلى مناطق تبادل الأراضي، إعادة التّوطين في الدّول المضيفة، الهجرة إلى دول ثالثة، وتعويض مالي([29]).
استُخدم القرار هنا كإطار مرجعي فضفاض، لكن مضمونه فُرّغ من محتواه، لأنّ الخطة لم تنص على العودة إلى داخل إسرائيل. وهذا أثبت أنّ القوى الكبرى لا ترى في القرار سوى أداة لتغطية حلول بديلة عن العودة، فكشف كيف يمكن للنصوص القانونيّة الضّعيفة أن تتحول إلى غطاء لتمرير حلول سياسية على حساب الحقّوق التاريخية.
المبحث الثاني: القرار 194 و”صفقة القرن“
طرحت الإدارة الأميركية في العام 2020، خطة “صفقة القرن” التي تجاهلت عمليًا القرار 194، وأعلنت أنّ اللاجئين الفلسطينيين لن يعودوا إلى ديارهم داخل إسرائيل، بل يمكن استيعابهم في الدّولة الفلسطينيّة المقترحة أو إعادة توطينهم في دول أخرى([30]).
هذا الموقف لم يكن جديدًا، لكنه كان الأكثر وضوحًا في تجاوز القرار 194. فقد تحولت العودة من حقّ معترف به دوليًا إلى مجرد خيار غير مطروح. واللافت أنّ بعض القوى الدّولية عدّت الخطة “واقعية”، ما كشف أنّه لم يعد يتمتع بأيّ قيمة إلزاميّة حتى على المستوى الرمزي. وبهذا مثّلت صفقة القرن القطيعة النهائيّة مع القرار، وأثبتت أنّ التّمسك به من دون تطوير خطاب قانوني بديل يجعل الموقف الفلسطيني واللبناني ضعيفًا أمام المبادرات الدّوليّة. ولذلك كان رفض التّوطين في الدّستور اللبناني أكثر من ضرورة لعلة عدم تخطي لبنان كدولة معترف بها دولاً، ودفعت أثمانًا باهظة من تداعيات القضية الفلسطينيّة.
المبحث الثالث: الموقف اللبناني النقدي من القرار
تعامل لبنان، بخلاف السّلطة الفلسطينيّة، مع القرار بحذر نقدي. ففي حين تمسكت منظمة التّحرير به كمرجعيّة أساسية، ظلّ لبنان يؤكد أنّ العودة يجب أن تستند إلى مبادئ القانون الدّولي الأشد قوة، مثل الإعلان العالمي والعهدين الدّوليين، وليس فقط القرار 194([31]).
هذا الموقف اللبناني نابع من مصلحته المباشرة. فقبول أيّ تفسير بديل للقرار، مثل التعويض أو التوطين، يعني فرض توطين الفلسطينيين على أراضيه. لذلك، أعلن لبنان مرارًا أنّ القرار غير كافٍ، وأنّ الدستور اللبناني يحسم المسألة عبر النّص الصريح على رفض التوطين.
يبرهن الموقف اللبناني أنّ هذا القرار ليس ضمانة، بل قد يكون فخًا، وأنّ حماية لبنان لحقّ العودة أقوى عندما تستند إلى قواعد القانون الدّولي القطعية لا إلى توصيات سياسيّة.
خلاصة الفصل: من خلال تتبع مسار القرار 194 في المفاوضات الحديثة، يتضح الآتي:
- القرار فقد قيمته القانونيّة منذ البداية لأنّه توصية فقط.
- استخدامه في أوسلو وخطة كلينتون وخارطة الطريق جعله جزءًا من مساومات سياسيّة، لا أداة قانونيّة.
- صفقة القرن تجاوزته نهائيًا، ما كشف أنّ التمسك به دون تطوير بدائل قانونيّة خطأ استراتيجي.
- الموقف اللبناني تميز بوعي نقدي، فتمسك بالقرار كرمز سياسي لكنه استند إلى دستور وقانون دولي أقوى.
تحوّل القرار من “رمز أمل” إلى “فخ سياسي”. والدّرس الأساسي هو أنّ الحقّوق لا تُصان إلّا إذا استندت إلى قواعد قطعية ملزمة، لا إلى نصوص فضفاضة قابلة للتأويل والتّجاهل. والمقاومة الجادة وصولًا إلى تقرير المصير لا إلى استخدامها في التّفاوض مع المحتل.
الفصل السّابع: نحو مقاربة بديلة لحقّ العودة
إن النقد المتكرر للقرار 194 لا يعني التخلي عن حقّ العودة، بل يعني ضرورة البحث عن إطار قانوني أكثر صلابة. فبدل حصر العودة في قرار توصوي صادر عن الجمعيّة العامة، يجب الارتكاز على نصوص قطعيّة في القانون الدّولي لحقّوق الإنسان والقانون الإنساني.
فالمادة 13 من الإعلان العالمي لحقّوق الإنسان والمادة 12 من العهد الدّولي الخاص بالحقّوق المدنيّة والسياسية تقدمان أساسًا أقوى بكثير([32]). فهاتان المادتان تنصان على أنّ العودة حقّ فردي لا يمكن لأي دولة أن تسقطه أو تساوم عليه. كما أنّ اتفاقيّة جنيف الرابعة تجعل من التّهجير جريمة، ما يعني إنّ استمرار منع العودة يُعدّ جريمة مستمرة. إذ يجب أن تركز على أنّ العودة ليست “مطلبًا سياسيًا” بل “واجبًا قانونيًا”، وأنّ أي تفاوض لا يمكن أن ينقص من جوهر هذا الحقّ.
المبحث الأول: العودة كحقّ فردي وجماعي
إحدى أبرز نقاط ضعف القرار 194 أنّه صوّر العودة كخيار جماعي يخضع للمساومات. لكن القانون الدّولي يقرّ أنّ العودة حقّ فردي لكل لاجئ على حدى. أيّ أنّ كل فلسطيني مُهجّر يملك حقّا شخصيًا في العودة إلى بيته وأرضه([33]).
إلى جانب ذلك، هناك البعد الجماعي: فحقّ الشّعب الفلسطيني كشّعب في العودة إلى أرضه يدخل في إطار حقّ تقرير المصير. وهذا يجعل العودة ليست فقط مسألة فرديّة بل قضية وجوديّة مرتبطة بهُويّة الشّعب ككل. فالجمع بين الحقّ الفردي والجماعي يعزز الموقف القانوني، ويجعل التّنازل عن العودة مستحيلًا. وقد تجاهل هذا القرار هذا التلاقي، بينما النصوص القطعيّة تؤكده.
المبحث الثاني: تجارب دولية مقارنة – البوسنة وكوسوفو
لتأكيد قوة القانون الدّولي، يمكن النظر إلى تجارب أخرى. ففي البوسنة (اتفاقية دايتون 1995)، نص الاتفاق على حقّ اللاجئين في العودة إلى بيوتهم، وأُنشئت آلية تنفيذيّة عبر لجنة خاصة، نجحت في إعادة مئات الآلاف على الرّغم من التّعقيدات([34]).
في كوسوفو (1999)، أصدر مجلس الأمن القرار 1244 الذي أكد حقّ النازحين في العودة، وأشرف المجتمع الدّولي مباشرة على تنفيذه. هذه الحالات تظهر أنّ العودة ليست حلمًا مستحيلًا، بل حقّ يمكن فرضه إذا توفرت الإرادة الدّوليّة. إذا كانت العودة تحقّقت في تجارب أخرى، فهذا يعني أنّ الفشل في فلسطين لا يعود إلى صعوبة الحقّ ذاته، بل إلى غياب الإرادة الدّولية، وهو ما يثبت قصور القرار 194 وضرورة تجاوز الاعتماد عليه.
المبحث الثالث: الدستور اللبناني كمرجعية موازية
تميّز لبنان من باقي الدّول المضيفة للاجئين بأنّه حصّن موقفه في دستوره بعد اتفاق الطائف (1990). فقد نصّت مقدمة الدستور على رفض التوطين بشكل قطعي([35]). وهذا النّص يجعل من أي محاولة لفرض التّوطين مخالفة للدستور، وباطلة قانونيًا.
هذا الإطار الدّستوري يوفّر للبنان قوة تفاوضيّة استثنائيّة. فعلى عكس الدول التي يمكن أن تغيّر موقفها السياسي مع تغيّر الظروف، يجد لبنان نفسه محميًا بنص دستوري لا يمكن تجاوزه إلّا عبر تعديل يحتاج إلى إجماع وطني غير متوافر.
الجمع بين الدستور اللبناني والنّصوص القطعيّة في القانون الدّولي يجعل موقف لبنان الأكثر صلابة بين الدول المضيفة، لكنه يفرض عليه مسؤولية أكبر في تطوير خطاب قانوني متكامل
المبحث الرابع: الموقف الفلسطيني الرسمي – بين التمسك والمرونة
ظلت القيادة الفلسطينيّة، خاصة بعد أوسلو، متمسكة بالقرار 194 كمرجعيّة، لكنها أبدت مرونة مفرطة في تفسيره. ففي مفاوضات كامب ديفيد (2000)، قَبِلت فكرة العودة المحدودة إلى الدّولة الفلسطينيّة المستقبليّة، بدل العودة إلى داخل إسرائيل([36]).
هذا الموقف أضعف المطالبة الحقّيقية، لأنّه أظهر استعدادًا لتقديم تنازلات جوهريّة. كما أنّ التمسك بالقرار 194 من دون الإشارة إلى النّصوص القطعيّة في القانون الدّولي جعل الموقف الفلسطيني هشًا أمام الضغوط.
ساهم الموقف الفلسطيني الرسمي في إضعاف القرار 194 أكثر، لأنّه تعامل معه كمرجع نهائي بدل أن يراه نصًا ناقصًا يحتاج إلى تعزيز بسند قانوني أقوى. فالمفاوض الفلسطيني اعترف بإسرائيل مقابل اعتراف إسرائيل بمنظمة التحرير الفلسطينيّة لا الاعتراف بالدّولة الفلسطينيّة المستقلة ولا الاعتراف بحقّ تقرير المصير؟
الخاتمة : بعد سبعة عقود من صدور القرار 194، يمكن القول إنّ هذا القرار تحوّل من كونه “نصًا أُمميًا داعمًا” إلى “فخ سياسي” استُخدم لتجميد قضية اللاجئين بدل حلّها. فقد عجز عن توفير أي ضمانة قانونيّة، ولم ينص على آليات تنفيذ، كما سمح غموضه لإسرائيل باستغلاله لمصلحتها([37]).
في المقابل، فإنّ التمسك الفلسطيني والعربي به جاء في الغالب من باب الرّمزيّة، لا من باب القوّة القانونيّة. ولعلّ أخطر ما في القرار أنّه جعل العالم يتوهم أنّ هناك حلًا مطروحًا، بينما ظلّ اللاجئون في معسكرات الشتات يعانون الحرمان والفقر.
لا يمكن والحال هذه التعويل على القرار 194 كمرجع وحيد لحقّ العودة. بل يجب إعادة صياغة الخطاب القانوني والسياسي بما يتلاءم مع نصوص القانون الدّولي القطعية التي تعطي الحقّ قوة أكبر من أي توصية أممّية. أولاها المادة 13 من الإعلان لحقّوق الإنسان للعام 1948.
النتائج 1– الطابع القانوني والسياسي
- غياب الإلزامية: القرار 194 توصية فقط، ما جعله ضعيفًا أمام رفض إسرائيل.
- غموض الصياغة: عبارة “العيش بسلام مع الجيران” استخدمت كذريعة لإسقاط العودة[38].
- الخلط بين العودة والتعويض: النص ساوى بين الحقّ والبديل، ما أتاح لإسرائيل التهرب من التزاماتها.
- انعدام آليات التنفيذ: لجنة التوفيق لم تكن سوى جهازًا شكليًا بلا قوة عملية.
تحليل: هذه النتائج تؤكد أنّ القرار 194، من حيث الطبيعة القانونيّة، ليس سندًا حقّيقيًا للعودة، بل وثيقة سياسية عكست ميزان القوى عام 1948 أكثر مما عبّرت عن عدالة الحقّ الفلسطيني.
النتائج 2– المواقف الدّولية والإقليميّة
- المواقف الدّولية: القوى الكبرى استخدمت القرار كأداة سياسيّة، بينما تراجعت إرادتها في تنفيذه مع مرور الوقت.
- المفاوضات الحديثة: إدراج القرار في أوسلو وخطط لاحقّة لم يحمِ العودة، بل حوّلها إلى موضوع تفاوضي قابل للتقليص([39]).
- صفقة القرن: شكلت تجاوزًا نهائيًا للقرار، وأكدت أنه لم يعد يُنظر إليه كمرجعية على الرغم من اختلاله خصوصاً الفقرة 11 منه.
- الموقف اللبناني: الأكثر تشددًا، لأنّه استند إلى الدستور والقانون الدّولي، بينما مواقف أخرى (أردنية أو فلسطينية رسمية) أظهرت مرونة أضعفت المطلب. لم يوحّد القرار الموقف الدّولي أو العربي، بل صار مادة للخلافات، وأحيانًا غطاء لتبرير حلول بديلة. وهذا بسبب ظروفًا موضوعيّة بل بسبب أن القرار 194 وخاصة الفقرة 11 منه أُقرّت بشكل مدروس مكّن الاحتلال الإسرائيلي من تكريس واقع أنّ إسرائيل دولة، وأنّ الفلسطينيين مجرد بشر يعكرون صفو الاحتلال ولا حقّوق لهم بتقرير حقّ المصير.
التّوصيات:
- الاستناد إلى القانون الدّولي القطعي: يجب التركيز على نصوص الإعلان العالمي والعهدين الدّوليين واتفاقية جنيف الرابعة باعتبارها ملزمة، بدل الاكتفاء بالقرار 194.
- تفعيل الدّبلوماسيّة الفلسطينيّة واللبنانية: عبر مخاطبة المجتمع الدّولي بلغة القانون لا بلغة الرّموز السياسية.
- إعادة تعريف العودة: بوصفها حقّا فرديًا وجماعيًا غير قابل للتصرف، لا مجرد بند تفاوضي([40]).
- تعزيز الموقف اللبناني: عبر إبراز النّص الدّستوري الرافض للتوطين وربطه بالنّصوص الدّولية، ليصبح النموذج الأقوى في الدفاع عن العودة وإقرار خطة وطنيّة لمواجهة التوطين داخليًّا وخارجيًّا وفي شتى ميادين استهداف لبنان.
- رفض المساومات الماليّة: أيّ صيغة تربط بين التّعويض وإسقاط العودة يجب أن تُعدُّ باطلة.
تمثل هذه التوصيات إطارًا عمليًا لتحويل قضية العودة من خطاب رمزي إلى مطلب قانوني وحقّوقي مدعوم بسند إلزامي.
فتح آفاق البحث: يفتح هذا البحث المجال أمام دراسات مستقبليّة معمقة، أبرزها:
- المسار القضائي: إمكان رفع دعاوى أمام محكمة العدل الدّولية، أو المحكمة الجنائيّة الدّوليّة ضد إسرائيل بوصفها تمنع حقّا قطعيًا كونها دولة احتلال لا دولة قائمة بذاتها.
- المقارنة الدّوليّة: دراسة حالات العودة الناجحة (البوسنة، كوسوفو) وكيفية الاستفادة منها لبناء آليات مشابهة للفلسطينيين([41]).
- المسار اللبناني: تحليل تفصيلي للعلاقة بين رفض التوطين وحقّ العودة، وكيف يمكن للبنان أن يقود جبهة عربية–دوليّة لتعزيز هذا الحقّ أضف إلى إقرار استراتيجيّة وطنيّة تمنع التّوطين في كل الوسائل.
- البعد الإنساني: دراسة أوضاع المخيّمات وكيفيّة تحسينها إنسانيًا من دون أن يُفسَّر ذلك كتوطين.
المصادر والمراجع
- فواز طرابلسي، تاريخ لبنان الحديث، بيروت: رياض الريس، 2007، ص 299.
-2Rex Brynen, Palestinian Refugees: Challenges of Repatriation and Development, London: I.B. Tauris, 1990, p. 115.
3- الدستور اللبناني، مقدمة الدستور، الفقرة “ي”، 1990.
4-الدستور اللبناني، مقدمة الدستور، الفقرتان “ط” و”ي”، 1990.
5-العهد الدّولي الخاص بالحقّوق المدنية والسياسية، 1966، المادة 1؛ اتفاقية جنيف الرابعة، 1949، المادة 49.
6- محمد المجذوب، القانون الدّولي العام، بيروت: منشورات الحلبي الحقّوقية، 2010، ص 244.
7- الجامعة العربية، مبادرة السلام العربية، قمة بيروت، 2002.
8- وثائق اتفاق القاهرة، القاهرة، 1969.
9- يزيد صايغ، الكفاح المسلح والبحث عن الدولة: الحركة الوطنية الفلسطينية 1949–1993، بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 1996، ص 233.
10-كمال الصليبي، تاريخ لبنان الحديث، بيروت: دار النهار، 1988، ص 421.
11-توفيق المديني، المقاومة الفلسطينية والكيان اللبناني، بيروت: دار الفارابي، 1983، ص 215. ميثاق الأمم المتحدة، المادة 2، 1945.
12- الجمعية العامة للأمم المتحدة، القرار 3236، 22 تشرين الثاني/نوفمبر 1974.
13-اتفاقية جنيف الرابعة، 1949، المادة 49.
14-تقرير الأونروا، “أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنا.ن”، بيروت، 2020
-15Rashid Khalidi, Palestinian Identity: The Construction of Modern National Consciousness, New York: Columbia University Press, 1997, p. 142.
16-خطابات الوفد اللبناني في الجمعية العامة للأمم المتحدة، الدورة 36، نيويورك، 1981.
-17Rex Brynen, Palestinian Refugees: Challenges of Repatriation and Development, London: I.B. Tauris, 1990, p. 205.
18- الجامعة العربية، مبادرة السلام العربية، قمة بيروت، 2002.
19- فواز طرابلسي، تاريخ لبنان الحديث، بيروت: رياض الريس، 2007، ص 342.
20-خطابات الرؤساء اللبنانيين في الأمم المتحدة، نيويورك، 1993–2005.
21-تقرير الأونروا، “اللاجئون الفلسطينيون في لبنان: الإحصاءات والتحديات”، بيروت، 2019.
22- تقرير الأونروا، “التقرير السنوي”، بيروت، 2020.
23- توفيق المديني، المقاومة الفلسطينية والكيان اللبناني، بيروت: دار الفارابي، 1983، ص 217.
24- تقرير الأونروا، “أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان”، بيروت، 2021.
-25Rashid Khalidi, The Iron Cage: The Story of the Palestinian Struggle for Statehood, Boston: Beacon Press, 2006, p. 223.
[1]– طالب دكتوراه في كلّية الحقوق- الجامعة الإسلاميّة – بيروت – لبنان- قسم القانون الدولي
PhD student at the Faculty of Law, Islamic University of Beirut, Lebanon, Department of International Law .
Email:8akhalifh@gmail.com
1 – الجمعيّة العامة للأمم المتحدة، القرار 194 (الفقرة 11)، 11 كانون الأول/ديسمبر 1948.
2 -Walid Khalidi, All That Remains: The Palestinian Villages Occupied and Depopulated by Israel in 1948, Institute for Palestine Studies, 1992, p. 11.
[3]– Benny Morris, The Birth of the Palestinian Refugee Problem, Cambridge: Cambridge University Press, 1987, p. 252.
[4] – محمد المجذوب، القانون الدولي العام، بيروت: منشورات الحلبي الحقوقية، 2010، ص 243.
[5] -George Jabbour, The Palestinian Right of Return in International Law, Beirut: IPS, 2009, p. 52.
[6]– UNCCP, Progress Report, 1951, p. 11.
[7] -William Zartman, International Relations in the Middle East, London: Routledge, 1971, p. 115.
[8] -Charles D. Smith, Palestine and the Arab-Israeli Conflict, Boston: Bedford/St. Martin’s, 2010, p. 189.
[9] -Benny Morris, The Birth of the Palestinian Refugee Problem Revisited, Cambridge: Cambridge University Press, 2004, p. 589.
[10] – يزيد صايغ، الكفاح المسلح والبحث عن الدولة: الحركة الوطنية الفلسطينية 1949–1993، بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 1996، ص 122.
[11] – خطابات الوفد اللبناني في الجمعية العامة للأمم المتحدة، الدورة 36، نيويورك، 1981.
[12] – محمد المجذوب، القانون الدولي العام، بيروت: منشورات الحلبي الحقوقية، 2010، ص 244.
[13] – الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، 1948، المادة 13.
[14] – العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، 1966، المادة 12.
[15] – اتفاقية جنيف الرابعة، 1949، المادة 49.
[16] – George Jabbour, The Palestinian Right of Return in International Law, Beirut: IPS, 2009, p. 67.
[17] -Susan Akram, “Palestinian Refugees and Durable Solutions,” Boston University International Law Journal, Vol. 22, 2004, p. 239.
[18]– UNCCP, Progress Report, 1951, p. 15.
[19]– Naseer Aruri, The Obstruction of Peace: The U.S., Israel, and the Palestinians, Common Courage Press, 1995, p. 77.
[20]– William Quandt, Camp David: Peacemaking and Politics, Brookings Institution, 1986, p. 243.
[21] – تقرير الأونروا، “اللاجئون الفلسطينيون: الواقع والتحديات”، بيروت، 2020.
[22]– Rex Brynen, Palestinian Refugees: Challenges of Repatriation and Development, London: I.B. Tauris, 1990, p. 142.
[23] – خطابات الوفد اللبناني في الجمعية العامة للأمم المتحدة، الدورة 36، نيويورك، 1981.
[24] – الدستور اللبناني، مقدمة الدستور، الفقرة “ي”، الفقرة ط 1990.
[25] -Laurie Brand, Palestinians in the Arab World: Institution Building and the Search for State, Columbia University Press, 1988, p. 77.
[26] -Edward Said, The Question of Palestine, Vintage Books, 1992, p. 121.
[27]– Edward Said, Oslo and its Aftermath, New York: Vintage, 1995, p. 144.
[28] -Charles Enderlin, Shattered Dreams: The Failure of the Peace Process in the Middle East 1995–2002, New York: Other Press, 2003, p. 277.
[29] -William B. Quandt, Peace Process: American Diplomacy and the Arab-Israeli Conflict since 1967, Washington D.C.: Brookings, 2005, p. 402.
[30] -White House, Peace to Prosperity: A Vision to Improve the Lives of the Palestinian and Israeli People, Washington D.C., January 2020.
[31] -خطابات الوفد اللبناني في الجمعية العامة للأمم المتحدة، الدورة 64، نيويورك، 2009.
[32] – الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، 1948، المادة 13؛ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، 1966، المادة 12.
[33] -Susan Akram & Terry Rempel, “Temporary Protection for Palestinian Refugees,” Boston University International Law Journal, Vol. 22, 2004, p. 211.
[34] -Richard Caplan, International Governance of War-Torn Territories, Oxford University Press, 2005, p. 98.
[35] -الدستور اللبناني، مقدمة الدستور، الفقرة “ي”، 1990.
[36]– Charles Enderlin, Shattered Dreams: The Failure of the Peace Process in the Middle East 1995–2002, New York: Other Press, 2003, p. 289.
[37]– Edward Said, The Question of Palestine, Vintage Books, 1992, p. 127.
[38] George Jabbour, The Palestinian Right of Return in International Law, Beirut: IPS, 2009, p. 73.
[39] -Charles Enderlin, Shattered Dreams: The Failure of the Peace Process in the Middle East 1995–2002, New York: Other Press, 2003, p. 295.
[40] -Susan Akram, “Palestinian Refugees and Durable Solutions,” Boston University International Law Journal, Vol. 22, 2004, p. 241.
[41] Richard Caplan, International Governance of War-Torn Territories, Oxford University Press, 2005, p. 101.