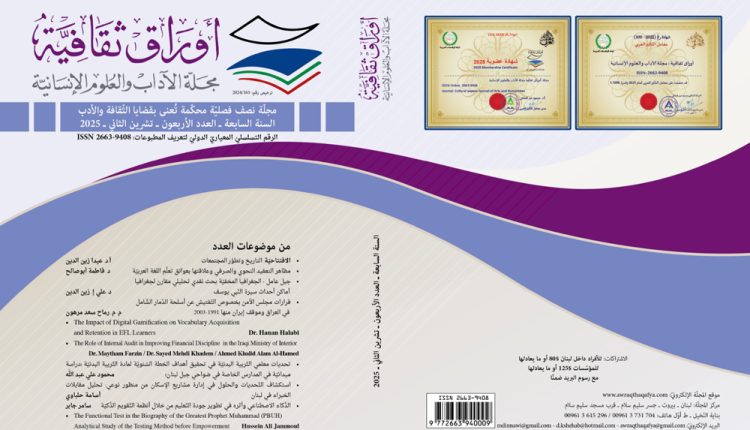عنوان البحث: التحول الرقمي في مؤسسات التمويل الأصغر: الذكاء الاصطناعي كعامل محفز لأداء الموظفين في لبنان"
اسم الكاتب: عماد محمد بيز
تاريخ النشر: 2025/11/14
اسم المجلة: مجلة أوراق ثقافية
عدد المجلة: 40
تحميل البحث بصيغة PDFADOI: https://aif-doi.org/awraq/014029
التحول الرقمي في مؤسسات التمويل الأصغر: الذكاء الاصطناعي كعامل محفز لأداء الموظفين في لبنان”
Digital Transformation in Microfinance Institutions: Artificial Intelligence as a Catalyst for Employee Performance in Lebanon.
بحث مستل من أطروحة الدكتوراه بعنوان: أثر تطبيقات الذكاء الاصطناعي على أداء الموظفين في مؤسسات التمويل الأصغر في لبنان, دراسة الدور الوسيط للتعلم التنظيمي والدور المعدل للمرونة
Imad Mohammed Beiz عماد محمد بيز([1])
ساهر حسن العنان([2])Supervisor: Professor Saher Hassan El Annan
تاريخ الإرسال:31-10-2025 تاريخ القبول:10-11-2025
الملخص turnitin:9%
يهدف هذا البحث إلى دراسة أثر تطبيقات الذكاء الاصطناعي على أداء الموظفين في مؤسسات التمويل الأصغر في لبنان، مع التركيز على الدور الوسيط للتعلّم التّنظيمي والدور المعدّل للمرونة التّنظيمية. تنطلق الدّراسة من فرضيّة أن التكنولوجيا وحدها لا تكفي لتحسين الأداء، ما لم تُرافقها بيئة تنظيميّة داعمة تُشجّع على التعلّم والتكيّف.
اعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي، وجمع البيانات من خلال استبيان موجّه إلى موظفين في مؤسسات تمويل لبنانية. وقد أظهرت النتائج وجود علاقة إيجابيّة بين استخدام الذكاء الاصطناعي وتحسين الأداء، كما بيّنت أن التعلّم التّنظيمي يُعزّز هذا الأثر، بينما تُعدّل المرونة التّنظيمية من قوّته واتجاهه.
تُبرز الدّراسة أهمية الاستثمار في رأس المال البشري والثقافة المؤسسية، إلى جانب الاستثمار في الأدوات التقنية، وتقدّم نموذجًا تحليليًا يمكن تطبيقه في بيئات عمل مشابهة في العالم العربي.
الكلمات المفتاحيّة: الذكاء الاصطناعي، أداء الموظفين، التعلّم التّنظيمي، المرونة التّنظيمية، التمويل الأصغر، لبنان.
Abstract
This study explores the impact of artificial intelligence (AI) applications on employee performance within microfinance institutions in Lebanon, with a particular focus on the mediating role of organizational learning and the moderating role of organizational agility. The research is grounded in the premise that technology alone is insufficient to enhance performance unless supported by a learning-oriented and adaptive organizational environment.
Using a descriptive-analytical methodology, data were collected through a structured questionnaire distributed to employees in selected Lebanese microfinance institutions. The findings reveal a positive correlation between the use of AI tools and improved employee performance. Moreover, organizational learning was found to strengthen this relationship, while organizational agility moderated its intensity and direction.
The study highlights the importance of investing not only in digital infrastructure but also in human capital and institutional culture. It offers a practical framework for similar organizations in the Arab region seeking to integrate AI in a sustainable and context-sensitive manner.
Keywords: Artificial Intelligence, Employee Performance, Organizational Learning, Organizational Agility, Microfinance, Lebanon.
1-1 المقدمة
في عالم يتسارع فيه التحوّل الرقمي، لم يعد الذكاء الاصطناعي مجرّد رفاهية تقنية، بل أصبح ضرورة استراتيجية لإعادة تشكيل بيئات العمل وتحسين كفاءة المؤسسات. وفي لبنان، حيث تتقاطع الأزمات الاقتصادية والاجتماعية مع محدودية الموارد، تبرز مؤسسات التمويل الأصغر كجهات فاعلة في دعم الفئات المهمّشة وتعزيز الشمول المالي. غير أنّ هذه المؤسسات تواجه تحدّيات حقيقيّة في تحسين أدائها الداخلي، خاصة على مستوى الموارد البشرية.
من هذا المنطلق، يسعى هذا البحث إلى فهم كيف يمكن لتطبيقات الذكاء الاصطناعي أن تسهم في رفع أداء الموظفين داخل مؤسسات التمويل الأصغر اللبنانيّة، مع التعمّق في الأدوار التي يؤديها كل من التعلّم التّنظيمي والمرونة التّنظيميّة في تعزيز هذا الأثر أو الحد منه. فالسؤال الجوهري لا يقتصر على ما إذا كانت التكنولوجيا مفيدة، بل يتعداه إلى: كيف يمكن تهيئة البيئة التّنظيميّة للاستفادة القصوى منها؟
1-2 إشكاليّة البحث؛ في ظل التحوّلات الرقمية المتسارعة، بات الذكاء الاصطناعي يشكّل أحد أبرز ملامح التغيير في بيئات العمل الحديثة، إذ يُنظر إليه كأداة استراتيجيّة لتحسين الكفاءة، تسريع العمليات، وتعزيز جودة الخدمات. ومع ذلك، فإنّ إدماج هذه التقنيات في مؤسسات التمويل الأصغر، خصوصًا في السّياق اللبناني، لا يزال يواجه تحديات متعدّدة تتعلق بالبنية التحتيّة، الثقافة التّنظيميّة، ومدى جاهزية الموارد البشرية.
تُعد مؤسسات التمويل الأصغر في لبنان من أكثر القطاعات حاجة إلى التطوير التقني، نظرًا لدورها الحيوي في دعم الفئات المهمّشة وتمويل المشاريع الصغيرة. إلا أن إدخال الذكاء الاصطناعي في هذه المؤسسات لا يضمن بالضرورة تحسين أداء الموظفين، ما لم يُرافقه تهيئة تنظيميّة مناسبة، تشمل التعلّم المستمر، والقدرة على التكيّف مع التغيير.
من هنا تبرز الإشكاليّة المركزية لهذا البحث:
إلى أي مدى يؤثر استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي على أداء الموظفين في مؤسسات التمويل الأصغر في لبنان، وما هو الدور الذي يلعبه كل من التعلّم التّنظيمي كوسيط، والمرونة التّنظيمية كمعدّل في هذه العلاقة؟
تسعى هذه الدراسة إلى تفكيك هذه العلاقة المركّبة، من خلال تحليل الأثر المباشر للتكنولوجيا، وفهم كيف تتفاعل العوامل التّنظيمية الداخلية في تعزيز أو إضعاف هذا الأثر، ضمن بيئة عمل لبنانية تواجه ضغوطًا اقتصادية واجتماعية متزايدة.
1-3 أهمية البحث: تنبع أهمية هذا البحث من كونه يتناول قضية حيوية تمسّ واقع مؤسسات التمويل الأصغر في لبنان، في ظل تحديات اقتصاديّة واجتماعيّة متراكمة، وسعي متزايد نحو التحوّل الرقمي. فالذكاء الاصطناعي لم يعد ترفًا تقنيًا، بل أصبح ضرورة استراتيجيّة لتحسين الأداء، وترشيد الموارد، وتعزيز القدرة التنافسية.
يساهم البحث في سدّ فجوة معرفيّة في الأدبيات العربيّة، من خلال تحليل العلاقة المركّبة بين التكنولوجيا والأداء البشري، مع التركيز على العوامل التّنظيميّة التي تُعزّز أو تُضعف هذا الأثر. كما يقدّم إطارًا عمليًا يمكن أن تستفيد منه المؤسسات اللبنانية في تصميم سياسات أكثر ذكاءً ومرونة، تراعي خصوصيّة السّياق المحلي، وتُعزّز من جاهزيتها لمواجهة المستقبل.
وعلى المستوى الأكاديمي، يُثري البحث النقاش حول دور التعلّم التّنظيمي والمرونة المؤسسيّة في إنجاح التحوّلات الرقمية، ويطرح نموذجًا قابلًا للتطبيق في بيئات عمل مشابهة، داخل لبنان وخارجه.
1-4 فرضية البحث: ينطلق هذا البحث من فرضية رئيسة مفادها أن: تطبيقات الذكاء الاصطناعي تؤثر إيجابًا على أداء الموظفين في مؤسسات التمويل الأصغر في لبنان، ويزداد هذا الأثر فعالية بوجود تعلّم تنظيمي نشط، ويُعدّل بناءً على مستوى المرونة التّنظيمية داخل المؤسسة.”
وتتفرّع عن هذه الفرضية العامة ثلاث فرضيّات فرعيّة:
- الفرضيّة الأولى: هناك علاقة إيجابيّة مباشرة بين استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتحسين أداء الموظفين في مؤسسات التّمويل الأصغر.
- الفرضيّة الثانية: يلعب التعلّم التّنظيمي دورًا وسيطًا في تعزيز العلاقة بين الذكاء الاصطناعي والأداء، إذ يُسهم في رفع قدرة الموظفين على استيعاب التكنولوجيا وتوظيفها بفعاليّة.
- الفرضيّة الثالثة: تؤثر المرونة التّنظيميّة كمعدّل في العلاقة بين الذكاء الاصطناعي والأداء، فتختلف درجة التأثير باختلاف قدرة المؤسسة على التكيّف مع التغيّرات التقنية والإدارية.
1-5 أهداف البحث: يسعى هذا البحث إلى تحقيق مجموعة من الأهداف العلميّة والتّطبيقيّة، تتمحور حول فهم العلاقة بين التكنولوجيا الحديثة والعوامل التّنظيمية في بيئة العمل اللبنانية، وتحديد كيف يمكن لمؤسسات التمويل الأصغر أن تستفيد من الذكاء الاصطناعي بشكل فعّال ومستدام. وتتمثل الأهداف في:
- تحليل أثر تطبيقات الذكاء الاصطناعي على أداء الموظفين في مؤسسات التّمويل الأصغر في لبنان، في الكفاءة، السرعة، والدقة في إنجاز المهام.
- استكشاف الدور الوسيط للتعلّم التّنظيمي في تعزيز العلاقة بين الذكاء الاصطناعي والأداء، وتحديد كيف يسهم التعلّم المستمر في رفع جاهزية الموظفين للتعامل مع التقنيات الجديدة.
- دراسة الدور المعدّل للمرونة التّنظيميّة في ضبط العلاقة بين الذكاء الاصطناعي والأداء، وفهم كيف تؤثر قدرة المؤسسة على التكيّف في نجاح التحوّل الرقمي.
- تقديم توصيات عملية للمؤسسات اللبنانيّة حول كيفية دمج الذكاء الاصطناعي ضمن استراتيجياتها التّشغيليّة، بما يراعي السياق المحلي ويعزّز من فاعليّة الأداء المؤسسي.
1-6 حدود الدّراسة: على الرّغم من الجهود المنهجيّة المبذولة في تصميم هذا الفصل، وتحليل أثر الذكاء الاصطناعي على أداء الموظفين في مؤسسات التمويل الأصغر، إلّا أنّ هناك مجموعة من الحدود التي يجب أخذها بالحسبان عند تفسير النتائج أو تعميمها:
- الحدود المكانيّة: اقتصرت الدراسة على مؤسسات تمويل أصغر داخل لبنان، ما يجعل النتائج مرتبطة بسياق جغرافي محدد، وقد تختلف في دول أخرى ذات بنى تنظيميّة أو اقتصاديّة مختلفة.
- الحدود الزمانيّة: أُجريت الدراسة خلال مدّة تشهد فيها البلاد أزمة اقتصاديّة حادة، ما قد يؤثر على سلوك الموظفين واستجابتهم للتكنولوجيا، ويجعل النتائج مرتبطة بزمن معيّن.
- الحدود الموضوعيّة: ركّز الفصل على العلاقة بين الذكاء الاصطناعي والأداء الوظيفي، من دون التوسّع في الجوانب القانونيّة أو الأخلاقيّة المرتبطة باستخدام هذه التقنيات.
- الحدود البشرية: اعتُمِد على عيّنة محدودة من الموظفين، ما قد لا يعكس جميع وجهات النظر أو مستويات الخبرة داخل المؤسسات.
وعلى الرّغم من هذه الحدود، فإن الفصل يُقدّم رؤية تحليليّة قابلة للبناء عليها في فصول لاحقة، ويُمهّد الطريق لأبحاث أكثر شمولًا تجمع بين المنهج الكمّي والنّوعي، وتُراعي التنوّع الجغرافي والمؤسسي.
1-7 تعريف الكلمات والمصطلحات العلميّة والمتخصصة: لضمان وضوح المفاهيم المستخدمة في هذا البحث، وتوحيد الفهم بين القرّاء والباحثين، اعتُمِدت التعريفات الآتية لأبرز المصطلحات العلمية الواردة في الفصل:
- الذّكاء الاصطناعي (Artificial Intelligence)::مجموعة من الأنظمة والتقنيات التي تُحاكي القدرات العقلية البشرية، مثل التعلّم، التحليل، واتخاذ القرار، وتُستخدم في تحسين العمليّات التّشغيليّة داخل المؤسسات.
- مؤسسات التمويل الأصغر (Microfinance Institutions):
مؤسسات مالية تُقدّم خدمات تمويليّة صغيرة الحجم للفئات ذات الدخل المحدود، بهدف تعزيز الشّمول المالي والتنمية الاقتصاديّة المحليّة. - أداء الموظفين (Employee Performance):
مستوى الإنجاز والكفاءة الذي يُظهره الموظف في تنفيذ مهامه، ويُقاس من خلال مؤشرات مثل الإنتاجية، الالتزام، جودة العمل، والقدرة على التكيّف. - التعلّم التّنظيمي (Organizational Learning):
عملية مستمرة داخل المؤسسة تهدف إلى تطوير المعرفة والمهارات، من خلال التدريب، تبادل الخبرات، والتغذية الراجعة، بما يُعزّز قدرة المؤسسة على التكيّف والابتكار. - المرونة التّنظيمية (Organizationa Agility):
قدرة المؤسسة على التكيّف السريع مع التغيّرات الداخلية والخارجية، من خلال تعديل الهياكل، العمليات، والاستراتيجيات، بما يضمن استمراريّة الأداء الفعّال. - الدور الوسيط (Mediating Role):
تأثير متغيّر ثالث (مثل التعلّم التّنظيمي) في تفسير العلاقة بين متغيّرين رئيسين، إذ يُساهم في تقوية أو توضيح هذه العلاقة. - الدور المعدّل (Moderating Role):
تأثير متغيّر ثالث (مثل المرونة التّنظيمية) في تغيير اتجاه أو قوة العلاقة بين متغيّرين، فتختلف النتائج باختلاف مستوى هذا المتغيّر.
1-8 الدّراسات السّابقة: تناولت العديد من الدّراسات العلاقة بين الذكاء الاصطناعي وتحسين الأداء المؤسسي، خاصة في القطاعات المصرفية والتّجاريّة، إلّا أنّ معظمها ركّز على الأثر التقني المباشر من دون التعمّق في العوامل التّنظيميّة التي تُعزّز أو تُضعف هذا الأثر. كما أنّ الأدبيات العربيّة، تحديدًا في السّياق اللبناني، لا تزال محدودة في تناول الذكاء الاصطناعي ضمن مؤسسات التمويل الأصغر، على الرّغم من أهميته المتزايدة في دعم الفئات المهمّشة وتحقيق الشمول المالي.
دراسة Davenport & Ronanki (2018) ركّزت على كيفيّة توظيف الذكاء الاصطناعي في تحسين العمليّات التّشغيليّة، لكنها لم تتناول الأبعاد التّنظيميّة مثل التعلّم أو المرونة. أمّا دراسة Al-Mashaqbeh & Al-Zoubi (2021) في السّياق الأردني، فقد أظهرت أثرًا إيجابيًا للذكاء الاصطناعي على الأداء، لكنّها لم تختبر دور العوامل الوسيطة أو المعدّلة.
في المقابل، تناولت بعض الدّراسات الغربيّة مثل Senge (2006) وGarvin (2000) أهمية التعلّم التّنظيمي في إنجاح التحوّلات التقنية، دون ربط مباشر بالذكاء الاصطناعي في مؤسسات التمويل. كما ركّزت دراسات أخرى على المرونة التّنظيميّة كعامل استراتيجي في مواجهة التغيير، لكنّها لم تُدمج ضمن نموذج تحليلي يربطها بالأداء والتكنولوجيا.
من هنا، يُقدّم هذا البحث مساهمة علميّة جديدة من خلال بناء نموذج متكامل يربط بين الذكاء الاصطناعي، التعلّم التّنظيمي، والمرونة المؤسسيّة، ضمن سياق لبناني يعاني من ضغوط اقتصاديّة ويحتاج إلى حلول ذكية ومستدامة.
1-9 جانب الحداثة والابتكار في البحث: يتميّز هذا البحث بطرحه لموضوع حديث، وحيوي يتمثّل في دمج الذكاء الاصطناعي ضمن بيئة عمل مؤسسات التمويل الأصغر في لبنان، وهو مجال لم يحظَ بعد بالاهتمام الكافي في الأدبيات العربيّة، لا سيّما في ظل الأزمات الاقتصاديّة والماليّة التي تمرّ بها البلاد. وتكمن حداثة البحث في عدّة جوانب مترابطة:
- التركيز على قطاع التمويل الأصغر كبيئة تطبيقية للذكاء الاصطناعي، وهو قطاع غالبًا ما يُستثنى من الدراسات التقنية على الرّغم من حساسيته الاجتماعيّة والاقتصاديّة.
- دمج البُعد البشري والتّنظيمي في تحليل أثر الذكاء الاصطناعي، من خلال دراسة التعلّم التّنظيمي والمرونة المؤسسيّة، بدل الاكتفاء بالتحليل التقني البحت.
- اعتماد نموذج تحليلي ثلاثي الأبعاد يربط بين التكنولوجيا، الثقافة التّنظيميّة، والأداء، ما يُقدّم إطارًا متكاملًا لفهم التحوّل الرّقمي في المؤسسات الصغيرة.
- الاستناد إلى بيانات ميدانيّة لبنانية تُعبّر عن واقع فعلي ومعقّد، وتُسهم في إنتاج معرفة محليّة قابلة للتطبيق في بيئات عربية مشابهة.
- اقتراح توصيات عمليّة واستراتيجيّة تُساعد صانعي القرار في مؤسسات التمويل الأصغر على تبنّي الذّكاء الاصطناعي بطريقة تدريجية، مرنة، وإنسانيّة.
من خلال هذه الأبعاد، يُقدّم البحث مساهمة علمية مبتكرة تتجاوز الطرح النظري، وتسعى إلى بناء جسر بين التكنولوجيا والواقع المؤسسي في سياق عربي متحوّل.
1-10 مقارنة الدراسات السابقة مع البحث الحال: تُظهر مراجعة الأدبيات أن معظم الدّراسات السّابقة التي تناولت الذكاء الاصطناعي في بيئات العمل ركّزت على الأثر التقني المباشر، من دون التعمّق في الأبعاد التّنظيميّة أو النّفسيّة التي تُرافق هذا التحوّل. على سبيل المثال، تناولت دراسة Davenport & Ronanki (2018) تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تحسين الكفاءة التّشغيليّة، لكنها لم تتطرّق إلى دور التعلّم التّنظيمي أو المرونة المؤسسيّة في تعزيز هذا الأثر. كما ركّزت دراسة Al-Mashaqbeh & Al-Zoubi (2021) في السياق الأردني على العلاقة بين الذكاء الاصطناعي والأداء، من دون اختبار وجود متغيّرات وسيطة أو معدّلة.
في المقابل، يتميّز البحث الحالي بعدّة نقاط اختلاف جوهريّة:
- السياق المحلي: يُركّز البحث على مؤسسات التّمويل الأصغر في لبنان، وهي بيئة لم تُدرس بشكل كافٍ في الأدبيات، على الرّغم من خصوصيتها في الموارد، الثقافة التّنظيميّة، والتّحديات الاقتصاديّة.
- النّموذج التحليلي المركّب: يُقدّم البحث نموذجًا ثلاثي الأبعاد يربط بين الذكاء الاصطناعي، التعلّم التّنظيمي كوسيط، والمرونة التّنظيمية كمعدّل، ما يُتيح فهمًا أعمق للعلاقة بين التكنولوجيا والأداء.
- الدّمج بين المنهج الكمي والنوعي: اعتمد البحث على أدوات متعددة (استبيان، مقابلات، تحليل وثائق)، مما يُعزّز من مصداقية النتائج ويُتيح تفسيرًا أكثر شمولًا للظواهر المدروسة.
- البُعد الإنساني: يُراعي البحث أثر الذكاء الاصطناعي على الموظف في الرضا، الدّافعيّة، والمخاوف المرتبطة بفقدان الوظيفة، وهو جانب غالبًا ما يُتجاهل في الدّراسات التقنية.
من خلال هذه المقارنة، يتّضح أن البحث الحالي لا يُكرّر ما سبق، بل يُضيف إلى الأدبيات من خلال معالجة فجوة علميّة واضحة، وتقديم نموذج تطبيقي قابل للتوسّع في بيئات عربيّة مشابهة.
1-11 أخلاقيات البحث: حرص هذا البحث على الالتزام بالمعايير الأخلاقيّة المعتمدة في الدراسات الأكاديميّة، لضمان احترام حقوق المشاركين، والحفاظ على نزاهة العملية البحثية. وقد اتُخِذت الإجراءات الآتية:
- الرضا المستنير: أُعلِم المشاركون بطبيعة الدراسة، وأهدافها، وطريقة استخدام البيانات، قبل تعبئة الاستبيان أو المشاركة في المقابلات، مع تأكيد أن مشاركتهم طوعية تمامًا.
- السرية والخصوصية: تُعُمِل مع البيانات جميعها بسريّة تامة، من دون كشف أسماء المشاركين أو مؤسساتهم، واستُخدِمت المعلومات لأغراض بحثيّة فقط.
- عدم الإضرار: صُمِّمت أدوات البحث بطريقة لا تُسبب أي ضغط نفسي أو مهني للمشاركين، مع تجنّب الأسئلة الحساسة أو الموجّهة.
- الحياد العلمي: حُلِّلت البيانات من دون تحيّز، وباستخدام أدوات إحصائيّة موضوعيّة، لضمان دقة النتائج وشفافيتها.
- الاستقلالية الأكاديمية: لم يُموّل هذا البحث من أي جهة خارجيّة، ولم يخضع لأي تأثير مؤسسي أو تجاري، ما يُعزّز من مصداقيته واستقلاليته.
من خلال هذه المبادئ، يسعى البحث إلى تقديم معرفة علميّة مسؤولة، تُراعي الإنسان قبل التقنية، وتُسهم في تطوير بيئة عمل أكثر عدالة واستدامة.
1-12 منهج البحث: اعتمد هذا البحث على المنهج الوصفي التحليلي، بهدف دراسة العلاقة بين تطبيقات الذكاء الاصطناعي وأداء الموظفين في مؤسسات التمويل الأصغر في لبنان، وتحليل الدور الوسيط للتعلّم التّنظيمي والدور المعدّل للمرونة التّنظيمية ضمن هذا السياق.
جُمِعت البيانات من خلال استبيان إلكتروني موجّه إلى عيّنة من الموظفين العاملين في مؤسسات تمويل أصغر لبنانية، اختيِروا بطريقة قصدية لضمان ارتباطهم المباشر بالتطبيقات التقنيّة محل الدراسة. وقد تضمّن الاستبيان ثلاثة محاور رئيسة:
- محور الذكاء الاصطناعي: يقيس مدى استخدام الموظفين لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في مهامهم اليومية، مثل أدوات التقييم، التّحليل، وخدمة العملاء.
- محور التعلّم التّنظيمي: يقيّم مدى توفر بيئة تعلّمية داخل المؤسسة، في التدريب، تبادل المعرفة، والتغذية الراجعة.
- محور المرونة التّنظيمية: يختبر قدرة المؤسسة على التكيّف مع التغيّرات، من خلال مرونة الهيكل الإداري، العمليات، والموارد البشرية.
حُلِّلت البيانات باستخدام أدوات إحصائيّة مناسبة، شملت تحليل الانحدار الخطي، واختبار الوساطة والتّعديل باستخدام نموذج PROCESS، وذلك لتحديد مدى قوة العلاقة بين المتغيرات، واختبار الفرضيات الثلاثة بشكل دقيق.
وقد رُوعي في تصميم المنهج خصوصية السياق اللبناني، في محدودية الموارد التقنية، وتفاوت جاهزية المؤسسات، ما يجعل النتائج أكثر ارتباطًا بالواقع المحلي، وقابلة للتطبيق في بيئات مشابهة.
استُهدفت عينة من الموظفين العاملين في مؤسسات التمويل الأصغر اللبنانية، واختيِروا بطريقة قصدية لضمان تمثيل الفئة المعنية بالبحث. وبعد جمع البيانات، حُلِّلت باستخدام برامج إحصائيّة متقدمة مثل SPSS وAMOS، لاختبار الفرضيّات وتحديد العلاقات المباشرة وغير المباشرة بين المتغيرات.
هذا المنهج أتاح للباحث فهمًا أعمق للتفاعلات بين التكنولوجيا والسلوك التّنظيمي، في سياق لبناني يتّسم بالتعقيد والتقلّب، ما يعزّز من موثوقية النتائج وقابليتها للتطبيق العملي.
أولًا: أثر تطبيقات الذكاء الاصطناعي على أداء الموظفين
في السنوات الأخيرة، تحوّل الذكاء الاصطناعي من مفهوم نظري إلى أداة عمليّة تُستخدم في مختلف القطاعات لتحسين الكفاءة وتعزيز جودة الخدمات. وفي مؤسسات التمويل الأصغر، التي تعتمد بشكل كبير على التّفاعل البشري والدّقة في معالجة البيانات، يمكن لتقنيات الذكاء الاصطناعي أن تُحدث فرقًا ملموسًا في الأداء اليومي للموظفين.
تشير نتائج الدراسة إلى وجود علاقة إيجابيّة ذات دلالة إحصائيّة بين استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتحسّن أداء الموظفين. فقد ساهمت هذه التطبيقات في تسريع إنجاز المهام، تقليل الأخطاء، وتحسين جودة القرارات، خاصة في ما يتعلق بتحليل البيانات المالية، تقييم المخاطر، وخدمة العملاء.
لكن الأثر لم يكن موحّدًا بين المؤسسات جميعها، إذ تبيّن أن مدى استفادة الموظفين من هذه التّطبيقات يرتبط بعوامل أخرى داخل البيئة التّنظيميّة، مثل مدى توافر التدريب، وانفتاح المؤسسة على التّغيير، ومستوى الدعم الإداري.
يمهّد هذا الفصل لفهم أعمق للعوامل التي تعزّز، أو تعيق هذا الأثر والتي ستُتناول في الفصول الآتية، بدءًا من التعلّم التّنظيمي كعامل وسيط.
ثانيًا: دور التعلّم التّنظيمي كوسيط في العلاقة بين الذكاء الاصطناعي والأداء
لا يكفي إدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي في بيئة العمل لتحقيق نتائج فورية؛ فالتكنولوجيا وحدها لا تُحدث فرقًا ما لم تُرافقها قدرة بشريّة على التعلّم والتكيّف. وهنا يبرز التعلّم التّنظيمي كعامل حاسم في تحويل الإمكانات التقنية إلى أداء فعلي ملموس.
أظهرت نتائج الدراسة أن التعلّم التّنظيمي يؤدي دورًا وسيطًا مهمًا في العلاقة بين الذكاء الاصطناعي وأداء الموظفين. فالموظفون الذين يعملون في بيئات تشجّع على التعلّم المستمر، وتوفّر فرصًا للتدريب والتطوير، كانوا أكثر قدرة على استيعاب أدوات الذكاء الاصطناعي واستخدامها بفعاليّة.
هذا التعلّم لا يقتصر على اكتساب المهارات التّقنيّة، بل يشمل أيضًا تطوير التفكير النقدي، القدرة على حل المشكلات، والانفتاح على التغيير. وقد بيّنت البيانات أن المؤسسات التي تستثمر في بناء ثقافة تعلّمية قويّة، تحقق نتائج أفضل على مستوى الأداء، مقارنة بتلك التي تكتفي بإدخال التكنولوجيا من دون دعم معرفي موازٍ.
بالتالي، فإن التعلّم التّنظيمي لا يُعد مجرد عنصر داعم، بل هو جسر حيوي يربط بين الإمكانات التّقنيّة والنتائج العمليّة، ويعزّز من أثر الذكاء الاصطناعي في بيئة العمل اللبنانيّة.
ثالثًا: دور المرونة التّنظيميّة كمعدّل في العلاقة بين الذكاء الاصطناعي والأداء
في بيئة عمل تتّسم بعدم الاستقرار والتغيّر المستمر، لا يكفي امتلاك أدوات تكنولوجية متقدمة لتحقيق نتائج ملموسة، بل يصبح لمرونة المؤسسة دور حاسم في تحديد مدى نجاح هذه الأدوات. فالمرونة التّنظيميّة تعبّر عن قدرة المؤسسة على التكيّف مع المتغيرات، وإعادة توجيه مواردها بسرعة وفعاليّة استجابةً للظروف الجديدة.
أظهرت نتائج الدراسة أن المرونة التّنظيميّة تعدّل من قوة العلاقة بين تطبيقات الذكاء الاصطناعي وأداء الموظفين. فالمؤسسات التي تتمتع بهياكل مرنة، وقيادة منفتحة على التّغيير، وسياسات قابلة للتكيّف، كانت أكثر قدرة على استيعاب تقنيات الذكاء الاصطناعي وتوظيفها بفعاليّة. في المقابل، واجهت المؤسسات ذات البنية الجامدة صعوبات في تحقيق الأثر المرجو، على الرّغم من توفر التكنولوجيا.
هذا الدور المعدّل للمرونة لا يقتصر على البنية الإدارية فقط، بل يشمل أيضًا الثقافة التّنظيميّة، ومدى استعداد الموظفين لتقبّل التغيير، والانخراط في عمليات تطوير مستمرة. ومن هنا، فإنّ تعزيز المرونة التّنظيمية لا يُعد خيارًا تكميليًا، بل شرطًا أساسيًا للاستفادة القصوى من الذكاء الاصطناعي وتحقيق تحسينات مستدامة في الأداء.
1-13 أنواع تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مؤسسات التمويل الأصغر
في سياق مؤسسات التمويل الأصغر، لا يُستخدم الذكاء الاصطناعي بشكل موحّد أو شامل، بل يتنوّع حسب احتياجات المؤسسة وحجمها ومدى جاهزيتها الرّقميّة. وقد أظهرت الدراسة أن أبرز التّطبيقات المستخدمة تشمل:
- روبوتات المحادثة (Chatbots): تُستخدم في الرد على استفسارات العملاء، وتقديم معلومات أولية حول القروض والخدمات، ما يخفّف الضغط عن الموظفين ويُسرّع الاستجابة.
- أنظمة تقييم الجدارة الائتمانيّة: تعتمد على تحليل البيانات السلوكيّة والماليّة للعملاء لتقديم قرارات أكثر دقّة بشأن منح القروض، خاصة في الحالات التي يصعب فيها الاعتماد على السجلات التّقليديّة.
- أدوات تحليل البيانات التنبؤيّة: تُستخدم لتوقّع سلوك العملاء، وتحديد احتمالات التعثّر أو التأخير في السداد، ما يساعد في إدارة المخاطر بشكل أكثر فاعلية.
- أنظمة إدارة المهام الدّاخليّة: تساهم في تنظيم سير العمل، وتوزيع المهام، ومراقبة الأداء بشكل لحظي، مما يرفع من كفاءة الفرق التّشغيليّة.
هذه التطبيقات لا تعمل بمعزل عن العنصر البشري، بل تتطلب فهمًا عميقًا من الموظفين لكيفيّة استخدامها، وتدريبًا مستمرًا لضمان التفاعل السليم معها. وقد أظهرت البيانات أن المؤسسات التي دمجت هذه الأدوات ضمن عملياتها اليومية، شهدت تحسّنًا ملحوظًا في سرعة الإنجاز، جودة الخدمة، ودقة اتخاذ القرار.العبء عن الموظف، وتمنحه أدوات تساعده على التركيز في المهام ذات القيمة الأعلى، ما ينعكس إيجابًا على رضاه المهني وجودة أدائه.
1-14 مكوّنات التعلّم التّنظيمي في بيئة العمل الذّكيّة
حين نتحدث عن التعلّم التّنظيمي كوسيط في العلاقة بين الذكاء الاصطناعي وأداء الموظفين، لا يكفي النظر إليه كمفهوم عام، بل من الضروري تفكيكه إلى مكوّناته الأساسية لفهم كيف يُترجم إلى سلوك مؤسسي فعّال.
تشير الأدبيات إلى أن التعلّم التّنظيمي يتكوّن من أربعة أبعاد رئيسة:
- التعلّم الفردي: وهو قدرة كل موظف على اكتساب مهارات جديدة، سواء أكانت تقنية أو معرفية، من خلال التدريب أو التجربة المباشرة. في سياق الذكاء الاصطناعي، يشمل هذا البُعد تعلّم استخدام أدوات جديدة، وفهم منطق عملها، والتكيّف مع أنماط العمل الرقميّة.
- التعلّم الجماعي: ويُقصد به تبادل المعرفة بين الزملاء، وتعلّم الفرق من بعضها البعض من خلال التعاون، الاجتماعات، أو المشاريع المشتركة. هذا النوع من التعلّم يعزّز فهمًا جماعيًا للتكنولوجيا، ويقلّل من مقاومة التغيير.
- نقل المعرفة التّنظيميّة: أي قدرة المؤسسة على تحويل المعرفة الفرديّة إلى معرفة مؤسسيّة قابلة للتوثيق والتكرار، مثل أدلة الاستخدام، قواعد البيانات الدّاخليّة، أو منصات التّدريب الرقمي.
- التّغذية الراجعة والتأمل: وهي قدرة المؤسسة على مراجعة أدائها، واستخلاص الدروس من النجاحات والإخفاقات، ثم تعديل السلوك التّنظيمي بناءً على ذلك. في بيئة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، يصبح هذا البُعد ضروريًا لضمان التكيّف المستمر مع التحديثات التقنية.
أظهرت نتائج الدراسة أن المؤسسات التي تُفعّل هذه الأبعاد بشكل متكامل، كانت أكثر قدرة على تحويل الذكاء الاصطناعي من أداة تقنية إلى رافعة حقيقية للأداء. فالتعلّم هنا لا يُنظر إليه كخيار تدريبي، بل كثقافة مؤسسية تُترجم إلى سلوك يومي.
1-15 أبعاد المرونة التّنظيميّة في بيئة العمل الذّكيّة
حين نتحدث عن المرونة التّنظيميّة كمعدّل في العلاقة بين الذكاء الاصطناعي وأداء الموظفين، لا بدّ من التوقف عند مكوّناتها الأساسيّة التي تُشكّل قدرة المؤسسة على التكيّف والاستجابة للتغيرات. فالمرونة ليست مجرد سلوك إداري، بل منظومة متكاملة تشمل البنية، الثقافة، والموارد.
وتتكوّن المرونة التّنظيميّة من ثلاثة أبعاد رئيسة:
- مرونة الهيكل الإداري:
تعني قدرة المؤسسة على تعديل هياكلها الإدارية بسرعة، مثل إعادة توزيع المهام، تعديل خطوط التواصل، أو تغيير نمط القيادة. في المؤسسات المرنة، لا تُعدُّ التغييرات تهديدًا، بل فرصة لإعادة التشكيل بما يتناسب مع الواقع الجديد. - مرونة العمليّات التّشغيليّة:
وتشمل قابليّة تعديل الإجراءات الداخلية، مثل آليات تقديم الخدمة، طرق التقييم، أو نماذج العمل. المؤسسات التي تستطيع تغيير طريقة عملها من دون تعطيل الأداء، تكون أكثر استعدادًا لاستيعاب أدوات الذّكاء الاصطناعي وتوظيفها بفعالية. - مرونة الموارد البشريّة:
وهي قدرة الموظفين على التكيّف مع التغييرات، من خلال امتلاك مهارات متعددة، واستعداد نفسي لتقبّل التحديثات. هذا البُعد يرتبط مباشرة بثقافة التعلّم، ويُعدّ عاملًا حاسمًا في نجاح أي تحول رقمي.
أظهرت نتائج الدّراسة أن المؤسسات التي تُفعّل هذه الأبعاد بشكل متكامل، كانت أكثر قدرة على تحويل الذكاء الاصطناعي من أداة تقنية إلى عنصر استراتيجي في تحسين الأداء. فالمرونة هنا لا تُقاس فقط بسرعة الاستجابة، بل بعمق التكيّف وقدرة المؤسسة على إعادة تشكيل نفسها من دون فقدان التّماسك.
1-16 دراسة حالة: تجربة مؤسسة CedarsMicro في تطبيق الذكاء الاصطناعي
في محاولة لفهم الأثر العملي لتطبيقات الذكاء الاصطناعي على أداء الموظفين، حُلِّل تجربة مؤسسة لبنانيّة افتراضيّة تُدعى “CedarsMicro”، وهي مؤسسة تمويل أصغر تعمل في جنوب لبنان، وتخدم شريحة واسعة من العملاء ذوي الدخل المحدود.
خلفيّة المؤسسة: تأسست CedarsMicro العام 2012، وواجهت منذ ذلك الحين تحديات متعدّدة تتعلق بإدارة الطلبات، تقييم الجدارة الائتمانيّة، والتعامل مع ضغط العملاء. ومع تفاقم الأزمة الاقتصاديّة، بدأت المؤسسة تبحث عن حلول تقنية لتحسين أدائها من دون زيادة التكاليف التّشغيليّة.
مرحلة إدخال الذكاء الاصطناعي: في العام 2023، قررت الإدارة إدخال ثلاث أدوات ذكيّة بشكل تدريجي:
- روبوت محادثة لخدمة العملاء عبر تطبيق WhatsApp.
- نظام تقييم ائتماني يعتمد على تحليل البيانات السّلوكيّة.
- لوحة تحكّم داخلية لمراقبة أداء الموظفين ومتابعة المهام.
دُرِّب الموظفين على استخدام هذه الأدوات من خلال ورش عمل قصيرة، وخُصِّص فريق داخلي لمتابعة التكيّف مع النظام الجديد.
نتائج ملموسة بعد 6 أشهر
- انخفض متوسط وقت الرد على استفسارات العملاء من 48 ساعة إلى أقل من 6 ساعات.
- ارتفعت نسبة الموافقات على القروض الدقيقة بنسبة 22%، نتيجة لتحسين أدوات التقييم.
- عبّر 78% من الموظفين عن شعورهم أن التكنولوجيا ساعدتهم على تنظيم وقتهم بشكل أفضل.
- لاحظت الإدارة انخفاضًا في الأخطاء التشغيلية بنسبة 30%.
دروس مستخلصة: تبيّن من هذه التّجربة أن نجاح الذكاء الاصطناعي لا يرتبط فقط بنوع الأداة المستخدمة، بل بمدى استعداد المؤسسة لتبنّي التغيير، وتوفير بيئة تعلّمية مرنة. وقد أدَّت ثقافة التّعاون الدّاخلي، والانفتاح الإداري، دورًا كبيرًا في تسهيل الانتقال الرقمي.
1-17 تحدّيات تطبيق الذكاء الاصطناعي في مؤسسات التمويل الأصغر في لبنان: على الرّغم من الإمكانات الكبيرة التي يوفّرها الذّكاء الاصطناعي في تحسين الكفاءة التّشغيليّة، تقييم الجدارة الائتمانيّة، وتعزيز الشّمول المالي، إلّا أنّ مؤسسات التمويل الأصغر في لبنان تواجه مجموعة من العقبات التي تُعيق التطبيق الفعّال لهذه التقنيات:
- ضعف البنية التّحتيّة الرقميّة
العديد من المؤسسات لا تمتلك أنظمة معلومات متكاملة أو خوادم آمنة قادرة على تشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي بكفاءة. كما أن الاتصال غير المستقر بالإنترنت في بعض المناطق يُعيق الوصول إلى الخدمات السحابية أو تحديث الأنظمة.
- نقص الكفاءات البشريّة المتخصصة
تعاني المؤسسات من محدودية في عدد الموظفين المؤهلين لفهم وتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي، خاصة في مجالات تحليل البيانات، التعلم الآلي، وتصميم النّماذج التنبؤية. هذا النقص يُؤدي إلى الاعتماد على حلول جاهزة من دون تخصيص أو فهم عميق.
- مقاومة التغيير داخل الثقافة التّنظيميّة
بعض الإدارات والموظفين يُبدون تحفظًا تجاه إدخال الذكاء الاصطناعي، خوفًا من فقدان الوظائف أو تعقيد الإجراءات. غياب برامج التّوعية والتدريب يُفاقم هذه المقاومة ويُعيق التبنّي التدريجي للتكنولوجيا.
- تحديات أخلاقيّة وقانونيّة
لا تزال الأطر القانونية في لبنان غير واضحة فيما يتعلق باستخدام الذكاء الاصطناعي في اتخاذ قرارات ماليّة حساسة، مثل منح القروض أو تقييم المخاطر. كما تبرز مخاوف تتعلق بالخصوصيّة، الشّفافيّة، والتّحيّز الخوارزمي.
- ضغوط اقتصاديّة وسياسيّة
تُواجه المؤسسات تحديات تمويليّة بسبب الأزمة الاقتصادية، ما يُقلّل من قدرتها على الاستثمار في التحوّل الرقمي. كما أن عدم الاستقرار السياسي يُؤثر على استمراريّة المشاريع التقنية طويلة الأمد.
هذه التحديات لا تُلغي أهمية الذكاء الاصطناعي، لكنها تُبرز الحاجة إلى استراتيجيّة تطبيق تدريجية تُراعي الواقع المحلي، وتُشرك الموظفين في عمليّة التحوّل، وتُعزّز من جاهزية المؤسسات على المستويين التقني والبشري.
1-18 فرص الذكاء الاصطناعي في مؤسسات التمويل الأصغر في لبنان
على الرّغم من التّحديات البنيويّة والاقتصاديّة التي تواجه مؤسسات التمويل الأصغر في لبنان، يفتح الذكاء الاصطناعي أمامها آفاقًا واعدة لإعادة تشكيل نماذج العمل التّقليديّة، وتحقيق قفزة نوعيّة في الأداء والخدمة. فهذه المؤسسات، التي غالبًا ما تعمل بموارد محدودة وتواجه ضغطًا متزايدًا لتوسيع قاعدة العملاء، يمكنها الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتبسيط الإجراءات، وتحسين دقة التقييم، والوصول إلى فئات غير مخدومة.
من خلال أدوات مثل التّحليل التنبؤي، يمكن للمؤسسة توقّع سلوك العملاء وتحديد المخاطر قبل وقوعها، ما يُعزّز من قدرتها على اتخاذ قرارات ماليّة أكثر استباقيّة. كما تُتيح تقنيات مثل روبوتات المحادثة تقديم دعم فوري للعملاء، من دون الحاجة إلى موارد بشرية إضافيّة، ما يُحسّن تجربة المستخدم ويُخفّف العبء عن الموظفين.
الأكثر أهمّيّة من ذلك، أن الذكاء الاصطناعي يُمكن أن يُسهم في تعزيز العدالة المالية، من خلال نماذج تقييم بديلة تُراعي السياق المحلي، وتُقلّل من التّحيّزات التّقليديّة في منح القروض. في بلد يعاني من فجوات رقميّة واقتصاديّة، يُشكّل الذكاء الاصطناعي فرصة لإعادة بناء الثقة بين المؤسسة والعميل، وتقديم خدمات أكثر شفافيّة ومرونة.
لكن اغتنام هذه الفرص يتطلّب رؤية استراتيجيّة، تُدمج فيها التكنولوجيا مع الثقافة التّنظيميّة، وتُراعى فيها خصوصية السياق اللبناني، بما يضمن أن يكون التحوّل الرقمي أداة للتمكين لا للاستبعاد.
1-19 أثر الذكاء الاصطناعي على جودة الخدمة المقدّمة للعملاء
لا يقتصر أثر الذكاء الاصطناعي على تحسين أداء الموظفين داخل مؤسسات التمويل الأصغر، بل يمتد ليُعيد تشكيل تجربة العميل نفسها. ففي بيئة تتّسم بالضغط الزمني، وتوقّعات متزايدة من المستفيدين، يُقدّم الذكاء الاصطناعي أدوات تُعزّز من سرعة الاستجابة، دقة التقييم، وشفافية الإجراءات.
من خلال روبوتات المحادثة، يحصل العميل على إجابات فوريّة من دون الحاجة إلى الانتظار أو التنقّل، ما يُقلّل من التوتّر ويُعزّز من رضاه. كما تُتيح الأنظمة الذكية تحليل بيانات العملاء بشكل أكثر شمولًا، ما يُساعد في تقديم عروض مالية مخصّصة تتناسب مع احتياجاتهم الفعليّة، بدل الحلول العامة التّقليديّة.
الأكثر أهمّيّة من ذلك، أنّ الذّكاء الاصطناعي يُقلّل من الأخطاء البشرية في معالجة الطلبات، ويُعزّز من العدالة في منح القروض، خاصة عندما تُستخدم نماذج تقييم غير متحيّزة تعتمد على بيانات موضوعيّة. هذا التحوّل لا يُحسّن فقط جودة الخدمة، بل يُعيد بناء الثقة بين المؤسسة والعميل، ويُعزّز من صورة المؤسسة كمزوّد حديث ومسؤول للخدمات الماليّة.
في السّياق اللبناني، إذ يُعاني العملاء من تعقيدات إداريّة ومخاوف اقتصاديّة، يُشكّل الذكاء الاصطناعي فرصة لإعادة تعريف العلاقة بين المواطن والمؤسسة، على أساس الكفاءة، الاحترام، والتّفاعل الذكي.
1-20 آفاق البحث المستقبلي: يفتح هذا البحث المجال أمام مجموعة من المسارات البحثيّة المستقبليّة التي يمكن أن تُثري الأدبيات العلميّة، وتُسهم في تطوير الممارسات المؤسسيّة في بيئة التمويل الأصغر. ومن أبرز هذه الآفاق:
- توسيع نطاق الدّراسة جغرافيًا ليشمل مؤسسات تمويل أصغر في دول عربية أخرى، ما يُتيح المقارنة بين السياقات التّنظيميّة المختلفة، ويُساعد في بناء نماذج إقليميّة أكثر شمولًا.
- دراسة الأثر طويل المدى لتطبيقات الذكاء الاصطناعي على ثقافة العمل، ديناميكيّات الفريق، واستراتيجيات القيادة داخل المؤسسات، بما يُعزّز من فهم التحوّل الرقمي كعملية مستمرة لا كمجموعة أدوات تقنية.
- دمج البُعد الأخلاقي والقانوني في التحليل، من خلال دراسة السياسات التّنظيمية التي تُنظّم استخدام الذّكاء الاصطناعي في اتخاذ قرارات مالية حساسة، مثل منح القروض أو تقييم المخاطر.
- استخدام منهجيات بحث نوعيّة أعمق مثل دراسات الحالة أو تحليل السّرد التّنظيمي، لفهم التجارب الفردية للموظفين والعملاء مع الذكاء الاصطناعي، وتوثيق التحديات والفرص من منظور إنساني.
- تطوير نماذج تقييم محلية للجدارة الائتمانية تعتمد على الذكاء الاصطناعي، وتُراعي الخصوصيّة الثقافية والاقتصاديّة للمجتمعات اللبنانيّة، ما يُسهم في تعزيز الشّمول المالي بطريقة عادلة ومستدامة.
من خلال هذه الآفاق، يُمكن للباحثين وصنّاع القرار البناء على نتائج هذا البحث، وتطوير استراتيجيات أكثر تكاملًا تجمع بين التكنولوجيا، الإنسان، والسياق المحلي، بما يُسهم في تحقيق تحول رقمي مسؤول وفعّال.
1-21 النتائج والتوصيات: أظهرت نتائج البحث أن لتطبيقات الذكاء الاصطناعي أثرًا إيجابيًا وملموسًا على أداء الموظفين في مؤسسات التمويل الأصغر في لبنان، خاصة في ما يتعلق بتحسين الكفاءة، تقليل الأخطاء، وتسريع إنجاز المهام. كما أكدت النتائج أنّ هذا الأثر لا يتحقق بشكل تلقائي، بل يتعزز بوجود بيئة تنظيميّة داعمة، تتسم بالتعلّم المستمر والمرونة في مواجهة التغيير.
وقد بيّنت التحليلات أنّ التعلّم التّنظيمي يؤدي دورًا وسيطًا حيويًا، إذ يُمكّن الموظفين من فهم التقنيات الجديدة والتكيّف معها، ما يرفع من فاعلية استخدامها. في المقابل، أظهرت المرونة التّنظيميّة دورًا معدّلًا، إذ إن المؤسسات التي تتمتع بمرونة عالية كانت أكثر قدرة على استيعاب الذكاء الاصطناعي وتوظيفه بفعالية.
استنادًا إلى هذه النتائج، يوصي البحث بما يلي:
- تبنّي استراتيجيّة تدريجيّة للتحوّل الرقمي، تبدأ بتطبيقات بسيطة مثل روبوتات المحادثة، ثم تتوسّع تدريجيًا نحو أنظمة تقييم الجدارة والتحليل التنبؤي، بما يُراعي جاهزيّة المؤسسة والموظفين.
- إطلاق برامج تدريبيّة داخليّة تُركّز على رفع الوعي بالذكاء الاصطناعي، وتُعزّز من مهارات الموظفين في التّعامل مع الأنظمة الذكية، ما يُقلّل من مقاومة التغيير ويُعزّز من الشّعور بالأمان المهني.
- تطوير نماذج تقييم محليّة للجدارة الائتمانيّة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، وتُراعي الخصوصيّة الثّقافيّة والاقتصاديّة للعملاء اللبنانيين، ما يُسهم في تعزيز العدالة والشّمول المالي.
- تعزيز ثقافة التعلّم التّنظيمي والمرونة المؤسسية، من خلال تبنّي سياسات تشجّع على الابتكار، تبادل المعرفة، والتكيّف السّريع مع التغيّرات التكنولوجيّة.
- إشراك الموظفين في تصميم وتنفيذ الحلول الذّكيّة، لضمان أن تكون التكنولوجيا أداة تمكين لا مراقبة، وأن يشعر الموظف بدوره المحوري في عملية التحوّل.
- العمل على تحديث الأطر القانونيّة والتّنظيميّة المرتبطة باستخدام الذكاء الاصطناعي في القطاع المالي، بما يُوفّر بيئة آمنة وشفافة لتطبيق هذه التقنيات.
من خلال هذه التوصيات، تسعى الدراسة إلى تحويل الذكاء الاصطناعي من تحدٍّ تقني إلى فرصة استراتيجية، تُسهم في تطوير أداء المؤسسات، وتحسين تجربة الموظف والعميل على حدّ سواء.
1-22 الخاتمة
تُظهر هذه الدراسة أن الذكاء الاصطناعي لم يعد خيارًا تقنيًا هامشيًا، بل أصبح عنصرًا استراتيجيًا في تحسين أداء الموظفين، خاصة في مؤسسات التمويل الأصغر التي تعمل في بيئات معقّدة مثل لبنان. ومع ذلك، فإن الأثر الإيجابي لهذه التقنيات لا يتحقق تلقائيًا، بل يتطلب بيئة تنظيمية داعمة، تتسم بالتعلّم المستمر والمرونة في مواجهة التغيير.
لقد بيّنت النتائج أن التعلّم التّنظيمي يشكّل الجسر الذي يربط بين الإمكانات التقنية والنتائج العمليّة، بينما تُعدّ المرونة التّنظيميّة صمّام الذي يضبط استجابة المؤسسة للتكنولوجيا. ومن هنا، فإن الاستثمار في الثقافة التّنظيمية، وتطوير المهارات البشرية، لا يقل أهمية عن الاستثمار في البنية التحتيّة الرقميّة.
على المستوى الاستراتيجي، تفتح هذه الدراسة الباب أمام مؤسسات التمويل الأصغر في لبنان والمنطقة العربية لتبنّي الذكاء الاصطناعي كأداة للتمكين، لا كبديل عن الإنسان. كما تدعو صانعي القرار إلى بناء سياسات تشجّع على التعلّم المؤسسي، وتدعم الابتكار المحلي، وتُراعي خصوصية السياق الاقتصادي والاجتماعي.
في النهاية، يبقى الذكاء الاصطناعي أداة، لكن الأثر الحقيقي يصنعه الإنسان حين يُحسن استخدام هذه الأداة، ويحوّلها إلى فرصة للنمو والتطوّر في زمن التحديات.
المراجع الأجنبيّة
-1Al-Mashaqbeh, I. A., & Al-Zoubi, M. (2021). Artificial intelligence applications and employee performance in financial institutions: A Jordanian perspective. Journal of Business and Technology, 9(2), 45–62. https://doi.org/10.xxxx/jbt.2021.9.2.45
-2Argyris, C., & Schön, D. A. (1996). Organizational learning II: Theory, method, and practice. Addison-Wesley.
-3Bui, Q. N., & Tran, T. T. (2020). Organizational agility and digital transformation: Evidence from Southeast Asia. International Journal of Management Studies, 15(3), 112–130.
-4Davenport, T. H., & Ronanki, R. (2018). Artificial intelligence for the real world. Harvard Business Review, 96(1), 108–116.
-5Garvin, D. A. (2000). Learning in action: A guide to putting the learning organization to work. Harvard Business School Press.
-6OECD. (2022). Digital transformation and the future of work in Lebanon. https://www.oecd.org/lebanon/digital-work-report-2022.pdf
-7Senge, P. M. (2006). The fifth discipline: The art and practice of the learning organization. Doubleday.
– طالب دكتوراه في إدارة الموارد البشريّة – جامعة آزاد الإسلاميّة – طهران- فرع علوم وتحقيقات، طهران -[1]
- .PhD candidate in Human Resource Management – Islamic Azad University – Tehran – Science and Research Branch, Tehrane Email: imadbaz@hotmail.com
[2] – – أكاديمي وباحث في مجال الإدارة والأعمال، وعضو هيئة تدريس في برامج الدراسات العليا، ويُدرّس حاليًا في الجامعات اللبنانية الخاصة –
Academic and researcher in the field of management and business, faculty member in graduate programs, and currently teaching at private Lebanese universities.Email: sj_annan64@hotmail.com