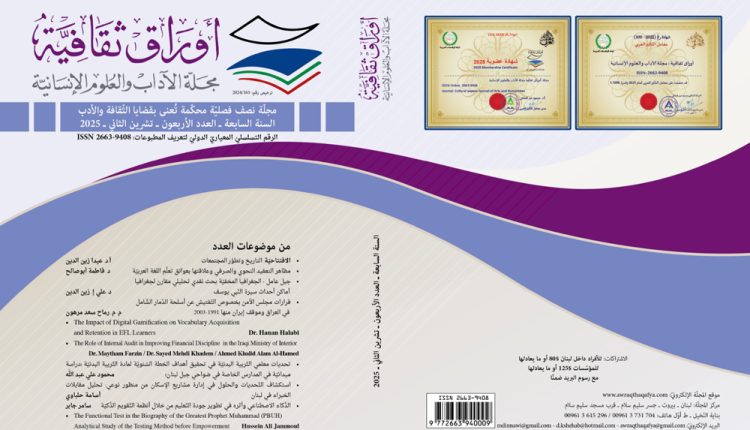عنوان البحث: جبل عامل بين انهيار التعصّب العثماني وتشكيل مقومات مستقبل الهُويّة الشّيعيّة 1880-1920
اسم الكاتب: أكرم عادل باقر
تاريخ النشر: 2025/11/14
اسم المجلة: مجلة أوراق ثقافية
عدد المجلة: 40
تحميل البحث بصيغة PDFADOI: https://aif-doi.org/awraq/014030
جبل عامل بين انهيار التعصّب العثماني وتشكيل مقومات مستقبل الهُويّة الشّيعيّة 1880-1920
Jabal ‘Amil between the Decline of Ottoman Intolerance and the Formation of the Future Shi‘i Identity (1880–1920)
Akram Adel Baqer أكرم عادل باقر([1])
تاريخ الارسال: 21-10-2025 تاريخ القبول:2025-10- 31
ملخّص الدّراسةturniin:2%
تمثل منطقة جبل عامل في جنوب لبنان حالة دراسيّة فريدة لتتبع تحوّل جماعة شيعيّة مهمّشة إلى مكوّن
فاعل في الهُويّة الوطنيّة الحديثة. يهدف هذا المقترح البحثي إلى تحليل تحوّلات أوضاع شيعة جبل عامل خلال المدّة (1880-1920) والممتدة من أواخر العهد العثماني حتى بداية الانتداب الفرنسي، وهي حقبة حاسمة شهدت انهيار سياسة التمييز العثمانيّة وبوادر تشكّل مقومات الهُويّة الشّيعيّة اللبنانيّة المستقبليّة. عاشت هذه الجماعة منذ أواخر القرن التاسع عشر تحت نظامٍ عثماني مركزيٍ كرّس التّفاوت المذهبي والتّهميش الإقليمي، ما جعل الجنوب اللبناني وجبل عامل خصوصًا منطقةً معزولة عن مراكز القرار السياسي والاقتصادي. لكنّ التحوّلات الكبرى التي شهدها المشرق العربي، من سقوط الدولة العثمانيّة إلى الحرب العالميّة الأولى فالانتداب الفرنسي، دفعت أبناء جبل عامل إلى إعادة إنتاج ذاتهم ضمن سياقات جديدة، جاعلةً إياهم ينتقلون من موقع “الطائفة المقهورة” إلى جماعة مندمجة في مشروع بناء الدّولة اللبنانيّة الحديثة.
يعتمد البحث منهج علم الاجتماع التاريخي لفهم كيف أسهمت العوامل الداخليّة (كّحركة الإصلاح الدّيني والتّعليمي) والخارجيّة (كالحرب العالميّة الأولى وانهيار السلطنة) في صياغة وعي جماعي جديد لدى هذه الجماعة. ومن خلال تحليل خطابات قادة الإصلاح العاملي وممارساتهم، تُبرز الدّراسة أن تجربة جبل عامل تمثل نموذجًا لـ“التحديث من الداخل” – أي نهضة نابعة من صميم المجتمع التقليدي نفسه من دون إملاء خارجي. تكمن أهمّيّة البحث في أنه يعالج حالةً لبنانيةً فريدةً تبيّن أن الطائفة الدّينية يمكن أن تتحول إلى
رافعة لبناء الدولة عندما يُعاد تعريفها ضمن أفق إصلاحي عقلاني. وتُثبت تجربة شيعة جبل عامل أن الحداثة ليست نقيضًا للتديّن بالضرورة، بل يمكن أن تكون امتدادًا له إذا أُعيد تأويل الدين في ضوء قيم العدالة والعقل. بذلك يُسهم البحث في إثراء فهمنا لمسارات بناء المواطنة في مجتمعٍ تعددي، عبر تقديم نموذج تاريخي لكيفية تحوّل جماعة مهمّشة إلى شريك أساسي في الوطن.
الكلمات المفتاحيّة: جبل عامل– الشّيعة– الدّولة العثمانيّة– الإصلاح الدّيني– الحرب العالميّة الأولى
الهُويّة الوطنيّة- المواطنة.
Abstract
Jabal ‘Amil (in present-day southern Lebanon) was a predominantly Shi‘i region marginalized under late Ottoman rule due to systemic sectarian discrimination. This study investigates how the decline of Ottoman sectarian intolerance and the socio-political upheavals of 1880–1920 facilitated the formation of a modern Shi‘i collective identity in Jabal ‘Amil. The central question asks how a formerly peripheral, disenfranchised community transformed into an active participant in the nascent Lebanese nation-state.
Employing a historical-sociological perspective, the study analyzes historical sources, reformist clergy writings, and socio-economic sources to trace the evolution of the community. It highlights the interaction between internal processes of reform, for instance, religious revival, greater modern education, and an expanding local press of the Nahda (Arab Renaissance), and external stimuli, that is, the Young Turk reforms, World War I, and the collapse of Ottoman dominion.
The findings suggest that these factors converged to empower Jabal ‘Amil’s Shi‘a to renegotiate their social and political status. By 1920, the Shi‘i community had begun to shed its insular sectarian role, developing a new sense of collective agency grounded in both Islamic revitalization and emerging notions of citizenship and social justice. This formative period laid the groundwork for the community’s further political integration during the French Mandate.
The contribution of this research is to reveal an unprecedented case of internal communal modernization, whereby a sectarian minority reshaped its identity and became an anchor element of Lebanese state-building in the contemporary period. It offers broader insights into identity construction and state-formation in multi-sectarian societies.
Keywords: Jabal ‘Amil -Ottoman Empire- Shi‘i identity- Sectarianism- Religious reform- Modernization- State formation- Lebanon
مقدمة
تُعدّ دراسة شيعة جبل عامل في جنوب لبنان من أكثر القضايا عمقًا في تحليل تشكّل الدولة اللبنانية الحديثة،
لأنّها تمثّل تجربة فريدة في الانتقال من الطائفة إلى المواطنة، ومن الهامش إلى المشاركة. فمنذ أواخر القرن التاسع عشر كانت هذه الجماعة تعيش تحت حكمٍ عثمانيٍ مركزيٍ يرسّخ اللامساواة المذهبيّة والجغرافيّة، فظلّت جبل عامل منطقةً بعيدةً من مراكز السّلطة في بيروت ودمشق وصيدا. وبسبب إرث الصّراع العثماني–الصفوي، نظرت الدولة العثمانيّة إلى الشّيعة بعين الارتياب وعدَّتهم طائفة “غير موثوقة سياسيًا”، ما كرّس سياسة إقصاءٍ وتهميشٍ منهجيّة في حقهم. في مطلع القرن العشرين، بدأت ملامح التغيير بالظهور: شهد المشرق نهضات إصلاحيّة وثقافيّة متزامنة، ولم يكن جبل عامل استثناءً. قادت نخبة من علماء الدّين والمفكرين العاملِيّين مشروعًا إصلاحيًا متكاملًا جمع بين التّنوير الدّيني والإصلاح الاجتماعي، وجعلوا من التّعليم والصحافة والعمل الأهلي أدواتٍ للتّغيير البنيوي. أتاحت هذه الجهود لمجتمعٍ ريفيٍّ مهمَّش أن يتحوّل، خلال عقود قليلة، إلى ركنٍ أساسي في الدّولة الحديثة. وعليه، فإن فهم تجربة جبل عامل يُغني ليس فقط التأريخ اللبناني، بل يسهم أيضًا في فهم أعمق لآليات التّحديث الاجتماعي في العالم العربي، عبر نموذج يُظهر أنّ الهُويّة الطائفيّة قادرة على إعادة تشكيل ذاتها ضمن إطار وطني جامع.
أهمية البحث: تنبع أهمية هذا البحث من جوانب تاريخيّة ونظريّة متعددة؛ فعلى الصّعيد التاريخي، تسلّط الدّراسة الضوء على مرحلة مفصليّة في تطوّر الجماعة الشّيعيّة في لبنان، إذ تكشف آليات انتقالها من التّهميش إلى الاندماج الوطني. إن تتبّع مسار شيعة جبل عامل بين عامي 1880 و1920 يعمّق فهمنا لتشكّل دولة لبنان الحديث ولموقع الطائفة الشّيعيّة ضمنه. كما يبرز البحث تجربة جبل عامل كنموذج لنهضة قاعديّة ساهمت في ترسيخ مفهوم المواطنة على الرّغم من بيئة طائفيّة منقسمة، تجربة لا يزال تأثيرها ممتدًا في البنية السياسيّة والاجتماعيّة اللبنانيّة المعاصرة. أمّا أكاديميًا، فتكتسب الدّراسة أهميتها لكونها تحليلًا نقديًا لتجربة إصلاحيّة عربية مبكرة تداخل فيها الدّيني بالدّنيوي، والعقائدي بالاجتماعي. فهي تمزج بين منهج التاريخ الاجتماعي وعلم الاجتماع السياسي لفهم كيف يمكن لعوامل كالتعليم والخطاب الدّيني العقلاني أن تعيد صياغة هوية جماعة مهمشة. وبذلك، يرفد البحث الأدبيات المجتمعيّة حول بناء الهُويّة الوطنيّة في المجتمعات المتعددة طائفيًا، ويقدّم دروسًا مقارنة قد تُستفاد لفهم تحوّل جماعات أخرى في المشرق. كذلك، قد تساهم نتائج البحث في إثراء النقاش العام حول تجاوز الاصطفافات الطائفيّة نحو عقد اجتماعي جديد قائم على العدالة والمساواة بين مكوّنات المجتمع.
إشكالية البحث: على الرّغم من عقودٍ طويلة من التّهميش تحت الحكم العثماني، شهدت بدايات القرن العشرين تحولًا جوهريًا في واقع شيعة جبل عامل: من طائفةٍ منعزلة تُعامل بارتياب سياسي إلى جماعة واعية تطالب بالعدالة ومكانة متكافئة في دولة حديثة. بناءً عليه تتحدد إشكاليّة البحث بالسؤال المحوري الآتي: كيف انطلقت عملية التحول لدى شيعة جبل عامل بين 1880 و1920 من موقع “الطائفة المهمّشة” في ظل التعصّب العثماني إلى تشكيل مقومات هويّة شيعيّة حديثة مندمجة وطنيًا؟ ويتفرع عن هذا السؤال الرئيس عدد من التساؤلات الفرعية، منها: ما دور سياسات الإقصاء والتّهميش العثمانيّة في توليد وعي إصلاحي داخلي لدى النُخب العامليّة؟ وكيف ساهمت الحرب العالمية الأولى وما رافقها من مجاعة وانهيار للسلطة في تفكيك البنى التقليدية وإعادة تشكيل الوعي الجماعي الشّيعي؟ ثم كيف تفاعل شيعة جبل عامل مع المشاريع السياسية الوليدة بعد الحرب (كالمشروع العربي الفيصلِي ثم الانتداب الفرنسي)، وكيف أثّر ذلك التفاعل على ولاءاتهم وهويتهم الناشئة؟ إن تفكيك هذه الإشكاليات يتيح فهم آليات إعادة تكوين الهُويّة لدى جماعة دينية ضمن سياق الانتقال من الحكم الإمبراطوري الإسلامي العثماني إلى الدولة الوطنيّة الحديثة.
الفرضيات
- فرضيّة التّهميش العثماني:أدّت سياسات الدولة العثمانيّة القائمة على التمييز المذهبي والإقصاء السياسي إلى تعميق الشعور بالظلم لدى شيعة جبل عامل، ما خلق دافعًا داخليًا لبروز وعي إصلاحي يطمح للتغيير.
- فرضيّة الإصلاح الداخلي:مثّلت حركة الإصلاح الدّيني والفكري التي قادها علماء جبل عامل، أمثال محسن الأمين وعبد الحسين شرف الدين وأحمد رضا، عاملًا حاسمًا في إعادة بناء الهُويّة الجماعيّة على أسس حديثة. فهذه الحركة تجاوزت البعد الفقهي البحت لتطرح مشروعًا اجتماعيًا أخلاقيًا هدفه تحرير المجتمع من الجهل والتبعيّة وبناء ثقافة سياسية جديدة قائمة على العلم والعدالة.
- فرضيّة صدمة الحرب:شكّلت أحداث الحرب العالميّة الأولى (1914–1918) وما نتج عنها من مجاعة وانهيار للسلطة نقطة انعطاف تاريخية. تفترض الدّراسة أنّ هذه الصّدمة البنيويّة أدّت إلى انهيار النّظام الاجتماعي القديم (الإقطاعي والعصبي) وبرزت قيادات دينيّة جديدة استطاعت تولي زمام المبادرة، ما أسهم في نشوء وعي اجتماعي قائم على التضامن الأهلي وقيم العدالة.
- فرضية الولاء الوطني الناشئ:مع انهيار الحكم العثماني ودخول حقبة الانتداب، تبلور لدى الشيعة العاملِيّين وعي وطني يتجاوز حدود الانتماء المذهبي. تفترض الدّراسة أن مشاركة وجهاء جبل عامل في المشروع العربي الفيصلِي ثم تصدّيهم لسياسات الانتداب الفرنسي عزّزا إدراكهم لضرورة الانخراط في كيان لبنان على أساس المواطنة المتساوية، بحيث لم يعد الولاء للطائفة يتعارض مع الولاء للوطن.
أهداف البحث: يسعى هذا البحث إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الرئيسة التي توجه مساره التّحليلي:
- توصيف السّياق التاريخي لأواخر العهد العثماني في جبل عامل، عبر إبراز ملامح التّهميش السياسي والاجتماعي والاقتصادي الذي عانته الطائفة الشّيعيّة آنذاك، وكيف هيّأت تلك الظروف الأرضيّة الأوليّة لظهور الوعي التّغييري فيما بعد.
- تحليل حركة الإصلاح العامليّة في نشأتها وروّادها وأفكارها، وبيان دورها في تحديث البُنى الاجتماعيّة والفكريّة داخل المجتمع الشّيعي العاملِي، لا سيما في ميادين التّعليم والاجتهاد الدّيني ونقد الممارسات التّقليديّة، وكيف ساعدت في ردم الفجوة بين جبل عامل ومراكز النّهضة العربيّة.
- دراسة تأثير الحرب العالمية الأولى على مجتمع جبل عامل، خصوصًا ما يتعلق بانهيار الهياكل التّقليديّة (الزعامات الإقطاعيّة والعلاقات العموديّة) وبروز أنماط جديدة من القيادة والتّنظيم الاجتماعي (كشبكات الإغاثة الأهليّة والجمعيّات الخيريّة). يهدف البحث إلى فهم كيف أسهمت تلك التّجربة القاسية في بلورة قيم جماعيّة جديدة كالصمود والتكافل والعدالة.
- استقصاء تفاعل شيعة جبل عامل مع المتغيرات السياسية بين 1918 و1920، بما في ذلك موقفهم من مشروع المملكة العربيّة السّعوديّة بقيادة فيصل بن الحسين، ثم إدماج منطقتهم في “دولة لبنان الكبير” تحت الانتداب الفرنسي. الهدف هو فهم كيف أثّرت هذه التّطورات على شعورهم بالانتماء الوطني وعلى مطالبهم السياسيّة (كالحرية والمساواة)، والتي تجلّت في مواقف مثل مبايعة فيصل أو الاحتجاج على الحكم الفرنسي.
- تحديد مقومات الهُويّة الشّيعيّة الحديثة كما تكوّنت ملامحها في هذه الحقبة التأسيسيّة. أي التّعرف إلى العناصر الفكريّة والمؤسسيّة والقيميّة التي أفرزتها التّجربة العامليّة (كشبكة المدارس والصحافة المحليّة، وصعود القيادة الدّينية المجدِّدة، وترسّخ خطاب العدالة الاجتماعيّة والمواطنة) والتي مهدت لجعل الشيعة أحد دعائم المجتمع والدّولة في لبنان الحديث.
الدّراسات السّابقة: حظي موضوع تحوّل شيعة جبل عامل باهتمام عدد من الباحثين، وتأتي هذه الدّراسة استكمالًا للحوار العلمي الدائر مع الأدبيات السّابقة، مع سعيها لإضافة بصمة خاصة في هذا المجال. من أبرز الدراسات السّابقة:
- صابرينا مرفان (2009) – “حركة الإصلاح الشيعي: علماء جبل عامل وأدباؤه… 1890–1943”. تناولت بالتفصيل دور علماء جبل عامل في تحديث مجتمعهم ودمجه في مشروع الدّولة الحديثة. أكدت مرفان على أنّ الحرب العالميّة الأولى كانت لحظة الوعي الوطني الأولى عند الشيعة العاملِيّين، وقد خرجوا من المحنة بفهم جديد لوطنهم يتجاوز الانعزال المذهبي. كما أبرزت خصوصيّة الإصلاح العاملِي مقارنةً بحركات الإصلاح السُنيّة المعاصرة؛ إذ تصفه أنّه إصلاح “اجتماعي – أخلاقي – وطني” انطلق من القاعدة المجتمعيّة، لا “سياسي – سلطوي” مفروض من النخبة.
- تمارا الشّلبي (2011) – “شيعة جبل عامل ونشوء الدولة اللبنانية (1918–1943)”. ركزت على المرحلة الانتقاليّة من الحكم العثماني إلى الانتداب الفرنسي وبدايات الاستقلال. توضح الشّلبي كيف تكوّن لدى شيعة جبل عامل مفهوم المواطنة كهُويّة وطنيّة جامعة خلال مدّة الانتداب، إذ لم تعد مطالبهم تُطرح كحقوق طائفة وحسب، بل كحقوق مدنية على قدم المساواة مع الآخرين. تشير مثلًا إلى أنّ موقف الشّيعة من المشروع الفيصلي العام 1919 كان تعبيرًا عن وعي قومي عربي يتجاوز حدود الانتماء المذهبي التقليدي.
- وجيه كوثراني (1996) – “الاجتماع السياسي للطوائف في لبنان”. قدّم كوثراني تحليلًا تاريخيًا-سوسيولوجيًا لدور كل طائفة في نشأة الكيان اللبناني. أنار كتابه الخلفيات العثمانيّة لنظرة الدولة السلبية للشيعة وعدِّهم عنصرًا “غير موثوق سياسيًا”، الأمر الذي يفسّر تهميشهم قبل 1920. كما وثّق التحوّل الذي شهده الجنوب العام 1918-1919 مع بدء تشكّل السّلطة الدّينيّة-الاجتماعيّة بقيادة العلماء، وانتقال الشيعة من موقع الرعايا الخاملين إلى فاعلين سياسيين منظمين.
- أحمد بيضون (2002) – “الهُويّة الطائفية والزمن الاجتماعي…”. يقدم بيضون إطارًا نقديًا لدراسة الطائفيّة، واستفادت دراستنا من طروحاته النّظريّة حول إعادة تكوين الهُويات. يصف بيضون الإصلاح الشيعي العاملِي بأنه لم يكن تبنّيًا للحداثة الغربية بقدر ما هو “إعادة تعريفٍ للهوية عبر إعادة تأويل النص الدّيني،” بمعنى حداثة نابعة من الداخل لا مستوردة. كما يشير إلى أن “النهضة الشّيعيّة العاملية كانت مشروعًا للعدالة الاجتماعية أكثر منها مشروعًا لاهوتيًا”، مؤكدًا أن جوهر الحركة الإصلاحيّة كان السّعي إلى الإنصاف المجتمعي.
- جورج قرم (1989) – “الطوائف وتكوين الدولة اللبنانية”. يتتبع قرم دور البُنى الطائفية في بناء دولة لبنان، ويتناول مرحلة الانتداب بالتفصيل. أبرز ما نستفيد من عمله تحليله لسياسة فرنسا في “لبنان الكبير”، إذ يرى إنّها كرّست الطائفية كآلية حكم عبر الاعتماد على الزّعامات التّقليديّة وضرب أيّ نزعة لوعي وطني جامع. يظهر ذلك مثلًا في تقسيم الفرنسيين للجنوب إداريًا واجتماعيًا واستمرار تهميش الشّيعة، ما ولّد رد فعل سياسي لديهم تمثل في المطالبة بالإنصاف والمشاركة المتكافئة.
- حليم بركات (1993) – “المجتمع العربي المعاصر…”. يعرض بركات رؤية بانورامية للمجتمعات العربية. ونقتبس من دراسته وصفه للمجاعة الكبرى في جبل عامل أنّها لحظة “انهيار التّراتبيّة الاجتماعيّة التقليدية، وبداية انتقال القيادة من القوة إلى القيمة”. هذا التوصيف يدعم فرضيتنا حول نشوء قيادات جديدة ذات شرعيّة أخلاقيّة (القيمة) بعد زوال سلطة القوة (الإقطاع). كما يتفق مع رصدنا لتحوّل مركز القيادة أثناء الحرب من الزعماء التّقليديين إلى العلماء والمثقفين.
- رولا ومالك أبي صعب (2014) – “The Shi‘ites of Lebanon: Modernism, Communism, and Hizbullah’s Islamists”. يغطي هذا العمل تاريخ شيعة لبنان في القرن العشرين ضمن سياق التحولات الفكريّة والسياسية الكبرى (الحداثة، والمد اليساري، وصعود الإسلام السياسي). وعلى الرغم من تركيزه على مراحل لاحقة، إلّا أنّه يضيء على استمراريّة بعض عناصر الوعي الجماعي المتشكلة في فترة دراستنا. يذكر الكاتبان مثلًا أنّ مجاعة 1915–1918 في جبل عامل أعادت تعريف معنى الشّهادة والخلاص في الخيال الشّيعي، إذ باتت “المعاناة اليومية نوعًا من الجهاد الاجتماعي”. ويُظهران كيف تحولت ذاكرة المجاعة إلى ركيزة هويّة وظّفت لاحقًا في خطاب قادة الشّيعة، مثل مفهوم الحرمان عند الإمام موسى الصدر في ستينيات القرن العشرين، بوصفه أداة تعبئة جماعيّة قائمة على المطالبة بالعدالة.
- Shaery-Eisenlohr, Roschanack (2008) – “Shi‘ite Lebanon: Transnational Religion and the Making of National Identities”. تناقش Shaery تأثير الارتباطات الدّينية العابرة للحدود (إيران والعراق) في تشكيل هويّة شيعة لبنان في القرن العشرين. تبرز دراستها مفهوم “الشّرعيّة المعاكسة” ، أي الشّرعيّة المستمدة من الناس لا من السّلطة ، لفهم التحول في دور المؤسسة الدّينية العامليّة. استفدنا من منظورها في تحليل انتقال خطاب علماء جبل عامل خلال الانتداب إلى خطاب نقدي مقاوم للاستبداد، وقد استخدموا الدين لبناء شرعية بديلة مناهضة للشرعيّة الاستعماريّة. كما تشير إلى تحول المقاومة الشّيعيّة من فعل عنيف إلى فعل معرفي ثقافي، إذ بُني “رأسمال رمزي مقاوم” عبر التّعليم والوعي التّاريخي في مواجهة قوة المستعمر – وهو ما يتقاطع مع استراتيجيّات العمل الأهلي والثقافي لعلماء الجنوب بعد 1920.
بالإضافة إلى ما سبق، اعتمدت الدّراسة على طيف من المصادر الأوليّة التي أضفت عمقًا على التّحليل، ومنها: مذكّرات أحمد رضا حول أحداث جبل عامل 1914–1922، التي قدّمت شهادة حيّة عن معاناة
الحرب ورؤى النّخبة العامليّة؛ مراسلات السيد محسن الأمين خلال الحرب العالمية الأولى وما بعدها، وفيها وصف لأوضاع المجاعة وتنظيم الإغاثة؛ رسائل السيّد عبد الحسين شرف الدين إلى المسؤولين الفرنسيين في مطلع عهد الانتداب، التي أبرزت احتجاجات العلماء على التّفرقة وطالبت بالمساواة؛ وكذلك مقالات مجلة العرفان وصحيفة لسان الحال في بدايات العشرينيات التي عكست تطلعات الجيل الجديد. كل هذه المصادر ساعدت في إعادة بناء الصورة الذهنية والسردية التاريخية من منظور أبناء جبل عامل أنفسهم.
منهج البحث: ينتهج هذا البحث منهجًا وصفيًا تحليليًا ضمن إطار علم الاجتماع التاريخي. ستُحلَّل الوقائع التّاريخيّة وتطوّر البُنى الاجتماعيّة في جبل عامل بالاستناد إلى مصادر أوليّة وثانوية موثوقة. تشمل المصادر الأوليّة: وثائق ومذكّرات معاصرة لتلك المرحلة (مثل مذكّرات أحمد رضا، ومراسلات الشّخصيات الدّينية والزّمنيّة العامليّة)، إضافة إلى أرشيفات الصّحف والدوريات الصادرة آنذاك (كجريدة العرفان التي وثّقت نشاط الإصلاحيين). أمّا المصادر الثانوية فقد ذُكر أبرزها في قسم الدّراسات السّابقة، وستوظَّف لتوفير إطار نظري مقارن ولملء الثّغرات المعلوماتيّة.
ستُفكك الظواهر المدروسة باستخدام مزيج من الأدوات: التّحليل النصّي لخطابات العلماء والوجهاء (مثال: تحليل مضمون رسالة محسن الأمين العام 1917 إذ قال :“الجوع دين والرحمة بدعة” لفهم دلالاتها الاجتماعية)؛ التحليل البنيوي للتغيّرات الاجتماعية (مثل دراسة انتقال مركز القيادة من الإقطاع إلى العلماء أثناء الحرب)؛ وكذلك التحليل المقارن بموازنة تجربة جبل عامل مع حركات إصلاحية موازية (كمقارنتها بإصلاحات محمد عبده في مصر أو الحركة الدستورية في إيران) لإبراز خصوصيات النموذج العاملي.
وسيعتمد البحث مقاربة متعددة التخصصات تجمع بين علم التاريخ (لتتبّع تسلسل الأحداث والسياق السياسي)، وعلم الاجتماع (لتحليل البُنى الاجتماعية وقيم الجماعة قيد الدّراسة)، وعلم الإنسان الأنثروبولوجي (لفهم الموروث الثقافي والرمزي كطقوس عاشوراء مثلا وكيف أثّر إصلاحها على الوعي الجمعي). ومن خلال هذه المقاربة الشمولية، نأمل برسم صورة متكاملة لتحوّل الهُويّة الشّيعيّة العاملية.
عمليًا، ستُقسَّم الدّراسة إلى محاور زمانيّة/موضوعيّة (كما هو مفصّل أدناه) تتناول كل منها جانبًا من الإشكاليّة. ستُوثق المعلومات تاريخيًا بالرجوع إلى المصادر الأصليّة، مع اتباع نهج نقدي في تمحيص الروايات المختلفة (العثمانيّة، الاستعماريّة، المحلّية) لضمان موضوعيّة الاستنتاجات. وسيُصار في النهاية إلى تركيب تحليلي يجمع الخيوط التّاريخيّة والمفاهيم السوسيولوجيّة لتقديم فهم معمّق لتحوّل الجماعة محل الدّراسة.
مصطلحات الدّراسة
- جبل عامل: منطقة جغرافيّة وتاريخيّة في جنوب لبنان (تُعرف أيضًا ببلاد بشارة تاريخيًا)، تضم حاليًا معظم محافظة النبطية وأجزاء من قضاء صور. تميّزت بكثافتها السّكانيّة الشّيعيّة وعرفت عبر التاريخ بحركاتها العلميّة والدّينية. خلال المدّة المدروسة، كان جبل عامل جزءًا من ولاية بيروت العثمانيّة (تحت إدارة متصرّفية صيدا)، وعانى تهميشًا سياسيًا واقتصاديًا جعل أبناءه يشعرون بالعزلة عن المركز.
- التعصّب العثماني: يُقصد به في سياق البحث النّهج الذي اتبعته السلطنة العثمانيّة حيال التعدّدية الدّينية والمذهبيّة، والقائم على تمييز طائفي وهيمنة الفئة الحاكمة (السنية التركيّة) على باقي المكوّنات. تجلّى هذا التعصّب في معاملة الشّيعة كمجموعة “غير موثوقة سياسيًا” وحرمانهم من المناصب والنفوذ. شكّل هذا التعصّب الخلفيّة السياسيّة لموقع شيعة جبل عامل كطائفة مهمّشة حتى نهاية الحكم العثماني.
- الهُويّة الشّيعيّة (العامليّة): مجموعة السّمات والخصائص الدّينية والاجتماعيّة والثقافيّة التي ميّزت جماعة الشّيعة في جبل عامل خلال المدّة موضوع الدّراسة. تشمل الانتماء المذهبي الجعفري، والولاء لمرجعيّة دينيّة محليّة، إضافة إلى الذاكرة التّاريخيّة المشتركة (كذكرى اضطهادهم أو مآسي المجاعة). يبحث هذا المقترح كيفيّة تطوّر هذه الهُويّة من إطار طائفي مغلق إلى هويّة حديثة تدمج البعد الوطني ، أي انتقال أبناء جبل عامل الشّيعة من التعريف بأنفسهم كطائفة دينيّة مضطهدة إلى فهم ذاتهم كمواطنين متساوين يسعون لبناء وطن يكفل العدالة للجميع.
- المواطنة: مفهوم يشير إلى انتماء الفرد إلى دولة حديثة يتمتع في ظلها بحقوق المواطِن مقابل أداء الواجبات، ضمن إطار مساواة أمام القانون بصرف النّظر عن الانتماءات الأوليّة (الدّين أو العرق). في هذه الدّراسة، يدل المصطلح على انتقال الشّيعي العاملِي من وضعيّة الرعيّة ضمن دولة الخلافة إلى وضعيّة المواطِن في دولة قوميّة. بدأ تبلور فكرة المواطنة في جبل عامل مع إصلاحات التنظيمات العثمانية (1839–1876) التي نظريًا أقرّت مساواة رعايا الدولة، ثم تجذّرت بعد 1920 حين طالبت النُّخب العامليّة بتطبيق مبدأ المواطنة المتساوية في لبنان الكبير بدل نظام الامتيازات الطائفية.
المحور الأول: الإطار التاريخي والسياسي (1880–1914) – من التهميش إلى الوعي الإصلاحي
يستعرض هذا المحور الأوضاع السياسيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة في جبل عامل أواخر العهد العثماني، لبيان كيف هيأت تلك الأوضاع أرضية الوعي الإصلاحي الذي بدأ بالتشكل قبيل الحرب العالمية الأولى.
التهميش العثماني وهيمنة البُنى التقليدية: شكّلت نهايات القرن التّاسع عشر مرحلة تأسيسيّة لفهم طبيعة علاقة شيعة جبل عامل بالدولة العثمانيّة.
لقد تداخل فيها العامل السياسي بالمذهبي، وتراوحت سياسة السلطنة بين الإقصاء والتّهميش الممنهج لهذه الجماعة. إداريًا، كان جبل عامل ملحقًا بمتصرّفية صيدا ضمن ولاية بيروت، بعيدًا من مركز صنع القرار في العاصمة بيروت. لم يحظَ العاملِيّون بتمثيل يُذكر في المجالس الإدارية والبلدية، ولا في الوظائف الحكوميّة العليا، إذ احتكرت النُّخب المارونيّة والسُّنيّة والدرزيّة تلك المناصب وبقي الشيعة على هامش البيروقراطيّة. يعزو الباحثون هذا التهميش إلى النظرة العثمانيّة الريبة تجاه الشّيعة بعد الصراع مع الصفويين، وقد عُدَّ الشّيعة عنصرًا “غير موثوق سياسيًا” ، ما أدّى إلى استبعادهم من مواقع النفوذ. في المقابل، كانت السّلطة الفعليّة ضمن مجتمع جبل عامل موزّعة بين عدد من الأسر الإقطاعيّة الكبرى (مثل آل الأسعد وآل الزين وآل الأمين) التي كرّست بحكم نفوذها العصبيّة العائليّة واستأثرت بالزّعامة المحليّة. وفّرت هذه الأسر قدرًا من الاستقرار والأمن الداخلي، لكنها في المقابل عمّقت الانقسامات الطبقيّة: فقد تحوّل أغلب الفلاحين إلى شبه تابعين يعملون في أراضي الإقطاع مقابل جزء من المحصول أو أجر محدود. وعلى الصّعيد الاقتصادي العام، بقي جبل عامل منطقة زراعيّة تقليديّة (تبغ، زيتون، حبوب) شبه معزولة عن الأسواق المركزيّة. إذ حالت ضعف الطرق والمرافئ من دون انخراطه في الدّورة التّجارية النشطة لمرافئ بيروت وصيدا. كما أن نظام الضرائب العثماني (الالتزام) سمح للملتزمين المحليين باستغلال الفلاحين عبر اقتطاع جزء من الجبايات لأنفسهم، ما زاد من إرهاق الأهالي وتبعيتهم. وهكذا، عشيّة القرن العشرين، كان المشهد العام في جبل عامل مجتمَعًا ريفيًا راكدًا يعاني تهميش الدولة وثقل الإقطاع المحلي، ما تركه في حالة من الانغلاق النسبي عن ركب التحديث الذي بدأ يظهر في مدن الساحل القريبة.
بدايات الوعي الإصلاحي والنهضة الثقافية: على الرغم من حالة الجمود تلك، بدأت إرهاصات الوعي الجديد بالظهور منذ ثمانينيات القرن التّاسع عشر. تأثر بعض علماء جبل عامل ومتعلميه برياح النّهضة الفكرية التي هبّت من مراكز كبرى كبيروت والقاهرة ودمشق. تزامن ذلك مع صعود حركة إصلاح إسلاميّة عامة في العالم السني قادها جمال الدين الأفغاني وتلميذه محمد عبده في مصر، ما أوحى لنظرائهم العاملِيّين بضرورة مراجعة البنى التّقليدية في مجتمعهم هم أيضًا.
برز السيّد أحمد رضا كأحد طلائع المصلحين العاملِيّين؛ فقد دعا مبكرًا إلى “عقلنة الدين” و“إصلاح التربية والتعليم”، ورأى في الجمود الفكري والتقليد الأعمى أحد أبرز أسباب تخلف الطائفة. أكد رضا في كتاباته أنّ “الدين إذا جُرّد من العقل صار عادة، والعادة لا تلد فكرًا”، رابطًا بذلك بين إصلاح الفكر الدّيني والنّهوض الاجتماعي، وداعيًا إلى العودة للعقل والاجتهاد. كذلك عاد السيد محسن الأمين إلى جبل عامل مطلع القرن العشرين بعد دراسته في النّجف ودمشق، حاملاً معه مشروعًا إصلاحيًا جريئًا. في مؤلَّفه “التنزيه في أعمال الشبيه” ندّد الأمين ببعض الممارسات العاشورائيّة الشّعبيّة وعدّها “بدعًا تُسيىء إلى صورة الدّين وتُقدّم الانفعال على العقل”، محاولًا تنقية الشعائر ما عدَّه خرافات. أثارت دعوته هذه جدلًا واسعًا بين علماء الدّين التّقليديين، لكنها أرست أساسًا لتيار عقلي معتدل داخل المجتمع العاملِي يرى أنّ العقل والتّجربة جزء أصيل من الإيمان. أمّا السيّد عبد الحسين شرف الدين، فتبلورت رؤيته الإصلاحيّة في المجال التربوي. شدّد في مراسلاته على أنّ نهضة المجتمع تبدأ من المدرسة كما تبدأ من المسجد، إذ كتب: “من أراد أن يُصلح الدين فليُصلح التّعليم، فإنّ المدرسة هي منبر الأمة وبها تُبنى العقول قبل المعابد”. وهكذا تحوّل الإصلاح العاملِي تدريجيًا من اجتهادات فرديّة متناثرة إلى حركة اجتماعيّة تغييرية تستهدف إعادة هيكلة العلاقة بين الدين والمجتمع، وردم الهوّة بين التعليم الدّيني التقليدي والتعليم المدني الحديث. وقد شجّعت هذه الجهود العواملُ الإصلاحيّة الأوسع في الدولة العثمانية ، أي التنظيمات (1839–1876) التي أعلنت نظريًا مبدأ المساواة بين الرعايا ومنحت غير المسلمين وبعض المسلمين (كالشيعة) حقوقًا على الورق. صحيح أن أثر التنظيمات بقي محدودًا في الأطراف كجبل عامل بسبب استمرار الهيمنة المركزيّة في بيروت وصيدا، لكن مجرد شيوع مفاهيم المواطنة القانونيّة شجّع الشباب العاملِيّ المثقف على التأمل في موقع طائفتهم ضمن كيان دولة حديثة ناشئة. من منظور سوسيولوجي، يُمكن عدّ الإصلاح الدّيني العاملِي محاولة “تحديث من الداخل”؛ إذ سعى العلماء إلى التوفيق بين أصالتهم المذهبيّة ومتطلبات العصر الحديث. وكما يعبّر أحمد بيضون: “الإصلاح الشّيعي العاملِي لم يكن تبنّيًا للحداثة الغربية بل إعادة تعريفٍ للهوية عبر إعادة تأويل النص الدّيني” – أي حداثة منبثقة من التجربة الاجتماعيّة المحليّة نفسها. ولم يقتصر الإصلاح العاملِي على الشّأن الدّيني، بل امتد إلى الحقل الثقافي والأدبي. ففي مطلع القرن العشرين، نشطت في صور والنبطية حركة صحافيّة وأدبيّة رائدة تجسدت في مجلات مثل العرفان (أسسها أحمد عارف الزين العام 1909) والهدى وغيرها. أدَّت العرفان خاصةً دورًا محوريًا في نشر أفكار النّهضة والتّواصل مع التيارات الفكريّة العربيّة. نشرت مقالات حول قضايا التحديث، والتعليم وحقوق المرأة، وروّجت لأفكار مصلحي جبل عامل أمثال رضا وشرف الدّين والأمين.
ويرى وجيه كوثراني أنّ هذه النّهضة الأدبيّة “أدخلت شيعة جبل عامل في المجال الثقافي العربي العام، وجعلتهم جزءًا من مشروع النّهضة الحديثة”. ساعد ذلك في إعادة تشكيل الهُويّة الثقافيّة للطائفة خارج الإطار الطقوسي الضيق، من خلال لغة وخطاب عقلاني ووطني جديد. في إحدى مقالاته بعنوان “الإصلاح بين المسجد والمدرسة” كتب أحمد رضا: “الدين لا يصلح ما أفسد الجهل إلا إذا صار علمًا، والعلم لا يثمر ما لم يكن إيمانًا بالإنسان” (نشرها في مجلة العرفان العام 1912)، ملخصًا جوهر المشروع الإصلاحي العاملِي: جعل الدين في خدمة نهضة المجتمع، لا مجرد وسيلة لتعزيز سلطة دينيّة تقليديّة. كذلك يشير حليم بركات إلى أن “الفكر الإصلاحي في جبل عامل حمل مشروعًا مزدوجًا: تحرير الإنسان من الجهل، وتحرير الطائفة من العزلة”، مؤكدًا أن إصلاح علماء جبل عامل كان في جوهره مشروعًا اجتماعيًا لتحرير مجتمعهم من حالة التبعية والتخلّف.
خلاصة: يمكن القول إنّ المدّة 1880–1914 شكّلت الأساس التكويني لنهضة شيعة جبل عامل اللاحقة. فمن رحم التّهميش السياسي والاقتصادي وُلد وعي إصلاحي داخلي مزج بين الأصالة الدّينية والحداثة الفكرية. انتقلت القيادة تدريجيًا من أيدي الإقطاعيين إلى أيدي العلماء والمثقفين، ومن ولاءات العصبيّة إلى ولاءات الفكرة. وعبر التّعليم والصحافة والاجتهاد، بدأ مشروع مجتمعي جديد يقوم على العقل والإصلاح والعدالة. وعلى الرّغم من محليّة هذه الصّحوة، فقد توازت مع نهضات عربيّة مماثلة في مصر والشام والعراق، ما جعل جبل عامل، على الرّغم من فقره الجغرافي والاقتصادي، أحد المراكز الفكريّة الإصلاحيّة البارزة في المشرق مطلع القرن العشرين. هذه الحقبة ضروريّة الفهم لأنّها المهاد لما سيأتي في الحرب العالميّة الأولى وبعدها، حيث ستثمر البذور الإصلاحية زرعًا وعيًا جمعيًا جديدًا في خضم المحن.
المحور الثاني: الحرب العالمية الأولى (1914–1918) – المجاعة، الانهيار، وبناء الوعي الجمعي
يناقش هذا المحور أثر الحرب العالمية الأولى على مجتمع جبل عامل، بوصفها مرحلة كارثيّة أعادت تشكيل البناء الاجتماعي والذّهني للطائفة الشّيعيّة، ومهدت لولادة وعي جديد ومتطوّر.
الانهيار الاقتصادي والاجتماعي في زمن الحرب: مع اندلاع الحرب العالميّة الأولى وتشديد جمال باشا قبضته العسكرية على بلاد الشام، فرضت السّلطات العثمانيّة إجراءات قمعية استنزفت موارد جبل عامل. جرى تجنيد قسري لأبناء المنطقة في الجيش، ومصادرة للمحاصيل والمواشي لإمداد الجيوش. أدى ذلك إلى انهيار العمود الفقري للاقتصاد الريفي العاملِي، الإنتاج الزراعي، فتفاقمت المجاعة بشكل مأساوي.
كما فرض العثمانيون حصارًا على سواحل الجنوب ومنعوا استيراد المواد الغذائيّة من الخارج، فقطعت الإمدادات التي كانت تصل سابقًا من مصر وفلسطين (خصوصًا القمح). ونتيجة ذلك انتشر الجوع والأوبئة (كالطاعون والتيفوئيد) في معظم القرى. يصف أحمد رضا في مذكراته تلك الفترة السوداء بقوله: “لم يكن في جبل عامل قرية إلا وفيها مقبرة جديدة؛ الجوع يأكل الناس قبل المرض، والظلم يسبق الموت” ، عبارة تختصر الواقع المأساوي الذي عاشته المنطقة حيث حلّ الموت البطيء نتيجة الجوع والقهر قبل أن تجهز الأمراض على السكان. أمام هذا الوضع، انهارت ركائز النظام الاجتماعي القديم: عجزت الزعامات الإقطاعيّة عن حماية الأهالي وتأمين قوتهم فانفضّ الناس من حولها، وتراجعت القيم التّقليديّة القائمة على الطاعة العمياء مع تغلّب غريزة البقاء. ينظر علماء الاجتماع إلى تلك المرحلة كنوع من “الاختبار الوجودي” للمجتمع العاملِي، إذ كشفت الحرب مدى هشاشة بنيته الاقتصاديّة واعتماده على تضامن أهلي محدود.
المجاعة الكبرى وإعادة ترتيب المجتمع: بلغت المحنة ذروتها في مجاعة 1915–1918 (المعروفة شعبيًا بـ“السفر برلك”). لم تكن المجاعة مجرد نقص في الغذاء، بل مثّلت حدثًا بنيويًا فارقًا أحدث قطيعة مع الماضي. فقد أودت بحياة الآلاف وزعزعت كل البنى التقليدية: زالت زعامات إقطاعية عديدة لعجزها عن مساعدة القرويين، وبرزت مكانها قيادات جديدة تستند إلى العلم والدين وشرعية أخلاقيّة. يصف حليم بركات المجاعة أنّها لحظة “انهيار التراتبية الاجتماعيّة التقليدية، وبداية انتقال القيادة من القوة إلى القيمة” ، أي من سلطة النفوذ والمال إلى سلطة الخدمة والقيم. بالفعل، خلال الحرب تصدّى علماء الدين الشيعة لمسؤولية إدارة الأزمة على الرّغم من المخاطر. أثبتوا قدرتهم على تنظيم الإغاثة وتقديم العون، فاكتسبوا مكانة قياديّة جديدة داخل المجتمع. في غياب الدولة العثمانيّة كمرجع للشّرعيّة، تحوّل العلماء إلى ممثلي الجماعة ومقدّمي الخدمات الأساسيّة: وزّعوا ما توفر من حبوب، وأداروا الأوقاف لتوجيه عائداتها للفقراء، وأقاموا شبكات دعم اجتماعي بدائية. من أبرز هؤلاء السيّد عبد الحسين شرف الدين والسيد محسن الأمين، وقد قادا مبادرات إغاثيّة وتعليميّة على الرّغم من تضييق السلطات. يروي السيد الأمين في رسالة العام 1917 أنه كان “يجمع التبرعات من الميسورين لتوزيع الخبز على الأطفال والأرامل” ويضيف واصفًا الحال: “في زمنٍ صار فيه الجوع دينًا والرحمة بدعة” – وهي مقولة تعبّر ببلاغة عن التحوّل العميق في الوعي الدّيني: إذ لم يعد الإيمان مجرد شعائر، بل غدا ممارسة اجتماعيّة مقاومة للجوع والظلم. لقد ولّد هذا التحوّل ما يمكن تسميته بـ“لاهوت الصمود الاجتماعي”، أي توظيف الدين كمورد رمزي لمواجهة الانهيار المادي والمعنوي. ومن جهة أخرى، أدّت المجاعة إلى تفكك العلاقات العموديّة التّقليديّة بين الفلاحين والإقطاعيين، وحلّت محلها علاقات أفقية جديدة قائمة على التعاون الأهلي. يرى أحمد بيضون أن تلك المدّة شهدت بداية “تشكل وعي اجتماعي جديد قائم على التّضامن الأهلي لا الولاء الطبقي” ، فقد حلّت روابط التّكافل محل علاقات التبعيّة القديمة. ومهّد هذا التحوّل لظهور أنماط تنظيم اجتماعي جديدة كالجمعيّات الخيرية والمدارس الأهليّة الحديثة التي ستصبح لاحقًا نواة لمجتمع مدني ناشئ في جنوب لبنان خلال عهد الانتداب.
القيادة الدّينيّة الجديدة والشّرعيّة الأخلاقيّة: مع عجز الزعامات الوراثيّة عن إدارة الأزمة، انتقلت السّلطة الرّمزيّة تدريجيًا إلى العلماء الإصلاحيين الذين جمعوا بين الدور الدّيني والدور الاجتماعي. يصف أحمد رضا العام 1918 هذا الواقع بقوله: “الناس بعد انسحاب العسكر، لجأوا إلى العلماء لحل النزاعات وتنظيم الموارد، إذ غابت الدولة وبقي الضمير”. وهكذا تبلور مفهوم جديد للقيادة داخل المجتمع الشّيعي قائم على الشّرعيّة الأخلاقيّة المتأتية من الخدمة والتّضحيّة، لا على الثروة أو النسب. يعدُّ وجيه كوثراني هذا التّحول بداية تشكّل “السلطة الدّينية الاجتماعيّة” في الجنوب اللبناني. فقد أصبح “العالِم” الدّيني في تلك الفترة شخصية جامعة بين تفسير النص وخدمة الناس، يوزّع الموارد ويقود العمل الأهلي. وابتدأ الخطاب الدّيني يأخذ منحى اجتماعيًا ميدانيًا ينتقد الظلم ويدعو إلى العدالة والمساواة ، وبذلك بات قريبًا في مضامينه من الخطاب السياسي وإن بقي ديني الشكل. هذا الوعي القيادي الجديد خلق نوعًا من الانفصال الرمزي عن الدولة العثمانيّة: بدأ الشيعة العاملِيّون يشعرون أنّ خلاصهم لن يأتي من “المركز” (إسطنبول) بل من داخل مجتمعهم أنفسهم. ومن منظور علم الاجتماع السياسي، تحوّلت الطائفة في هذه المرحلة من كيان تابع إلى فاعل اجتماعي مستقل، وهي سمة أساسية لبروز الهويات الجماعية الحديثة في الشرق الأوسط.
انبثاق الوعي الوطني والعدالة الاجتماعية: على الرّغم من الكارثة الإنسانية المهولة، خرجت من رحم المعاناة بذور وعي سياسي جديد. أدرك المثقفون العاملِيّون أن ضعفهم وتهميشهم ليسا قدرًا محتومًا، بل نتيجة بنية سلطويّة ظالمة يمكن تغييرها. أُعيدت قراءة العلاقة بين الدين والسياسة داخل الوعي الشّيعي: فلم يعد يُنظر إلى الدولة كمصدر للظلم فقط، بل بوشر التفكير بقيام دولة بديلة عادلة. كتب أحمد رضا العام 1918 مقالًا بعنوان “في معنى الوطن” قال فيه: “الوطن ليس الأرض، بل العدالة. فإذا غابت العدالة غابت الأوطان ولو كثرت الرايات”. تمثل هذه العبارة تحولًا جوهريًا من الانتماء الدّيني أو الولاء الإقليمي إلى الانتماء لقيم وطنية جامعة تقوم على العدالة. وهو ما تؤكده صابرينا مرفان في تحليلها إذ تعدُّ الحرب العالمية الأولى “لحظة الوعي الوطني الأولى” عند الشّيعة العاملِيّين – أي اللحظة التي وُلدت فيها فكرة الوطن العادل كغاية تتجاوز أي ولاء طائفي ضيّق. كما ساهمت المحنة في كسر بعض القيود التّقليديّة، إذ خرجت المرأة العامليّة إلى الفضاء العام لأول مرة خلال الحرب. شاركت النّساء في أعمال الإغاثة وجمع الطعام ورعاية المرضى، ما منحهن دورًا اجتماعيًا جديدًا وأعاد تعريف موقعهن داخل الأسرة والمجتمع. تقول تمارا الشلبي في ذلك: “في زمن الحرب، خرجت المرأة الشّيعيّة من البيت إلى الفضاء العام لأول مرة، لا كناشطة سياسية بل كأمٍّ ومربّية وفاعلة اجتماعيّة” ، وهي ملاحظة تُبرز بُعدًا اجتماعيًا مهمًا لتحول أدوار المرأة بفعل الحرب.
إلى جانب آثارها المباشرة، تركت المجاعة ذاكرة جماعيّة عميقة لدى شيعة جبل عامل، غدت لاحقًا ركيزة في بناء الهُويّة الشّيعيّة الحديثة. تحولت قصص الجوع والموت إلى رموز للتّضحيّة والصبر وأُدرجت ضمن الخطاب الدّيني كتجارب أخلاقيّة عن الصمود والمقاومة. ويرى رولا ومالك أبي صعب أن “المجاعة في جبل عامل أعادت تعريف معنى الشّهادة والنجاة في الوجدان الشيعي، إذ أصبحت المعاناة اليومية نوعًا من الجهاد الاجتماعي”. هذه الذاكرة، بوضع الجماعة في موقع الضحية السّاعية للعدالة لا الانتقام، سمحت لاحقًا ببناء خطاب سياسي قائم على مفهوم “الحرمان” كأداة تعبئة جماعيّة في جنوب لبنان. وقد أحيا الإمام موسى الصّدر في السّتينيات مفهوم الحرمان هذا، مستندًا إلى تلك الذاكرة التاريخيّة للمظلوميّة والصمود، لحشد أبناء الجنوب حول المطالبة بحقوقهم الوطنية المهضومة.
خلاصة: مثّلت سنوات الحرب العالميّة الأولى مختبرًا تاريخيًا لتوليد الوعي الجمعي الجديد لدى شيعة جبل عامل. فعلى الرّغم من المأساة غير المسبوقة، خرج المجتمع العاملِي من أتون 1918 أكثر وعيًا ونضجًا. تحطّمت البُنى التقليدية القديمة (الإقطاع والعصبية)، وتأصلت قيم التضامن والعقلانيّة والشّرعيّة الأخلاقيّة كأساس لهُوية جماعيّة حديثة. بدأ العاملِيّون يعرّفون أنفسهم ليس فقط كطائفة دينيّة مهمّشة، بل كجماعة تمتلك ذاكرة ومعنى ورموزًا مشتركة وتبحث عن العدالة والمساواة في وطنها. وكما قال أحمد بيضون: “الحرب في جبل عامل كانت مولد الوعي لا نهايته، إذ كشفت للشّيعة أن خلاصهم لن يأتي من فوق، بل من إعادة تنظيم أنفسهم من الداخل” – أي إدراكهم أن حقوقهم لن تُمنح لهم من سلطة عليا، بل عليهم انتزاعها بتنظيم صفوفهم وبناء مؤسساتهم الذاتية. لقد أرست الحرب والمجاعة بنية رمزيّة جديدة قوامها التضامن والعقلانية والشرعية الأخلاقية، مما مهّد الطريق أمام حركة الإصلاح الدّيني والسياسي في العشرينيات والثلاثينيات. وبذلك يمكن عدُّ هذه الحقبة المهد التّاريخي للفكر الإصلاحي الوطني الشّيعي الذي سيتبلور في عهد الانتداب كحركة اجتماعيّة شاملة لبناء وطنٍ يتسع لجميع أبنائه.
المحور الثالث: من انهيار السلطنة إلى الانتداب الفرنسي (1918–1920) – التحوّل نحو الوعي السياسي الوطني
يتناول هذا المحور التطورات السريعة في جبل عامل بين أواخر 1918 والعام 1920، وهي المدّة التي شهدت انتقال الجنوب من الحكم العثماني إلى الحكم الفرنسي. نركّز على كيفية استجابة الشّيعة العاملِيّين لفراغ السلطة بعد سقوط العثمانيين، ثم تفاعلهم مع مشروع المملكة العربيّة الفيصليّة، وأخيرًا تحديات اندماجهم في دولة لبنان الكبير مطلع عهد الانتداب، وما رافق ذلك من بروز وعي سياسي جديد.
فراغ السلطة وبداية الفاعليّة المحليّة: مع نهاية الحرب العالمية الأولى وسقوط السلطنة العثمانية في أواخر 1918، دخلت منطقة جبل عامل، كسائر مناطق المشرق، مرحلة فراغ سياسي كامل. انهارت مؤسسات الدولة المركزية، وانسحب الجيش العثماني مخلفًا فراغًا إداريًا وأمنيًا واقتصاديًا واسعًا. وجد الشّيعة أنفسهم أمام منعطف غير مسبوق؛ فبعد قرون من التبعية والتهميش في ظل السلطنة، بات عليهم أن يواجهوا سؤالًا مصيريًا: كيف يُعاد تنظيم المجتمع في غياب الدولة؟ ومن يقود المرحلة المقبلة؟ في هذه الأجواء الحرجة، برزت الحاجة إلى قيادة محليّة بديلة تسد الفراغ. وبالفعل، نهض العلماء والمثقفون العامليّون لملء الفراغ الذي خلّفه انهيار الإدارة العثمانيّة. يشير أحمد رضا في مذكراته إلى أن “الناس بعد انسحاب العسكر، لجأوا إلى العلماء لحل النزاعات وتنظيم الموارد، إذ غابت الدولة وبقي الضمير”. أي أن العلماء أصبحوا الملاذ لتنظيم شؤون المجتمع المحلي. هكذا تحوّل العلماء من سلطة رمزية روحيّة إلى سلطة تنظيميّة فعليّة، ما أعطى الشّيعة شعورًا متناميًا بالاستقلال الذاتي في إدارة مناطقهم. وشكّل هذا الفراغ لحظة تحول من التبعية إلى الفاعلية؛ فمن اعتُبروا سابقًا مجرد “رعايا” في كنف السلطنة، بدأوا ينظرون إلى أنفسهم كـ“جماعة سياسية” لها رأي ودور. يصف وجيه كوثراني تلك اللحظة بأنها “بداية الانتقال من الطائفة كهُويّة اجتماعيّة إلى الطائفة كفاعل سياسي منظم”. وهكذا بدأ يتشكل وعي سياسي جديد محوره الدّفاع عن كيان الجنوب الاجتماعي وقيم العدالة والمساواة في مرحلة ما بعد العثمانيين.
المشروع العربي الفيصلي وتجربة الانخراط القومي: عقب انسحاب العثمانيين، أعلن الأمير فيصل بن الحسين في دمشق قيام المملكة العربيّة السّوريّة (1918–1920) بشعار استقلال بلاد الشام ووحدتها العربية. لاقى هذا المشروع صدى قويًا في جبل عامل، إذ رأى فيه العلماء الإصلاحيون بصيص أمل بالخلاص من قرون التّهميش والهيمنة الأجنبيّة. أُرسل وفد من وجهاء الشيّعة العامليّين إلى دمشق لمبايعة فيصل في ربيع 1919، ضمّ شخصيات بارزة مثل السيّد عبد الحسين شرف الدين والسيّد أحمد رضا والسيد محسن الأمين.
كتب السيّد شرف الدين إلى فيصل رسالة أكد فيها: “نحن من العرب وبالعروبة نحيا، ونرى في وحدتكم خلاص المظلومين من عسف الأجنبي” ، معبّرًا عن التقاء تطلعات شيعة جبل عامل مع المشروع القومي العربي في هدف التخلص من الاستعمار. يعكس هذا الموقف تحولًا جذريًا في خطاب طائفة جبل عامل: من الانغلاق المحلي والشّك تجاه الدّولة إلى الانخراط في مشروع قومي أوسع. لقد أدرك العلماء العامليّون حينها أنّ انتماءهم المذهبي لا يتعارض مع هويتهم العربيّة، وأنّ الدّفاع عن حقوق جبل عامل جزء لا يتجزأ من الدّفاع عن نهضة المشرق العربي ككل. توافق تمارا الشّلبي على هذا التحليل، إذ ترى أن “موقف الشّيعة العاملِيّين من المشروع الفيصلي لم يكن مجرد تأييد سياسي، بل تعبير عن وعي قومي جديد تجاوز حدود الطائفة”. غير أن هذه الآمال لم تدم طويلًا؛ فقد انهارت المملكة العربيّة عقب هزيمة قوات فيصل أمام الفرنسيين في معركة ميسلون (يوليو 1920) ودخولهم دمشق. ترتب على ذلك إخضاع كامل سوريا ولبنان للانتداب الفرنسي، بما فيه جبل عامل الذي وجد نفسه فجأة منتزعًا من محيطه الطبيعي وملحقًا بدولة لبنان الكبير الوليدة.
إعلان لبنان الكبير وتحديات الاندماج: في الأول من أيلول/سبتمبر 1920، أعلن الجنرال الفرنسي غورو قيام دولة لبنان الكبير بحدود جديدة ضمت جبل عامل والبقاع إلى متصرفية جبل لبنان السابقة. هكذا وُضع شيعة جبل عامل ضمن كيان سياسي جديد لم يساهموا في رسم ملامحه، وتحت سلطة استعماريّة أجنبيّة. ولّد هذا الواقع شعورًا بالاغتراب السياسي لدى الكثيرين منهم، إذ رأوا أن الكيان اللبناني صُمّم أساسًا لخدمة مصالح فرنسا وحلفائها المحليين (النّخبة المارونيّة)، بينما أُلحق الجنوب والشّيعة قسرًا بهذا الكيان من دون حسبان رأيهم. يصف أحمد رضا هذا الحدث في مذكراته بعبارة مؤثرة: “نُقلنا من حكم الأتراك إلى حكم الفرنجة، لا خيار لنا إلا أن نصبر كما صبرنا، لكننا هذه المرة نملك الوعي”. تعكس هذه الكلمات إدراكًا جديدًا لدى الشّيعة العاملِيّين: فبعد أن صبروا طويلًا على ظلم العثمانيين من دون حول ولا قوة، باتوا الآن يمتلكون وعيًا سياسيًا وخبرة نضالية سوف تسعفهم في مقاومة سياسات الاستعمار الفرنسي. وبينما كان التّهميش في العهد العثماني ذا طابع بنيوي، طائفي متجذّر، أصبح في عهد الانتداب سياسة استعماريّة مباشرة سعت إلى تكريس التقسيم الطائفي للمجتمع اللبناني وإبقاء الشّيعة في مرتبة ثانوية. فقد جزّأت فرنسا الجنوب إداريًا وعرقلت وحدته الجغرافيّة والاجتماعيّة، وأبقت إدارته بيد شخصيات محليّة تابعة لها تتمركز في صيدا، ما همّش القرار الشّيعي وأضعف أي محاولة لتنظيم وعي وطني جامع. لكنّ المفارقة (كما يلاحظ قرم) أن هذه السياسة ولّدت نتيجة معاكسة في الجنوب: إذ دفعت الشّيعة العاملِيّين نحو بلورة وعي سياسي جماعي مقاوم، أدركوا معه أن خلاصهم لن يتحقق إلّا عبر الانخراط في مشروع وطني لبناني مستقل ومتحرر من السيطرة الأجنبيّة.
المقاومة السياسيّة والفكريّة لسلطات الانتداب: منذ الأشهر الأولى للانتداب، ظهرت في جبل عامل بوادر رفض واحتجاج على السياسات الفرنسيّة. شهدت مدن مثل صور وبنت جبيل والنبطية العام 1920 اجتماعات وعرائض تطالب بإنهاء الحكم العسكري الفرنسي وبالمساواة بين اللبنانيين جميعهم من دون تمييز مذهبي. قاد هذه التّحركات العلماء والمثقفون العامليّون. كتب السيّد أحمد رضا، الذي أصبح نائبًا وناشطًا سياسيًا، في مجلة العرفان مقالة بعنوان “لبنان للجميع لا لفئة منه” العام 1921، جاء فيها: “لا وطن لمن لا حرية له، ولا مساواة في ظل حكم يُفرّق بين المواطنين على أساس المذهب”. كذلك وجّه السيّد عبد الحسين شرف الدين رسالة شهيرة إلى المفوض السامي الفرنسي احتجاجًا على اعتقال بعض شبان الجنوب المشاركين في الاحتجاجات، قال فيها: “إنّ الأمة التي يُساق أبناؤها إلى السّجون لأنهم طالبوا بالحريّة، لا يمكن أن تخضع طويلًا، لأن الله خلقها حرّة”. تعبّر هذه النصوص عن انتقال خطاب شيعة جبل عامل من الإصلاح الداخلي إلى الوعي السياسي التحرّري: فلم يعد الإصلاح محصورًا في المجال الفكري أو التربوي، بل أصبح مقاومة فكريّة وهيئاتيّة ضد الهيمنة الأجنبيّة. وكما تقول صابرينا مرفان، كانت حركة الإصلاح الشّيعي في جوهرها “مشروعًا للتحرّر الاجتماعي والسياسي معًا”، أي أنّها لم تفصل بين تصحيح أوضاع المجتمع الدّاخليّة ومقارعة الاستعمار الخارجي. توثّق تمارا الشّلبي هذه المرحلة بوصفها “اللحظة التي تشكّل فيها مفهوم المواطنية في الوعي الشّيعي اللبناني”، إذ إنّ مطالب المساواة لم تعد تُطرح بصفتها امتيازًا لطائفة، بل أصبحت مطلبًا لحقوق إنسانية ومدنية عامّة لكل الجنوبيين واللبنانيين.
ولم تقتصر حركة الرفض على البيانات والخطب؛ فقد شهد عامي 1920 و1921 بعض المواجهات المسلحة المحدودة بين الثوار العاملِيّين والقوات الفرنسيّة في مناطق بنت جبيل وجوارها، عُرفت بـ“انتفاضة جبل عامل”. وعلى الرّغم من أن الفرنسيين أخمدوها سريعًا، إلّا أنّها كشفت استعداد المجتمع الجنوبي للتضحية في سبيل كرامته. يصف أحد شهود تلك الحقبة، السيّد علي الزّين، حال المقاومين بقوله: “لم يكن في يدنا سلاح كثير، لكنّ الكلمة كانت سلاحنا الأكبر، والوعي كان نارًا لا تنطفئ”. تلخّص هذه العبارة جوهر المقاومة العامليّة المبكرة: مقاومة ثقافيّة وفكريّة قبل أن تكون عسكرية. أدرك العاملِيّون محدوديّة قدراتهم العسكرية قياسًا بآلة الاستعمار، فاستثمروا في بناء رأسمال رمزي مقاوم عبر التعليم والكتابة وإحياء الوعي التاريخي. تشير صابرينا مرفان إلى أنّ “الصحافة والتعليم في جبل عامل خلال العشرينيات أدّيا دورًا موازيًا للمقاومة، إذ حملا فكرة التحرر والمساواة إلى الأجيال الجديدة”. وفي هذا الإطار، تأسست جمعيات أهلية مثل جمعية التعاون والإصلاح في صور، وأُنشئت مدارس أهلية حديثة مثل المدرسة العامليّة في صور (1923)، التي أصبحت مراكز لتنوير الشباب وبث الوعي الوطني.
من منظور علم الاجتماع الثقافي، تمثل تجربة تلك المرحلة مثالًا على “تحوّل المقاومة من فعل عنيف إلى فعل معرفي”. فالمجتمع الذي فشل في مواجهة قوة المستعمر عسكريًا، نجح في بناء قوة معنوية عبر الثقافة والتعليم والذاكرة الجماعية، وهي التي أثمرت في العقود التالية في تكوين جيل جديد من المثقفين والسياسيين الشيعة ذوي النزعة الوطنية الصادقة.
بحلول العام 1920، كانت ملامح وعي وطني شيعي جديد قد بدأت تتبلور بوضوح في جنوب لبنان. لم يعد الشّيعة العاملِيّون يرون أنفسهم جماعة دينية مغلقة فحسب، بل جزءًا من كيان وطني ناشئ يحتاج إلى العدالة والمساواة كي يزدهر. يقول أحمد بيضون إنّ “جبل عامل انتقل في تلك السنوات من وعي الطائفة إلى وعي الوطن، ومن المذهب إلى المواطنة”. فقد تكوّنت خلال تلك الفترة المكونات الأساسية لهوية شيعيّة وطنيّة جامعة، تمزج بين انتمائها المذهبي وولائها للبنان كوطن حديث يكفل المساواة لجميع أبنائه.
المحور الرابع: نحو هوية شيعية وطنية – من الطائفة إلى المواطنة
يركز هذا المحور على رصد أبرز المقومات والعناصر التي تكوّنت نتيجة التحوّلات السابقة (1880–
1920)، والتي شكّلت أساس الهُويّة الشّيعيّة اللبنانية الحديثة في المراحل التالية. ونستعرض أيضًا استمرار تطور هذه العناصر خلال مدّة الانتداب الفرنسي (1920–1943) بوصفها امتدادًا لما تكوّن سابقًا.
استمرار النّهضة التّعليميّة والثقافية: بعد العام 1920، وعلى الرّغم من سياسات التّهميش الاستعماري، تابع الشّيعة العاملِيّون مشروعهم النّهضوي من خلال توسيع نطاق التعليم والمؤسسات الأهليّة. شهدت عشرينيات القرن العشرين طفرة في تأسيس المدارس الأهلية الحديثة في الجنوب (في صور والنبطيّة خصوصًا)، حتى بلغ عددها أكثر من ثلاثين مدرسة بحلول أواخر الثلاثينيات. أفرز هذا الاستثمار في التعليم جيلًا جديدًا من المتعلمين يحملون مزيجًا من المعارف الدّينية والعلميّة، ويجمعون بين الولاء لموروثهم والانفتاح على قيم الدّولة الحديثة. وكما تذكر صابرينا مرفان، “خرج من المدارس العامليّة جيلٌ لم يعد يرى الإصلاح مجرّد واجبٍ ديني، بل مشروعًا اجتماعيًا ووطنيًا لتحرير الإنسان من الجهل والتبعية”. من الناحية السوسيولوجية، أدّى انتشار التعليم إلى نقل مركز السلطة الرمزية داخل المجتمع من يد السيّد والإقطاعي إلى يد المعلّم والمثقف، ما أفسح المجال لقيادة اجتماعية جديدة منافسة للقيادة التقليديّة. ترافق ذلك مع ازدهار الصحافة الثقافية في الجنوب: استمرت مجلة العرفان بالصدور وتوسّع انتشارها، وظهرت صحف محليّة أخرى كبوق للمطالب الوطنية. حملت هذه المنابر الفكرية راية التحرر والمساواة إلى الأجيال الشّابة، وأسهمت في ترسيخ اللغة الوطنية الجامعة بديلًا من الخطاب الفئوي الضيق. كذلك تأسست في تلك الفترة العديد من الجمعيّات الأهلية (مثل جمعية المقاصد الخيرية الإسلاميّة في صور 1928، وغيرها) التي اهتمت بالتّعليم والصّحة وشؤون المجتمع، وكانت نواة مبكرة لمؤسسات المجتمع المدني التي تخدم جميع أبناء الجنوب بصرف النّظر عن طوائفهم.
المقومات الحديثة للهوية الشّيعيّة: نتيجة للتراكمات التاريخية منذ أواخر العهد العثماني ثم تجربة الحرب والانتداب، تبلوَرت بحلول منتصف القرن العشرين جملة من المقومات التي باتت تُعرِّف الهُويّة الشّيعيّة اللبنانية الحديثة:
- قيادة دينية مجدِّدة ذات دور اجتماعي: وقد حلّ العلماء الإصلاحيون محل الزعامات التقليديّة، حاملين هموم مجتمعهم ودافعين نحو العدالة. هذه القيادة المزدوجة (دينيّة-دنيويّة) أعطت الطائفة صوتًا في قضايا الوطن، وساهمت في كسر صورة “العالِم المنكفئ” وتحويله إلى قائد شعبي أخلاقي.
- نخبة مثقفة وتعليم حديث: أنتجت حركة التّعليم الموسعة نخبة من المعلمين والمثقفين الشّيعة الذين جمعوا بين معارف الحداثة وروح الهُويّة الدّينية. هذه النّخبة قادت عمليّة دمج الطائفة في مؤسسات الدولة لاحقًا (كالبرلمان والإدارة) بمقاربات جديدة، وأصبحت طرفًا فاعلًا في الحياة الفكريّة والسياسيّة اللبنانية.
- خطاب اجتماعي-سياسي جديد: تكرّس خلال هذه المدّة خطاب يقوم على مفاهيم العدالة الاجتماعيّة والمساواة ومناهضة الظلم، حلّ محل الخطاب الطائفي الدّفاعي القديم. صار الشّيعة يطالبون بحقوقهم كمواطنين عبر هذا الخطاب، رافعين شعارات الوحدة الوطنية والتحرر من الاستعمار. وقد أدى هذا إلى خلق تحالفات عابرة للطوائف مع فئات أخرى تشاركهم الشّعور بالحرمان والغبن، ما عزز انتماءهم إلى فكرة الوطن الجامع.
- الذاكرة الجماعيّة المشتركة: شكلت التّجارب التّاريخيّة الأليمة (سياسات العثمانيين التّمييزيّة، مجاعة الحرب، قمع الانتداب) ذاكرة مشتركة لدى شيعة جبل عامل، رسّخت إحساسهم بهويتهم وبوحدتهم وبضرورة التكاتف لنيل الحقوق. هذه الذاكرة غذّت وجدان الأجيال اللاحقة وزوّدتها بمعين رمزي تستمد منه تصميمها على مواجهة التّهميش (كما ظهر في خطاب “الحرمان” في السّتينيات مثلًا).
- التعددية والانفتاح الوطني: أدرك علماء جبل عامل ومثقفوه، من خلال تفاعلهم مع المشروع الفيصلي ثم تجربة لبنان الكبير، أهمية التعدديّة اللبنانيّة وضرورة الشراكة مع بقيّة الطوائف في بناء دولة العدالة. دعا الإصلاحيون العامليّون إلى التضامن بين مكونات الشعب على الرّغم من اختلافاتها، ورأوا أنّ تعدد الطوائف يمكن أن يكون مصدر ثراء حضاري لا سببًا للشقاق. من هنا، نضجت نظرة منفتحة لدى الشيعة تعدُّ أنّهم جزء من كيان وطني متنوع، وأنّ تحقيق مصالحهم يأتي ضمن إطار المصلحة الوطنيّة العامة لا بمعزل عنها.
هذه المقومات مجتمعة أنتجت ما يسميه أحمد بيضون “النموذج العاملي” في التّعامل مع مسألة الهُويّة والسّلطة. فهو نموذج قدّم فهمًا مبكرًا لكيفيّة المواءمة بين الانتماء الطائفي والولاء الوطني ضمن أفق إصلاحي عقلاني. وكما يصف بيضون علماء جبل عامل: “الإصلاحي العاملِي لم يكن فقيهًا مجردًا، بل عالم اجتماع بالفطرة، أدرك أنّ العدالة الاجتماعية هي جوهر الدين”. بهذا المعنى، يُعدّ الإصلاح العاملِي أحد أوائل التجارب العربية في تحويل الدين إلى مشروع تنموي أخلاقي يجمع بين الفقه والتربية والسياسة، من دون أن يتحوّل إلى أيديولوجيا سلطوية. لقد استطاعت جماعة جبل عامل، عبر النقد الذاتي والمثابرة على التعليم والتنظيم، أن تنقل نفسها من هامش الخريطة السياسيّة العثمانيّة إلى مركز المعادلة الوطنيّة اللبنانيّة، مع حفاظها في الوقت عينه على خصوصيتها الثقافية والدّينيّة.
التوصيات: انطلاقًا من مجمل ما تقدّم، توصي هذه الدّراسة بعدّة أمور على الصّعيدين الأكاديمي والمجتمعي:
- في مجال البحث الأكاديمي: ضرورة توسيع الدّراسات حول التاريخ الاجتماعي للطوائف اللبنانيّة خارج المقاربة الطائفيّة الضيقة، والنظر إليها كبُنى اجتماعيّة وثقافيّة ديناميكيّة متحوّلة لا كمجموعات منعزلة ثابتة. كما توصى بإجراء المزيد من الأبحاث المقارنة بين التّجارب الإصلاحيّة العربية المختلفة (في جبل عامل، مصر، العراق، إيران) لتحديد نقاط التشابه والاختلاف، ما يساهم في فهم أعمق لخصوصيّة كل تجربة.
- في منهجية الدّراسة التاريخيّة-الاجتماعيّة: تشجيع تبنّي مناهج متعددة التّخصصات (تاريخيّة وسوسيولوجيّة وأنثروبولوجيّة ودينيّة) لفهم التّداخل بين الدين والتحول الاجتماعي في المجتمعات العربية. فحالة جبل عامل تثبت أن التحليل المزدوج (المادي والرمزي) ضروري لفهم ظواهر معقدة كإعادة تكوين الهُويّة. كذلك يوصى بالاهتمام بدراسة دور العوامل الثقافيّة (كالصحافة والتّعليم المحلي) في الحركات الاجتماعيّة مبكرًا، لما لها من أثر بالغ كما رأينا في التّجربة العامليّة.
- في التربية الوطنية والتّاريخيّة: إدماج مؤلفات وإرث أعلام الإصلاح العاملِيّين (أمثال السيد محسن الأمين، السيّد شرف الدين، السيّد أحمد رضا) ضمن مقررات الدّراسات التّاريخيّة والفكريّة حول النهضة العربية الحديثة. فهي نصوص تأسيسيّة للفكر الدّيني العقلاني في لبنان، وتعرّف الطلاب على نموذج للتفاعل الإيجابي بين الدين والعقلانيّة.
- في السياسات التنموية الحاليّة: الإفادة من دروس تجربة جبل عامل التّاريخيّة في تعزيز التنمية المتوازنة والمشاركة السياسيّة الشاملة في الجنوب وسائر المناطق المهمشة. فقد أثبتت هذه التّجربة أن تهميش أي فئة يولّد على المدى البعيد وعيًا اعتراضيًا، قد يتحوّل إلى قوة تغيير إيجابيّة إذا أُحسن توجيهها. وعليه، توصى الدولة اللبنانيّة اليوم بتعزيز نهج الإنماء المتوازن وضمان عدالة التمثيل لجميع الطوائف والمناطق، تجنّبًا لإعادة إنتاج مشاعر الحرمان التاريخي.
المراجع العربيّة:
[1]- كوثراني، وجيه،” الاجتماع السياسي للطوائف في لبنان“. بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 1996. صفحة 41
2 – مرفان، صابرينا،” حركة الإصلاح الشيعي: علماء جبل عامل وأدباؤه من نهاية الدولة العثمانية إلى بداية استقلال” لبنان. ترجمة هاشم الأمين، بيروت: دار النهار، 2009. صفحة22
3- بيضون، أحمد،” الهُويّة الطائفية والزمن الاجتماعي عند المؤرخين اللبنانيين المعاصرين“. بيروت: دار النهار، 2002. صفحة 55.
4- رضا، أحمد،” مذكرات للتاريخ: حوادث جبل عامل 1914–1922″، تحقيق وتقديم منذر جابر، بيروت: دار النهار، 2009. صفحة 44.
5- الأمين، محسن،” أعيان الشيعة“. بيروت: دار التعارف للمطبوعات، 1986. صفحة 9.
6- رضا، أحمد،” مذكرات للتاريخ: حوادث جبل عامل 1914–1922″، تحقيق وتقديم منذر جابر، بيروت: دار النهار، 2009. صفحة 44
7- بركات، حليم،” المجتمع العربي المعاصر: بحثٌ اجتماعي تحليلي“. بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 1993. صفحة 212
8- بيضون، أحمد،” الهُويّة الطائفية والزمن الاجتماعي عند المؤرخين اللبنانيين المعاصرين“. بيروت: دار النهار، 2002. صفحة 78
9- رضا، أحمد،” مذكرات للتاريخ: حوادث جبل عامل 1914–1922″، تحقيق وتقديم منذر جابر، بيروت: دار النهار، 2009. صفحة 49.
10- كوثراني، وجيه،” الاجتماع السياسي للطوائف في لبنان“. بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 1996. صفحة 56.
11- شرف الدين، عبد الحسين، “مراسلات جبل عامل، مجموعة رسائل وخطب غير منشورة“، صور، 1918–1921. صفحة 54.
12- شرف الدين، عبد الحسين، “مراسلات الاستقلال، رسائل إلى قيادات الاستقلال” 1943، من أرشيف مجلة العرفان من العام 1909 ولغاية العام 1996، https: alerfan.org
13- شرف الدين، عبد الحسين، “مراسلات وطنية، رسائل بينه وبين شخصيات لبنانية“، صور. صفحة 7
المراجع الأجنبية:
- Abisaab, Rula Jurdi, and Malek Abisaab. The Shi‘ites of Lebanon: Modernism, Communism, and Hizbullah’s Islamists. Syracuse University Press, 2014.
- Shaery-Eisenlohr, Roschanack. Shi‘ite Lebanon: Transnational Religion and the Making of National Identities. Columbia University Press, 2008.
- Zamir, Meir. The Formation of Modern Lebanon. Cornell University Press, 1985.
[1] – طالب في المعهد العالي للدكتوراه في الجامعة اللبنانيّة- الآداب والعلوم الإنسانيّة والاجتماعيّة- بيروت- لبنان- قسم التاريخ
– Doctoral student at the Lebanese University – Faculty of Arts, Humanities and Social Sciences – Beirut – Lebanon – Department of History Email: akrambaqer@gmail.com. Phone: 70941377
.