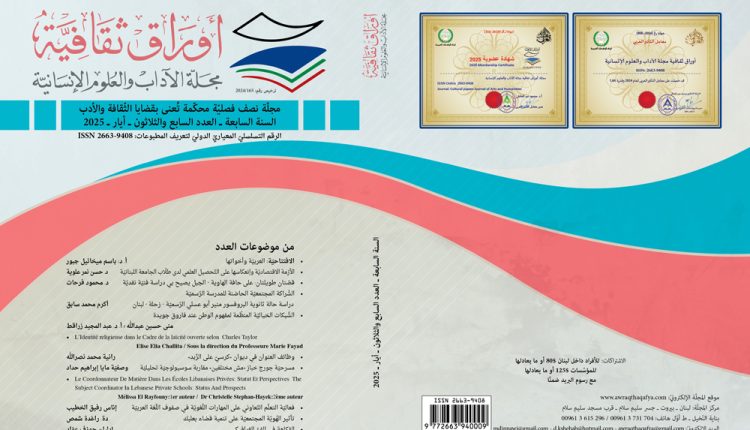عنوان البحث: الاقتصاد ومشكلته: مقاربة إسلاميّة
اسم الكاتب: نعمةالله حسن مروة
تاريخ النشر: 2025/05/13
اسم المجلة: مجلة أوراق ثقافية
عدد المجلة: 37
تحميل البحث بصيغة PDFADOI: https://aif-doi.org/awraq/013705
الاقتصاد ومشكلته: مقاربة إسلاميّة
The economy and its problem: an Islamic approach
Neamatolah Hassan Mrouwe نعمةالله حسن مروة*
تاريخ الإرسال:15-4-2025 تاريخ القبول:27-4-2025
الملخّص turnitin:19%
يُعد الاقتصاد الإسلامي مذهبًا وليس علمًا، والمراد من المذهب الاقتصادي للمجتمع هو الطريقة التي يُفضِّل المجتمع اتباعها في حياته الاقتصاديّة وحل مشاكلها العمليّة؛ أي هو مجموعة من النّظريات الأساسيّة التي تُعالج مشاكل الحياة الاقتصاديّة، وأمّا المراد من علم الاقتصاد فهو العلم الذي يتناول تفسير الحياة الاقتصاديّة وأحداثها وظواهرها، وربط تلك الأحداث والظواهر بالأسباب والعوامل العامة التي تتحكم بها.
وتوجد علاقة جذريّة بين المذهب والتّشريعات، فيشكل المذهب الطابق السّفلي للعمليّة الاقتصاديّة والتّشريعات الطابق العلوي لها، وتجدر الإشارة هنا إلى أنّ الإسلام يفترق عن باقي المذاهب الأخرى في أنّه لم يعطنا مذهبًا جاهزًا سواء في باب المعاملات، أو الاقتصاد، أو الاجتماع… إلخ، وإنما نحن من خلال التّشريعات نكتشف ملامح ذلك المذهب.
ولهذا فإنّ للمذهب الاقتصادي الإسلامي هيكل عام يتألف من ثلاثة أركان رئيسة، يتحدد وفاقًا لها محتواه المذهبي وهي كما يلي:
- مبدأ الملكيّة المزدوجة.
- مبدأ الحريّة الاقتصاديّة في نطاق محدود.
- مبدأ العدالة الاجتماعيّة.
يعدُّ الإنتاج أساس كل نشاط اقتصادي، ويُعرف في مفهومه الواسع أنّه كلّ عمليّة تؤدي إلى إيجاد أو إضافة منفعة سواء ماديّة أو معنويّة، أمّا مفهومه الاقتصادي الضيق فيقتصر على تلك الحلقة من النّشاط الاقتصادي المتمثلة في إنتاج سلعة أو خدمة معيّنة؛ وذلك باستخدام مزيج من عناصر الإنتاج (العمل، رأس المال، والطبيعة) ضمن إطار زمني محدد.
ولا يختلف مفهوم الإنتاج من منظور إسلامي عنه في المفهوم السّابق، غير أنّه يجب في المفهوم الإسلامي أن تكون السّلعة المُنتَجة وأساليب إنتاجها وتوزيعها مقبولة شرعًا؛ أيّ أن يكون الإطار الذي تحصل فيه العمليّة الإنتاجيّة من توظيف، وتمويل، وإنتاج، وتوزيع ضمن دائرة الحلال، إضافة إلى ذلك فإنّ الإسلام يحِد من إنتاج سلع الرفاه والترف، حفاظًا على موارد المجتمع ولتوجيهها في الوجهة الصحيحة.
إن من أهداف الإنتاج في الاقتصاد الإسلامي المهمّة ما يلي:
- الوفاء بحاجات الإنسان في المجتمع الإسلامي، وعدم الاعتماد على الآخرين في تأمينها.
- إنّ الإنتاج لا يكون للوفاء بحاجات الفرد فقط أو المجموعة القائمة على الإنتاج، إنما يكون أيضًا للوفاء بحاجات الآخرين.
- إن الإنتاج في الإسلام هو وسيلة وليس غاية، فالعمل عبادة وإعمار الأرض أمر من الله.
امتاز نظام التوزيع في الاقتصاد الإسلامي عن الأنظمة الأخرى التي جرّبها الإنسان على مرّ التاريخ في الطريقة التي تُوزَّع بها ، فصارت المعيار الشّاهد على إنسانيّة النّظام الاقتصادي الإسلامي، فبينما أخذت الرّأسماليّة توزع الناتج الاقتصادي على شكل حصص متناسبة مع وسائل الإنتاج (رأس المال، المواد الأولية، العمل)، فإنّ النّظام الاشتراكي اتخذ من الحاجة أساسًا لتوزيع الناتج، أمّا النّظام الاقتصادي الإسلامي فذهب إلى الحلّ الوسط، وأخذ وسائل الإنتاج بالحسبان مع شيء من التّهذيب على ما هو موجود في الرّأسماليّة، بالإضافة إلى الأخذ بأهميّة الحاجة في التوزيع؛ إذ القاعدة الأساسيّة في التوزيع لدى الاقتصاد الإسلامي تقوم على ركنين هما العمل والحاجة.
ويتميز الاقتصاد الإسلامي أيضًا عن النظامَين الرأسمالي والاشتراكي برؤيته الخاصة لتوزيع الدخل والثروة، فهو يعالج التوزيع على نطاق أرحب وأشمل، ويرى أن نقطة الانطلاق أو المرحلة الأولى هي التوزيع بدلًا من الإنتاج، لأنّ توزيع مصادر الإنتاج يسبق الإنتاج نفسه، وكل عمليّة إنتاج تُصبح من الدّرجة الثانية، فنرى عندها توزيعًا ما قبل الإنتاج، وتوزيعًا ما بعد الإنتاج.
تختلف نظرة الإسلام إلى المشكلة الاقتصاديّة عن نظرة كل من النّظامين الرأسمالي والاشتراكي، فهو لا يُعزي سبب المشكلة إلى الطبيعة وقلّة مواردها كما تدعي الرّأسماليّة لأنّه يرى أن الطبيعة قادرة على ضمان كل حاجات الإنسان التي يؤدي عدم إشباعها إلى مشكلة حقيقيّة في حياته، كما لا يرى الإسلام أن المشكلة في التناقض بين شكل الإنتاج وعلاقات التوزيع كما تقرر الماركسيّة، وإنما المشكلة قبل كلّ شيء مشكلة الإنسان نفسه لا الطبيعة ولا أشكال الإنتاج.
الكلمات- المفتاحيّة: المذهب الاقتصادي- النظام الاشتراكي- النظام الرأسمالي- الاقتصاد الإسلامي.
Abstract
Islamic economics is a doctrine and not a science, and what is meant by the economic doctrine of society is the way that society prefers to follow in its economic life and solve its practical problems, that is, it is a set of basic theories that address the problems of economic life, and what is meant by economics is the science that deals with the interpretation of economic life, its events and phenomena, and linking those events and phenomena to the causes and general factors that control them. There is a radical relationship between the doctrine and legislation, so that the doctrine forms the basement of the economic process and legislation is its upper floor, and it should be noted here that Islam differs from the rest of the other sects in that it did not give us a ready-made doctrine, whether in the section of transactions, economy, or society… etc., but through legislation we discover the features of that doctrine. Therefore, the Islamic economic doctrine has a general structure consisting of three main pillars, according to which its doctrinal content is determined, which are as follows: The principle of dual ownership. The principle of economic freedom in a limited scope. The principle of social justice. Production is the basis of all economic activity, and is defined in its broad sense as every process that leads to any …
Islam’s view of the economic problem differs from that of both the capitalist and socialist systems, as it does not attribute the cause of the problem to nature and its lack of resources, as capitalism claims, because it believes that nature is capable of ensuring all human needs, which unsatisfying leads to a real problem in his life, and Islam does not see that the problem is in the contradiction between the form of production and the relations of distribution as Marxism decides, but the problem is above all the problem of man himself, not nature or forms of production.
Keywords: economic doctrine – socialist system – capitalist system – Islamic economy.
تعاني البشرية من مشكلات كثيرة، متنوعة، متعددة؛ وهذا جزء من طبيعة تكوينها ووجودها على سطح مقدمة
هذه البسيطة؛ وذلك على أساس أنّ الإنسان مخلوق في كبد، وليعمل ويسعى ويجتهد ويجد؛ وكل ذلك هدفه القيام بوظيفة الاستخلاف على أكمل وجه، وفي هذا كلّه اختبار من الخالق جل وعلا: ﴿لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً﴾([1])؛ لذا لم تكن المشكلة الاقتصاديّة في يوم من الأيام منفصلة عن المشكلات الإنسانيّة العامة التي ولدت مع ولادة الاجتماع الإنساني العام.
فالمشكلة الاقتصاديّة للإنسان تشكل جزءًا من المشكلة الإنسانيّة العامة؛ إذ إنّ الاقتصاد يمثل جانبًا من جوانب حياة الإنسان لا كلّها؛ غير أن تحديد هُوية هذه المشكلة وحقيقتها كان ولا يزال نقطة اختلاف بين المذاهب والنظم المتعددة.
فالرأسمالية تعدُّ أن المشكلة الاقتصاديّة هي قلّة الموارد الطبيعيّة نسبيًّا، نظرًا إلى محدوديّة الطبيعة نفسها والتي لا تفي بالحاجات الماديّة الحياتيّة للإنسان التي تبدو في تزايد مستمر، فتنشأ المشكلة حول كيفيّة التوفيق بين الإمكانات الطبيعيّة المحدودة والحاجات الإنسانيّة المتزايدة. في حين أنّ الماركسية تؤمن أنّ المشكلة الاقتصاديّة تتمثل بالتناقض المستمر بين الشّكل والنّظام الذي يُنتَج في المجتمع وبين نظام التّوزيع. أمّا الإسلام فإنّه يكشف حقيقة المشكلة بنحو آخر، وبخلاف ما تطرحه الرّأسماليّة والماركسيّة، فالمشكلة بحسب الرؤية الإسلاميّة لا تكمن في قلّة الموارد الطبيعيّة وعجزها عن تلبية الحاجات الإنسانيّة المتزايدة، ولا في التّناقض بين نظامي الإنتاج والتوزيع، وإنّما في الإنسان نفسه، وتحديدًا في الجانب السّلوكي منه؛ أي بظلمه وجشعه وسوء استخدامه للموارد، وكذلك بكسله وتقاعسه عن العمل، فتظهر المشكلة الاقتصاديّة في نظر الإسلام في تمثلها أولًا وأساسًا بالبعد من الالتزام بالضوابط الأخلاقيّة والتّشريعات الإسلاميّة، سواء أكان ذلك على صعيد الإنتاج، أو التّوزيع، أو الاستهلاك.
إشكاليّة البحث
تنطلق هذه الدّراسة من مشكلة مفادها أنّ الاقتصادات بأشكالها كافّة، تعاني مما سُمي “بالمشكلة الاقتصاديّة” والتي هي محور علم الاقتصاد القائم على محاولة إشباع الحاجات الإنسانية من خلال الموارد المتاحة، ويؤمن الاقتصاد الإسلامي بوجود المشكلة الاقتصاديّة ولكن طبيعة هذه المشكلة وجوهرها في فكره ليست هي ذاتها في الفكرين الاقتصاديين الاشتراكي والرأسمالي.
منهجية البحث
للإجابة على إشكالية البحث اعتُمِد على المنهج الوصفي التحليلي؛ وعلى الكتب والدراسات المختلفة، وذلك للاطلاع على كل ما يتعلق بموضوع البحث.
المطلب الأول: الهيكل العام للاقتصاد الإسلامي
من المهم بداية التمييز بين المذهب الاقتصادي وعلم الاقتصاد، بوصف أنّ الاقتصاد الإسلامي مذهبٌ وليس علمًا، والمراد من المذهب الاقتصادي للمجتمع هو الطريقة التي يُفضل المجتمع اتباعها في حياته الاقتصاديّة وحل مشاكلها العمليّة؛ أي هو مجموعة من النّظريات الأساسيّة التي تُعالج مشاكل الحياة الاقتصاديّة، وأما المراد من علم الاقتصاد فهو العلم الذي يتناول تفسير الحياة الاقتصاديّة وأحداثها وظواهرها، وربط تلك الأحداث والظواهر بالأسباب والعوامل العامة التي تتحكم بها([2]).
وتوجد علاقة جذرية بين المذهب والتشريعات، بحيث يشكل المذهب الطابق السفلي للعمليّة الاقتصاديّة والتّشريعات الطابق العلوي لها، وتجدر الإشارة هنا إلى أن الإسلام يفترق عن باقي المذاهب الأخرى في أنه لم يعطنا مذهبًا جاهزًا سواء في باب المعاملات أو الاقتصاد أو الاجتماع… إلخ، وإنّما نحن من خلال التّشريعات نكتشف ملامح ذلك المذهب، فمثلًا مرةً يوضع المذهب ثم تُنظم التّشريعات على أساسه، وتوضع الأطر ثم يُشرَّع المشرع القوانين على أساسها، فهل الإسلام هكذا؟ بالطبع لا؛ بل الإسلام يكون عنده في كتابه المقدس (القرآن) وفي الروايات مجموعة أدلة ومجموعة تشريعات مع مجموعة من الإشارات للأطر العامة.
لذا فالمفكر الإسلامي يكون أمام اقتصادٍ منجزٍ، وُضِع بخلاف الاقتصادات الأخرى الذي يضع فيها المفكر أطرها، فالاقتصاد الإسلامي موجود إنما يجب اكتشافه من خلال هذه التفصيلات، فهو جزء من نظام الإسلام الشّامل الذي أنزله الله جلّ وعلا، وبيّنه في كتابه وسنته؛ وعليه فهو يقوم على مبادئ وقواعد ربانيّة وضعها خالق البشر الذي هو أعلم بهم من أنفسهم فيعلم ما يُضرهم وما يُصلحهم.
ولهذا فإن للمذهب الاقتصادي الإسلامي هيكلًا عامًا يتألف من ثلاث أركان رئيسة يتحدد محتواه المذهبي وفاقًا لها، وهي كما يلي([3]):
- مبدأ الملكية المزدوجة
إنّ الإسلام يٌقرر الأشكال المختلفة للملكيّة في وقت واحد، فيضع بذلك الملكيّة المزدوجة (أي ذات الأشكال المتعددة)، بدلًا من مبدإ الشّكل الواحد للملكيّة الذي أخذت به الرّأسماليّة والاشتراكيّة، فهو يؤمن بالملكيّة الخاصة والملكيّة العامة وملكيّة الدولة، ويُخصص لكل واحد من هذه الأشكال المتنوعة حقلًا خاصًّا يعمل فيه.
- مبدأ الحرية الاقتصاديّة في نطاق محدود
يُقصد به السّماح للأفراد على الصعيد الاقتصادي بحرية محدودة بحدود من القيم المعنويّة والخُلقيّة التي يؤمن بها الإسلام، فالإسلام قد اعترف بالحريّة الاقتصاديّة ولكنه وضع قيودًا لها، فلم يُطلقها إطلاق الرأسماليّة ولم يمنعها كما فعلت الاشتراكيّة؛ بل جعل منها حرية منضبطة مُقيدة بحدود الشّريعة الإسلاميّة التي تهدف إلى تحقيق مصالح البشر في الدنيا والآخرة، فالفرد له حرية الاستهلاك والإنتاج والاستثمار، إذا التزم بالضوابط والأحكام الشرعيّة([4]).
ولقد قسم المذهب الاقتصادي الإسلامي الحرية الاقتصاديّة قسمين:
- ذاتي: وهو ينبع من أعماق النّفس ويستمد قوته ورصيده ومحتواه من المحتوى الروحي والفكري للشّخصيّة الإسلاميّة؛ أي يتكون طبيعيًّا في ظل التربية الخاصة التي ينشأ عليها الفرد في المجتمع الإسلامي.
- موضوعي: وهو يُعبّر عن قوة خارجيّة تحدد السّلوك الاجتماعي وتضبطه؛ أي هو التّحديد الذي يُفرض على الفرد في المجتمع الإسلامي من الخارج بقوة الشّرع، ويقوم على المبدإ القائل إنّه لا حرية للشّخص في ما نصت عليه الشّريعة المقدسة من ألوان النشاط التي تتعارض مع المثل والغايات التي يؤمن الإسلام بضرورتها.
ولتنفيذ هذا المبدإ كفِلت الشريعة في مصادرها العامة منع مجموعة من النّشاطات الاقتصاديّة والاجتماعيّة المعيقة عن تحقيق المُثُل والقيم التي يتبناها الإسلام كالربا والاحتكار وغير ذلك، كما ووضعت مبدأ إشراف ولي الأمر على النشاط العام، وتدخُل الدّولة لحماية المصالح العامة وحِراستها بالتحديد من حريات الأفراد في ما يُمارسون من أعمال، ولقد كان وضع الإسلام لهذا المبدإ ضروريًّا لكي يضمن تحقيق مفاهيمه في العدالة الاجتماعيّة على مرِّ الزّمن، والأصل التّشريعي لمبدإ الإشراف والتّدخل هو القرآن الكريم في قوله تعالى: ﴿أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾([5]).
- مبدأ العدالة الاجتماعيّة
وهو الركن الثالث في الاقتصاد الإسلامي أي مبدأ العدالة الاجتماعيّة التي جسدها الإسلام في ما زُود به نظام توزيع الثّروة في المجتمع الإسلامي، من عناصر وضمانات تكفل للتوزيع قدرته على تحقيق العدالة التي يرتكز عليها.
فالإسلام حين أدرج العدالة الاجتماعيّة ضمن المبادئ الأساسيّة التي يتكون منها مذهبه الاقتصادي لم يتبنّها بمفهومها التجريدي العام، ولم يُناد بها بشكل مفتوح، ولا أوكلها إلى المجتمعات الإنسانيّة التي تختلف في نظرتها إليه باختلاف أفكارها الحضاريّة ومفاهيمها عن الحياة، وإنّما حدد الإسلام هذا المفهوم وبلوره في مخطط اجتماعي معين، يمكن اختصاره بمبدأين عامين لكل منهما خطوطه وتفصيلاته وهما:
أولًا: مبدأ التكافل الاجتماعي العام.
ثانيًا: مبدأ التّوازن الاجتماعي وفي التّكافل والتوازن بمفهومهما الإسلامي، تُحقق القيم الاجتماعيّة العادلة، ويوجد المثل الإسلامي للعدالة الاجتماعيّة([6]).
المطلب الثاني: الإنتاج في الاقتصاد الإسلامي والتّوزيع
- الإنتاج في الاقتصاد الإسلامي
يعدُّ الإنتاج أساس كل نشاط اقتصادي، ويُعرف في مفهومه الواسع أنّه كلّ عمليّة تؤدي إلى إيجاد أو إضافة منفعة سواء ماديّة أو معنويّة، أمّا بمفهومه الاقتصادي الضيق فيقتصر على تلك الحلقة من النشاط الاقتصادي المتمثلة في إنتاج سلعة أو خدمة معينة؛ وذلك باستخدام مزيج من عناصر الإنتاج (العمل، رأس المال، والطبيعة) ضمن إطار زمني محدد([7]).
ولا يختلف مفهوم الإنتاج من منظور إسلامي عنه في المفهوم السابق، غير أنّه يجب في المفهوم الإسلامي أن تكون السّلعة المُنتَجة وأساليب إنتاجها وتوزيعها مقبولة شرعًا؛ أيّ أنّ يكون الإطار الذي تحصل فيه العمليّة الإنتاجيّة من توظيف وتمويل وإنتاج وتوزيع ضمن دائرة الحلال، إضافة إلى ذلك فإنّ الإسلام يُحِدُّ من إنتاج سلع الرفاه والترف حفاظًا على موارد المجتمع، ولتوجيهها في الوجهة الصحيحة.
فالإسلام يوجه الكبار إلى استخدام ما أودعهم الله من قدرات ومواهب للاستفادة من موارد الطبيعة في إيجاد السّلع والخدمات المباحة([8])، ويحثّ على العمل والإنتاج، ويربط كرامة الإنسان بالعمل، فأصبح العمل في ضوء مقاييس وتقديرات معينة يُعد عبادة يُثاب عليها المرء، وصار العامل في سبيل قوته أفضل عند الله من المتعبد الذي لا يعمل، وأصبح الخمول والترفع عن العمل نقصًا في إنسانيّة الإنسان وسببًا في تفاهته، فعن رسول الله (ص) أنّه رفع يومًا يد عامل مكدود فقبلّها وقال: «طلب الحلال فريضة على كل مسلم ومسلمة، ومن أكل من كديده مرّ على الصّراط كالبرق الخاطف، ومن أكل من كديده نظر الله إليه بالرّحمة ثم لا يعذبه أبدًا، ومن أكل من كديده حلالًا فتح له أبواب الجنة يدخل من أيها يشاء»([9]).
وحث الإسلام على العمل وقاوم فكرة البطالة كذلك قاوم فكرة تعطيل ثروات الطبيعة، وتجميد الأموال، وسحبها عن مجال الانتفاع والاستثمار، ودفع إلى توظيف أكبر قدر ممكن من قوى الطبيعة وثرواتها في عملية الإنتاج، وخدمة الإنسان.
وعدَّ أن تعطيل أو إهمال مصادر الطبيعة وثرواتها لون من الجحود وكفران النّعمة التي أنعم الله تعالى بها على عباده([10])؛ وقد قال تعالى: ﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالْطَّيِّبَاتِ مِنْ الْرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِيْنَ آمَنُوْا فِي الْحَيَاةِ الْدُّنْيَا خَالِصةً يَوْمَ الْقْيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلْ الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُوْنَ﴾([11]).
ويُعد من أهداف الإنتاج في الاقتصاد الإسلامي المهمّ ما يلي([12]):
- الوفاء بحاجات الإنسان في المجتمع الإسلامي وعدم الاعتماد على الآخرين في تأمينها.
- إن الإنتاج لا يكون للوفاء بحاجات الفرد فقط أو المجموعة القائمة على الإنتاج، إنما يكون أيضًا للوفاء بحاجات الآخرين.
- إن الإنتاج في الإسلام هو وسيلة وليس غاية، فالعمل عبادة وإعمار الأرض أمر من الله.
لقد ربط الإسلام بين الإنتاج والإنتاجيّة والتي يُقصد بها إتقان العمل وتحسينه، لتكون الفوائد الناتجة عنه عالية بما يُحقق التنمية الاجتماعيّة والاقتصاديّة، إلى جانب تأمين الإشباع الروحي الذي يتمثل في استشعار أن العمل عبادة وفريضة، وشرف وقيمة، ويُعدُّ من مقومات رفع الكفاءة الإنتاجيّة المهمّة في الإسلام ما يلي([13]):
- الاهتمام بإعداد العامل وتدريبه، وتنميته عقديًّا، وخُلُقيًّا، وسلوكيًّا، وفنيًّا وفاقًا لقاعدتي الكفاءة والأمانة، وتحقيق الأمن والسكينة له والجزاء العادل والأجر الإضافي.
- تنمية الموارد الطبيعيّة والمحافظة عليها، وترشيد استخدامها بالأساليب المفيدة والنافعة من دون إسراف أو تبذير، مع الاعتماد على التقنيات الحديثة المشروعة.
- المحافظة على المال وتنميته وتوظيفه وفاقًا للأسس الإسلاميّة التي ترفع من كفاءة تشغيله، ومنعه من التّشغيل في الباطل كالربا والاكتناز.
- تطوير وتنمية المؤسسات الماليّة الإسلاميّة وكذلك الأدوات والأساليب والأسواق الإسلاميّة، والنظر إلى هذه المؤسسات الماليّة على أنّها وسيلة لتوفير المال من أجل استخدامه في الإنتاج طبقًا لصيغ الاستثمار الإسلامي.
- ضبط نفقات الإنتاج وترشيدها وتطهيرها من كل نواحي الإسراف، والضّياع، والتّبذير، والتّرف، لأنّ ذلك يقود إلى تخفيض الكلفة، وزيادة العائد بما يمكّن الوحدة الاقتصاديّة من النّمو والتطور.
وإن هناك ضوابط للإنتاج في الاقتصاد الإسلامي يمكن إجمالها في ما يلي([14]):
- أن يكون الإنتاج حلالًا بمعنى إنتاج الطيبات التي تنفع الناس وتعود بالخير والرفاه عليهم، فيُحرم إنتاج الخبائث التي تضر البشر جسديًّا وعقليًّا وروحيًّا.
- ترتيب الإنتاج بحسب الأهمية فتُنتَج الضروريات، ثم الحاجيات، ثم التّحسينات.
- استغلال الموارد الاستغلال الأمثل، وعدم إهدارها لما لذلك من أضرار وتأثير على حجم الإنتاج في السّوق.
- أن يكون هدف الإنتاج تعظيم المنافع ودفع الأضرار.
- التوزيع في الاقتصاد الإسلامي
من الموضوعات المهمة في النّظم الاقتصاديّة هو كيفية توزيع حصص عوامل الإنتاج، بما يُحقق العدالة التي هي من أهداف الاقتصاد الإسلامي المهمّة، وامتاز نظام التوزيع في الاقتصاد الإسلامي عن الأنظمة الأخرى التي جرّبها الإنسان على مر التاريخ في الطريقة التي تُوزَّع، فصارت المعيار الشّاهد على إنسانيّة هذا النّظام الاقتصادي الإسلامي.
فبينما أخذت الرأسماليّة توزع الناتج الاقتصادي على شكل حصص متناسبة مع وسائل الإنتاج (رأس المال، المواد الأولية، العمل)، فإنّ النّظام الاشتراكي اتخذ من الحاجة أساسًا لتوزيع الناتج، أمّا النّظام الاقتصادي الإسلامي فذهب إلى الحلّ الوسط، فهو أخذ وسائل الإنتاج بالحسبان مع شيء من التّهذيب على ما هو موجود في الرّأسماليّة، بالإضافة إلى الأخذ بأهمّية الحاجة في التوزيع، نظرًا إلى أن القاعدة الأساسيّة في التّوزيع لدى الاقتصاد الإسلامي تقوم على ركنين هما العمل والحاجة([15]).
ويُعدُّ العمل في نظر الإسلام سبب لملكيّة العامل لنتيجة عمله، وهذه الملكيّة الخاصة القائمة على أساس العمل تُعبّر عن ميل طبيعي للفرد في تملك نتائج عمله، ويعود إلى شعور كل فرد بسيطرته على عمله، وبذلك تكون الملكية القائمة على أساس العمل حقًّا طبيعيًّا للإنسان العامل في نظر الإسلام، وعلى هذا الأساس يُعدُّ أداة رئيسة في نظام التوزيع الإسلامي([16]).
وتُعد الحاجة أداة رئيسة أخرى في عملية التوزيع، وتشترك مع العمل في تحديد الشكل الأولي العام للتوزيع في المجتمع الإسلامي؛ إذ إنّ النّظام الاقتصادي الإسلامي يُعدُّ مسؤولًا عن تأمين حاجات النّاس جميعًا حتى العاطلين عن العمل والعاجزين عنه، ليُحقق بذلك حياة اجتماعية تُحفظ بها كرامة النّاس جميعًا([17]).
ويتميز الاقتصاد الإسلامي أيضًا عن النّظام الرأسمالي والاشتراكي برؤيته الخاصة لتوزيع الدّخل والثروة، فهو يعالج التّوزيع على نطاق أرحب وأشمل، ويرى أن نقطة الانطلاق أو المرحلة الأولى هي التّوزيع بدلًا من الإنتاج، لأنّ توزيع مصادر الإنتاج يسبق الإنتاج نفسه، وكل عملية إنتاج تُصبح من الدرجة الثانية، فيُوجد توزيع ما قبل الإنتاج وتوزيع ما بعد الإنتاج، ويمكن توضيح هذا أكثر في ما يلي([18]):
- التوزيع ما قبل الإنتاج
المقصود بتوزيع ما قبل الإنتاج هو كيفيّة استفادة المسلمين من الثروات الطبيعية كالأرض، والماء، والمباحات العامة(أسماك، طيور)، وفي هذه المرحلة يضع الإسلام قوانين معينة للمنع من تراكم الموارد والثروات بيد فئة معيّنة وحرمان الفئات الأخرى من الاستفادة منها؛ وذلك من خلال إعطاء كل نوع من أنواع الملكية الثلاثة (خاصة، عامة، دولة) نصيبه من مصادر الثّروة الطبيعيّة.
- التوزيع ما بعد الإنتاج
أي توزيع العوائد التي تجنيها عناصر الإنتاج لقاء مشاركتها في العمليّة الإنتاجيّة، ويتمثل في القيمة أو الثّمن مقابل الخدمات الإنتاجيّة التي قدمتها، وكل عنصر من عناصر الإنتاج يحصل على عائد واحد أو أكثر كل بحسب إسهامه في العملية الإنتاجيّة، وقد اختلف الاقتصاديون في تحديد عناصر الإنتاج، فحددها القدماء منهم بعنصرين هما الأرض والعمل، وبعضهم حددها بثلاثة: الأرض والعمل ورأس المال، والمعاصرون أضافوا عنصرًا جديدًا وهو التّنظيم، أمّا الاقتصاد الإسلامي فقد حددها بثلاثة هي: العمل ورأس المال والأرض.
وتوجد أيضًا إعادة التّوزيع والتي يُعبر عنها اليوم بالتّحويلات الاجتماعيّة كتحويل جزء من دخل الأغنياء إلى الفقراء، وللاقتصاد الإسلامي وسائله الخاصة في هذا المجال، من سياسات ماليّة واجتماعيّة تقوم بها الدولة، إلى تصرفات اختياريّة يُبادر بها الأفراد في المجتمع الإسلامي، وتعد الحاجة هي المعيار للتوزيع في هذه المرحلة([19]).
وما لا شك فيه أن عجز شريحة من المجتمع عن المساهمة في الإنتاج أو الأنشطة الاقتصاديّة، بالإضافة إلى وجود بعض العوامل الطبيعيّة التي تؤدي إلى حدوث فوارق بين أفراد المجتمع كاختلاف المواهب، والمخاطرة والطقس… إلخ، كلها تسبب اختلاف المداخيل والذي يتولد عنه تفاوت طبقي في المجتمع.
لذلك فإنّ الاقتصاد الإسلامي يهدف من إعادة التّوزيع القضاء على الفقر، وإزالة التّفاوت الشّديد في امتلاك الثّروات بين أفراد المجتمع، ويعتمد في سبيل ذلك على الضوابط والتّشريعات الإسلاميّة المختلفة، التي تعتمد آليات إعادة توزيع المداخيل والمكاسب مثل: الميراث والخمس والزّكاة، وتحريم كنز المال، وتحريم الكسب غير المشروع عن طريق الاحتكار والقمار مثلًا وغيرها([20]).
ومن ذلك نلاحظ أن الاقتصاد الإسلامي رسم ثلاث مراحل للتوزيع العادل للثروة والدّخل بهدف القضاء على الفقر وإحلال الرخاء العام في المجتمع، بما يحقق حياة كريمة تُحفظ بها كرامة أفراد المجتمع جميعهم، من خلال التوزيع ما قبل الإنتاج، والتّوزيع ما بعد الإنتاج، وإعادة التوزيع.
المطلب الثالث: المشكلة الاقتصاديّة في الفكر الإسلامي
تختلف نظرة الإسلام إلى المشكلة الاقتصاديّة عن نظرة كل من النّظامين الرّأسمالي والاشتراكي، فهو لا يُعزي سبب المشكلة إلى الطبيعة وقلّة مواردها كما تدعي الرّأسماليّة؛ لأنّه يرى أنّ الطبيعة قادرة على ضمان كل حاجات الإنسان التي يؤدي عدم إشباعها إلى مشكلة حقيقيّة في حياته، كما لا يرى الإسلام أن المشكلة في التّناقض بين شكل الإنتاج وعلاقات التوزيع كما تقرر الماركسيّة، وإنما المشكلة قبل كل شيء هي مشكلة الإنسان نفسه لا الطبيعة ولا أشكال الإنتاج، وما يُظهر ذلك بوضوح قوله تعالى: ﴿اللهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَاْلأَرضَ وأَنزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَأَخرَج َبِهِ مِنَ الثَّمَراتِ رِزقاً لَّكُم وسَخَّرَ لَّكُم الفُلكَ لِتَجرِيَ فيِ البَحرِ بِأَمرِهِ وسَخَّرَ لَكُمُ الأَنْهَارَ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ والقَمَرَ دَآئِبَينِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الَّيلَ وَالنَّهَارَ، وَءَاتاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ﴾([21]).
فالآيات الكريمة تُقرر بوضوح أن الله تعالى قد حشد للإنسان في هذا الكون الفسيح كل ما فيه مصالحه ومنافعه، ووفر له الموارد الكافية لإمداده بحاجاته اللازمة، ولكن الإنسان هو الذي ضيع على نفسه هذه الفرصة التي منحها الله له بظلمه وكفرانه للنعم حيث قال تعالى: ﴿إنَّ الإِسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ﴾([22])، فيُعدُّ ظلم الإنسان وكفرانه للنعمة هما السببان الأساسيان للمشكلة الاقتصاديّة في نظر الإسلام، ويتجسد هذا الظلم على الصعيد الاقتصادي في سوء التوزيع، وكفرانه للنعمة في إهماله لاستثمار الطبيعة وموقفه السّلبي منها([23]).
وبهذا يُعارض الإسلام نظرة النّظام الرأسمالي للمشكلة على أنّها ندرة الموارد الطبيعية، ويُقرر أن الأصل في هذه الموارد الوفرة وليست الندرة؛ لأن الله تعالى خلق كل شيء بميزان العدل وما يدل على ذلك بشكل صريح قوله تعالى: ﴿وَاْلأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيناَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيْهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ﴾ ([24]).
وإن سلّم الإسلام جدلًا بوجود ندرة نسبيّة تُمثل أحد جانبي المشكلة الاقتصاديّة، فإنّه يجعل منها حافزًا للعمل وتعمير الأرض، كما ويجعلها مجالًا للاختبار والابتلاء، وبذلك فإن وجود ندرة نسبيّة لا يتعارض مع أصل الوفرة التي أقرّ بها الإسلام وبكفاية الموارد التي أنزلها الله تعالى([25])، وفي هذا قال تعالى: ﴿وَلَوْ بَسَطَ اللهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَواْ فِي الأَرضِ وَلَكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَآءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبيِرٌ بَصِيرٌ﴾ ([26])، ويقول في آية أخرى: ﴿وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفْ وَالْجُوعِ وَنقْصٍ مِنَّ الأَمْوَالِ وَالأَنفُسِ وَالثَّمَراتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ﴾([27])، فالله تعالى قد يصيب الإنسان بأنواع من البلاء والحرمان في حياته، لغرض اختباره وتمحيصه وصقل إيمانه، أو عقابًا لسوء أفعاله، وفي تحديد إن كان هذا النقص اختبارًا أو عقابًا فالله وحده هو الخبير العليم، ولكن تبقى أفعال الإنسان هي المؤشر الدّال على أحد الغرضين.
وتجدر الإشارة هنا إلى أنّه عندما تُخصَّص كثير من الأموال لزيادة القوى التّدميريّة للأمة؛ أي في سباق التّسلح بين الدّول خشية اندلاع الحروب بينهم ولتعزيز القوة الرّدعيّة، فإنّه لن يبقى إلا مصادر قليلة جدًا لعمليّة الخلق، والإنتاج، والإبداع، والبناء([28]).
وعليه فإنّ الإنسان عندما يلبي حاجاته وفاقًا لفطرته السليمة لن تعجزه موارد الطبيعة في الغالب عن ذلك، وإن عجزت فإنّ الشّريعة الإسلاميّة تكفلت بعلاجها وحلّها، من خلال مجموعة من الضوابط الأخلاقيّة والقيميّة التي تحقق مصلحة الفرد في الدنيا والآخرة، أمّا إذا سعى الفرد لإشباع رغباته وفاقًا لشهواته، فإنّه لن ينتهي عند حد وسيقع في مشكلات اقتصاديّة عدة بدلًا من مشكلة واحدة فقط، وهذا ما نجده في الاقتصاديات الوضعيّة التي تستخدم شتى الوسائل التي تعمل على سد الحاجات والرّغبات، بصرف النَّظر عن النّواحي الروحيّة والعقديّة، وعن الأضرار التي قد تلحق بالآخرين في المجتمع نتيجة استخدام هذه الوسائل التي تتناقض مع الإسلام.
إذ إنّ علماء الاقتصاد الوضعي لم يميزوا بين الحاجات الفطريّة والحاجات المكتسبة، ولا بين المشروعة منها وغير المشروعة؛ إذ الحاجات بنظرهم تتصف بالحياديّة؛ أي لا تتطلب التّوافق بين الدّين والأخلاق، وهذا ما يؤدي بهذه الأنظمة إلى استخدام وسائل قد تكون غير مشروعة، إلّا أنّ نظام الإسلام يختلف عن نظام الاقتصاد الوضعي في أنه يقيد الحاجات ووسائل إشباعها بإطار شرعي كما بيّنا، ويقسّم هذه الحاجات الإنسانيّة إلى ثلاثة مستويات تصاعديّة تبدأ بالضروريات التي تتوقف عليها حياة الإنسان، ثم بالحاجيات وهي التي لا ترتبط بحفظ حياته؛ بل لأجل رفع الحرج عنه والتوسعة عليه، وأخيرًا الكماليات وهي التي تتجاورز حدود الضروريات والحاجيات معًا([29]).
ومن هنا يمكن اختصار أسباب النّدرة النسبيّة إن سلمنا جدلًا بوجودها في وقنا الحاضر بالأسباب الآتية([30]):
- التفاوت في توزيع الموارد على مستوى الدّول والأقاليم، سواء أكان ذلك على شكل أراضٍ صالحة للزراعة، أم معادن أم مناخ جيد أم تقدم علمي وتكنولوجي؛ ما ساعد على وجود دولٍ غنيّة وأخرى فقيرة.
- عدم الاستفادة المثلى من الموارد من الإنسان، نتيجة لتقصيره في العمل، وتقاعسه عن الاستفادة من الموارد المتاحة.ِ
- السّلوك الترفي في إشباع الحاجات والرّغبات الماديّة، فتستهلك بعض الوحدات الاقتصاديّة بناءً على قدراتها الشرائيّة من دون النّظر إلى حاجاتها الفعليّة؛ ما يترتب عليه إهمال حاجات الآخرين.
- كفران النّعمة والأزمة الرّوحيّة التي تعاني منها المجتمعات المختلفة، نتيجة لابتعاد الناس من الارتباط الفعلي بالله؛ ما يجعلها عرضة للابتلاء بنقص الموارد أو باستخدام الموارد على نحو يؤدي إلى حرمان الآخرين منها، والابتعاد بذلك من مبادئ الإسلام وقِيَمه العالية.
- عدم تحمل بعض الدّول المسؤوليّة في توفير الحاجات الأساسية لمجتمعها، وتحقيق حد الكفاية* لأفراده، بيد أن الإسلام يُعدُّ أن تحقيق حد الكفاية من أهم واجبات الدولة([31]).
الخاتمة
تظهر المشكلة الاقتصاديّة في نظر الإسلام في تمثلها أولًا وأساسًا بالبعد من الالتزام بالضوابط الأخلاقيّة والتّشريعات الإسلاميّة، سواء أكان ذلك على صعيد الإنتاج، أو التوزيع، أو الاستهلاك؛ إذ إن الإسلام يحوي في داخله منهجًا متكاملًا لحياةٍ كريمة بجانبيها المادي والروحي.
ويحرر الإسلام الإنسان بطريقتين: الأولى: عن طريق العقيدة التي تملأ القلب إيمانًا بأن العمر والرزق بيد الله وحده، فلا يُذل لغيره تعالى ولا يتوجه في الطلب والشّكوى إلّا إليه، فالجميع وسائط ووسائل والكون كلّه يسير بأمره، ويُسخّر بإذنه جلّ وعلا من وما يشاء إلى من شاء. الثانية: عن طريق الشّريعة والضوابط الأخلاقيّة التي تكفل حرمة الدماء والأموال وتكفل للجميع حدّ الكفاية بالزكاة، والخمس، والآليات الشّرعيّة الأخرى، وفي هذا ضمان لحفظ حرية الإنسان وكرامته وإنسانيته، ومع المتابعة والرقابة التي توضع على الإنسان داخليًّا بصوت الضمير الذي يعمل على أساس التقوى والإيمان، وخارجيًّا بسطوة وحكم ولي أمر المسلمين بفرضه تنفيذ الفرائض، والواجبات، والحقوق، وبتنفيذه للحدود والتعاذير.
الهوامش
* طالبة دكتوراه في الجامعة الإسلاميّة؛ بيروت – لبنان – قسم الدراسات الإسلاميّة
PhD Student at the Islamic University;Beirut- Lebanon-department of Islamic Studies
Email: neamatolahmrouweh@gmail.com
[1]– سورة الملك، الآية2.
[2]– محمد باقر الصدر، اقتصادنا، ط2(بيروت: دار التعارف، 1424هـ، ص394).
[3]– محمد باقر الصدر، اقتصادنا، المرجع نفسه، ص323.
[4]– سعد بن حمدان اللحياني، مبادئ الاقتصاد الإسلامي، لا ط (لا م: لا د، 1428ه، ص19).
[5]– سورة النساء، الآية 59.
[6]– محمد باقر الصدر، اقتصادنا، المرجع السابق، ص323.
[7]– سعيد سعد مرطان، مدخل لدراسة الفكر الاقتصادي في الإسلام، ط2 (لبنان: مؤسسة الرسالة للنشر، 2004م، ص78).
[8]– محمد باقر الصدر، اقتصادنا، المرجع السابق، ص726.
[9]– ميرزا حسين النوري، مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل، ط1 (قم: مؤسسة آل البيت، 1407ه، ص23-24).
[10]– محمد باقر الصدر، اقتصادنا، المرجع السابق، ص726.
[11]– سورة الأعراف، آية 32.
[12]– إبراهيم البطاينة وآخرون، النظرية الاقتصادية في الإسلام، ط1 (عمان: دار المسيرة، 2011م، ص31).
[13]– إبراهيم خريس، الاقتصاد الإسلامي الواقع ورهانات المستقبل، لا ط (الجزائر: لا د، 2012م، ص6).
[14]– إبراهيم خريس، الاقتصاد الإسلامي الواقع ورهانات المستقبل، المرجع نفسه، ص32.
[15]– سعيد فراهاني، السياسات الاقتصادية في الإسلام، ط1 ( ط1 (لبنان: دار الولاء، 2014م، ص132).
[16]– محمد باقر الصدر، اقتصادنا، المرجع السابق، ص358.
[17]– سعيد فراهاني، السياسات الاقتصادية في الإسلام، المرجع السابق، ص153.
[18]– رفعت السيد العوضي، الاقتصاد الإسلامي: المرتكزات التوزيع الاستثمار، ط1 (قطر: مركز البحوث، 1990م، ص15).
[19]– رفيق المصري، أصول الاقتصاد الإسلامي، ط2 (دمشق، دار القلم، 1993م، ص226).
[20]– عبد الله علوان، التكافل الاجتماعي في الإسلام، ط6 (القاهرة: دار السلام، 2001م، ص44).
[21]– سورة إبراهيم، آية 32-34
[22]– سورة إبراهيم، آية.34
[23]– محمد باقر الصدر، اقتصادنا، المرجع السابق، ص380.
[24]– سورة الحجر، الآية 19.
[25]– سعيد مرطان، المرجع السابق، ص65.
[26]– سورة الشورى، الآية 27.
[27]– سورة البقرة، الآية 155.
[28]– شمعون بيريس، الشرق الأوسط الجديد، ترجمة محمد حلمي عبد الحافظ، ط1 (الأردن: لا د، 1994م، ص99).
[29]– إبراهيم البطاينة، النظرية الاقتصادية في الإسلام، المرجع السابق، ص68.
[30]– زينة سويهي، الأزمة الاقتصادية في الفكر الاقتصادي، لا ط (لا م: لا د، 2017م، ص116).
* حد الكفاية: أي توفير الحد الأدنى اللائق لمعيشة الفرد، وإن حد الكفاية قابل للزيادة ومختلف باختلاف مستوى التقدم في كل زمان ومكان.
[31]– زينب السويهي، الأزمة الاقتصادية في الفكر الإسلامي، المرجع السابق، ص116.
المصادر والمراجع
- القرآن الكريم.
- إبراهيم البطاينة وآخرون، النظرية الاقتصادية في الإسلام، ط1 (عمان: دار المسيرة، 2011م، ص31).
- إبراهيم خريس، الاقتصاد الإسلامي الواقع ورهانات المستقبل، لا ط (الجزائر: لا د، 2012م، ص6).
- رفعت السيد العوضي، الاقتصاد الإسلامي: المرتكزات التوزيع الاستثمار، ط1 (قطر: مركز البحوث، 1990م، ص15).
- رفيق المصري، أصول الاقتصاد الإسلامي، ط2 (دمشق، دار القلم، 1993م، ص226).
- زينة سويهي، الأزمة الاقتصادية في الفكر الاقتصادي، لا ط (لا م: لا د، 2017م، ص116).
- سعد بن حمدان اللحياني، مبادئ الاقتصاد الإسلامي، لا ط (لا م: لا د، 1428ه، ص19).
- سعيد سعد مرطان، مدخل لدراسة الفكر الاقتصادي في الإسلام، ط2 (لبنان: مؤسسة الرسالة للنشر، 2004م، ص78).
- سعيد فراهاني، السياسات الاقتصادية في الإسلام، ط1 ( ط1 (لبنان: دار الولاء، 2014م، ص132).
- شمعون بيريس، الشرق الأوسط الجديد، ترجمة محمد حلمي عبد الحافظ، ط1 (الأردن: لا د، 1994م، ص99).
- عبد الله علوان، التكافل الاجتماعي في الإسلام، ط6 (القاهرة: دار السلام، 2001م، ص44).
- محمد باقر الصدر، اقتصادنا، ط2(بيروت: دار التعارف، 1424ه، ص394).
- ميرزا حسين النوري، مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل، ط1 (قم: مؤسسة آل البيت، 1407ه، ص23-24).