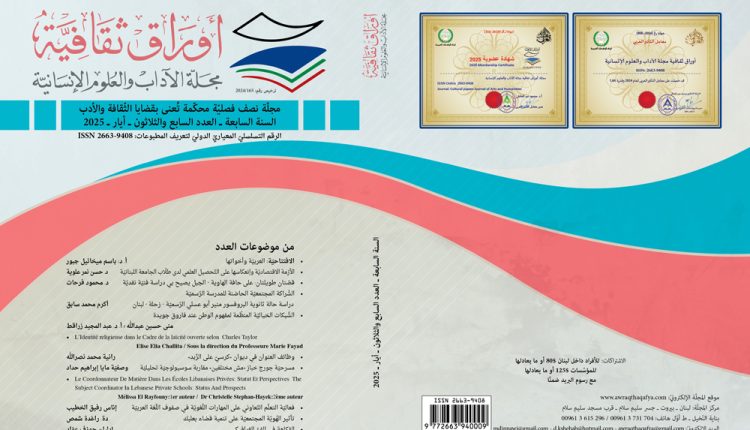عنوان البحث: الشّبكات الخياليّة المنظّمة لمفهوم الوطن عند فاروق جويدة أنموذج: ديوان "كانت لنا أوطان"
اسم الكاتب: منى حسين عبدالله، أ. د. عبد المجيد زراقط
تاريخ النشر: 2025/05/13
اسم المجلة: مجلة أوراق ثقافية
عدد المجلة: 37
تحميل البحث بصيغة PDFADOI: https://aif-doi.org/awraq/013713
الشّبكات الخياليّة المنظّمة لمفهوم الوطن عند فاروق جويدة
أنموذج: ديوان “كانت لنا أوطان”
“The Imaginary Networks Organizing the Concept of Homeland in thePoetry of Farouk Goweda A Case Study of the Diwan ‘Kānat Lanā Awtān’ (“We Once Had Homelands”)
بحث مستل من رسالة أعدّت لنيل شهادة الماستر في اللغة العربية وآدابها
Mona Hussein Abdalla منى حسين عبدالله([1])
Dr. Abd Al Majid Zarakt أ. د. عبد المجيد زراقط([2])
تاريخ الإرسال:23-4-2025 تاريخ القبول: 5-5-2025
الملخص turnitin:13%
حبُّ الأوطان يجري في عروق كل شخصٍ منا، لأنّه ملجأ القلوب، والملاذ الآمن الذي يضمُّ أبناءه، ويصون كرامتهم وعزّتهم. ولكن هل الوطن العربي يتّصف بهذه الصّفات؟. اخترت ديوان ” كانت لنا أوطان” لدراسة رؤية الشاعر إلى ” الوطن” كما تتمثّل في قصائده.
عنوان الدّيوان يدل على الفقد والحرمان أي يدل على رؤية سوداوية للوطن العربي . في هذا البحث سأدرس مفهوم الوطن الواقع والوطن الحلم عند فاروق جويدة عبر دراسة الشّبكات الخياليّة المنظّمة لمفهوم الوطن . إن كان حلم جويدة بناء وطن على قدر طموحاته وآماله، فقد يُعد هذا الحلم أداة للخيال الشعريّ وتكوين الصورة، وأحيانًا يأتي مع الخيال المادي وعناصره الماء والهواء والتراب والنار. من خلال دراسة كيفيّة استخدام هذه المواد في شعر جويدة، وتبيان دلالاتها وعلاقتها بالوطن، ودراسة علاقة الخيال المادي مع الخيال العلائقي سأصل إلى رؤية الشّاعر لمفهوم الوطن.
الكلمات المفاتيح :الخيال المادي- الخيال العلائقي – المادة – الماء – الهواء – النار – التراب
summary
The love of homelands flows in the veins of every one of us, for they are the refuge of hearts and the safe haven that embraces their children, preserving their dignity and pride. Yet the question that arises is: Does the Arab homeland embody these qualities? This question led me to select the poetry collection *Kāna Lanā Awṭān* (“We Once Had Homelands”) as the subject of this study, to explore the poet’s vision of the “homeland” as reflected in his poems. This vision unfolds through two perspectives: the first is the *homeland as reality*, and the second is the *homeland as dream*. This duality is what this study seeks to unravel in the poetry of Farouk Juwaida.
The title of the diwan itself signifies loss and deprivation, reflecting a bleak vision of the Arab homeland. In this research, we will conduct an objective analysis of the concepts of the “homeland-reality” and the “homeland-dream” in Farouk Juwaida’s work by examining the structured imaginative networks that frame his notion of homeland. If Juwaida’s dream is to construct a homeland aligned with his aspirations and hopes, this dream may serve as a tool for poetic imagination and the crafting of imagery, occasionally intersecting with *material imagination* and its elements—water, air, soil, and fire. By studying how these elements are employed in Juwaida’s poetry, elucidating their symbolic meanings and their connection to the homeland, and exploring the relationship between *material imagination* and *relational imagination*, we will uncover the poet’s vision of the concept of homeland.
Keywords: Earth Material Imagination- Relational Imagination- Matter- Water- Air- Fire.
المقدّمة
أسباب دراسة الموضوع: لعلّ السبب الأساسي في اختياري هذا الموضوع هو معرفة رؤية شاعرٍ كبيرٍ إلى الوطن كما هو واقعه وكما يحلم في أن يكون عليه هذا الواقع، ما يفضي إلى تسليط الضّوء على أعمال شاعرٍ وصحفيٍّ مصريّ مهمٍ جدًا في عصرنا، وهو” فاروق جويدة”. فهو من أبرز الشعراء في مسيرة الشعر العربي المعاصر، قدّم للمكتبة العربية حتى الآن أربعين كتابًا من بينها ست عشرة مجموعة شعريّة، وقدم للمسرح الشّعري ثلاث مسرحيات ترجمت قصائده ومسرحياته إلى عدة لغات عالمية. هذا البحث جديدٌ، ولم يُدرَس سابقًا، ولي الشّرف أن أدرس أعمال هذا الشّاعر الجديرة بالدراسة، لأنها تنقل لنا هموم المواطن العربي وهواجسه وطموحاته وأحلامه والواقع الذي نعيشه، وتستشف المستقبل ومصير العرب، إضافة إلى أنه توجد في أشعاره صرخة عنيفة تدعو للثّورة على الظلم والتغيير.
الإشكالية: تتمثل إشكالية هذا الموضوع في قضيّة مركزيّة هي رؤية الشّاعر فاروق جويدة إلى الوطن عبر دراسة الشّبكات الخياليّة المنظّمة لمفهوم الوطن.
الفرضيات: الكاتب يتحدّث عن العالم العربي، وأعتقد أن معظم المواطنين غير راضين عن الأوضاع السّياسيّة أو الأمنيّة أو الاجتماعيّة التي يعيشها، بوجود هذه الطّبقة السّياسيّة التي تتولّى إدارة شؤون هذه البلاد، لأنها تتصرّف بحسب مصالحها الضّيقة، وتفتِّش عن طرق الحفاظ على كرسي االحكم ولو على حساب بيع أوطانها للأجنبي. بحسب اطّلاعي على ديوان الشّاعر والدواوين الأخرى قد أجد أنّ الشّاعر حمل همومَ وطنه العربي، فكان يحارب بقلمه، ويحاول الإصلاح والتّغيير فهو حمل هموم كثير من البلاد العربيّة منها مصر وفلسطين والكويت والعراق…
المنهج: يتبع هذا البحث المنهج الموضوعاتي الذي يُعدّ الأدب ذا جوهرٍ روحيٍّ. تأثّر هذا المنهج بالظّواهريّة والوجوديّة والأبحاث النفسيّة. وهو يسعى إلى اكتشاف التوازن في العمل الأدبي، من روّاده غاستون باشلار(Gaston Bachelard)،([3]) وجان بيير ريشارد ([4])(Jean Pierre Richard) وجورج بوليه (Poulet Georges).([5])
من مرتكزاته اكتشاف الملامح المتشابهة التي تساعد على تثبيت عناصر التشكّل، ثم كشف المتناقضات على مختلف المستويات النصيّة وأيضًا هو بحث عن المعنى في كل الاتجاهات.
الأسس الكبرى للموضوعاتيّة هي :
الموضوع، المعنى ،الحسيّة، الخيال، العلاقة، التّجانس، الدّال و المدلول، شكل المضمون و البنية والعمق، المشروع والمحالة والخيال.
مسار البحث: البحث جاء تحت عنوان: “الشّبكات الخياليّة المنظمة لمفهوم الوطن”. يتناول الشبكات الدّالة على الوطن، فتحدثنا فيها عن العناصر الماديّة، من نار وتراب وماء وهواء وعلاقتها بالخيال الدينامي، كما تحدثنا عن الثنائيات الضدية “النور والظلام” و”الماء والنار” والماء والتراب والاستسلام والمواجهة، وعلاقة هذه الثنائيات بوطن الحلم والواقع عند الشاعر.
الشّبكات الخياليّة المنظمة لمفهوم الوطن
التمهيد: المادة في الأدب مصدرُ إيحاءٍ وجمالٍ، بناءً على هذا، تستحضر الحقيقة الخياليّة، من ثَمَّ توصف، وثم تُعَدُّ القوالب لتشكّل منها رؤى([6]). استنادا إلى باشلار، يُميّز ريشار الخيال المادي من الحسي والحركي. لفهم موضوع ما، يقتضي نشر قِيَمِه الدلاليّة المختلفة، من خلال الخيال العلائقي الذي يربط بين الثّلاث. وعلى ما يرى ريكور، علينا فهم أي موضوع من خلال آخر وآخر، وذلك استنادًا إلى قانون التشابه القصدي([7]). لقد اعتمد روّاد المنهج الموضوعاتي على أربعة عناصر ماديّة هي: (النار، الماء، التراب، والهواء). فسأدرس في هذا الفصل الخيال الماديّ وعلاقته بالخيال الديناميّ عند الشّاعر من خلال دراسة كيفيّة استخدام هذه المواد في قصائد الشّاعر، والوقوف على دلالاتها من خلال الصور والسّياق، لنظهر علاقتها بمفهوم الوطن عند فاروق جويدة. إضافة إلى تركيز أبرز الخصائص الشعريّة التي تبيّنا بعضها آنفًا.
أولًا : العناصر الماديّة ودلالاتها
- الماء: الماء سائلٌ عليه عماد الحياة في الأرض. ويُعَدّ الماء المكوّن الأساسيّ في حياة الإنسان واستقراره، وسببًا لِدَيمومة الحياة واستمرارها. ومن المعلوم أن موضوع الماء يُشكِّل باستمرار دلالة شعريّة وظّفها الشعراء العرب قديمًا وحديثًا، ولقد استعمل رمز الماء برؤى وتصوّرات عديدة تختلف باختلاف الثقافات والدّيانات والعقائد. فهو “مصدر الحياة والخصب والطّهارة والتجدّد الجسديّ والروحيّ والحكمة والمعرفة والخلود والسلام والبعث”([8]).
ونجد ألفاظ الماء وأماكنه ومصادره تتردد في معظم أشعار العرب كالبحر ، النهر ، المطر ، السيل، الموج …..السحاب. “كل سائل قياسًا إلى الخيال المادي يُعَد ماءً” ([9]).
لعلّ القارئ لشعر فاروق جويدة يكاد يسمع صوت الماء ينساب بين سطوره وأبياته، وهو يتموّج به خلال منعطفات حياته وحياة الشعوب العربيّة، فيكون هادئًا تارة، وثائرًا غاضبًا تارات أخرى. وقد استخدم الشّاعر ألفاظًا عديدةً للماء منها: نهر، دموع، دم، ماء، فيضان، بحر، بئر، موج، مطر، البراكين، بكاء، النيل، نزيف.
يقول الشّاعر، في قصيدة “أبحث عن شيءٍ يؤنسني”، متحدّيًا الظّلم والاستبداد والقمع الذي تمارسه السّلطات على الشّعب: “إن خنقوا صوتي/ سوف أغني فوق الريح/ وتحت الماء… ولو قطّعوا كل الأوتار”([10]). هذه العبارات تدلّ على إصرار الشّاعر على الحفاظ على حريته وعلى حرية قلمه الذي يُعَدّ ” صوت الحق” بوجه الباطل، وعلى مقاومة السّلطة وتحدّيه لها. فإن حاولوا أن يقمعوا صوته سوف يتحدّاهم، ويغنّي فوق الرّيح وتحت الماء، والريح رمز الاضطراب والعواصف والزّوابع والعنف الأعمى([11]). فهو سيكون أقوى من عواصف السّياسيّة العنيفة. والماء عنصرٌ مقاومٌ للصوت لأن الإنسان لا يستطيع أن يتكلّم تحت الماء. فهنا يظهر إصرار الشّاعر على تحدّي كل الظّروف القامعة لقول الحق، وسيبقى صوته عاليًا على الرّغم من كل الصعاب.
رسم الشّاعر هذه الصورة في مكانين “فوق الريح وتحت الماء” نجد في هذه الصورة حركتَي الصّعود والهبوط مايدلّ على استخدام الخيال الدينامي مع الخيال الماديّ في تكوينها. كما نجد جدليّة الصّوت/ الصّمت والعجز/ المقاومة من خلال العبارات “خنقوا صوتي، قطّعوا كل الأوتار/ سوف أغني”. ما يدل على إصرار الكاتب على إعلاء كلمة الحق، على الرّغم من عجزه عن ذلك أحيانًا.
في قصيدة “من أغاني مانديلا”، يتحدّث الشّاعر عن تخاذُلِ الناس واستسلامهم لقهر السّلطات، يقول:
فالنّاس باعَت أجمل الأيام/ في سوق الجواري/ لم يعد في العمر شيء تشتريه/ باعوا الليالي البكر/ والحلم البريء… ونشوة الذّكرى/ وباعوا نخوة الزّمن النزّيه/ قد شيّدوا للقهر أوكارا/ فصار النهر مقبرة…/ وضاق الماء بالعفن الكريه/ خنقوا خيوط الفجر في رحم الليالي/ ثم راحوا يرجمون الضوء فيه/ قل لي بربك يا فؤادي:/ أي حُلم بعد هذا… ترتجيه؟!([12])
النّهر الجاري المتحرّك الدّال على الحياة والتجدّد يتحوّل إلى مقبرةٍ. في هذه العبارة تتغيّر دلالاته من رمز للحياة والتّجدّد إلى رمزٍ للموت والفناء واغتيال الحياة. فالماء الجاري الصّافي يحمل قيمة الطّهارة، فعندما يتحوّل النّهرإلى مقبرةٍ، ويضيق الماء بالعفن الكريه، تنتفي صفة الطّهارة عن الماء فيتحوّل إلى ماءٍ دنسٍ. و”الماء الدنس في اللاشعور وعاءٌ للشر، إنه ماهيّة الشر”([13]).
فهنا يظهر الكاتب تحوّل الأوضاع في أوطانه فلم يعد هناك شيء يشتهيه. فالنّاس تغيّرَوا، واستسلمَت للقهر، وباعوا الأيّام الجميلة والحلم البريء، حتى النخوة فُقِدت في هذا الزّمن، وانقلَب الجمال إلى قبحٍ، والطهرُ إلى دنسٍ، وسيطر الموت على الحياة. لذلك يكرر الكاتب سؤاله لفؤاده: “قل لي بربك يا فؤادي/ أي حلم بعد هذا… ترتجيه؟؟؟”.
يقول الكاتب في القصيدة نفسها: صارت نياشين الزعامة/ في عيون الناس/ جلّادًا… ونهرًا من دم.
تكررت كلمة “نهر”، ولكن ليس نهرًا من الماء، بل من الدم. كناية عن العدد الكبير من القتلى الذين تهرق دماؤهم كل يوم في بلادنا العربيّة. فأصبح القتل والظّلم من سِمات الزّعيم العربي.
يقول الكاتب في “مرثية ما قبل الغروب”:
قالوا لنا : أرضُنا أرضٌ مباركةٌ فيها الهدى والتُّقى والوحي والرسل
مالي أراها وبحر الدّم يغرقها وطالع الحظّ في أرجائها زُحل
لم يبرح الدم في يوم مشانقها حتى المشانق قد ضاقت بمن قُتلوا
يا لعنة الدم مَن يومًا يُطهّرها فالغدر في أهلها دينٌ له مللُ([14])
وردت كلمة “دم” في ثلاثة مواضع “بحر الدم” ، لم يبرح الدم في يوم مشانقها “يا لعنة الدم”.
كما معروف، كلمة بحر تدل على “حركة المدّ والجزر، وهذه العمليّة الأبديّة حركةٌ قائمةٌ على الهبوط والصّعود، على الارتفاع والانخفاض، على الهجوم والانسحاب، أي حركةٌ قائمةٌ على التغيير المستمر”([15]). فنَسْبُ الدّم إلى البحر يدل على حركة المقاومة التي يقوم بها الشّعب ضد العدو الإسرائيلي، أو ضد أي سلطة مستبدة. فهي تتذبذب بين المواجهة والانسحاب، بين النّجاح والفشل، بين الهبوط و الصّعود. كلمة دم تدلّ على الضّحايا التي تَسقُط في هذه الأرض، وتُهرَق دماؤها. ولكن باءت حركة المواجهة بالإخفاق، الدليل على ذلك قوله: ” طالع الحظ في أرجائها زُحَل”. وزحل هو كوكب التّأخيرات والعقبات والفقر والمآسي والكآبة والمشاكل، فهو مرتبطٌ عند العرب بالشّؤم والنّحس وضيق الطّالع([16] ). فالدّم لم يترك المشانق، وهذا دليل على استمرارية القتل، ويؤكّد قوله: إنّ القتل من صفات الزّعيم العربي، ولكن دماء الشّهداء ستكون لعنةً على الزّعماء، وهذه اللّعنة سَتَلحَقهم إلى أن يزول حكمهم. نجد في هذه الأبيات تضادًا ومقابلةً بين الماضي والحاضر، فأرض العرب كانت مباركةً وطاهرةً نزل فيها الأنبياء والوحي، أمّا الآن فانقلبت إلى أرض نجسٍ يُسيطر عليها القتل والإرهاب والكفر ف”الدم أغرقها”، هنا الأرض يمتزج فيها عنصران ماديّان هما التراب والماء. فالتراب طاهرٌ والماء المتمثّل بالدم نجسٌ. عندما يغرق الدم الأرض فهذا يعني سيطرة عنصر الماء المتمثّل في الدم على عنصر التّراب أي سيطرة صفة النّجس على الطّهر، أي سيطرة الشّر على الخير، ما يُمثِل واقع الدول العربية البائس، لذا يتساءل الكاتب من يومًا يطهرها؟؟؟
أمّا في قصيدة “من أغاني مانديلا” فيواجه الشّاعر الجلّاد قائلًا:
إلى متى ستظل خلف سجون قهرك تحتمي؟/ أخرج لتلقى يا عدو الله/ حتفك في المصير المؤلم/ وانظر لقبرك إنه الطوفان/ يلعن كل عهدٍ مُظلم([17]).
الطوفان عنصرٌ مائيٌّ، من صفاته أنّه قويٌّ، جارفٌ ومهلك كل شيء أمامه. في قصة نوح، عندما امتلأت الأرض ظلمًا من البشر، جاء الطوفان ليقضي على الناس الأشرار، وأنجى نوح وامرأته ومن معه من المؤمنين استجابةً لدعوته بعد أن أخبره الله بأن شعبه الذي ظلَ أكثر من تسعمائة عام يدعوهم إلى الإيمان، لن يؤمنوا أو يتّبعوه، ﴿وَقَالَ نُوحٌ رَّبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا﴾، ﴿ إِنَّكَ إِن تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا ﴾ ([18]). استطاع نوحٌ وأسرتُه بالإيمان أن يعبروا في الطوفان في سفينة أمرَهُ الله أن يبنيها. فخرجت الحياة من داخل الموت. وهذه هي فلسفة المعموديّة، أو معنى المعموديّة والدّفن والقيامة الجديدة عند المسيحيين، وهو رمز التّجدد. فهنا يحذر الشّاعر كل عهدٍ ظالمٍ، وكل حاكم ظالم، أن نهايته عذابٌ من الله وقتلٌ وفناءٌ. ولم ينجُ من غضب الله غير المؤمنين فهنا يرمز الطّوفان للخير والشّر وللموت والحياة معًا، موت الظالمين ونجاة المؤمنين منهم، يجرف كل شيء، وفي الوقت نفسه يُطهّر الأرض من القوم الظالمين.
أمّا الدّمع فذُكر في أكثر من موضع في قصائده، وجميعها ترمز إلى الحزن. ففي قصيدة “ليالي الخريف” يقول الشاعر:
لم يبقَ للروض الحزين سوى الأسى لحنٌ قديمٌ دمعةٌ وسؤال([19])
نلاحظ أنّ مادة المّاء جاءت في أكثر المواضع في ديوان الشاعر رامزةً إلى الشّر والحزن . وفي قصيدة “أبحث عن شيء يؤنسني” يقول الشاعر:
“أكره أن أغدو أمواجًا يشطرها الصخر/ ما أجمل أن تبقى مطرًا/ وسحابا يسري فوق البحر”([20]).
مادة الماء موجودة في “الأمواج، المطر، والسحاب”. الموج حركته المدّ والجزر عند التطامه بالصّخر العنصر التّرابيّ القوي والصّلب يتراجع إلى الوراء، فهذه العبارة تعبّر عن ضعف الموج أمام الصّخر وانكساره. فالشاعر يكره أن يكون ضعيفًا ينكسر أمام القوة السّياسيّة المستبدّة، بل يتمنى أن يبقى مطرًا وسحابًا يسري فوق البحر. فهنا المطر والسحاب أتيا بمعنى إيجابيٍ، المطر باعث الحياة ومعطاءٌ والسّحاب مأوى المطر. فالكاتب يرغب في أن يكون عنصرًا نافعًا للبشر جميعهم باعثًا الحياة في نفوس الضعفاء.
يمكن أن نكتشف، من خلال هذه الصُّوَر، عالم روح الشّاعر، ألا هو الفضاء . يرتقي بروحه إلى السّماء إلى السّحاب ولا يهبِط إلى الأرض إلّا إذا كان له دورٌ نافعٌ للأرض بعناصرها جميعها(إنسان، حيوان ونبات). نجد حركَتا الصّعود والهبوط في هذه الصورة، ما يدل على ارتباط الخيال الماديّ عند الشاعر بالخيال الدينامي، يظهر ذلك عبر الخيال العلائقي.
يرمز عنصر الماء في شعر جويدة، الى الشر عندما يتكلّم عن واقع الدول العربية، أما عندما يتحدّث عن أحلامه يرمز عنصر الماء إلى الخير .
- النار: تُشكّلُ النار عنصرًا بإمكاننا تقديم تفسيراتٍ مختلفةٍ له، بحسب تعدُّد حقول ومجالات الاستعمال الإنسانيّ. النار يمكن أن تحمل تعدّدا قيميًا يُعطيها القدرة على إظهار القِيَم ونقيضها في الوقت نفسه، فهي حميميّة وكونيّة تضيء وتحرق، ومن بين كل الظواهر يمكنها الحصول بشكل واضح على القيمتين المتعارضتين: الخير والشر، الحياة والموت، الحب والكراهية.
يقول فاروق جويدة في قصيدة “عودوا إلى مصر”:
في رحلة العمر بعض النّار يُحرقنا وبعضها في ظلام العمر يهدينا ([21])
فهنا نجد قيمتين متناقضَتَين للنار، (تحرق، تهدي) فهي تمثل الخير والشر. “النار التي تحرق” منها نار الحرب، ونار الشّوق للوطن، أو النّار التي تعتري الإنسان ساعةَ الغضب والألم. أمّا النار التي تَهدي فهي النار التي تضيء لنا الطريق، أو النار التي توقَد في ليلة ظلماء باردة لضيف تقاذفته البيد والجوع والخوف. فالنار هنا تحمل علامات الهداية وعبارات الترحيب.
في قصيدة “أبحث عن شيء يؤنسني”، يصف لنا الشاعر غُربته الروحيّة وضياعه النّفسيّ، فأخذ يفتّش عن نفسه، يصف حاله معها قائلًا:
“نتلاشى في الأرض حيارى/ فأراها موتي أحيانًا /وأراها في يوم عرسي/ ننشطر بعرض الكون/ فنُصبح ذرات كشعاع الشمس/ نفترق ونمضي أغرابًا ببلاد الله/ وتحملنا دوّامة بؤسٍ/ نشتاق ليومٍ يجمعنا… لأعود لنفسي.”([22])
هنا نجد المفارقة في التضاد: ” أراها موتي أحيانًا وأراها في يوم عرسي ” هذا التّضاد وظيفته تصوير حالته المتقلّبة بين الفرح والحزن، بين الحياة والموت، بين الأمل واليأس. والإنسان مزيج من المواد الأربعة: الماء والنار والتراب والهواء. وهو “كذلك ذرّات صغيرة في جسد الكون، موصولة حركته بالحركة الكونية، إذا هو ذو وظيفة كونيّة. فالخيال تحقيق لسيكولوجيّة كاملة، وأنموذج لحركيّة روحية تتّجه إلى الأعلى، وعملية الارتقاء هذه هي إرادة الحلم وغايته”([23]). يقول الشّاعر: “ننشطر بعرض الكون فنصبح ذرات كشعاع الشمس”، هذا القول دليل على شعوره بالشرذمة والتشتت، لأن الشعاع ينتشر في الفراغ لِخفّته، ويتشتّت، وهذا دليل على ابتعاد نفسه الحالمة وتَوقها للاتجاه للأعلى في عملية ارتقاء روحيّة. فالواقع الذي يعيشه بائسٌ، ما يشكّل معوّقًا أمام تحقيق أحلامه وطموحاته، لذا تجد نفسه الحالمة غريبة، تنعتق عن جسده، وتنطلق في الفضاء باحثةً عن أرضيّة لتحقيق أحلامها، وكأن الجّسد بثقله يمثّل سجنًا للروح التي تتّصف بالخفّة، ولكن يبقى لديه أملٌ في أن يلتقي بها، ويحققا معًا ما يبتغيه في يومٍ من الأيام، ليتصالح معها.
يقول الشّاعر في رحلة البحث عن نفسه: ” ألمحها ضوءًا يتهادى في طلعة بدر/ تصرخ في ألمٍ كالعصفور بلدغة قهر/ فأرى الأيام على صدري كتلال الجمر”([24]). شعاع الشّمس ينعكس على القمر فينتج الضّوء الذي يضيء الأرض. فهذا الضّوء يرمز عند الشّاعر إلى الخلاص والانعتاق وإلى الحلم والأمل . ولكن نفسه تصرخ كالعصفور بلدغة قهر ولعلّها لدغة قهر العصبة الحاكمة التي تحوّل الأيام بنظر الشّعب إلى جمرٍ حارقٍ يحرق قلوبهم . فتشبيه الشّاعر الأيام بتلال الجمر، دليل على قساوة تحمّل ألم هذه الأيام الحارقة بنيران الظّلم.
هذه الصّورة تُعبّر عن الارتفاع الحلمي الذي هو واقعٌ نفسيٌّ عميقٌ. تتوق نفس الشاعر إلى الارتفاع والارتقاء إلى الفضاء، فيجد نفسه تتراءى في طلعة بدر. يظهر في هذه الصورة الخيال الدينامي فالشّاعر يتوجّه صعودا إلى السّماء لكي يتّحد معها، ويهرب من ثقل الهموم التي يحملها على الأرض. فهنا يتحوّل الشاعر من عنصر ثقيلٍ إلى عنصر خفيفٍ في الفضاء.
- ثنائيات تُشكّلها المادة: إن ظاهرة الثّنائيات واحدةٌ مِن الظّواهر الفنيّة المهمّة التي يمكن معاينتها ورصدها في التّجربة الشّعريّة للشّاعر جويدة، حيث اتّخذَتْ عبر شعره موضوعاتٍ متعدّدةٍ، عبّر بها عن مضامينه الشعريّة التي يمكن من خلالها، وعبر اتّساقاتها المتضادة، خلق جو من الحركة والتّوتّر في قصائده الشّعريّة، من هذه الثنائيات ما يأتي:
1-3-1 ثنائيّة النور والظلام: ترمز مفردات (النور، النهار، الشمس، النجم) عند الشّاعر إلى الخلاص والانعتاق، إنّها ضد اللّيل والظّلمة المستعملَين غالبًا للإشارة إلى كل ما له علاقة بالنّظام القمعي أو الوضعية غير المرغوب فيها.
تتردّد، لدى الشّاعر ثنائيات النّور والظّلام، النهار والليل وتترجّح بين الأمل واليأس. يقول الشاعر مخاطِبًا موطنه في قصيدة “من أغاني مانديلا”:
يا موطني .. مهما تغرّبنا/ وضاعت في الدروب هويتي/ ميعادنا آتٍ فضوء الصبح…/ يرفع كل يوم جبهتي/ قد كنتُ أدمنت الظلام/ وداست الأقدام عمرًا قامتي/ يا أيها الجلاد قد دارت الأيام/ لا تنظر لرأسي… إن رأسك غايتي([25]).
يفضّل الشاعر بعد سنين من الانسحاق تحت ثقل آلة القمع، الهروب والاغتراب بحثًا عن معنىً ضائعٍ للحياة، بحثًا عن هوية لم يجدها. لذا رأى أنّه لا بد من مواجهة هذه السلطة لاسترجاع هويته وكرامته وعزّته.
في هذه الأسطر، نلحظ ثنائيات الذل/ الكرامة، الصبح/ الظلام، والماضي/ المستقبل. فالمستقبل يحمل الأمل والنّصر والعودة واسترجاع الكرامة عند الشاعر. وذلك يحصل عند الثورة، ومواجهة الشعب للحاكم الظالم بعد استسلامه سنينا للذلّ والمهانة. فالصبح آتٍ بعدما كان قد أدمن الظلام، أي النّصر آتٍ بعد الخضوع للظلم سنينا طِوال. هذا النّصر سيُعيد كرامة الشّعب، ويرفع جبينه عزًّا وشرفًا، وستدور الأيّام، وتصبح غاية الشّعب الانتقام من الحاكم الظّالم والقضاء عليه، بعدما كان الحاكم المُستبِدّ يظلم الشّعب، ويُمارس القمع والقتل بحقّه.
الظّلام ارتبط بعهد القمع وقبول المهانة، والصّبح ارتبط بالنّصر واسترجاع الكرامة . وعندما أراد الشّاعر مواجهة الحاكم بأعماله القبيحة، قال:
قد بِعْتَ للأصنام توبة مسلم
وأقمت عرسك في سرادق مأتمي
ودفنت ضوء الصبح في سرداب ليلٍ معتم([26]).
أيضا نجد ثنائيات: الإيمان/ الكفر والموت/ الحياة والنور/ الظلام.
يتحدّث الشّاعر عن خضوع القوة الحاكمة للأعداء، وخيانتها للشّعب المؤمن، وبيع قضاياه. ثم يشير الى الترف والبذخ اللذَين يعيشهما السّياسيّون على حساب دماء شَعبهم، وقَتْل أحلامهم، و آمالهم بالنّصر وسيادة العدل، ودفنها في سرداب سنين الحكم القمعيّ الطويلة. من جديد نجد ارتباط ” الصبح” بالأحلام والنصر، ومفردات ” السرداب والليل والدفن” مرتبطةً بسنيّ الحكم القمعي.
ففي قصيدة ” كانت لنا أوطان ” التي يتكلّم فيها الشاعر عن احتلال اليهود للدولة الفلسطينية، هذا الاحتلال هو من حوّل نهارنا العربيّ إلى ليلٍ مظلمٍ، فأفلَت شمس الأمان والنصر . يقول الشاعر:
لن يطلع الفجر يومًا من حناجرنا ولن يصون الحمى من بالحمى غدروا([27])
الفجر هو معادل موضوعي للنصر والخلاص من ظلام الواقع وعتمته. فلن يأتي النّصر من الخطب والشّعارات، ولن يحمي الأرض الذين غَدَروا بها و باعوها.
هكذا تصبح مدلولات النّور ومفرداتها، كالفجر والنّهار والصبح والنّجم، رموزا للفرح والأماني والانتصار والحق والهداية . أما الظلام فتمثّل في ألفاظ كالليل والقبر والسّرداب. والسّواد والظلام كثيرا ما يرمزان إلى الحزن والمعاناة والهمّ والشؤم والهزيمة. في هذه النماذج السابقة، تبرز سلطة الظّلام نفسها بشكل أقوى لدى الشّاعر على الواقع المعيش. فحضورها ملحوظٌ في قصائده، وكثيرا ما يردّد مفرداتها التي هي ذات أبعادٍ دلاليةٍ سلبيةٍ، عانى منها الشعب. بالمقابل نلاحظ دلالات غياب النور، فيكثّف الشاعر الكلام عنه، ويتحدّث عن غيابه، ويتمنّى حضوره ويأمل في أن يراه في المستقبل (ضوء الصبح يرفع جبهتي – دفن ضوء النور- لن يطلع الفجر من حناجرنا – الصبح هذا الزائر المنفي يطل يجري ينتشر – فالشمس اذا سقطت يوما ستعود وتنجب ألف نهار) هذه الدلالات تؤكّد أمل الشّاعر في حضور النّور ليبدّد سلطةَ الظّلام التي يقع تحت وطأتها.
أين الدماء التي بيعت بلا ثمن واشعلت بعدها أحزان من غابوا؟([28])
في هذا البيت أعطى الشّاعر صفة الإشعال للدماء، العنصر المائي، ولكنه يُشعل أحزانا، والأحزان عنصرٌ مجرّدٌ أعطاه صفة العنصر الناريّ، وهو الاشتعال. الدّماء دماء الضحايا والأموات والشّهداء الذين رحلوا وتركوا وراءهم أحزان ذويهم. فالإشعال يرمز إلى إشعال نار الشّوق للأحبة والحنين لهم. فهنا نلحظ أنّ ثنائية الماء والنار ذات دلالة سلبية حين تصبح دليلا على معاناة الشعب، وتكشف عن النفوس المتوجّعة واحزانها الملتهبة والمحترقة، فتوضح حجم الظروف القاسية التي أحاطت بالمواطنين والمصائب التي ألمّت بهم. يقول الشاعر، في قصيدة “أحزان ليلة ممطرة” واصفًا حالته: “رأيت أشلائي دموعا في عيون الشمس/ تسقط بين أحزان النهر “. يشبه الشاعر أشلاءه بالدموع، العنصر المائي الذي يرتقي لِيصل إلى عيون الشّمس، العنصر الناريّ، ثم تهبط إلى النهر العنصر المائي. نجد ” أنّ الخيال يحلم بالخلق مثل اتحاد حميم لقدرة الماء والنار المضاعفة وتكوّن صورة ماديّة مختلِفة ومتفرّدة في قوّتها، إنها الصّورة الماديّة للرطوبة الحارة المُتمثِّلة بالدّموع في عين الشمس. إن مفهوم الرطوبة الحارّة هذه يحتفظ في كثير من الأذهان بأفضلية غريبة، فبفضلها يأخذ الإبداع تمهله الواثق”([29]). تشخيص الشاعر للشّمس ساعده على تكوين هذه الصورة المُبدِعة التي مزجَت الأشلاء مع العنصرَين الماء والنار، ومع العنصر التّجريدي الأحزان. كما مزجت الخيال المادي مع الخيال الدينامي من خلال عمليّة الصّعود والهبوط، صعود الأشلاء إلى الشّمس بشكل دموعٍ، وهبوطها إلى النّهر ليظهر قوّة أحزانه. الشّمس رمز الأمل والتفاؤل تنظر إلى الكاتب باكيةً فيرى أشلاءه أي ضياعه و تشتّته في دموعها التي تذرفها على النّهر الحزين . هنا يظهر لنا الواقع المرير، واقع ضياع الشعب وتشتّته، تراه الشمس من بعيد وتعجَز عن تغييره، فيبقى الأمل بالنصر والتغيير بعيدا. لذا نراها تبكي على ما يحصل على أرض الواقع من مآسٍ وويلات، وتمزج دموعها مع دموع النّهر التي عبّر عنها الكاتب بأحزان النّهر، لأن النهر يرمز إلى التحوّل المستمر والتغيير، فنجده حزينا لعجزه عن تغيير الواقع المأساوي.
1-3-3 ثنائية الماء والتراب: يزاوج الخيال المادي بين الماء والنار، والماء والأرض. بفضل الخيال العجيب تتلاقى العناصر في جدليّة تصارعيّة عدوانيّة بين الصّلب والرّطب . فصورة المادّة الأرضيّة رمزٌ للمقاومة والماء والنّار رمزان للاقتحام والعدوانيّة. “يأتي التّراب كمادة غير بسيطة كي يتشتّت على حقائق مختلفة في مظهرها وفي أدائها فهو يكون بصورة دورية رملًا فتربة فحصى فصخرًا، ثم معدنًا من الرصاص إلى الذهب ولكن باشلار الذي يرغب في أن يصنع مقياسا جيدا لهذا العنصر يضيف الى التراب ملحقات كالخشب والصّمغ والظّواهر الكبيرة التي لا ترتبط بالتّراب كعنصر بل بالتّراب ككرة أرضيّة حيث الجّبال والكهوف والجذور التي توحّد النبات بالتراب وبالمنزل الذي يؤصّل الانسان…”[30] ولا ننسى أن الانسان خُلق من تراب يقول الله تعالى في القرآن الكريم: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ﴾([31]) و﴿الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ ۖ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِن طِينٍ﴾([32]).
ذُكِرَت أماكنُ عباديّة عديدة في ديوان الشاعر، مثل القدس، الكعبة، المسجد، مئذنة، ومحراب. وهذه الأماكن لها صفاتٌ مشتركةٌ، تحمل دلالاتٍ كثيرةً. فهي صلبة وقويّة، لأنها مؤلّفة من حجارة قويّة، ما يدل على الصّلابة والقوة لمتانتها، وهي بيوت الله، فالاهتمام بها يدلّ على قوّة الإيمان، وإهمالها يدل على الابتعاد عن الدين، والبيت يبعث الأمان والاطمئنان والدفء. فهذه البيوت تبعث الدفء والراحة والاطمئنان في قلوب المؤمنين، فهي أماكن خاصة عبادية وعامة لجميع الناس. ولكن المئذنة تبكي، والكعبة تشتكي لِله غربتها، وتذرف الدّمع، والمسجد في الأندلس في كهوف الصّمت يبتهل، وقدسُنا في العار تغتسل.
لكي يبتعد الشّاعر من السّطحيّة المباشرة، حاول إضفاء بعض الخواص الإنسانيّة على الجمادات، وأسقَط ما بنفسِهِ عليها، وجعلها تشاركه وجدانه وأحزانه، وتحسّ وتشعر مثله تمامًا. حزن الشاعر على واقع الدين الإسلامي وعلى ضياع أمجاد العرب، لذا أضاف صفتَي البكاء والشكوى للكعبة، والاغتسال بالعار للقدس. وهذا ما يشعر به الكاتب وكل عربي شريف بمخاطر ضياع الدّين وتشويه معالمه ومبادئه وضياع القدس بسبب انهزام العرب واستسلامهم للواقع الذي فرضه العدو والقوة المستكبرة على المنطقة العربية. في هذه الصُوَر يمزج الكاتب بين العنصرَين الماديَين الماء والتراب. ويقول أيضا:
قالوا لنا أرضنا أرضٌ مباركةٌ فيها الهدى والتّقى والوحي و الرسل
مالي أراها وبحر الدّم يغرقها وطالع الحظّ في أرجائها زُحَل؟
عارٌ على الأرض كيف الرّجس ضاجعها كيف استوى عندها العنين والرجل([33])
أرضنا يقصد بها الكاتب أرض الدول العربية، وهي مباركةٌ لنزول الوحي والرسل فيها، ولوجود المزارات والكعبة والقدس، ولكن من كثرة القتل والظّلم اللذين يحصلان فيها انتقلت من أرضٍ طاهرةٍ إلى أرضٍ نجسةٍ. هذه الأرض أرض الطّهر والعدل، ضاجَعَها الرجسُ. الرّجس مذكر والأرض مؤنث، والمضاجعة يعني الملازمة أو المُجامعة، في الحالتَين يدلُّ على الارتباط القويّ بين الرّجس والأرض، وملازمته إياها عوضا عن الطّهر. وهنا نجد عنصر التحوّل والتبدّل من أرض الطهر إلى أرض النجس ومن أرض الإيمان إلى أرض الكفر، من أرض العدل إلى أرض الظّلم . فلم تعد تميّز الرّجل من العنين. كما نجد عنصر التحوّل و التبدّل في البيت الآتي:
يا وصمة العار هزّي جذع نخلتنا يساقط القهر والإرهاب والدّجل([34])
النخلة رمز لبعض الدول العربية كان يتساقط منها الرطب والخير، أصبح يتساقط منها القهر والإرهاب والدجل.
يقول الكاتب في قصيدة ” ليال الخريف”:
فحوائط الأحزان تصفع جبهتي وبريق عمري كلّه أطلال ([35])
الحائط عنصرٌ ترابيٌّ صلبٌ . نُسِبَت ” الحوائط” للأحزان للدلالة على قوة الأحزان و قساوتها وتحجّرها وثباتها، هذه الحوائط تصفع جبهة الشاعر. أن خيال ” حوائط الأحزان” يثير صورة التحجّر والجمود والحزن الذي يقضي على نضارة الحياة. واستخدام فعل “يصفع” ضد الشاعر دليل على سيطرة أحاسيس العنف والعداوة. هذه الأحزان طالت جبهته وتركت آثارها عليه، من ألمٍ وصبرٍ وتحمّلٍ للوجع حتى أصبح بريقُ عمره، أي سنوات حياته السعيدة أطلالًا.
في قصيدة “أحزان ليلى ممطرة” يقول الشّاعر: “السقف ينزف فوق رأسي/ والجدار يئن من هول المطر”([36]).
يتحدث الشاعر عن بيته الذي يأوي إليه، والذي تعبّر صورته عن رغبة عميقة في السكينة والهدوء، والذي يوفر للشّاعر الحماية والأمن. السقف ينزف والجدار يئن من هول المطر. والسّقف والجدار عنصرا تأسيس البيت، فهما يتميّزان بالصّلابة. بفضل الخيال الحركي تتلاقى العناصر في جدليّة تصارعيّة عدوانيّة بين الصّلب والرطب . فصورة المادة الأرضيّة المُتمثّلة بالسّقف والجدار رمزٌ للمقاومة والماء المتمثّل بالمطر رمزٌ للاقتحام والعدوانية. وهنا نلحظ صراعًا بين العناصر الماديّة (الماء والتراب)، ما أدى إلى نزيف السقف وأنين الجدار، ما يدل على غلبة الماء على التراب، فاستطاع خرق السقف وترك آثار سلبية على الجدار. وهما يمثلان عنصرَي الحماية والأمن للكاتب. تدل هذه الصورة على زعزعة الشعور بالأمن، والأمان في البيت الذي يجب أن يكون مصدرهما.
يقول الكاتب: “لا شيء في بيتي سوى صمت الليالي/ والأماني غائمات في البصر/ وهناك في الركن البعيد لفافة فيها دعاء من أبي/ تعويذة من قلب أمي/ لم يباركها القدر”([37]).
البيت هو واحدٌ من أهم العوامل التي تُدمَج فيه أفكارٌ وذكرياتٌ وأحلام الإنسانيّة . والبيت يحفظ الإنسان من عواصف السّماء وأهوال الأرض ، إنه جسدٌ وروحٌ . هو عالم الإنسان الأول([38]) .. لم يجد الشاعر فيه غير صمت الليالي، ما يدل على الشعور بالخلاء والوحدة . فلم يبق غير ذكريات تلك اللّيالي التي تُذكِّره بها لفافة فيها دعاء من أبيه وتعويذة من أمّه في ركن من أركان البيت . هذه اللفافة تُذكِّره بوالديه، وحبّهما ودعاؤهما المستمر له، وتدل على أن الشاعر تربّى في بيت مؤمن وديّن تسوده المحبّة، لذا نجد البيت مأوى الذكريات السّعيدة والحميمة كما يرى باشلار “يحتوي البيت على الزّمن مكثّفا يصبح بيت الذكريات الحميمة([39]) هنا البيت تجاوز حدود الهندسة.
أما الأشجار على العموم فهي عنصرٌ ترابيٌّ وناريٌّ، فهي تنبِتُ في التّراب، وتوقد منها النار، فهي تمدّ جذورها في الأرض وتتشبّث بها، فنجد علاقة وطيدة بين الأرض والأشجار . وللنخيل في قلوب العرب حميمية كبيرة، فهي تُعَدُّ رمزًا لكثير من الدول العربية بسبب طبيعتها الصحراوية القاسية. يستذكر الشّاعر في قصيدة “عودوا إلى مصر” شجر النخيل، فيسأل عنها قائلاً:
أين النّخيل التي كانت تظلّلنا ويرتمي غصنها شوقًا و يُسقينا ؟ ([40])
الإنسان بالفطرة يتعلّق بأرضه، كما يتعلّق بكل شيء ينبت فيها، ولا سيّما الأشجار التي تُظلّله وتُعطيه الثّمر. لذا، يتساءل االشّاعر مستفقدًا إيّاها: أين هي التي يرتمي غصنها ويسقينا؟ فهنا نلحظ عنصرّي الحبّ والعطاء في الأغصان، هذا دليل على تعلّق الأشجار بناسها وحبّها لهم، ما يولّد شعورًا مُتبادِلًا تجاهها. فهي تقوم بدور الأم، فتعطي الحنان، وتحمي من مخاطر الشّمس، وتعطينا الثمر، وتلبي حاجات إنسانيّة كما تفعل الأم. لذا يدعو المصريين للعودة للتمتّع بحنان الطبيعة وجمالها، وليستعيدوا الأيام الجميلة التي كانوا يعيشونها في حضن الطّبيعة. فيتوجه الشّاعر الى المصريين ناصحًا، فيقول:
منذ اتجهنا إلى الدولار نعبده ضاقت بنا الأرض و اسودّت ليالينا
لن ينبت النفط أشجارًا تظللنا ولن تصير حقول القار ياسمينا ([41])
عند إهمال المواطن أرضه وهجرها طمعا بالمال (الدولار)، يفقد الشعور بالحبّ والاهتمام والفرح، ولا تعوّضه عنه أي أرض أخرى، مهما حصّل فيها المال الوفير كبلاد النفط . بل ستضيق الأرض به، وتسوّد لياليه. فأرض وطنه مسقط رأسه، حاوية رفات أجداده. يشير الشّاعر من خلال هذين البيتين، إلى تعلّق الإنسان بأرض وطنه والشّعور بالراحة والسعادة في ربوعها، وبين أحضان أشجارها وفي طبيعتها. فهذا التعلّق تعلّق فطريّ، فالسعادة والراحة اللذان يجدهما الإنسان في وطنه، متمتّعًا بطبيعته، ومحاطًا بأهله لا يجدهما في حقول النّفط والقار، فهذه الحقول لا تنبت أشجارًا وياسمينًا أي أنها لم تصبح أرضًا خضراء جميلة، والإنبات دليل ولادة والياسمين رمزٌ للفرح لجمالها، ما يُثبِت إن بلاد الغربة لن تولد السعادة في ربوعها بل في أرض الوطن.
- الهواء: يربط غاستون باشلار بين الخيال التحريكي والهواء، بحسبان الهواء العنصر المتقلّب الذي يوحي باستعاداتٍ تمتدّ إلى ما لا نهاية. إذ يحيل الحركيّ والخفيف إلى السّماوات الصّافية، بينما يُبقى التراب والماء الأكثر كثافة في الأسفل. فيما يدعو الهواء للارتقاء، ولنزع الماديّة، والابتعاد منها، الأمر الذي يحيل الخيال التحريكي إلى خيال تحليق مستمر([42]).
لقد مرّ بنا أن الشّاعر يرى نفسه بدرًا يتراءى، أو يتحوّل إلى شعاع الشّمس، أو يجد نفسه دموعا في عين الشّمس، ويتمنّى أن يكون سحابًا يسري فوق البحر. نستشفّ من هذه الصُوَر حبّ الشاعر للطيران والتحليق عاليًا نحو السّماء. فهو يعيش الرغبة الخاصّة بالبشر بالانطلاق نحو الأعلى، نحو الضوء والنقاء، حيث يحرّره الهواء من أحلام اليقظة المادية، ويحرره من ارتباطه بالمواد، فهو إذًا مادة حريته.
في قصيدة “أبحث عن شيء يؤنسني” يرى الشاعر نفسه “تسري أحيانا فوق الموج/ بين أحياء الموتى كطيور الفجر”. هذا التشبيه يدل على أن حلم الطيران هو النمط العريق لكل تحليقاته نحو الأعلى . هكذا فإنّ حياته الروحية تريد أن تكبر رمزيًا، وأن ترتقي. هي تبحث عن السمو، ترفض الانكسار، والبقاء مع الناس الخاضعين لقهر السلطات.
في قصيدة ” أحزان ليلة ممطرة” يتحدّث الشاعر عن أحلامه، فيقول:
كم كنت أبني كل يوم ألف قصر/ فوق أوراق الشجر/ كم كنت أزرع ألف بستان على وجه القمر/
كم كنت ألقي فوق موج الريح أجنحتي/ وارحل في أغاريد السحر/ منذ انشطرت على جدار الحزن
ضاع القلب مني وانشطر.([43])
تبدو مملكة الشّاعر مبنيّة في الأعلى (على ورق الشجر، على وجه القمر، فوق الريح) والانتقال إليها يَحدِث عبر “أجنحة” فالفضاء يُعدّ وطنه الأسمى ما يتوافق مع نظرية العالم نيتشه. “لا بد أن نذكر أن ظاهرة الصعود الخيالي تؤدي دورًا كبيرًا في العالم النفسيّ والخيالي لـ”نيتشه” فيلسوف إرادة القوة الذي يرى في عنصر الهواء مادة غنية لسعادة “فوق انسانية” فالفضاء العلويّ بالنسبة لهذا الفيلسوف يُعد الوطن الأسمى بدعامتَيه المؤلفتَين من البرودة والعلو ويمثل الهواء عنده مادة الحرية”([44]) وعند الشاعر جويدة يمثل الهواء مادة حريّته ومادة ثورته ومقاومته. فنجد في قصائد الشّاعر صراعًا قائمًا بين الأمل واليأس، إنّه ذهابٌ وإيابٌ لا ينقطع بين وضعياتٍ متناقضةٍ ليست دائمًا واضحةً . ما يُولّد منها ثنائيّة الاستسلام والمقاومة.
في قصائد الشّاعر وصْفٌ للواقع المعيش الذي يستسلم له النّاس الخاضعون للقهر والذّل ، ولأفعال السّلطات المهينة، من قتْلٍ واذلالٍ وكبْتٍ للحريات ونهب أموال الناس. كما نجد صوت المقاومة، ولا سيما صوت روح الشّاعر الحالمة بالخلاص والانعتاق والثّورة . تبدو ثنائية الاستسلام والمقاومة في توصيفه لنفسه، في قصيدة “أبحث عن شي يؤنسني”: نفسي أعرفها إن سقطت/ ستعود وتبني أجنحة/ وتحلّق بين الأشجار/ إن ماتت يومًا/ سوف تحطّم صمت القبر/ وتهدم حولي كل جدار/ إن ركعت قهرًا لن ترضى/ ستقوم وتهدر كالإعصار/ إن خنقوا صوتي/ سوف أغني فوق الريح/ وتحت الماء… ولو قطّعوا كل الأوتار/ فالشمس إن سقطت يوما/ ستعود وتنجب ألف نهار([45]).
الأفعال الدالة على الاستسلام هي: “سقطت، ماتت، ركعت، خنقوا، قطّعوا” غلبت عليها حركة الهبوط، ومعاني الموت والضّعف. بالمقابل الأفعال الدّالة على المقاومة هي “تبني، تحلّق، تُحطّم، تهدر، أغني، تعود، تنجب”، فهي يغلب عليها حركة الصعود، ومعاني التّجدّد والغضب والثّورة.
للشّاعر فلسفةٌ حياتيةٌ خاصةٌ به، تتمثّل في أنه لا سبيل للشاعر في هذه الحياة إلا أن ينتصر على أحزانها وآلامها ومآسيها . ولا بد أن ينمو لديه حسّ المقاومة، من خلال القهر والاضطهاد اللذين يتعرّض لهما. نجده، في هذه الأبيات، يرفض أي لون من ألوان الانتهازية، لأنه يتمتّع برباطة الجأش وعزيمة يتلاشى معها الإحساس بالخوف من اليأس والقلق والردى . فنفسه إن سقطت ستعود و تبني أجنحة وتحلّق، ما يدل على قوة عزيمتها واصرارها على المقاومة. وإن ماتت ستُحطم صمت القبر، وتهدم حوله كل جدار، ما يدلّ على حبّها للحياة ورفضها للاستسلام للموت. وإن ركعت قهرا ستقوم وتهدر كالإعصار ما يدل على عصيانها على الظلم، وعلى شعورها بالغضب واقتناعها بحتمية الثورة. ويختم قوله بتفاؤله بالنصر بالرغم من الواقع المرير، ومن كل العنف والذلّ اللذين يتعرّض لهما، ألا إن الشاعر كان لديه تطلعات إلى أملٍ جديدٍ، ونور فجرٍ تتحقّق فيه أمنياته. فإن الشمس رمز الأمل والنّصر والفتح، إن سقطت يوما ستعود وتنجب ألف نهار، ما يدلّ على تفاؤل الشّاعر بالنّصر مهما طال ليل الطّغيان. فبفضل المقاومة و الثورة سيولد ألف نصرٍ.
يقول الشاعر في قصيدة “أحزان ليلى ممطرة”:
لا تحزني/ إن الزمان الراكع المهزوم لن يبقى/ ولن تبقى خفافيش الحفر/ فغدًا تصيح الأرض/ فالطوفان آتٍ/ والبراكين التي سجنت/ أراها تنفجر/ والصبح هذا الزائر المنفي من وطني/ يطلّ الآن… يجري بنتشر / وغدا أحبّك مثلما يوما حلمت/ بدون خوف أو سجون أو مطر([46]).
تظهر هذه الأبيات تفاؤل الشّاعر بالمستقبل . فإنّ زمن الهزائم سيُولّى، و لن تبقى خفافيش الحفر، والخفافيش “تمثل نوعا من الكوابيس السّوداء وترمز الى معاني الدّناءة والتّشاؤم والشّر:” ([47]) . فالكوابيس التي يراها المواطنون سترحل مع الاشرار الذين يمارسون أعمال الدّناءة والشّر. وستغضب الشّعوب وتقوم الثّورة ويهلك الظّالمون . ويعود الحقّ وتسود المحبة والعدالة .
هذه الصُوَر تجمع العناصر الماديّة كافة، في مشهديّة سينمائية رائعة ، وتظهر كأنّ بعضَها متلاحمٌ مع بعضها الآخر، لترسم صورة الغضب والثورة. فالأرض – العنصر الترابي – تصيح غاضبةً بسبب الجور المُسيطر عليها معلنةً الثورة ويلبّي نداءها الطّوفان – العنصر المائي – فالطّوفان كما ذكرنا سابقا دوره القضاء على القوم الظّالمين، والبراكين –العنصر المائي التّرابي – التي سُجِنَت تنفجّر ويقصد بها غضب الشّعوب الذي كان مكبوتا سنينا طوالا، سيتفجّر ثورةً ضد الظّلم، والصّبح – العنصر النّاريّ- الذي كان منفيًا لأن سلطة الظّلام كانت مسيطرةً على أوطاننا سيعود وينتشر في سماء أوطاننا ويُبدِّد ظلمة الأيّام وحينها تصبح الأوطان العربيّة كما يحلم أن تكون، فيها الأمان والعدل والحق فحينها يتحقّق حلمه ويحبّ أوطانه أكثردون خوفٍ من الظّلم.
بالرّغم من النّظرة المعتّمة للدول العربية نجد هذه الصّورة قد قضَت على التّشاؤم، مع إن ديوان الشّاعر حفل بالأبيات التي نقلت لنا الواقع المرير المعيش. فالشّاعر مؤمنٌ بانتصار الحقِّ، وبانحسار الظّلم مهما طال.
أما في قصيدة ” من أغاني مانديلا” فيواجه الشّاعر الحاكم المُستبِد والخائن، من خلال رمز “الجلّاد” بأعماله الإجراميّة، طالبًا منه الرّحيل، مهدّدًا إياه بأنه سيلقى مصيرًا مُؤلِما من خلال ثورة الشّعب عليه، ومشيرا إلى تحوّل ثوّار العصر إلى مُجرمين عند تولّيهم السّلطة .فيقول:
يا أيّها الجّلّاد/ لا تطلق خيولك في دمي/ نيشانك المهزوم تاجر/ من سنين في بقايا أعظمي/…
كبّلتني بالصمت/ حتى ماتت الكلمات حزنا في فمي/ قيّدتني حتى ظننت/ بأن هذا القيد يسكن معصمي
وقتلتني / حتى ظننت بأن قتل النفس/ في الأديان غير محرّم/ …
اخرج لتلقى يا عدوّ الله/ حتفك في المصير المؤلم/ وانظر لقبرك إنه الطوفان/ يلعن كل عهدٍ مظلم/ لم يبق من ثوّار هذا العصر/ غير جماجم القتلى/ وصوت الجوع/ والبطش العمي/ صارت نياشين الزعامة/ في عيون الناس…/ جلّادا… ونهرا من دم/ قد خدّرونا بالضلال وبالأماني الكاذبات/ وبالزعيم الملهم / وماذا تقول الآن يا قلبي؟… أجب/ من كان في عينيك يومًا ثائرا/ الآن أصبح في سجل القهر/
أكبر مجرم.
في هذه الأسطر، يخاطب الشّاعر الجلاد – أي الحاكم المستبدّ ويطلب منه الكفَّ عن البطش، ويواجهه بأعماله السوداويّة من إفقارٍ وتعذيبٍ وعنفٍ واعتقالٍ وقتلٍ وكبت للحريات. يقول الشّاعر: من كان ثائرا أصبح في سجل القهر أكبرَ مجرمٍ . ولكن لم يستسلم الشّاعر للواقع المرير الذي يعيشه بل بقي مؤمنا بالثورة وباسترجاع العدل من خلال طوفان الشعب الذي سينزل و يجرف كل حاكمٍ مجرمٍ مختبئٍ وراء أعماله الإجرامية.
تبيّنت دراسة شبكات الخيال المادي والدينامي إبداع الشاعر وبراعته في فهم علم نفس البشريّة. عند دراستنا للخيال المادي لديه وجدنا أنّ عناصر الماء والتّراب والنّار ارتبطت بوطن –الواقع عند الشّاعر. فالبحر والنهر احتضنا رفات الضّحايا والشّهداء الذين قُتِلوا دفاعًا عن الوطن والأمّة، أما الطّوفان فكان رمزًا للثورة على الظّالمين والقضاء عليهم، أما عنصر النّار فله قيمتان مُتناقضتان، فالنّور يدلّ على التشتّت وضياع الكاتب تارةً، ويرمز إلى الخلاص والانعتاق والحلم والأمل تارةً أخرى، أما التّراب فهو عنصر التّحوّل والتّبدّل، أرض العرب كانت أرضًا طاهرةً تحوي بيت الله ومقامات العبادة التي تبعث الأمان في نفوس النّاس تحوّلت إلى أرضٍ نجِسةٍ تُهتَك فيها حُرمات المقامات ويُحرّف فيها الدّين، حتّى شجرة النّخيل التي ترمز إلى العطاء والخير تحوّلت الى شجرة يتساقط منها القهر والإرهاب. أما الهواء فارتبط بوطن الحلم لديه عبر تحليقه عاليًا وبناء مملكته في الأعلى، فهو مادة حرّيته. فحلم الطّيران هو النّمط العريق لكل تحليقاته نحو الأعلى، نفسه تطمح إلى السّمو وتسعى إليه في عمليّة ارتقاءٍ روحيّة نحو السّماء، كما ارتبطت حركة الهبوط بالواقع الأليم وحركة الصّعود بالوطن الحلم . وعند دراستنا لثنائيّة النّور والظّلام ، وجدنا أن الظّلام يُعبِّر عن واقع الأمّة البائس وبسنين الحكم القمعي. أما النّور فارتبط بوطن الحلم والأمل والنّصر. وبالرغم من الشّعور السّوداوي الذي غلب على القصائد من خلال استسلام الشّعب ويأسه إلا إنّ روح المقاومة لم تغب عن الشّاعر، بل ظلَّ مُتفائِلًا بالنّصر القريب وبثورة الشّعب مهما طال ليل الطغيان.
المصادر
- القرآن الكريم
- جويدة فاروق، الأعمال الشعرية ، المجلّد الثالث، دار الشروق، القاهرة، 2004، لا طبعة .
- جويدة فاروق، ديوان ” كانت لنا أوطان” دار الشروق ، القاهرة، لا سنةن لا طبعة.
- خليا أحمد خليل، معجم الرموز ، دار الفكر اللبناني، بيروت ، 1995، ط1.
المراجع
- أيوب ،نبيل ، نص القارئ المختلف، مكتبة لبنان، بيروت. لاسنة، لا ط
- جرجور، مهى، الدلالة الثانيّة – قراءة في شعر محمود درويش، دارعودة، لبنان، لا سنة ، لا ط
- سلامة، نبيل ، ملخص كتاب جماليات المكان لغاستون باشلار، دمشق.
- شعيبي، عماد (فوزي) ، كتاب الخيال ونقد العلم عند غاستون باشلال، دار طلاس، دمشق، ط1
المراجع المترجمة
- باشلار ، غاستون ، الماء و الأحلام ، دراسة عن الخيال والمادة ، ترجمة د علي نجيب ابراهيم، منظمة العربية للترجمة توزيع مركز دراسات الوحدة العربية. لا سنة، لا ط
- باشلار، غاستون، جماليات المكان، ترجمة غالب هلسا، بيروت ،المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، 1996، ط4.
- باشلار غاستون ، النار في التحليل النفسي، ترجمة نهاد خياطة، دار الأندلس ، 1984، ط1.
المقالات
- الطبّال ، أحمد، الماء في رمزيته الأسطورية والدينيّة، مجلة الفكر العربي المعاصر ، العدد 25 1983م.
المواقع الإلكترونية
- http://www.sciencemag.scbaghdad.edu.iq/Blog%20Posts/article4.html
- – سلامة نبيل ، ملخص كتاب جماليات المكان لغاستون باشلار ،
http://www.maaber.org/issue_june11/books_and_readings3.htm
1- طالبة دكتوراه في الجامعة الإسلاميّة –خلدة- لبنان- قسم اللغة العربيّة وآدابها.
PhD student at the Islamic University – Khaldeh – Lebanon – Department of Arabic Language.Email: monaha2014@gmail.com
أستاذ دكتور في الجامعة اللبنانيّة – بيروت- لبنان- قسم اللغة العربية وآدابها.-[2]
Professor at the Lebanese University – Beirut – Lebanon – Department of Arabic Language and Literature.
[3] – غاستون باشلار (1884 – 1962) واحدٌ من الفلاسفة الفرنسيين ، ظاهراتي؛ وربما أكثرهم عصرية أيضًا . اهتم بفلسفة العلوم في الجزء الأول من حياته، ثم تحوّل إلى دراسة التخيل الشاعري وفلسفة الجمال والفن؛ إذ ابتدأها مع (التحليل النفسي للنار) العام 1937، ثم (الماء والأحلام) العام 1941 ، ثم (الهواء والرؤى)، ثم ( التراب وأحلام الإرادة والتراب وأحلام الراحة) العام 1948.
[4] – جان بيير ريشار J. P. richard هو أستاذ الأدب المعاصر في جامعة السوربون، وقد أمضى خمسًا وعشرين سنة يدرّس الأدب الفرنسي في لندن ومدريد. واستفاد من أطروحات باشلار، وبوليه. وصاغ منهجًا نقديًّا أطلق عليه اسم المنهج الموضوعاتي (التيمي). ووضع كتبًا مهمة من مثل: الأدب والإحساس (1954)، والشعر والأعماق(1955)، والعالم الخيالي لمالارميه (1961)، وإحدى عشرة دراسة في الشعر الحديث. (
[5] – جورج بوليه J. poulet مولود العام 1902، وأستاذ في جامعات أدنبرة، وبالتيمور (1952)، وزيوريخ (1956)، ونيس (1968). وقد نشر كتبًا عُدَّت من أسس (النقد الجديد)، منها: دراسات في الزمن الإنساني (1950)، والمسافة الباطنيّة (1952).
[6] – أيوب نبيل، نص القارئ المختلف ، مكتبة لبنان ناشرون ، 2011 ط 1 ص 307
[7] – المرجع نفسه، ص 301
[8] – الطبال، أحمد ، الماء في رمزيته الأسطورية والدينيّة، مجلة الفكر العربي المعاصر ، لبنان، مركز الانماء القومي ،العدد ،25، 1983م ص142
[9] – باشلار،غاستون، الماء والأحلام، ترجمة د. علي نجيب ابراهيم، بيروت، المنظمة العالمية للترجمة 2007 ط 1 ص 174
[10] – جويدة، الأعمال الشعرية، مصدر سابق، ص 17
[11]– خليل، خليل (احمد)، معجم الرموز، بيروت، دار الفكر اللبناني، ص81
[12] – جويدة، الأعمال الشعرية، مصدر سابق، ص 62
[13]– باشلار، غاستون، الماء والأحلام، دراسة في الخيال والمادة، ترجمة د. علي نجيب ابراهيم، مركز دراسات الوحدة العربية، ص205
[14]– جويدة ، الأعمال الشعرية، مصدر سابق،ص 41
[15] – جرجور ،مهى، الدلالة الثانيّة – قراءة في شعر محمود درويش، لبنان، دار عودة، ص 66
[16] – http://www.sciencemag.scbaghdad.edu.iq/Blog%20Posts/article4.html
[17] – جويدة، فاروق، كانت لنا أوطان، ص 136
[18] سورة نوح ، الآية 26/27
[19]– جويدة ، الأعمال الشعرية ، مصدر سابق، ص 59
[20]– المصدر نفسه، ص 16
[21]– المصدر نفسه ، ص 43
[22]– جويدة، فاروق،الأعمال الشعرية ، مصدر سابق، ص 10
[23]– أيوب، نبيل ، نص القارئ المختلف ، مرجع سابق، ص 309
[24] – جويدة، فاروق، الأعمال الشعرية، م س، ص10
[25] – جويدة، الأعمال الشعرية ، م 3 ، مصدر سابق ،ص 68
[26]– جويدة فاروق، الأعمال الشعرية ، م س، ص 70
[27]– المصدر نفسه ، ص 44
[28] – جويدة، فاروق،الأعمال الشعرية ، مصدر سابق ، ص 29
[29] – باشلار ،غاستون ، الماء و الأحلام ، مصدر سابق، ص 151
[30] – شعيبي، عماد (فوزي)، الخيال ونقد العلم عند غاستون باشلال، دمشق، دار طلاس، ط1
https://www.facebook.com/groups/1386616148246487/permalink/1386619004912868/
[31]– سورة الروم، آية 20
[32]– سورة السجدة ، الآية 7
[33]– جويدة، فاروق،الأعمال الشعرية، م3 مصدر سابق، ص 41
[34]– جويدة، فاروق،الأعمال الشعرية، م3 مصدر سابق، ص 42
[35]– جويدة، الاعمال الشعرية، م ن، ص 60
[36] – المصدر نفسه ، ص 18
[37] – المصدر نفسه ، ص 18
[38] – سلامة نبيل ، ملخص كتاب جماليات المكان لغاستون باشلار ،
http://www.maaber.org/issue_june11/books_and_readings3.htm
[39] – المصدر نفسه
[40] جويدة، الأعمال الشعرية ، مصدر سابق، ص 22
[41] المصدر نفسه ، ص 34
[42] سلامة ، نبيل ، ملخص كتاب جماليات المكان لغاستون باشلار ، مرجع سابق
[43] الأعمال الشعرية ، م3 ، مصدر سابق ، ص 20
[44] شعيبي، عماد (فوزي) ، كتاب الخيال ونقد العلم عند غاستون باشلال ، مصدر سابق
https://www.facebook.com/groups/1386616148246487/permalink/1386618948246207/
[45] – جويدة ، الأعمال الشعرية ، مصدر سابق، ص 17
[46] – جويدة، الأعمال الشعرية ، مصدر سابق ، ص 24
[47] – كتاب الخيال ونقد العلم عند غاستون باشلال ،مصدر سابق
https://www.facebook.com/groups/1386616148246487/permalink/1386618948246207/