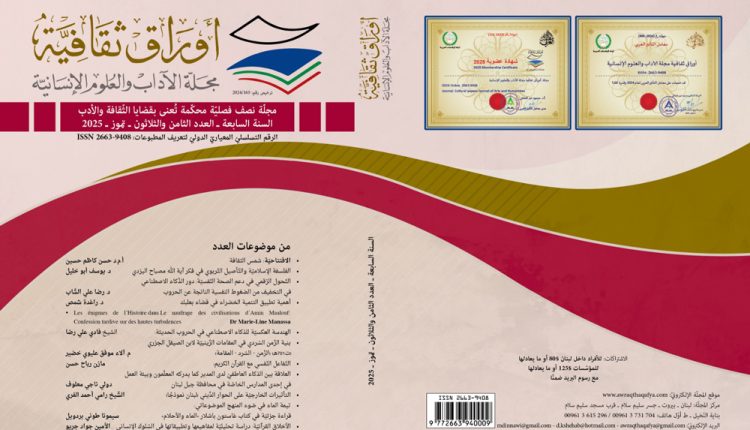عنوان البحث: دراسات صوتيّة ولغويّة في رسائل إخوان الصّفا
اسم الكاتب: م. آلاء موفق عليوي خضير
تاريخ النشر: 2025/07/16
اسم المجلة: مجلة أوراق ثقافية
عدد المجلة: 38
تحميل البحث بصيغة PDFADOI: https://aif-doi.org/awraq/013807
دراسات صوتيّة ولغويّة في رسائل إخوان الصّفا
Phonetic and Linguistic Studies in the Epistles of the Brethren of Purity
م. آلاء موفق عليوي خضير([1])Alaa Muwaffaq Aliwi Khader
تاريخ الإرسال:18-6-2025 تاريخ القبول:1-7-2025
الملخص
يتناول هذا البحث الدّراسات الصّوتيّة واللغويّة كما وردت في رسائل إخوان الصفا، وهي موسوعة فكريّة فلسفيّة تعكس عمق التّفكير العلمي عند مفكري القرن الرابع الهجري، ركّز البحث على تحليل مفاهيم الصوت واللغة من منظور فلسفي وعلمي، موضحًا كيف عالج إخوان الصفا الأصوات من حيث تعريفها، وتصنيفها، ومخارجها، وربطها بالنفس والموسيقى والكون.
الكلمات المفتاحيّة: الدّراسات الصّوتيّة، اللغويّة، رسائل إخوان الصّفا
Abstract
This research examines phonetic and linguistic studies as presented in the Epistles of the Brethren of Purity (Ekhwan al-Safa), a philosophical intellectual encyclopedia that reflects the depth of scientific thought among thinkers of the fourth century AH. The research focuses on analyzing the concepts of sound and language from a philosophical and scientific perspective, explaining how the Brethren of Purity treated sounds in terms of their definition, classification, and articulation, and their connection to the soul, music, and the universe.
Keywords: Phonetic studies, linguistics, Epistles of the Brethren of Purity
المقدمة
بات من الواضح أنّ قضايا علم اللغة الحديث اكتسبت رواجًا في الجامعات العربيّة لأهميتها، وبغية تسليط الضوء على بعض ما أبدعه إخوان الصّفا([1]) في رسائلهم الفلسفيّة([2])، انتظم هذا البحث الموسوم بـ(دراسات صوتيّة ولغويّة في رسائل إخوان الصّفا)، علمًا أنّ هذه الرّسائل لم تحظ بالبحوث الصّوتيّة واللغويّة باستثناء ما كتبه الدكتور أبو السعود أحمد الفخراني([3]). والحق أنّ رسائل إخوان الصّفا فيها من دراسات الصّوتيّة، واللغويّة الكثير من المباحث التي تغني المكتبة العربيّة.
من هنا ارتأينا أنّ نقدّم هذا البحث بعنوان دراسات صوتيّة ولغويّة في رسائل إخوان الصّفا عسى أنّ نوفق في رصد الأفكار المهمّة التي لها مساس مباشر مع هذا البحث.
وقد استقر الرأي على أن يكون البحث مؤلف من مبحثين الأوّل: الدّراسات الصّوتيّة وله مطالب متعددة، والثاني الدّراسات اللغويّة وله مطالب متعددة ثم يشفع بخاتمة يستوفى فيها النتائج التي توصل اليها البحث.
المبحث الأوّل: العلوم الصّوتيّة
من المعروف أنّ بداية ظهور (علم الأصوات) كان في الربيع الأوّل من القرن التّاسع عشر الميلادي وكان الدّافع لنشوئه، هو: المنهج الفكري الجديد الذي اتبعه العلماء في دراسة اللغة السّنكريتيّة ومقارنتها باللغات الأوروبيّة([4]). وقد تمخض عن تلك الدّراسات تقسيم علم الأصوات الى فروع متعددة ابرزها:
- علم الأصوات اللغويّة (Fhonetics): وهو العلم الذي يدرس الصّوت اللغوي الإنساني لذاته بصرف النّظر عن وظيفته التي يؤديها في لغة ما([5]).
- علم الأصوات اللغوي الوظيفي (Fhonolog): وهو “دراسة طريقة تأدية الأصوات الإنسانيّة لوظائفها في اللغات المختلفة، وطريقة تناسقها في أنماط بكل لغة”([6])، أي دراسة الوحدات الصّوتيّة داخل السياق الصّوتي للكلمة([7])، وتتسع دائرته لتشمل دراسة المقاطع والنّبر والنّغم([8]).
ومن خلال متابعتي لدراسات إخوان الصّفا الصّوتيّة اتضح أنّها في إطار علم الأصوات اللغوية (Fhonetics) وان كنا لحظ الاشارات التي توحي بالاهتمام بعلم وظائف الأصوات كما سيتضح فيما بعد.
ولغرض دراسة علم الأصوات اللغويّة Phonetics عند إخوان الصّفا لابُدَّ من ان نبدأ من المفهوم الفيزيائي لعمليّة التّصويت عندهم، فهم يعرفون الصّوت أنّه “فرع يحدث في الهواء من تصادم الأجسام بعضها ببعض”([9]) وقالوا في موضع آخر “فإن قيل: ما الصّوت؟ فيقال: قرع في الهواء من تصادم الأجرام”([10]).
قالوا: “الصّوت قرع يحدث في الهواء إذا صدمت الأجسام بعضها بعضًا، فتحدث بين ذينك الجسمين حركة عرضيّة تسمى صوتًا، بأيّ حركة تحركت، ولأي جسم صدمت ومن أي شيء كانت”([11]) وهذا التّفسير والتّعريف موافق لما ذهب إليه المحدّثون ([12]). وبيان للمعنى الموضوعي أو الفيزياوي([13]).
إذ يرى علماء الفيزياء أنّ حدوث الصّوت وإدركه يشترط فيه توفر أشياء ثلاثة عناصر: جسم ينبعث منه ويسمّى (المصوّت) أو (مصدر الصّوت)، ووسط مادي ينتقل الصّوت فيه، وحاسة سمع تدرك الصّوت([14])، والمقصود بالجّسم المصوّت هو “الجسم الاهتزازي الملامس لوسط ما، له القدرة على إمرار هذه الطاقة الاهتزازية الى الأذن”([15]). وعلى هذا يشتمل علم (الصّوتيات) على ثلاثة أجزاء الجزء الخاص بإنتاج الصّوت، الجزء الخاص بانتقاله والجزء الخاص باستقباله([16]).
ممّا تقدّم يتضح أن إخوان الصّفا قد أدركوا الجزء الخاص بإنتاج الصّوت، والجزء الخاص بانتقاله وذلك بالإشارة إلى الوسط الذي ينتقل فيه موجات الصّوت وهو الهواء إذ قالوا “إنَّ الهواء لشدة لطافته وخفة جوهره وسرعة أجزائه يتخلل الأجسام كلّها، فغدا صادم جسم جسمًا انسل ذلك الهواء من بينهما بحميّة وتدافع وتفوج إلى جميع الجهات، فحدث من حركته شكل كروي، واتسع كما تتسع القارورة من نفخ الزجاج فيها، أو الماء السّاخن إذ القي فيه حجر فيتزاحم الماء حتى يبلغ إلى أطراف الغدير”([17]). وفي ذلك إشارة إلى طبيعة انتقال موجات الصّوت إذ أضافوا قائلين: “وكلما اتسع ذلك الشّكل (إشارة إلى الموجات) ضعفت حركته وتموجه إلى أن يسكن ويضمحل فمن كان حاضرًا من الناس وسائر الحيوانات التي لها بالقرب من ذلك المكان، تموج ذلك الهواء الذي هناك، فأحست عند ذلك القوة السامعة بتلك الحركة والتغيير”([18]). وبذلك يتضح أنّ إخوان الصّفا كانوا قد أدركوا تفاصيل حدوث الصّوت وكيفيّة انتقاله واستقباله، أي: الجزء الخاص بإنتاج الصّوت، والجزء الخاص بانتقاله، والجزء الخاص باستقباله.
علم الأصوات العام: Phonetics
من فروع الدّراسات الصّوتية في علم اللغة الحديث “دراسة الصّوت اللغوي الإنساني بصرف النّظر عن وظيفته التي يؤديها في لغة ما”([19])، وتُدرس الأصوات من خلال علم الأصوات التّشريحي الذي يهتم بحركات أعضاء النُّطق الإنسانيّة، والدّراسة الفيزياويّة ويهتم بتأثير الأصوات في الهواء الذي ينقلها من المتكلم إلى السّامع، وعلم الأصوات السّمعي الذي يهتم بإدراك الأصوات بواسطة أذن السّامع وسيكولوجيّة الإدراك([20]). وقالوا: “الحروف اللفظيّة هي أصوات محمولة، بالهواء فمدركة بطرق الأذنين بالقوّة السّامعة”([21])، وهو ما عبَّر عنه المحدَّثون في تعريف الصّوت بقولهم: “الأثر الواقع على الأذن من بعض حركات ذبذبيّة للهواء، ومصدر الذّبذبة في الصّوت اللغوي من يحدثها الجهاز الصّوتي للمتكلم”([22]).
علم الأصوات التّشريحي: لعل أول عضو من أعضاء الجسم له دور في إنتاج الصّوت هي الرئة وقد أشار إخوان الصّفا إلى ذلك بقولهم: “الصّوت من الجسم في الرّئة بيت، الهواء”([23])، ثم أشاروا إشارات سريعة إلى معظم أعضاء النّطق سوى الأسنان واللهاة وللغار، فقالوا: “علم الحروف اللفظيّة إنّما هي أصوات تحدث في الحلقوم والحنك، وبين اللسان والشفتين. عند خروج النّفس من الرّئة بعد ترويحها الحرارة الغريزيّة”([24])، وقالوا “أبعد مخارج الحروف أقصى الحلق”، وهم يشيرون بذلك إلى الحنجرة التي كانت تُعرف آنذاك بالحلقوم([25])، وبينوا دور اللسان بقولهم: “وأصل الأصوات في الرئة هواء يصعد إلى أن يصير الى الحلق فيديره اللسان على حسب مخارجه”([26])، كذلك أشاروا إلى دور الشفتين وهو يتحدثون عن التّعبير بقولهم: “إلّا ما عبّر كل إنسان عما في نفسه لغيره من أبناء جنسه ولا يمكنه ذلك إلاّ بأدوات وآلات مثل اللسان والشفتين واستنشاق الهواء وما شاكلها”([27])، وبيّنوا دور الشفتين بقولهم: “تضم الشفتين بنوع مالا فتحدث الباء، وتضم بنوع آخر فتحدث الميم”([28]). وتحدثوا في موضع آخر وهم يشيرون إلى الحركات بقولهم: “حركتان للشّفتين بالفتح والضم”([29]). وقالوا في موضع آخر وهم يتحدثون عن حال النّفس (بالشفتين واللسان)([30]).
مخرج الصّوت: يقصد بالمخرج مكان النّطق أي مكان انحباس الهواء إذ عرّفه بعضهم أنّهُ الموضع الذي يكون فيه انحباس الهواء، وحجزه من المرور كليًّا أو جزئيًّا بأحد الحواجز الموجودة في الحلق أو الفم كاللهاة أو اللسان أو الشفتين”([31])، وقد فطن إخوان الصّفا إلى المقصود بمخارج الأصوات بقولهم: “اعلم أنّ هذه الأحرف لا تحدث إلّا بإرسال النّفس المستنشق من الهواء وإرساله، وقطع اللسان لها في مخارجها ومجاريها”([32]).
مخارج الأصوات: تحدث الخليل بن أحمد الفراهيدي، عن مخارج الأصوات وجعلها سبعة عشر مخرجًا أمّا سيبويه (ت 180هـ)، وابن جني (392هـ) فقد ذهبا إلى أنّ المخارج ستة عشر.
أمّا إخوان الصّفا فقد قالوا: “وأمّا حركات اللسان عند الكلام فإن نذكرها في فصل آخر”([33])، ويبدو أنّ هذا الجزء مفقود من الرّسائل. وقالوا “منها حركات اللسان أيضًا عند قطع الشفتين لحدوث الحروف التي مجراها على اللسان وهي أربعة عشر حرفًا في لغة العرب وهي هذه: ت، ث، د، ذ، ر، ز، س، ش، ص، ض، ط، ظ، ل، ن، والأربعة عشرة حرفًا أخرى فمخارجها مختلفة ليس للسان فيها مدخل”([34])، وأراهم قد جانبوا الصواب في مقالتهم، إذ نجد أنّ للسان دور في نطق كل من صوت الواو([35])، والجيم([36])، والكاف، والقاف([37])، أمّا أصوات الباء والميم والفاء والهمزة والهاء فلا دور للسان في نطقهن([38]).
المقاطع الصّوتية: المقطع عند ماريو باي “هو قمة إسماع غالبًا ما تكون حركة مضافًا إليها أصوات أخرى عادة تسبق القمّة أو تلحقها أو تسبقها وتلحقها ففي (ah) قمة الأسماع كما هو واضح ((a وفي (do) هي (o) وفي (get) هي (e)([39]). في حين يرى كانتينو “إنَّ المدّة الفاصلة بين عمليتين من عمليات غلق جهاز التّصويت سواء أكان الغلق كاملًا أم جزئيًّا هي التي تمثل المقطع”([40]). والذي أراه أن المقطع هو وحدة صوتيّة تبدأ بصوت مصروف تتبعه حركة طويلة أو قصيرة (غير مصروف) وتنتهي قبل أول صوت مصروف متبوعًا بحركة أو حيث ينقضي اللفظ قبل تمام الشّرط([41]). وقد فطن إخوان الصّفا إلى المقطع الصّوتي ولكن من دون أن يضعوا تعريفًا له إذ قالوا: “إنَّ النُّطق لا يكون إلّا في صوت يخرج من مخرج يمكن تقطيعه بالحروف”([42])، وقالوا: “أصل الأصوات في الرّئة هواء يصعد إلى أن يصير إلى الحلق فيديره اللسان على حسب مخارجه، فإنّ خرج على حروف مقطعة مؤلفة، عرف معناه وعلم خبره”([43]). وقالوا: “إنَّ الكلام هو صوت بحروف مقطعة”([44])، وقالوا: “الأقاويل كلُّها مركبة من الكلمات، والكلمات من الأسماء والأفعال والأدوات، وكلُّها مركّبة من الحروف المتحركات والسّواكن”([45])، وفي النّص الأخير شدُّ ما يقتربون من التّعريف الحديث للمقطع الصّوتي.
إنتاج الصّوت اللغوي
من المعروف أنّ إنتاج الصّوت اللغوي يمرّ بثلاث مراحل هي:
المرحلة الأوّلى: وهي مرحلة اندفاع هواء الزّفير من الرئتين وخلال تجويف الحنجرة والحلق والفم([46]). لقد قال إخوان الصّفا عن هذه المرحلة: “أصل الأصوات في الرّئة هواء يصعد الى أن يصير الى الحلق فيديره اللسان على حسب مخارجه”([47])، وقالوا في موضع آخر “أبعد مخارج الحروف أقصى الحلق وهو ما يلي أعلى الصّدر والصّوت من الجسم في الرئة بيت الهواء”([48]). وقالوا في موضع آخر “إعلم أنّ الحروف اللفظيّة إنّما هي أصوات تحدث في الحلقوم والحنك، وبين اللسان والشفتين عند خروج النّفس من الرئة بعد ترويحها”([49])، وهو قول موافق لرأي المحدثين.
والمرحلة الثانيّة من مراحل إنتاج الصّوت اللغوي، هي تحريك الوترين الصّوتيين بفعل العضلات للدّاخل والخارج([50])، ولما كان اللغويون يطلقون الحلقوم على الحنجرة والحنجور ([51])، والحلق موضع الغلصمة والمذبح ([52])، اكتفى إخوان الصّفا بالإشارة إلى الحلقوم من دون ذكر أو الأوتار الصّوتيّة، إذ قالوا: “أصوات تحدث في الحلقوم والحنك”([53]).
والمرحلة الثالثة مرور الهواء خلال صناديق الرّنين أيّ: المرنات: وهي الأعضاء التي يمرّ بها الهواء([54])، ومن هذه المرحلة قال إخوان الصّفا وهم يتحدثون عن الكلام والقول: “تقطيع الصّياح بانضمام أجزاء الفم فتحدث منه حروف، كما تضم الشّفتين بنوع ما فتحدث الباء، وتضم بنوع آخر فتحدث الميم، وكل هذه الأصوات إنّما هي قرع يحدث في الهواء من صادم الأجسام”([55])، وقالوا في موضع آخر “اعلم أنّ هذه الأحرف لا تحدث إلاّ بارسال النّفس المستنشق من الهواء وإرساله، وقطع اللسان لها في مخارجها ومجاريها”([56]). وفي كل ما تقدّم هم يتحدثون عن مخارج الأصوات من دون ذكر للمرنات.
وصف النّظام الصّوتي العربي: ذكر إخوان الصّفا عدد حروف اللغة العربيّة وقالوا عنها: أنّها ثماني وعشرون حرفًا([57])، والصّواب أنّ أصوات الحروف العربيّة تُصنّف إلى نوعين:
- الأصوات المصروفة (أو الصّافة) ثمانية وعشرون حرفًا.
- الأصوات غير المصروفة([58])، (المدّ) ثلاثة حروف.
مخارج الحروف العربيّة وصفاتها: ذكر سيبويّه ستة عشر مخرجًا للحروف العربيّة ([59])، في حين ذكر الخليل تسعة مخارج([60])، وقد اتبع سيبويه ترتيب الخليل في وصف الأصوات بدءًا من الحلق حتى الشفتين([61])، والحال اليوم يبدأ من الشّفتين إلى الحلق ما يكون أسهل في الرؤية. أمّا إخوان الصّفا فقد قالوا: “لأنّ النّطق لا يكون إلاّ في صوت يخرج من مخرج يمكن تقطيعه بالحروف التي إذا خرجت عن صفة الحروف إمكان اللسان الصّحيح نظمها ووزنها فتخرج مفهومة باللغة المتعارفة بين أهلها”([62])، وقد أشاروا إلى الحنجرة بقولهم: “وأبعد مخارج الحروف أقصى الحلق”([63])، وقالوا أصل الأصّوات في الرّئة هواء يصعد إلى أن يصير إلى الحلق، فيديره اللسان على حسب مخارجه فإنّ خرج على حروف مقطعة مؤلفة، عرف معناه. يسمى نطقًا”([64])، وقالوا: “إنَّ هذه الأحرف لا تحدث إلّا بإرسال النّفس المستنشق من الهواء وإرساله وقطع اللسان لها في مخارجها ومجاريها”([65])، وبذلك يبدو أنّهم أدركوا المقصود من مخارج الأصوات.
الصّوت والحروف: قال إخوان الصّفا وهم يتحدثون عن الأصوات اللغويّة: “الحروف اللفظيّة إنّما هي أصوات تحدث بالحلقوم والحنك، وبين اللسان والشفتين، وخروج النفس من الرئة”([66]). وقالوا: “النّطق: لا يكون إلّا في صوت يخرج من مخرج يمكن تقطيعه بالحروف”([67])، وقالوا عن النّطق اللفظي: “هو ألفاظ مؤلفة من الحروف المعجمة”([68])، وقالوا: “اللفظ: كل صوت له هجاء”([69])، و”الكلام: كل لفظ يدل على معنى”([70]). وفي كل ما تقدم إشارة إلى أنّ الأصوات اللغويّة، وهذا يعني أنّهم كانوا يدركون الفصل بين الأصوات اللغويّة والرّموز أو الحروف الخطيّة أو حروف الهجاء([71])، والدّليل على ذلك قولهم “الحروف اللفظيّة هي أصوات محمولة في الهواء”([72]).
الإدغام: من صور المماثلة التي أشار اليها الخليل بن أحمد الفراهيدي الإدغام ([73])، وهو عند المحدثين “ضرب من التأثير الذي يقع في الأصوات المتجاوزة إذا كانت متماثلة أو متجانسة أو متقاربة”([74]). ويقسم تأثير الأصوات نوعين:
- تأثير مدبر (Regressive) وفيه يتأثر الصّوت الأوّل بالثاني.
- وتأثير مقبل (Progressive) وفيه يتأثر الصّوت الثاني بالأوّل.
والإدغام عند القدماء هو اللفظ بحرفين حرفًا كالثاني مشددًا([75])، وقد أشار إخوان الصّفا إلى ذلك في معرض حديثهم عن الحروف المقطعة في بداية بعض سور القُرآن الكريم إذ قالوا “أربعة عشر حرفًا تدغم فيها لام التّعريف وهي… التاء، الثاء، والدال، والذال، والراء، والسين، والشين، والصاد والضاد والطاء والظاء، واللام، والنون”([76]).
المبحث الثاني: دراسات لغويّة
تمهيدًا لدراساتنا اللغويّة لابُدَّ من البحث عن تعريف اللغة، إذ قال المحدثون: اللغة “نظام من العلامات الاصطلاحيّة ذات الدّلالة الاصطلاحيّة”([77])، وهي تطابق (الكلام)([78]).
ويقصد بكلمة (العلامات): الأصوات الصّادرة عن جهاز النطق.
أمّا إخوان الصّفا فقد قالوا: “النّطق اللفظي… يعبّر به كل إنسان عما في نفسه من المعاني لغيره من النّاس السّائلين عنه والمخاطبين له”([79])، وبهذا فضل الإنسان على غيره من الحيوان([80])، وقالوا: “والغرض من الكلام تأدية المعنى وكلّ كلام لا معنى له فلا فائدة للسامع منه والمتكلم به، وكل معنى لا يمكن أن يعبّر عنه بلفظ ما في لغة ما فلا سبيل إلى معرفته”([81])، وفي ذلك إشارة إلى الدّلالة التي من دونها يعزُّ التّعبير ويصبح الكلام لغوًا.
مصطلحات ثلاثة: اللغة – اللسان – الكلام.
من يدرس ما كتبه دوسوسير Saussure يجده يفرق بين ثلاث مفاهيم، فهو يرى أن هنالك كيانًا عامًّا يضمُّ النّشاط اللغوي الإنساني، في صورة ثقافة منطوقة، أو مكتوبة، معاصرة أو متوارثة وباختصار كل ما يمكن أن يدخل في نطاق النّشاط اللغوي من رمز صوتي أو كتابي، أو إشارة أو اصطلاح، فخص هذا النشاط بكلمة Langage أي: اللغة([82]). أقوال: في الرّسالة الحادية والثلاثين من رسائل إخوان الصّفا تحدثوا عن علل اختلاف اللغات، ورسوم الخطوط والعبارات إذ قالوا: إنَّ معرفة علل اللغات والكلام والأصوات ورسوم الخطوط والكتابات… لا تكون إلّا بعد البيان والإيضاح عن الأصل التي تفرعت عنه هذه الأمور التي ذكرناها([83]).
وحينها تحدثوا عن معرفة أصوب الأصوات الأرضيّة والأصوات المفهومة والأصوات غير المفهومة([84]). أمّا الأصوات الدّالة فهي كالكلام والأقاويل التي لها جاء في أي لغة كانت وبأي لفظ قيلت. وأطالوا الشّرح حتى بلغوا قولهم: “إنَّ المعاني في الكلام كالأرواح والفاظها أجساد لها فلا سبيل لقيام الأرواح إلّا بالأجساد([85])، وبهذا قد لا نغادر الحقيقة إذ قلنا إنّهم شرحوا المقصود بـ(اللغة) وإن لم يصطلحوا في كلامهم بهذا المصطلح.
اللسان: النّظر إلى اللغة في صورة منظمة ذات قواعد وقوانين وذات وجود اجتماعي يطلق عليها Langue يقابلها بالعربيّة: (اللسان)([86]). أمّا إخوان الصّفا فقد أطلقوا مصطلح (لغة) على اللهجة؛ وهي ما تقابل اللسان إذ قالوا: “وصار لكلّ قبيلة من قبائل العرب لغة يعرفون بها، وكلام ينسب اليهم ويتميزون به من غيرهم”([87])، كذلك قالوا: “واختلفوا في أسماء الأشياء حتى صار الشّيء الواحد من الموجودات في لغة العرب أسماء كثيرة يعرف بها ويشار إليه بها كلها، ولذلك صار علم اللغة العربيّة من العلوم الكبار”([88]). وبهذا اتضح أن مصطلح كلام تعني في ما تعنيه اللهجة ولعل المراد من كلمة (اللسان) فضلًا عن اللغة.
الكلام: وعندما يكون الكلام في “صورة ممارسة فردية منطوقة، على أي مستوى يطلق عليها Parole وهو بالعربية الكلام”([89]). والحقّ أن المصطلح الأخير وبالدّلالة التي أشار إليها دوسوسير Saussure لم أجد لها ما يقترب منها في رسائل إخوان الصّفا إلّا في دائرة الكلام.
دائرة الكلام([90]): تحت عنوان (موقع اللغة من حقائق اللسان) “قال دي سوسير Saussure إذا أردنا أن نفصل من مجموعة العناصر التي تؤلف اللسان، تلك التي تعود إلى اللغة العربيّة وجب علينا أن نفحص الفعل الفردي الذي يمكن أن يستخدم في إعادة بناء الدائرة الكلامية”([91])، ثم قال: “فمثل هذا الفعل يحتاج إلى وجود شخصين في الأقل، وهذا أقل عدد يقتضيه اكتمال الدّائرة لنفرض أنّ شخصين أ، و ب، يتحدثان إلى بعضهما”([92])، وأفترض أنّ بداية الدّائرة في دماغ (أ) “حيث ترتبط الحقائق الفكريّة بما يماثلها من الأصوات اللغويّة التي تستخدم للتعبير عن هذه الأفكار”([93]). وحينها “الفكرة المعيّنة تثير الصورة الصّوتيّة التي ترتبط بها، وهذه الظاهرة السايكولوجيّة تتبعها عمليّة فسلجيّة”([94])، حينها “يرسل الدماغ إشارة مناسبة للصورة إلى الأعضاء المستعملة لإنتاج الأصوات فتنتقل الموجات الصّوتيّة من فم الشّخص (أ) إلى أذان الشّخص (ب) وهذه عملية فيزياويّة محضة”([95]). وعندها “تستمر الدّائرة عند الشّخص (ب) ولكن بأسلوب معكوس إذ تسير الإشارة من الأذان إلى الدّماغ، وهو إرسال فسلجي للصورة الصّوتيّة، ويحصل في الدّماغ الربط السايكولوجي بين الصورة والفكرة”([96])، في المقابل “إذا تكلم الشخص (ب) بدأ من جديد من دماغه إلى دماغ الشّخص (أ) متبعًا خط السير نفسه الذي سار فيه الفعل الأوّل([97])، ولكي نتعرف إلى طبيعة الفكر اللغوي عند إخوان الصّفا علينا أن نقارن بين ما أسلفنا من فكر المحدثين وبين مقالة إخوان الصّفا.
دائرة الكلام عند إخوان الصّفا: قال إخوان الصّفا في فصل تحت عنوان (في ما يختصر بالقوة النّاطقة من الأفعال): “إنَّ من شأن القوة الناطقة إذا استعانت بها القوّة المفكرة في النيابة عنها في الجواب، والخطاب أن تؤلف الفاظًا من حروف المعجم بنغمات مختلفة السّمات التي هي الكلام، ثم تضمن تلك الألفاظ المعاني التي هي مصورة عند القوة المفكرة، فتدفعها عند ذلك إلى القوّة المعبرة لتخرجها إلى الهواء بالأصوات المختلفة في اللغات لتحملها إلى مسامع الحاضرين بالقرب، فتكون تلك الألفاظ المؤلفة من الحروف المختلفة الأشكال والسّمات كالأجساد المركبة من الأعضاء المختلفة وتكون تلك المعاني المضمنة في تلك الألفاظ كالأرواح لها”([98]).
وأرى أن من يقارن بين دائرة الكلام عند المحدثين، ودائرة الكلام عند إخوان الصّفا يجد أنّ هناك تقاربًا إذا ما علمنا أن إخوان الصّفا ربطوا بين عمليّة النّطق وبين القوة المتخيّلة والمفكرة والحافظة والنّاطقة([99])، المعروفة بالقوى الرّوحانيّة، وما يهمنا هو أنّ الفكرة تحفظ في القوة الحافظة لتحفظها إلى وقت التّذكار ثم أنّ من شأن القوة النّاطقة التي مجراها على اللسان إذا أرادت الأخبار عنها والأنباء عن معانيها والجواب عن معلوماتها ألقت لها ألفاظًا من حروف المعجم، وجعلتها كالسّمات لتلك المعاني… وعبّرت عنها للقوة السّامعة من الحاضرين([100]).
علم المنطق اللغوي: يجد المتتبع لإشارات إخوان الصّفا أنّ هناك كمًّا من الأفكار اللغويّة ذات الأهمّيةّ البالغة مبثوثة في ثنايا الرّسائل منها قولهم: “الصّوت المخصوص به الإنسان، فإنّه يقال له كلام ولفظ متكلم كقول القائل: فلان يتكلم بالعربيّة والفارسيّة والرّوسيّة وغير ذلك”([101])، في إشارة إلى أنّ الكلام أو اللفظ المتكلم يقابل مصطلح اللغة، وفي موضع آخر قالوا: “النطق اللفظي: هو الفاظ مؤلفة من الحروف المعجمة”([102])، وفي ذلك إشارة إلى الرّموز الصّوتيّة التي يعبّر بها الناس عن أغراضهم وفي موضع آخر تحدثوا عما سموه علم المنطق اللغوي، إذ قالوا: “إنَّ المنطق مشتق من نطق ينطق نطقا، وأنطق فعل من أفعال النفس الإنسانية وهذا الفعل نوعان: فكري ولفظي، فالنطق اللفظي أمر جسماني محسوس، والنطق الفكر أمر روحاني معقول”([103])، ثم فصلوا القول عن النّطق اللفظي إذ قالوا: “إنَّ النّطق اللفظي: إنّما هو أصوات مسموعة لها هجاء، وهي تظهر من اللسان الذي هو عضو من الجسد، وتمرُّ إلى المسامع من الأذان التي هي أعضاء من أجساد آخر، وأنّ النّظر في هذا المنطق والبحث عنه والكلام على كيفيّة تصاريفه وما يدل عليه من المعاني، يسمى علم المنطق اللغوي”([104])، ولما قالوا: “اللفظ: كلّ صوت له هجاء”([105])، وقالوا: “الكلام: كلّ لفظ يدل على معنى”([106]). يتضح مما تقدم أنّهم أدركوا المقصود من اللغة بل ووضعوا مفهوماً لعلم المنطق اللغوي وكأنّهم كانوا يؤسسون لتعريف علم اللغة، “وهو العلم الذي يبحث في اللغة، ويتخذها موضوعًا له، فيدرسها من النّواحي الوصفيّة، والتّاريخيّة، والمقارنة، كما يدرس العلاقات الكائنة بين اللغات المختلفة، أو بين مجموعة من هذه اللغات، ويدرس وظائف اللغة وأساليبها المتعددة، وعلاقتها بالنّظم الاجتماعيّة المختلفة”([107])، والحقّ أنّهم بحثوا معظم موضوعات علم اللغة كما سيتضح من نصوصهم لاحقًا.
الحاجة إلى اللغة: أوضح إخوان الصّفا الحاجة إلى اللغة بقولهم: “أعلن أيّها الأخ أنّه لو أمكن النّاس أن يفهم بعضهم من بعض المعاني التي في أفكار نفوسهم، من غير عبارة اللسان لما احتاجوا الى الأقاويل التي هي أصوات مسموعة”([108])، وبيّنوا أهمّيّة التّعبير اللغوي بقولهم “ولا يدري المرء ما عند كل واحد منها من العلوم إلّا ما عبر كل انسان عما في نفسه لغيره من أبناء جنسه، ولا يمكنه ذلك إلّا بأدوات وآلات مثل اللسان والشفتين…)([109]).
الفكر واللغة: قال إخوان الصّفا: “إنّ من شأن القوّة المفطرة أن تنظر الى ذاتها وتراها معاينة وتتروى فيها وتميزها، وتبحث عن خواصها ومنافعها ومضارها، ثم تؤديها الى القوّة الحافظة لتحفظها الى وقت التذكر”([110]) وبعد ذلك تحدثوا عن القوّة الناطقة وعلاقتها بالقوّة المفكرة قالوا: “ثمَّ إنّ من شأن القوّة النّاطقة التي مجرها على اللسان، إذا أرادت الإخبار عنها والإنباء عن معاينها والجواب للسّائلين عن معلوماتها ألّفت لها ألفاظًا من حروف المعجم وجعلتها كالسّماء لتلك المعاني التي في ذاتها، وعبّرت عنها للقوة السّامعة من الحاضرين”([111]) ولك أن تتصور السّبق الذي ميّز فكر إخوان الصّفا في هذا الموضوع، عندما تقرأ ما كتبه المحدثون وعلى سبيل المثال قول أحدهم: “حركة التّفكير في الإنسان ذات ارتباط وثيق اللغة بل إنّ الإنسان لا يستطيع أن يفكّر إلّا إذا صاغ عناصر فكره في قوالب لغويّة، وترجمها الى رموز لغويّة”([112]).
اللغة المنطوقة والمكتوبة والصلة بينهما: صنف إخوان الصّفا الحروف الى ثلاثة أنواع فكريّة وخطيّة؛ فالفكريّة: “هي صورة روحانيّة في أفكار النّفوس مصورة في جواهرها قبل إخراجها معانيها بالألفاظ”([113]) والحروف اللفظيّة: “هي أصوات محمولة في الهواء، فمدركة بطرق الأذنين بالقوة السّامعة”([114]) والخطيّة: “هي نقوش خطت بالأقلام في وجوه الألواح وبطون الطوامير، مدركة بالقوة الباصرة بطريق العينين”([115]) ثم قدّروا أنّ الحروف هي رموز إذا قالوا :”واعلم أنّ الحروف الخطيّة إنّما وضعت سمات ليستدل بها على الحروف اللفظيّة، والحروف اللفظيّة وضعت سمات ليستدل على الحروف الفكريّة، والحروف الفكريّة هي الأصل، إنّ الكلام لفي الفؤاد وإنّما جعل اللسان على الفؤاد دليلًا. ولزيادة البيان توضيح المقصود نشير إلى أنّ لكلّ حرف صوت ورمز واسم ففي اللغة العربيّة على سبيل المثال: صوت مهموس احتكاكي (رخو) ينطق بأن تتصل الشّفة السفلى بالأسنان العليا اتصالًا لا يسمح للهواء أن يمرّ بينهما؛ فيحتك بها مع رفع مؤخر الطبق لسدّ التّجويف الأنفي من دون أن يهتز مع الوترين الصّوتيين، ونظيره في اللغات الأوروبيّة الصّوت المجهور (V) وفي الانكليزي (W) في الألمانيّة. ذلك الصّوت رمزه (ف)، اسمه الفاء، رموز الكلمة عندما تكتب تسمى اللغة المكتوبة، وقد أشار إخوان الصّفا الى ذلك بقولهم: “يعبر عن تلك الصور المتخيّلة في ضميره بألفاظ مؤدية عنها، ثم يقيد تلك الألفاظ برسوم من الكتابة دالة على تلك الألفاظ، دلالة الألفاظ على تلك الخواطر، دلالة الخواطر على أعيان الأشياء وحقائقها ومعانيها”([116])، ولكون اللغة المكتوبة رموز فإنّهم يقولون: إنّ الإنسان “عند نظره الى الخطوط والكتاب، يفهم ما يتضمنها من معاني الكلمات والعبارات”([117]) وبينوا مراحل التّعلم بقولهم: “واعلم أنّ فهم القراءة والكتابة ومعرفتها متأخرة عن فهم الكلام والأقاويل، ومعرفتها إنّما هي متأخرة عن فهم المحسوسات”([118]). وعللوا سبب وجود الكتابة بقولهم: “لما كانت الأصوات لا تمكث في الهواء إلّا ريثما تأخذ المسامع حظها، ثمَّ تضمحل، اقتضت الحكمة الإلهيّة والعناية الرّبانيّة، واحتالت الطبيعة بأن قيّدت تلك الألفاظ بصناعة الكتابة”([119]). وأردفوا عللًا لذلك بقولهم:”ليبقى العلم مفيدًا فائدة من الماضين للغابرين، وأثرًا من الأوّلين للاخرين وخطابًا من الحاضرين للغائبين، وهذه من جسم نعم الله”([120]).
نشأة اللغة: في فصل معرفة بداية الحروف
قالوا: “اعلم أنّ الله تعالى لما خلق آدم عليه السّلام الذي هو أبو البشر ومبدؤه، جعله ناطقًا متكلمًا فصيحًا ميّزًا بالقوّة المناطقة”([121]). وبما أنّ الله قد ميّزه عن الجماد والحيوان إذ جعله “قائمًا ناطقًا متكلمًا معلمًا مفهمًا عاقلًا حكيمًا”([122]) لكونه خليفة الله، وقد “نُفِخ فيه من روح قدسه، وأيّده بكلمته، وعلمه الأسماء كلها وصفات الأشياء كلّها”([123]) وفي مقالاتهم تلك هم على نهج معظم اللغوين في عصرهم، إلَّا أنّهم تميزوا بقولهم:”وجمع له هذه الأشياء، كلّها صغيرها وكبيرها، جليلها وحقيرها في تسع علامات بأشكال مختلفة مسماة بأسماء قد جمعت أسماء الموجودات جميعها… وهذه الحروف هي التي علَّمها الله (I) آدم (ص) وهي التي يستعملها أهل الهند على هذه الصفة”([124])، وبهذا تهيأ لهم أن آدم (ص) “كان بهذه الحروف يعرف أسماء الأشياء كلّها وصفاتها على ما هي عليه وبه موجود من أشكال هماتها، ولم يزل كذلك إلى أن كثر أولاده وتكلّم بالسّريانية”([125])، وقولهم هذا بحاجة إلى دليل وبحث مستقل([126]).
الخاتمة: بعد رحلة في سطور رسائل إخوان الصّفا؛ اتضح أنّ إخوان الصّفا أدركوا الطّبيعة الفيزيائيّة للصوت، بل كانت لهم ملاحظات بشأن الأصوات اللغويّة بدءًا بجهاز النّطق وصولًا الى عدد الحروف، والفرق بين الصّوت والحرف وأشاروا الى الإدغام بين الحروف الشّمسيّة واللام غير أنّهم جانبوا الصّوت عند الحديث عن دور اللسان في إنتاج بعض الأصوات. ولعل المهم ما يفلت الانتباه في الدّراسات اللغويّة، هو معرفتهم بأهمّيّة اللسان والكلام في إحداث اللغة أو ما يعرف بدائرة الكلام. كذلك اعتمادهم مصطلح علم المنطق اللغوي، وبيان المقصود منه كذلك إشارتهم الى أهمّيّة اللغة في نقل الأفكار. ولولا أنّ آلية البحث تتطلب الاختصار لتوسع البحث الى أفكار أخرى مفيدة، أملنا أن يساهم الباحثون في مواصلة دراسة البحوث اللغوية الواردة في الرّسائل من خلال توظيف الدراسات الحديثة للوصول الى حقائق تخدم طلبة ومن الله التوفيق.
الهوامش:
– وزارة التربيّة – مديرية تربية بغداد – الكرخ الثالثة. [1]
Ministry of Education – Baghdad Education Directorate – Karkh 3.Email: alaamufaq999@gmail.com
[1]– إخوان الصفا، هم أشخاص عديدون من مختلف الفئات والطبقات من دون تحديد الأسماء. ومؤلفون الرسائل، ذكر أسماء في بعض المصادر. انظر: رسائل أخوان الصفاء وخلان الوفا، ط1، بيروت، الدار الاسلامية، 1412هـ: 1/5 التوحيدي، ابو حيان (ت414هـ)، الامتاع والمؤانسة، ط1، بيروت، المكتبة العصرية، 1323هـ: 162-163. البيهقي، ابو الفضل ظهير الدين علي بن زيد (ت 565 هـ)، تتمة صوان الحكمة، ط2، دمشق، المجمع العلمي العربي، 1976م: 21.
[2]– بصرف النظر عن موفقنا من أفكارهم الفلسفيّة.
[3]– بعنوان (البحث اللغوي عند اخوان الصفا) ط1، مصر، مطبعة الامانة، 1411ه-1991م نشأة اللغة: ص36.
[4]– ينظر: كامل، الدكتور مراد، علم الأصوات، نشأته ونطوره، مجله مجمع اللغة العربية، ج6، لسنة 1963: 75.
[5]– أبو الفرج، الدكتور محمد احمد، مقدمة لدراسة فقه اللغة: 122.
[6]– المرجع نفسه: 123.
[7]– ينظر: السعران، الدكتور محمود، علم اللغة، مقدمة للقارئ العربي، دار المعارف بمصر، 1962م: 2120216.
[8]– مقدمة لدراسة فقه اللغة: 123.
[9]– رسائل اخوان الصفا: 1/188.
[10]– المصدر نفسه: 1/189.
[11]– المصدر نفسه: 3/95.
[12]– عبدالله، الدكتور عبد الجبار، علم الصوت، ط1، بغداد، مطبعة العاني، 1955م: 1.
[13]– يصطلح على دراسة الصوت فيزياويا بـ(علم الصوت) أو (الصوتيات) وهو (العلم الذي يبحث فيه عن الظواهر المتعلقة بحدوث الصوت، وانتقاله، وانعكاسه، وانكساره، وتداخله، وقياس، وما أشبه ذلك).
(مصطلحات في علم الصوت) من وضع مجمع اللغة العربية المصري. مجلة اللغة العربية، الجزء العشرون، لسنة 1966، ص303.
[14]– علم الصوت، الدكتور عبد الجبار عبدالله: 1.
[15]– علمن الصوت: 14.
[16]– المصدر نفسه: 14.
[17]– رسائل: 2/ 407.
[18]– رسائل: 2/ 407.
[19]– أبو الفرج، الدكتور محمد أحمد، مقدمة لدراسة فقه اللغة، ط1، بيروت، دار النهضة العربية، 1966: 122.
[20]– ينظر: مقدمة لدراسة فقه اللغة: 122.
[21]– رسائل: 2/ 392.
[22]– ج. منذر يس، اللغة، ترجمة، عبد الحميد الدواخلي، ومحمد القصاص، ط1، مصر، 1950م: 43.
[23]– رسائل: 3/ 114.
[24]– المصدر نفسه: 3/ 114.
[25]– ابن منظور، محمد بن مكرم افريقي، دار صادر، مادة حنجر، 1955م.
[26]– رسائل: 3/ 114.
[27]– المصدر نفسه: 1/ 403.
[28]– المصدر نفسه: 2/ 407.
[29]– المصدر نفسه: 3/ 330.
[30]– المصدر نفسه: 2/ 385.
[31]– عبد التواب، الدكتور رمضان، مدخل إلى فقه اللغة العربية، ط1، مكتبة الخانجي بالقاهرة، دار الرفاعي بالرياض، 1403هـ – 1982م: 116.
[32]– رسائل: 3/ 330.
[33]– المصدر نفسه: 3/ 330.
[34]– المصدر نفسه: 3/ 330.
[35]– ينظر: انيس، الدكتور ابراهيم، الأصوات اللغوية، ط5، دار وهدان للنشر والتوزيع 1979م: 43.
[36]–الصالح، الدكتور صبحي، دراسات في فقه اللغة، ط7، بيروت،، دار العلم للملايين، 1978: 279.
[37]– المرجع نفسه: 278.
[38]– المصدر نفسه: 280.
[39]– ماريو باي، أسس علم اللغة ترجمة، الدكتور أحمد مختار عمر، منشورات جامعة طرابلس، كلية التربية، 1973م: 96.
[40]– جان كانتينو، دروس في علم أصوات العربية، ترجمة، صالح القرمادي، مركز الدراسات والبحوث الاقتصادية والاجتماعية، تونس، 1966: 191.
[41]– ينظر: مزبان، علي حسن، فصول في علم اللغة، جامعة صنعاء، كلية التربية صحة: 43.
[42]– رسائل: 3/ 101.
[43]–المصدر نفسه: 3/ 114.
[44]– المصدر نفسه: 3/ 114.
[45]– رسائل إخوان الصفا: 1/ 197.
[46]– ينظر: شحاته، الدكتور مصطفى احمد، لغة الهمس، الهيئة المصرية للكتاب، 1972م: 42-43؛ اما المرحلة الثانية فهي مرحلة تأثير الاصوات في الهواء الذي ينقلها من المتكلم الى السامع؛ والمرحلة الثالثة مرحلة ادراك الاصوات. انظر ابو الفرج: 122
[47]– رسائل: 3/114.
[48]–المصدر نفسه: 3/114.
[49]– المصدر نفسه: 1/393.
[50]– لغة الهمس: 42- 43.
[51]– ينظر: لسان العرب: 4/ 173، مادة حجر.
[52]– ينظر: المصدر نفسه: 10/ 58، مادة حلق.
[53]– رسائل: 1/ 393، 3/ 103.
[54]– لغة الهمس: 43.
[55]– رسائل: 2/ 407.
[56]– المصدر نفسه: 3/ 330.
[57]– ينظر: المصدر نفسه: 3/ 378.
[58]– خضير، موفق عليوي، الدراسات الصوتية في كتاب العين في ضوء علم اللغة الحديث، رسالة ماجستير، كلية الآداب، الجامعة المستنصرية 1406هـ- 1985م: 65، 122.
[59]– ينظر: سيبويه، الكتاب، طبعة مصورة عن طبعة بولاق الأولى، 1316هـ: 2/ 405.
[60]– الفراهيدي، الخليل بن أحمد، العين، تحقيق: الدكتور مهدي المخزومي والدكتور ابراهيم السامرائي، بغداد، وزارة الثقافة والاعلام، 1980م: 1/ 57- 58.
[61]– الكتاب لسيبويه: 2/ 405.
[62]– رسائل:3/ 101.
[63]– المصدر نفسه: 3/ 114.
[64]– المصدر نفسه: 3/ 114.
[65]– المصدر نفسه: 3/ 330.
[66]– المصدر نفسه: 1/ 392.
[67]–رسائل: 3/ 101.
[68]– المصدر نفسه: 1/ 391.
[69]– المصدر نفسه: 3/ 397.
[70]– المصدر نفسه: 3/ 397.
[71]– لمعرفة المزيد عن الحروف والأصوات ينظر: الدكتور هادي نهر، الحروف والأصوات العربية في مباحث القدماء والمحدثين، مجلة آداب المستنصرية: 4/ 8، 1404هـ- 1984م: 207- 260.
[72]– رسائل: 1/ 391.
[73]– الفراهيدي، العين.
[74]– أنيس، الدكتور ابراهيم، في اللهجات العربية، ط2، مطبعة لجنة البيان العربي، 1952: 60.
[75]–ابن الجرزي، ابو الخير محمد بن محمد الدمشقي، النشر في القراءات العشر، تصحيح ومراجعة علي محمد، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع: 1/ 274.
[76]– رسائل: 3/ 381.
[77]– السعران، علم اللغة: 66.
[78]– شاهين، د. عبد الصبور، في علم اللغة العام: 27.
[79]– رسائل: 1/ 392.
[80]– ينظر: المصدر نفسه: 3/ 105.
[81]– المصدر نفسه: 3/ 108- 109.
[82]– شاهين: 29.
[83]– ينظر: رسائل: 3/ 84- 85.
[84]– ينظر: المصدر نفسه: 3/ 101.
[85]– ينظر: المصدر نفسه: 3/ 109.
[86]– ينظر: شاهين: 29.
[87]– رسائل: 3/ 152.
[88]– رسائل: 3/ 152.
[89]– شاهين: 29.
[90]– ينظر: المصدر نفسه: 39.
[91]– فردينان دي سوسير، علم اللغة العام، ترجمة، د. يوئل يوسف عزيز، مراجعة، د. مالك يوسف المطلبي، 91 سلسلة آفاق عربية، 1985: 29.
[92]– شاهين: 30.
[93]– المصدر نفسه: 30.
[94]– المصدر نفسه: 30.
[95]– دي سوسير: 30.
[96]– المصدر نفسه: 30.
[97]– المصدر نفسه: 30.
[98]– رسائل: 3/ 244، في النص أعلاه نجد صورة من صور علم اللغة عند المحدثين، ينظر: شاهين: 29.
[99]– رسائل: 2/ 414.
[100]– ينظر: المصدر نفسه: 2/ 414- 415.
[101]– المصدر نفسه: 3/ 113.
[102]– رسائل: 1/ 391.
[103]– المصدر نفسه: 1/ 392.
[104]– رسائل: 1/ 392.
[105]– المصدر نفسه: 3/ 397.
[106]– المصدر نفسه: 3/ 397.
[107]– عبد التواب، الدكتور رمضان، المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي، المقدمة.
[108]– رسائل: 1/ 402.
[109]– المصدر نفسه: 1/402.
[110]– رسائل: 2/411.
[111]– المصدر نفسه: 2/415.
[112]– شاهين، د. عبد الصبور، في علم اللغة العام: 95.
[113]– رسائل: 1/392.
[114]– المصدر نفسه: 1/392.
[115]– رسائل: 1/392.
[116]– المصدر نفسه: 1/12.
[117]– المصدر نفسه: 3/413.
[118]– رسائل: 3/413.
[119]– المصدر نفسه: 2/415.
[120]– المصدر نفسه: 3/245.
[121]– المصدر نفسه: 3/141.
[122]– المصدر نفسه: 3/141.
[123]– المصدر نفسه: 3/141.
[124]– رسائل: 3/141
[125]– المصدر نفسه : 3/142.
[126]– لمعرفة المزيد عن بداية نشأة اللغة انظر: البحث اللغوي عند اخوان الصفا: 36.
المصادر
- ابن الجرزي، ابو الخير محمد بن محمد الدمشقي، النشر في القراءات العشر، تصحيح ومراجعة علي محمد، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع.
- ابن منظور، محمد بن مكرم افريقي، دار صادر، مادة حنجر، 1955م.
- أبو السعود أحمد الفخراني، البحث اللغوي عند اخوان الصفا، ط1، مصر، مطبعة الامانة، 1411هـ-1991م .
- أبو الفرج، د. محمد أحمد، مقدمة لدراسة فقه اللغة، ط1، بيروت، دار النهضة العربية، 1966.
- انيس، د. ابراهيم، الأصوات اللغوية، ط5، دار وهدان للنشر والتوزيع 1979م.
- أنيس، د. ابراهيم، في اللهجات العربية، ط2، مطبعة لجنة البيان العربي، 1952.
- البحث اللغوي عند اخوان الصفا: 36
- البيهقي، ابو الفضل ظهير الدين علي بن زيد (ت 565 هـ)، تتمة صوان الحكمة، ط2، دمشق، المجمع العلمي العربي، 1976م
- التوحيدي، ابو حيان (ت414هـ)، الامتاع والمؤانسة، ط1، بيروت، المكتبة العصرية، 1323هـ.
- ج. منذر يس، اللغة، ترجمة، عبد الحميد الدواخلي، ومحمد القصاص، ط1، مصر، 1950م.
- جان كانتينو، دروس في علم أصوات العربية، ترجمة، صالح القرمادي، مركز الدراسات والبحوث الاقتصادية والاجتماعية، تونس، 1966.
- خضير، موفق عليوي، الدراسات الصوتية في كتاب العين في ضوء علم اللغة الحديث، رسالة ماجستير، كلية الآداب، الجامعة المستنصرية 1406هـ- 1985م.
- رسائل اخوان الصفاء وخلان الوفا، ط1، بيروت، الدار الاسلامية، 1412هـ.
- السعران، د. محمود، علم اللغة، مقدمة للقارئ العربي، دار المعارف بمصر، 1962م.
- سيبويه، الكتاب، طبعة مصورة عن طبعة بولاق الأولى، 1316هـ.
- شاهين، د. عبد الصبور، في علم اللغة العام.
- شحاته، د. مصطفى احمد، لغة الهمس، الهيئة المصرية للكتاب، 1972م
- الصالح، د. صبحي، دراسات في فقه اللغة، ط7، بيروت،، دار العلم للملايين، 1978.
- عبد التواب، د. رمضان، المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي.
- عبد التواب، د. رمضان، مدخل إلى فقه اللغة العربية، ط1، مكتبة الخانجي بالقاهرة، دار الرفاعي بالرياض، 1403هـ – 1982م.
- عبدالله، د. عبد الجبار، علم الصوت، ط1، بغداد، مطبعة العاني، 1955م.
- الفراهيدي، الخليل بن أحمد، العين، تحقيق: د. مهدي المخزومي ود.ابراهيم السامرائي، بغداد، وزارة الثقافة والأعلام، 1980م.
- فردينان دي سوسير، علم اللغة العام، ترجمة، د. يوئل يوسف عزيز، مراجعة، د. مالك يوسف المطلبي، 91 سلسلة آفاق عربية، 1985.
- كامل، د. مراد، علم الأصوات، نشأته ونطوره، مجله مجمع اللغة العربية، ج6، لسنة 1963.
- ماريو باي، أسس علم اللغة ترجمة، الدكتور أحمد مختار عمر، منشورات جامعة طرابلس، كلية التربية، 1973م.
- مزبان، علي حسن، فصول في علم اللغة، جامعة صنعاء، كلية التربية.
- مصطلحات في علم الصوت، من وضع مجمع اللغة العربية المصري. مجلة اللغة العربية، الجزء العشرون، لسنة 1966.
- نهر، د. هادي، الحروف والأصوات العربية في مباحث القدماء والمحدثين، مجلة آداب المستنصرية، 1404هـ- 1984م.