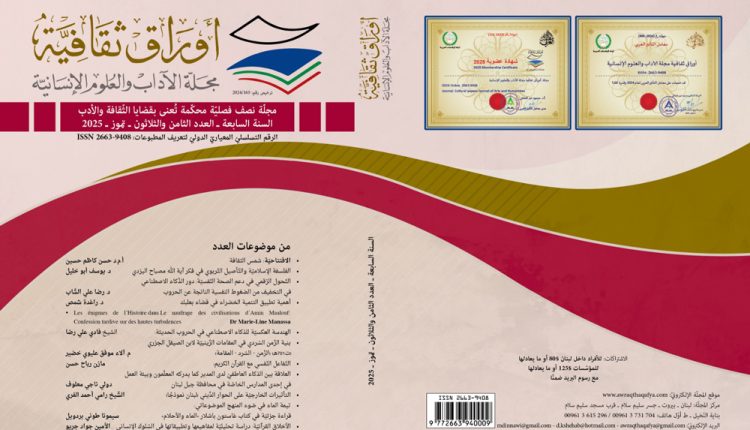عنوان البحث: الفلسفة الإسلاميّة والتّأصيل التّربوي في فكر آية الله مصباح اليزدي
اسم الكاتب: د. يوسف أبو خليل
تاريخ النشر: 2025/07/16
اسم المجلة: مجلة أوراق ثقافية
عدد المجلة: 38
تحميل البحث بصيغة PDFADOI: https://aif-doi.org/awraq/013811
الفلسفة الإسلاميّة والتّأصيل التّربوي في فكر آية الله مصباح اليزدي
Islamic philosophy and educational foundations in the thought of Ayatollah Mesbah Yazdi
Dr. Youssef Abou Khalilد. يوسف أبو خليل)[1](
تاريخ الإرسال: 3-6-2025 تاريخ القبول: 15-6-2025
ملخص
شغل آية الله محمد تقي مصباح اليزدي (1935/2021) مكانة بارزة في الفكر الإسلامي المعاصر، خاصةً في مجالي الفلسفة الإسلاميّة والتربية. يُعدّ اليزدي من أبرز الشّخصيات التي سعت إلى ربط الأصول الفلسفيّة الإسلاميّة بالجوانب التربويّة والعمليّة، مقدمًا رؤية متكاملة تهدف إلى بناء الفرد والمجتمع على أسس إسلاميّة راسخة.
لم تكن فلسفة اليزدي مجرد أبحاث نظريّة، بل كانت دائمًا موجهة نحو التأصيل التّربوي والعملي. يمكن ملاحظة ذلك في عدة جوانب:
* التربية العقائديّة: ركز اليزدي على بناء عقيدة صحيحة ومتينة لدى الأفراد، عادًّا ذلك الأساس لكل تربية سليمة.
* التربية الأخلاقيّة: أولى اليزدي أهمّية قصوى للتربية الأخلاقيّة، مستندًا إلى الفلسفة الإسلاميّة التي تربط بين المعرفة والعمل. وقد أكد دور الأخلاق في بناء شخصية متوازنة وقادرة على أداء دورها الإيجابي في المجتمع.
* التربية السياسيّة والاجتماعيّة: لم يغفل اليزدي الجوانب السياسيّة والاجتماعيّة للتربيّة، مؤكدًا ضرورة تربية الأفراد على تحمل المسؤولية تجاه المجتمع والدولة الإسلامية. وقد كان له دور فعال في التأسيس لبعض المؤسسات التربويّة والبحثيّة في إيران التي تُعنى بهذه الجوانب.
* منهجيّة التّعليم: دعا اليزدي إلى منهجيّة تربويّة قائمة على أهمّيّة التفكير النّقدي، والاستدلال العقلي في فهم المعارف الدّينيّة والفلسفيّة، بدلًا من الاكتفاء بالتّقليد الأعمى.
يمثل فكر آية الله مصباح اليزدي نموذجًا حيًا للتكامل بين الفلسفة الإسلاميّة والتأصيل التربوي. لذلك يمكن القول إنّه كان من الفلاسفة المسلمين الكبار الذي لا يمكن لأي باحث في الفلسفة الإسلاميّة أن يتجاوزه. وسأحاول في هذا المقال الإضاءة على الفلسفة التربوية عنده.
الكلمات المفتاحيّة: اليزدي، الفلسفة، التربية، التأصيل، فلسفة التربية الإسلاميّة.
Summary
Ayatollah Mohammad-Taqi Mesbah-Yazdi (1935–2021) occupied a prominent position in contemporary Islamic thought, particularly in the fields of Islamic philosophy and education. He is considered one of the most significant figures who sought to link Islamic philosophical foundations with educational and practical dimensions, offering a comprehensive vision aimed at building both the individual and society on firm Islamic principles.
Mesbah-Yazdi’s philosophy was not merely theoretical research but was always directed toward educational and practical application. This is evident in several aspects:
- Doctrinal Education: Mesbah-Yazdi emphasized the importance of building a sound and strong belief system in individuals, considering it the foundation for any proper education.
- Moral Education: He gave great importance to ethical training, relying on Islamic philosophy that connects knowledge with action. He stressed the role of ethics in shaping a balanced personality capable of playing a positive role in society.
- Political and Social Education: He did not overlook the political and social dimensions of education, stressing the need to raise individuals to be responsible toward their society and the Islamic state. He played an active role in establishing some educational and research institutions in Iran that focus on these aspects.
- Educational Methodology: Mesbah-Yazdi advocated for an educational approach based on critical thinking and rational reasoning in understanding religious and philosophical knowledge, rather than relying solely on blind imitation.
The thought of Ayatollah Mesbah-Yazdi represents a living model of the integration between Islamic philosophy and educational grounding. Thus, it can be said that he was one of the major Muslim philosophers whom no researcher in Islamic philosophy can overlook. This article aims to shed light on his educational philosophy.
Keywords: Mesbah-Yazdi, philosophy, education, grounding, Islamic philosophy of education.
مقدمة
تمتاز العلوم الإنسانيّة عن باقي العلوم الأخرى، بصعوبة تعريف مفاهيمها وغاياتها، سواء أكانت هذه المفاهيم فلسفيّة أو اجتماعيّة أو تربويّة، ولا يوجد اتفاق ما بين العلماء على تعريف واحد لها، والاختلاف ينشأ من تعدد نظرتها للإنسان الذي هو موضوع هذه العلوم، وتعدد مدارسها ومذاهبها الفلسفيّة، بل من تعدد الآراء حتى داخل المذهب الواحد، فمثاليّة أفلاطون مثلا تختلف عن مثاليّة كانط وهيجل و…
وينشأ الاختلاف في تعريف الفلسفة، بحسب الرؤية الكونيّة للوجود، فمثلا نرى اختلافًا شديدًا بين الماديّة (Materialism) والمثاليّة (Idealism) وكذلك باقي الفلسفات الأخرى، فالماديّة تنطلق من فكرة أصالة المادة، أمّا المثاليّة، فتبني كل نظرياتها على أصالة العالم المفارق للمادة، وعن الفرق بين المبادئ الفلسفيّة بين مختلف المذاهب، يقول آية الله مصباح عن الفلسفة الماديّة:”لا سبيل لإثبات تلك الأمور المعنويّة مستقلة عن الأمور البدنيّة الماديّة، لأنّهم لا يقولون بشيء وراء المادة، فالمعنويات عندهم أمور لا أصالة لها بالنسبة إلى المادة فإذا قالوا بالأمور المعنويّة يفترضونها كأمور فرعيّة للبدن وللحياة المادية”([2]). يعني الأصالة عندهم للمادة وكل شيء يتفرع عنها. ومن هنا نجد أنّ الاختلاف بين المدرسة الإسلاميّة والمادية يبدأ من الأسس الفلسفيّة لكلتا المدرستين.
فلا يمكن أن نجد أي علم من العلوم لا سيما العلوم الإنسانيّة والاجتماعيّة والتربويّة، إلّا أن يكون متولدًا من رحم فلسفي ورؤية كونيّة فلسفيّة. لأنّها ستكون منطلقًا ومبدأ لمختلف هذه العلوم. وقد يصل الاختلاف في تعريف المفاهيم الفلسفيّة، إلى حد تصبح فيه مجرد مشترك لفظي بين المدارس الفلسفيّة المتعددة.
وما يجري على الفلسفة، ينسحب على باقي العلوم الإنسانيّة كالتربيّة والسياسة والاجتماع و… لذلك نجد هذا التّفاوت بين التّعريفات المختلفة للتربيّة، وتعريف التربية يعود أصلًا إلى أصول موضوعة أو مسلمات نشأت من الرؤى الكونية لكل مذهب أو مدرسة فلسفيّة، فالتربية لا تأتي إلّا مع قيد وهدف، التربية على إعداد الإنسان ليكون…، ومن هنا ينشأ الاختلاف في تعريف الفلسفة، وتعريف الإنسان بالإضافة إلى الأهداف التربويّة التي يجب استخراجها. فمنهم من يريد أن يربي الإنسان لسوق العمل، ومنهم من يركز على الجانب الاخلاقي، والرؤية الدّينيّة تنظر إلى الإنسان ببعديه الروحي والمادي… وعن انطلاق العمليات التربويّة من الفلسفة الإسلاميّة يقول العلامة مصباح اليزدي:” ومن الطبيعي أن نظام التعليم والتربية الإسلاميّة مبني أيضًا على مجموعة من الأسس الخاصّة التي تنبثق من الرؤية الإسلاميّة… وانطلاقًا مما سبق ذكره، ينبغي ـ قبل تسليط الضوء على نظام التعليم والتربية الإسلاميّة ـ تركيز الاهتمام على هذه الأسس، ثم يتم في ضوئها بيان الأصول العمليّة للتعليم والتربية من وجهة نظر الإسلام.”([3])
وفي زيارته الأخيرة للبنان، وفقنا الله إلى اللقاء به، وكنا حينها نعمل على إنجاز وثيقة تربوية قائمة على الفكر الإسلامي الأصيل، وبعد سؤاله عن كيفيّة استخراج المباني والأصول التربويّة من الفلسفة الإسلامية، كان جوابه كالآتي:” الارتكاز إلى الفكر الإسلامي الأصيل مبدأ ومنشأ لكل العلوم الإنسانيّة في مختلف الميادين والساحات العلميّة”.
- المذاهب الفلسفيّة (الإيسم ism) والتربية
عندما نقول: المثاليّة، فإنّ (ية) الياء والتّاء المربوطة يُعبَّر عنها بالإنكليزيّة (ism)، بمعنى مذهب، فنقول :
– Idealism: المثاليّة
– Materialism: المادّيّة.
هذه (ism) إنّما تُشير إلى مدارس فلسفيّة كبرى والّتي بدورها لديها رؤية متكاملة على المستوى الوجوديّ (الأنطولوجيّ)، والإبستمولوجيّ (المعرفيّ)، وعلى مستوى القِيَم([4]).
فيما يتعلّق بـ”الماديّة Materialism”؛ وفي علم الوجود ontology، فإنّ لها رؤية وجوديّة تؤمن أنّ الوجود هو المادّة والعالم الطبيعي فقط، وكل حديث عن عالم مفارق ومجرد، ليس له واقعيّة، حسب رأيهم، هو من صنع الخيال الإنساني.
وفي البحث الابستمولوجي epistemology أي علم المعرفة، ونتيجة لرؤيتها الأنطولوجيّة أيضًا، فهي تقول إنّ المعرفة، هي معرفة حسيّة مستمدة من التّجربة والعالم المادي حصرًا، وبما أنّ المعرفة حسية، وبالتالي هي معرفة نسبيّة تتغير بتغيّر المعطيات الماديّة، وبالتالي لا يوجد في المدرسة الماديّة معرفة وعلم بالمطلقات أو ما يعرف بالبديهيات واليقينيات العقليّة التي تأتي من عالم مفارق.
أمّا بخصوص علم القيم أو الاكسيولوجيا Axiology، فالقِيَم هي قِيَم مادّيّة نسبيّة متغيرة مستمدّة من المادّة والمجتمع المُعاش، وتتعلّق بالزّمان والمكان، وتتغير بتغيرهما. وهذا ما نشاهده اليوم في المجتمعات الغربيّة التي تغيّرت فيها القيم، فعلى سبيل المثال، لقد كان الشّذوذ الجنسي أو ما يعرف بالمثليّة الجنسيّة، مرفوضًا في المجتعات الغربيّة حتى سبعينيات القرن الماضي، أمّا اليوم وبعد المصادقة القانونيّة عليها في الولايات المتحدة الأميركيّة وعدد من الدول الغربيّة، أضحى الشّذوذ قيمة إنسانيّة يجب الدّفاع عنها، وعوقِبت الدّول التي لا تجيز الشّذوذ في مجتمعاتها، وللأسف أصبح الشّذوذ، قيمة إنسانيّة دخلت إلى وثائق الأمم المتحدة، وأصبحوا اليوم يروّجون لها في وثائقهم، لا سيما في البند الخامس من وثيقة التنمية المستدامة2030. ومن الجلي أنّ هذه التّشريعات لم تنطلق من أي رؤية دينيّة، بل من فلسفة أخذت بمباني أصول الفلسفات الماديّة التي أُلبِسَت لباس العلمانيّة التي لم تفصل الدين عن السياسة فقط، بل أخرجت الدّين عن الحياة الاجتماعيّة والاقتصاديّة و…
في مقابل المدرسة الماديّة، نجد أنّ المثاليّة “Idealism” هي مدرسة تؤمن بعالم المُثُل كما عند أفلاطون، ولم تولي انطولوجيّة افلاطون أهمية للعالم المادي، بل وسمته بعالم الوهم والخيال، وله وظيفة واحدة، هو التذكير بالعالم الحقيقي، وعالم الكليات، وهو العالم المفارق للمادة.
وبناء لهذه النظرة الأنطولوجيّة، نجد أنّ العلم الحقيقي هو العلم بالكليات؛ لأنّ كلّ معطيات الحسّ غير يقينيـّة ومتأرجحـة فـي حـين أنّ معطيات العقل يقينيّة وفوق الزّمان ولا تحد بمكان، لذلك لم نجد الأفلاطونيّة تولي اهتمامًا لغير العلوم العقليّة، واقتصرت التربية عندهم على الأبحاث النّظريّة، حتى أن فلاسفة عصر التنوير وما بعده، عدُّوا أنّ الأفلاطونيّة كان العامل الأساس في تأخير تطور العلوم التّجريبيّة لعدة قرون.
وعلى مستوى القيم، فالقيم الأفلاطونيّة، هي قيم ثابتة لا تتغيّر ولا تتبدل بتغير الزّمان والمكان، وذلك لأن منشأها عالم المثل وعالم الكليات وبالتالي ستكون هذه القيم مطلقة.
وتتجلى نظريّة أفلاطـون فـي فلسـفة الأخـلاق، عنـدما أكثـر مـن الحديث عن ضبط الرّغبة إلى اللـذات الحسـيّة، لا بـل التّرفـع عـن ما في هذه الدنيا من سـعادة ناتجـة عـن اللـذات الحسـيّة، والسّعي بتزكيـة النّفس، وإدامة الفكر والتّأمل للوصول إلى السّعادة الحقيقيـّة عبر الاتصـال بالعـالم الآخـر.
إذًا، وبناء على ما تقدم، فإنّ كل العلوم الإنسانيّة والتربويّة، أتت من نظرة فلسفيّة لحياة الإنسان؛ وعن أهميّة الفلسفة يقول العلامة الطباطبائي(ره): “إنّ الفلسفة هي أعم العلوم جميعًا، لأنّ موضوعها أعم الموضوعات وهو “الموجود” الشّامل لكل شيء، فالعلوم جميعًا تتوقف عليها في ثبوت موضوعاتها، وأمّا الفلسفة فلا تتوقف في ثبوت موضوعها على شيء من العلوم.”([5]) وبمعنى آخر، لا يمكن لأيّ علم إلّا أن يبدأ من الفلسفة، لا أن ينتهي اليها، كما فعل أصحاب الفلسفة الوضعيّة الذين قدموا العلوم التّجريبيّة على الفلسفة، لذلك جاءت فلسفتهم محكومة بالعلوم التّجريبيّة ومستمدة منها ومحكومة اليها.
أمّا في الأديان السماوية، فان المسيحيّة مثلا وبناء لرؤيتها الكونية، لا تنظر إلى الدّنيا بشكل أساس ولا تعيرها أهميّة؛ بل نظرتها تركز دائمًا على عالم الآخرة. فيما ارتكز الفكر اليهودي على أهمية الحياة الدنيا والسعي اليها.
أما النّظرة الإسلاميّة، اختلفت عن ما سبقها من الأديان السّماويّة، واتت بنظرة شموليّة أوسع منها. لأنّ النّظرة الإسلاميّة قدّمت نظرة متكاملة في مختلف الأبعاد الإنسانيّة، إذ إنّ الإسلام -كونه آخر الأديان- قد أنتج شريعة متكاملة. وبالتالي، لم يكن هذا موجودًا في الأديان السّماويّة الأخرى. فالإسلام لديه شريعة متكاملة تدعو إلى التوحيد، وأن تكون مختلف الأبعاد الإنسانيّة على مستوى السّياسة والاقتصاد والاجتماع مرتبطة بالله؛ أي إنّ للإسلام آيات شريفة وأحاديث وأحكام وشرائع، وهذه الشّرائع تتعلّق بكلّ الأبعاد الإنسانيّة والاجتماعيّة للفرد.
ومن هنا، ولاختلاف الرؤية الكونيّة بين الإسلام والمدارس الأخرى لا سيما العلمانيّة الحاكمة على كل العلوم التربويّة والنّفسيّة حاليًّا، نجد اختلافًا بنيويًا، ليس فقط في المناهج بل على المستوى الوجودي والابستمولوجي، وبالتالي سوف يكون هناك اختلاف كبير في المنظومة القيميّة، لأنّ القيم العلمانيّة لن يكون منشأها سوى التنشئة الاجتماعيّة التي تختلف بين مجتمع وآخر، وتتأثر بالزّمان والمكان، وهي نسبيّة متغيرة، في حين أن منشأ المنظومة القيميّة الإسلاميّة ينطلق من القيمة الأعلى للإسلام، وهو قيمة القرب (من الله) التي تجعل الإنسان يسير في طريق التكامل الإنساني والذي يشكل الرسول الأكرم (ص) والمعصومين (ع) الأسوة والقدوة لكل إنسان للسير في هذا التكامل، وقيمة القرب حسب الرؤية الإسلاميّة، تجعل من كل القيم الأخرى خادمة وتابعة لها. وعن أهميّة قيمة القرب من الله في التربية والمناهج التربويّة، يقول آية الله مصباح:” نظرًا إلى ضرورة الحياة الاجتماعيّة ومستلزماتها ومتطلّباتها، وكذلك ضرورة التمتّع المادّي لتوفير الاحتياجات الفرديّة والاجتماعيّة والحفاظ على عزّة وسيادة المجتمع الإسلامي، يتّضح لزوم ادخال العلوم الطبيعيّة والرياضيّة والاجتماعيّة ضمن المناهج الدّراسيّة، إذن يتعيّن على من يضطلعون بمهمة التخطيط والبرمجة أن يُدرجوا المناهج العامّة والتخصصية بدقّة كافية في المناهج الدّراسيّة مع الأخذ بالحسبان الشّروط العمريّة والذّهنيّة للمتعلمين وحاجات وإمكانيّات المجتمع. تجدر الإشارة إلى أنّه يجب في كل الحالات أن ينصبَّ التّركيز والاهتمام على الغاية الأساسيّة وهي التقرّب إلى الله تعالى. ولا ينبغي تفويت أيّة فرصة في سبيل إحياء الدّوافع الإلهيّة والقيم السّامية وكذلك محاربة الغفلة وهوى النفس. وبعبارة أخرى يجب جعل كل الأهداف مقدّمة للهدف النّهائي.”([6]) أي القرب من الله.
وعن علاقة الرؤية الفلسفيّة في التربية يضيف العلامة مصباح اليزدي:”يُبنى كل نظام تعليمي وتربوي على أساس رؤية ونظرة مؤسّسيه إلى حقيقة الإنسان وأبعاده الوجوديّة، وأيضًا وفاقًا للهدف أو للأهداف التي يبتغون تحقيقها من وراء التعليم والتربية، وكذلك انطلاقًا مما لديهم من اعتقاد في كيفيّة تطوّر الإنسان وحركته صوب الهدف المنشود. والحقيقة أن هذه الرؤى والنظرات هي التي تؤلّف أسس وأصول التعليم والتربية في كل نظام وإن كانت لا تحظى بالاهتمام عن وعي أو لا يُصَرَّح بها”([7]).
وفي السّياق نفسه، وفي تعريفه للثقافة، يقول آية الله المصباح:” يوجد معانٍ كثيرة للفظة “الثقافة” وربما تبلغ خمسمئة معنى على ما قيل لكن الأصل في معنى الثقافة حسبما نرى أو على الأقل حسبما نريد من هذه اللفظة أمرين أصيلين هما ركنان للثقافة أحدهما: العقيدة والرؤية الكونية والثاني: القيم والمثل العليا. وأحدهما يرجع إلى معرفة الواقعيات “الأمور الموجودة” والثاني يرجع إلى معرفة ما ينبغي أن يوجد، ما يجب على الإنسان أن يفعل، وما لا ينبغي. فيعبّر عن الأول بالعقيدة أو الرؤية الكونيّة وعن الثاني بالقيم.
فأساس الثقافة هذان الأمران، بهما تتميز ثقافة عن ثقافة أخرى، وإن كان يتعلق بالثقافة أمور فرعيّة مثل الآداب العرفيّة والكتابة واللغة وما إلى ذلك، لكن تغيّر هذه الأمور لا يُغيّر جوهر الثقافة.”([8])
والباحث عن المباني والأصول التربوية وفاق العلامة آية الله مصباح اليزدي، يجد أنّه قد وضع مباني نظريّة، وأصول عملية([9]) يمكن بيانها كالآتي:
- المباني النظرية والأصول العملية للتعليم والتربية في الإسلام
ولما تبين أنّ كلّ نظام تعليمي وتربوي يُبنى على أساس رؤية ونظرة مؤسّسيه إلى حقيقة الإنسان وأبعاده الوجودية، وأيضًا وفاقًا للهدف أو للأهداف التي يبتغون تحقيقها من وراء التعليم والتربية، وكذلك انطلاقًا مما لديهم من اعتقاد في كيفيّة تطوّر الإنسان وحركته صوب الهدف المنشود. لذلك، فإنّ هذه الرؤى والنّظرات هي التي تؤلّف مباني وأصول التعليم والتربية في كل نظام وإن كانت لا تحظى بالاهتمام عن وعي أو لا يُصَرَّح بها.
ومن الطبيعي أن نظام التعليم والتربية الإسلاميّة مبني أيضًا على مجموعة من المباني الخاصّة التي تنبثق من الرؤية الإسلاميّة للقضايا الآنف ذكرها. وانطلاقًا مما سبق ذكره، ينبغي ـ قبل تسليط الضوء على نظام التعليم والتربية الإسلاميّة ـ تركيز الاهتمام على هذه المباني والأسس، ثم يجري في ضوئها بيان الأصول العمليّة للتعليم والتربية من وجهة نظر الإسلام.
في ضوء الرؤية الإسلاميّة إلى حقيقة الإنسان وأَبعاده الوجوديّة، والهدف من خلقه، وكماله النهائي، وكيفيّة سيره نحو ذلك الكمال، يبيّن آية الله مصباح اثني عشر مبنى، يجب على المفكرين التّربويين الإسلاميين أن يعدُّوها أسسًا للتعليم والتربية الإسلاميّة. ومن الطبيعي أنّ الغاية من التعليم والتربية الإسلاميّة ليست إلا توفير الحياة الطيبة حسب الرؤية الإسلاميّة التي تحقق القرب من الله والى تكامل الإنسان.
المباني النظرية للتربية:
1ـ حقيقة الإنسان
لأنّ الإنسان هو موضوع التربية، فهو في الرؤية الإسلامية ليس مجرد كيان عضوي محسوس، بل ينطوي على مكوّنات مما وراء الطبيعة تبقى بعد فناء البدن([10]) وله بعد الموت حياة خالدة يعيش فيها السّعادة الأبديّة أو الشّقاء الأبدي. والحقيقة هي أنّ إنسانيّة الإنسان إنَّما تكون بروحه، وما بدنه إلا آلة تُتخذ للعمل، أو كمركب يُتخذ للسير والحركة. ولابد طبعًا من الاهتمام بسلامة وقوّة الآلة والمركب من أجل العمل والسير.
2ـ مكانة الإنسان في الكون
يتمتّع الإنسان من بين موجودات هذا الكون بمواهب إلهية وقابليات معيّنة تميّزه عن سائر المخلوقات، كالدقّة التي تتصف بها اعضاؤه الظاهريّة والدّاخليّة خاصة الدّماغ والجهاز العصبي، وما لديه من قدرات روحيّة خاصّة لا مثيل لها في سائر الكائنات الحيّة. وهذه هي الخصائص التي تتيح له التصرّف في ظواهر الطبيعة جميعها وتسخيرها في سبيل رقيّه. وان منح هذه المزايا للإنسان يُعد نوعًا من التكريم التّكويني الالهي له. وهو ما أشير إليه في القرآن الكريم([11]).
3ـ الإنسان على مفترق طريقين (عليه الاخيتار بينهما)
الطاقات والاستعدادات التي منحها الله للإنسان تُعدّ مؤهلات تكوينيّة وفطريّة لحركته نحو الغاية النّهائيّة. غير ان تسخير هذه المؤهلات رهين بارادته واختياره وانتخابه. فهو يستطيع أن يحسن الاستفادة من هذه النعم ويسخّرها في طريق تكامله الحقيقي، ليطوي هذا الطريق وينال السّعادة الأبديّة. ويمكنه أيضًا ان يُسيء استغلالها بما ينتهي به إلى التدني والانحطاط إلى درجة يغدو فيها أضلّ من الحيوان([12])؛ فيشتري بذلك الشقاء الأبدي لنفسه.
وفي ضوء ذلك يمكن تصوّر مسير الإنسان وكأنّه بين طريقين لا نهاية لهما، يعرج به أحدهما نحو الكمال والسّعادة الأبديّة، وينتهي به الآخر نحو الشقاء والعذاب الأبدي([13]). إذًا قيمة الإنسان وكرامته النّهائيّة رهينة باختياره لطريق التقوى([14]). ومن الطبيعي أنّه لن تكون لكلّ الناس قيمة مطلقة ومتساوية، بل سيكون لأهل الإيمان والعمل الصالح قيمة إيجابيّة، وسيكون لأهل الكفر والعصيان قيمة سلبيّة، وسيكون لكل واحدة من هاتين القيمتين مراتب مختلفة([15]).
4ـ الهدف من خلق الإنسان (الكمال النهائي)
لقد خُلِق الإنسان بهذه المؤهّلات الخاصّة من أجل أن يطوي طريق تكامله بإرادة حرّة واختيار واع ([16])، ويكسب الأهليّة لإدراك الفيوضات الخاصة التي تُفاض في ظل الحركة الاختياريّة، والوصول إلى مقام القرب الإلهي المقرون بالسّعادة الأبديّة. ولكن بما أنّ هذه الحركة وهذا السير يجب أن يأتي بشكل اختياري، فلابد من وجود مسير آخر في الجهة المخالفة لهذا السّير ينتهي به إلى الشّقاء والعذاب الأبدي([17]).
5ـ الدّنيا مقدّمة الآخرة
يتّضح من خلال النّظر إلى الغاية من خلق الإنسان بأنّ حياته في الدّنيا ليست إلّا مرحلة محدودة، وتمهيديّة لبناء ذاته وتنمية استعداداته وتحويلها إلى الفعليّة، والنتيجة الثابتة والأبديّة التي تتمخّض عن ذلك تظهر في عالم الآخرة. فاذا ما اختار الإنسان في هذه الدّنيا طريق الكمال، فسينتهي به المطاف إلى دار النّعيم والرّحمة الأبديّة. وأمّا إذا اختار الاتجاه المضاد له فسينتهي إلى دار العذاب والهلاك الأبدي. وحسب تعبير القرآن الكريم فانّ الدنيا «دار ابتلاء» ([18]) لتمييز الصالحين من المفسدين ولينال كل إنسان في عالم الآخرة ما يستحقّه.
6ـ الوسيلة العامة للحركة
تتحقق حركة الإنسان نحو الكمال والسّعادة، أو انحداره في هاوية السّقوط والهلاك، بأعماله وسلوكه الدّاخلي (كذكر الله) والخارجي. وكلّما جاءت هذه الأعمال باختيار أتمّ وحريّة أكثر يكون لها تأثير أشد وتساهم في تعجيل الحركة. وبصرف النّظر عن القيام بمثل هذه الأعمال لا يتحقق أي خير وشر أخلاقي، ولا يحصل أي استحقاق للثواب أو العقاب([19]).
7ـ شروط الحركة الاختياريّة
ينبثق السّلوك الاختياري للإنسان ـ وهو الذي يمثّل تبلور حركته التّكامليّة أو التّنازليّة ـ من ميوله وتوجّهاته الغريزيّة والفطريّة. وتوجيهها يتوقّف على ما لدى المرء من علوم ورؤى واعتقاد بقيم معيّنة([20]). وإضافة إلى ذلك، فإنّ النشاطات الظاهريّة للإنسان تتطلب مستلزمات طبيعيّة واجتماعيّة، وتوفّر ظروف وأسباب خارجيّة أيضًا.
8ـ حدّ النصاب في الاختيار المؤثّر
ينبثق السّلوك الابتدائي للإنسان (مثلما هو الحال في مرحلة الرضاعة) من الميول الغريزيّة والمعارف المكتسبة من تجارب بسيطة، ومن خلال الظروف الماديّة التي تتهيأ له بغير اختيار منه. وليس لمثل هذا السّلوك ـ وإن كان لا يخلو من نوع من الاختيارـ تأثير مصيري في سعادته الأبديّة أو شقائه الأبدي؛ لأنّه لا يملك الحريّة والوعي الكافي. إلّا أنّ السّلوك يأخذ بالتعقيد شيئًا فشيئًا، وتدخل الدّوافع والميول وتوفّر العلوم والرؤى وكذلك الأسباب والظروف الخارجيّة في دائرة اختيار الشخص، وتوفّر له الأجواء من أجل أن يسير خطوات أوسع ومصيريّة، وذلك عندما يبلغ الرّشد العقلاني اللازم (عهد البلوغ والتكليف). وهنا يتحقق حدّ نصاب الاختيار الواعي والمؤثر في السّعادة الأبديّة أو الشّقاء الأبدي، ويكون الشخص عندها في موضع المسؤولية الجادّة([21]).
9ـ العلاقة بين أنواع التّفاوت ودرجات المسؤوليّة
بنو الإنسان غير متساوين في ما حباهم الله من عطايا ومواهب (سواء أكانت في القوى البدنيّة أو القدرات الرّوحيّة)، مثلما هم متفاوتون في ما لديهم من نعم طبيعيّة واجتماعيّة وأسباب ومستلزمات النشاطات الخارجيّة. وهذا التّفاوت ناجم عن نظام العليّة والمعلوليّة السّائد في الكون ويجري بتدبير الهي حكيم([22]).
وتبعًا لهذا التفاوت يختلف حجم وكيفيّة المسؤوليات وسعة وضيق ميدان التكامل أو التنزّل.
والقاعدة العامّة في هذا المضمار هي أنّ كلّ شخص مسؤول أمام الله الذي منحه هذه النِّعم على قدر استعداده وقدرته([23])، وفي حدود مجال اختياره([24])، ويكون مدى ترقّيه وتكامله معادلًا وموازنًا لمدى انحطاطه وهبوطه.
10ـ تأثير التعليم والتربية (دور المعَلِّم والمربّي)
بميسور الإنسان الاستعانة بالآخرين لكسب العلوم والرؤى ومعرفة القيم، ولنقل استعداداته ـ بشكل عام ـ من القوة إلى الفعليّة؛ وتصحيح وتقويم أخطائه وانحرافاته. ومن هنا يتضح مدى أهمية المعَلِّم والمربّي؛ لأنّه هو الذي يستطيع من خلال تعليم الأشياء المفيدة والمعارف القيّمة، توسيع مديات المعرفة والتعقّل لدى المتعلّم([25]). ويمكنه أيضًا مساعدة المتعلّم على الاختيار الصحيح والتغلّب على أهوائه النّفسيّة وكسب الملكات الفاضلة كالإيثار والتّضحيّة، وبكلمة واحدة، يساعده على السّير في السّبيل الذي أراده له الله، وذلك عن طريق تعليمه القيم السامية وإثبات أفضليّتها على الميول والأهواء الدنيئة، وتعريفه بسبل التّحكم بالغرائز وتهذيبها. وهكذا فهو يغدو وسيلة قيّمة لتحقيق الغاية الإلهيّة من خلق الإنسان، مع ما يتضمّنه ذلك من السير خطوات كبرى على طريق تكامله([26]).
11ـ ضرورة الحياة الاجتماعيّة ومتطلّباتها
لا بدّ للإنسان من التّعاون والتّعايش مع أبناء جنسه من أجل مواصلة حياته وتوفير مستلزماتها ومجابهة شتّى المخاطر التي تهدده. ومن الطبيعي أنّ انتظام الحياة الاجتماعيّة يتوقّف على تقسيم العمل والتّوزيع العادل للمنافع والمنتجات، ووجود القوانين والقرارات والأجهزة الكفيلة بتنفيذها. ومن غير ذلك تضطرب الحياة الاجتماعيّة وتسودها الفوضى، ويُحرم أفراد المجتمع من الإمكانات اللازمة لحركتهم التّكامليّة. كما أنّ انعزال الأفراد وتقوقعهم على أنفسهم يجعل الحياة عسيرة عليهم أو متعذّرة أحيانًا، ويُحرم المجتمع من نشاطهم وعطائهم. وكلا هذين الأمرين خلاف للمصلحة والحكمة من خلق الإنسان. وأساسًا تتيسّر النّشاطات ومختلف أنواع التعاطي في ظل الحياة الاجتماعيّة، وبها تتوفر الأجواء المناسبة للاختبار والاختيار في مختلف الجوانب([27]).
12ـ المسؤوليات الاجتماعيّة
نظرًا إلى أن طريق حياة الإنسان يتفرع إلى فرعين، وتعيين اتجاه السير رهين باختيار الأفراد والجماعات، فمن الطبيعي أن يوجد هناك على الدوام من يسيرون ـ خلافًا لمصلحتهم الشّخصيّة ـ نحو الشّقاء والهلاك، وليس هذا فحسب، بل يخلقون أيضًا مشاكل وعراقيل لغيرهم ويمارسون الظلم والجور والعدوان على الآخرين. وإذا لم يُتّخذ إجراء مؤثر لنصح وإرشاد الضالّين([28]) وإزالة شر الظالمين وحماية المحرومين والمظلومين، فلن يمضي وقت طويل حتّى يمتلىء العالم كلّه ظلمًا وفسادًا، ولا يبقى ثَمّة مجال لرقي وتكامل الخيّرين وذوي الاستعداد([29]). وهكذا تثبت أنواع من المسؤوليات الاجتماعيّة على الأفراد والجماعات والمؤسسات الرّسميّة.
الأصول العمليّة للتعليم والتربية من وجهة نظر الإسلام[30].
بناءً على الأسس التي سبق ذكرها (في الأسس النّظريّة للتعليم والتربية في الإسلام)، يمكن استخلاص عدد من النتائج العامة في مجال كيفيّة التعليم والتربية، سميّناها بـ«الأصول العمليّة للتعليم والتربية»، وهي كالآتي:
1ـ التقييم الصحيح للمتطلّبات المادية والمعنوية
ينبغي أن يكون مضمون التّعليم والتربية وسلوك المربي شاملًا؛ فيصبح ناظرًا ومدركًا لأصالة البُعد الروحي والمعنوي للإنسان، وينظر دومًا إلى المتطلبات المادية كأداة ووسيلة (وليس كهدف)([31]). وفي الوقت نفسه ينبغي اجتناب الإفراط في النّصائح والإرشادات التي تدعو إلى الزّهد وتؤدّي إلى اضطرابات بدنيّة أو تؤدّي حتّى إلى اضطرابات نفسيّة، وينبغي عدم تجاهل الالتزام بالتّعاليم الصحيّة والتربية البدنيّة والترفيه المعقول.
2ـ تحفيز مشاعر الكرامة والاعتزاز بالنّفس
نظرًا إلى المكانة التي خُصَّ بها الإنسان بين المخلوقات، والنِّعم الإلهيّة التي منَّ الله بها عليه ـ سواء البدنيّة منها والنفسيّة، أو النِّعم الخارجيّة والاجتماعيّة ـ وما حباه من سيطرة على الطبيعة وهيمنة عليها، لا بدَّ – عند تعليمه- من تحفيز مشاعر الكرامة والعزّة لديه، ولابدّ من إفهامه أنَّ اقتراف الأعمال الرّذيلة تدنيس لجوهر إنسانيّته، وأنّ الانقياد لأهواء النفس يعني استعباد وإذلال عقله وروحه الملكوتية([32]). وعلى صعيد آخر، نظرًا إلى أنّ أعضاء بدنه وقواه النّفسيّة كلّها أمانة إلهية عنده ـ كما هو حال النِّعم الخارجيّة ـ فلا بدَّ أن يكون التعامل معها واستخدامها بشكل يرضي صاحبها الحقيقي وهو الله تعالى، لكي لا تكون هناك خيانة في هذه الأمانة. وكذلك يتعيّن على المعَلِّم والمربّي ان ينظر إلى المتعلّمين كأمانة إلهية أُودعت لديه، ويجب عليه أن يعلّمهم أسمى العلوم وبأفضل الأساليب ويربّيهم أحسن ما تكون التربية([33]).
3ـ محاربة الغفلة
بما أن الإنسان يقف على الدّوام عند مفترق طريقين يقودها أحدهما نحو غاية الرقي بلا نهاية، وينتهي به الآخر نحو غاية الانحطاط بلا نهاية، فلا بدَّ أن يتركّز التعليم على تبيين خطورة موقفه لكي لا يغتر بالتكريم الإلهي الابتدائي وبالنِّعم الدّنيويّة([34]). ولا يظن ـ كما يظن بعض القائلين بأصالة الإنسان ـ أن هذا مدعاة لفخره الأبدي، وعليه أن لا يقضي حياته بالغفلة والبطالة([35]). وينبغي تسخير غريزة حب المنفعة وحب الكمال واجتناب الضرر المودعة في فطرة كل إنسان، في سبيل التّعجيل بحركته التّكامليّة، مثلما هو مشهود في تعاليم القرآن الكريم([36])، وسُنّة المعصومين(عليهم السلام).
4ـ إحياء ذكر الله
بما أنّ الهدف من خلق الإنسان هو الوصول إلى القرب الإلهي، فمن الواجب إحياء ذكر الله في قلب المتعلّم لكي تتوفر له السكينة النّفسيّة([37])، ولكي يجعله كالبوصلة لتعيين وتصحيح مسيره، وأن يضفي على أعماله قيمة أيضًا من خلال إعطائها دافعًا إلهيًا([38]).
5ـ استبدال اللامتناهي بالمتناهي
نظرًا إلى أنّ الدّنيا مقدّمة للآخرة، فلابدَّ من استخلاص نتيجتين مهمَّتين من ذلك: الأولى عدم إعطاء أولويّة أو أصالة لملذّات الدنيا وآلامها؛ لكي لا تبهره طيّباتها ولا تُرهبه آلامُها([39]).
والثانية: أن يدرك القيمة الحقيقيّة لساعات ولحظات عمره، إذ يمكنه نيل السعادة الأبديّة عن طريق قضائها في أعمال ترضي الله، ويمكنه انفاقها في الرذائل؛ فينتهي به الحال إلى الشقاء الأبدي. وهذا يعني أنّ قيمة لحظة واحدة من العمر لا تقاس بأرطال من الذهب والجواهر.
6ـ محاربة التطفّل
بما أنّ الكمال والسعادة الأبدية للإنسان لا تتحقق إلا بعمله الاختياري([40])، وحتى الشّفاعة أيضًا لا بدّ أن ينالها بالعمل الصّالح([41])، إذًا فلا بدَّ من استنهاض نزعة الاندفاع الذاتي والمبادرة الذاتيّة واستقلال الشّخصيّة لديه، وتقوية روح الشّعور بالمسؤوليّة والالتزام فيه، ومحاربة مافيه من روح الاتكاليّة والتطفّل والاعتماد على الآخرين([42])، مع التنبيه إلى هذه الملاحظة في كل سلوك وتصرّف يمارسه المعلّم مع المتعلّمين (كما في حالة اداء التكاليف والواجبات المدرسيّة….)
7ـ الاهتمام بالحرية في الاعمال والممارسات
انطلاقًا من أهمية «حرية الاختيار» في حركة الإنسان التكامليّة، لا بد من إعطاء المتعلم حريّة العمل والممارسة، وعدم صياغته بشكل حلقة فاقدة للإرادة، مع السّعي إلى أن لا تتصف التعاليم والايحاءات بطابع الضغط والإكراه. وفي الحالات التي تقتضي فيها مصلحة المتعلّم تدخّل المعَلِّم والمربّي، ينبغي الحرص على أن لا يكون هذا التدخل مباشرًا فلا يشعر المتعلم بضغط أو تقييد، وأن يكون مقرونًا بالاستدلال المنطقي جهد الإمكان، ولا يتعدى حدود الإرشاد والتوجيه.
8ـ رعاية مبدأ التدرّج
نظرًا إلى تدرّج سير الإنسان في تطوّره وتكامله الطبيعي والاكتسابي، فعلى المعَلِّم والمربّي أن يأخذ بالحسبان على الدّوام مقتضيات المراحل العمريّة والعوامل الطبيعيّة والاجتماعيّة، ويسعى لكي يتدرج المتعلّم خطوة بعد خطوة بهدوء وتأن، وأن لا يتوقّع منه طفرات سريعة ومفاجئة، وأن يمنع بتدبير عقلاني حتّى إفراط المتعلّم في عمله الدّراسي أو تهذيب ذاته مما يُحتمل منه إضعاف بدنه أو إصابته بأضرار نفسيّة([43]).
9ـ المرونة والاعتدال
نظرًا إلى وجود جوانب كثيرة من التّفاوت على الصعيد الفردي والجماعي، لا بدّ من جعل المرونة اللازمة والمعقولة نصب العين سواءً عند وضع المناهج أو عند تطبيقها، مع اجتناب الإصرار على تطبيق مناهج وبرامج جافّة وذات وتيرة واحدة وبشكل متساو على المتعلّمين جميعهم إذ يؤدّي ذلك إلى طمس حقوق وخيبة الكثير منهم. وعلى كل الأحوال يجب أن يتّخذ الاعتدال أصلًا ومبدءًا في العمليّة التربويّة.
10ـ ترجيح الأكثر أهمّيّة
نظرًا إلى أهمية دور المعَلِّم والمربّي في تنشئة وإعداد الناشئة من المتعلّمين وانضاج استعداداتهم، يجب أن يضع المعَلِّمون والمربّون وخاصّة المسؤولون عن وضع الخطط والمناهج، نصب أعينهم مسؤوليتهم الخطيرة هذه، مع الاهتمام الدّقيق بمصلحة كل واحد من المتعلّمين، وكذلك مصالح المجتمع الإسلامي بل وحتى مصالح المجتمع البشري، واجتناب وضع أو تطبيق الخطط والمناهج أو المواد التي تؤدّي إلى اهدار الوقت وتضييع العمر، أو إذا لم تكن ذات قيمة مهمّة بالمقارنة مع مصالح أسمى. وأن يركّزوا من بين الدّروس على ما له تأثير أكبر في السعادة الأبديّة (كالعقائد والأخلاق الإسلاميّة) وتدريسها بشكل يجعلها محبوبة ومرغوبة أكثر في النّفس، وأن يحرصوا على أن يكونوا هم أنفسهم نماذج صالحة يقتدي بها المتعلّمون.
11ـ العلوم الطبيعيّة والاجتماعيّة
نظرًا إلى ضرورة الحياة الاجتماعيّة ومستلزماتها ومتطلّباتها، وكذلك ضرورة التمتّع المادّي لتوفير الاحتياجات الفرديّة والاجتماعيّة([44]) والحفاظ على عزّة وسيادة المجتمع الإسلامي([45])، يتّضح لزوم إدخال العلوم الطبيعيّة والرياضيّة والاجتماعيّة ضمن المناهج الدّراسيّة، إذن يتعيّن على من يضطلعون بمهمة التّخطيط والبرمجة أن يُدرجوا المناهج العامّة والتخصصيّة بدقّة كافية في المناهج الدّراسيّة مع الأخذ بالحسبان الشّروط العمريّة والذّهنيّة للمتعلمين وحاجات المجتمع وإمكانيّاته. تجدر الإشارة إلى أنّه يجب في كل الحالات أن ينصبَّ التركيز والاهتمام على الغاية الأساسية وهي التقرّب إلى الله تعالى. ولا ينبغي تفويت أيّة فرصة في سبيل إحياء الدّوافع الإلهيّة والقيم السامية وكذلك محاربة الغفلة وهوى النّفس. وبعبارة أخرى يجب جعل كل الأهداف مقدّمة للهدف النهائي.
12ـ تقوية الشعور بالمسؤولية ازاء المصالح الاجتماعية
إن وجود أنواع المسؤوليات الاجتماعيّة يتطلب توجيه جهاز التّعليم والتربية نحو الاهتمام بالمجتمع وحب الآخرين. وأن يُركَّز سواء عند إعداد مضامين الدّروس، أو في تعامل المعَلِّمين والمربّين مع المتعلّمين، على تقوية خصال التّعاون والتّضامن والإيثار والتّضحية ونكران الذات وحبّ الخير للآخرين وحب العدالة، إلى جانب مكافحة صفات الأنانيّة و”اللا أبالية” إزاء المصالح الاجتماعيّة مكافحة شديدة([46])، وأن يجري تأكيد وجه الخصوص على غرس روح البسالة ومحاربة الظلم ومجاهدة ومقارعة الجبابرة والمفسدين وحماية المظلومين والمحرومين لدى المتعلمين لأجل تنشئة عناصر صالحة وفاعلة لبناء المجتمع المنشود، وقادرة على الاضطلاع بدورها في تحقيق الهدف الإلهي([47]).
الخاتمة
وفي الختام لا بدَّ من الإشارة إلى أنّنا في مركز الأبحاث والدّراسات التربويّة، قد عملنا لعدة سنوات على إعداد وثيقة تربوية قائمة على الفكر الإسلامي، وضعت المباني والأصول التربوية، في الأبعاد والسّاحات الإنسانيّة العشرة (البعد الإيماني، الجهادي، السياسي، الاجتماعي، البيئي، العلمي، الاقتصادي، الجمالي، العلمي، الإداري)، بالإضافة الى الأهداف والسياسات العامة، ويعمل الآن على تطبيقها في مؤسسات تربويّة إسلاميّة في لبنان، وذلك عبر الاستفادة القصوى مما أُنجز في الجمهوريّة الإسلاميّة في إيران، ومن المؤلفات العلميّة القيمة لآية الله مصباح، ومما أُنجز تحت إشرافه، نذكر مثلا المباني الفلسفيّة للتربية والتعليم في الجمهوريّة الإسلاميّة في إيران التي أعدَّها المجلس الأعلى للثورة الثقافيّة، والكتاب الذي ألفه سماحة الشيخ مجتبى مصباح ومجموعة من المؤلفين والذي أُنجز تحت إشرافه أيضًا. ونحن قد عملنا على ترجمة هذا الكتاب القيم الى اللغة العربية.
المصادر والمراجع
- القرآن الكريم
- أصول الكافي، ج 2
- أصول المعارف الإنسانية، آية الله مصباح اليزدي، جمعية المعارف الثقافية الإسلامية، لبنان، 2001
- مقالة للشيخ مصباح اليزدي تحت عنوان: أسس وأصول التربية والتعليم، نشرت في موقع شبكة فجر الثقافية بتاريخ 18/7/2018.
- مقالة للشيخ مصباح اليزدي تحت عنوان: الأسس النظرية للتعليم والتربية في الإسلام، نشرت في موقع مركز الاشعاع الإسلامي عام 2019.
- الموقع الرسمي لسماحة آية الله مصباح اليزدي.
- نهاية الحكمة، العلامة الطباطبائي، مؤسسة النشر الإسلامي، قم.
[1] – أستاذ مساعد في الجامعة اللبنانية، ومدير مديرية الأبحاث النظرية في مركز الأبحاث والدراسات التربوية، لبنان.
Assistant Professor at the Lebanese University, and Director of the Theoretical Research Directorate at the Center for Educational Research and Studies, Lebanon.Email: yaklb2000@gmail.com
[2] – أصول المعارف الإنسانية، آية الله مصباح اليزدي، جمعية المعارف الثقافية الإسلامية، لبنان، 2001، ص. 163.
[3] – مقالة للشيخ مصباح اليزدي تحت عنوان: الاسس النظرية للتعليم والتربية في الإسلام، نشرت في موقع مركز الاشعاع الإسلامي عام 2019.
[4] – في حين أنّ الفلسفات الحديثة، التي نشأت في القرن العشرين؛ كالفلسفة التّحليليّة (Analytique Philosiphy)، لم تقبل أن تكون مذهبًا فلسفيًّا، إنّما كانت منهجًا فلسفيًّا أو طريقة فلسفيّة، كونها عمدت إلى تحليل اللّغة والتخلّص من كلّ ما يشوب أصل اللّغة وأصل المفاهيم وتوضيحها. لذا، لا نجد من يقول: Analytisim، بل يُقال: Analytic Philosiphy أو الفلسفة التّحليليّة أو فلسفة التّحليل، وكثير من المترجمين يترجمونها بـ”فلسفة التّحليل”. اذا لم تعدُّ التّحليليّة نفسها مذهبًا فلسفيًّا، بل منهجًا للبحث في الفلسفة، خصوصًا في فلسفة اللغة.
[5] – نهاية الحكمة، العلامة الطباطبائي، مؤسسة النشر الإسلامي، قم، ص.5
[6] – مقالة للشيخ مصباح اليزدي تحت عنوان: أسس وأصول التربية والتعليم، نشرت في موقع شبكة فجر الثقافية بتاريخ 18/7/2018.
[7] – م.ن.
[8] – أصول المعارف الإنسانية، آية الله مصباح اليزدي، جمعية المعارف الثقافية الإسلامية، لبنان، 2001، ص. 10-11.
[9] – نقلا عن الموقع الرسمي لسماحة آية الله مصباح اليزدي رضوان الله تعالى عليه.
[10] – القران الكريم: سورة الحجر: الآية 29 وسورة ص: الآية 72: ﴿… وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي… ﴾
[11] – القرآن الكريم: سورة الاسراء: الآية 70: ﴿ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴾.
[12] -القرآن الكريم: سورة الاعراف: الآية 179: ﴿ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ ﴾
[13] – القرآن الكريم: سورة التين: الآية 4 ـ 6: ﴿ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإنسان فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ * ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ * إلا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ﴾.
[14] – القرآن الكريم: سورة الحجرات: الآية 13: ﴿… إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ… ﴾.
[15] – القرآن الكريم: سورة آل عمران: الآية 163: ﴿ هُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ اللَّهِ… ﴾
[16] – القرآن الكريم: سورة الكهف: الآية 29: ﴿… فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ… ﴾
[17] – القرآن الكريم: سورة البلد: الآية 10: ﴿ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ ﴾
[18] – القرآن الكريم: سورة هود: الآية 7: ﴿… لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا… ﴾
[19] – القرآن الكريم: سورة البقرة: الآية 286: ﴿… لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ… ﴾
[20] – القرآن الكريم: سورة الإنسان: الآية 3: ﴿ إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ﴾
[21] – القرآن الكريم: سورة النساء: الآية 6: ﴿ وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ… ﴾.
[22] – القرآن الكريم: سورة الانعام: الآية 165: ﴿… وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ… ﴾
[23] – القرآن الكريم: سورة البقرة: الآية 233: ﴿… لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إلا وُسْعَهَا… ﴾
[24] – القرآن الكريم: سورة النحل: الآية 93: ﴿… وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾.
[25] – القرآن الكريم: سورة الكهف: الآية 66: ﴿… هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَىٰ أَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا ﴾.
[26] – قال رسول الله (ص) لامير المؤمنين (عليه السلام): يا علي، لأن يهدي الله بك رجلًا خير لك ممّا طلعت عليه الشمس. وقال(ص): انّ معَلِّم الخير يستغفر له دواب الارض وحيتان البحر وكل ذي روح في الهواء وجميع اهل السماء والارض. وانّ العالم والمتعلّم في الاجر سواء. وقال(ص): العالم والمتعلّم شريكان في الاجر: للعالم اجران، وللمتعلّم اجر، ولا خير في سوى ذلك. راجع: بحار الانوار، العوالم، أصول الكافي، بصائر الدرجات و….
[27] – القرآن الكريم: سورة محمد: الآية 4: ﴿… وَلَٰكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ… ﴾
[28] – القرآن الكريم: سورة آل عمران: الآية 104: ﴿ وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إلى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ… ﴾ و….
[29] – القرآن الكريم: سورة البقرة: الآية 251: ﴿… وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ…﴾
– نقلا عن الموقع الرسمي لسماحة آية الله مصباح اليزدي رضوان الله تعالى عليه.[30]
[31] – القرآن الكريم: سورة آل عمران: الآية 14: ﴿ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ ﴾.
[32] – القرآن الكريم: سورة الشمس / الآيتان 9 ـ 10: ﴿ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا * وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا ﴾
[33] – كما جاء في الحديث: كلّكم راع وكلّكم مسؤول عن رعيّته.
[34] -القرآن الكريم: سورة لقمان: الآية 33 وسورة فاطر / الآية 5: ﴿… فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ ﴾.
[35] – القرآن الكريم: سورة الروم: 7: ﴿ يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ ﴾
[36] – القرآن الكريم: سورة البقرة: الآية 213: ﴿… فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ… ﴾
[37] – القرآن الكريم: سورة الرعد: الآية 28: ﴿ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ إلا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ﴾.
[38] – القرآن الكريم: سورة المائدة: الآية 2﴿… يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا… ﴾.
[39] – القرآن الكريم: سورة الحديد: الآية 23: ﴿ لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ﴾.
[40] – القرآن الكريم: سورة النجم: الآية 39: ﴿وَأَنْ لَيْسَ لِلْإنسان إلا مَا سَعَىٰ﴾.
[41] – القرآن الكريم: سورة الانبياء: الآية 28: ﴿…وَلَا يَشْفَعُونَ إلا لِمَنِ ارْتَضَىٰ…﴾.
[42] – راجع: أصول الكافي، ج 2، ص 148 ـ 149: «قال الصادق (عليه السلام): طلب الحوائج إلى الناس استلاب العزّ، ومذهبة للحياء، واليأس ممّا في ايدي الناس عزّ المؤمن في دينه، والطمع هو الفقر الحاضر». وكان امير المؤمنين (عليه السلام) يقول: «ليجتمع في قلبك الافتقار إلى الناس والاستغناء عنهم، فيكون افتقارك اليهم لين كلامك وحسن بشرك، ويكون استغناؤك عنهم في نزاهة عرضك وبقاء عزّك».
[43] – راجع: أصول الكافي، ج 2، ص 86 ـ 87: «قال رسول اللهˆ: انّ هذا الدين متين فاوغلوا فيه برفق ولا تكرهوا عبادة الله إلى عباد الله فتكونوا كالراكب المنبت الذي لا سفرًا قطع ولا ظهرًا أبقى».
[44] – القرآن الكريم: سورة البقرة: الآية 29: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا…﴾
[45] – القرآن الكريم: سورة المنافقون: الآية 8: ﴿…وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ…﴾
[46] – كما جاء في الحديث الشريف:”من أصبح لا يهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم”.
[47] – كل ما ورد من المباني النظرية والأصول العملية هي منشورة على بعض المواقع لا سيما الموقع الرسمي لسماحة آية الله الشيخ مصباح اليزدي حفظه الله.