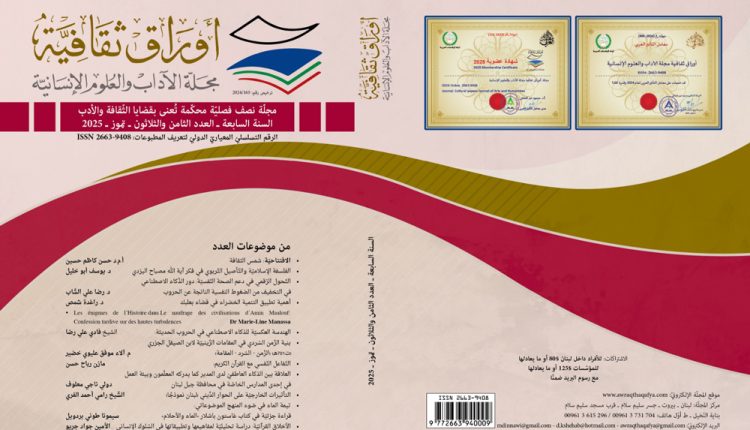العلامة السّيميائيّة قضيّة فلسفيّة بين الميتافيزيقا المجرّدة والممارسة الإنسانيّة فلسفة “أمبرتو إيكو” أنموذجًا
عنوان البحث: العلامة السّيميائيّة قضيّة فلسفيّة بين الميتافيزيقا المجرّدة والممارسة الإنسانيّة فلسفة "أمبرتو إيكو" أنموذجًا
اسم الكاتب: ياسر زغيب
تاريخ النشر: 2025/07/16
اسم المجلة: مجلة أوراق ثقافية
عدد المجلة: 38
تحميل البحث بصيغة PDFADOI: https://aif-doi.org/awraq/013813
العلامة السّيميائيّة قضيّة فلسفيّة بين الميتافيزيقا المجرّدة والممارسة الإنسانيّة
فلسفة “أمبرتو إيكو” أنموذجًا
The chemical sign is a philosophical issue between abstract metaphysics and human practice “Ampo Eco” philosophy is a model
Yasser Zogheib ياسر زغيب([1])
Supervisor Professor: khanjar hamieh الأستاذ المشرف: حميّة خنجر([2])
تاريخ الإرسال:20-6-2025 تاريخ القبول:1-7-2025
الملخّص
البحث هو محاولة لتفقي أثر العلامة السّيميائيّة بوصفها علمًا من جهة، وكونها لغة الوجود ولغة الخالق في مخاطبة الإنسان من جهة ثانية. إلّا أنّ علامات الكون والطّبيعة تبدو عديمة الفائدة وفاقدة المعنى من دون الإنسان الذي يتلقّى ويفهم هذه العلامات؛ ويحوّلها إلى كلمات ورموز هي بدورها علامات سيميائيّة. إنّ الإنسان، وفاقًا لفلسفة العلامة عند الفيلسوف الإيطاليّ “أمبرتو إيكو”، لا يتعرّف ذاته والوجود من حوله إلّا كونها سيميائيّة في حركة وأنظمة من مدلولات وعمليّات تواصل. والخارطة السّيميائيّة وحدها هي التي تقول لنا من نكون، وكيف أو في ما نفكّر؟. لذلك العلامات السّيميائيّة هي الميتافيزيقيا المجرّدة والممارسة الإنسانيّة في آن. البحث يحدّثنا عن رحلة طويلة ومضنية في تقفي أثر الحقيقة أو العلامة السّيميائيّة ومختلف تعلقاتها، ابتداءً من طبيعتها الخام أو الصناعية، إلى اللّفظ والمدلول والقاموس والدّراية الموسوعيّة والسّنن والرمز، وتصنيفات العلامات وكيفيّة إنتاجها ومكانتها في اللّغة والعلم والحياة والفلسفة، وصولًا إلى عدّها قضيّة فلسفيّة تحاكي تجربة الإنسان بوصفه حيوانًا رمزيّا علاميّا، في فلسفة “أمبرتو إيكو”.
الكلمات المفتاحيّة: العلامات السّيميائيّة، أمبرتو إيكو، الميتافيزيقيا، الفلسفة الحديثة، الكون والطّبيعة.
This research is an attempt to understand the impact of the semiotic sign as a science on the one hand, and as the language of existence and the language of the Creator in addressing man on the other. However, the signs of the universe and nature seem useless and meaningless without man, who receives and understands these signs and transforms them into words and symbols, which are in turn semiotic signs. According to the philosophy of the sign of the Italian philosopher Umberto Eco, man only recognizes himself and the existence around him as semiotics in movement and systems of meanings and communication processes. The semiotic map alone tells us who we are and how (or what) we think. Therefore, semiotic signs are both abstract metaphysics and human practice. The research tells us about a long and arduous journey in tracing the truth or semiotic sign and its various connections, starting from its raw or artificial nature, to the word, the signified, the dictionary, the encyclopedic knowledge, the norms, the symbol, the classifications of signs, how they are produced, and their place in language, science, life, and philosophy, arriving at considering them a philosophical issue that mimics the human experience as a symbolic, semiotic animal, in the philosophy of Umberto Eco.
Keywords: semiotic signs, Umberto Eco, metaphysics, modern philosophy, universe and nature.
مقدّمة
يرى الإنسان نفسه والعالم المحيط به من خلال علامات أو رموز، ويعبّر عنهما، أيضًا، بعلامات أخرى يستنبطها لتحقيق عمليّة التواصل؛ أي إنّ الإنسان يتعرّف نفسه والعالم من حوله والوجود الأرحب من خلال العلامات، ويُعبِّر عن ذلك كلّه بعلاماتٍ أيضًا. هذا هو تمامًا جوهر ما قاله الفيلسوف الإيطاليّ “أمبرتو إيكو”: “لا نتعرّف أنفسنا إلّا كوننا سيميائيّة في حركة وأنظمة من مدلولات وعمليّات تواصل. والخربطة السّيميائيّة وحدها هي التي تقول لنا من نكون، وكيف أو في ما نفكّر”([3]). هذا؛ وبما أن الإنسان لا يمكنه أن يفكّر، ولا أن يقول بما يفكّر، ولا كيف يفكّر، إلّا من خلال الرموز والكلمات التي هي علامات، فهذه الرموز أو الكلمات هي الوجود الذي يتبدّى للإنسان، وهي الفكرة المجرّدة التي ينتجها عن هذا الوجود، وتاليًا هي “الإنسان نفسه”.
الإشكاليّة: تتمحور إشكاليّة البحث في أنّ الوجود يقدّم ذاته على شكل علامات سيميائيّة، والله يخاطب خلقه بوساطة علامات سيميائيّة، فكيف يتلقى الإنسان علامات الكون والطّبيعة؟ وكيف يفسرها؟ وهل الإنسان كائن علاميّ يفسر الكون والوجود من خلال كلمات هي رموز وعلامات أم أن التيه هو سمة هذا الوجود العلاميّ؟ وبالتالي ما هي ماهية العلامة السّيميائيّة بين الميتافيزيقيا المجرّدة والممارسة الإنسانيّة؟
يعتمد البحث منهجين:
- المنهج التّحليليّ: يعمد التّحليل إلى تفكيك المركّب، وهو بذلك يسلك الدّرب المعاكس للتركيب. وعليه، فالتّحليل هو إرجاع الكلّ إلى أجزائه، وفي العلامة إرجاع العلامة إلى مرجعها الموسوعيّ والدّلالات المتوفرة في قاموس المتلقّي. وفي الاصطلاح هو الانتباه إلى التصوّر، ثمّ تحليله إلى تصوّرات أخرى تؤلفه، وبعدها إحصاء المعاني كلّها التي يدلّ عليها اللّفظ ومحاولة التقاط الخاصيّة المشتركة بينها. وبدأ هذا الاتّجاه في إنجلترا مع جورج مور([4]) (George Edward Moore) ثمّ سار في طريقه فيما بعد مع “برتراند راسل”([5]) (Bertrand Russell) و”ألفريد نورث وايتهد”([6]) (Alfred North Whitehead) وكانوا يريدون الرجوع إلى العناصر الأوليّة العاديّة والوحدات الجزئيّة التي يقوم عليها الفكر والوجود، ثمّ العمل على توضيح حقيقة تلك العناصر والجزئيّات والعلاقات التي تربطها ببعضها البعض.
- المنهج التأويليّ: التأويل في اللّغة هو الإرجاع، و”آل إليه” تعني رجع إليه، وهو غير التفسير؛ لأنّ التفسير يركّز على شكل الكلمة وما يقابلها من مرادفات. أمّا التأويل فيهتمّ بالمعنى الباطنيّ. والتأويل في العربيّة يقابله في اللّغة الأجنبيّة الهيرمينوطيقا Herméneutique المشتقة من هيرمس، الإله اليونانيّ المتكفّل عندهم باللّغة. وهذا المهنج مارسه فيلسوف التفكيك “جاك دريدا”([7])، وكلّ من “تشارلز بيرس” و”سوسير” و”أمبرتو أيكو”([8]). وهو منهج يختلف تطبيقه عند كلّ واحدٍ منهم. ويعرّفه “أندريه لالاند” (André Lalande)([9]) أنّه منهج تفسير النصوص الفلسفيّة أو الدينيّة، وبنحو خاص، الكتاب المقدّس. وتقال عنده هذه الكلمة خصوصًا على ما هو رمزيّ. وقد ظهر المنهج التأويلي مع تأويل الكتاب المقدّس، ثمّ انتقل إلى الفلسفة مع أعمال “فردريك شلاير ماخر”(Friedrich Schleiermacher)([10]) في القرن الثامن عشر. وهنا؛ اتسع ليدرس النّصوص الدينيّة كلّها وغير الدينيّة. لقد عُرف التأويل في العالم الإسلاميّ، ومارسه المتصوّفة والمعتزلة لفهم القرآن والسّنة والتراث، بشكل عام. ومن أبرز الفلاسفة العرب الذين مارسوا التأويل ونظّروا له الفيلسوف محمّد بن أحمد بن رشد([11]).
مدخل تعريفيّ: كان “أمبرتو إيكو” (بالإيطآليّة: Umberto Eco) (1932 – 2016) عالمًا في إيطاليا القروسطيّة وفيلسوفًا وروائيًا وناقدًا ثقافيّا ومعلقًا سياسيًا واجتماعيًا. في اللغة الإنجليزيّة، اشتهر بروايته الشهيرة “اسم الوردة”، في العام 1980، وهي لغز تاريخيّ يجمع بين السّيميائيّة في الخيال مع تحليل “الكتاب المقدّس” والدّراسات القروسطيّة والنّظريّة الأدبية، وكذلك روايته “|بندول فوكو” التي تتناول موضوعات مماثلة.
كتب “إيكو” بغزارة طوال حياته، بما في ذلك كتب الأطفال والترجمات من الفرنسيّة والإنجليزيّة، بالإضافة إلى عمود صحفيّ نصف شهريّ في مجلّة L’Espresso ابتداء من العام 1985، مع عموده الأخير “تقويم نقديّ للوحات فرانشيسكو هايز الرومانسيّة”، والذي ظهر في 27 يناير/كانون الثاني في العام 2016. وفي وقت وفاته، كان أستاذًا فخريًا في جامعة بولونيا، حيث درّس معظم حياته. في القرن الحادي والعشرين، واصل “إيكو” تألقه بمقاله في العام 1995 بعنوان “الفاشية الدائمة”، حيث أدرج أربع عشرة خاصيّة عامة يعتقد أنّها تشمل الأيديولوجيّات الفاشية.
أولًا – العلامة بين الفكر والواقع
إنّ علم العلامات هو العلم الذي يدرس كيف يتكوّن الموضوع في الفكر والواقع، على حدٍ سواء. ولعلّ هذا ما كان يفكّر به ويقصده “إيكو” عندما قال: “إنّ البشر والكلمات يتعلّمون بصفة متبأدلّة: كلّ إثراء من المعلومات يملكه شخص ما يحتِّم إثراءً موازيًا لمعلومات الكلمة”([12])؛ فـــ”أنت تعني فقط؛ لأنّك تقول بضع كلمات كونها مؤوِّلات لفكرك”([13])؛ وبما أنّ كلّ فكر هو علامة وكلّ كلمة هي علامة، فالحياة والوجود في الواقع هما دفق مستمرّ من الأفكار، ومن العلامات تاليًا. وعليه؛ فإنّ الإنسان نفسه هو علامة، وهذا ما يؤكّده “إيكو” بالتحديد؛ بقوله: “إنّ تأكيد أنّ كلّ فكر هو علامة خارجيّة، يدلّ على أنّ الإنسان علامة خارجيّة، بمعنى أنّ الإنسان والعلامة الخارجيّة متماثلان”([14]). لقد اعتنى الفكر الفلسفيّ بدراسة الروابط القائمة بين العلامات والواقع. والتي يلخّصها “إيكو” بخمسة أشكال من الروابط يطلق عليها اسم “قضايا” أو “أطروحات”؛ وهي([15]):
- روابط بين شكل العلامات المركبّة أو الملفوظات وشكل التفكير؛ وتبعًا لذلك هناك روابط بين النّظام المنطقيّ والنّظام السّيميائيّ؛ القبضة تدلّ على القوة واليد الممدودة تدلّ على الحاجة.
- روابط بين العلامات البسيطة والأشياء التي تعنيها (dénotent) أو تحيل إليها، عبر المفهوم كونها وسيطًا- المفهوم الموجود في الفكر هو علامة مجرّدة- وهو الذي يعطي السّهم، وهو علامة ماديّة، والذي يدلّ على الاتّجاه معناه الواقعيّ.
- روابط بين شكل العلامة المركّبة (الملفوظات) وشكل الأحداث التي تصفها، وهي روابط تحيل إلى وجود علاقة بين النّظام السّيميائيّ، أي العلاميّ، والنّظام الإنطولوجيّ المعرفيّ أو المفهوميّ، والذي يدرس طبيعة الوجود غير الماديّ في القضايا الميتافيزيقيّة المترتبّة على التصوّرات أو المفاهيم والقوانيين العلميّة – مثال: الكفّان المرفوعان في الصّلاة هو دعاء تحيل إلى معنى إنطولوجيّ، أما الكفّان على الرأس هو خوف، فتحيل إلى معنى ماورائيّ معنويّ غير ماديّ، وكذلك الكفّان الممدوان للتسول تحيل إلى معنى الكرم في الشّخص العاطي والحاجة في الشّخص الآخذ.
- روابط بين شكل العلامة العاديّة وشكل الشّيء الذي تحيل إليه العلامة؛ لأنّ الموضوع هو في شكل من الأشكال، السّبب في وجود هذه العلامة؛ مثال: علم الإشارة للصمّ الإشارة مطابقة للمعنى، والأمر نفسه ينطبق على إشارات السّير لكلّ متلقٍ.
- روابط وظيفيّة بين العلامة والموضوع الذي تحيل عليه، ومن دون هذه الروابط تصبح العلامة مفرغة من أي قيمة تصريحيّة؛ ولن يكون لها أبدًا أي صفة إثبات لمعنى ما؛ وهي مثل: المفهوم الذي تولّده الكلمات، ومعانيها المرادفة لها في الواقع أو معجم المعاني.
إنّ هذه الروابط أو الفرضيّات للعلاقة بين العلامة من جهة والفكر والواقع من جهة أخرى، هي وثيقة الصّلة ببعضها البعض. إذ إنّ النّظام الرمزيّ الذي تشكّله العلامات الفكريّة واللغويّة يعكس نظام الظاهرة التي يقوم بوصفها؛ سواء على مستوى الشّكل أم المضمون.
ثانيًا – الإنسان حيوانٌ علاميّ يُرمِّز الوجود (حصريّة العلامة بالعقل البشريّ)
إذا كان الإنسان يُرمِّز الأشياء والوجود من حوله، من خلال الكلمات والرموز والصّور والرسومات فهو حيوانيّ رمزيّ علاميّ، وهي صفة لا تخصّ النّظام اللّغويّ الإنسانيّ فحسب، تشمل أيضًا المنظومة الفكريّة الشّاملة والكاملة للإنسان، فما دام الإنسان يفكّر ويدرك فهو يُرمِّز، وما دام يُرمِّز فهو يفهم الواقع والحياة والوجود من خلال رموزه، إنّها فلسفة فهم الإنسان لذاته والطّبيعة من حوله والنّظام الأنطولوجيّ المفارق للطبيعة من خلال ما ينتجه من علامات. يرى “إيكو”: “إنّ وجود الإنسان مرتبط بوجود المجتمع، ووجود المجتمع مرتبط ومرتَهَن بوجود العلامات، فبفضل العلامات استطاع الإنسان أن يتخلّص من الإدراك الخام، ويصل إلى التجريد، ومن دون التجريد لا يمكن الحديث عن المفهوم، فلا وجود للعلامات؛ تاليًا”([16]). يبيّن “إيكو” كيف أنّ النقاشات الفلسفيّة في الأفكار ترجع في الأساس إلى قدرة الإنسان على إنتاج العلامات؛ فــــ”الثقافة ولدت عندما استطاع الإنسان بلورة أدواته من أجل السّيطرة على الطّبيعة. وكانت هناك فرضيّة أخرى تقول: “إنّ وضع الأداة رهينٌ في وجوده بوجود نشاط رمزيّ”([17]). وفي هذا دلالة عميقة على البعد الفلسفيّ للعلامات، فلكي يكون هناك اختراع للأداة لا بدّ من توافر ثلاثة شروط كما يفترضها “إيكو”؛ وهي([18]).
- وجود كائن مفكّر، يمنح هذه الأداة وظيفة محدّدة وجدت من أجلها.
- قيام هذا الكائن بوضع تسمية لهذه الأداة من أجل تعرّفها، والتمييز بينها وبين الأدوات الأخرى.
- لاحقًا يصبح تعرّف هذه الأداة بناءً على وظيفتها المحدّدة، ووفقًا لتسميتها الموضوعة.
في اللّحظة التي تتخذ فيها هذه الأداة المبتدَعة صورة السّلوك السّيميائيّ، تصبح لغةً قابلة للمعرفة وللفهم وللملاحظة، يتبادلها الأشخاص وإن لم يستخدموها في حياتهم اليومية ولو لمرة واحدة. لكن كيف لهذه الذات المفكّرة أن تنتج العلامات؟ وهل من الضروريّ أن تكون لفظيّة؟ وتاليًا كيف لهذه الذات المفكّرة أن تترجم العلامات الموجودة في الكون في لغة هي علامات أيضًا؟
إنّ من المستحيل، وفقًا لـــــــ”إيكو”، أن نفكّر من دون كلام، لذلك العلامة لا بدّ أن تُترجم في لغة. وصحيح أنّ العلامة قد لا تكون لفظيّة، كحال الإنسان القديم البدائيّ ما قبل اللّغة عندما رسم نفسه على جدران المغارة يراقب ويصوّب على الطريدة التي يريد قتلها، ولكنّ الطابع اللّفظيّ هو شكل الفكر، “فعلم اللّغة اللفظيّة هو العلم الوحيد القادر على أن يترجم ما في عقولنا، والقادر على شرح بنيتنا الداخلية”([19]). وإنّ الإنسان يرى نفسه والعالم المحيط به من خلال علامات، لكنّه يعبر عنهما، أيضًا، بعلامات أخرى يستنبطها لتحقيق عمليّة التواصل، أي إنّنا – وفقًا لما يقوله “إيكو” – “لا نتعرّف أنفسنا إلّا بكوننا سيميائييّن في حركة وأنظمة من مدلولات وعمليّات تواصل. والخريطة السّيميائيّة هي التي تقول لنا من نكون وكيف أو في ما نفكر”([20]).
إذًا باختصار، إننا نتحكّم بالأشياء عبر علامات، أو أشياء نحوّلها إلى علامات تدلُّ على الأشياء التي نريد التحكّم بها، فنحيل وجودنا إلى مجموعة من العلامات التي قام العقل بوضعها، أو استطاع من خلالها تفسير العلامات الموجودة في الوجود والكون من حولنا. وعلى هذا؛ قامت الفلسفة السّفسطائيّة وفلسفة التركيب الكلاسيكيّة في الهند، ومن خلال هذا ولدت، أيضًا، نظريّة البرهنة القائمة على المحتمل لا على المقدّمات المستندة إلى قيم مطلقة، أو ما يُسمّى في المنطق “القياس المضمر”، حيث بالإمكان البرهنة على عدم اليقين، وذلك لأنّ عالم العلامات هو عالم لا يحدّد وعالم التعدديّة. وهذا ينطبق، أيضًا، على الأبعاد القانونيّة والتداوليّة والبرهانيّة التي أرسى دعائمها “أرسطو”([21])، والتي يستطيع الإنسان بفضلها استخدام العلامات للتحكّم بسلوك الكائنات البشريّة، من خلال التمييز بين العادل وغير العادل، وبين ما يمكن القيام به وما يستحيل فعله، وبين المحمود من الأفعال والأخلاق والمذمومة منها([22]).
ثانيًا – ميتافيزيقيّة العلامة عند “إيكو“
خاض الإنسان تجاربه الأولى في قراءة الطّبيعة من خلال الرمز والعلامة، فأصبحت الطّبيعة، بأشيائها وكائناتها والموجودات المختلفة فيها، وفاقًا للرؤية اللاهوتيّة وبعض الفلاسفة وعلى رأسهم “أفلاطون”([23])، علامات يحدّثنا الله من خلالها عن ملكوتٍ لا نرى منه سوى الصّور المجسّدة في الطّبيعة. لقد كانت نظريّة أفلاطون أوّل محاولة في هذا المجال، فأصبحت الطّبيعة هي الشيء الذي يحيل إلى المفهوم، والقائمة التي تحيل إلى المرجع المتعالي. وبات عالم المثل هو عالم الحقيقة، وعالم المادة ما هو إلّا انعكاس لعالم الحقيقة أو خيالات له. لكنّ رؤية “أرسطو” كانت أكثر واقعيّة؛ فقد عارض الرؤية الأفلاطونيّة، ورأى أنّ العالم هو نتاج قدر إلهيّ قام بتنظيم الأشياء وفقًا لقواعد وقوانين لكي يجعلها أدوات تمكّن الإنسان من معرفة الوجود والأشياء، وتمكّنه من تحقيق التواصل. تأثرت الرؤية اللاهوتيّة، وفقًا لـــ”إيكو”، بالرؤية الأفلاطونيّة التي قامت على أساسها الميتافيزيقيّات القروسطيّة الأولى، فقد أصبح الكون عند المفكّرين اللاهوتيّين في هذه المرحلة “هو تجلٍّ إلهيّ: فالله يكشف عن نفسه من خلال العلامات التي هي أشياء([24]) (…) إن الرمزيّة القروسطيّة في كلّيتها مشتقة من هذه الفرضيّة: كلّ كائنات هذا الكون هي كتب وصور تشكّل بالنسبة إلينا مرايا، في حياتنا ومماتنا، في وجودنا وقدرنا”([25]). لكنّ الرؤية اللاهوتيّة للعلامات ليست بحاجة “إلى بطل إلهيّ”، على حدّ تعبير “إيكو”، من أجل إقامة ميتافيزيقيا سيميائيّة شاملة، بل يمكن ذلك من خلال أي رؤية فلسفيّة تنظر إلى الوجود بوصفه “وحدة تحكم الكلّ”، حين يصبح “الكون جسمًا يدلّ على نفسه بنفسه”([26]). لكنّ التحوّل الكبير الذي حصل في السّيميائيّة الشّاملة نجد تجسّده في “نظريّة بازوليني” في العلاقة بين اللّغة السّيميائيّة ولغة الواقع([27]) والتي قلبت المعأدلّة السّيميائيّة من كونٍ يحدّثنا الله من خلاله إلى كونٍ بكلّ الأشياء الموجودة فيه يشكّل علامة على ذاته، حيث أصبحت “الأشياء تشكّل كتاب العالم، إنها نثر الطّبيعة ونثر الفعل وشعر الحياة. إنّ شجرة السّنديان هاته ليست مدلولًا لعلامة مكتوبة أو منطوقة، لا ليس الأمر كذلك، إنّ شجرة السّنديان الماثلة أمامي هي ذاتها علامة”([28]). وهكذا تحوّلت الطّبيعة، وفاقًا لنظريّة بازوليني، من السّيميائيّة الشّاملة التي تعتمد صيغة “الأسماء هي الأشياء” إلى صيغة “الأشياء هي الأسماء”. إنّ الواقع هنا يفرض نفسه، فتصبح الأشياء هي التي تخبر عن ذاتها وعن دلالاتها، فيصبح الواقع هو الذي يتوجّه إلى نفسه على شكل ذات مدركة. لقد أدى الفلاسفة العرب دورًا مركزيًا ومهمًا في دراسة الكون والوجود والتجليّات العلاميّة فيه. ولكنّ الفلاسفة الغربيين الذين جدّدوا وطوروا هذا العلم، ومنهم “إيكو”، أغفلوا هذا الدور. علمًا أنّ كثيرًا من تجليّات هذا المعنى نجدها عند المتصوّفة المسلمين في العصر العباسيّ وما تلاه، إذ نجد أنّ الله، في رأي هؤلاء، يتحدّث مع البشر بلغتين:
الأولى: لغة الكتاب التدوينيّ (الكتب السّماويّة المنزّلة بالّلغات المحكيّة والمنطوقة).
الثانية: الكتاب التكوينيّ المتمثل بهذا العالم والكون والطّبيعة التي تتحدّث معنا بلغة لا يمكننا فكّ رموزها وعلاماتها إلّا بالإلهام والتجلّي والعرفان، فالأشياء المستودعة في هذا العالم الطبيعيّ هي رموز وعلامات تحمل رسائل تحمل ما تحمله اللّغة، ولها ما للكلمات في اللّغة، وربما ما تعجز اللّغة عن إيصاله.
يطرح “إيكو” مجموعة من التساؤلات عمّا ما إذا كان الكون في كلّيته والأشياء المكوّنة له ليسوا إلّا علامات تحيل برعونة (سوء توجيه) (Maladroitement) إلى تأويلات خارجيّة مثاليّة تشكّل عالم الأفكار؟ وهل العالم رسمٌ من إنتاج الله الذي قام بتنظيم أشياء الطّبيعة ليجعل منها أدواتٍ للتواصل مع الإنسان؟ أم أنّ الكون ينبئ عن ذاته وليس له وظيفة تأويليّة لأفكار ومفاهيم خارجيّة ميتافيزيقيّة؟
يرى “إيكو”، في معرض الإجابة عن هذه التساؤلات، أنّ جميع الأشياء التي من خلالها نبني نسقًا من العلاقات هي بشكل مسبق علامة على ذاتها، وتشكّل في الوقت نفسه نسقًا رمزيّا للكون. فــــ “العالم غابة من الرموز التوجه الإنسانيّ (Humanisme)، وهذه الأنساق الفكريّة تبيّن كيف كوّنت الإنسانيّة هندسة رمزيّة واسعة، إذ لم يعد الله هو الذي يتحدّث إلى الإنسان عبر العلامات، وإنّما هو ما يتشكّل في التاريخ عبر مشاهد رمزيّة – ثقافيّة كبرى”([29]).
ثالثًا – العلامة بين العقل والشّك والتخمين والتيه
ينطلق البحث، في هذه القضيّة، من إشكاليّة عقليّة فلسفيّة تتمحور في دور العقل ومدى حاكميّته في صناعة العلامات وصياغتها، وما إذا كان قوةً فاعلةً يمكنه إنتاج معرفة، وتاليًا علامات يقينيّة أم أنّ العقل فاقد لمثل هذه القدرة، ويقتصر دوره على التلقّي لما هو موجود في الكون من معرفة وعلامات؟
يؤكّد “إيكو” دور العقل الإنسانيّ في صناعة العلامات، وأنّ الأنساق الفكريّة والإنسانيّة هي التي كوّنت هندسة رمزيّة واسعة للكون والوجود والطبيعيّة والحياة، إلى درجة أنّ الله يتشكّل في التجربة الفكريّة الإنسانيّة عبر مشاهد رمزيّة – ثقافيّة كبرى. كما أنّ تجربة “إيكو” في دراسة العلامة السّيميائيّة وتقفي أثرها في التجربة الفكريّة والفلسفة واللغويّة الإنسانيّة، يمكن تلخيصها في ما قاله “سعيد بنكراد”، في مقدّمة ترجمته لكتاب أمبرتو إيكو؛ العلامة تحليل المفهوم وتاريخه: “يكتفي “إيكو” بـتأمل تجربة إنسانيّة شاملة، يتأمل محاولات الإنسان المضيئة من أجل التخلّص من براثن طبيعة هوجاء لا ترحم لكي يحتمي بعالم ثقافيّ (رمزيّ) يمنحه الدفء والطمأنينة ويوفر له التفاسير الممكنة للظواهر الطبيعيّة والاجتماعيّة، على حدّ سواء”([30]). لكنّ العقل الإنسانيّ ليس هو الميزان في إنتاج العلامات وفهمها دومًا، لذلك نجد أنّ روايات “إيكو” التي صاغها على منوالٍ من العلامات والرموز السّيميائيّة، خاصة أشهر رواياته “إسم الوردة”، لم يكن العقل فيها ميزانًا لفهم العلامات وقراءتها وسبر أغوارها. بل إنّ العقل الإنسانيّ، في كثير من محطات هذه الرواية، يقف عاجزًا مخمنًا إزاء بعض العلامات، طبيعيّة كانت أم صناعيّة.. فكيف يقرأ الإنسان العلامات؟ وكيف له الوصول إلى كنهها؟ وهل يصل إلى ذلك بالعقل؟ أم بالغريزة؟ أم بالتجربة؟ أم بالتخمين؟
إنّ رواية “إيكو” “اسم الوردة”، على سبيل المثال، تعطينا خريطة معقّدة لكيفيّة قراءة الإنسان للعلامات، سواء تلك الموجودة في الكون أم تلك التي تُحدِثُها التجربة الإنسانيّة أم الأفعال البشريّة في مختلف ميادين الحياة. وتتشعّب خطوط هذه الخريطة وتتعقد لتصبح أشبه بالمتاهة، تارةً يكون العقل هو المركب والقارئ، وتارةً أخرى تكون التجربة (الخبرة) الإنسانيّة السّابقة، وطورًا يحتلّ التخمين مكان العقل والتجربة ليبدأ في عمليّة تنقيبٍ بين خياراتٍ متعدّدة. كما أنّ للشهوة والغريزة دورًا في فهم العلامات وقراءتها. وفي المحصّلة، فإن حاكميّة العقل ليست مطلقة، لا بل ليست غالبة، كونها تتداخل مع عوامل أخرى قد تكون منافسة أو غالبة على العقل ودوره، في كثيرٍ من الأحيان.
من النّماذج العمليّة التي “أوردها” إيكو”، في هذا المجال، في روايته “اسم الوردة”:
- خاطب غوليالمو تلميذه أدسو قائلًا: “لنفترض أنّ شخصًا قٌتِل مسمومًا، يمكنني من التجربة أن أتصوّر.. أنّ شخصًا آخر قام بعمليّة التسميم”([31]). إنّ مثل هذا الاستنتاج قائمٌ على قراءةٍ لعلاماتٍ معيّنة مأخودة من التجربة الحسيّة من جهة لا من خلال التفكير العقلي، وقائمٌ أيضًا على التصوّر من جهة ثانية. لذلك نجد أنّ أدسو تلميذ غوليالمو يعلّق على طريقة تعامل أستاذه مع العلامات؛ فيقول: “إنّها قائمة على مبدأ تجريبيّ لا يستند إلى المعرفة (العقليّة)”([32]).
- قال غوليالمو، في أثناء حديثه عن الكيفيّة التي استطاع أن يعرف من خلالها، بشكل دقيق، الحصان الفالت من الدّير من دون أن يكون قد رآه: “نحن نستعمل العلامات، وعلامات العلامات فقط عندما تنقصنا الأشياء”([33]). وهذا يعني أنّ اللّجوء إلى قراءة العلامات هو خبرة وحاجة عمليّة.
- إنّ قراءة العلامات وعلامات العلامات قد تأخذ طابعًا آخر، فهي قد تكون قراءة تحدث عن طريق التّخمين. والتّخمين وإن كان مفارقًا لليقينيّة، هو محاولة للإمساك بها؛ فـ”الحدس” يُنبئ بمعطيات تخمينيّة لا يقين تامًا فيه، لكنّ بعض العلامات لا يمكن أن تدرك إلّا “عن طريق الحدس”([34]). إنّ غوليالمو لم يكن مدركًا بوضوح كامل دقّة الأوصاف التي قدّمها عن الحصان الضائع، لذلك قال: “لم أشفِ غليلي من المعرفة إلّا عندما رأيت ذلك الجواد بالذات يقوده الرهبان من لجامه”([35]).
لكنّ السّؤال الذي يفرض نفسه، هنا، هل هذا يعني أنّ إيكو قد أهمل حاكميّة العقل؟ والجواب بالتأكيد لا، بل إنّ “إيكو” جعل حاكميّة العقل في مكانٍ متعالٍ على كلّ الطرائق والآليّات التي تحدّثنا عنها في قراءة العلامات، لكن من دون أن يجعل العقل هو الأداة الوحيدة، ومن دون أن يجعل العقل غير قابل للشكّ والخطأ، فنجد أنّ غوليالمو ينصح تلميذه أدسو، والذي ظن أنّ أستاذه يعتمد على التجريب، قائلًا له: “ياعزيزي أدسو، يجب أن تتعلّم كيف تستعمل عقلك للتفكير”([36]).
إذًا الأستاذ الحاذق والمحقّق البارع في الجرائم واقتفاء أثار الجرائم غوليالمو، في رواية “إيكو”، يقول لتلميذه أدسو: “في قراءة العلامات يجب أن تتعلّم كيف تستعمل عقلك، لكنّ العقل ليس أداة جاهزة للتفكير، بل هو أداة خاملة من دون التجارب والتدريب، وفعّالة ومؤثرة في حال نالت حظًا وافرًا من والتدريب والتجارب. يذكّرنا هذا بما قاله الفيلسوف العقلانيّ “إيمانيول كانط”([37])، في كتابه “نقد العقل الخالص”، حين يرى أنّ العقل يحتاج إلى جملة من الشّروط حتى يكون مدعاة للثقة، فلا إمكان لمعرفة حقيقة يقينيّة إذا لم تتحقّق هذه الشّروط التي تؤمِّن مسالكه إليها. لكنّ “إيكو”، وعلى الرّغم من ذلك، يذهب في روايته الشّهيرة “اسم الوردة” إلى عدم حاكميّة العقل حاكميّة مطلقةً في قراءة العلامات، فهو عندما سأله أدسو بحيرة مَنْ مِنَ الطرفين على صواب؟ “ومَن الصائب ومن المخطيء؟”([38])؛ أجابه غوليالمو: “لكلٍّ حجّته المعقولة، وكلّهم أخطؤوا”([39]). وهذا يدلّ على أنّ “إيكو”، على لسان بطل روايته غوليالمو، لم يصل إلى برد اليقين، فحجّة كلّ من الفريقين معقولة، والحجّتان متناقضتان في ما تقدّمانه من أدلّة. وعليه؛ فإنّ الحجة المعقولة عند “إيكو” لم تقدّم حقيقة. وهذا تعريض بشأن العقل وحاكميّته شئنا أم أبينا. في المقابل؛ نجد أنّ “إيكو” قد أبرز، عبر أحد شخصيّات روايته، حاكميّة أخرى في قراءة العلامات غير حاكميّة العقل. إذ نجد أنّ أبارتينو نصح غوليالمو ” لينجح في مهمّته التحقيقيّة في مقتل أدالمو قائلًا: “إذن تجسّس، نقّب، أنظر بعين الفهد نحو ناحيتين: الفسق والغرور”([40]). وإذا كان الفسق بالنسبة إلى أوبارتينو متحكّمًا بسلوك كثير من رهبان الدّير؛ فإنّ طلبه إلى غوليالمو بالتجسس (تجميع معلومات خاصة)، والنّظر نظرة الفهد السيّئة الظن، هو في المحصّلة كلام مفاده: أنّه إذا كان الفسق آليّة سلوك، فإنّ آليّة قراءة علاميّة لاكتشاف الحقيقيّة”؛ فتاليًا هو آليّة لاكتشاف العلامات. تجدر الإشارة إلى أنّ “إيكوط يُظهر، في روايته “اسم الوردة”، أنّ الشّهوة هي، أيضًا، إحدى العوامل المؤثرة في إنتاج العلامات والحاكمة في فهمها وقراءتها، حين يُدخل القاريء من جهة، وآليّات فهم العلامات وقراءتها وحتى عوامل إنتاجها من جهة ثانية، في متاهة كبرى. وهي هوايته المفضّلة في السّرديّة القصصيّة وفي التأويل وفي إنتاج العلامات وفهمها. إذ “يرى غوليالمو أنّ بانشو “ضحيّة شهوة كبيرة”؛ فهل يعني “إيكو” أنّ الشّهوة هي محركة السّلوك وتمثل آليّة في قراءة العلامات؟”([41]). بالتأكيد أنّ “إيكو” أكّد دورًا للشهوة في قراءة العلامات وصناعتها، والشّهوة ليست “شهوة الجنس، فما يصدر عن برناردو المحقّق والمدقّق هو، أيضًا، شهوة، لكنّها شهوة منحرفة للعدالة تتطابق مع شهوة السّلطة”([42]).
أخيرًا؛ لا يترك “إيكو” حاكميّة لشيء في قراءة العلامات وفهمها، فكلّ شيء عرضة للتشكيك، خاصة مركزيّة العقل وحاكميّته، وهذا سيظهر في حديث غوليالمو إلى أوبارتينو: “يبدو أنّ الجحيم هو الفردوس منظورًا إليه من الناحية الأخرى”([43])؛ هنا لم يعد ثمّة معيارًا، ولم يعد ثمّة حاكميّة لأي شيء، فالأمر نسبيّ يختلف باختلاف الناظر والزاوية التي ينظر منها، وهذا يعني “أنّ ماهيّة الأمور وحقيقتها ليست ماهيّة قائمة بذاتها ومستقلّة بذاتها؛ بل تأخذ حقيقتها من الزاوية التي يُنظر منها إليها؛ فهي حقائق بعدد وجهات النّظر”([44]).. إنّها أقصى دراجات المتاهة والتيه.
رابعًا- العلامة هي الممارسة الإنسانيّة
العلامات الموجودة في هذا الكون، وفي هذه الطّبيعة، أو تلك التي توحي به الطّبيعة والكون من علامات مجرّدة مفارقة للطبيعة، هي علامات عديمة المعنى ما لم يكن هناك متلقٍ هو الإنسان. كما أنّ العلامات الصناعيّة الفكريّة واللغويّة واللسانيّة والأيقونيّة ..إلخ، هي علامات تأخذ طابعها العلاميّ من كونها تشكّل صلات وصلٍ بين الإنسان الباث والإنسان المتلقّي، أو بين الإنسان وعالمه الخارجيّ. إنّ العلامة، وفقًا لـ” إيكو”، هي “الأداة التي من خلالها تأنسن الإنسان، وانفلت من رِق الطّبيعة ليلج عالم الثقافة الرحب الذي سيهبه طاقات تعبيريّة هائلة”([45]).
الإنسان، كما يتبنّى “إيكو”، هو حيوان رمزيّ علاميّ، وهو تعبيرٌ اقتبسه من “إرنست كاسير”([46]) الذي تبناه منذ عشرينيات القرن العشرين. والرمزيّة ليست ميزة لغويّة لسانيّة تميّز الإنسان عن غيره من الكائنات الأخرى فحسب؛ “هي تشمل ثقافة الإنسان كلّها؛ فالمواقع والمؤسسات والعلاقات الاجتماعيّة والملابس هي أشكال رمزيّة أودعها الإنسان تجربته لتصبح صالحة للإبلاغ”([47]). إنّ هذه الرمزيّة هي التي تبيّن الإنسان في موقع المبدع لها تارة، وفي موقع الفاهم والمحلّل والمتلقّي لها تارة أخرى. لقد تصدّى “إيكو” لإيضاح طبيعتها وحقيقتها في قصة المواطن الإيطاليّ “السّيد سيغما” الذي يقضي عطلته في باريس، وهو لا يجيد اللّغة الفرنسيّة، لكنّه يجد نفسه في بحرٍ من العلامات التي تتجلّى في باريس المدينة التي تغطيها الأضواء والمصابيع، مدينة مليئة بالألوح التوجيهيّة، ومليئة بالأصوات والإشارات من الأنواع كلّها. ولكن هذه ليست الحقيقة التي تفسّر عالم العلامات والرموز، “فحتى لو كان السّيد سيغما فلاحًا معزولًا عن العالم، فسيعيش، أيضًا، وسط العلامات، سيجوب أطراف الريف منذ طلوع الفجر تحت رحمة الغيوم الممتدّة في الأفق، سيكون بإمكانه التكهن بالزمن، وستطمئنه ألون الأوراق على مآل الموسم الفلاحيّ، وستخبره سلسلة الأخاديد المحفورة على أديم الأرض فوق الهضاب عن نوعيّة الفلاحة التي تصلح لهذه التربة. ويخبره برعم وسط الحشائش عن انتشار نوعيّة معيّنة من الحبوب في هذا المكان، وسيكون بإمكانه التمييز بين الفطريّات السّامة وتلك الصالحة للاستهلاك ..إلخ. والخلاصة أنّ “السّيد سيغما” حتى ولو كان غارقًا وسط عالم طبيعيّ فسيعيش وسط العلامات”([48]). إنّ هذه العلامات التي يعيش في وسطها “السّيد سيغما” في الريف ليست ظواهر طبيعيّة، لأنّ الظواهر الطبيعيّة بحدّ ذاتها، عند “إيكو”، لا تقول شيئًا، وهي غير قادرة على أن تتحدّث مع “السّيد سيغما”، “إلّا إذا كانت هناك تقاليد علّمته كيف يقرأ هذه الظواهر. إنّ سيغما يعيش إذًا وسط عالم من العلامات، لا لأنّه يعيش وسط الطّبيعة، بل لأنّه يعيش وسط مجتمع حتى وهو يعيش وحده؛ فما كان لهذا المجتمع الريفيّ أن تقوم له قائمة لو لم يبلور سُننه الخاصة في تأويل المعطيات الطبيعيّة، والتي ستتحوّل حينها إلى معطيات ثقافيّة”([49]).
في السّياق نفسه؛ نجد أنّ “إيكو” يميّز بين تعامل الإنسان في العصور الوسطى مع العلامات وبين الإنسان الحديث. إذ نجد “أنّ الإنسان الوسيط يستدعي عالمًا محدّدًا؛ حيث يستطيع العيش والتوجه بحسب علامات مؤكّدة، أمّا الإنسان الحديث فيرى ضرورة تأسيس مسكن جديد من دون أن يعرف قوانينه الغامضة؛ فيبقى مسكونًا على الدوام بذكرى الطفولة الضائعة”([50]). بناءً على ذلك؛ “إيكو” يرى أنّ العصر الوسيط كان محكومًا بعقلٍ شديد الثقة بنفسه ينتج علامات مؤكّدة، تجعل الإنسان قادرًا على العيش في ظلّ منظومة فكريّة وثقافيّة يثق بها ويتخذها معراجًا، ويتوجه بناءً عليها إلى العيش الآمن والمطمئن. أما إنسان العصر الحديث؛ فهو محكوم بعقلٍ قائم على المغامرة التي باتت بديلًا عن العلامات المؤكّدة، إلى درجة أنّ هذا العالم الحديث بات بالنسبة إلى الإنسان الحديث أشبه بالمسكن الذي يجهل عنه هذا الإنسان قوانينه التي وصفها “إيكو” بالغامضة.
إنّ العلامات التي يتحدّث عنها إيكو هي علامات موضوعيّة تخضع للسنن التي رسّختها العلاقات والقواعد الاجتماعيّة. ولكنّ العلامات هذه قد تصبح ذاتية مع أنّها ترجع في أصالتها التكوينيّة إلى السّنن الاجتماعيّة الموضوعيّة، فالهاجس الوحيد عند روبارتو([51])، في أوّل عهده على ظهر السّفينة دافني “هو أن يكتشف كائنًا حيًا”([52]). لقد كان هذا السّعي مشفوعًا بدافع أو هاجس من الخوف الشّخصيّ الذي انتاب ناجيًا من الغرق، وهو يحتاج إلى أنيسٍ فوق ظهر سفينة تائهة بين أمواج المحيطات المتلاطمة. لذلك؛ هذا الهاجس الذاتيّ كان وراء استنطاق ما استنطقه من علامات. لكنّ السّؤال الذي يطرح نفسه هنا: هل الذاتيّة متعالية على الموضوعيّة في هذه الحال؟
إنّ ظروف هذا الناجي على ظهر السّفينة هي التي أوقعت قراءة العلامات في قبضة الذاتيّة. الناجي روبارتو يحاول التقاط الأدلّة، بشكل تدقيقيّ، محاولةَ قاضٍ حريص يريد الوصول إلى الحقيقة، خصوصًا أنّ الحقيقة ليست عاديّة بالنسبة إلى روبارتو. إذ لو افترضنا من كانوا على متن السّفينة هلكوا جميعًا، لوجد روبارتو هنا أو هناك، على سطح السّفينة جثث الموتى الآخرين، لو قبلنا فكرة أنّهم روموا في البحر. كما أنّ هناك غيابًا لقارب النجاة. آخر من بقي على قيد الحياة، أو جميعهم ابتعدوا عن السّفينة”([53])، إنّها المنافسة بين علامتين في اتجاهٍ دلاليٍّ واحد.
إنّ عدم وجود جثث فوق سطح السّفينة إشارة إلى وجود من رماها في البحر تخلصًا منها، والتخلّص إشارة إلى حرص الباقين على قيد الحياة أن تبقى السّفينة صالحة للحياة، فأين هم؟ ويأتي غياب قارب النجاة، العلامة الثانية، ليعزّز هذه القراءة للعلامة الأولى. ولكن هل يوصلنا هذا إلى ما هو يقينيّ بخصوص إمكان وجود بشر فوق ظهر تلك السّفينة، وهل هو الأساس الذي يتعلّق بما يبحث عنه روبارتو؟، أمسك من جديد بطرف خيط يشير إلى وجود شخص آخر على ظهر السّفينة، ذلك “أنّ تلك النباتات التي كانت ما تزال طرية وحيّة تؤكّد كما هو الأمر بالنسبه إلى الطعام أنّ حفظها قد تمّ منذ وقت قريب”([54]).. العلامة باختصار ما هي إلّا عقل اصطدم بالواقع (التجربة).
العلامات أفضليّات لا حقائق: إنّ الثقافة الإنسانيّة هي المسؤول الأوّل عن إنتاج العلامات، لأنّ الإنسان وفقًا لها يقوم بتحويل الطّبيعة إلى علامات ثقافيّة تمكّنه من فهم هذه الطّبيعة وتحويلها إلى معجم من المصطلحات والعلامات اللغويّة والفكريّة التي يتمكّن من خلالها تكوين “درايته الموسوعيّة”([55])؛ التي تجعله قادرًا على فهم العلامات والدلالات والتواصل مع الآخرين. هذا فضلًا عن تحقيق إمكانات الفهم الموحّد أو شبه الموحّد لتلك العلامات التي يبثها الإنسان في سبيل التواصل مع الآخرين، أو التي تفصح عنها الطّبيعة بشكل اعتباطيّ. لكنّ الإنسان، في حياته الثقافيّة هذه، هو في حالٍ من الصّراع بين الماضي والحاضر، وبين النّظر إلى الماضي من الحاضر، والنّظر إلى الحاضر من الحاضر، فعندما يصبح الحاضر ماضيًا، سينشأ صراع بين الماضي بما هو وبين الحاضر بما هو من جهة، ونظرته إلى الماضي من جهة ثانية. إذ إنّ التاريخ الثقافيّ للإنسان، عند “إيكو”، عبارة عن مرحلتين أساسيتين، حين “كان إنسانًا وسيطًا في مرحلة زمنيّة محدّدة، وإنسانًا حديثًا في مرحلة أخرى. العقل الوسيط محكوم بعقل قائم شديد الثقة بنفسه ينتج علامات (مؤكّدة)، تجعل الإنسان قادرًا على العيش، والتوجه بناءً عليها بكلّ أمان وطمأنينة.
أمّا العصر الحديث؛ فهو محكوم بعقلٍ قائم على المغامرة التي باتت بديلًا للعلامات المؤكّدة”([56]). وإذا اكتشف الوعي البشريّ أنّ في العالم “مغامرةً مفتوحة على الإمكانات”، فسيدرك حتمًا عجزه عن القبض على الحقيقة، “فكلمتا “مغامرة” و”إمكانات” مفتوحتان على عدم النّهاية. وإذا تقاسمت ثنائية الفشل/ النجاح كلمة “المغامرة”، وما في ذلك من إشارة قويّة إلى ارتباك محاولة القبض على الحقيقة، فإن الكلمة الثانية “إمكانات” محكومة بتوالديّة مستمرّة لا تنقطع؛ تنهي أي أمل في عمليّة القبض على الحقيقة”([57]). إنّ هذا العجز عن القبض على الحقيقة يستحضر ثنائية غياب النّظام وضرورة النّظام؛ حيث نجد أنّ الغياب يتعالى على الوجود والضرورة، فعندما تتخلّى الثقافة الإنسانيّة عن التصوّر الثابت للنظام؛ يعني أنّنا دخلنا دائرة غياب النّظام.. فهل يمثل هذا الغياب دخول دائرة الفوضى؟ وهل يعني وجود مغامرة مفتوحة على الإمكانات الفوضى عينها؟
لقد كانت الهندسة الإقليديّة([58]) هي المسيطرة بلا منازع على علم وعالم الهندسة لمدة طويلة من الزمن، وهي الهندسة التي رأت “أنّ المسلّمات هي حقائق “مؤكّدة” قبليّة ثابتة ومطلقة أبديّة أزليّة غير قابلة للتغير والتبدّل، وكانت هذه الهندسة تمثل، بشكل واضح، مرحلة ما قبل الحداثة الثقافيّة، حين كانت العلامات مؤكّدة وواثقة”([59]). أمّا مرحلة الحداثة؛ فقد مهّدت وأسسّت وكوّنت عالمًا من الهندسات اللاقليديّة، الأمر الذي مثّلَ “جهدًا جديدًا قامت به الثقافة لتوسيع أفاقها، فما وصلت إليه هو عالم هندسات متعدّدة لا هندسة واحدة، وكلّها لا إقليديّة، أي إنّها مفارقة للبديهيّات والمسلّمات التي قامت عليها الهندسة الإقليديّة، يعني مفارقة أي نظام أو انتظام”([60]). إنّها حقائق لا حقيقة واحدة.
إذا نظرنا إلى الموضوع من زاوية أخرى، نرى تأثر “إيكو” بما ذهب إليه “إدموند هوسرل”([61])، وهو أحد أبرز وأهمّ فلاسفة المدرسة الفينومينولوجيّة، والذي يرى أنّ الحقيقة لا يمكن الإمساك بها، “إنّ جوانب الموضوع التي تُلتقط، حقيقةً في كلّ إدراك حسيّ تحيل إلى الجوانب التي لا تُلتقط، والتي لا يكون توقّعها إلّا بالانتظار، بوصفها مظاهر ستأتي في الإدراك الحسيّ”([62]). وإذا شاطر “إيكو” هوسيرل الرأي؛ فهذا معناه أنّ الإدراك الحسيّ هنا عاجزٌ عن الإمساك بكلّ ما يقوم عليه الموضوع من جوانب، إذ ستحيل الجوانب الملتقطة إلى جوانب أخرى غير ملتقطة، وستحيل هذه الأخرى في حال التقاطها إلى جوانب جديدة لم تُلتقط. وبذلك أراد “إيكو” إفهامنا أنّ الإنسان يعيش انتظارًا دائمًا مؤسسًا على توقّع مضمونه من حيّز المستقبل لا الحاضر، وعليه لا إمكان لالتقاط الحقيقة كاملة أصلًا. ويبدو واضحًا، هنا، أنّ “إيكو” قد تأثر بتفكيكيّة “جاك دريدا” ما بعد الحداثة.
إنّ الحداثة الغربيّة، وفقًا لــ” إيكو”، تستند إلى سلطة العقل العلميّ لتحديد الحقيقة، مدعيّة القدرة على بلوغ الحقيقة اليقينيّة التي تستطيع الإحاطة بكلّ جوانب الموضوع والتفريق بين الخطأ والصواب. لقد وصلت سلطة العقل العلميّ هذه إلى ميدان الفلسفة، فأصبحت الفلسفة في بعض مدارسها -كما مع الماركسيّة- فلسفة علميّة تسعى إلى الوصول إلى الحقيقة الماديّة اليقينيّة، وليس إلى الحقائق المجرّدة. وهذا ما رفضته فلسفة التفكيك مع “دريدا”، والتي عرفت بــ”فلسفة ما بعد الحداثة” التي هدفت إلى تقويض حاكميّة العقل. هذا نفسه نجده عند “إيكو” في أحد أجوبته: “لم يكن هناك سوى أفضليّات لا حقائق”([63]). وهذا يكشف اعتقاد “إيكو” بعدم حاكميّة العقل العلميّ، ويشكّل تاليًا إشارة واضحة إلى نسبيّة الحقيقة؛ أفضليّات لا حقائق.
لقد تأثر “إيكو” أيما تأثير بــ”دريدا” والفلسفة التفكيكيّة خاصة في نظرته للحقيقة، وإلى حدٍّ ما في رؤيته التأويليّة، مع أنّ “إيكو” ليس فيلسوفا تفكيكيًا صرفًا في العمليّة التأويليّة، وانطلاقا من هذا نجده يقول: “في مفهوم التفاوض أساسًا في السّيميائيّات، كما في السّياسة، ما من قيمة للحقيقة المطلقة”([64]). ويذهب “إيكو” أبعد من ذلك في موقفه من الحقيقة؛ حين يقول: الواقعيّ الحقيقيّ ليس ذاك الذي يؤكّد أنّ الأشياء موجودة وبأنّنا نعرفها، بل الذي يشكّ بأنّها موجودة”([65]).
لقد أخرج “إيكو” الواقعيّ الحقيقيّ المدرك بالحواس ما يتبادر إلى الذهن من فهم لذلك الواقعيّ، الشّك في واقع الأشياء هو الواقعيّ الحقيقيّ بالنسبة إليه، إنّها النقلة من المشي على أرض صلبة إلى التخبّط في طريق التيه.. إنّه يعمل على إعادة النّظر في المفاهيم الحداثيّة ليدخل في دائرة ما بعد الحداثة. وهذا ما يُدخل الفكر والثقافة الإنسانيّين وكذا العلامات، في دوامة من التيه، فالحقيقة هي البحث عنها من دون أن تجدها، وليس أن تجدها، متى وجدت لم تعد حقيقة. وكأنّ “إيكو” يقول: الحقيقة الثابتة جمود، والحقيقة التائهة حياة.
نتيجة وتحليل: قام “إيكو” برحلة طويلة في تقفّي أثر الحقيقة أو العلامة السّيميائيّة وتعلّقاتها، ابتداءً من طبيعتها الخام أو الصناعيّة، إلى اللّفظ والمدلول والقاموس والدّراية الموسوعيّة والسّنن والرمز، وتصنيفات العلامات وكيفيّة إنتاجها ومكانتها في اللّغة والعلم والحياة والفلسفة، وصولًا إلى كونها قضيّة فلسفيّة تحاكي تجربة الإنسان بوصفه حيوانًا رمزيًّا علاميًّا، يفهم العلامات وينتجها ويفهم العالم والوجود وذاته من خلالها. يمكننا أن ندرك، من خلال هذه التجربة الطويلة والشاقة، والتي كانت الرواية جزءًا تطبيقيًا منها، على قاعدة أنّ “إيكو” يرى أنّ ما لا يمكن تنظيره ينبغي سرده، أنّ كلّ محاولة لحصر العلامة ضمن قاعدة واضحة ونهائية لا تعدو كونها حلمًا صعب المنال.
المصادر والمراجع
- أمبرتو إيكو، السّيميائيّة وفلسفة اللّغة، ترجمة أحمد الصمعي، دار المنظمة العالمية للترجمة، توزيع مركز الوحدة العربيّة، الطبعة الأولى، بيروت، 2005.
- بلقاسم الزميت، المسارات العامة لتحديد مفهوم العلامة، موقع إلكترونيّ، https://www.aljabriabed.net/n57_04azmit.htm؛ تاريخ الزيارة في 8/12/2023.
- أمبرتو إيكو، العلامة تحليل المفهوم وتاريخه، ترجمة سعيد بنكراد، الطبعة الثانية، المركز الثقافي العربيّ، الدار البيضاء، بيروت، 2010.
- علي مهدي زيتون، المدرسة الإيكوبة في الكتابة، الطبعة الأولى، دار المعارف الحكمية، بيروت، 2018.
- أمبرتو إيكو، اسم الوردة، ترجمة أحمد الصمعي، الطبعة الثانية، دار الكتاب الجديدة المتحدة، بيروت، 2016.
- أمبرتو إيكو، جزيرة اليوم السّابق، ترجمة أحمد الصمعي الطبعة الأولى، دار أويا، ليبيا، 2000.
- ياسر زغيب، المرشد في الفلسفة، الطبعة الثالثة، دار الندى، بيروت، 2015.
[1]– طالب دكتوراة في المعهد العالي للدكتوراه في كلّية الآداب والعلوم الإنسانيّة والاجتماعيّة في الجامعة اللّبنانيّة- قسم الفلسفة.
A PhD student at the Higher Institute of Doctorate in the Faculty of Arts and Humanities and Social Sciences at the Lebanese University- Department of Philosophy.Email: yaserzgheib1970@gmail.com
[2]– أستاذ محاضر في كلية الأداب والعلوم الإنسانيّة في الجامعة اللّبنانيّة – قسم الفلسفة.
Lecturer at the College of Literature and Humanities at the Lebanese University- Department of Philosophy Email: dr.khanjar_hamieh@hotmail.com
[3]– أمبرتو إيكو، السّيميائيّة وفلسفة اللّغة، ترجمة أحمد الصمعي، دار المنظمة العالمية للترجمة، توزيع مركز الوحدة العربيّة، الطبعة الأولى، بيروت، 2005، ص 112.
[4]– جورج إدوارد مور (1873-1958) هو فيلسوف بريطاني أثر في كثير من الفلاسفة البريطانيين المعاصرين، دافع عن نظرياّت الفِطرة السّليمة وشجع على دراسة اللّغة العاديّة أداةً للفلسفة.
[5]– برتراند أرثر ويليام راسل (1872 – 1970)، فيلسوف وعالم منطق ورياضيّ ومؤرخ وناقد اجتماعيّ بريطانيّ. قاد الثورة البريطانيّة “ضد المثاليّة” في أوائل القرن العشرين. يُعدّ أحد مؤسسي الفلسفة التحليليّة، وأهمّ علماء المنطق في قرنه. ألف بالشراكة مع أي. إن. وايتهيد مبادئ الرياضيات في محاولة لشرح الرياضيات بالمنطق. وتُعدّ مقالته الفلسفيّة عن التدليل (On Denoting) نموذجًا فكريًا في الفلسفة. وما يزال لعمله أثر ظاهر على المنطق والرياضيات ونظريّة المجموعات واللّغويّات والفلسفة وتحديدًا فلسفة اللّغة ونظريّة المعرفة والميتافيزيقيا.
[6]– ألفريد نورث وايتهيد (1861- 1947)، هو فيلسوف وعالم رياضيات إنجليزيّ والشّخصيّة الأساسيّة في المدرسة الفلسفيّة المعروفة باسم “فلسفة الصّيرورة”، والتي وجدت طريقها، في الوقت الحالي، للتطبيق في مجالات عدة بما في ذلك الإيكولوجيّ (علم البيئة) واللاهوت والتربية والفيزياء والبيولوجيا والاقتصاد والسّيكولوجيا ومجالات علمية أخرى. ثم حوّل انتباهه إلى فلسفة العلم، وفي نهاية المطاف إلى الميتافيزيقيا، ثمّ انغمس في تأليف الكتب عن فلسفة الصّيرورة.
[7]– جاك دريدا (1930 – 2004 باريس، فرنسا) فيلسوف فرنسيّ وناقد أدبيّ.. يعدّ أوّل من استخدم مفهوم التفكيك بمعناه الجديد في الفلسفة، وأوّل من وظفه فلسفيًا بهذا الشكل ومن أجل ذلك هو من أهم الفلاسفة في القرن العشرين. هدفه الأساس يتمثل بنقد منهج الفلسفة الأوربيّة التقليديّة، من خلال آليّات التفكيك الذي قام بتطبيقها إجرائيا من أجل ذلك.
[9]– أندريه لالاند (André Lalande) (1876-1963)، فيلسوف فرنسيّ. كان أستاذًا مساعدًا في الفلسفة في السّوربون، وأستاذ كرسي في العام 1918، ثم عمل أستاذًا في الجامعة المصرية. تخرّج على يديه الفوج الأوّل من طلاب قسم الفلسفة. أَلف “المعجم الفلسفيّ” المعروف بمعجم لالاند. آمن بالأخلاق وقال بنظريّة عكسيّة تقوم على فكرة أساسيَّة وهي: أنَّ قانون الحياة ليس التطوّر (Evolution) ولكنَّه الانحلال (Dissolution) أو التطوّر العكسيّ، أي من التنوع إلى التجانس. استخدم كلمة (Involution) التي هي عكس (Evolution)، بمعنى التطوّر إلى الوحدة والتجانس، أو التطّور من الاختلاف إلى التشابه.
([10]) فريدريك دانيال إرنست شليرماخر بالألمانية (Friedrich Schleiermacher) (1768-1834) كان لاهوتيًا وفيلسوفًا وعالمًا في الكتاب المقدّس، عرف عنه محاولته التوفيق بين الانتقادات الموجّهة إلى التنوير مع المسيحيّة البروتستانتيّة التقليديّة. كما أصبح مؤثرًا في تطوّر النقد العالي، ويشكل عمله جزءً أساسيًا في مجال علم التأويل الحديث.
[11]– أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن أحمد بن رشد (520 هـ- 595 هـ) يسمّيه الأوروبيون Averroes واشتهر باسم ابن رشد الحفيد (1126-1198م) هو فيلسوف وطبيب وفقيه وقاضٍ وفلكيّ وفيزيائيّ عربيّ مسلم أندلسي. نشأ في أسرة من أكثر الأسر وجاهة في الأندلس، واشتهر بجهود للتوفيق بين الدّين والفلسفة والقول بضرورة التأويل للنصول الدينيّة، وقد ردّ على الفلاسفة والفقهاء الذين كفّروا الفلاسفة في عصره.
[12]– المصدر نفسه، ص 112.
[13]– المصدر نفسه، ص 112.
[14]– المصدر نفسه، ص 112 و113.
[15]– بلقاسم الزميت، المسارات العامة لتحديد مفهوم العلامة، موقع إلكترونيّ، https://www.aljabriabed.net/n57_04azmit.htm؛ تاريخ الزيارة في 8/12/2023.
[16]– أمبرتو إيكو، العلامة تحليل المفهوم وتاريخه، ترجمة سعيد بنكراد، الطبعة الثانية، المركز الثقافي العربيّ، الدار البيضاء، بيروت، 2010، ص 203.
[17] – المصدر نفسه، ص 206.
[18] – المصدر نفسه، ص 206.
[19]– المصدر نفسه، ص 207.
[20]– أمبرتو إيكو، السّيميائيّة وفلسفة اللّغة، مصدر سابق، ص 16.
[21]– أَرِسْطُو (384 ق.م – 322 ق.م) أو أَرِسْطُوطَالِيس أو أرسطاطاليس الملقب بالمعلم الأوّل، هو فيلسوف يونانيّ وتلميذ أفلاطون ومعلّم الإسكندر الأكبر. ويعد مؤسس مدرسة ليقيون ومدرسة الفلسفة المشائية والتقاليد الأرسطيّة، وواحد من عظماء المفكّرين. تغطي كتاباته مجالات عدة، منها الفيزياء والميتافيزيقيا والشّعر والمسرح والموسيقى والمنطق والبلاغة واللّغويات والسّياسة والحكومة والأخلاقيّات وعلم الأحياء وعلم الحيوان. كان لفلسفته تأثير فريد في كلّ شكل من أشكال المعرفة تقريبًا في الغرب، ولا يزال موضوعًا للنقاش الفَلْسَفيّ المعاصر.
[22]– أمبرتو إيكو، العلامة تحليل المفهوم وتاريخه، مصدر سابق، ص 205-207.
[23]– أفلاطون Plato (427ق.م-374 ق.م)، هو أرستوكليس بن أرستون، فيلسوف يونانيّ كلاسيكيّ، رياضياتيّ، ويعدّ مؤسس لأكاديميّة أثينا التي هي أوّل معهد للتعليم العالي في العالم الغربي، أستاذه سقراط وتلميذه أرسطو. رائد المدرسة المثاليّة في الفلسفة، نادى بالمجتمع الإنسانيّ الأمثل من خلال النّظام السّياسيّ الذي نظّر له في “كتابه الجمهورية”، والذي عرف فيما بعد بـ” المدينة الفاضلة”.
[24]– يرى القديس توماس الأكويني أنّ علامات الكتابة المقدّسة لا يمكن قراءتها قراءة مجازية، فهي وحيدة المعنى، فعندما يقول الكتاب المقدّس إنّ المعجزة الفلانيّة قد حدثت، فهذا معناه أنّ المعجزة قد حدثت فعلًا. وما يمكن تأويله وقراءته قراءة مجازية هي الأحداث داخل التاريخ المقدّس، إنّها كلمات تنتمي إإلى لغة كونيّة قام الله بتنظيمها لكي نتمكّن من قراءة مصائرنا وأقدرانا.
[25]– المصدر نفسه، ص208.
[26]– المصدر نفسه، ص 208.
[27]– إنّ نظريّة باولو بازوليني “العلاقة بين اللّغة السّيميائيّة ولغة الواقع”، قد وضعها في كتاب له تحت عنوان empirismo eretico، “هرتقة التجريب”، طبع لأوّل مرة باللّغة الإيطاليّة في مطبعة، Garzanti، سنة 1972، وخصّص لها فضلًا كاملًا ما بين ص 171-297.
[28]– أمبرتو إيكو، العلامة تحليل المفهوم وتاريخه، المصدر السّابق، ص 209.
[29]– بلقاسم الزميت، المسارات العامة لتحديد مفهوم العلامة، مرجع سابق.
[30]– أمبرتو إيكو، العلامة تحليل المفهوم وتاريخه، مصدر سابق، ص 8.
[31]– علي مهدي زيتون، المدرسة الإيكوبة في الكتابة، الطبعة الأولى، دار المعارف الحكمية، بيروت، 2018، ص 130.
[32]– المرجع نفسه، ص 130.
[33]– أمبرتو إيكو، اسم الوردة، ترجمة أحمد الصمعي، الطبعة الثانية، دار الكتاب الجديدة المتحدة، بيروت، 2016، ص 51.
[34]–علي مهدي زيتون، المدرسة الإيكوية في الكتابة، المرجع السّابق، ص127.
[35]– المرجع نفسه، ص 51.
[36]– المرجع نفسه، ص 175.
[37]– إيمانويل كانط أو عَمانُوئيل كنط (بالألمانية: Immanuel Kant) (1724 – 1804). هو فيلسوف ألمانيّ ولد في مدينة كونيغسبرغ في مملكة بروسيا عاش حياته كلّها فيها. كان آخر وأهم الفلاسفة المؤثرين في الثقافة الأوروبيّة الحديثة. وهو أحد الفلاسفة المهمّين الذين كتبوا في نظريّة المعرفة الكلاسيكيّة. كان إيمانويل كانط آخر فلاسفة عصر التنوير الأوروبيّ، وقد تميّز بطرحه منظورًا جديدًا في الفلسفة ما يزال يؤثر في الفلسفة الأوروبيّة والفكر الإنسانيّ حتى الآن. وما تزال مؤلفاته تحظى باهتمام كبير في الفلسفة والفكر الإنسانيّ؛ ومن أهمها : نقد العقل الخالص، ونظريّة المعرفة، ونقد العقل العملي.
[38]– علي مهدي زيتون، المدرسة الإيكوية في الكتابة، مرجع سابق، ص 47.
[39]– المرجع نفسه، ص47.
[40]– المرجع نفسه، ص88.
[41]– المرجع نفسه، ص 133.
[42]– أمبرتو إيكو، اسم الوردة، المصدر السّابق، ص 461.
[43]– المصدر نفسه، ص 95.
[44]– علي مهدي زيتون ، المدرسة الإيكوية في الكتابة، مرجع سابق، ص 133.
[45]– أمبرتو إيكو، العلامة تحليل المفهوم وتاريخه، مصدر سابق، ص 203.
[46]– إرنست كاسيرر فيلسوف ألمانيّ ومؤرخ ينتمي إلى ما يُسمّى بـــ”مدرسة ماربورج” في “الفلسفة الكانطيّة الجديدة”. اشتهر كأبرز بشارح للفلسفة النقديّة الكانطيّة في القرن العشرين. غادر ألمانيا في العام 1933، وتوفي في نيويورك. من مؤلفاته المهمّة “فلسفة الأشكال الرّمزيّة” و”مقال في الإنسان” و”فلسفة التنوير”. وله كتابات أخرى في فلسفة العلم، والأسطورة، واللّغة والتاريخ.
[47]– المصدر نفسه، ص 203.
[48]– أمبرتو إيكو، العلامة تحليل المفهوم وتاريخه، المصدر السابق، ص 33-34.
[49]– المصدر نفسه، ص 34.
[50]– علي مهدي زيتون، المدرسة الإيكوية في الكتابة، المصدر السّابق، ص 26.
[51]– ربارتو هو أحد أبطال رواية امبرتو إيكو “جزيرة اليوم السّابق“.
[52]– أمبرتو إيكو، جزيرة اليوم السّابق، ترجمة أحمد الصمعي الطبعة الأولى، دار أويا، ليبيا، 2000، ص 241.
[53]– المصدر نفسه، ص 19.
[54]– المصدر نفسه، ص 47.
[55]– الدراية الموسوعية هي القاموس الفرديّ الذاتيّ عند الإنسان المتلقّي حول معاني العلامات ومعرفتها، بما يتوافق مع الثقافة المجتمعة.
[56]– علي مهدي زيتون، المدرسة الإيكوية في الكتابة، مرجع سابق، ص 27.
[57]– المرجع نفسه، ص 27-28 .
[58]– الهندسة الإقليديّة نسبة للفيلسوف الرياضيّ اليونانيّ إقليدس بن نوقطرس بن برنيقس الإسكندريّ الذي ولد سنة 300 ق م، ويعود له أوّل نظام هندسي في مجال المسلّمات الهندسيّة.
[59]– ياسر زغيب، المرشد في الفلسفة، الطبعة الثالثة، دار الندى، بيروت، 2015، ص 112-113.
[60]– علي مهدي زيتون، المدرسة الإيكوية في الكتابة، مرجع سابق، ص 28.
[61]– إدموند هوسرل Edmund Husserl، (1859- 1938)، هو فيلسوف ألمانيّ ومؤسّس الظاهريّة أو الفينومينولوجيّة، بعد دراسته الفلسفة والرياضيات عمل استاذًا للفلسفة في جامعة هاله ثمّ في جامعة غوتنغن، كتب كثيرًا من كتب الفلسفة من أبرزها: “فلسفة علم الحساب” (1891)، و”بحوث منطقية” (1900-1901)، و”الفلسفة كعلم دقيق” (1911)، و”أفكار: “مقدّمة عامة لفلسفة ظاهرية خالصة” (1913)، و”المنطق الصوري والمتعالي” (1929)، و”تأملات ديكارتية” (1932)، و”أزمة العلوم الأوروبية والظاهريات المتعالية” (1936)، و”التجربة والحكم” (1939).
[62]– المصدر نفسه، ص 29.
[63]– علي مهدي زيتون، المدرسة الإيكوية في الكتابة، مرجع سابق، ص 18.
[64]– المرجع نفسه، ص 18.
[65]– المرجع نفسه، ص 18.