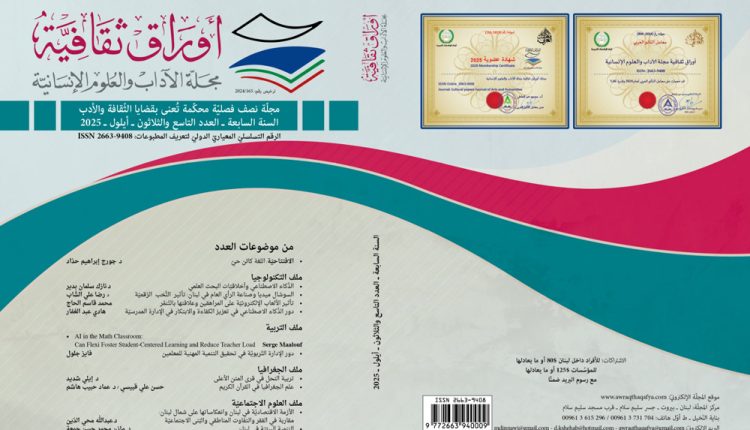عنوان البحث: التنمية البيئيّة في لبنان
اسم الكاتب: د. مازن محمد حسن جمعة
تاريخ النشر: 2025/09/15
اسم المجلة: مجلة أوراق ثقافية
عدد المجلة: 39
تحميل البحث بصيغة PDFADOI: https://aif-doi.org/awraq/013909
التنمية البيئيّة في لبنان
Environmental development in Lebanon
Dr. Mazen Mohammad Hassan Jumaa د. مازن محمد حسن جمعة([1])
تاريخ الإرسال:10-8-2025 تاريخ القبول:18-8-2025
المستخلص
تهدف هذه الدّراسة الى الإشارة الى المشاكل البيئيّة المتنوعة الموجودة في المجتمع، وماهي الوسائل والأساليب والسياسات التي يمكن اعتمادها في تخطي المشاكل البيئيّة ؛من تلوث، وتصّحر ونقابات ومقالع وكسّارات. ويمكن النّظر الى مشكلة حماية البيئة في حدود إطارين: إصلاح العطب، خفض استهلاك المواد غير المتجددة، وتشير هذه الدّراسة الى طرق الوقاية من النّفايات الصلبة، ومعالجة مشكلة مياه الصّرف الصّحي والقمامة وهناك مهام لوزارة البيئة والجمعيات البيئيّة.
وأخيرًا نلفت النظر الى المؤتمرات المهمّة التي عالجت البيئة، إذ أدّت الى المتغيّرات المتعلقة بها.
الكلمات المفتاحيّة: التنمية البيئيّة، مشاكل البيئة، الجمعيّات، المؤتمرات، وزارة البيئة
Abstract
This study aims to highlight the diverse environmental challenges present in Lebanese society and to explore the methods, strategies, and policies that can be adopted to address them—ranging from pollution and desertification to waste management, quarries, and stone crushers.The issue of environmental protection is considered within two primary frameworks: repairing environmental damage and reducing the consumption of non-renewable resources. The study points to preventive measures for managing solid waste, treating wastewater and garbage, and it emphasizes the roles and responsibilities of the Ministry of Environment as well as environmental associations. Finally, the study draws attention to key conferences that have addressed environmental concerns and led to significant changes in environmental awareness and policy.
Keywords: Environmental development, environmental problems, associations, conferences, Ministry of Environment.
مقدمة
إن موقع لبنان المطل على السّاحل الشّرقي للبحر المتوسط، وتنوع طبيعته ووفرة مياهه تجعل منه موقعًا مميزًا تتنوع منظوماته الأيكولوجيّة الطبيعيّة الغنيّة بالكائنات الحيّة المتعددة، ما يستدعي حماية مكثفة وسريعة لا سيما أنّ هذه البيئة الغنيّة سريعة العطب نظرًا لموقعه الجغرافي، ولإنعدام الحماية ولا مبالاة سكانه([2]).
إن موجة التّمدن السّريع والهجرة الدّاخليّة والنّمو الاقتصادي والآثار التّخريبيّة للحرب وعجز الحكومة وغياب الدّولة والتّخطيط على صعيد إدارة النّفايات، وتصريف المياه وتلويث الهواء إلخ… أدّت كلّها إلى تدهور سريع وكارثي في وضع لبنان البيئي.
وقد أدركت الحكومة اللبنانيّة أهمّية الأزمة البيئيّة في لبنان بعد الحرب فقامت بإنشاء وزارة البيئة([3])، وعلى الرّغم من قيام هذه الوزارة برعاية مشاريع الدّراسات، واقتراحات القوانين إلّا أنّها تعاني من عدم كفاية الموارد البشريّة، والماديّة للقيام بالمهمة المصيريّة التي وضعت لها، وتتميز هذه السّلطات المعطاة لها لفرض التوجيه البيئي وتحقيق الإلتزام به بالضعف الشديد([4]).
وإذا تمعنّا بالقوانين اللبنانيّة منذ نصف قرن حتى اليوم نرى أنّ غالبيتها ومنذ 1921، قد أحاطت بالعديد من الأمور التي تتعلق بالبيئة. فمنعت تشويه الشواطئ والأملاك العامّة وتملكها، وسرقة الآثار فالرّمال والحصى ورمي النّفايات على الطرقات أو في الأملاك العامة والخاصة، ومنعت تصريف المياه المبتذلة سواء بوساطة الآبار الإرتوازيّة أو في الأنهار ومجاري المياه وعلى الشواطئ.
لكن هذه القوانين المجتزئة والمبعثرة بقيت عمليًّا من دون تطبيق، وما يعطل تطبيقها هو التّخلف العقلي لروح التكنولوجيا الحديثة التي نستعملها في لبنان، وأنانيتنا الجامحة وسعينا اللامحدود للربح وفساد العديد من الإدارات العامة وتكاثر مافيات الربح السّريعة([5]).
- أسباب إختيار الموضوع وأهميته: إن الأوضاع البيئيّة في لبنان متدهورة إلى درجة أنها تجعل إعادة إنتاج بيئة صحيّة وسليمة أمرًا صعبًا ومكلفًا في آن، الأمر الذي دفع الكثير من الهيئات والمؤسسات بل والدّول في الوقت الحاضر إلى تولية البيئة اهتمامًا كبيرًا وخاصة قضية التّلوث وانتشار القمامة، الغبار والأتربة، الغازات السّامة، طفح المجاري الاحتراق المتزايد للوقود الأحفوري، كثرة الاستخدام للأسمدة والمبيدات.
وبما أن البيئة للجميع وتهمّ الجميع، ومشكلاتها تنعكس على الجميع فإنّ انتقاءنا لهذا الموضوع عائد بالدرجة الأولى لأسباب تمثل خطورة مشكلة التلوث في بيئة لبنان.
- إشكالية البحث: لا شكّ أن مشكلة التلوث البيئي، هي من أبرز قضايا العصر بوصفها ظاهرة خطيرة تعاني منها مجتمعات كثيرة، ويسعى الإنسان بطرق شتى للحدّ من آثارها السّلبيّة على صحته ومن هذه الزاوية نطرح مشكلة التّلوث البيئي في لبنان، لأجل إيجاد الحلول والوسائل للحدّ من تفاقم آثارها وخطرها. بناء عليه لا بد من طرح التساؤل الرئيس الآتي:
ما هي السياسات والبرامج والإجراءات التي ينبغي اتخاذها للتخفيف من التلوث البيئي؟
أمّا الأسئلة الفرعيّة، فقد صيغت على الشكل الآتي:
- هل تقوم الدولة بدورها على الصعيد البيئي؟
- هل تسعى الجمعيّات الأهليّة بفعاليّة لحماية البيئة؟
- ماهي أبرز المؤتمرات التي عقدت على المستوى العالمي وعلى المستوى المحلي لتحقيق التنمية البيئة؟
- هل تدعم وزارة البيئة الجمعيات الأهلية دعمًا ماديًا؟
- الفرضيات: هي جواب احتمالي مسبق على أسئلة الإشكاليّة، يمكن أن يثبت صحّتها أو عدم صوابيتها عند الانتهاء من معالجة الموضوع، وفي محاولة للرّد على تساؤلات الإشكاليّة، فقد طرحنا الفرضيات الآتية:
- إنّ تدني مستوى البيئة، وتدهورها مرده إلى إهمال الحكومة لجهة تطوير سياسات بيئيّة واضحة بإصدار تشريعات بيئية متكاملة.
- وزارة البيئة عاجزة عن تأمين الحدّ الأدنى من الدعم المادي، والمعنوي لتواصل الأنشطة البيئيّة بشكل مستدام.
- هناك عدد كبير من الجمعيات الأهليّة المبنيّة على مبدأ حماية البيئة، إلّا أنّ مردود عملها وعمل ناشطيها متواضع حتى الآن.
- لقد عقدت العديد من المؤتمرات لحماية البيئة إلّا أن توصياتها غير ملزمة وإختياريّة، ما أدى إلى التقليل من فعاليتها في حماية البيئة.
- منهج البحث: في ما يتعلق بالمنهج فقد استُخدِم المنهجين الآتيين: المنهج المقارن والمنهج الوصفي. ويمكن أن يعتمد عليهما في العديد من الحالات:
تحديد أفضل الممارسات يمكن استخدام المنهج المقارن، والمنهج الوصفي لتحديد أفضل الممارسات البيئيّة في مجال معين. ويمكن استخدام المنهج المقارن والمنهج الوصفي، لتقييم فعالية السياسات والبرامج البيئية في مختلف الدول.
ويستخدم المنهج المقارن والوصفي في تطوير النّظريات، والنّماذج التي تشرح الظواهر الاقتصاديّة والإجتماعيّة والبيئيّة.
التنمية البيئيّة:عُرِّفت التنمية البيئيّة أنّها نوع من التنمية الدّاخليّة القائمة على الاعتماد على الذّات، انطلاقًا من منطق يقوم على حاجات مجموع السكان وليس من أجل الإنتاج ذاته، وبوعي كامل لبعدها البيئي، ساعية إلى تحقيق التّعايش بين الإنسان والطبيعة، ويفترض هذا التّعايش علاقة حميميّة لدرجة تجعل العنصرين المكونين للنّسق يخضعان لتعديلات مفيدة لكليهما.
ولا يعني هذا التعريف العودة إلى أسلوب الحياة البدائيّة، فالتنمية البيئيّة إحدى أدوات استكشاف خيارات تنموية معقولة. ويمثل التّحدي في التّوصل إلى شكل للنمو يتيح المواءمة بين التقدم الاجتماعي، والاقتصادي والإدارة الرّشيدة للموارد والبيئة. يكمن الخطر في حقيقة أن الأرض التي لم تستغل بعد محدودة للغاية، وأنّه في الوقت الذي تنمو فيه التكنولوجيا بسرعة في المجالات غير الأساسيّة، فإنّها تتسم بطابع الجمود في مجال الغذاء مثلًا. إنّنا نشير نحو أقصى استفادة من الزراعة للتكنولوجيا ضئيلة الكفاءة، تهدد في أن تسبب انهيار الأنظمة التي تكفل استمرار الحياة، ما يترتب على ذلك من المجاعات وسوء التّغذية العامة، والانخفاض الحادّ لمستوى المعيشة ويتمثل جوهر التنمية البيئيّة في العمل على أن تستهدف استراتيجيّات، وخطط وسياسات وتكنولوجيّات التنمية تحاشي هذا المصير.
فالموضوع المطروح للنقاش ليس مجرد الحفاظ على البيئة من أجل البيئة نفسها، أو المحافظة على بعض مواضع الجمال لأغراض ترفيهيّة، بل الحفاظ على قاعدة الموارد في حال جيدة قادرة على توفير الحاجات الأساسيّة لأحفادنا، وبمستوى مماثل على الأقل للمستويات الحاليّة إن لم يكن أفضل؛ لذلك يمكن النّظر إلى التنمية بوصفها عمليّة درء خطر الكوارث البيئيّة، والمقصود بالكوارث البيئيّة الكبرى التي تلحق بمناطق واسعة في الكون، هي زيادة عدد سكان العالم إلى الدّرجة التي يصبح الفقر معها دائمًا وغير قابل للاستئصال حيث يعيش الناس في مدن الأكواخ يعانون من شظف العيش وصعوبة تدبير المأكل والملبس، وفي حالة من الضعف، لا تسمح لهم حتى بالثورة التي لن توفر إذا قامت، وفي أفضل الأحوال، سوى نوع من التّخفيف المؤقت لحد بؤسهم([6]). إن هذا التقدم في التفكير بالعلاقة بين البيئة، والتنمية يكشف أنّ بلدان العالم عمومًا لا تواجه في الحقيقة، وقلّة اختيار بين التنمية والبيئة فالاختيار في الواقع ليس بين البيئة، والتنمية ولكن بين بدائل ممكنة في مجال التنمية، والمهم أن يحاول الإنسان أينما كان على هذا الكوكب، التعرف إلى تلك البدائل في الاستهلاك والإنتاج والتكنولوجيا وأنماط استغلال التربة، وتصميم المصانع وتخطيطها وفي تطوير المستوطنات البشريّة، وأن يستخدم منها ما يؤدي إلى تحقيق تحسن الحياة على أسس بيئيّة سليمة. وعلينا أن نعي تمامًا أنّ الوقاية من النّشر يجب أن تفضل دائمًا على العمل العلاجي، وقد ثبت أن من المستحيل الحصول على نتائج مهمّة إذا اختصر الأمر على توفير الطعام، واتخاذ عمل دفاعي عند إعداد مشروعات التّصنيع، والمدن والأفضل استبعاد أسباب معيّنة للتلوث عند إنشاء مصنع أو بناء مدينة جديدة مثلًا.
وما تزال الفرصة سانحة أمام الدّول النّاميّة، وهي تأخذ خطوات تنموية للاستفادة من المشكلات البيئيّة التي واجهت الدّول الصناعيّة عندما استخدمت العمل والتكنولوجيا في عملياتها التنموية، بل إنّ الطّريق أمام تخطيط عالمي شامل طويل المدى له أثر إيجابي لا يستبعد أن يؤدي بالبشريّة إلى البيئة الفاضلة على غرار المدينة الفاضلة الأسطوريّة.
ومن ذلك، يمكن النّظر إلى مشكلة حماية البيئة في حدود إطارين إصلاح العطب، وخفض استهلاك المواد غير المتجددة.
- إصلاح العطب: لقد أحدثت معدات الإنسان التكنولوجيّة على مدى ثلاثة قرون مجموعة من الأخطاء البيئة المؤسفة، لا يستقيم الحال من دون تصحيحها، فالأحياء البريّة والبحريّة تعرضت لصنوف الأذى من تشريد، وقتل وصل إلى حدّ الانقراض وإجراءات الحماية تقضي بسن التّشريعات الصّارمة للمحافظة على الأحياء البريّة، والبحريّة من اعتداءات الإنسان والتّوسع في إنشاء المحميّات من شأنه أن يُبقي على الأحياء المهددة بالانقراض… ونقل الأنواع قليلة العدد إلى حدائق الحيوانات من شأنه أن يوفر لها فرص الاستمراريّة، والتّكاثر يمكن أن تنقل بعدها إلى مواطنها الأصليّة.
والتّلوث النوعي والكمي عطب بيني كبير، ولا بدَّ أن يجهد الإنسان في مكافحته على كل المستويات البشريّة من منزليّة وترويحيّة وصناعيّة وزراعيّة، والتربة الزراعيّة تناولها الخلل من جراء إهمالها وتعريضها المستمر لعوامل الجرف والإسراف في استغلالها، ما أوجب اللجوء إلى استخدام مخصبات متنوعة، كما أن انتشار المدن قد قلّص من مساحة الأراضي الزراعيّة، الخلل في الأرض الزراعيّة يتوجب إصلاحه.
- خفض استهلاك الموارد غير المتجددة: إنّ حرص الإنسان على رفع مستوى معيشته، والسّعي إلى أسلوب حياة الترف أديا إلى استهلاك الكثير من موارد البيئة غير المتجددة، ما جعلها مهددة بالنّفاذ والنّضوب، وحماية هذه الموارد يقتضي أن تساهم البشريّة أفرادًا، وجماعات وعلى كل المستويات في العمل على إعادة استخدام مخلفات الموارد من زجاجات فارغة، وعلب الصّفيح والفضلات الخشبيّة والسّيارات السّكراب (الخردة) والحماية تقتضي البحث عن بدائل للموارد غير المتجددة وعلى الأخص الطاقة.
فالسيارات الخردة، يمكن فكّها وقطعها واستخدامها، ويمكن صهر الباقي لصناعة نوع جديد من الصّلب، وعلب الألمنيوم الفارغة يمكن أن تصهر وتُصنّع منها شرائح جديدة من الألمنيوم تستخدم استخدامات شتى، والزّجاجات الفارغة يمكن أن تجمع وتفرز حسب الألوان، وأمّا الغابات نفسها فهي تحمى من الانقراض بالغرس المستمر والصّيانة، ولهذا التّحريج علم له متخصصون خبراء ومياه المجاري تجمعها كثير من الدّول وتعالجها قبل أن تستخدم في الزراعة، أو تدفع في البحر… وهناك تفكير جاد لاستعادة مياه عذبة تصلح للشّرب من مياه المجاري.
- الوقاية من التلوث نتيجة المياه المستعملة والصّرف الصحي: ويكون ذلك بتطبيق القوانين في التنظيم المدني، والعمل على دراسة المخطط التّوجيهي الكامل للصرف الصّحي في لبنان، وذلك بإنشاء محطات لتكرير مياه الصّرف الصّحي، ومعالجته على الأراضي اللبنانيّة كافة، مثال ذلك المحطات الآتية: طرابلس كسروان الغدير بيروت الجيّة صيدا صور النبطية زحلة وتبنين، وهناك الكثير من المحطات الصّغيرة، هذه المحطات مدروسة بحيث تستقطب المجاري حسب أحواض مسطحات القرى والمدن، وبعضها يشتغل وبعضها قيد الإنشاء وقسم بحاجة إلى ترميم، وإعادة بناء وهناك عدد كبير من المحطات بحاجة إلى البناء على الأراضي اللبنانيّة كافة.
أمّا المخلفات المنزليّة الصّلبة (القمامة يمكن أن يستخلص منها أسمدة مفيدة تخصب بها الأراضي الزراعيّة لزيادة إنتاجها، وأمّا تحويل المادة العضويّة التي تشكل ٧٥% من القمامة بالانحلال الحراري إلى غاز الميثان الذي يمكن أن يستخدم وقودًا للسيارات والمواقد وغيرها.
الوقاية من النفايات الصّلبة
- العمل على النّفايات العادية بفرزها مراعاة استخدامها Recycling هذه العمليّة سهلة جدًا، وكل ما وجب عمله هو الاهتمام عن طريق البلديات بتجميع هذه النّفايات بأكياس، ولكن قبل جمعها يجب فصلها عن بعضها البعض، فتوضب المواد التي يعاد استعمالها في حاويات خاصة بها مثل الورق – البلاستيك – الزّجاج – الحديد، أمّا النفايات العضويّة فتُؤخذ إلى معامل التّسبيخ ليعاد استعمالها في الزّراعة كمواد سماديّة عضويّة، أمّا المواد العاديّة كالزّجاج المكسر والعظام والمواد المشابهة فتُجمع، وتستعمل في الرّدم للطرقات الجديدة أو تُحرق بشكل علمي لإعادة طمرها في مطامر صحيّة، أمّا نفايات المستشفيات فإنّ لها شركات خاصة تعتمد على الطرق العلميّة المختصة في التّخلص منها.
- طريقة الحرق وتوليد الطاقة هذه الطريقة لا تعني طريقة الحرق في العراء أو في أماكن بعيدة، بل هنالك طريقة حرق النّفايات في معامل خاصة جدًا وعلى درجة حرارة تزيد عن ۸۰۰ درجة سليسيوم وتولد منها الطاقة الحراريّة.
- طريقة معالجة النّفايات بالتّفكك الحراري، وهي طريقة علميّة حديثة تستعمل في عدد كبير من دول العالم.
- طريقة التّرحيل فتستطيع ترحيلها إلى سوريا إلى أيّة منطقة أخرى من الصّحاري العربيّة، كليبيا والمغرب ومصر ومناطق نائية أخرى([7]).
المبيدات على أنواعها بالغ الإنسان في إنتاجها وفي استهلاكها حتى هناك من رشها بالطائرات، والمبيدات سموم لا تميز في الكثير من الأحيان بين حيوان وآخر ولا بين نبات وآخر، وهناك أمراض عديدة تعزى للمبيدات كسرطان الدّم والتهاب الكبد والحساسيّة، لذلك فإنّ الاقتصاد في استخدام المبيدات يحمي البيئة من مواد كيميائية خطرة.
للحدّ من التلوث بالمبيدات لا بدّ من اتباع أسلوب المكافحة المتوازنة تندمج خلاله أساليب التّحكم الكيماويّة والحيوية والبيئيّة المتمثلة في الخطوات الآتية:
- استخدام أقلّ كمية ممكنة من المبيدات.
- تطوير المبيدات: إن المبيد المثالي يكون لنوع أو أكثر من الحشرات الضارة بشرط أن يكون مأمونًا لكل صورة الحياة الأخرى.
- إبادة الحشرات الضارة قبل انتشارها.
- رش المبيدات في الأوقات المناسبة لأحوال الطقس.
- ضرورة معرفة نوعيّة الحشرات وطور نموها، والمادة الكيماوية والكمية المناسبة للقضاء عليها.
- التأكد من التّخزين الجيد والمضبوط لكي لا تسرب وتلوث البيئة.
- عدم جني المحصول المرشوش حديثًا بالمبيدات قبل انقضاء مدّة كافية لاختفاء آثار المبيد.
- المكافحة الحيويّة تتركز المكافحة الحيويّة على استعمال الحشرات المفترسة، أو الطفيليّة للحدّ من انتشار الأنواع الضارة، وعلى أسلوب تعقيم الذّكور من فرص الأخصاب لدى الإناث.
- المكافحة البيئيّة وهذه تشتمل على أساليب حديثة للتّعامل مع الأراضي الزراعيّة من شأنها تقليل فرص التكاثر لدى الحشرات، متمثلة في تنظيف الأرض من بقايا المزروعات، وحرثها وتطبيق دورة زراعيّة محكمة تتعاقب خلالها المحاصيل الزراعيّة، وتتضمن المكافحة البيئيّة الأمور الآتية:
- نصب المصائد الضوئيّة وهي تجذب إليها العديد من الحشرات.
- تطوير نباتات جديدة مقاومة للآفات.
- تقليم الأشجار بإزالة الأفرع الكبيرة.
- وضع مادة لزجة حول الجذوع لمنع بعض الحشرات من تسلقها.
- حفر فنادق طولية أمام تقدم أسراب الجراد لكي تعيق تقدمه.
وللتقليل من مشاكل التلوث الغذائي يمكن اتباع الإرشادات الآتية:
- مقاومة الحشرات والآفات الزّراعيّة بالأسلوب المتكامل الذي تتضافر فيه المكافحة الحيويّة والبيئيّة والكيماويّة.
- تنظيم عمليّة إنتاج وتسويق واستخدام المبيدات، فلا يستعمل منها إلّا المبيدات التي تضر بالصّحة.
- اتباع الطرق العمليّة في التصنيع والمناولة، والتّخزين فلا تتعرض المواد الغذائيّة التلوث والفساد.
- الفحص الفني المستمر للأطعمة المحفوظة، والتأكد من تاريخ صلاحيتها وإتلاف الكميّات التي انتهت مدتها.
- سنّ القوانين الخاصة الأغذيّة.
- وضع قوانين تحدّ من ظاهرة الباعة المتجولين.
- الرّقابة الصّحيّة في المذابح ومحلات بيع الأسماك واللحوم والخضروات.
- وضع رقابة مشددة على المطاعم.
- عدم استخدام مياه المجاري في الرّي.
- حفظ الأغذية في أواني مُحكمة الإغلاق لحمايتها من الذّباب والصراصير.
- طهي الطعام جيدًا خاصة اللحوم والبيض.
- حفظ القمامة في صناديق أو أكياس خاصة، وتجميعها دوريًا في أوقات محددة.
- نشر الوعي البيئي بين الجماهير عن طريق وسائل الإعلام والاتصال الثقافيّة، وإدخال مادة حافظة للبيئة ضمن برامج التّعليم في المدارس والجامعات.
- يتعين على الدّول الغنيّة التبرع بمزيد من معونات التنمية للدّول الفقيرة وإلغاء ديونها.
- عدم تعبئة أصناف معينة في عبوات بلاستيكيّة، وخاصة اللبن الزبادي والزيت ولبن الأطفال، لأنّ البلاستيك يسبب أمراض سرطانيّة للإنسان.
- وضع وزارة البيئة والجمعيات البيئيّة وتوصيات لتقويتها:
- مهام الوزارة وطريقة إدارتها: لقد استحدثت وزارة البيئة في لبنان بناء للقانون ۲۱٦ تاريخ ٢ نيسان ۱۹۹۳ ولكن هذا القانون جاء غامضًا، ولم توضح بنوده أسس علاقات التّعاون بينها وبين الوزارات والإدارات المختلفة.
تحدد المادة الثانية من القانون ۲۱٦ مهام وزارة البيئة كما يلي:
- إعداد سياسة عامة في كل ما يتعلق بشؤون البيئة، واقتراح الخطوات اللازمة لتنفيذها بالتّنسيق مع الإدارات المعنيّة.
- المحافظة على المحيط الذي يتصل بحياة الإنسان، والمجتمع سواء أكان طبيعيًّا أو من صنع الإنسان.
- مكافحة التلوث مهما كان مصدره، وبطرق قانونيّة أو علاجيّة.
- تحديد:
- كيفيّة معالجة النّفايات والمياه المبتذلة.
- شروط التّرخيص بإنشاء المصانع والمعامل، والمناطق الصناعيّة ومزارع الدّواجن والمزارع الحيوانيّة والكسارات والمقالع والمناجم ومصانع الزفت.
- الشّروط والقوانين لاستعمال الأراضي العامّة على اختلاف أنواعها.
- تحديد أنواع الحيوانات أو الطيور المسموح بصيدها.
- تنظيم حملات تربويّة وتوعية بالنسبة إلى المحافظة على البيئة.
- تشجيع المبادرات الفرديّة والجماعيّة التي من شأنها تحسين أوضاع البيئة.
- تصنيف المناظر والمواقع الطبيعيّة وإصدار المراسيم الخاصة والقرارات لحمايتها.
- تحضير الخطط الوقائيّة لمجابهة الكوارث والأضرار([8]).
تنقسم إدارة الوزارة إلى ثلاث مصالح رئيسة بالإضافة إلى المديرية العامة للبيئة، ومجلس استشاري متخصص لوزارة البيئة.
- المديريّة العامة للبيئة تتولى الإشراف على أعمال الوحدات الإداريّة التابعة لها، والتّنسيق مع إدارات ومؤسسات القطاع الخاص والعام في كل ما يتعلق بحماية البيئة.
- مصلحة المحافظة على الطبيعة تتولى الإشراف على صيانة الأراضي العامة، والغابات وحماية المواقع الطبيعيّة والمحافظة على الرّمول والشواطئ من التلوث.
- مصلحة حماية البيئة السكنيّة تتولى الإشراف على كيفيّة معالجة النّفايات، وصرف المياه المبتذلة وحماية الهواء والماء من التلوث.
- مصلحة الوقاية من مؤثرات التكنولوجيا والمخاطر الطبيعيّة، تتولى دراسة وإبداء الرأي في طلبات الاستيراد للمواد الكيماويّة، والمبيدات والإشراف على المصانع المحليّة المنتجة للمواد الكيماويّة وعلى معالجة النفايات الصناعيّة.
- الوضع الحالي للجمعيات البيئيّة غير الحكوميّة: بدأت فكرة الجمعيّات البيئيّة غير الحكوميّة منذ العام ۱۹۷۰ بوساطة علماء وباحثين في هذا الموضوع، كان دور الجمعيّات يشدد على التّوعية البيئيّة بين الناس، وعلى لفت الانتباه للمشاكل البيئيّة والصحيّة الملحة.
ففي نهاية الثمانينيات أصبح في لبنان حوالى ۳۲ جمعيّة تُعنى بالبيئة، ومشاكلها موزعة في أنحاء الأراضي اللبنانيّة جميعها، وتركز اهتمامها على المشاكل البيئيّة الطارئة كل في منطقته، في غياب للتنسيق في ما بينها أو مع مؤسسات القطاع العام.
وفي العام ۱۹۹۲ تأسس التّجمع اللبناني لحماية البيئة، وأصبح الآن يضم حوالى ٢٤ جمعيّة تحت لوائه يتركز اهتمامه على التّشجير إنشاء المحميّات المحافظة على الأبنية الأثريّة مثل الجوامع، والكنائس إنشاء نوادٍ بيئية في المدارس والجامعات، والتّوعية بشأن المحافظة على البيئة ولكن أداءه يبقى ضعيفًا بسبب قلّة الموارد الماليّة والبشريّة والتقنيّة.
وفي العام ١٩٩٥، حضرت استراتيجيّة جديدة وخطة عمل لتفعيل عمله، خطة العمل شملت أربع نقاط:
- اعتماد استراتيجيّة لجمع الأموال عبر مساعدة خبراء.
- اعتماد استراتيجيّة بعيدة الأمد للتجمع عبر طلب المساعدة من الخبراء.
- إنماء القدرات المؤسساتيّة.
- إنشاء حلقة وصل للمعلومات بين الجمعيات البيئة، وعملها هو جمع المعلومات البيئيّة، ونشرها بينهم عبر سبل اتصال حديثة بدأ العمل بها منذ شباط (١٩٩٥).
جمعية بيئة بلا حدود “مغدوشة”: تأسست سنة ۱۹۹۳ بعد عودة سكانها من التّهجير دام لثلاث سنوات، حلّت مشكلة النّفايات وإدارتها مساهمة السّفارة الهولنديّة، وتجاوزت الجمعيّة مشكلة تعطل الشّاحنة بعد شراء أخرى حديثة لجمع النّفايات بمساهمة السفارة الإيطاليّة.
أمّا مشروع فرز النّفايات المنزليّة عضويّة – صلبة – بطاريات – كرتون فهو بمساهمة منUNDP حاليًّا تقوم الجمعيّة بالتّفتيش عن قطعة أرض لاستعمالها في تخمير النّفايات العضويّة وتحويلها إلى أسمدة، وضمن مشروع النّظافة العام نُظِّف كرم العريش ثم طُرِشت جذوع الأشجار، والأعمدة باللون الأبيض على امتداد الشّارع العام، وأُنشئت غابة عائلة البيئة في البلدة التي تتضمن أكثر من خمسمئة نصبة صنوبر جوي يزيد عمرها على عشر سنوات، أمّا إدارة مياه الشّفة في بلدة مغدوشة فهي أيضًا من مهمات الجمعيّة.
جمعيّة هيئة حماية البيئة والمحافظة على التراث في النبطيّة: أقامت الجمعيّة حملات تشجير وتوزيع النّصوب وحملات مكافحة حشرات الأشجار لا سيما آفة دودة الصندل، وتبرز إنجازات الجمعيّة في ميادين التربية والصّحة والتّوعية البيئيّة، فأَنشأت نوادٍ بيئيّة وأَصدِرت مجلات تربويّة، وتوعيّة بيئيّة القيام، وأطلقت حملة الكشف الصّحي في المدارس الرسميّة، والبدء في بناء وإعداد محتويات المتحف البيئي أضف إلى بناء مركز الجمعيّة ومكتبة خاصة للأطفال والشّباب في المدينة، ومن الإنجازات الأخيرة على الصّعيد البيئي تنظيم الجمعيّة مشروعها لمسح النفايات الطبيّة في النّبطيّة لإحصاء كميّة النُّفايات الطبيّة الخطرة، والنُّفايات الخطرة والمعدية والنّفايات المشعة.
نشاطات جمعيّة البيئة والإنسان حبوش: نظمت الجمعية بالتّعاون مع البلدية حملات نظافة عامة، والعناية بالأشجار المزروعة أضف إلى تشجير مداخل البلدة، ورش المبيدات على مدار فصلي الربيع والصيف، وعلى صعيد حملات التوعية والتثقيف فقد أطلقت البلدية حملاتها في المدارس للمحافظة على البيئة بدءًا من المدرسة والبيت إلى الشارع.
جمعية التنمية للإنسان والبيئة – صيدا: لقد نجحت الجمعيّة في سعيها لإيجاد بلديات صديقة للبيئة، والإنسان تمكّن الشّباب المتطوعين من خلال اللجان النيابيّة في البلديات المشاركة في الشّأن البيئي كطريقة لتعزيز التواصل، وردم الهُوة بين الشّباب ومؤسسات المجتمع المدني، تقوم الجمعيّة بتحقيق النّجاحات المزدهرة في برامجها بالتّنسيق والتّعاون مع عدد من الجمعيات الأهليّة المهتمة بالبيئة في مختلف المناطق اللبنانيّة، وقامت الجمعيةّ بالتّصدي لعمل الكسارات والمقالع والمصانع الملوثة، وإقامة حملات التّوعية للتجمع المحلي على أهمّية فرز النّفايات، وقد شاركت أكثر من مئة جمعيّة مهتمة بالبيئة في عمليّة الفرز من المنزل كما جرت حملة وطنية لتنظيم السير في لبنان.
جمعيّة المستقبل الأخضر – جزين: نفذت الجمعيّة مجموعة من النّشاطات من أكثرها أهميّة:
- تقديم مقاعد خاصة للمقعدين (أكثر من خمسمئة مقعد) إلى مستوصفات البلدات المحتاجة.
- إقامة جورة لجمع النّفايات فيها تمهيدًا لإنشاء معمل لفرز النّفايات، وتخميرها إلّا أنّ هذا المشروع توقف بوساطة الأيدي السياسيّة في البلدة.
- تنظيم لقاء بيئي ودعوة خمس عشرة جمعية مهتمة بالوضع البيئي من مختلف الأراضي اللبنانيّة.
جمعيّة رابطة شباب الخرطوم – الإنمائيّة: تميزت الجمعيّة أنّها تقوم مقام البلديّة في أعمالها البيئيّة جميعها، وعملت منذ تأسيسها ۱۹۹۸ على تنفيذ مجموعة من النّشاطات، من أكثرها أهمّيّة الالتزام مع متعهد من أهل البلدة بجمع الّنفايات، ورميها خارج البلدة بسعر رمزي قدره ٢۰۰۰۰ ليرة شهريًّا من كلّ منزل، وبإشراف مهندس زراعي ثم إزالة النّفايات على طول مدخل البلدة، ونزع الأعشاب اليابسة على جوانب الطرقات كافة، وبالإشتراك مع ۱۳۰ متطوع من الشّباب، ثم تشجير حديقة عامة بسماحة ١٧ ألف م، وأقامت الجمعيّة دورات صيفيّة للأطفال لمدة شهر واحد شارك فيها ۱۷۰ طفلًا، تتراوح أعمارهم بين 5 و ۱۸ عامًا تضمن برنامج المخيم نشاطات بيئية وتربويّة وأشغال يدوية وألعاب ترفيهيّة.
- المؤتمرات المهمّة التي عنيت بالبيئة:
التوجه للإهتمام بالبيئة منذ بداية السبعينيّات: كانت بداية السبعينيّات نقطة البداية في تطور أبحاث البيئة والسياسات المتبعة إزاءها، وجاء هذا الاهتمام من خلال الوعي المتزايد بتدهور البيئة، وتلوثها سواء لدى الرأي العام أو للبعض من متخذي القرار السياسي وسميت هذه الحركة البيئيّة)، واتجه كثير من الطلاب للبحث في مضمار البيئة متأثرين في ذلك ببعض الكتب مثل كتاب “الربيع الصامت” لجارسون العام ١٩٦٣ أو كتاب أرض واحدة فقط للسيدة هاردور يويس العام ۱۹۷۲، أو حدود النمو لميدوس العام ۱۹۷۲ وفي خلال تلك الحقبة شهدت مجموعة من دول العالم مثل بريطانيا وكندا، والولايات المتحدة والمكسيك إقامة أقسام للبيئة في حكومتها وإصدار تشريعات عديدة لحماية البيئات فيها.
مؤتمر ستوكهولم: هو أول مؤتمر تعقده الأمم المتحدة وترعاه، يركز بصورة عامة على البيئة، وحضره ممثلو ۱۱۳ دولة إضافة لمجموعات من ممثلي المنظمات غير الحكوميّة في دول الشّمال الذين حضروا المناقشات وكان التّركيز الأساسي في موضوعاته على:
- التّلوث في الماء والهواء على مستوى البيئات الصغيرة (المحليّة).
- مشكلات النّمو الحضري.
- كيفيّة المحافظة على البيئات وصيانتها.
- الوقوف في وجه أخطار القوى النوويّة.
- الحاجة لحماية الثدييات البحريّة.
- اتهمت الدّول النّامية الدّول المتقدمة بمحاولة إبطاء معدلات النّمو الاقتصادي في الجنوب، بحجة التّحكم في تلوث الإنسان للبيئة، وكان من نتائج المؤتمر المهمّة تأسيس برنامج الأمم المتحدة للبيئة في نيروبي المعروف باختصار بـ UNDP الذي يعد مظهرًا للاهتمام العالمي بالبيئة.
ولم يؤدِ الجغرافيون سوى دورًا محدودًا في مؤتمر ستوكهولم، ولكنهم سرعان ما نشطوا بقوة، وأصدروا العديد من الكتب والمقالات، والأبحاث حول انتقادات السياسات البيئيّة المناخيّة وتطويرها، وعملوا على إجراء عدد من الدّراسات الجغرافيّة المنافسة للأساليب الكمّيّة والإحصائيّة التي انصبت على تقييم دور الإنسان في تغيير بيئاته، وآثار التنمية المختلفة على استنزاف الموارد، بل وتدميرها في بعض الحالات، وأدّت فروع الجغرافيا الطبيعيّة التّطبيقيّة دورًا حيويًّا في هذا الصدد وتوجه النّقد بقوّة للمدرسة الإمكانيّة في الجغرافيا البشريّة، بل والنّظريّة التنمية ذاتها، ونوقشت سلوكيّات البشر إزاء الكوارث الطبيعيّة مثل الجفاف أو الفيضانات والانزلاقات الأرضيّة والإنهيارات([9]) الجليديّة وزحف الرمال.
ندوة بلغراد ١٩٧٥: حدّدت ندوة بلغراد في أكتوبر ۱۹۷۵ بدعوة من اليونسكو، وبالتّعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة غايات وأهداف وخصائص التربية البيئيّة، والمنتفعين منها وتهدف التربية البيئيّة إلى إعطاء الإنسان القدرة على فهم ما تتميز به البيئة من طبيعة معقدة نتيجة للتفاعل الدّائم بين مكوناتها البيولوجيّة، والفيزيائيّة والاجتماعيّة والثّقافيّة والتربية البيئيّة، كذلك تسعى إلى إيجاد وعي وطني بأهميّة البيئة أخيرًا تهدف إلى إيجاد وعي على أهمّية التكامل البيئي. ولكن كيف السّبيل إلى بلوغ هذه الأهداف. يتطلب بلوغ هذه الأهداف عمليّة تربويّة تستطيع:
- تطوير مواقف ملائمة لتحسين نوعيّة البيئة عن طريق إحداث تغيير حقيقي في سلوك الناس تجاه بيئتهم، فتؤدي إلى إيجاد الشّخصيّة المنضبطة ذاتيًّا والتي تتصرف في البيئة بروح المسؤوليّة.
- الاستعانة بأساليب شتى لتزويد الناس بمجموعة متنوعة من الكفايات العلميّة، والتقنيّة التي تسمح بإجراء أنشطة رشيدة في البيئة.
أمّا عن خصائص التربية البيئيّة فإنّها تتسم بجملة من السّمات:
- التربية البيئيّة تتجه عادة إلى حلّ مشكلات محددة للبيئة البشريّة، عن طريق مساعدة الناس على إدراك هذه المشكلات.
- التربية البيئيّة تأخذ بمنهج جامع لعدة فروع علميّة في تناول مشكلات البيئة.
- التربية البيئيّة تحرص على أن تنفتح على المجتمع المحلي.
- التربية البيئيّة تتميز بطابع الاستمراريّة.
- التربية البيئيّة تسعى بحكم طبيعتها ووظيفتها لتوجيه شتى القطاعات.
المؤتمر الدولي الحكومي للتربية البيئيّة في تبليس: كان هذا المؤتمر تجمعًا ضخمًا التقى فيه أناس من كل حدب وصوب، جاؤوا إليه يحملون أفكارًا واستراتيجيّات تدعو كلها إلى تنمية خلق بيئي، وضمير بيئي ينقذ المجتمع البشري من ويلات الممارسات الخاطئة في البيئة البشريّة.
الذين التقوا في تبليس كانوا يمثلون مختلف قطاعات المجتمع الدّولي، وزراء تربية مخططون، واضعوا مناهج دراسيّة، معلمون أساتذة جامعات مهندسون، مهنیون محامون قضاة، أطباء، إعلاميّون… وقد قام هؤلاء بداية ذي البدء بتشخيص واقع البيئة الراهن وخلصوا إلى:
- إن الاهتمام الجدي بالمشكلات البيئيّة يشكل ظاهرة حديثة العهد نسبيًّا في مجتمعنا المعاصر.
- ثمة في الوقت ذاته حاجة ملحّة للتنمية، فالفقر هو نوع من تدهور البيئة وإذا نظرنا إليه بهذا المفهوم، فلن يصبح في وسعنا أن نفاضل بعد الآن بين حماية البيئة وبين الحاجة إلى التنمية، كما ينبغي على الإنسان أن يستخدم موارد الأرض بطريقة يمكن معها أن تنتقل إلى أناس لم يشهد العالم مولدهم بعد.
- وعلى الرغم من اتخاذ التدابير والإقدام على عدد من المبادرات على الصعيدين الوطني والدّولي منذ مؤتمر ستوكهولم، فإنّه يبدو أنّها لا تفي بالمتطلبات والآمال التي أعرب عنها في مؤتمر ستوكهولم.
- يقتضي حلّ المشكلات البيئيّة أولًا تحليلًا دقيقًا لها فكثيرًا ما بحثت المشكلات بطريقة جزئيّة، بدلًا من دراستها دراسة شاملة لبحث العلاقات المتبادلة بينها.
- يتعين إعادة النّظر في نماذج التنمية، فقد أصبح من الضروري التمييز بين الضروريات والكماليّات سواء ما يتعلق بالبيئة أو بالتنمية.
- إن حلّ المشكلات البيئيّة يقتضي أولًا تحليلًا دقيقًا لها فكثيرًا ما بحثت المشكلات بطريقة جزئيّة بدلًا من دراستها دراسة شاملة لبحث العلاقات المتبادلة بينها([10]).
المرحلة الثانية في الثمانينيات:
بزغت خلال هذه المرحلة مجموعة جديدة من الاهتمامات البيئيّة، لتوضع على القائمة الدّوليّة متمثلة في:
- دور الأنشطة البشريّة في تأكل طبقة الأوزون.
- التّغيرات المناخيّة، وعلاقاتها باستخدامات الأراضي وأنشطة الإنسان.
- فقدان التنوع البيولوجي.
ولا شكّ أن أسباب عدة مردّها الإسراف الشّديد في الاستفادة من الموارد المتاحة كلّها على سطح الأرض.
لقد أدت الأنشطة البشريّة إلى تغيير النّظام الأرضي أو الكوني من خلال:
- الإسراف الشّديد في استخدام الكيماويات الأمر الذي أضر بطبقة الأوزون وبالمياه والتربة.
- احتراق الوقود الأحفوري الفحم والبترول، والغاز الطبيعي أسهم في تركيز غازات عدة.
وركزت كثير من الأبحاث والدّراسات في مختلف العلوم على هذه التغيرات البيئيّة الكونيّة، وطُبِعت في الجامعات والجمعيّات العلميّة المتخصصة في أبحاث البيئة وبعض الحكومات.
وعُنيت دراسات أخرى بوضع الغابات في حوض الأمازون، وما يتعرض من تدمير واتجهت دراسات بيئيّة أخرى لفحص تأثير التغيرات المناخيّة في البيئات الفقيرة، وتحديدًا في البلدان النّامية واتخذت من المكسيك نموذجًا لذلك.
مؤتمر الأرض في ريو ۱۹۹۲: انعقد في ريو دي جانيرو بالبرازيل وحضره رؤساء ۱۲۱ دولة، وممثلون عن ٥٠٠ منظمة غير حكوميّة وركز المؤتمر بصورة رئيسة على ثلاثة اتجاهات:
التّغيّر المناخي – التنمية المستدامة – حماية التنوع البيولوجي.
وأكد المؤتمر أنّه لا بدَّ لأهل الأرض المجتمعة أن تعمل على:
- الحدّ من المخاطر التي تتعرض لها البيئة.
- التّقليل من معاناة الفقراء في الجنوب بتنازل سكان الشّمال عن بعض أنشطتهم الضارة بالبيئة.
- عدم تصدير المشروعات الضّارة بالبيئات لشّعوب الجنوب.
- التّكاتف للحيلولة دون تدمير البيئات الطبيعيّة.
- تكوين رأي عام عالمي مناهض للاحتكارات الرّأسماليّة، والصّناعيّة التي تهدف لتحقيق الأرباح.
إنّ قمة الأرض عقدت الآمال على تبني ما عرف باسم أعمدة حكمة البقاء السّبعة وهي:
- الاهتمام بسكان الأرض لتعزيز مسؤولياتهم تجاه الوجود، ونشر التّعليم والتّدريب بينهم.
- حقّ الإنسانيّة في امتلاك الغلاف الجوي، والمائي والصّخري والبيولوجي.
- الاستخدام الجيد للموارد الطبيعيّة مثل الأراضي الزّراعيّة والطاقة والمياه العذبة.
- الحرص على إقامة مستوطنات بريّة تحقق الاحتياجات الإنسانيّة الأساسيّة.
- الإدارة الجيدة للكيماويّات، والفضلات الصناعيّة والتّخلص من الملوثات السّامة والمشعّة.
- مواجهة مشكلات التّغيرات الدّيموغرافيّة، ومحاولة للحدّ من الفقر وبالذّات في عالم الجنوب.
- إعادة تنظيم التنمية في المجتمعات البشريّة على أسس جديدة تعمل على خفض التّلوث، ومواكبة نمو السكان مع رفاهيتهم.
- التغيرات المهمّة المتعلقة بالبيئة والتنمية والعوامل المؤثرة بعد قمة الأرض العام ١٩٩٢:
- استراتيجية لبنان البيئيّة وأولوياته:
استحدثت وزارة البيئة في لبنان بناء للقانون رقم ۲۱٦ تاريخ ٢ نيسان ۱۹۹۳ وبما أنّ لبنان موارده الماليّة، والتقنيّة والبريّة والمؤسساتيّة محدودة، ولتحديد هذه الأولويات اعتُمِدت خمسة معايير وهي:
1- الإلحاحيّة ٢- عدم المعكوسيّة ٣- صحّة الإنسان 4- خسارة أسباب الراحة
5-عدد الأشخاص
اعتمادًا على هذه المعايير، حُدِّدت خمس أولويات للعمل المباشر، وهي:
- إدارة النُفايات السّامة.
- إدارة نوعيّة هواء المدن.
- تنظيم استخدام الأراضي خاصة المنطقة السّاحليّة.
- إدارة موارد المياه.
- ضبط انجراف التربة.
المناهج الإستراتيجية المقترحة لذلك:
- تقرير القوانين والأنظمة البيئيّة: وضع مقاييس وحدود للانبعاثات تكون واضحة، وقابلة للتنفيذ خصوصًا في ما يتعلق بنوعيّة الهواء والمياه، تسجيل ومراقبة مصادر التلوث المختلفة مع وضع حوافز لنقلها بعيدًا من المناطق الصناعيّة.
- استعمال الحوافز الاقتصاديّة: التّسعير الملائم للموارد الطبيعيّة (الطاقة والمياه) مثل رفع الدّعم عن الأمور المضرة للبيئة مثل البنزين المحتوي على الرصاص، ووضع الحوافز على الأمور المساعدة للبيئة مثل إلغاء الجمارك على السيارات الجديدة.
- بناء القدرات المؤسساتيّة وثمة حاجة لتقوية المؤسسات القائمة المسؤولة عن الإدارة البيئيّة، وخاصة وزارة البيئة بالإضافة إلى إجراء المراقبة عن طريق الإدارات المحليّة (دوائر التفتيش البيئي في المحافظات والأقضية).
- تعميم المعلومات ونشرها، إنشاء آليات لتعميم المعلومات البيئيّة على الشعب.
- الاستثمار الهادف الاستثمار البيئي جار حاليًّا بشكل جدي، فقد خصص البرنامج مجلس الإنماء والإعمار (أفاق ۲۰۰۰) مبلغ ۱۳۰۰ مليون دولار، وهو يشمل قطاعات إمداد المياه ومعالجة المياه المبتذلة والنّفايات الصلبة.
- التّنفيذ والاستدامة، لذلك لا بد من تنفيذ الشّروط الآلية ديمومة ماليّة تعتمد على استرداد الكلفة، وضرائب التلوث ومشاركة القطاع الخاص، وديمومة مؤسساتيّة مدعومة بهيكليّة قانونيّة حديثة.
ب- برنامج تنمية القدرات: أهمّيّة قمة الأرض أنها أنتجت أخيرًا ۲۱ التي حددت المشاكل البيئيّة، واقترحت الحلول لها، لتنفيذ هذه الأَجندا، انبثق عنها برنامج تنمية القدرات ۲۱ ولكن على كلّ بلد أن يحدد هيكليّة البرامج الفرعيّة فيه حسب أولويات المشاكل البيئيّة التي يعاني منها.
إنجازات الدّولة اللبنانية على صعيد بنود “أجندا” ۲۱:
- على صعيد السّكان: مشروع إعادة المهجرين إلى سكنهم الأساسي ودفع مبالغ تعويضيّة لهم عن طريق صندوق المهجرين، إعادة تفعيل مصرف الإسكان وتشجيع البنوك الخاصة على إعطاء قروض إسكانيّة.
- على صعيد التربية والتعليم:
- هيكليّة جديدة للمناهج التّعليميّة.
- مشروع مرسوم الزاميّة التعليم.
- تأهيل وترميم المدارس الرّسميّة الموجودة.
- مشروع إعادة إعمار بعض المدارس الرّسميّة المهدمة.
- توقيع إتفاق تعاون بين وزارة البيئة، ووزارة التربية لنشر التوعية البيئيّة في المدارس والجامعات بشكل إلزامي.
- وضع اتفاق تعاون ثقافي وتربوي بين الحكومة اللبنانيّة، والحكومات الفرنسيّة السوريّة المصريّة.
- على صعيد الصّحة:
- تأهيل المستشفيات الحكوميّة الموجودة بوساطة مجلس الإنماء والإعمار.
- مشروع بناء مستشفيات حكوميّة جديدة على مستوى عال من التّجهيزات والتّقنيّات الحديثة.
- مشروع الرّعاية الصّحيّة الأوليّة بالتّنسيق مع البنك الدّولي.
- التنسيق بين وزارة الصّحة ووزارة التعليم المهني والتّقني لاستحداث قسم لتخريج مفتش صحي.
- على الصعيد الاجتماعي:
- إصدار بطاقة للمعوقين للتمكن من إجراء إحصاء عنهم بعد الحرب، وتغطية استشفائهم تغطية كاملة على حساب وزارة الصّحة.
- قطاع الخدمات العامة:
- تأهيل كل نواحي البنى التّحتيّة، وتأهيل الأبنية القطاع الصّحة والتربية والإسكان، بالإضافة إلى التنمية الإداريّة (البرنامج الوطني الطارئ لإعادة الإعمار).
- مشروع إنشاء شبكات جديدة بوساطة مجلس الإنماء والإعمار.
- صدور قانون يمنع المستشفيات والمصانع بصرف نفاياتها إلى شبكة المجاري من دون معالجة في مركز خاص بها.
- قطاع السّياحة: هناك فكرة قيد الدّرس بالنسبة إلى زيادة نسبة الاستثمار في الأراضي المصنفة للسياحة وتشجيعها.
- قطاع الصّناعة:
- مشروع لوضع استراتيجيّة لمراقبة التلوث الصناعي مع منظمة UNIDO.
- هناك فكرة قيد الدّرس لتشجيع إقامة مناطق صناعيّة خارج المناطق السّكنيّة.
- قطاع التجارة:
- عقد اتفاقيّات تعاون تجاري مع الدّول المجاورة مثل مصر الكويت -سوريا.
- قطاع العمل:
- عقد اتفاقيّات تعاون مع الدّول المجاورة مثل مصر وسوريا لتسهيل معاملات تبادل العمال.
- قطاع الزراعة:
- مشروع التنميّة الرّيفيّة المتكاملة في بعلبك – الهرمل بالتّنسيق مع UNDP.
- عقد اتفاقيّات مع الدول المجاورة لتصريف الإنتاج الزراعي مثل مصر سوريا – الأردن.
بالإضافة إلى المشاريع الإعماريّة الكبيرة مثل إعادة إعمار وسط بيروت، مشروع اليسار للضاحية الجنوبيّة، مشروع توسيع المطار، وشق أوتوسترادات جديدة على طول الخط السّاحلي، والخط الدّولي مع سوريا التي سيكون لها آثار إيجابيّة في تحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي للسكان.
ج – التّغيرات الصّادرة في لبنان على صعيد إتفاقيّات قمّة الأرض: أمّا بالنسبة إلى الاتفاقيّات التي انبثقت من قمة الأرض، وهي اتفاقيّة التنوع البيولوجي واتفاقيّة مكافحة التّصحر، فلبنان قد وقّع عليها كلّها، وبناء لهذه الاتفاقيّات بدأ لبنان بتنفيذ عدة مشاريع بتمويل من منظمة UNDP.
- اتفاقية تغيّر المناخ: بالنسبة إلى غاز CO2 فكلما ازداد عدد السّكان، زاد استهلاك الطاقة ولكن من المتوقع أن يقلّ انبعاث هذا الغاز بسبب تحسن نوعيّة المولدات المستعملة، والسّيارات والتّحول في محطات إصدار الكهرباء من الفحم، والغاز الطبيعي إلى الطاقة الحراريّة أو الشّمسيّة.
أما بالنسبة إلى CFC فهي تستعمل في تجهيزات التّبريد، والتّدفئة وصناعة العطور وعلى الرّغم من أنّ مساهمة لبنان في هذه المشكلة ضئيلة، إلّا أنّه استدرك ذلك بإصدار وتنفيذ قانون في حزيران ١٩٩٤ يمنع استيراد الـ CFC ووضع برنامجًا للحدّ من استعمالها، وبقايا تأثيرها هذا القرار له تأثير على صعيدين:
- الحدّ من تأثير الـ CFC في مشكلة تغيّر المناخ وطبقة الأوزون.
- رفع مستوى الصناعة ومواكبتها للتقدم التقني.
كما أصدر قرارًا لمنع استيراد الدّواليب المستعملة في لبنان التي غالبًا ما ترمى، أو تحرق فتؤدي إلى تلويث الهواء.
بالإضافة إلى ذلك فقد أنجزت وزارة البيئة بروتوكولًا يحدد نسبة الملوثات في الهواء والماء والتربة إعتمادًا على النسب العالمية.
- اتفاقية التنوع البيولوجي: في لبنان ٤ محميات طبيعيّة هي جزر النّخيل بالقرب من طرابلس، بحيرة عميق في البقاع، منطقة الباروك غابات إهدن، وقد أُعلنت كلّها محميات طبيعيّة بوساطة قرار ۱۲۱ بتاريخ ۹ آذار ۱۹۹۲ ما عدا منطقة أرز الباروك بقانون رقم ٥٣٢ تاريخ ٢٤ تموز ١٩٩٦. وقدمت وزارة البيئة بتاريخ ٢ نيسان،۱۹۹۳ مشروع قانون يتعلق بكيفيّة حماية هذه المحميّات، والمحافظة عليها وإقامة غيرها عبر مشروعين هما مشروع المناطق المحميّةCEF) ) ومشروع البحيرات الطبيعيّة، والشواطئ المحميةMEDWEJ) ) هذا المشروع يظهر التزام الدولة بالمحافظة على المناطق الطبيعيّة وإقامة غيرها من المحميات.
- اتفاقيّة مكافحة التّصحر: أمّا بالنسبة إلى اتفاقيّة الحدّ من التّصحر، فقد اهتم لبنان بهذا الموضوع من منظار أوليات مشاكله، وخاصة مشكلة استخراج الرّمول من الأملاك البحريّة العموميّة، ومشكلة المقالع والكسّارات في الأراضي الدّاخليّة.
بالنسبة إلى استخراج الرّمول من الأملاك البحريّة، لقد أصدر مرسوم رقم ۳۸۹۹ بتاريخ 1-7-1993 ينظم هذا الموضوع بعد أن عشوائيًّا.
أمّا موضوع المقالع والكسّارات التي تؤدي إلى مشاكل عديدة صحيّة – بيئة -جغرافيّة وغيرها، فقد أصدر مرسوم رقم ٥٦١٦ العام ١٩٩٤ لتنظيم عملها والحدّ من المشاكل النّاتجة عنها.
- حماية المياه الإقليميّة: تحسسًا من الدّولة بأهمّيّة مشكلة تلوث المياه الإقليميّة، وخاصة من السّفن الرّاسيّة على شواطئها، لقد أصدرت قانونًا يحدّد كيفيّة التّخزين والنّقل، والتّوزيع للبضائع وخاصة البترول ومشتقاته، هذا القرار هو رقم ٥٥٠٩ بتاريخ ۱۸ آب ۱۹۹٤، ويطلب من وزارة الصناعة والبترول فالمنطقة السّاحليّة لها أهمية كبرى في لبنان، وذلك لإقامة أكثر من 60% من السكان فيها و80% من اليد العاملة في المصانع و78% من وسائل النقل، ولذلك فأيّ مشكلة بيئيّة على الشواطئ سيكون لها تأثير شديد على الصعد الآتية:
- تأثير مباشر وغير مباشر على الصّحة.
- خسائر نوعيّة الحياة.
- تأثير مباشر على البيئة وخسارة الموارد الطبيعيّة.
- خسائر اقتصاديّة.
- تأثير سلبي على نوعية الحياة([11]).
الخاتمة
صحيح أن الثّورة الصناعيّة التي حدثت، طورت وحسنت حياة الإنسان على المستويات جميعها، ولا أحد يستطيع نكران ذلك، لكن عندما تنظر للصناعة والتكنولوجيا من منظور بيئي، فإنّنا لا نستطيع أن نراها إلّا بشكل سلبي وسلبي جدًا، فالأبخرة والغازات والنّفايات وغيرها أدّت إلى حدوث اضطراب بيئي وغذائي أيضًا، فعلى سبيل المثال:
- تلوّث المياه نتيجة رمي النُّفايات بشكل عشوائي وغير مراقب.
- تلوّث الجو نتيجة لتصاعد أدخنة المصانع، ووسائل النقل إضافة إلى الغازات السامة المتصاعدة، مثل الكلور أول أوكسيد الكربون الحديد الزنك والرصاص.
- تلوّث التربة الناتج عن إلقاء النفايات، والفضلات أو حتى دفنها في التربة إضافة إلى استخدام المبيدات الحشريّة، والأسمدة الكيماويّة التي تحتوي على نسبة كبيرة من المواد الكيمائيّة التي تضر بالتربة فتؤثر بدورها على نمو النّباتات.
ولاحتواء هذه الأخطار البيئيّة عقدت المؤتمرات الآتية:
- مؤتمر ستوكهولم العام ۱۹۷۲.
- مؤتمر بلغراد ۱۹75.
- مؤتمر قمة الأرض في ريو العام ۱۹۹۲.
واعترف العالم في أكبر تظاهرة دوليّة عقدت في استوكهولم العام ١٩٧٢ أنّ التكنولوجيا، والتّشريعات والاعتمادات الماليّة لا تكفي بأيّ حال من الأحوال لضمان حماية البيئة، ولا بد من توعية سكان العالم بكل فئاتهم، وتبصرّهم بالدّور الذي يمكن أن يؤديه كل منهم من أجل حماية البيئة، وهذا الاعتراف هو التنبه لدور التربية البيئيّة في ترشيد سلوك الإنسان وهو يتعامل مع البيئة في أي مستوى من مستويات حياته.
أمّا الإتفاقيّات التي انبثقت من مؤتمر قمة الأرض على الصعيد اللبناني هي ثلاثة:
- اتفاقية تغير المناخ.
- اتفاقية التنوع البيولوجي.
- اتفاقية مكافحة التّصحر.
المراجع
- بول سالم، أبعاد الأزمة البيئيّة في لبنان، أبعاد، المركز اللبناني للدراسات، العدد السابع، حزيران 1998، ص 5 -6.
- رشيد الحمد ومحمد سعدي صباريني، سلسلة عالم المعرفة، العدد 22، ص 183 – 186.
- زخيا عبد الله، البيئة اللبنانية واقع وآفاق، أعمال المؤتمر الوطني في حزيران، ص 106.
- علي عيسى إبراهيم وفتحي عبد العزيز أبو راضي، دار النهضة العربية، بيروت، 2004، ص 317 – 318.
- عيسى نعمة الله، الإنسان والبيئة، دار المنهل اللبناني، بيروت، 202.
- مؤتمر التشاور العربي للبيئة، بيروت، 1996، ص 63.
- المؤتمر الجنوبي الأول، البيئة والمجتمع، مقاربات بيئية علمية، ط1، منشورات رشاد برس، بيروت، 1917.
- Coeteau (j-y) le spectre de la pollution dans Encyclopedie cousteaux, Robrtt Loffont, 1975.
- Conference Mondial intercommumale pour la protection de la mer de conseil municipal de Beyrouth, charte de Beyrouth, Etités par le conseil municipale de Beyrouth, 229.
[1]– باحث لبناني، محاضر في كلية الآداب والعلوم الإنسانية/ الجامعة اللبنانية، حائز على شهادة دكتوراه في علم الاجتماع في الجامعة اللبنانية، وكان عنوان الأطروحة: المتطوعون والعمل التطوعي، بإشراف الأستاذ الدكتور إبراهيم مارون.
Lebanese researcher, lecturer at the faculty of letters and human sciences – lebanese university. He holds a PHD in sociology from the lebanese university, his dissertation was titled: Volunteers an Voluntary work, supervised by: Professor Ibrahim Maroun. Email:mazenjomaa78@gmail.com
[2]-زخياعبد الله، البيئة اللبنانية واقع وآفاق، أعمال المؤتمر الوطني في حزيران 1995، ص 106.
[3]– بول سالم، أبعاد الأزمة البيئية في لبنان، أبعاد، المركز اللبناني للدراسات، العدد السابق، حزيران 1985، ص 5.
[4]– بول سالم، المرجع السابق، ص 6.
[5]– زخيا عبد الله، المرجع السابق، ص 106
[6]– نعمة الله عيسى، الإنسان – البيئة، دار المنهل اللبناني، بيروت 202.
[7]– المؤتمر الجنوبي الأول، البيئة والمجتمع، مرجع سابق، ص 7.
[8]– مؤتمر التشاور العربي للبيئة، بيروت، 1996، ص 63.
[9]– علي عيسى إبراهيم وفتحي عبد العزيز أبو راضي، دار النهضة العربية، بيروت، 2004، ص 317 – 318.
[10]– رشيد الحمد ومحمد سعدي صباريني، سلسلة عالم المعرفة، العدد 22، ص 183 – 186.
[11]– مؤتمر التشاور العربي للبيئة، مرجع سابق، ص 57 – 59.