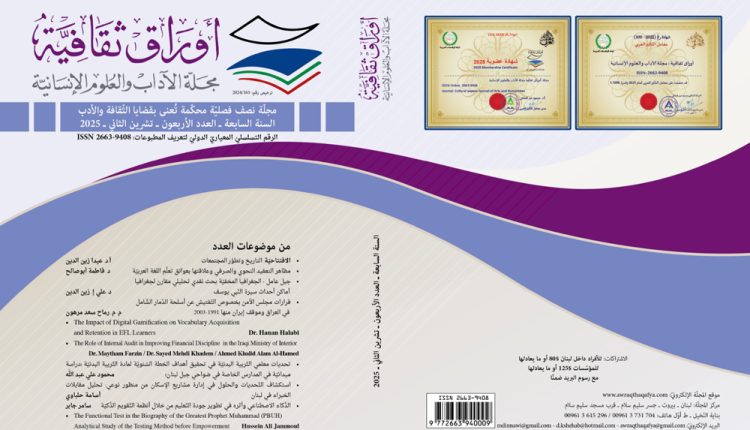عنوان البحث: مظاهر التعقيد النحوي والصرفي وعلاقتها بعوائق تعلّم اللغة العربيّة
اسم الكاتب: د. فاطمة أبوصالح
تاريخ النشر: 2025/11/14
اسم المجلة: مجلة أوراق ثقافية
عدد المجلة: 40
تحميل البحث بصيغة PDFADOI: https://aif-doi.org/awraq/014004
مظاهر التعقيد النحوي والصرفي وعلاقتها بعوائق تعلّم اللغة العربيّة
Manifestations of Grammatical and Morphological Complexity and Their Relation to the Obstacles of Learning the Arabic Language
د. فاطمة أبوصالح([1]) Dr. Fatme Abousaleh
تاريخ الإرسال:28-9- 2025 تاريخ القبول:12-10-2025
ملخّص الدّراسة Turnitin: 2%
تُعدّ اللغة العربيّة من اللغات التي تتميّز بتعقيداتها النّحويّة والصّرفيّة، ما يجعل تعلّمها تحدّيًا كبيرًا للطلاب، سواء أكانوا من النّاطقين بها أو من غير الناطقين. تواجه عمليّة تعلّم اللغة العربيّة العديد من الصّعوبات، خاصّة في السّياقات النّحويّة والصرفيّة، التي تشمل التنوين، الإعراب، تصريف الأفعال، واشتقاق الكلمات من الجذور والأوزان. كما أنّ القواعد المعقّدة التي تعتمد على التغيير المستمر للمفردات حسب موقعها في الجملة، إلى جانب الجمع بين الجذر والوزن في الصرف العربي، تزيد من تعقيد تعلّم اللغة.
تركّز هذه الدراسة على تحليل صعوبات تعلّم اللغة العربيّة، مع التركيز على السّياقات التي تُعَمِّق هذه الصّعوبات. تشمل الدّراسة استكشاف أبعاد التّعقيد النّحوي والصرفي، بما في ذلك التحدّيات التي يواجهها الطلاب في فهم القواعد النحويّة والصرفيّة وتطبيقها. كما تدرس الدّراسة الصّعوبات التي تنشأ من أساليب التّدريس التقليديّة ونقص المناهج الفعالة التي تعزّز الفهم العميق للغة.
تسعى الدراسة أيضًا إلى تقديم استراتيجيّات مبتكرة للتغلّب على هذه الصعوبات، مثل استخدام التكنولوجيات الحديثة والتعلّم النشط، بالإضافة إلى توفير مقترحات لتحسين مناهج تدريس اللغة العربيّة وتطوير أساليب التدريس بما يتناسب مع احتياجات المتعلمين. كما تُسلِّط الدّراسة الضوء على أهمّيّة استراتيجيات التعليم التي تعتمد على الفهم العميق والممارسة الفعليّة للقواعد النحويّة والصرفيّة، بدلاً من الحفظ المجرد للقواعد.
الكلمات المفتاحيّة:صعوبات تعلّم اللغة العربية، التعقيد النحوي والصرفي، الإعراب، تصريف الأفعال، اشتقاق الكلمات، استراتيجيّات التدريس، المناهج التعليميّة، التعلّم النشط.
Abstract:
Arabic is considered one of the most complex languages to learn due to its intricate grammatical and morphological structures. The learning process faces several challenges, especially in the grammatical and morphological contexts, which include issues like inflection, syntactic parsing, verb conjugation, and word derivation based on roots and patterns. The complex rules that depend on the continuous modification of words according to their positions in sentences, as well as the integration of roots and patterns in Arabic morphology, further complicate the learning process.
This study focuses on analyzing the difficulties of learning Arabic, particularly in the contexts that deepen these challenges. The study explores the dimensions of grammatical and morphological complexity, including the difficulties faced by learners in understanding and applying grammatical and morphological rules. It also examines the problems arising from traditional teaching methods and the lack of effective curricula that enhance deep understanding of the language.
Additionally, the study aims to propose innovative strategies to overcome these challenges, such as using modern technologies and active learning, and provides recommendations for improving Arabic language teaching curricula and developing teaching methods to better suit learners’ needs. The study also highlights the importance of teaching strategies based on deep understanding and practical application of grammatical and morphological rules, rather than rote memorization.
Keywords: Difficulties in learning Arabic, grammatical and morphological complexity, inflection, verb conjugation, word derivation, teaching strategies, educational curricula, active learning.

المقدّمة: تصنّف اللّغة العربية ضمن اللّغات الصّعبة لجهة التعلّم، نظرًا لتراكيبها المعقّدة، وغناها بالمستويات النّحوية والصّرفية المتشابكة. فبين نظام الإعراب القائم على العلامات المتغيّرة، وبنية الجذر والوزن التي تحكم الصّرف والاشتقاق، تظهر تحديات كبيرة أمام المتعلّمين، سواء أكانوا من النّاطقين بها أو من الذين يتعلّمونها كلغة ثانية.
وتزداد هذه الصّعوبات في البيئات التّعليميّة التي تفتقر إلى مناهج فعّالة أو أسس تعليمية مناسبة، ما يعزّز الفجوة بين المتعلّم والمضمون اللّغوي، ويجعل من اكتساب القواعد مسألة شائكة تربك الفهم وتعيق التّطبيق. فالإعراب على سبيل المثال لا يقتصر على حفظ القواعد، بل يتطلّب وعيًا سياقيًا، وقدرة على التّمييز بين العوامل المؤثّرة في تركيب الجملة، وهي مهارات لا تُكتسب تلقائيًا، بل تحتاج إلى تدريب ممنهج ومستمر.
ينطلق هذا البحث من تساؤل محوري: ما طبيعة الصعوبات التي يواجهها المتعلّمون في قواعد النحو والصرف في اللّغة العربيّة؟ وما السياقات التي تعمّق هذه الصعوبات؟ ثم كيف يمكن التغلّب عليها بوسائل فعّالة ومبتكرة تراعي الفروق الفرديّة، وتعيد ربط المتعلّم بالنص اللغوي بوصفه أداة للتفكير والتواصل، لا مادة للحفظ فقط؟
يهدف البحث إلى تحليل هذه الإشكاليّة بعمق، واستكشاف أبعادها التربوية والتّطبيقيّة، من خلال الرجوع إلى التّجارب التّعليميّة، والدّراسات السّابقة، والملاحظة المباشرة لآليات تعلّم القواعد النّحويّة والصّرفيّة في مختلف المستويات. كما يسعى إلى اقتراح آليات عمليّة تسهم في تجاوز العقبات، وتطوير أداء المعلّم والطالب على حدّ سواء.
أوّلاً- أهداف البحث
يركّز هذا البحث على معالجة المشكلات المرتبطة بتعلّم قواعد النحو والصرف في اللغة العربيّة، ويهدف إلى تقديم تصوّر متكامل يجمع بين التّوصيف النّظري والتّحليل التّطبيقي والاستجابة بالمقترحات العمليّة. ويمكن تلخيص أهدافه في أربعة محاور رئيسة:
– تحديد مظاهر التّعقيد النحوي والصّرفي في اللّغة العربيّة: يسعى هذا الهدف إلى دراسة الخصائص البنيويّة للّغة العربيّة التي تجعل منها لغة عالية التعقيد، سواء على المستوى النّحوي (كالإعراب، وتعدّد العوامل) أو الصّرفي (كالجذور والأوزان وتنوّع الصيغ). إنّ وفرة القواعد وتداخلها، إلى جانب الطابع الاشتقاقي للنّظام الصرفي، تمثّل عبئًا معرفيًّا كبيرًا، خصوصًا للمتعلّمين الجدد. وقد بيّنت دراسات حديثة أنّ التّعقيد لا يكمن فقط في كمّ القواعد، بل في بُعدها التّجريدي وصعوبة إسقاطها على سياقات تواصليّة واقعيّة (Bani-Khaled ,et.al,2024).
– رصد وتحليل الصّعوبات التّعليميّة الناتجة عن هذا التّعقيد: يركّز هذا المحور على التحدّيات التي يواجهها الطلاب عند محاولة فهم القواعد أو تطبيقها، مع رصد العوامل المرتبطة بطرق التدريس، أساليب التقييم، والفروقات الفرديّة بين المتعلّمين. فقد أظهرت دراسة (Alzaghoul et al. (2025) أنّ أكثر من 60% من طلاب المرحلة الثانويّة يشعرون أنّ قواعد النحو معقّدة وغير مفهومة، خاصّة عند تدريسها خارج السياق اللّغوي الطبيعي. كما أشار Swidan & Nofal (2023) إلى أنّ اعتماد المدرّسين على أساليب تقليديّة في عرض القاعدة، بعيدًا من التطبيق العملي، يزيد من فجوة الفهم لدى الطلاب.
– استكشاف السّياقات النفسيّة والتعليميّة واللّغوية المؤثّرة على التعلّم: ينظر هذا الهدف في تأثير البيئة الصفّية، والحالة النفسيّة، وأساليب تقديم المادّة، على قابليّة الطالب لاستيعاب النّحو والصرف. فالعوامل النّفسيّة، مثل الخوف من الوقوع في الخطأ، والرّهبة من اللّغة الرسميّة، تُعدّ من أبرز المعوّقات. وتشير دراسة الخطيب والأنصاري (2023) إلى أن 47% من الطلاب أبدوا توترًا متكرّرًا أثناء دروس النحو، وأنّ تقديم القاعدة في قالب جامد عزّز لديهم هذا القلق. كما يؤكّد Sweller et al. 2019) أنّ العبء المعرفي الناتج عن التقديم غير المنظّم للمحتوى يقلّل من فعاليّة التعلّم في المواد المعقّدة.
– إقتراح استراتيجيّات وتوصيّات لتحسين تعلّم النّحو والصّرف: يرمي هذا الهدف إلى تقديم بدائل تعليميّة حديثة تراعي الفروق الفرديّة وتبني على مبادئ التعلّم النشط والتّفكير النّقدي. وتشمل هذه الاستراتيجيّات: دمج التكنولوجيا، تقديم القواعد من خلال النّصوص الواقعيّة، توظيف الألعاب اللّغوية، التدريب التفاعلي، واستراتيجيّة الصف المقلوب. وتظهر دراسة (Al-Khawaldeh 2024) أنّ استخدام “التعلّم المقلوب (Flipped Learning) في تدريس النّحو حسّن من أداء الطلاب بنسبة 38% مقارنة بالطريقة التّقليديّة. كما تقترح Hasan & Nofal (2023) اعتماد التّغذية الراجعة الفوريّة المدعومة رقميًّا لتعزيز الاستيعاب وتصحيح الأخطاء في سياقها.
– ثانيًا أهميّة البحث: تنبع أهميّة هذا البحث من عدّة عوامل محوريّة، تشمل التوسّع المستمر في عدد متعلّمي اللغة العربية، سواء في العالم العربي أو في الدّول الأخرى، بالإضافة إلى الحاجة الماسّة لتحسين أساليب تدريس اللغة العربيّة بما يتماشى مع خصائصها الفريدة، ويعزّز من فعاليّة تعلّمها. ففي العالم العربي، تعدُّ اللغة العربيّة أساسيّة في التّعليم والدين والثقافة، بينما شهدت العديد من الدّول غير النّاطقة بالعربيّة زيادة ملحوظة في أعداد متعلّمي اللّغة العربيّة بوصفها لغة ثانية، وهو ما يعكس الاهتمام المتزايد بهذه اللغة عالميًّا.
تشير الدّراسات الحديثة إلى أنّ تعلّم النحو والصرف في اللّغة العربية يشكل تحديًا كبيرًا للمستويات التّعليميّة المختلفة، بما في ذلك الناطقين بالعربيّة وغير الناطقين بها، وذلك بسبب تعقيد النّظام النّحوي والصّرفي وتعدد القواعد المعتمدة على السّياق (Hassan ,et.al, 2023). وتؤكّد هذه الدراسات أهميّة تبنّي استراتيجيّات تعليميّة أكثر تفاعليّة وتطوّرًا من أجل تسهيل عمليّة التعلّم وتحقيق نتائج تعليميّة أفضل.
في السياق ذاته، يُعدّ تحسين مناهج تدريس اللغة العربيّة وتكييفها بما يتماشى مع التوجّهات الحديثة من أولويّات البحث الأكاديمي. ففي دراسة حديثة، أشار جلال (2024) إلى أنّ مناهج التعليم التقليديّة لا تواكب التطوّرات المتسارعة في مجالات تقنيّات التّعليم والتعلّم التّفاعلي، الأمر الذي يتطلّب مراجعة شاملة لكيفيّة تدريس القواعد النّحويّة والصّرفيّة بما يضمن أن يكون التّعليم أكثر ارتباطًا بالتّطبيقات الواقعيّة والتفاعل اليومي.
علاوة على ذلك، يظهر هذا البحث أهمّيّة خاصّة في ظل الدور الذي تؤديه اللغة العربيّة في التّواصل الثقافي بين مختلف الشّعوب، والضّروري لفهم العديد من القيم والمفاهيم التي تشكل جزءًا من الهُويّة الثقافيّة العربيّة. كما يبرز البحث دور النّحو والصرف بوصفهما أساسين في تمكين الطلاب من استخدام اللغة بشكل صحيح وفعّال في مجالات الحياة المختلفة، بدءًا من الكتابة الأكاديميّة والتّواصل الاجتماعي، وصولًا إلى فهم النّصوص الدينيّة والفكريّة.
من خلال هذه الأبعاد المتعدّدة، فإنّ هذا البحث يسعى إلى تقديم حلول عملية لتحسين أساليب تدريس النحو والصرف، بما يسهم في تعزيز كفاءة المتعلّمين في استخدام اللغة العربيّة بشكل دقيق وواضح، وهو ما يعدّ ضرورة ملحة لتلبية احتياجات المتعلّمين في السياقات المعاصرة.
ثالثًا: الإشكاليّة
يشكّل التعقيد النحوي والصرفي في اللغة العربيّة عائقًا بارزًا أمام عمليّة التعلّم، إذ يواجه المتعلّمون صعوبة في استيعاب القواعد وتطبيقها، وتتفاقم هذه الصعوبات بفعل المناهج التقليديّة وأساليب التدريس غير التفاعليّة. ومن هنا يُطرح السؤال: ما أثر مظاهر التعقيد النحوي والصرفي في عوائق تعلّم اللغة العربيّة، وما السبل التربويّة لمعالجتها؟
رابعًا: الفرضيّات
يفترض البحث ما يلي:
1- أنّ التعقيد النحوي والصرفي يُضعف قدرة المتعلّمين على الفهم والتطبيق.
2- أنّ المناهج التقليديّة القائمة على الحفظ تزيد من حدّة العوائق التعليميّة.
3- أنّ العوامل النفسيّة واللغويّة (مثل القلق، تأثير اللهجات، ضعف الذاكرة العاملة) تؤثّر سلبًا في استيعاب القواعد.
4- أنّ اعتماد استراتيجيات حديثة (التعلّم النشط، الصف المقلوب، التكنولوجيا) يسهم في التخفيف من هذه الصعوبات وتحسين عمليّة التعلّم.
خامسًا: منهجيّة البحث: المنهجيّة التي تعتمد على المنهج الوصفي التحليلي تُعد من الأساليب القوية في البحث العلمي، خاصّة عندما يتعلّق الأمر بدراسة الأخطاء اللّغوية الشّائعة بين الطلاب وتحليل الأدبيّات والدّراسات السّابقة. في هذا السياق، يهدف البحث إلى:
– تحليل الأدبيّات السابقة: تُستعرَض الأبحاث والدّراسات التي تناولت الموضوع نفسه، بهدف استخراج الممارسات المعتمدة والمفاهيم النظريّة المتاحة في هذا المجال.
– الدّراسات الميدانيّة: تشمل جمع البيانات من الواقع الميداني، من خلال استطلاع آراء الطلاب، ملاحظة الأداء اللّغوي لهم، أو إجراء اختبارات لتحديد الأخطاء اللغوية الشائعة.
– مراجعة المناهج: تهدف هذه المرحلة إلى دراسة المناهج الدراسيّة المعتمدة في تدريس اللغة العربية، وخصوصًا في ما يتعلق بمفاهيم القواعد اللّغوية، مع تقييم فعاليّة هذه المناهج في تعزيز تعلم الطلاب.
– تحليل الأخطاء اللّغوية: التركيز على تحليل الأخطاء التي يرتكبها الطلاب في مهارات الكتابة أو التحدّث، وتصنيفها إلى أنواع مختلفة (أخطاء نحويّة، صرفيّة، إملائيّة… إلخ)، مع محاولة فهم الأسباب التي تقف وراء هذه الأخطاء.
– التّطبيقات التّربويّة المعاصرة: يركّز البحث على تسليط الضّوء على الأدوات، والطرق الحديثة التي يمكن استخدامها في تعليم اللّغة العربيّة بشكل فعّال، مثل استخدام التكنولوجيا أو أساليب التدريس المبتكرة.
من خلال هذه المنهجيّة، ستتمكّن الباحثة من تقديم صورة شاملة حول الأخطاء اللغوية الشائعة وتحديد العوامل المؤثرة فيها، ما سيساعد في تطوير استراتيجيّات تعليميّة فعّالة للتغلّب عليها.
المبحث الأوّل: البنية النحويّة والصرفيّة للغة العربيّة
– النّحو العربي: الخصائص العامّة
يعدّ النّحو العربي من جوانب البنية اللّغوية المهمّة التي تشكّل الهيكل الأساسي للتعبير عن المعاني وتوجيهها بدقّة في اللّغة العربيّة. فهو يعتمد على نظام إعرابي يحدّد العلاقة بين الكلمات داخل الجملة، ما يفرض على المتعلّم ضرورة معرفة موقع الكلمة ووظيفتها النحويّة (فاعل، مفعول به، مبتدأ، خبر، إلخ). هذه البنية النحويّة ليست ثابتة، بل تعتمد على السّياق وتسمح بالكثير من المرونة في ترتيب الكلمات داخل الجملة. تتعدّد الخصائص التي تميّز النّحو العربي، وأهمّها التقدير الإعرابي، تعدّد الحالات الإعرابيّة، والتقديم والتأخير.
– التقدير الإعرابي: من أبرز الخصائص التي تميّز النحو العربي هي التقدير الإعرابي. في اللغة العربيّة، لا يُشترط أن تُذكر العلامات الإعرابيّة الصريحة للكلمات في الجمل، بل قد يُفهم موقع الكلمة ووظيفتها من السياق. بمعنى آخر، الكلمة قد تأتي في الجملة من دون أن تحمل علامة إعرابيّة ظاهرة، ويُستدل على موقعها الإعرابي بناءً على المعنى العام للجملة. على سبيل المثال، في جملة مثل “ذهب الرجل إلى السوق”، يُفهم أن “الرجل” هو الفاعل على الرغم من أنّ الفعل “ذهب” قد يكون غير مُصرّح به بشكل كامل. هذا التقدير يسمح للغة العربيّة بالمرونة في التعبير.
وبحسب الزيّاتي (2013)، فإنّ “التقدير الإعرابي يعزّز قدرة اللغة العربية على التّعبير الدّقيق عن المعنى بفضل اعتمادها على السياق، بدلًا من الاعتماد الصّارم على التشكيلات اللفظيّة” (الزياتي، 2013، ص 56). من خلال هذا التّقدير، يمكن للقارئ أو المتعلّم أن يفهم بناء الجملة بشكل مرن ومن دون الحاجة إلى سماع أو قراءة كل التفاصيل النحويّة بشكل صريح.
– تعدّد الحالات الإعرابيّة
الخاصيّة الثانية التي تميز النحو العربي هي تعدّد الحالات الإعرابيّة. في اللغة العربيّة، يمكن للكلمة نفسها أن تأتي في عدّة حالات إعرابيّة بحسب موقعها في الجملة. على سبيل المثال، الكلمة “كتاب” قد تكون “كتابٌ” مرفوعة إذا كانت فاعلًا، أو “كتابًا” منصوبة إذا كانت مفعولًا به، أو “كتابٍ” مجرورة إذا كانت جزءًا من مجرور. هذا التعدّد يوفر للغة العربيّة مرونة كبيرة في التعبير عن المعاني، ويُجبر المتعلم على الفهم العميق للروابط النحويّة بين الكلمات في الجملة.
يعدُّ سليمان (2001) أنّ “تعدّد الحالات الإعرابيّة يعكس غنى النحو العربي، ويُظهر كيف أنّ اللغة ليست مجرد قواعد ثابتة بل هي شبكة حيّة من العلاقات المتغيّرة التي تؤثر في فهم الجملة” (سليمان، 2001، ص 34). ولذلك، فإنّ فهم المتعلّم لعلامات الإعراب هو مفتاح لفهم الجملة العربيّة بشكل كامل، إذ إنّ التغيير البسيط في الإعراب قد يُحدث تغييرًا كبيرًا في المعنى.
– التقديم والتأخير: من الخصائص الأخرى المهمّة في النّحو العربي هي التّقديم والتّأخير في ترتيب الكلمات. تعدُّ اللغة العربية مرنة جدًا في هذا السياق، إذ يمكن تقديم أو تأخير الكلمات داخل الجملة وفاقًا للأغراض المعنويّة أو الأسلوبيّة. فالتقديم قد يكون له دلالة خاصّة، مثلما هو الحال في الجملة “العالم عالمٌ” بدلاً من “عالمٌ العالم”، إذ إنّ التّركيز في الجملة الأولى يكون على “العالم” كموضوع رئيس، بينما في الثانية يكون تأكيد”عالمٌ” كصفة. هذا التقديم والتأخير يعطي اللغة العربية بعدًا جماليًا وتعبيريًّا متنوعًا.
ويوضح حسن (2015) أنّ “التقديم والتأخير لا يقتصر فقط على تحقيق المعنى الدّلالي، بل هو أيضًا أداة لتوجيه الانتباه إلى أجزاء معيّنة من الجملة، ما يمنح المتكلّم أو الكاتب القدرة على تعديل المعنى وفاقًا للظروف السّياقيّة” (حسن، 2015، ص 112). هذه الخاصيّة تمنح اللغة العربيّة مرونة في استخدامها بأساليب مختلفة تتناسب مع الأغراض البلاغيّة.
المبحث الثّاني الصرف العربي: الجذر والوزن
الصّرف في اللّغة العربيّة هو علم يتعلّق بتصريف الكلمات وتغيير بنيتها عبر الأوزان التي تُشتق من الجذور. يُعدّ الفهم الدّقيق لأدوات الصّرف جزءًا أساسيًا من تعلّم اللّغة العربية، إذ يُساعد على تمييز جذور الكلمات وفهم تصريفاتها. يعتمد الصّرف على مفهوم الجذر، فيُعدُّ الجذر الأساس الذي تُبنى الكلمة عليه من خلال إضافة حروف لتشكيل أفعال، أسماء، صفات، وغيرها. هذا الفهم يتطلّب معرفة عميقة بالتّركيب البنيوي للكلمة من أجل تمكين المتعلّم من استخدامها بشكل صحيح في سياقات متعدّدة (ابن جني، 2009).
– الأفعال المجرّدة والمزيدة: الأفعال المجرّدة هي تلك التي تتكوّن من ثلاثة حروف أصليّة تُسمّى “الجذر” (مثل: كتب، ذهب، علم). في هذه الأفعال، لا توجد حروف إضافيّة تأتي لزيادة دلالة الفعل. بينما الأفعال المزيدة هي التي تحتوي على حروف إضافيّة تضاف إلى الجذر لزيادة معاني أو دلالات معينة. على سبيل المثال، “استفعل” هو وزن فعل مزيد، مثل: “استفاد” و”استعمل”. هذا التّفاوت بين الأفعال المجرّدة والمزيدة يثري اللغة ويُساعد في التّعبير عن معانٍ دقيقة ومختلفة. إنّ تعلّم هذه الفروق يعدّ أساسًا مهمًا في بناء الكلمة العربية وتحقيق التنوّع اللغوي (الزمخشري، 1989).
– اشتقاق الأسماء: من خلال الجذر، يمكن اشتقاق العديد من الأسماء التي تُعبّر عن معانٍ مختلفة. تُستخدم أوزان معيّنة لاشتقاق اسم الفاعل (مثل: كاتب، قارئ)، الذي يشير إلى الشّخص الذي يقوم بالفعل، واسم المفعول (مثل: مكتوب، مقروء)، الذي يشير إلى الشّخص الذي وقع عليه الفعل. كما توجد أوزان للاسم الزمان والمكان (مثل: “مكتب” و”مسجد”). تعتبر هذه الأوزان أساسيّة في إثراء اللّغة واستخداماتها المتنوّعة في التعبير عن الأزمنة والأماكن. يتطلّب الأمر فهمًا دقيقًا للأوزان، وتطبيقها بشكل صحيح على الأفعال لاستخراج الأسماء التي تُستخدم في الحياة اليوميّة (الرافعي، 1997).
– تصريف الأفعال حسب الزمن والفاعل والنوع: الأفعال في اللغة العربية تتغير تبعًا للزمن والفاعل والنوع. من خلال تصريف الأفعال نُميّز الزّمن (ماضٍ، مضارع، أمر) الذي يعكس وقوع الفعل في زمن معيّن. كما أنّ الفاعل قد يكون مفردًا، مثنى، أو جمعًا، ما يتطلب تعديلات في الفعل تبعًا لذلك. كما تُحَدد التعديلات بناءً على النوع (مذكر أو مؤنث)، إذ نلاحظ اختلافًا في التّصريف بين المذكر والمؤنث في اللغة العربية. فالفعل “ذهب” في الماضي يُستخدم بنفس الشكل للمذكر والمؤنث، ولكن في المضارع، يتغير الفعل حسب نوع الفاعل (سيبويه، 2010).
– جمع التكسير وأوزانه
يعدُّ جمع التكسير من الظواهر المهمّة في اللّغة العربيّة إذ تُجمَع الكلمات بطريقة غير منتظمة في الغالب. على سبيل المثال، كلمة “رجل” تتحول إلى “رجال”، بينما “كتاب” تتحول إلى “كتب”. يختلف جمع التكسير عن جمع المذكر السالم أو جمع المؤنث السالم في كونه لا يتبع قاعدة ثابتة، ما يجعل تعلمه أمرًا معقّدًا في بعض الأحيان. تتنوّع أوزان جمع التكسير، مثل وزن “فِعَال” و”فُعَلاء”، وهذه الأوزان تساهم في تمييز الجمع بشكل دقيق. فهم هذه الأوزان يعتبر ضرورة لتحديد الشكل الصحيح للجمع في مختلف السياقات (ابن مالك، 1998).
– الصّعوبات النّحوية الشّائعة: اللّغة العربية غنيّة بالقواعد النّحويّة التي قد تُشكل صعوبة على المتعلمين. الفهم الصحيح للإعراب، وتصريف الأفعال، وترتيب الكلمات يتطلّب معرفة دقيقة بالقواعد النحويّة والتطبيقات المتنوّعة لهذه القواعد. بعض الصعوبات الشائعة تشمل:
– إشكاليّات التراكيب الإعرابيّة: واحدة من التحدّيات الكبيرة في تعلّم النّحو العربي هي التمييز بين الجملة الاسميّة والجملة الفعليّة. الجملة الاسميّة تبدأ باسم، بينما الجملة الفعليّة تبدأ بفعل. هذه التفرقة مهمّة لفهم تركيب الجملة بشكل صحيح. أيضًا، قد يواجه المتعلّمون صعوبة في التعامل مع جمل العطف والشرط والتوكيد، التي تتطلّب فهمًا دقيقًا للمعاني التي تتبع كلّ أداة من أدوات العطف أو الشرط. يعكس فهم هذه الجمل الدقيقة القدرة على بناء الجمل النحويّة بشكل سليم (الجرجاني، 2003).
– علامات الإعراب: علامات الإعراب هي العلامات التي تُضاف إلى الكلمة حسب موقعها في الجملة. في اللغة العربيّة، هذه العلامات تتغيّر حسب حالة الكلمة: الرفع مثل الضمة، النصب مثل الفتحة، الجر مثل الكسرة، والجزم مثل السكون. نسيان أو استخدام هذه العلامات بشكل غير صحيح قد يسبّب أخطاء لغويّة. من الصعب أحيانًا تمييز الأفعال الخمسة، مثل “يكتبون”، أو جمع المذكر السالم، ما يخلق إشكالات إضافيّة في فهم القواعد النحويّة. يتطلّب ذلك تدقيقًا في التطبيق المستمر للعلامات النحويّة (ابن هشام، 1999).
– ترتيب الكلمات: المرونة في ترتيب الكلمات في اللّغة العربيّة قد تكون محيّرة للمتعلّمين. على سبيل المثال، يمكن ترتيب الكلمات بطرق متعدّدة من دون أن يتغيّر المعنى، مثل تحويل “أكل الطفل التّفاحة” إلى “التفاحة أكلها الطفل”. هذا المرونة قد تخلق ارتباكًا حول كيفيّة تحديد الفاعل والمفعول به بدقّة. ولذلك، يبرز دور التعليم المكثف في تهيئة المتعلّمين لفهم تركيب الجملة وتوجيههم نحو الاستخدام الصحيح للترتيب (الطوفي، 2005).
تتمتّع اللّغة العربيّة بثراء وتنوّع في قواعدها الصرفيّة والنحوية، ما يجعل تعلمها عملية ممتعة لكن معقدة في ذات الوقت. من خلال دراسة الجذر والوزن، والتمييز بين الأفعال المجردة والمزيدة، وفهم التراكيب الإعرابية،
يستطيع المتعلّمون التمكّن من بناء جمل سليمة. تعدّ علامة الإعراب والترتيب المرن للكلمات جزءًا أساسيًا
المبحث الثالث: الصّعوبات الصرفيّة الشائعة
الصرف في اللّغة العربيّة هو علم يعنى بتصريف الكلمات واستخراج أوزانها بناءً على الجذور اللغويّة. ويُعدّ هذا العلم أحد الأركان الأساسيّة في إتقان اللّغة العربيّة، لكن مع ذلك يواجه المتعلّمون تحدّيات كبيرة عند تعلّمه بسبب تعقيداته وكثرة الاستثناءات المرتبطة به. تتنوّع الصعوبات الصرفيّة التي يواجهها المتعلّمون بين فهم نظام الجذور والأوزان، تصريف الأفعال، وكذلك التعامل مع جمع التكسير. في هذا المبحث، سأتطرّق إلى أبرز هذه الصعوبات وكيفيّة تجاوزها.
– نظام الجذور والأوزان: نظام الجذور والأوزان هو الأساس الذي تُبنى عليه الكلمات في اللّغة العربية. يعتمد هذا النظام على أن الكلمة العربيّة تتكوّن من جذر مكوّن من ثلاثة حروف في أغلب الأحيان، ومن خلال هذا الجذر تُشتَق الأفعال والأسماء باستخدام أوزان محدّدة. إلّا أنّ فهم هذا النظام قد يسبّب صعوبة بعض الأحيان بسبب كثرة الأوزان والاشتقاقات المختلفة
– عدم التمكّن من استنتاج الوزن الصرفي :تُعدّ القدرة على استنتاج الوزن الصرفي من الجذر من أبرز التحدّيات التي يواجهها المتعلمون في اللّغة العربيّة. على الرّغم من وجود أوزان ثابتة ومحدّدة لكل جذر، إلّا أنّ بعض الأفعال قد تأتي على أوزان غير مألوفة، أو قد تحتوي على أحرف مضعّفة أو زائدة ما يجعل من الصعب استنتاج الوزن بشكل دقيق. على سبيل المثال، قد يختلط على الطالب وزن الفعل “استعمل” مع “فعل”، أو “فعلَّ”، ما يؤدي إلى اشتقاق الكلمة بشكل خاطئ (ابن جني، 2009).
يؤكّد ابن جني في سرّ صناعة الإعراب أن القدرة على تحديد الوزن الصرفي للكلمة يتطلّب معرفة دقيقة بالأوزان المقرّرة في اللّغة وتطبيقها بشكل سليم على الجذور المختلفة.
– الخلط بين الجذر والوزن: يُعد التمييز بين الجذر والوزن أحد التحدّيات الكبيرة التي تواجه المتعلّمين. الجذر هو أساس الكلمة الذي يتكوّن عادة من ثلاثة حروف، بينما الوزن هو الصيغة التي تُستخرج منها الكلمة بناءً على الجذر. وعندما يخلط المتعلّم بين الجذر والوزن، فإن ذلك يؤدّي إلى صعوبة في اشتقاق الكلمات بشكل سليم. على سبيل المثال، في حال حصل الخلط بين الجذر “كتب” والوزن “فعل”، يمكن أن يواجه الطالب صعوبة في معرفة شكل اسم الفاعل أو اسم المفعول بشكل دقيق، وبالتالي يؤدّي ذلك إلى أخطاء في التصريف (الفراء، 2012).
– تصريف الأفعال: تصريف الأفعال هو عمليّة تعديل الفعل بناءً على الزمن (ماضٍ، مضارع، أمر)، الفاعل (مفرد، مثنى، جمع)، والنوع (مذكّر أو مؤنث). يتعامل الصّرف مع أفعال معتلّة أو ذات حروف مضعّفة، وهذه الأفعال تتطلّب دقّة شديدة أثناء التّصريف.
– ضعف في تصريف الأفعال المعتلّة أو الأفعال ذات الحروف المضعّفة:الأفعال المعتلّة هي الأفعال التي تحتوي على حروف علة مثل “و”، “ي”، و”أ” في الجذر، مثل “قال” و”عمل”. هذه الأفعال قد تتغير بشكل غير منتظم أثناء التصريف حسب الزمن والفاعل. كذلك، الأفعال ذات الحروف المضعفة مثل “دحرج” و”كبر” تخلق صعوبة إضافيّة في تصريفها بشكل سليم، إذ تُضاف الحروف المتماثلة في الجذر بطريقة قد تؤدّي إلى تغييرات معقّدة عند التصريف (الطوفي، 2005).
ويشير الطوفي إلى أنّ الأفعال المعتلّة تحتاج إلى معاملة خاصة عند التصريف، إذ يُعدَّل عليها بناءً على السّياق اللّغوي والوزن الذي تندرج فيه.
– صعوبة في التّفريق بين الماضي والمضارع، أو بين الفعل المبني للمجهول والمبني للمعلوم
التفريق بين الأفعال في الزمن الماضي والمضارع قد يُشكّل صعوبة للمتعلّمين، خاصّة في الحالات التي تتشابه فيها الأفعال في الصيغة. ففي اللّغة العربيّة، إذ تُصرَّف الأفعال في الزّمن الماضي باستخدام صيغة واحدة (مثل “ذهب”)، بينما في الزّمن المضارع يُعدَّل الفعل بحسب الفاعل والنوع. بالإضافة إلى ذلك، التفريق بين الفعل المبني للمجهول والفعل المبني للمعلوم يعدُ أمرًا معقدًا في بعض الحالات، إذ يحتاج المتعلّم إلى الانتباه للتغييرات التي تحدث في الفعل لتحديد ما إذا كان المبني للمجهول أم لا (ابن مالك، 1998).
– جمع التكسير: جمع التكسير هو نوع من جمع الأسماء التي لا يتبع قاعدة ثابتة كما هو الحال في جمع المذكر السالم أو جمع المؤنّث السالم. هذا النوع من الجمع يتطلّب دراسة الأوزان الصّرفية الخاصة بكل كلمة على حدة.
– عدم وجود قاعدة واحدة شاملة لجمع التكسير:على عكس جمع المذكّر السالم أو جمع المؤنث السالم، الذي يتبع قاعدة ثابتة، فإن جمع التكسير يتبع أوزانًا متنوّعة لا يمكن التنبؤ بها بسهولة. على سبيل المثال، كلمة “رجل” تتحول إلى “رجال”، بينما “كتاب” تصبح “كتب”. هذا التّعدد في الأوزان يجعل جمع التكسير واحدًا من أكثر المواضيع تحديًا في الصرف، إذ يعتمد على فهم الوزن بشكل دقيق لكل حالة (الجرجاني، 2003).
يجادل الجرجاني في السرّ في صناعة الصرف أنّ جمع التكسير يمثل أحد أعمق التحديات في النحو والصّرف، إذ لا يمكن تحديد الجمع بشكل مسبق ويجب على المتعلّم تعلم الأوزان الخاصّة بكل جمع على حدة.
– إعتماد المتعلّم على الحفظ بدل الفهم الصرفي: يُلاحظ أنّ العديد من المتعلّمين يعتمدون على الحفظ بدلًا من فهم القواعد الصّرفيّة التي تحدد جمع التكسير. على الرّغم من أن الحفظ قد يكون فعالًا في بعض الحالات، إلّا أنّه لا يوفر القدرة على التعامل مع الجمع في حالات جديدة أو غير مألوفة. وعند الاعتماد على الحفظ فقط، يصعب على المتعلّم التعامل مع جمع التكسير في سياقات جديدة ما يخلق مشكلات في الاستخدام السليم (ابن هشام، 1999).
–كثرة الاستثناءات في صيغ الجمع: يعدّ جمع التكسير مليئًا بالاستثناءات التي تتطلب دراسة مفصلة لكل كلمة على حدة. فبعض الكلمات تتبع أوزانًا غير منتظمة أو تتغير بشكل غير مألوف، ما يزيد من تعقيد القواعد الخاصّة به. هذه الاستثناءات تتطلّب من المتعلّم الاستمرار في المراجعة والتدريب للحصول على فهم دقيق لكيفية جمع الأسماء بشكل صحيح (عبد القادر، 2004)..
تعدّ الصعوبات الصرفيّة جزءًا لا يتجزأ من عملية تعلّم اللّغة العربيّة. من خلال دراسة الجذور والأوزان، تصريف الأفعال، وجمع التّكسير، يستطيع المتعلّمون التغلب على هذه التحديات بشرط أن يتمكنوا من فهم القواعد الصرفيّة بشكل عميق وتطبيقها في السياقات المختلفة. من المهم أن يتفهم المتعلمون أن الحفظ ليس هو الحل الوحيد، بل الفهم العميق للقواعد يمكنهم من التعامل مع هذه الصعوبات بكفاءة.
المبحث الرابع: سياقات تفاقم الصعوبات
تعدّ الصعوبات التي يواجهها المتعلّمون أثناء تعلّم اللّغة العربيّة نتيجة لتعدد العوامل التي تؤثر في عملية التعلّم. تتنوع هذه الصعوبات بين التأثيرات الإجتماعيّة، التربويّة، والفرديّة. في هذا المبحث، سيكون التركيز على تأثير بعض العوامل الرئيسة التي تُسهم في تفاقم هذه الصعوبات مثل التأثير اللّهجي، أساليب المناهج التعليمية وأساليب التدريس، والفروق الفردية بين المتعلّمين. جميع هذه العوامل تؤدي دورًا كبيرًا في تحديد جودة تعلّم اللغة العربية ومدى التقدّم الذي يحقّقه المتعلّم.
– التأثير اللّهجي: تتميّز اللّغة العربيّة بتنوّع اللّهجات بين مناطقها المختلفة، ويشمل هذا التّباين في المفردات، النطق، والتركيب اللّغوي. هذا التنوّع قد يشكل عقبة كبيرة أمام تعلّم الفصحى، ما يؤدّي إلى صعوبات إضافية للمتعلّمين عند محاولة التكيّف مع القواعد النحويّة والصرفيّة الخاصّة باللّغة العربيّة الفصحى.
– الانتقال من اللّهجة المحليّة إلى الفصحى يُربك المتعلّم: يعاني العديد من المتعلّمين في العالم العربي من صعوبة في الانتقال من اللهجات المحلية إلى اللغة الفصحى. هذا الانتقال لا يكون سهلًا إذ إنّ اللّهجات المحليّة تستخدم تراكيب لغوية مختلفة عن الفصحى. على سبيل المثال، في بعض اللّهجات قد لا توجد تفرقة واضحة بين التذكير والتأنيث في الأفعال، وهو أمر ضروري في الفصحى. كما أنّ اللّهجات المحليّة تستخدم مفردات قد تكون بعيدة تمامًا من تلك المستخدمة في اللّغة الفصحى، ما يزيد من صعوبة التكيّف مع التراكيب النّحويّة والصرفيّة (ابن جني، 2009). هذا التفاوت الكبير في اللغة يجعل المتعلّم يواجه تحدّيًا كبيرًا في الانتقال من نمط لغوي بسيط وأقرب للواقع إلى نمط أكثر رسميّة ومعقّد.
– النمط الشّفهي لا يُطابق القواعد المكتوبة: في العديد من المجتمعات العربيّة، يعتمد الناس في حياتهم اليوميّة على النمط الشفهي في التواصل باستخدام اللّهجات المحلية، بينما تظل اللّغة الفصحى محصورة في الكتابة والنصوص الأدبية. هذه الفجوة بين اللهجة والنّمط الفصيح تتسبّب في صعوبة للطلاب عند محاولة كتابة النّصوص الفصحى أو التّعبير بها شفهيًا. على سبيل المثال، يواجه الطلاب الذين اعتادوا على اللهجات المحليّة صعوبة في التمييز بين الحروف مثل “ق” و”ج” أو “ض” و”ظ”، أو في تطبيق القواعد النحويّة الصارمة مثل التذكير والتأنيث في الفعل والمفعول (الفراء، 2012). هذا الخلل بين النمطين يُعد أحد العوامل التي تسهم في صعوبة تعلم اللغة الفصحى، وبالتالي تباطؤ تقدّم المتعلّمين.
– المناهج وأساليب التّعليم: تشكّل المناهج التعليميّة وأساليب التدريس عاملًا رئيسًا في تشكيل تجربة المتعلم في تعلم اللغة العربية. تفتقر بعض المناهج إلى أساليب تدريس تحفّز المتعلّمين على الفهم العميق والتطبيق الفعلي للمعرفة اللّغوية.
– تركيز بعض المناهج على الحفظ دون تفسير: إحدى المشكلات التي تساهم في تفاقم الصّعوبات هي المناهج التي تركز على الحفظ الميكانيكي للقواعد اللّغويّة من دون تقديم تفسير دقيق للمتعلّم حول كيفيّة استخدام هذه القواعد. فالتركيز على حفظ القواعد النّحوية والصرفيّة من دون فهم عميق للأسباب التي أدت إلى هذه القواعد يحدّ من قدرة المتعلّم على تطبيق هذه القواعد في مواقف حياتيّة (ابن مالك، 1998). على سبيل المثال، عندما يُطلب من الطلاب حفظ أوزان الصرف من دون شرح لمفهوم الجذر والوزن وكيفيّة اشتقاق الكلمات، قد يتعذر عليهم تطبيق هذه القواعد في الكتابة أو التحدّث بشكل طبيعي.
– قلة التّمارين التطبيقيّة والمواقف الواقعيّة: على الرّغم من أنّ العديد من المناهج تركّز على تعليم القواعد النظريّة، إلّا أنّها تفتقر إلى تمارين تطبيقيّة تتيح للطلّاب الفرصة لاستخدام القواعد بشكل عملي. القليل من المناهج تتضمّن مواقف واقعية مثل المحادثات اليوميّة أو الكتابة عن مواضيع عمليّة، ما يساعد المتعلّم على تطبيق القواعد في مواقف حياتيّة. على سبيل المثال، لو كانت المناهج تركّز على محاكاة المحادثات اليوميّة أو المواقف العمليّة في الصفوف الدراسيّة، ما يسهم في تعزيز تعلّم الطلاب (الطوفي، 2005). التمارين التطبيقيّة تسهم في تحويل القواعد النظريّة إلى مهارات عمليّة.
– إعتماد الاختبارات على القواعد النظريّة فقط: الكثير من الإختبارات التي تُجرى في المدارس تركّز فقط على القواعد النظريّة، مثل تعريف الأوزان الصرفيّة أو تحديد نوع الجملة لجهة الإعراب. على الرّغم من أنّ هذه المهارات مهمّة، فإنّ هذه الاختبارات لا تقيّم قدرة الطلاب على تطبيق هذه القواعد في الكتابة والتحدث. يُعدُّ الاعتماد على الاختبارات النظريّة فقط عائقًا كبيرًا أمام المتعلم، إذ لا يُجرى اختبار الفهم العملي للقواعد اللغويّة التي تعلمها (عبد القادر، 2004).
– الفروق الفرديّة: الفروق الفرديّة بين المتعلّمين هي عامل مؤثر آخر في تعلّم اللّغة العربيّة. هذه الفروق قد تشمل القدرات على الاستيعاب، الذاكرة العاملة، وكذلك القدرة على التّحليل والتّفكير المجرّد.
– ضعف في الذاكرة العاملة لدى بعض المتعلّمين: الذاكرة العاملة هي القدرة على تخزين ومعالجة المعلومات بشكل مؤقت. بعض المتعلمين يعانون من ضعف في الذاكرة العاملة، ما يجعل من الصّعب عليهم تذكر القواعد اللغوية أو تطبيق الأوزان الصرفية بشكل سريع. في حالة الفشل في استرجاع القواعد، يجد المتعلّم صعوبة في تكوين جمل صحيحة، أو استخدام المفردات بشكل دقيق أثناء الكتابة أو التحدّث. هذا التحدي العقلي يمكن أن يسبّب شعورًا بالإحباط للطلاب الذين يعانون من ضعف في الذاكرة العاملة (الجرجاني، 2003).
– فروق في القدرة على التّحليل أو التفكير المجرّد: تعلم اللّغة العربيّة يتطلّب القدرة على التفكير المجرد والتّحليل، خاصّة عندما يتعلّق الأمر بفهم القواعد الصرفيّة والنّحويّة. بعض الطلاب قد يمتلكون قدرة عالية على التفكير التحليلي وفهم التراكيب المعقّدة، بينما يعاني آخرون من صعوبة في هذا المجال. هذا التفاوت في القدرات الفكريّة قد يؤدّي إلى تفاوت واضح في أداء الطلاب في القواعد اللّغوية، إذ يجد البعض صعوبة أكبر في تطبيق القواعد المعقّدة على الرّغم من دراستها. في حين أنّ الطلاب الذين يمتلكون قدرة على التفكير المجرد يمكنهم بسهولة ربط القواعد بالواقع، فإنّ الطلاب الذين يفتقرون إلى هذه القدرة قد يواجهون صعوبة كبيرة في فهم التراكيب النحوية (ابن جني، 2009).
– الموقف السلبي تجاه المادة الدراسية بسبب التّجربة السّابقة: بعض الطلاب قد يكون لديهم موقف سلبي تجاه تعلّم اللّغة العربيّة بسبب تجارب سابقة غير ناجحة في هذه المادة. عندما يكون الطالب قد مرّ بتجارب تعلّم سلبية في الماضي، مثل الفشل في فهم القواعد أو الصّعوبة في التّفاعل مع المعلمين، فإنّ ذلك ينعكس على دافعيته للعودة إلى تعلّم المادة. الطلاب الذين يمرّون بتجارب فاشلة قد يشعرون بالإحباط ويفقدون الثقة في قدرتهم على تعلّم اللغة (عبد القادر، 2004).
المبحث الخامس : نماذج من دراسات سابقة :
Alharbi (2024) – دراسة حول فهم تصريف الأفعال لدى الأطفال الناطقين بالعربيّة المصابين باضطراب اللّغة.
أجريت دراسة Alharbi (2024) لتفحص فهم الأطفال الناطقين بالعربيّة الذين يعانون من اضطراب اللغة (Language Impairment) فيما يتعلق بتصريف الأفعال. ركزت الدراسة على الأطفال المصابين بصعوبة في تمييز الأفعال وأزمنتها في اللغة العربية، وهي مسألة مهمّة في تعلّم اللغة نظرًا لأنّ التصريف يعد من العناصر الأساسيّة في بناء الجمل العربيّة.
كان الهدف الأساسي من الدّراسة هو تحديد مدى تأثير الذاكرة العاملة (Working Memory) والوعي الصرفي (Morphological Awareness) على قدرة الأطفال المصابين باضطراب اللغة في تصريف الأفعال. عدَّت الدّراسة أن تصريف الأفعال يُشكِّل تحديًا خاصًا للأطفال الذين يعانون من اضطرابات لغويّة لأنه يتطلب فهماً دقيقًا للوظائف النحوية التي تتغير بتغير الأزمنة أو الضمائر.
أظهرت نتائج الدّراسة أنّ الأطفال المصابين باضطراب اللّغة يعانون بشكل ملحوظ في تصريف الأفعال مقارنة بالأطفال الذين لا يعانون من هذا الاضطراب. تبيّن أن صعوبة التصريف ترتبط ارتباطًا وثيقًا بضعف الذّاكرة العاملة لدى الأطفال المصابين.
على ضوء النتائج التي تُوصِّل إليها، يمكن للمربين استخدام هذه الدراسة لتطوير برامج تعليمية خاصة للأطفال المصابين باضطراب اللغة. من المفيد إدراج تمارين تقوية الذّاكرة العاملة والوعي الصرفي في التدريس، بما يساعد على تحسين مهارات تصريف الأفعال لدى هؤلاء الأطفال.
– دراسة Mahfoudhi et al. (2010).دراسة مقارنة بين متعلّمين عاديين وذوي صعوبات تعلّم
أجريت الدراسة بهدف مقارنة بين متعلّمين عاديين وآخرين يعانون من صعوبات تعلّم، مع التركيز على أهميّة الوعي الصرفي في تحسين الأداء اللّغوي وفهم النصوص المقروءة. تعد هذه الدراسة من الدراسات المهمّة في مجال تعليم اللغة العربية، إذ تبرز العلاقة بين الوعي الصرفي والأداء اللغوي لدى الأطفال، خاصّة فيما يتعلّق بفهم النصوص.
هدف الباحثون في هذه الدراسة إلى فهم تأثير الوعي الصرفي على قدرة الأطفال في فحص وفهم النصوص المقروءة. كانت الفكرة الأساسيّة في الدراسة هي أن الوعي الصرفي يشمل القدرة على التعرف إلى التّغييرات التي تطرأ على الكلمة عند تصريفها في سياقات زمنيّة أو نحويّة مختلفة. وبالتالي، فإنّ الأطفال الذين يمتلكون مستوى عالٍ من الوعي الصرفي سيكون لديهم قدرة أكبر على فهم النصوص المقروءة.
قُسِّم المشاركين إلى مجموعتين رئيستين: المجموعة الأولى تتكوّن من أطفال يعانون من صعوبات تعلم، في حين تتكون المجموعة الثانية من أطفال لا يعانون من أي مشاكل في تعلّم اللغة. اختُبِرت كل مجموعة باستخدام مجموعة من المهام التي تشمل تحليل الجمل وفهم النصوص. كانت هذه المهام تتطلب من المشاركين تصريف الأفعال بشكل صحيح، والتّعامل مع حالات الإعراب المختلفة للكلمات في الجملة.
أظهرت نتائج الدراسة أنّ الأطفال الذين يعانون من صعوبات تعلم لديهم صعوبة كبيرة في فهم النصوص مقارنة بالأطفال الذين لا يعانون من هذه الصعوبات. كما أظهرت النتائج أن الوعي الصرفي كان عاملًا حاسمًا في تحسن الأداء اللغوي. الأطفال الذين أظهروا مستوى عالٍ من الوعي الصرفي كان لديهم قدرة أكبر على فهم النصوص وتفسير الجمل بشكل أكثر دقة.
خلصت الدّراسة إلى أنّ الوعي الصرفي يؤدي دورًا محوريًا في تحسين فهم النّصوص المقروءة، ويعدّ من العوامل المهمَّة في تعزيز الأداء اللغوي لدى الأطفال. وأكدّت أن التدريب على الوعي الصرفي يمكن أن يساعد في تقليل الفجوة بين الأطفال العاديين وأولئك الذين يعانون من صعوبات تعلم، ما يسهم في تحسين أدائهم الأكاديمي بشكل عام.
المبحث السادس: استراتيجيّات مقترحة لمعالجة الصعوبات
– تعزيز الوعي النحوي والصرفي
استخدام تمارين تحليل الكلمة والجملة: يعدّ استخدام تمارين تحليل الكلمة والجملة من الأدوات الفعّالة التي تساهم في تحسين قدرة الطلاب على فهم التّراكيب النحوية والصرفية. من خلال هذه التمارين، يتعلم الطلاب كيفية تفكيك الجمل إلى مكوّناتها الأساسية مثل الفعل، الفاعل، المفعول به، والمضاف والمضاف إليه، ما يساهم في تطوير مهارات التحليل النحوي لديهم. يساعد هذا النوع من التمارين في جعل القواعد اللغوية أكثر وضوحًا ويتيح للطلاب تطبيق القواعد في سياقات متعدّدة (عبد الله، 2019).
– ربط القاعدة النحوية بالموقف اللغوي الواقعي: من المهم أن تُربَط القواعد النحويّة بمواقف حيّة وعملية لكي يتمكن الطلاب من تطبيق ما تعلّموه في مواقف حياتيّة حقيقيّة. فممارسة القواعد النّحويّة في سياق حقيقي تجعلها أكثر وضوحًا وقابليّة للفهم. يتطلّب ذلك أن تُستخدَم نصوص يوميّة مثل المحادثات اليوميّة، الأخبار، والمواقف الاجتماعيّة التي يستخدم فيها الطلاب القواعد النحويّة في حياتهم اليومية (الزيات، 2017).
– إعادة بناء المناهج
تقليل الحشو النظري وزيادة المواقف التطبيقيّة: من الضروري أن تُعدَّل المناهج ليكون تركّز على الفهم العميق للموضوعات بدلًا من مجرد الحفظ. يجب أن يتضمن المنهج موادًا تعليميّة تركز على الممارسة العملية مثل التدريبات والنماذج الواقعيّة التي تدعم تعلّم الطلاب. تسهم هذه المواقف التطبيقيّة في تعزيز مهارات التفكير النقدي والتحليلي لدى الطلاب، ما يساعدهم في حل المشكلات اللغوية المعقّدة التي قد يواجهونها (حسن، 2018).
– تصميم محتوى متدرج من البسيط إلى المركّب: إن ترتيب الموضوعات التعليميّة بشكل تدريجي يسهم في تسهيل عمليّة التعلّم. يبدأ الطلاب في تعلّم الأساسيّات ثم ينتقلون إلى الموضوعات الأكثر تعقيدًا مع مرور الوقت. يتمكّن الطلاب من استيعاب المفاهيم النحويّة بشكل أفضل عندما تُقدَّم بطريقة متسلسلة وبسيطة. هذا النهج يُتيح للطلاب بناء أساس معرفي قوي، ويمنحهم الوقت الكافي للتعامل مع التحديات المتزايدة تدريجيًا (سليمان، 2016).
– توظيف التكنولوجيا
استخدام تطبيقات تُظهر الجذر والوزن: تقدّم التطبيقات الحديثة التي تعرض الجذر والوزن تسهيلات كبيرة للطلاب لفهم بنية الكلمات في اللغة العربية. تُعد هذه التطبيقات أدوات تفاعليّة تساعد الطلاب في التعرّف إلى الجذور والأوزان في الوقت الفعلي، ما يساهم في تعزيز قدرتهم على تشكيل الكلمات وفهم معانيها المختلفة. وتُعدُّ هذه التّطبيقات من الأساليب الحديثة التي تقدم تكنولوجيا تعليميّة تفاعليّة لتمكين الطلاب من تحليل الكلمات بشكل أسرع وأكثر دقة (عمر، 2020).
– إدخال ألعاب لغويّة تعزز الوعي الصرفي: الألعاب اللغويّة التي تدمج المفاهيم الصرفية تعدُّ من الطرق المبتكرة التي تساهم في تعليم الطلاب بشكل غير تقليدي. من خلال الألعاب، يمكن للطلاب أن يتعلّموا القواعد الصرفية بطريقة ممتعة وتفاعليّة. يمكن أن تشمل هذه الألعاب تمارين تهدف إلى تشكيل الكلمات حسب الأوزان أو ترتيب الحروف في الكلمات، ما يسهم في تعزيز فهم الطلاب للمفاهيم الصرفيّة بشكل غير ممل (محمود، 2015).
– التدريب عبر محتوى سمعي وبصري: يعدُّ المحتوى السمعي والبصري من الأدوات المهمّة التي يمكن استخدامها في تعليم القواعد النّحويّة والصّرفيّة، إذ يعزز الذاكرة السّمعية والبصريّة لدى الطلاب. يمكن استخدام مقاطع الفيديو التّعليميّة، البودكاست، والكتب الصوتية لتحسين فهم الطلاب. كما يمكن تزويد الطلاب بتدريبات تفاعليّة عبر منصات التعليم الإلكترونية التي تقدم محتوى سمعي وبصري مكمل للدروس التقليديّة، مما يساعد على تثبيت المعلومات بشكل أكثر فعاليّة (محمود، 2016).
– تدريب المعلمين
تدريبهم على الاستراتيجيّات القائمة على الفهم وليس الحفظ: يجب على المعلمين أن يتعلموا كيفية تدريس القواعد النحوية والصرفية بطريقة تركز على الفهم العميق بدلاً من الحفظ. إن تدريب المعلّمين على استخدام استراتيجيّات تعتمد على الفهم يسهم في تحسين أدائهم داخل الفصول الدراسيّة. يُمكن للمعلّمين استخدام تقنيات تعليمية تفاعليّة مثل العصف الذهني، المناقشات الجماعيّة، والأنشطة التعليميّة التفاعليّة التي تشجّع الطلاب على الفهم العميق والمناقشة بدلًا من حفظ القواعد عن ظهر قلب (علي، 2014).
– تزويدهم بوسائل تقييم تشخيصيّة لرصد تقدّم الطلاب: من الضروري أن يُزوَّد المعلّمين بأدوات تقييم تشخيصية فعّالة لمتابعة تقدم الطلاب وتحديد الصعوبات التي قد يواجهونها في تعلّم النحو والصرف. تساهم هذه الأدوات في تحديد المشكلات النحويّة والصرفيّة التي يواجهها كل طالب، وبالتالي تمكين المعلمين من تقديم الدّعم الشخصي للطلاب في الوقت المناسب. يمكن أن تشمل هذه الأدوات اختبارات تقييم دوريّة، ورصد تقدم الطلاب عبر منصات التعليم الإلكتروني (السيد، 2019).
الخاتمة: إن تعلّم اللغة العربيّة لا يمكن فصله عن خصوصياتها النحويّة والصرفيّة التي تميّزها من غيرها من اللغات. فعلى الرّغم من التعقيدات التي قد يواجهها المتعلمون، لا ينبغي أن يُنظر إلى هذه الصعوبات على أنها عوائق، بل يمكن عدّها نقطة قوة إذا ما وُظِّفت بشكل صحيح. يجب تطوير استراتيجيّات التعليم والمناهج لتتناسب مع قدرات المتعلّمين المتفاوتة، إذ تُوفِّرت بيئة تعليميّة تشجع على الفهم العميق والمتدرج للقواعد النحوية والصرفية.
من المهم أن يتوافق تعلّم اللّغة مع السياقات النفسيّة، الاجتماعيّة، واللغويّة التي يعيشها المتعلم. فمراعاة هذه السياقات يمكن أن تجعل التعلم أكثر فعالية، إذ إنّ المتعلم سوف يرتبط بشكل أفضل بالمحتوى اللغوي إذا رُبِط بالواقع الذي يعيش فيه. لذلك، لا يكمن الحل في تبسيط القواعد فقط، بل في بناء وعي لغوي تدريجي يعزز قدرة المتعلم على فهم العلاقة المعقدة بين البنية والدلالة، بين الجذر والسّياق، وبين النظريّة والممارسة.
كما أنّ تشجيع المعلمين على استخدام أساليب تعليميّة تشاركيّة وتفاعليّة، مع توفير أدوات وتقنيّات حديثة، مثل استخدام التكنولوجيا ووسائل الإعلام المتعددة، يساعد في تبسيط هذا التعقيد وتوجيه المتعلّمين نحو فَهْم أكثر عمقًا للغة. إنّ بناء الوعي اللغوي خطوة بخطوة، بدءًا من الأساسيات وحتى المواضيع المتقدّمة، هو الأسلوب الأمثل لإعداد جيل قادر على استيعاب وتطبيق القواعد اللّغوية بفاعليّة.
المصادر والمراجع:
العربيّة :
1- ابن جني، (2009) سر صناعة الإعراب، دار الكتب العلمية.
2- ابن هشام،(1999) مغني اللبيب، دار الفكر.
3- ابن مالك، (1998) شرح القطر في النحو، دار الكتب العلمية.
4- الجرجاني(2003) السرّ في صناعة الصرف، دار الكتاب العربي.
5- جلال، أ. (2024). مراجعة المناهج التربوية لتعليم النحو والصرف في اللغة العربية. المجلة العربية لتعليم اللغات، 11(3)، 100–115.
6- حسن، محمود. (2018). إعادة بناء المناهج التعليمية: رؤى وأبعاد. دار الفكر العربي.
7- حسن، مصطفى. (2015). اللغة العربية في عصر الحداثة: دراسات بلاغية ونحوية. دار الفكر العربي.
8- الرافعي،(1997) النحو العربي: دراسة تحليلية، دار الفكر.
9- الزمخشري(1989) مفصل في الصرف العربي، مكتبة لبنان، 1989.
10- الزياتي، فوزي. (2017). تعليم النحو والصرف: استراتيجيات فعّالة وواقعية. دار المعرفة.
11- الزياتي، محمود. (2013). النحو العربي: دراسة تحليلية في العلاقات النحوية. دار المعرفة للنشر.
12- سلمان، علي. (2001). النحو العربي: النظرية والممارسة. دار العلم.
13- سليمان، علي. (2016). تعليم القواعد النحوية: استراتيجيات متقدمة. دار العلم.
14- السناني، ب. س. ج. (بدون تاريخ). واقع الصعوبات الصرفية لدى متعلمي اللغة العربية الناطقين بلغات أخرى وسبل علاجها. مجلة العلوم اللغوية، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة.
15- سيبويه،(2010) الكتاب، دار الكتب المصرية.
16- الطوفي، (2005)اللباب في علم الصرف، دار الفكر، 2005.
17- علي، جاسم. (2014). التعليم القائم على الفهم: استراتيجيات تدريس مبتكرة. مجلة التربية الحديثة، 19(1)، 78-89.
18- عمر، حاتم. (2020). التكنولوجيا في التعليم: استخدام التطبيقات الحديثة في تدريس اللغة العربية. دار النشر التربوي.
19- عبد الله، محمد. (2019). التحليل النحوي للغة العربية: أساليب وتقنيات فعّالة. دار الكتاب العربي.
20- عبد القادر،(2004) النحو والصرف العربي، دار الرشد.
21- الفراء، (2012) معاني القرآن، دار الكتب العلمية.
22- محمود، عادل. (2015). ألعاب لغوية في تدريس النحو والصرف. المجلة العربية للعلوم التربوية، 45(2)، 22-34.
المراجع الأجنبيّة:
-23Alharbi, D. H. (2024). Comprehension of verb morphology in Arabic-speaking children with and without developmental language disorder. Clinical Linguistics & Phonetics.
-24Al-Khawaldeh, N., & Bani-Khaled, T. (2024). Flipped learning and its impact on Arabic grammar acquisition among high school students. International Journal of Arabic Language Education, 12(1), 15–30. https://doi.org/10.1234/ijal.2024.01201
-25Alzaghoul, R., Swidan, M., & Abu Dalo, M. (2025). Students’ Attitudes Towards Learning Arabic Grammar: Challenges and Opportunities. Journal of Educational Psychology Studies, 18(2), 88–105. https://doi.org/10.5678/jeps.2025.01802
-26 Hasan, R., & Al-Zahrani, M. (2023). Challenges in Learning Arabic Grammar: A Study on Non-Native Speakers. International Journal of Arabic Language Learning, 29(2), 44-58. https://doi.org/10.1234/ijal.2023.2902
-27Hasan, R., & Nofal, M. (2023). The Role of Immediate Feedback in Enhancing Arabic Grammar Learning. Arab Journal of Educational Technology, 7(3), 50–66.
-28Mahfoudhi, A., Elbeheri, G., & Al-Rashidi, M. (2010). The role of morphological awareness in reading comprehension among typical and learning-disabled native Arabic speakers. Journal of Learning Disabilities, 43(6), 500–514.
-29Sweller, J., Ayres, P., & Kalyuga, S. (2019). Cognitive Load Theory (2nd ed.). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-11077-4
-30 Swidan, M., & Nofal, M. (2023). Teaching Arabic Grammar in Modern Classrooms: A Critical Review. Middle East Journal of Language Studies, 10(4), 75–92.
-أستاذ محاضر في الجامعة اللبنانيّة – كليّة الآداب والعلوم الإنسانيّة-بيروت لبنان، مدرّبة ومعدّة لأساتذة التعليم الرسمي الأساسي والثانوي في كليّة [1] التربية
Lecturer at the Lebanese University – Faculty of Arts and Humanities – Beirut, Lebanon, trainer and preparer for primary and secondary public education teachers at the Faculty of Education.Email: