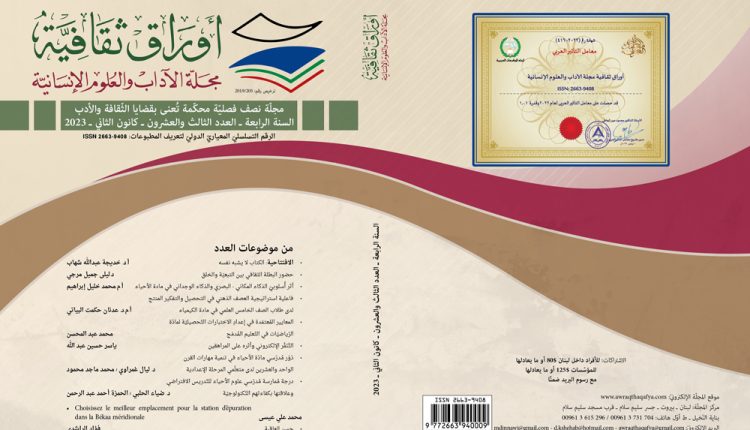اسم المجلة: مجلة أوراق ثقافية
في أجناسيّة القصّة القصيرة
أثرٌ من الضّبط إلى الانفلات
رافد سالم سرحان المحمدي[1]) )
تاريخ الإرسال: 29 /12/ 2022 تاريخ القبول: 31/12/2022 تاريخ النشر:30/ 01/2023
الملخص
يسلّط البحثُ الضّوءَ على أجناس القصة القصيرة (أثر من الضبط إلى الانفلات)، حيث عالج الباحث القدرة على اختزال العالم بهذه الأقصوصة، وتحدث عن الحدود الأجناسية، والفرق بين القصة القصيرة والشعر.
الكلمات المفتاحية: أقصوصة، قصة، أجناس.
ABSTRACT
The research sheds light on the genres of the short story (an effect from discipline to liberation), as the researcher dealt with the ability to reduce the world to this story, and talked about the gender boundaries, and the difference between the short story and poetry.
Keywords: story, story, genres.
المقدّمة:
“قِيل إنّ وجهًا جديدًا ظهر على الكورنيش ، سيّدة تصحبُ كلبًا …( [2]) “
هذه جملة افتتاحيّة من أقصوصة “السيدة صاحبة الكلب” للأنطون تشيكوف. تساءل كثيرون من أين للأقصوصة تلك القدرة على اختزال عالمٍ بأكمله في حفنة من الكلمات؟ ! وما السرُّ في تلك الطاقة المتوهّجة التي تمنحها شاعريّةً ما ؟!
و السؤال الأكثر أهمّيّة هل يمكن إخضاع هذا النوع من الكتابة للضّبط الأجناسي ؟ و هل قدرُ الأقصوصة أن يظلّ مرتهنًا بالرواية من جهة علاقة الأصل بالفرع كما يزعمون ؟!
إذا كان مصطلح الرواية قد رسخ واستقرّ في النقد العربي والغربي، فإنّ فنّ الأقصوصة ظلّ جنسًا مراوغًا غير واضح المعالم و الحدود كما لا ننسى أنّ الدراسات النظرية في مجال الأقصوصة توشك أن تكون غائبة وخاصة في النّقد العربي([3]). والسؤال الذي يطرح نفسه بامتياز هو :
– كيف يمكن لهذا الفنّ الأدبي البسيط أن يختزل التّجربة الإنسانية في عدد قليل من الصفحات ؟
– ما سرّ الطاقة الشعريّة الكامنة في لغة القصّة القصيرة ؟
– هل ثمّة حدود أجناسية بين القصة والقصة القصيرة، والأقصوصة أم هي تنويعات اصطلاحية لمدلول واحد ؟
– هل من امتداد و تواشج بين الأقصوصة العربيــة وأشكال القصّ القديم ؟
لا بدّ من التمييز بداية بين الأقصوصة كجنس أدبيّ قائـــم الذات، والقصّة كمصطلح جامع لكلّ الموروث السردي الإنساني . وفي هذه الحال لا يمكن أن نتحدّث عن بدايات لأنّ تاريخ القصة طويل وقرين الوجود الإنساني منذ أن ابتدع الأساطير والحكايات والنوادر والأمثال …أمّا تاريخ الأقصوصة فبالغ الإيجاز (صبري حافظ([4]))
في مشكلة البدايات نجد ثلاثة اتّجاهات متباينة :
* واحد يرجع الأجناس المستحدثة إلى أشكال تراثية عرفها الأدب العربي القديم كالمقامة([5]) والنادرة وأيام العرب والرسالة و سرعان ما ينزلق إلى الفكر التأصيلي، وينحو البحث فيه إلى نوع من السجال الحضاري العقيم .
* وثانٍ يسلّم بأنّ الأقصوصة جنس وافد غربيّ المنابت له أصوله التّاريخيّة والحضاريّة الخاصة .
* و ثالث يتحدّث عن ازدواجية المنابع إذ لا يمكن عزل نشأة الأقصوصة العربية الحديثة عن أشكال القصّ القديم لسببين :
– أنّ المروث القصصي العربي و الإنساني عامة يمثّل جزءا من ذاكرة الكاتب و ثقافته .
– أنّ الأشكال القصصية القديمة قد تساهم في بناء مواضعات أجناسية خاصة بالأقصوصة الحديثة .
كما لا يفوتنا التذكير ببعض الأجناس التي يُقال: إنّها أثّرت وربّما ساهمت في نشأة الأقصوصة الغربية من قبيل :
أجناس حكائيّة انتشرت في القرون الوُسطى و تحديدا في فرنسا مثل : fabliau ، lais ، dits ، devi، exemples ، contes … ، وبعضها كان حكايات قصيرة من دون مؤلّف تروى وتوزّع في الطريق العامّ مجانًا وتصنّف إلى عائلتيْن:
– ما يُسمّى بالقصص الوعظيّة الصغيرة: les exemplums وهي ذات منزع ديني تنشدُ الأخلاق و التّعاليم الكنائسيّة .
– الحكايات الملفّقة أو الكاذبة Les canards وتروي أخبار السرقة والقتل والغشّ والتحيّل، وهذا النوع سيصبح لاحقًا دالًّا على ما نسمّيه اليوم بالصحف وأخبار المتفرقات .
مع القرن الخامس عشر ميلادي سيظهر عمل مستوحى من الديكاميرون لبوكاس (1349/1353) وهو مائة أقصوصة جديدة، وهو مجهول المؤلّف ثمّ يتلوه كتاب ميغال دي سرفنتس: les Nouvelles exemplaires سنة 1613.
ومهما كان الأمر فإنّ أنتروبولوجيّة القصّة القصيرة ستظلّ غائمة لاعتبارات تاريخية واجتماعية، إذ ارتبطت الأقصوصة بالبساطة والنّقصان في حين كانت الرواية علامة على الاكتمال والنّضج، ولذلك رفض الكثير من الناشرين في القرن السادس عشر في فرنسا نشر أقاصيص لكتاب مبتدئين إلاّ لبعض الأسماء الروائيّة المشهورة .
فالغبن الذي لحق بالأقصوصة عائد لا محالة في بعض جوانبه إلى ما يُسمّى بالعرف الثقافيّ ،وفيه العرف الأجناسي الذي يجعل من الأقصوصة استطرادًا داخل الرواية، وكأنّ الثانية هي الأصل والأمّ الحاضنة لهذا الابن الذي سيصير عاقًّا في زمن ما غير زمن الرواية .
– الحدود الأجناسية للقصة القصيرة :
أ – في منزلة القصة القصيرة من الرواية :
غُبن حظّ القصة القصيرة من الدراسة والبحث عن مبرراتها الأجناسيّة بالنظر إلى الرواية، كما توجّس البعض في إمكانات القصة القصيرة على استيعاب عالم التجربة الإنسانية الواسع والمعقّد . فالتّجربة الإنسانيّة كما يقولون تفيض على الشــــكل الأدبي للأقصوصة. هذا الحيف الذي لحق بالأقصوصة عائد إلى طول مقارنتـها بالرواية وعدَّ الكمّ والحجم مؤشّرًا على العمق والتميّز إذ ليس في قدرة القصة القصيرة أن تختزل جوهر الحياة الإنسانيّة في حفنة مــــن الكلمات.
بدأت أولى المحاولات الدّقيقة للتمييز بين جنسيْ الرواية والأقصوصة مع الشكلانيــــين الروس وخاصّة :
– تينيانوف (Tynianov.J 1894/1943) في مقال له بعنوان ” مفهوم البناء” نشر بالروسية أول مرة سنة 1923
– إيخنباوم (Eikhenbaum.B.N1886/1959) “حول نظرية النثر” 1925
– شكلوفسكي (V.Chklovski 1893/1984) “بناء الأقصوصة و الرواية”1925
من مقال لإيخنباوم نسوق الخصائص التّمييزيّة الأوليّة الآتية بين الرواية والأقصوصة :
– ” ليست الرواية والأقصوصة شكلين مؤتلفين، وإنّمـــا هما شكلان متباعدان تباعدًا عميقًا… إنّ الرواية شكل توليفيّ قائم على التعدّد والتعقّد، أمّا الأقصوصة فشكل أساسي أوّلي قائم على الوحدة والبساطة مع التنبيه ههنا إلى أنّ البساطة لا تعني أنّ الأقصوصة ذات بناء بدائيّ ضعيف”
– تستمدّ الرواية مادّتها من التاريخ أو من وقائع الرّحالات في حين تنشئ الأقصوصة مادّتها من الكتابة والنوادر وأحيانًا من اليومــيّ والعرضيّ أو العادي المهمّش والمبتذل :Le banal .
– بناء الرواية انسجامي توليفي، أمّا الأقصوصة فتبنى على أساس التناقض أو انعدام الائتلاف أو وجود خطأ (مقصود) أو تضـــادّ وتشظّ .
– الشكل الأساسي للرواية ثلاثيّ الأقطاب (البناء الأرسطي) في حين تبنى الأقصوصة على مثلّث ضلعه الثاني وهميّ إذ تومئ بوجود ذروة، ولكنّها في الحقيقة تحشد كامل طاقتها إلى النّهاية (لحظة التنوير) إنّها كالقنبلة التي تلقى من طائرة يكون هدفها الأساسي، هو المسارعة بإصابة الهدف بكلّ طاقتها الانفجاريّة.
– تفتقر الأقصوصة إلى الذروة البنائيّة، بل تصبح النّهاية أو لحظة الكشف هي البديل عن هذه الذروة المفتقدة.
– يصبح مصطلح الأقصوصة عند إيخنباوم تركيزًا لشرطين أساسيين هما: صغر الحجم وتركيز الحبكة المؤدية إلى النهاية . فالأحداث حركة متوهّجة نحو النهاية، التي تتركّز فيها كلّ المقومات البنائيّة وبها تكتسب الأقصوصة مبررات وجودها وملامحها الأجناسيّة المميّزة .
– محور الأقصوصة يكون في نهايتها (ذيلها) حتّى لو كانت هذه النهاية ضمنيّة، أو متخفيّة في ثنايا العمل القصصيّ.
– تعمد الرواية إلى تقنية الإبطاء في نسق الأحداث والربط بين العناصر المتنافرة وتكون النهاية لحظة ارتخاء أو هدوء بعد توتـــر و اضطراب([6]):Moment d’affaiblissement
– تعمد الأقصوصة إلى الاختزال بتسريع نسق الأحداث (ومضات) و بنائها على المنافرة والتضادّ .
– مآل الرواية منطقية منتظرة منسجمة مع ما سبق في حين تكون نهاية الأقصوصة مفاجئة غير منتظرة مراوغة ، فهي تتوقّف في لحظة القمّة (الانتحار، الخروج مع الثور إلى الغابة عوضا عن مواصلة النّزال، الرّحيل …) فهي تقف في لحظة الاشتداد([7]): Moment de renforcement
ما نستخلصه مما سبق :
* أنّ الحسم الذي قام به إيخنباوم بين الـــرواية و القصّة يقضي على الاعتقاد الواهم بكون أحدهما اختزالًا أو تصغيًرا للآخر.
* الفارق بين النوعين ليس فارقًا كميًّا مرتبطًا بالحجم والقالب بل هو فارق في الجوهر و المبدأ والإيديولوجيا على الرّغم من التّشابه السّطحي .
* لا يمكن مقاربة أحد النوعين بمصطلحات الآخر بناء على التباين في الجهاز الاصطلاحيّ، والمواضعات الأجناسيّة الخاصة .
في بعض المواضعات الأجناسيّة :
هذه المواضعات تمثّل نحو الشكل الأدبيّ، وشفرته فيها ما هو ثابت وفيها ما هو متحرّك رجراج ينحو إلى الانفلات و التوسّع . و ما إن يبدأ الشكل الأقصوصي في رسم أجروميته الخاصة حتّى تنفلت بعض عناصره انفلاتا جزئيا عن المواضعات القديمة .
أولى هذه المواضعات هي : الاختـزال والإخبار عن طريق الإيماء والإيحاء أو التّضمين. فالجملة الواحدة تكتنز عددًا لانهائيًّا من المعاني والإحالات . فالاختصار والقطع (brièveté، concision ) هما اللذان وسما التّسمية الأجناسيّة القائمة على التصغير في العربية و في اللغة الأنقليزية short story و الألمانية kursgeschichte
لنأخذ مثلا جملة عابرة من أقصوصة الأرض المستحيلة لإيميلي نصر الله :” لقد جاؤوا من شتّى المجالات والأزمنة يحملون وجوها كواها الحزن ([8])“.
فكميّة المعلومات التي تخبرنا بها هذه الجملة مؤشّر على قدرة الاختزال، والتّضمين على أسر عالم بأكمله في قبضة حفنة من الكلمات. إذ نكتشف ضمنيًّا أنّ السّياق الحافّ بالجملة هو الاحتلال وأنّ المخبر عنهم من خلال ضمير الغيبة (هم) لا شكّ في أنّهم من رجالات المقاومة، والنّضال ونفهم أنّ مجيئهم محفوف بالسريّة والخطر كما تستبطن العبارة تاريخهم المليء بالمعاناة من خلال عبارة (يحملون وجوها كواها الحزن) …
كما تفوح من الجملة رائحة الحبّ و الإخــلاص و الانشداد إلى الأرض… فهذا الفيض الدّلالي الذي تختزنه الجملة الواحدة عائد إلى تقنية الإيماء كشفرة خاصة بين الســــارد، والقارئ وكأنّ الأوّل يعوّل على رهافة حسّ الثاني وفطنته فلا داع إذن لذكر الزوائــــد والتفاصيل، وكأنّ القاصّ يقيم عقدًا قرائيًّا قوامه: أنا أشعـــل الومضات و القارئ يكمل الباقي
ثاني المواضعات هي : التقطيع والاجتزاء أو التأطير بالمفــــهوم السينمائي: فالحياة في عالم الأقصوصة قطعة أو جزء متوهّج لكنّه يختزل الحياة كاملة : فهو الجزء الذي يختزل الكلّ الوهمي: فعبارة : لن تمنعه عن الحضور تهديدات سابقة ، من شتّى الجهات، ولن يمنعه الحزام الأمنيّ الجديد، الملتفّ مثل حبل مشنقة حول عنق الجنوب ([9]).(الأرض المستحيلة) هي تحمّل ومضات استرجاعيّة لتاريخ كامل من: الاحتلال إلى اجتياح جنوب لبنان إلى الخـيانات والمخيمات و الخيبات ….
يرى أوفلين أنّ “القصّة القصيرة حيلة مكثّفة تعتمد على الثقة المطلقة، وهي وهم مكثّف وإنجاز تكتيكي بارع كعرض واحد من أمهر الحواة .” كما قال يوسف إدريس :” أستطيع بالقصّة أن أصغّر بحرا في قـطرة و أن أمرّر جُملًا من ثقب إبرة كالحاوي الذي يملك حبلًا طوله نصف متـــــرو لكنّه يستطيع أن يحوط به الكون الذي يـريد([10])”
الملمح الثالث هو : وحدة الانطباع
وهو مقوّم بلوره إدغار آلان بو سنة 1842وعدَّه الخصيصة البنائيّة الأساسيّة للأقصوصة .
هذا المحدّد يعدُّ محدّدًا أجناسيًّا تقبّليًّا أي مرتبطًا بمشــاعر القارئ وحساسيته المختلفة من الرواية إلى الأقصوصة. فالقصة القصيرة لا تسمح بتشتّت الانفعالات أو تعدّدها أو تناقضها كما هو الشأن في الرواية، وذلك لأنّها تقرأ في مقام ونَفَسٍ واحديْن. وتفترض وحدة الانطباع مقوّمًا آخر مرتبطا بالمدى L’ampleur إذ لا يسمح قصر الأقصوصة بتعدد المواضيع أو تعدد المسارات أو أيّ شكل من الاستطراد. فظاهرة التكثيف والتركيز تستدعي شذب أيّة زوائد أو شوائب ممجوجة .
*لحظة الإضاءة أو التنوير: أو لحظة الكشف أو لحظـــة الأزمة أو الإشراقات … وهي اللحظة التي تطرأ فيها تحولات حاسمة كما يفاجأ القارئ بالنّهاية المراوغة لما كان يقرأ : فهي اللحظة المخيّبة لانتظارات القارئ إن شئنا. فالكشف مضاعف : كشف لمصير الشخصية الكارثي والفادح أي خيبة المآل وكشف معاكس لانتظارات القارئ فتكون النهاية :
باردة:”لو أنّك سحبت الباب نحوك بدلًا من دفعه أمامك لخرجت من الزنزانة منذ أوّل يوم([11])“(حكاية الباب/عز الدين المدني)، أو السّاخرة الثقيلة :” و بارك الله في الحكومة([12])“(أمانه /عبد الحميد جوده السحار) أو العبثيّة المأساويّة، إذ تنغلق فيها الأحداث بمثل ما ابتـــدأت به : ” تبًّا لدنيا لا مجال فيها لصادق([13])” (صادق / ميخائيل نعيمة)
أو النّهاية الشّاعريّة المتوهّجة والمتوتّرة :” وكانت المــركبة في انتظاري ، وأنا أغادر العتبة مركبة مجنّحة بوسعها رفع جبال …([14]) ” (الأرض المستحيلة لأيميلي نصر الله )
* اتّساق التصميم :
ويعني به إدغار آلان بو طريقة بناء الحبكة أيّ أسلوب ترتيب الأحداث وانتقائها حسب رؤية القاصّ واستراتيجيته .
منطق ترتيب الأحداث يمكن أن يكون مساوقًا لنظام الأحداث الطبيعي أي كما تجري في الواقع، ويمكن أن يكون مفارقًا و مختلفًا فيعمد القاصّ إلى تقنيات عديدة كـ : التضمين والارتـــداد أوالاستباق أو القطع والإرجاء …
* البنى و مستويات الرؤية :
لننطلق من عبارة متكرّرة في أقصوصة ” أمانة ” لعبد الحميد جودة السحّار وهي :”و بارك الله في الحـــــكومة ([15])”
فالجملة تمثّل عبارة رسمية ممجوجة ينطق بها السارد في نهاية كلّ فقرة، وهي وإن وردت على لسانه فإنّها تقال عادة من قبل العمال الخاملين المتحايلين على صاحب المصنع كما تضمر صوتًا آخر متخفّ هو صوت القارئ الساخر المتهكّم .
فالعبارة تختزن أصواتًا عديدة ووجهات نظر متباينة :
وجهة نظر فئة من العمال الانتهازيين.
وجهة نظر السّارد.
وجهة نظر القارئ.
فتعدّد الأصوات كما يقول باختين: narration polyphonique سمة أجناسيّة محدّدة للعمل الأقصوصي
و عبارة “تبًّا لدنيا لا مجال فيها لصادق([16])” يمكن أن تكون إضافة إلى صوت الشّخصيّة المحوريّة (صادق) صدى آخر لصوت السارد الناقل للحكاية و صوت القارئ المعتبر والمندهش من النهاية .
* البنى :
تخضع الحركة الداخلية للنصّ القصصي لتنويعات عديدة في البنية الثنائيّة، وقد ضبط شكلوفسكي أنساقًا كثيرة من الأبنية في بحثه المنشور سنة 1925 نذكر أهمّها :
و داخل كلّ فئة نجد تنويعات أخرى كبنية الحلقة (أقصوصة صادق) أو البنية اللولبية أو بنية التركيب والتراصف …
في ما بين القصة القصيرة و الشعر :
يرى صبري حافظ أنّ التكثيف والإيجاز والإيحاء تضع على اللغة عبئا ثقيلًا .. فلغة الأقصوصة “متأهّبة مستحوزة فياضة بالمعـــاني و الإيحاءات)([17](” .
و إذا كان الروائي يعمل بالفقرة والفصل، فإنّ كاتب الأقصوصة يشتغل بالجملة والكلمة ولذلك كانت أكثر الأجناس اقترابًا من الشعر و الشّعرية خاص وأنّ إدغار بو ربط بينها وبين القصيدة الغنائية .
فكلاهما يقرأ في جلسة واحدة ويجمع بينهما وحدة التركيز والهدف والشّحنة العاطفية واتساق التصميم .
ملامح الشّعرية في القصة القصيرة نجدها في مستويين :
– مستوى الخطاب : عبر الإيقاع والانــزياح و التكثيف :
مثال :
التقت نظراتنا
حدث ذلك على عجل
و بين النظرة و النظرة
كانت ترتفع أزمنة
و تقف شعوبا و قبائل
لكن لمعة البرق كانت هناك
مختبئة كامنة
لم يطفئها مرور الأيام([18])(الأرض المستحيلة لإيميلي نصر الله )
فالتقطيع الذي خلقته الفواصل والموازنة النـــّحوية والتّركيبيّة بين الجمل دفع بالكلام ليستيقظ من سباته النثريّ ويتسرّب إليه الإيقاع .
أمّا الانزياح فهو عدول عن التصريح و نزوع إلى الإيحاء والإيماء وهو ما يمنح الكلام مكوّنا مهمًّا من مكونات الشّعريّة ألا وهو الغموض والتكثيف .
منزلة القصة القصيرة من الواقع و من الموروث السّردي
ترى ماري لويزبرات في مقال لها بعنوان: “القصة القصــــيرة والرواية([19]): الطول والقصر” أنّنا نجد في “القصة القصيرة إحياءً لبقايا التراث القصصي الشّفاهي والشّعبي والدّيني مثل الحكاية الخرافية، وقصص الأشباح والعفاريت والقصة الدّينيّة أو المــثل والقصـص الأخلاقيّة وقصص الحيوان … وقد استطاعت القصة القصيرة أن تستوعب كلّ هذه النوعيات في الأدب بصفة عامة”.
ما نستخلصه :
– أنّ استيعاب التراث السردي الإنساني سمة أجناسيـــة مُميّزة للأقصوصة .
– تستدعي الأقصوصة أحيانًا أشكالًا سردية قديمة في مستـويات أربعة :
– الخبر : أحداث، شخصيات، الراوي (المروض والثور، حكاية الباب…)
– في مستوى العوالم التخيلية المفارقة المكانية والزّمانيّة : في قديم الزّمان، في مدينة من مدن الأندلس…
– في مستوى الخطاب: عبر قرائن نصية توهم بالانشداد إلى أشكال السرد القديم : زعموا أنّ ، يُروى أنّ ، كان في القديم ، كان يا ما كان …
في تطوّر جنس الأقصوصة :
إذا انتهينا إلى أنّ الأقصوصة جنسٌ متعدّد الأشكال polymorphe فربّما ذلك عائد إلى قابليته للتجدّد والاستئناف دائمًا أمام الضبط الأجناسي، ولذلك نجد تنويعات وتشكيلات كثيرة في مستوى العوالم الممكنة (واقعية، فنطاستيكية ) و الأسلوب (ساخرة ، شاعرية …) وحتى بروز أشكال جديدة مثل:
– الأقصوصة الومضة La Nouvelle –instant وهي لا تروي حكاية بقدر ما تسلّط الضوء على لحظة معيّنة من الحياة أو شعور ما لشخصيّة في مواجهة وضعية ما، ومن أبرز اعلامها اليوم (Annie Saumont ، Olivier Adam..)
– الأقصوصة الانحداريّة : La Nouvelle à chute وتتميّز بنهايتها المٌفاجئة والمُراوغة مثل أقصوصة “الحلي” لموبسان، وعندما كانت أنجيلا لوحدها لباسكال ميريجو (Le parure ، de Maupassant ، Quand Angèle fut seule ، Pascal Mérigeau)
– الأقصوصة الصغرى La micronouvelle
و تتكوّن من 4 إلى 1000 كلمة أي أقلّ من صفحة، وسمتها القطع والاختصار والإيماء و من أبرز كتّابها فيليكس فينيون Felix Fénéon و الذي كتب قصصًا تمتدّ على ثلاثة أسطر استوحاها من المتفرقات .
و السؤال الأخير : أليست التغريدة twitter ([20]) حاليًّا جنسًا أقصوصيّا بامتياز؟ أليس هو الجنس الأكثر قراءة في عالمٍ متشظٍّ و مُجزّءٍ و مفتوح على المجهول ؟
المصادر و المراجع :
العربية :
1- الصادق قيسومه ، طرائق تحليل القصّة . دار الجنوب للنشر بتونس سلســـــــــلة مفاتيح 2000
2- أبو المعاطي أبو النّجا ، القصّة القصيرة و البحث عن خصوصيّة الذات ، كتاب العربي عدد 31 ، 1993
3- سمير المرزوقي و جميل شاكر ، مدخل إلى نظريّة القصّة ، الدار التونسية للنشر 1985
4- عبد الملك مرتاض ، نظرية الرواية ، عالم المعرفة عدد 240 ، 1998
5- محمد القاضي ، إنشائيّة القصّة القصيرة ، دراسة في السرديّة التونسيّة ، الوكالة المتوسطيّة للصحافة ، ط1 مارس 2005
6- مجلة فصول المجلّد الثاني العدد الرابع 1982 عدد خاصّ حول القصة القصيرة ، اتجاهاتها و قضاياها
الأجنبيّة :
7- Mary Louise Pratt، The Short Story: The Long and the Short of It، in The New Short Story Theories، éd. Charles May، Ohio UP، Athens، 1994 et Gitte Mose، Danish Short Shorts in the 1990s and the Jena-Romantic Fragments، in The Art of Brevity: Excursions in Short Fiction Theory and Analysis، éd. Per Winther، Jakob Lothe et Hans H. Skei، Université de Caroline du Sud، Columbia 2004
8- Aubrit، J.P.، 1997. Le conte et la nouvelle. Paris : Armand Colin/Masson.
9- Engel، V. (sous la direction de)،1995. Le genre de la nouvelle dans le monde au tournant
du XXIe siècle. Belgique : Editions Phi.
10- Goyet، F.، 1993. La nouvelle (1870-1925). Description d’un genre à son apogée. Paris :
PUF Ecriture.
11- Grojnowski، D.، 1993. Lire la nouvelle. Dunod.
12- Jouve، V.، 1997. La poétique du roman. Sedes : Coll.»Campus Lettres».
13- Lecarme، J. et Vercier، B. (sous la direction de)، 1988. Maupassant، miroir de la nouvelle
(Colloque de Cerisy). PUV.
14- Louvel، L. et Verley، C.، 1993. Introduction à l’étude de la nouvelle. PUM.
– [1]طالب دكتوراه في اللغة العربية وآدابها- جامعة الجنان- قسم اللغة العربيّة- Rafidsalem@mtu.edu.iq
[2]– مجموعة الأعمال المختارة لأنطون تشيكوف، دار الشروق، الطبعة الأولى 2009.
[3] -تكاد تنفرد مجلّة فصول في عددها الخاص بالقصة القصيرة والصادر سنة 1982 المجلّد الثاني العدد الرابع بكونها من بواكير التنظيرات الجديّة للأقصوصة
[4] – الخصائص البنائيّة للأقصوصة : صبري الحافظ ، مجلة فصول المجلّد الثاني العدد الرابع 1982.
[5] -ثمّة من يعدُّ المقامة لبديع الزمان الهمذاني في القرن العاشر ميلادي البدايات الحقيقية لنشأة فنّ الأقصوصة .
[6]– الصادق قيسومه : طرائق تحليل القصّة . دار الجنوب للنشر بتونس سلســـــــــلة مفاتيح 2000
[7]– نفس المصدر .
[8] -من أقصوصة “الأرض المستحيلة ” لإيميلي نصر الله مجلّة العربي جوان 2000 العدد 499 ص 112/114
[9] – نفس المصدر : ص 112/114
[10] – ضمن حوار مع يوسف إدريس بمجلة فصول المجلّد 2 العدد 4 سبتمبر 1982 و من بين ما قاله أيضا : “لقد اخترع بيكاسو ذات مرّة طريقة لرسم لوحة فوسفوريّة تختفي بعد دقيقة ، هذه الدقيقة هي القصة القصيرة ، هي اقتناصي لحظة كشف خارقة .”
[11] -“من حكايات هذا الزّمان” لعز الدّين المدني دار الجنوب للنــــــــــــشر بتونس 1982 ص 27-29
[12] – ” في الوظيفة” لعبد الحميد جوده السّحار . مكتبة مصر 1977 ص 70-76
-[13] “أكابر” لميخائيل نعيمه . دار صادر بيروت – دون تاريخ ص 78-81
[14] -“الأرض المستحيلة ” لإيميلي نصر الله مجلّة العربي جوان 2000 العدد 499 ص 112/114
-[15] ” في الوظيفة” لعبد الحميد جوده السّحار . مكتبة مصر 1977 ص 70-76
[16] -“أكابر” لميخائيل نعيمه . دار صادر بيروت – دون تاريخ ص 78-81
[17]– الخصائص البنائيّة للأقصوصة : صبري الحافظ ، مجلة فصول المجلّد الثاني العدد الرابع 1982
[18] – “الأرض المستحيلة ” لإيميلي نصر الله مجلّة العربي جوان 2000 العدد 499 ص 112/114 .
ملاحظة : لقد قمنا بإعادة توزيع الفقرة على نحو مخصوص لنرصد مستويات الشعرية الكامنة في المقطع .
[19] -ماري لويز برات: القصة القصيرة: الطول والقصر، ترجمة محمود عياد، مجلة فصول العدد الثاني المجلد الرابع سبتمبر 1982
[20]– للتذكير فقط توجد اليوم مؤسسة كنديّة في مون ريال تعني بالأدب التغريدي المُقارن institut de twitterature comparée