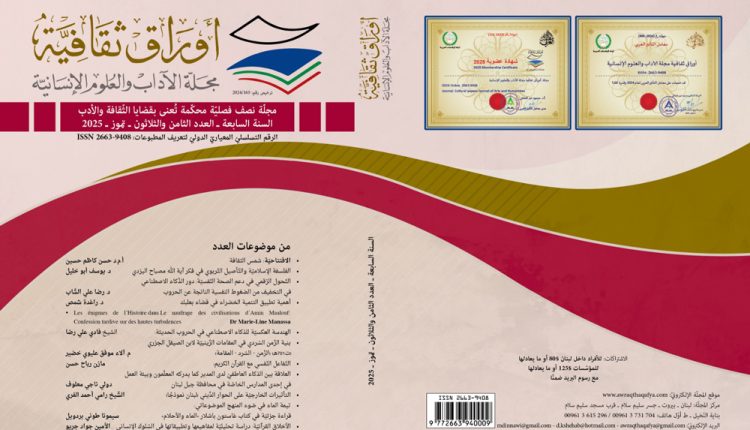العلاقة بين الذكاء العاطفيّ لدى المدير كما يدركه المعلّمون وبيئة العمل في إحدى المدارس الخاصّة في محافظة جبل لبنان
عنوان البحث: العلاقة بين الذكاء العاطفيّ لدى المدير كما يدركه المعلّمون وبيئة العمل في إحدى المدارس الخاصّة في محافظة جبل لبنان
اسم الكاتب: دولي ناجي معلوف
تاريخ النشر: 2025/07/16
اسم المجلة: مجلة أوراق ثقافية
عدد المجلة: 38
تحميل البحث بصيغة PDFADOI: https://aif-doi.org/awraq/013801
العلاقة بين الذكاء العاطفيّ لدى المدير كما يدركه المعلّمون وبيئة العمل في إحدى المدارس الخاصّة في محافظة جبل لبنان
The Relationship Between the Principal’s Emotional Intelligence as Perceived by Teachers and the Work Environment in a Private School in Mount Lebanon Governorate
مقال أعدّ استكمالًا لنيل شهادة الماستر البحثيّ في اختصاص الإدارة التربويّة
Dolly Najy Maalouf دولي ناجي معلوف([1])
تاريخ الإرسال:15-6-2025 تاريخ القبول:27-6-2025
الملخّص
هدفت هذه الدّراسة الى معرفة العلاقة بين الذكاء العاطفيّ كما يدركه المعلّمون وبيئة العمل المدرسيّ. تناولت الدّراسة بُعدين للذكاء العاطفيّ “التنظيم الذاتيّ والوعيّ الاجتماعيّ” من أصل 4 أبعاد بحسب نموذج دايفيد جولمان للذكاء العاطفيّ. أجريت الدّراسة في إحدى المدارس الخاصّة في جبل لبنان على عيّنة من المعلّمين والمعلّمات في أقسام المدرسة جميعها بلغت 62 فردًا. وُزِّعت استمارة مكوّنة من ثلاثة محاور على المعلّمين لجمع المعلومات حول إدراكهم للوعي الاجتماعيّ والتنظيم الذاتيّ لدى المدير كما لبيئة العمل في المدرسة. استخدمت الباحثة المتوسّطات الحسابيّة، الانحرافات المعياريّة، اختبار بيرسون للارتباط والتّحليل الانحداريّ المتعدّد للإجابة عن أسئلة الدّراسة. أظهرت النتائج أنّ المعلّمين يوافقون على المؤشّرات جميعها الواردة في الاستمارة إذ إنّ المؤشّرات الثلاثة عدم تسرّع المدير في الّتعامل مع الأزمات، معاملة المدير للجميع باحترام مهما اختلفت الآراء وتعبير المعلّم عن رأيه من دون الخوف من الرّفض قد حظيت بأعلى درجة موافقة حولها. كما تبيّن وجود علاقة ارتباطيّة موجبة وقويّة بين الوعي الاجتماعيّ وبيئة العمل أكبر من العلاقة الارتباطيّة الموجبة والقويّة أيضًا بين التنظيم الذاتيّ وبيئة العمل، وظهر أيضًا من خلال نموذج الانحدار المتعدّد أنّ بًعدي الذكاء العاطفيّ المذكورين يفسّران ما نسبته 72.7% من التباين في بيئة العمل.
الكلمات المفتاحيّة: الذكاء العاطفيّ، التنظيم الذاتيّ، الوعي الاجتماعيّ، المدير، المعلّمون، بيئة العمل.
Abstract
This study aimed to examine the relationship between emotional intelligence, as perceived by teachers, and the school work environment. The study focused on 2 dimensions of emotional intelligence (Self-Management and Social Awareness) based on Daniel Goleman’s four-dimensional model of emotional intelligence. The research was conducted in a private school in Mount Lebanon, with a sample of 62 teachers from all school departments. A questionnaire consisting of three sections was distributed to collect information about teachers’ perceptions of the principal’s self-management and social awareness, as well as their views on the school work environment. The researcher used means, standard deviations, Pearson correlation, and multiple regression analysis to answer the study’s questions. The results showed that teachers agreed with all the indicators presented in the questionnaire. Among the most highly agreed-upon items were the principal’s patience during crises, their respectful way of treating all individuals regardless of differences in opinion, and teachers’ ability to express their views without fear of rejection. Furthermore, the findings revealed a strong positive correlation between social awareness and the work environment, stronger than the also positive significant correlation between self-management and the work environment. Multiple regression analysis showed that these two emotional intelligence dimensions explained 72.7% of the variance in the school work environment.
Keywords: The emotional intelligence, the self-management, the social awareness, the principal, the teacher, the work environment.
مقدّمة
لطالما عدَّ لمدّة طويلة أنّ القدرات الذّهنيّة المتقدّمة كالتحليل، التفكير المنطقيّ وحلّ المشكلات أسسًا للتفوّق الدراسيّ وللنجاح لاحقًا في الحياة المهنيّة. لكنّ هذه الفكرة بدأت تضمحلّ مع الوقت، فلم يعد الذكاء العقليّ المؤشّر الوحيد للنجاح في ميدان العمل خصوصًا مع تطوّر علم النّفس وعلم الاجتماع. وهكذا أصبح الاعتماد على الذكاء العقليّ فقط مخلّ لفهم الإنسان ولفهم القدرات البشريّة، فتوسّع مفهوم الذكاء كي يشمل مجموعة من المهارات الاجتماعيّة والنفسيّة عرفت لاحقًا بالذكاء العاطفيّ Emotional Intelligence. يذكر جولمان في كتابه عن الذكاء العاطفيّ أنّ العديد من الأفراد من ذوي معدّلات الذكاء العقليّ المرتفعة تتعثّر في حياتها المهنيّة في حين يحقّق آخرون ممّن لديم معدّل ذكاء عقليّ متوسّط نجاحات مبهرة وأداءً مدهشًا(Goleman, 2009) .
يتعيّن على القائد التربويّ المتميّز أن يجمع بين المعرفة والمهارة العاطفيّة، كما يتأثّر سلوكه بعوامل ماديّة ترتبط بطبيعة بيئة العمل وبأخرى معنويّة تحكمها التّفاعلات بين الأفراد، وتتقاطع هذه العوامل كي توجّه القائد التربويّ وممارساته فيستطيع حينئذ التحكّم بواسطتها بنفسه والتأثير على من حوله، وهكذا يرتبط الجانب الوجدانيّ لديه بقدراته العقليّة (سكر، 2018). لذا يجدر الانتباه الى التمييز بين المدير والمدير القائد، فالمدير عادة ينفّذ قوانين موضوعة وأنظمة من أجل حسن تسيير العمل في المدرسة، أمّا المدير القائد فهو من يضع الأنظمة ويوظّف قدراته ويوجّه انفعالاته من أجل التأثير في الفرق ومساعدتها على النموّ لكي يصنع من أفرادها قادة بدورهم (الهلالي، 2022). تعدّ العاطفة مكوّنًا أساسيًا في الشخصيّة مؤثّرًا في المشاعر، الانفعالات، الحاجات، الميول والاهتمامات. لذا يجدر الاهتمام بتنمية مهارات الذكاء العاطفيّ لمدير المدرسة من خلال برامج تدريبيّة تركّز على كون الذكاء العاطفيّ عاملًا وسيطًا في العلاقات الإنسانيّة التي ينسجها المدير مع فريق العمل. وهكذا يتمكّن المدير من فهم نفسه، التعرّف على انفعالاته، التعبير عنها بالشكل المناسب وفهم الآخرين ما يؤدّي الى نجاحه بدوره (محمود وآخرون، 2022).
إذًا الذكاء العاطفيّ عند المدير هو قدرته على فهم مشاعره ومشاعر المعلّمين، استخدام المشاعر بفعاليّة في التّفاعلات اليوميّة في المدرسة، بناء علاقات مهنيّة سليمة مع زملاء العمل، حلّ النّزاعات داخل المدرسة والتّعامل مع التحدّيات بحسب ما تقتضيه الحاجة. وقد أظهرت الأبحاث أنّ المدير الذي يمتلك مهارات الذّكاء العاطفيّ هو قادر على تحقيق النجاح والتقدّم في حياته المهنيّة وعلى عيش حياة شخصيّة متوازنة وسعيدة (عويس & حوامدة، 2024).
طوّر جولمان نموذجًا خماسيّ الأبعاد للذكاء العاطفيّ العام 1998 ثم أعاد تصميمه العام 2002 وضمّنه فقط أربعة أبعاد هي على الشكل الآتي(Goleman, 2003) :
- الوعي الذاتيّ
- التنظيم الذاتيّ
- الوعي الاجتماعيّ
- تنظيم العلاقات
يذكر أنّ البعدين الأوّل والثاني يتعلّقان بالذات، أمّا البعدان الثالث والرابع يعودان للآخر.
جدول 1: أبعاد الذكاء العاطفيّ ومؤشّراتها
|
الذات |
الوعي |
الآخر |
|
| 1- الوعي الذاتيّ
الوعي الذاتيّ العاطفيّ التقييم الذاتيّ الدقيق الثقة بالنفس |
3-الوعي الاجتماعيّ
التعاطف الوعي التنظيميّ الخدمة |
||
| 2- التنظيم الذاتيّ
ضبط النفس العاطفيّ الشفافيّة القدرة على التكيّف الإنجاز المبادرة |
4-تنظيم العلاقات
التأثير القيادة الملهمة محفّز التغيير بناء الروابط إدارة الصراع التعاون |
||
| التنظيم | |||
الوعي الذاتيّ: يشكّل هذا البعد الأساس الذي تبنى عليه الأبعاد الأخرى. هو قدرة الفرد على التعرّف إلى مشاعره ودوافعه وفهمها، كما التعرّف إلى تأثير المشاعر على سلوكه. يتميّز القادة الفاعلون بدرجة عالية من الوعي الذاتيّ تمكّنهم من الحفاظ على استقرارهم الانفعاليّ وبناء علاقات صحيّة وصادقة، ومن دون هذا الوعي يصعب على مدير المدرسة أن يدرك كيف تؤثّر انفعالاته على بيئة العمل وأن يتقبّل وجهات النظر المختلفة Mayer et al., 2024)). التنظيم الذاتيّ: يتمثّل بقدرة الفرد على التحكّم في مشاعره السلبيّة كما إدارة الضغوط والتّعامل معها من خلال توجيه السلوك بإيجابيّة على الرّغم من التحدّيات، فهو لا يتنكّر لمشاعره بل يديرها بوعي واتّزان. يتفاعل هذا البعد مع أبعاد الذكاء العاطفيّ الأخرى من أجل إخراج سلوكيّات تتوافق مع بيئة العمل، ويتميّز المدير الذي يتقن هذا البعد بالقدرة على كبح ردود الفعل المتسرّعة، نشر ثقافة الاحترام، تعزيز الانضباط الذاتيّ والتواصل الإيجابيّ بين المعلّمين (Bar-On, 2006). الوعي الاجتماعيّ: يتضمّن هذا البعد قدرة الفرد على فهم مشاعر الآخرين، التّعاطف معهم، تقدير وجهات نظرهم والوعي بالديناميّات الجماعيّة. يتعيّن على المدير الذي يتميّز بهذا البعد أن يفهم الاحتياجات المهنيّة للمعلّمين، أن يقرأ أفكارهم ومشاعرهم وأن يدرك حالتهم النفسيّة من دون أن يعبّروا عنها، وبهذا يصبح قادرًا على حلّ النزاعات وتعزيز التّعاون بين أعضاء فريق العمل. وقد تبيّن أنّ المدير المتمتّع بوعي اجتماعيّ مرتفع يحقّق في بيئة العمل مستوى عالٍ من الرضا الوظيفيّ عند المعلّمين ومناخًا مرحّبًا بالتّفاهم وقائمًا على التواصل والاحترام بين المدير والهيئة التعليميّة (Cherniss et al., 1998). تنظيم العلاقات: يكون ذلك من خلال الوعي الذاتيّ والاجتماعيّ كما التنظيم الذاتيّ ويتجلّى بالقدرة على إدارة العلاقات الاجتماعيّة بين الأفراد. في البيئة المدرسيّة، يجب على المدير أن يتواصل بفعاليّة وأن يعزّز ثقافة قائمة على الثقة والاحترام المتبادل، فهو قادر على النَّجاح في تحفيز المعلّمين وتسهيل العمل الجماعيّ في حال كان يتمتّع بكفاءة في إدارة العلاقات الاجتماعيّة في المدرسة (Goleman et al., 2013).
إذًا بمجرّد أن يدرك المدير أولويّاته والاتجاه الذي يجب أن يسلكه يمكن لمهارته في إدارة العلاقات أن تساعده في توجيه المجموعة طبعًا في ظلّ إدراكه لمشاعره ومشاعر الأفراد، ما يعيدنا للتنظيم الذاتيّ لديه ولوعيه الاجتماعيّ اللذين ستتناولهما الباحثة حصرًا من خلال دراسة علاقتهما ببيئة العمل المدرسيّة.
ومن جهة أخرى، يقصد ببيئة المدرسة المناخ الذي يمارس المعلّمون فيه مهامهم والذي يراعي فيه المدير البعدين الإنسانيّ والمهنيّ في تعامله مع الكوادر. تتكوّن بيئة العمل في المدرسة من عناصر عدّة كالعلاقات المهنيّة، التواصل، الفرص المهنيّة، الاستقرار، الموارد، الإمكانات المتاحة، الدّعم النفسيّ… ترتبط بيئة العمل الجيّدة بقدرة المدرسة على الاحتفاظ بالمعلّمين، تعزيز التّعاون والتّطوير المهنيّ وتحقيق النتائج إذ إنّ المعلّم الذي يشعر بالدعم يكون أكثر استعدادًا للإبداع والابتكار (Cohen et al., 2009). وهنا يبرز دور المدير الذي يعدّ رأس الهرم في السعي للوصول لبيئة محفّزة ومنتجة، فكلّما كانت مساعيه متجّهة صوب صقل المهارات وتشجيع الإبداع والتّواصل بانفتاح ودعم المبادرات وتعزيز التعاون بين الأفراد، تزداد عندئذ الفرص لتحويل بيئة العمل في المدرسة الى بيئة آمنة للمعلّم للتعبير فيها عن رأيه والاستمرار بتقديم صور الإبداع كافّة.
تتكوّن بيئة العمل المدرسيّ من عدة أبعاد: (Collie et al., 2012)
- البعد الإداريّ المتمثّل بالأدوار، التّوجيه والدعم الإداريّ.
- البعد الاجتماعيّ المتعلّق بالعلاقات الإنسانيّة، التّعاون بين الزملاء، الثقة والاحترام.
- البعد المهنيّ الذي يشمل النموّ المهنيّ والتعبير عن الرأي.
يمكن عدُّ الوصول الى بيئة العمل المثاليّة يتطلّب التكامل بين الأبعاد الثلاثة من خلال تطبيق نموذجيّ للتعاون، التوجيه، الدّعم، النموّ المهنيّ على سبيل المثال لا الحصر مع ضرورة وجود إدارة عليا ذكيّة تجيد ممارسة فنّ الإدارة والقيادة بحكمة من خلال الموازنة بين العقل والقلب.
ورد في دراسة ماتلي (2025) أنّ ضعف التواصل الإداريّ الفعّال وعدم دعم الإدارة للمبادرات ترك انطباعات سلبيّة في المبحوثين حول البعد الإداريّ لبيئة العمل، على عكس البعد الاجتماعيّ الذي اتّفق المبحوثون حول جودته وإيجابيّته بسبب روح الفريق الموجودة والعلاقات الوديّة في العمل.
كما يعدُّ Mayer & Salovey (1997) أنّ المدير المتمتّع بالتنظيم الذاتيّ يكون أكثر قدرة على التعامل مع الضغوط والصراعات بعقلانيّة؛ فيصبح الجوّ العام داخل المؤسّسة أكثر استقرارًا ما يسهم في تخفيف التوتّر بين المعلّمين ويشعرهم بمناخ داعم وآمن نفسيَّا. كما ورد في كتاب Hoy & Miskel (2013) أنّ المدير القادر على إدراك مشاعر الآخرين وفهم احتياجاتهم يكون أكثر تعاطفًا ودعمًا، ما يعزّز بيئة مدرسيّة عالية الجودة قائمة على الثقة والمشاركة والاحترام.
مشكلة الدّراسة: من خلال الملاحظات والمحادثات مع المعلّمين اشتكى العديد منهم من أنّ بيئة العمل تعاني من التوتّر والتراجع في الدّافعيّة للاستمرار في مزاولة المهنة، وأنّ الإدارة المدرسيّة تفتقر أحيانًا الى التّفاعل الإيجابيّ والتّعاطف معهم في ظلّ التحدّيات التي يمرّ بها قطاع التعليم في الآونة الأخيرة من نقص موارد، ضغوط عمل، زيادة متطلّبات… فأصبح عندئذ الحفاظ على جودة بيئة العمل المدرسيّ عنصرًا مهمًّا في الحفاظ على الكوادر من أجل ضمان استمراريّة العمل في المؤسّسات التربويّة، وهنا برزت الحاجة لمعرفة دور الذكاء العاطفيّ لدى المدير القادر من خلال فهمه لمشاعر الآخرين ومن خلال تفاعلاته وتحكّمه بانفعالاته لربما خلق مناخًا مهنيًّا أفضل. وانطلاقًا ممّا سبق، قامت الباحثة بدراسة لمعرفة مدى إمكانيّة وجود علاقة ارتباطيّة بين الذكاء العاطفيّ ببعديه المختارين وبيئة العمل في المدرسة.
أسئلة الدّراسة
تتحدّد مشكلة الدّراسة بالإجابة على الأسئلة الآتية:
- ما هو واقع الذّكاء العاطفيّ لدى المدير ببعديه التنظيم الذاتيّ والوعي الاجتماعيّ في إحدى المدارس الخاصّة في محافظة جبل لبنان من وجهة نظر المعلّمين؟
- ما هو واقع بيئة العمل في إحدى المدارس الخاصّة في محافظة جبل لبنان من وجهة نظر المعلّمين؟
- هل توجد علاقة ارتباطيّة دالّة إحصائيًّا بين التنظيم الذاتيّ لدى مدير المدرسة كما يدركه المعلّمون وبيئة العمل المدرسيّ في إحدى المدارس الخاصّة في محافظة جبل لبنان؟
- هل توجد علاقة ارتباطيّة دالّة إحصائيًّا بين الوعي الاجتماعيّ لدى مدير المدرسة كما يدركه المعلّمون وبيئة العمل المدرسيّ في إحدى المدارس الخاصّة في محافظة جبل لبنان؟
أهميّة الدّراسة: من الناحية النظريّة، تتمثّل أهميّة الدّراسة في كونها تسلّط الضوء على بعدين أساسيّين من أبعاد الذكاء العاطفيّ لدى المدير وعلاقتهما بجودة البيئة المدرسيّة، كما تعزّز الأدب التربويّ المتعلّق بموضوع البحث. أمّا على الصعيد العمليّ، فهي تمكّن المهتمّين بالشأن التربويّ من فهم أهميّة الذكاء العاطفيّ، ضرورة العمل على تأهيل مهارات المدير كما خلق بيئة عمل أفضل من خلال دراسة نقاط القوّة والضعف في أسلوب عمل المدير وتحليل الأثر، ممّا ينعكس إيجابًا على سير عمل المدرسة.
محدّدات الدّراسة: تشكّل محدّدات الدّراسة الأطر التي التزمت بها الباحثة وهي على الشكل الآتي:
- الأطر المكانيّة: أجريت الدّراسة في مدرسة خاصّة في محافظة جبل لبنان.
- الأطر الزمنيّة: نُفِّذت الدّراسة خلال الفصل الثاني من العام الدراسيّ 2024-2025.
- الأطر الموضوعيّة: تقتصر الدّراسة على التحقّق من واقع الذكاء العاطفيّ لدى المدير ومن وجود علاقة ارتباطيّة بين بعدين من أبعاد الذكاء العاطفيّ لدى المدير وبيئة العمل المدرسيّ.
- الأطر البشريّة: شارك في الدّراسة عيّنة من معلّمي المدرسة المشاركة في الدّراسة.
مصطلحات الدّراسة: الذكاء العاطفيّ The Emotional Intelligence: عرّفه Goleman (2009) أنّه القدرة على فهم المشاعر الذاتيّة ومشاعر الآخرين، تنظيم الانفعالات كما إدارة وتنظيم العلاقات مع الأفراد. أمّا إجرائيًّا فهو الدرجة التي سيحصل عليها المدير من وجهة نظر المعلّمين في مجالي التنظيم الذاتيّ والوعي الاجتماعيّ.
بيئة العمل المدرسيّ The School Work Environment: هي مجموعة العوامل الاجتماعيّة والفيزيائيّة التي تجري فيها العمليّة التعليميّة والتي تكسب المدرسة صورة تميّزها من غيرها من المدارس (حبايب & الخليلي، 2008). المعنى الإجرائيّ للعبارة فهو ما يحيط بالمعلّم من شروط نفسيّة اجتماعيّة وتعليميّة في المدرسة.
المدرسة الخاصّةThe Private School : المدرسة هي منشأة تقوم بصفة التعليم الأكاديميّ أو المهنيّ ما قبل الجامعيّ وفاق خطط ومناهج مقرّرة من وزارة التعليم (النجار، 2024). أمّا إجرائيّا فالمدرسة الخاصّة هي مدرسة غير حكوميّة مستقلّة في شؤونها الإداريّة والماليّة.
المعلّم The Teacher: هو الشّخص المؤهّل علميًّا وتربويًّا القيام بمهمّة التدريس وبناء شخصيّة التلميذ على أسس سليمة لكي يكون فردًا صالحًا في الحياة ومنتجًا في المجتمع (مهاني، 2010). يعرّف إجرائيًّا بالشخص الميسّر لعمليّة التعلّم في المدرسة والمسؤول بالشراكة مع المدير عن تحقيق رؤية ورسالة المدرسة.
مدير المدرسةThe School Principal : هو المسؤول عن مجموعة العمليّات الوظيفيّة التي تتفاعل ضمن مناخ مناسب، داخل المدرسة وخارجها وفاقًا لسياسة عامّة وفلسفة تربويّة تتّفق مع أهداف محدّدة (النصيرات، 2024). تعرّفه الباحثة إجرائيًا بأنّه الشّخص المخوّل تسيير وإدارة أعمال المدرسة الخاصّة ذات الاستقلال الإداريّ والمادّيّ من خلال توظيف مكتسباته المعرفيّة التي حصّلها نتيجة الخبرة المهنيّة، التدريب الذي خضع له والتحصيل العلميّ.
منهجيّة الدّراسة
منهج الدّراسة: المنهج المعتمد هو المنهج الوصفيّ التحليليّ الذي يستخدمه الباحثون بكثرة في البحوث التربويّة، وبناءً عليه قامت الباحثة بوصف الذكاء الانفعاليّ لدى المدير وبيئة العمل المدرسيّ؛ ثمّ تحليل العلاقة إن وجدت بين المتغيّرين من خلال القيام بمجموعة إجراءات تعتمد على جمع بيانات من المعلّمين صُنِّفت هذه البيانات، معالجتها كميًّا وتحليلها من أجل الوصول الى نتائج واستنتاجات ومقترحات.
خصائص عيّنة الدّراسة: تشكّل الهيئة التعليميّة في جميع أقسام المدرسة المشاركة في الدّراسة مجتمع الدّراسة وعيّنتها على حدّ سواء ويبلغ عدد المعلّمين في المدرسة 74 فردًا شارك منهم 62 في الدّراسة. تظهر الرسوم البيانيّة أدناه التردّدات العائدة لبيانات المعلّمين الشخصيّة الخاصّة بالجنس، المؤهّل العلميّ والعمر.
رسم بياني 1: التردّدات العائدة للبيانات الشخصيّة لعيّنة المعلّمين (الجنس)
رسم بياني 2: التردّدات العائدة للبيانات الشخصيّة لعيّنة المعلّمين (المؤهّل العلميّ)
رسم بياني 3: التردّدات العائدة للبيانات الِشخصيّة لعيّنة المعلّمين (العمر)
متغيّرات الدّراسة: المتغيّر المستقلّ يتمثّل بالذكاء الاجتماعيّ ببعديه التنظيم الذاتيّ والوعي الاجتماعيّ المدركين من قبل المعلّمين، أمّا المتغيّر التابع فهو بيئة العمل المدرسيّ.
أداة الدّراسة: وُزِّعت الاستمارة أداة الدّراسة الوحيدة على الهيئة التعليميّة في المدرسة، وقد استُرِدت 62 استمارة من أصل 74 أي ما نسبته 83.78%، كما قامت الباحثة بالتوقّف عن استقبال الإجابات الكترونيًّا بعد إعطاء مهلة كافية لتعبئتها من الهيئة التعليميّة.
تتألّف الاستمارة الموجّهة الى المعلّمين من قسم مخصّص لجمع معلومات ديموغرافيّة خاصّة بالمعلّمين تتعلّق بالجنس، العمر والمؤهّل العلميّ وتتألّف أيضًا من 3 مجالات أتت على الشكل الآتي:
- المجال الأوّل: يضمّ 6 مؤشّرات عائدة لبعد الذكاء الانفعاليّ “التنظيم الذاتيّ” لدى المدير.
- المجال الثاني: يتضمّن هذا المجال 6 مؤشّرات عائدة لبعد آخر للذكاء الانفعاليّ وهو “الوعي الاجتماعيّ” لدى المدير.
- المجال الثالث: يتألّف من 7 مؤشّرات خاصّة ببيئة العمل المدرسيّ.
استخدمت الباحثة مقياس ليكرت Likert Scale 5 Point والمؤلّف من 5 اختيارات تبيّن درجة موافقة المعلّم على المؤشّر المطروح، وهي كالآتي:
جدول 2: مدى ورمز درجة الموافقة
| درجة الموافقة | الرمز | المدى العائد لدرجة الموافقة |
| لا أوافق بشدّة – I strongly disagree | 1 | ]1-1.8] |
| لا أوافق – I disagree | 2 | ]1.8-2.6] |
| محايد – Neutral | 3 | ]2.6-3.4] |
| أوافق – I agree | 4 | ]3.4-4.2] |
| أوافق بشدّة – I strongly agree | 5 | ]4.2-5[ |
صدق الأداة: كان التأكّد من صدق الاستمارة لجهة قدرتها على قياس ما وضع للقياس في الدّراسة بالاعتماد على نموذج Daniel Goleman للأبعاد الأربعة للذكاء العاطفيّ ((Ott, n.d.. وقد قامت الباحثة بإجراء بعض التعديلات واستبدلت مفردات معيّنة في الاستمارة في المجال الأوّل (المؤشّر الخامس) والمجال الثاني (المؤشّران الثالث والرابع) بمفردات أخرى أكثر دقّة في التعبير عمّا تقصده بالتحديد وذلك بعد إجراء الدّراسة الاستطلاعيّة وعرض الأداة على أحد الخبراء في المجال التربويّ.
ثبات الأداة: اعتمدت الباحثة طريقة احتساب معادة كرونباخ ألفا لقياس ثبات الاستمارة بالاعتماد على الدّراسة الاستطلاعيّة التي أجريت على 10 أفراد، فطُبِّقت الاستمارة مرّة واحدة ومن ثمّ قياس الاتساق الداخليّ للمؤشّرات مع بعضها البعض ومع كلّ المؤشّرات بصفة عامّة من خلال اعتماد احتساب برنامج SPSS لمعادلة كرونباخ ألفا:
جدول 3: قيم معامل كرونباخ ألفا
| المجال | عدد المؤشّرات | قيمة معادلة كرونباخ الفا | درجة الثبات |
| 1- التنظيم الذاتيّ | 6 | 0.903 | ممتازة |
| 2- الوعي الاجتماعيّ | 6 | 0.915 | ممتازة |
| 3- بيئة العمل المدرسيّ | 7 | 0.843 | جيّدة |
| كافّة المجالات | 19 | 0.953 | ممتازة |
بناءً على فحص الاتّساق الداخليّ للاستمارة المتضمّنة 19 مؤشّرًا حول الذكاء الانفعاليّ لدى المدير وبيئة العمل المدرسيّ ، حصلت الباحثة على قيمة كرونباخ ألفا البالغة 0.953 والدّالة على أنّ درجة الثبات الكليّ للاستمارة هي ممتازة (Berenson et al., 2015).
عرض ومناقشة النتائج
تحليل ومناقشة النتائج للإجابة عن السؤال الأوّل: ما هو واقع الذكاء العاطفيّ لدى المدير ببعديه التنظيم الذاتيّ والوعي الاجتماعيّ من وجهة نظر المعلّمين في إحدى المدارس الخاصّة في محافظة جبل لبنان؟
قامت الباحثة باحتساب المتوسّط الحسابيّ والانحراف المعياريّ كما يظهر في الجدول 4 والجدول 5، وبناءً على النتائج تمّ تحديد موقف المعلّمين من المؤشّرات الستّة العائدة للتنظيم الذاتيّ لدى المدير ومن 6 مؤشّرات أخرى تعود للوعي الاجتماعيّ لديه.
جدول 4: المتوسط الحسابيّ، الانحراف المعياريّ وموقف المعلّمين (ع=62) من مؤشّرات (ع=6) التنظيم الذاتيّ لدى المدير
| مؤشّرات التنظيم الذاتيّ | المتوسّط الحسابيّ | الانحراف المعياريّ | موقف المعلّمين | |
| المدير يحافظ على هدوئه في المواقف الصعبة | 3.90 | 0.740 | موافقة | |
| المدير يتحكّم بانفعالاته | 3.79 | 0.771 | موافقة | |
| المدير يتعامل مع الأزمات دون تسرّع | 4.00 | 0.810 | موافقة | |
| المدير يظهر توازنًا عند اتخاذ القرارات | 3.94 | 0.787 | موافقة | |
| المدير لا يسمح لعواطفه بالتأثير على سلوكه المهنيّ | 3.74 | 0.828 | موافقة | |
| المدير قادر على كبت مشاعره السلبيّة في العمل | 3.65 | 0.812 | موافقة | |
| الدرجة الكلّية لهذه المجموعة | 3.8360 | 0.65945 | موافقة |
تتراوح متوسّطات المؤشّرات الحسابيّة بين 3.65 و4.00 من أصل 5.00، وهي تقع ضمن المدى العائد لدرجة “موافقة” التي تعكس موقف المعلّمين من المؤشّرات الستة العائدة للتنظيم الذاتيّ لدى المدير. تشير هذه النتائج الى أنّ المعلّمين يعدُّون أن المدير يتمتّع نسبيًّا بدرجة مرتفعة من التنظيم الذاتيّ في سلوكه ومعاملاته المهنيّة، بحيث أنّ أعلى متوسّط حسابيّ يعود لمؤشّر التعامل مع الأزمات من دون تسرّع ما يدلّ على أنّ المدير يتعامل بعقلانيّة مع ضغوط العمل من دون اندفاع. في المقابل فإنّ أدنى متوسّط حسابيّ يعود لمؤشّر القدرة على كبت المشاعر السلبيّة في العمل، وعلى الرّغم من ذلك ما زالت قيمة المتوسّط الحسابيّ بحسب رأي المعلّمين تعكس إيجابيّة معيّنة إذ لا تزال ضمن فئة الموافقة، ولكن يمكن عدُّ أنّ الحاجة لتحسين إدارة المشاعر السلبيّة لدى المدير تبقى ضروريّة من أجل زيادة قدرته على التحكّم بانفعالاته إذ إنّ عدم ضبط المشاعر السلبيّة يمكن أن يؤثّر بمناخ العمل بشكل عامّ. يذكر أيضًا أنّ الانحراف المعياريّ يتراوح بين 0.740 و0.828 ما يدلّ على وجود تباين معتدل في آراء المعلّمين حول بعد التنظيم الذاتيّ.
أمّا المتوسّط الكليّ لبعد التنظيم الذاتيّ البالغ 3.8360 فهو يظهر عامّة أنّ المدير يمتلك مستوى جيّدًا من التنظيم الذاتيّ متمثّلًا بنضج انفعاليّ وقدرة على التفكير العقلانيّ ما يشكّل ركيزة أساسيّة للذكاء العاطفيّ تخلق بيئة مهنيّة مستقرّة، تعزّز التواصل وتحدّ من النزاعات بين أفراد فريق العمل. وقد أشار Goleman (2003) الى أنّ التنظيم الذاتيّ هو أساسيّ لأنّه يرتبط مباشرة بأداء المدير وفعاليّته.
جدول 5: المتوسط الحسابيّ، الانحراف المعياريّ وموقف المعلّمين (ع=62) من مؤشّرات (ع=6) الوعي الاجتماعيّ لدى المدير
| مؤشّرات الوعي الاجتماعيّ | المتوسّط الحسابيّ | الانحراف المعياريّ | موقف المعلّمين | |
| المدير يظهر تفهّمًا لمشاعر المعلّمين | 3.94 | 0.827 | موافقة | |
| المدير يتفاعل بتعاطف مع ضغوط المعلّمين | 3.68 | 0.825 | موافقة | |
| المدير يراعي مشاعر الآخرين عند اتّخاذ قرارات تخصّهم | 3.85 | 0.881 | موافقة | |
| المدير يدرك الأثر النفسيّ لأسلوب تواصله اللفظيّ مع المعلّمين | 3.81 | 1.128 | موافقة | |
| المدير يعامل الجميع باحترام مهما اختلفت آراؤهم | 4.13 | 0.966 | موافقة | |
| المدير يراعي الخلفيّات الثقافيّة المختلفة للمعلّمين | 4.03 | 0.829 | موافقة | |
| الدرجة الكلّية لهذه المجموعة | 3.9059 | 0.78210 | موافقة |
يظهر الجدول أنّ المتوسّط الحسابيّ الأعلى البالغ 4.13 من 5.00 يعود لمؤشّر معاملة المدير للجميع باحترام مهما اختلفت آراؤهم، وهذا دليل على كون المدير يحترم التنوّع الفكريّ ضمن فريق العمل ما يساهم في خلق بيئة عمل إيجابيّة قائمة على الثقة المتبادلة. وهذه النتيجة تتوافق أيضًا مع القيمة المرتفعة للمتوسّط الحسابيّ لمؤشّر مراعاة الخلفيّات الثقافيّة المختلفة والبالغة 4.03 من 5.00 ما يعكس إلمامًا لدى المدير بالتنوّع الديموغرافيّ داخل فريق العمل ويساهم في تعزيز مفعوم العدالة في التعامل معهم. في المقابل حظي مؤشّر تفاعل المدير بتعاطف مع ضغوط المعلّمين بأدنى درجة موافقة نسبة للمؤشّرات الأخرى ما يظهر أنّ بعضهم قد لا يشعر بالدّعم الكافي من المدير وأنّه يتوجّب عليه تطوير مهارات الإصغاء والتعاطف لديه. من اللافت أنّ الانحراف المعياريّ 1.128 هو الأعلى لمؤشّر إدراك المدير للأثر النفسيّ لأسلوب تواصله اللفظيّ مع المعلّمين على الرّغم من أنّ المتوسّط الحسابيّ ليس متدنيًّا ما يدلّ على وجود تباين في آراء المعلّمين لربّما يعود لعدم اتّساق سلوك المدير في التواصل مع المعلّمين.
بلغ المتوسّط الكلّي لمجموع مؤشّرات الوعي الاجتماعيّ 3.9059، ما يشير الى أنّ المدير يمتلك هذا البعد للذكاء العاطفيّ. مع ذلك تشير المتوسّطات الحسابيّة لبعض المؤشّرات لوجود حاجة لتحسين التعاطف ودعم المعلّمين ما يشكّل فرصة أكبر لتطوير الذكاء العاطفيّ لدى المدير ولتعزيز الرضا الوظيفيّ لدى المعلّمين. وقد أكدّ Mayer & Salovey (1997) أهميّة الوعي الاجتماعيّ في بناء علاقات إيجابيّة تؤثّر عل جودة بيئة العمل.
تحليل ومناقشة النتائج للإجابة عن السؤال الثاني: ما هو واقع بيئة العمل في إحدى المدارس الخاصّة في محافظة جبل لبنان من وجهة نظر المعلّمين؟
يظهر في الجدول 6 المتوسّط الحسابيّ والانحراف المعياريّ لسبعة مؤشّرات خاصّة بمتغيّر بيئة العمل، وبناءً على النتائج تمّ تحديد موقف المعلّمين.
جدول 6: المتوسط الحسابيّ، الانحراف المعياريّ وموقف المعلّمين (ع=62) من مؤشّرات (ع=7) بيئة العمل
| مؤشّرات بيئة العمل | المتوسّط الحسابيّ | الانحراف المعياريّ | موقف المعلّمين | |
| يشعر المعلّم بالتقدير من قبل المدير | 3.95 | 0.858 | موافقة | |
| يستطيع المعلّم التعبير عن آرائه دون خوف من الرفض | 4.10 | 0.863 | موافقة | |
| يسود جوّ من التعاون بين زملاء العمل | 3.94 | 0.787 | موافقة | |
| يتمّ تشجيع المعلّمين على المبادرة | 3.98 | 0.859 | موافقة | |
| يشعر المعلّم بالأمان الوظيفيّ | 3.60 | 0.896 | موافقة | |
| يشعر المعلّم بالانتماء الى المدرسة التي يعمل فيها | 3.89 | 0.870 | موافقة | |
| التواصل بين المدير والمعلّمين يتّسم بالفعاليّة | 3.98 | 0.799 | موافقة | |
| الدرجة الكلّية لهذه المجموعة | 3.9194 | 0.66937 | موافقة |
حاز مؤشّر قدرة المعلّم عن التعبير عن رأيه من دون خوف المتوسّط الحسابيّ الأعلى البالغ 4.10 من 5.00 ما يدلّ على أنّ المدير يدعم الحوار مع المعلّمين الذين يشعرون بالأمان للتعبير عمّا يجول في خاطرهم، بالإضافة حظي المتوسّط الحسابيّ لمؤشّري التواصل الفعّال بين المدير والمعلّمين وتشجيع المعلّمين على المبادرة بالمرتبة الثانية 3.98 من 5.00 ما يشير الى قدرة المدير على تعزيز التواصل الفعّال أحد مرتكزات الوعي الاجتماعيّ لديه ممّا يشكّل ركيزة لخلق مناخ إيجابيّ في المدرسة.
على الرَّغم من الموافقة على المؤشّرات التي ذكرت سابقًا والتي تساهم في زيادة جودة بيئة العمل، سجّل مؤشّر شعور المعلّم بالأمان الوظيفيّ أدنى متوسّط حسابيّ إيجابيّ 3.60 من 5.00 ما يعكس ربّما قلقًا عند المعلّمين بشأن استقرارهم الوظيفيّ في المدرسة قد يكون عائدًا إمّا لعوامل لا تتعلّق بالمدير أو لسياسات تنتهجها المدرسة بخصوص الترقية أو توزيع الأدوار…
بالنظر الى الانحراف المعياريّ يلاحظ أنّه بلغ في حدّه الأقصى 0.896 ما يظهر أنّ التباين بين المعلّمين هو أقلّ من متوسّط ويشير الى وجود تصوّر متقارب نسبيًّا للمعلّمين عن خصائص بيئة العمل في المدرسة ويؤكّد استقرار ومصداقيّة النتائج حول المتغيّر المذكور.
بالخلاصة أظهرت النتائج أنّ المدير يتمتّع بالتنظيم الذاتيّ والوعي الاجتماعيّ من وجهة نظر معلّمي المدرسة الذين وافقوا على وجود المؤشّرات كافّة التي ذكرت في الاستمارة، كما تبيّن أنّ بيئة العمل تتّسم بالإيجابيّة ممّا يخفّف من توتّرها.
بعد قيام الباحثة باحتساب الدرجة الكليّة أو المركّبة لمؤشّرات كل متغيّر مستقلّ ولمؤشّرات المتغيّر التابع وبما أنّ المتغيّرات التنظيم الذاتيّ، الوعي الاجتماعيّ وبيئة العمل هي كميّة، وبعد التأكّد من اتّساق كلّ مجموعة من المؤشّرات باستخدام معامل كرونباخ ألفا تمكّنت الباحثة من إجراء تحليل ارتباط بيرسون لدراسة العلاقة الارتباطيّة بين المتغيّرين المستقلّ والتابع كما يظهر في الجدولين اللاحقين.
تحليل ومناقشة النتائج للإجابة عن السؤال الثالث: هل توجد علاقة ارتباطيّة دالّة إحصائيًّا بين التنظيم الذاتيّ لدى مدير المدرسة كما يدركه المعلّمون وبيئة العمل المدرسيّ في إحدى المدارس الخاصّة في محافظة جبل لبنان؟
جدول 7: اختبار بيرسون لقياس قوّة واتّجاه العلاقة بين التنظيم الذاتيّ لدى المدير وبيئة العمل المدرسيّ
| الارتباطات | |||
| التنظيم الذاتيّ | بيئة العمل | ||
| التنظيم الذاتيّ | معامل ارتباط بيرسون | 1 | 0.790** |
| القيمة الاحتماليّة (ثنائيّة الطرف) | 0.000 | ||
| مجموع المربّعات | 26.527 | 21.275 | |
| التغاير | 0.435 | 0.349 | |
| عدد المشاركين | 62 | 62 | |
| بيئة العمل
|
معامل ارتباط بيرسون | 0.790** | 1 |
| القيمة الاحتماليّة (ثنائيّة الطرف) | 0.000 | ||
| مجموع المربّعات | 21.275 | 27.331 | |
| التغاير | 0.349 | 0.448 | |
| عدد المشاركين | 62 | 62 | |
| ** العلاقة الارتباطية دالّة إحصائيًا عند مستوى الدلالة (1%) ثنائية الطرف | |||
يظهر الجدول رقم 7 وجود علاقة ارتباطيّة موجبة وقوية عند مستوى دلالة 0.01 (معامل ارتباط بيرسون 0.790˂0.500، القيمة الاحتماليّة 0.000˃0.01) بين التنظيم الذاتيّ لدى المدير وبيئة العمل المدرسيّ، ما يعني أنّه كلّما ارتفع مستوى التنظيم الذاتيّ لدى المدير كما يدركه المعلّمون ارتفع تقييم بيئة العمل المدرسيّ وتعدّ العلاقة قويّة إحصائيًّا عند مستوى دلالة 0.01 أي أنّ احتمال وجود هذه العلاقة بمحض الصدفة هو أقلّ من 1%.
معامل التّحديد (Coefficient of Determination) بين المتغيّرين هو 2 (0.790)= 0.6241 أي أنّ التنظيم الذاتيّ (المتغيّر المستقلّ) لدى المدير يفسّر 62.41% من التباين في بيئة العمل (المتغيّر التابع)، وهكذا تؤكّد النتيجة أهميّة علاقة هذا البعد من الذكاء العاطفيّ ببيئة العمل وأهميّة تعزيزه الذي يعدُّ أداة لتحسين البيئة.
وبهذا يمكن عدُّ أنّ محافظة المدير على هدوء أعصابه، التحكّم بانفعالاته، التوازن بقراراته كما التعامل مع الأزمات من دون تسرّع وكبت المشاعر السيئة بالإضافة لعدم السماح للعواطف بالتأثير على سلوك المدير المهنيّ يعزّز مناخًا إيجابيًّا في المدرسة ويخلق بيئة عمل أكثر دعمًا للمعلّمين.
تحليل ومناقشة النتائج للإجابة عن السؤال الرابع: هل توجد علاقة ارتباطيّة دالّة إحصائيًّا بين الوعي الاجتماعيّ لدى مدير المدرسة كما يدركه المعلّمون وبيئة العمل المدرسيّ في إحدى المدارس الخاصّة في محافظة جبل لبنان؟
جدول 8: اختبار بيرسون لقياس قوّة واتّجاه العلاقة بين الوعي الاجتماعيّ لدى المدير وبيئة العمل المدرسيّ
| الارتباطات | ||||
| الوعي الاجتماعيّ | بيئة العمل | |||
| الوعي الاجتماعيّ | معامل ارتباط بيرسون | 1 | 0.834** | |
| القيمة الاحتماليّة (ثنائيّة الطرف) | 0.000 | |||
| مجموع المربّعات | 37.312 | 26.625 | ||
| التغاير | 0.612 | 0.436 | ||
| عدد المشاركين | 62 | 62 | ||
| بيئة العمل | معامل ارتباط بيرسون | 0.834** | 1 | |
| القيمة الاحتماليّة (ثنائيّة الطرف) | 0.000 | |||
| مجموع المربّعات | 26.625 | 27.331 | ||
| التغاير | 0.436 | 0.448 | ||
| عدد المشاركين | 62 | 62 | ||
| ** العلاقة الارتباطية دالّة إحصائيًا عند مستوى الدلالة (1%) ثنائية الطرف | ||||
يظهر الجدول رقم 8 وجود علاقة موجبة قويّة ودالّة إحصائيًّا عند مستوى دلالة 0.01 (معامل ارتباط بيرسون 0.834˂0.500، القيمة الاحتماليّة 0.000˃0.01) بين الوعي الاجتماعيّ لدى المدير كما يدركه المعلّمون وبيئة العمل المدرسيّة، ما يدلّ على ارتفاع تقييم بيئة العمل المدرسيّة كلّما زاد الوعي الاجتماعيّ لدى المدير وتعدّ العلاقة قويّة إحصائيًّا عند مستوى دلالة 0.01 أي أنّ احتمال وجود هذه العلاقة بمحض الصدفة هو أقلّ من 1%.
معامل التحديد (Coefficient of Determination) بين المتغيّرين هو 2(0.834)= 0.6965 أي أنّ الوعي الاجتماعيّ (المتغيّر المستقلّ) لدى المدير يفسّر 69.65% من التباين في بيئة العمل (المتغيّر التابع)، وهكذا تؤكّد النتيجة أهميّة علاقة هذا البعد من الذكاء العاطفيّ ببيئة العمل وأهميّة تعزيز هذا البعد الذي يعدُّ أيضًا أداة مؤثّرة في تحسين البيئة من دون حسبان أثر المتغيّر الآخر بذات الوقت.
وبهذا يمكن القول إنّ إظهار المدير تفهمًّا لمشاعر المعلّمين، التفاعل معهم بتعاطف، معاملتهم باحترام كما مراعاة خلفيّاتهم الثقافيّة ومشاعرهم عند اتّخاذ قرارات تخصّهم يعزّز مناخًا إيجابيًّا في المدرسة ويخلق بيئة عمل أكثر دعمًا للمعلّمين.
إضافة الى ما سبق، قامت الباحثة بإجراء تحاليل إضافيّة بهدف التأكّد من احتمال وجود تداخل بين المتغيّرين المستقلّين من أجل حسم جودة النموذج التنبّؤي في تفسير النتائج.
جدول 9: تحليل الانحدار المتعدّد (Multiple Linear Regression)
| النموذج التنبّؤيّ | معامل الارتباط R | معامل التحديد المعدّل R2 Adjusted | خطأ التقدير المعياريّ
Std. Error of the Estimate |
| 1 | 0.858 | 0.727 | 0.34989 |
| المتغيّران المستقلّان: التنظيم الذاتيّ والوعي الاجتماعيّ | |||
يدلّ معامل الارتباط على وجود علاقة قويّة بين المتغيّرين المستقلّين مجموعين والمتغيّر التابع أو بيئة العمل، أمّا معامل التحديد المعدّل المستخدم لتوضيح مدى قدرة النموذج التنبّؤيّ على تفسير التباين في بيئة العمل فهو يظهر أنّ 72.7% من التباين الحقيقيّ في بيئة العمل يعود الى التنظيم الذاتيّ والوعي الاجتماعيّ لدى المدير مع خطأ تقديريّ منخفض نسبيًّا (0.34989) ما يشير الى دقّة النموذج المختار في التنبّؤ، أمّا 27.3% من التباين يبقى من دون تفسير نتيجة ارتباطه بعوامل أخرى لا تشملها الدّراسة. تجدر الإشارة الى أنّه كان التأكّد من عدم وجود تداخل Multicollinearity بين المتغيّرين المستقلّين VIF)= 2.828) لضمان صحّة النتائج.
جدول 10: تحليل صلاحيّة النموذج (ANOVA)
| النموذج | مجموع المربّعات | درجات الحريّة | متوسّط المربّعات | قيمة F | الدلالة الاحصائيّة Sig. |
| الانحدار | 20.108 | 2 | 10.054 | 82.126 | 0.000 |
| المتبقّي | 7.223 | 59 | 0.122 | ||
| المجموع | 27.331 | 61 | |||
| المتغيّر التابع: بيئة العمل
المتغيّران المستقلّان: التنظيم الذاتيّ والوعي الاجتماعيّ |
|||||
يمكن الاعتبار أنّ النموذج التنبّؤي المختار يساهم بشكل دالّ احصائيًّا في تفسير بيئة العمل بما أنّ قيمة F هي مرتفعة (82.126) والدلالة الاحصائيّة (0.000) هي أدنى من 0.01.
جدول 11: المعاملات (Coefficients)
| النموذج | المعاملات غير المعياريّة Unstandardized Coefficients | المعاملات المعياريّة Standardized Coefficients Beta | قيمة t | الدلالة الاحصائيّة Sig. |
| الثابت | 0.724 | – | 2.726 | 0.008 |
| التنظيم الذاتيّ | 0.344 | 0.339 | 3.011 | 0.004 |
| الوعي الاجتماعيّ | 0.480 | 0.561 | 4.987 | 0.000 |
| المتغيّر التابع: بيئة العمل
المتغيّران المستقلّان: التنظيم الذاتيّ والوعي الاجتماعيّ كلا المتغيّرين المستقلّين يؤثّران على بيئة العمل، لكنّ الوعي الاجتماعيّ له تأثير أكبر وأكثر دلالة (=ß0.561 وSig =0.000) بالمقارنة مع التنظيم الذاتيّ (=ß0.339 وSig =0.004)، لعلّ ذلك مردّه الى اتّصال الوعي الاجتماعيّ المباشر خصوصًا بالعلاقات الانسانيّة في العمل وبالتفاعل بين الأفراد. |
||||
الاستنتاجات: خلصت الباحثة في دراستها عن علاقة الذكاء العاطفيّ ببيئة العمل الى الاستنتاجات الآتية:
- توجد علاقة ارتباطيّة قويّة موجبة ودالّة بين الذكاء العاطفيّ ببعديه التنظيم الذاتيّ والوعي الاجتماعيّ لدى المدير وبيئة العمل المدرسيّ، ما يدلّ على أن أي تحسين في مهارات الذكاء العاطفيّ لدى المدير سيؤدّي مباشرة الى تحسين جودة البيئة داخل المدرسة.
- تبيّن أنّ الوعي الاجتماعيّ لدى المدير هو أكثر تأثيرًا على بيئة العمل مقارنة بالتنظيم الذاتيّ ما يسلّط الضوء على أهميّة تفاعل المدير وتواصله مع المعلّمين بفعاليّة.
- أثبتت المعطيات أن التنظيم الذاتيّ والوعي الاجتماعيّ يشكّلان عاملين غير متداخلين ومهمّين في تفسير نسبة كبيرة من التباين في بيئة العمل، ما يجعل الذكاء العاطفيّ حاسمًا من أجل تحسين جودة البيئة المدرسيّة.
- عكست المتوسّطات الحسابيّة لمؤشّرات بعدي الذكاء العاطفيّ جميعها موافقة المعلّمين على وجود المؤشّرات جميعها لدى مدير المدرسة، كما أتت متوسّطات مؤشّرات بيئة العمل جميعها أعلى من 3.6 ما يوحي باستقرار البيئة في المدرسة وإيجابيّة الجوّ فيها.
- بما أنّ الدّراسة بنيت على أساس إدراك المعلّمين للذكاء الانفعاليّ لدى المدير وتصوّراتهم حول بيئة العمل في المدرسة بالتالي يمكن أن تصبح هذه الآراء أداة تشخيصيّة تعتمد من أجل إعداد سياسات تربويّة.
التّوصيات: تقترح الباحثة التوصيات التالية بناءً على كلّ ما سبق:
- اعتماد أدوات تقييم مهارات الذكاء العاطفيّ لدى المديرين الذين هم في الخدمة والذين يريدون الالتحاق بالإدارة بحيث يعتمد الاختبار كأحد مؤشّرات الكفاءة الإداريّة.
- تصميم أنظمة قياديّة مبنيّة على الذكاء العاطفيّ تعتمد كمنهج إداريّ في المدارس ينظر الى أبعاد الذكاء العاطفيّ ليس فقط كمهارات شخصيّة موجودة لدى المدير بل أيضًا كقدرات يجب تطويرها وتنميتها.
- تطوير برامج مهنيّة وتدريبات تطبيقيّة مستدامة خاصّة بالمديرين بهدف تنمية مهارات الذكاء العاطفيّ لديهم كالتنظيم الانفعاليّ، التعامل مع النزاعات، التواصل اللفظيّ…
- تشجيع ممارسة سياسات إداريّة تشاركيّة من خلال ورش عمل للمديرين والمعلّمين معًا من أجل إرساء لغة مشتركة ترتكز على التفاهم المتبادل وتمكّن المعلّمين من التعبير عن آرائهم ومن المشاركة بفعاليّة في اتّخاذ القرارات.
- تطوير أدوات تقييم دوريّ لبيئة العمل كما يدركها المعلّمون والعاملون في المدرسة.
- إجراء دراسات على نطاق أوسع تشمل الأبعاد المتبقيّة للذكاء الانفعاليّ لدى المدير التي لم يتمّ التطرّق اليها في هذه الدّراسة ومعرفة نسبة تباين هذه الأبعاد في بيئة العمل بهدف تطوير نماذج قياديّة أكثر فعاليّة.
المراجع
-1Bar-On, R. (2006) .Bar-On model of emotional-social intelligence (ESI). Psicotherma, Universidad de Ovieda, Vol.(18), pp.13-25. https://www.psicothema.com/pdf/3271.pdf
-2Berenson, M. & Levine, D. & Szabat, K. (2015) .Basic Business Statistics Concepts and Applications Thirteenth edition. Pearson Education Limited, Essex England.
-3Cherniss, C & Goleman, D. & Emmerling, R. & Cowan, K. & Adler, M. (1998) .Bringing Emotional Intelligence to the Workplace .The Consortium for research on emotional Intelligence, pp.1-34. https://www.eiconsortium.org/reports/technical_report.html
-4Cohen, J. & Mccabe, E. & Michelli, N. & Pickeral, T. (2009) .School Climate: research, Policy, practice, and Teacher Education. Teachers College Record, Vol.)111), Issue No.(1), pp.180-213. https://www.researchgate.net/publication/235420504_School_Climate_Research_Policy_Teacher_Education_and_Practice?_tp=eyJjb250ZXh0Ijp7ImZpcnN0UGFnZSI6Il9kaXJlY3QiLCJwYWdlIjoic2VhcmNoIn19
-5Collie, R.J. & Shapka, J.D. & Perry, N.E. (2012) . School climate and social-emotional learning: Predicting teacher stress, job satisfaction, and efficacy. Journal of Educational Psychology, Vol.(104), pp.1189-1204. http://dx.doi.org/10.1037/a0029356
-6Goleman, D. (2003) .Working with Emotional Intelligence .Bantam Books USA, pp.1-12. https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/57210792/_Daniel_Goleman__Working_With_Emotional_Intelligenb-ok.xyz_1-libre.pdf?1534750124=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DWISDOM_IN_A_NUTSHELL_WORKING_WITH_EMOTIO.pdf&Expires=1749156821&Signature=A4rM2uv6go1OkGz55VxapOnqILNcZ0jntDVuWFnHIHm6bYvm6mxID-CYbSb4VmxsUwFj2gz1FqhVLBnSTbhcOWBldblbyeSvQa7wJXyqjt7SSsScatKsARoJj8dEDHScpjW-PDuK9T1ndMjfp-19HpleBosOlWiSogfpPZH1QJLgis8QRSoNoJ~UQ3dEyEUBaRFTwNgk7cue5Q9LJbvYRUawmIVxKdEMD6I~kj545MSN6yoGqeEtrAiLVEttsRJ2bkP-3lOyLynNiefau7AkAwVj6cp9ptTPzu70BsdtaAuikpze89w8RcNp56LGraA8f6eTeQuq6kx1z7FUuvY6OA__&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA
-7Goleman, D .(2009) . Emotional Intelligence Why it can matter more than IQ. Bloomsbury Publishing Plc, 36 Soho Square, London.
-8Goleman, D. & Boyatzis, R. & McKee, A. (2013) .Primal Leadership Unleashing the Power of Emotional intelligence. Harvard Business Review Press Business & Economics, Boston Massachusetts. pp.3-88. https://www.google.com.lb/books/edition/Primal_Leadership/ibQTAAAAQBAJ?hl=en&gbpv=1&printsec=frontcover
-9Hoy, W.K. & Miskel, C.G. (2013) .Educational Admnistration: Theory, Research and Practice. McGraw Hill, NY 10020. https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/40954417/Educational_Administration_Theory-Wayne.pdf?1738280703=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DEducational_Administration_Theory_Wayne.pdf&Expires=1749228823&Signature=hFJvAqq2zP1y2vlPz8csBkRxwLbr4tZphOmz5NUOVhfIIKmf6NJg7-wm4-jqL1EuBFP0FjUVev8fZeh~~vkdl9POuqOlbPPxlyOmGS7vTHNjEhObJKOw~2HZmLQZExqxtFCDMSUxg5gVH9Pn4iuJZYShmSYglaUOuEETohWYdeEamSIh0aQZgKtInvCK63bp0C2KLlP6ENlJzbHDIH0k9846iN3bvq6I79vfiGKrzXxcFawjiHw9nA8BZdIqu6xUsUHo0JSPNiSo8YcsFVxCX7B15vtp5q8vq2MpsRjtMA1JsHHdV8BATVDelfMIpStf0rmrjOkN8HTcX2C-eThmmw__&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA
-10Mayer, J.D. & Salovey, P .(1997) .Emotional Development and Emotional Intelligence: Educational Implications. Basic Books, pp.1-31. https://www.researchgate.net/publication/284682534_Emotional_Development_and_Emotional_Intelligence_Educational_Implications
-11Mayer, J. & Caruso, D. & Sitarenios, G. & Escobar, M. (2024) .How many emotional intelligence abilities are there? An examination of four measures of emotional intelligence .Personality and Individual Differences, Vol.(219), pp.1-12. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0191886923003914?via%3Dihub
-12Ott, C .(n.d.). What is Emotional Intelligence?. Ohio State University, College of Food, Agricultural and Environmental Sciences. pp.1-5 https://ohio4h.org/sites/ohio4h/files/imce/Emotional%20Intelligence%20Background.pdf
13- النجار، ابراهيم. (2024). تطوير مدارس التعليم الخاص في مصر “دراسة تحليلية”. مجلة كلية التربية ببنها. عدد(139)، ج(3)، ص.419-442.
14-النصيرات، أيمن. (2024). درحة ممارسة مديري المدارس الأساسية لسلوك القيادة التحويلية من وجهة نظر المعلمين في مدارس مديرية المزار الشمالي – الأردن. المجلة العلمية جامعة أسيوط. مجلد(40)، عدد(3)، ص.124-154.
15-الهلالي، فاتن. (2022). الدور القيادي لدى مديرات المدارس الثانوية في مديرية تربية الأغوار الشمالية وعلاقته بالذكاء العاطفي لدى المعلّمين. مجلة جدارا للدراسات والبحوث. مجلد (9)، عدد(22)، ص.138-164.
16-حبايب، علي؛ الخليلي، فاخر. (2008). واقع البيئة المدرسيّة في محافظة نابلس من وجهة نظر المعلّمين. مجلة جامعة بيت لحم. ص.70-97.
17-سكر، ناجي. (2018). مستوى الذكاء العاطفي لدى المدارس الحكومية بمدينة غزة وعلاقته بدرجة النجاح في ممارساتهم القيادية من وجهة نظر المعلمين. كلية التربية جامعة الأقصى، غزة. ص.1-36.
18-عويس، رامي؛ حوامدة، باسم. (2024). الذكاء العاطفي وعلاقته بالاتصال الإداري لدى مديري المدارس الخاصة في المحافظات الشمالية في فلسطين. مجلة كلية التربية في جامعة أسيوط. مجلد(40)، عدد(9)، ص.251-275.
19-ماتلي، منار. (2025). أثر بيئة العمل على الكفاءة الإنتاجية لأعضاء هيئة التدريس: دراسة تطبيقية على كليتي إدارة الأعمال والقانون بجامعة الجفرة. مجلة جامعة سيها للعلوم البحتة والتطبيقية. عدد(24/1)، ص.147-160.
20-محمود، عبد الرازق؛ مرغني، أماني؛ ناجي، نادي. (2022). العلاقة بين مهارات التدريس الإبداعي وأبعاد الذكاء الوجداني لدى معلممي اللغة العربية بالمرحلة الابتدائية. المجلة التربوية لتعليم الكبار- كلية التربية- جامعة أسيوط. مجلد(4)، عدد(1)، ص.31-60.
21-مهاني، رندة. (2010). دور المعلم المساند في تحسين العملية التعليمية من وجهة نظر المعلمين الدائمين في مدارس وكالة الغوث الدولية في محافظات غزة. مجلة كلية التربية الجامعة الإسلامية غزة. ص.1-200.
– طالبة ماستر بحثيّ في الإدارة التربويّة في كليّة التربية في الجامعة اللبنانيّة[1]
Research Master Student in Educational Management Faculty of Pedagogy Lebanese University.Email: dolly.maalouf.1@st.ul.edu.lb