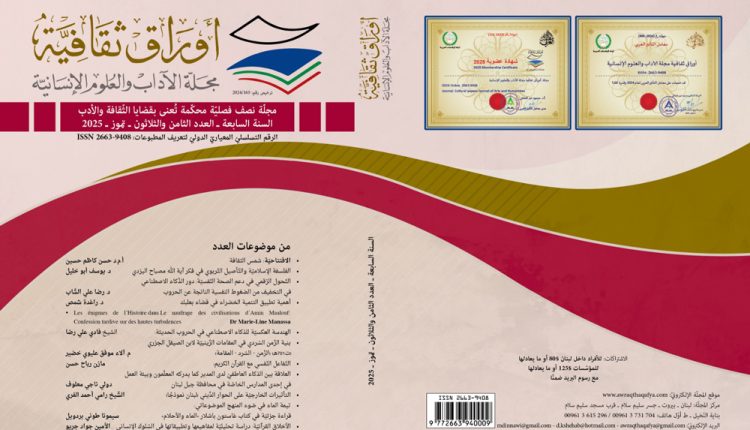عنوان البحث: الزيتون كتراث مقاوم وهوية مجاليّة: مقاربة ميدانيّة للمرونة الثقافية في ريف لبنان المهمّش
اسم الكاتب: د. سنتيا نصر
تاريخ النشر: 2025/07/16
اسم المجلة: مجلة أوراق ثقافية
عدد المجلة: 38
تحميل البحث بصيغة PDFADOI: https://aif-doi.org/awraq/013804
الزيتون كتراث مقاوم وهوية مجاليّة: مقاربة ميدانيّة للمرونة الثقافية في ريف لبنان المهمّش
Olives as a heritage of resistance and spatial identity: a field-based approach to cultural resilience in marginalized rural
د. سنتيا نصر([1])Dr. Cynthia Nasr
تاريخ الإرسال:5-5-2025 تاريخ القبول:3-6-2025
الملخص
يشكّل تراث الزيتون في لبنان أكثر من مجرد ممارسة زراعيّة تقليديّة؛ إنّه تعبير معقّد عن علاقة تاريخيّة وثقافيّة واقتصاديّة تربط الإنسان بالمجال، وتجسّد الهُويّة والقدرة على المقاومة. في ظل أزمات متراكبة تطال البنية الرّيفيّة، من التّدهور الاقتصادي إلى التّغيّرات المناخيّة، تطرح هذه الدّراسة إشكاليّة مركزيّة حول إمكانيّة تحويل هذا التراث إلى رافعة للمرونة المجاليّة في المناطق المهمّشة. انطلاقًا من مقاربة كيفيّة قائمة على العمل الميداني في ثلاث مناطق لبنانيّة (الكورة، مرجعيون، وعكار)، تعتمد الدّراسة على مقابلات، ملاحظات بالمشاركة، وتحليل سيميائي للمجال، من أجل فهم ديناميات التراث، وتحوّلاته، وقدرته على الاستمرار. وتظهر النتائج أن تراث الزيتون لا يزال يحمل إمكانيّة فاعلة لإعادة تشكيل العلاقات المجاليّة، شريطة إعادة إدماجه ضمن سياسات ثقافيّة وتنمويّة عادلة وبيئية. كما تقترح الدّراسة تصورًا متكاملاً لترسيخ التراث الثقافي المقاوم، يربط بين الاستدامة، والهُويّة، والتّضامن المجتمعي، في أفق استعادة السيادة الغذائية والثقافية في الريف اللبناني.
الكلمات المفتاحيّة: الزيتون، التراث الثقافي، المرونة المجالية، الريف اللبناني، التنمية المستدامة.
Abstract:
The olive heritage in Lebanon constitutes more than a traditional agricultural practice; it embodies a complex interplay of cultural, economic, and territorial meanings, deeply rooted in collective identity and community resilience. In the face of multiple crises economic collapse, state neglect, and climate disruption this study explores the potential of olive related heritage as a foundation for territorial resilience in Lebanon’s marginalized rural areas. Drawing on qualitative fieldwork conducted in three regions (Koura, Marjeyoun, and Akkar), the research employs semi structured interviews, participant observation, and semiotic spatial analysis to assess the evolving relationship between people, land, and memory. Findings reveal that olive heritage, despite fragmentation and precarity, retains the capacity to foster collective belonging and sustainable local economies. The study proposes a framework for “resistant cultural heritage” as a tool for spatial justice and cultural regeneration, grounded in agroecology, cooperative solidarity, and grassroots development in rural Lebanon.
Keywords: Olive heritage, cultural resilience, territorial identity, rural Lebanon, sustainable development.
المقدمة
يعيش لبنان اليوم في ظل تحولات جذريّة تطال كل مستويات البنية المجتمعيّة والاقتصاديّة والثقافيّة، حيث تشهد المناطق الرّيفيّة تحديدًا حالة من التّهميش التدريجي، لا بفعل الأزمات الآنية فحسب، بل نتيجة تراكمات تاريخيّة من السياسات التنمويّة غير المتوازنة. وفي قلب هذا التّهميش، يتجلى تراث الزّيتون كمجال رمزي ومادي يختزل صراعًا عميقًا بين الاستمرارية والاندثار، بين الجذور والضياع، بين الهُويّة واللامبالاة. فالزيتون، الذي يشكل جزءًا لا يتجزأ من المعيش اللبناني، ليس مجرد منتج زراعي أو غطاء نباتي، بل هو حامل لذاكرة جماعيّة، ولغة ثقافيّة، وشاهد على علاقة الإنسان بالأرض والزّمن والمقدّس .غير أنّ هذا التّراث العريق يواجه اليوم تحديات متعددة: من التصحر الاقتصادي للمناطق المنتجة، إلى انقطاع سلاسل التوريث، إلى تدهور القيم الاجتماعيّة المتصلة بالأرض والعمل الزراعي. في ظل غياب سياسات دعم مستدامة، وعجز البنى المؤسساتيّة، وتغيّر أنماط العيش، أصبح تراث الزيتون عرضة للضمور، وربما النسيان. تضاف إلى ذلك التغيرات المناخيّة المتسارعة، والتي باتت تهدد استمرارية أنماط الإنتاج التقليديّة، وتفرض ضرورة التكيف على نحو مستدام. فهل يمكن في هذا السّياق الانتقالي أن يتحول هذا التّراث من عبء على الذّاكرة إلى طاقة للمقاومة؟ وهل يمكن إعادة توظيفه كدعامة للمرونة المجاليّة والتنمية الثقافيّة المستدامة في مناطق الأطراف اللبنانيّة؟
تنبثق هذه الإشكاليّة من وعي متزايد لدى الباحثين والفاعلين المحليين بأهمّيّة الانتقال من مقاربة التّراث كقيمة رمزيّة أو فولكلوريّة، إلى إدراجه ضمن ديناميات اقتصاديّة اجتماعيّة قادرة على إنتاج فرص حقيقيّة للصمود، والابتكار، والتّجذر. ذلك أن مفهوم “المرونة المجاليّة”(résilience territoriale)، كما طُوّر في أدبيات الجغرافيا والنماء الإقليمي، يفتح آفاقًا جديدة لفهم العلاقة بين التراث والهُويّة والتنمية، إذ لم يعد التراث مجرد عنصر للمحافظة، بل أصبح أداة لإعادة تشكيل المكان من خلال أبعاده البيئيّة، والمعرفيّة، والاجتماعيّة، بل وحتى السياسيّة في لحظات الانهيار المؤسسي. لقد بات مفهوم التّراث في الأدبيات المعاصرة يتجاوز البعد الأثري أو الرّمزي المحض، ليتحول إلى منظومة ديناميّة تُنتج وتُعاد إنتاجها داخل سياقات اجتماعيّة واقتصاديّة متغيرة[1]. فالتراث ليس ما مضى وانتهى، بل ما يُستثمر في الحاضر بوصفه طاقة للتفاوض حول الهُويّة والانتماء والحقّ في المكان. وفي هذا السّياق، تنمو مقاربة جديدة تُعرف ب”التراث الثقافي المقاوم”، وهي لا تكتفي بتثبيت الخصوصية الثقافيّة، بل تدمجها في مشاريع استدامة مجاليّة تنبع من الدّاخل وتواجه قوى الإقصاء والتهميش الخارجي.[2]
يتجسد التراث المقاوم في لبنان، بشكل خاص في تراث الزيتون الذي يمتد عبر قرون من التقاليد الزّراعيّة والعائليّة والدّينيّة. هذه الشّجرة التي رُبطت بالسلام والمقدّس في المخيل الجمعي[3]، لم تكن فقط مصدرًا للغذاء أو الدخل، بل وسيلة لصياغة علاقة عضوية بين الإنسان وأرضه، وعلامة على الصمود في وجه التحولات البيئيّة والسياسيّة. غير أن هذا الصمود لم يعد مضمونًا، لا سيما في ظل هشاشة الاقتصاد الريفي وتفكّك شبكات التضامن التقليدية[4]. من هنا، تبرز الحاجة إلى إعادة قراءة هذا التراث من منظور “المرونة المجاليّة”، أي القدرة الجماعيّة لمجتمع ما على التكيّف والتّجدد في مواجهة الصّدمات، سواء أكانت بيئيّة، أو اقتصاديّة، أو اجتماعيّة[5]. فالمجال ليس مجرد إطار مكاني، بل هو نتاج تفاعلات بشريّة وماديّة تتطلب قدرة على التّجديد من دون فقدان المعنى. وتشكّل زراعة الزيتون في هذا الإطار نموذجًا لاقتصاد محلي معرفي[6]، يحفظ الذاكرة، ويعيد تشكيل الفعل الجماعي، ويعزز السيادة الغذائية والاقتصادية للمجتمعات المهمشة.
الجزء الثالث: الدّراسة الميدانية والمنهجية
تعتمد هذه الدّراسة على مقاربة نوعيّة (qualitative) تستند إلى المنهج الجغرافي النقدي، وذلك لكون هذا الأخير يسمح بفهم العلاقات المكانيّة ضمن بنيات السلطة والإنتاج والتّهميش. فالتّراث، في هذا السّياق، لا يُقرأ كمعطى ثابت بل كنتاج لصراعات مجاليّة تعبّر عن موازين قوى متغيرة، تتقاطع فيها الأبعاد الاقتصاديّة، والرّمزيّة، والبيئيّة، والسياسيّة.[7] وقد اختيرت ثلاث مناطق ريفيّة لبنانيّة كمجال للتحليل الميداني: قضاء الكورة (شمال لبنان)، منطقة مرجعيون (الجنوب الشّرقي)، وعكّار (أقصى الشّمال). واختيرت هذه المناطق وفاق معيارين رئيسين: أولًا، كونها مناطق ذات كثافة عالية من بساتين الزيتون وارتباط مجتمعاتها المحلّية بالزراعة الزيتونيّة تاريخيًا؛ وثانيًا، لتفاوت مستويات التنمية المجاليّة والبنية التحتيّة فيها، ما يسمح بمقارنة ديناميات المرونة من سياقات مختلفة.
أُجريت الدّراسة بين عامي 2022 و2024، واعتمدت على الأدوات الآتية:
- 1. المقابلات شبه الموجّهة (entretiens semi-directifs): أجريت 18 مقابلة مع مزارعين (8 ذكور، 4 إناث)، وممثلين عن التّعاونيّات الزراعيّة (3)، وناشطين ثقافيين محليين (2)، وموظفين بلديين (1). راوحت أعمار المشاركين بين 28 و71 عامًا، مما سمح بجمع تصورات من أجيال متباينة. كان التّركيز خلال المقابلات على ثلاثة محاور: تصور الأفراد لتراث الزيتون، التحديات التي تواجههم في الحفاظ عليه، والابتكارات أو الاستجابات الممكنة في ظل الأزمات.
- 2. الملاحظة بالمشاركة: (observation participante) خضع الباحث لتجربة ميدانيّة مباشرة ضمن موسم قطاف الزيتون في بلدة “بشمزّين” في الكورة، و”الخيام” في مرجعيون، و”فنيدق” في عكار، ما أتاح فهمًا مباشرًا للطقوس الزراعيّة والتفاعلات الاجتماعيّة المترافقة مع إنتاج الزيتون، خصوصًا في لحظات العمل الجماعي، وتقاسم الموارد، والنقل، والعصر.
- 3. تحليل الخطاب المحلي والمجالي: حُلِّلت اللافتات، والرموز، والرسائل الإعلانيّة، والأغاني الشّعبية، والأمثال المتداولة حول الزيتون في المجتمعات الثلاث، بهدف فهم البنية السيميائيّة التي تحيط بالتراث ودلالاته في المخيل الجماعي، وتفكيك العلاقة بين اللغة والمجال والزمن الثقافي[8].
- 4. التّحليل الوثائقي: استُخدمت وثائق بلدية ومحاضر اجتماعات تعاونيات، وتقارير منظمات دوليّة عاملة في مجال الأمن الغذائي والزراعة مثلFAO) و(UNDP لتتبع التّطور المجالي والإداري للقطاع، وتحديد الفجوات المؤسساتية بين السياسات والخطابات.[9]
تقوم القراءة التّحليليّة للبيانات على منهج التثليث (triangulation)، أي تقاطع المعطيات المختلفة من مقابلات وملاحظات ووثائق، للوصول إلى صورة مركبّة ومعمقة عن العلاقة بين تراث الزيتون والمرونة المجاليّة. ونُظِّمت المعطيات باستخدام برامج تحليل نوعي مثل NVivo، ما سمح بتصنيف الرّموز والمضامين ضمن محاور دلاليّة تتعلق بالهُويّة، والاقتصاد، والصراع، والاستدامة[10]. تجدر الإشارة إلى أنّ المقاربة المنهجيّة المعتمدة لا تسعى إلى تعميم النتائج على كامل الأراضي اللبنانيّة، بل إلى إنتاج فهم متعمّق contextualisé للرهانات المحليّة في مناطق الأطراف، بما يسمح بإعادة صياغة أدوات التدخل التنموي انطلاقًا من الديناميّات المجتمعيّة لا من الفرضيات المركزيّة أو السياسات الفوقيّة. وفي هذا السياق، يشكّل الفاعلون المحليون ليس فقط مصادر للمعلومة، بل شركاء في بناء المعنى، ما ينسجم مع التوجّه التّشاركي الذي بات يميز المقاربات النقديّة للتراث والمجال في السياق ما بعد الاستعماري[11].
الجزء الرابع: النتائج والتحليل الميداني
- 1. الحالة الأولى: الكورة.
تُعدّ الكورة من المناطق التقليدية في زراعة الزيتون، إذ يتوارث السّكان هذه الحرفة منذ قرون. غير أنّ التّحولات الاقتصاديّة في العقدين الأخيرين، وارتفاع تكاليف الإنتاج، وتراجع الدّعم المؤسساتي، أضعفوا من الجدوى الاقتصاديّة للزيت، دون أن يمحوا رمزيته.
في مقابلة مع أحد كبار المزارعين في بلدة “بشمزّين”، قال:” الزيتون صار غالي عالجيبة، بس بعدو غالي عالقلب. يعني منشتغل بالخسارة، بس ما منبطل[12]“. هذه الجملة تختصر التوتر بين الرّغبة في الحفاظ على الموروث، وصعوبة استمراره كرافعة اقتصاديّة. وعلى الرّغم من المبادرات المحدودة لتأسيس تعاونيّات، لا تزال سلاسل التّسويق ضعيفة، والمعاصر قديمة في معظمها، ما يجعل المجال عرضة للركود. تُظهر ملاحظات الباحثة أن أغلب العائلات تتابع عملية القطاف كطقس اجتماعي، يُستعاد فيه شعور الانتماء للأرض. غير أن هذا الانتماء غالبًا ما يُستخدم في الخطاب، من دون أن يُترجم في سياسات دعم أو استراتيجيات تسويق جدّية[13].
- 2. الحالة الثانية: مرجعيون
في مرجعيون، تُقابل الشّجرة الزّيتونيّة بمشاعر متباينة. فإلى جانب الرمزيّة الدّينيّة والاجتماعيّة، تُحمل الشجرة ذاكرة الحرب والتهجير، خصوصًا في القرى القريبة من الحدود. قال أحد الرجال المسنّين من “الخيام”:” كنا نخبّي الزيت تحت الأرض أيّام الحرب. الزيتون شاهد، بس كمان جريح”.[14]
يتجلّى هنا أنّ الزيتون لم يعد فقط رمزًا للهُويّة، بل حقلًا لتجاذب المشاعر بين الأمان والخوف، بين الاستذكار والنسيان. على الرّغم من ذلك، ظهرت مبادرات محليّة، خصوصًا نسائيّة، في بلدات مثل “عديسة”، تهدف إلى إعادة التّسويق اليدوي للزيت عبر الشّبكات المدنية في بيروت، وإن كانت تعاني من ضعف التمويل والبنية التحتيّة. تقول إحدى المشاركات: “في زيت، بس ما في شبكة. في تعب، بس ما في دعم[15]“. ما يدلّ على غياب الدّولة كفاعل، وضرورة تطوير شبكات دعم غير رسمية تعزز التبادل بين المركز والأطراف.
- 3. الحالة الثالثة: عكار (الشمال الحدودي)
عكار، بأراضيها الواسعة وإقصائها التنموي، تقدّم مشهدًا مغايرًا. إذ ما زال الزيتون مزروعًا بكثافة، لكنه لا يُسوق. معظم الإنتاج يدخل في دائرة الاستهلاك الذاتي والتبادل العائلي. قال أحد المزارعين في فنيدق:”نزرع للبيت. منبيع بس للجار. الزّيت هو أمان، مش تجارة[16]“. في “الشيخ طابا”، صادفت الباحثة مزارعًا يستخدم معصرة يدوية تعود لجده:”المعصرة تراث. نخسر، بس منبقى. الدولة ما بتدري أصلًا نحنا هون[17].” أمّا الخطر الأكبر، فيكمن في تغيّر المناخ. في العام 2023، شهدت عكار انخفاضًا حادًا في المحصول بسبب قلة الأمطار. وقد دفع هذا بعض الشّبان إلى استبدال الزيتون بالطماطم أو الحشائش السّريعة العائد، وهو ما عبّر عنه أحدهم قائلًا: “ما منترك الزيتون إلّا إذا الأرض عطشانة. بس الجفاف غلب الحب”[18].
الجزء الخامس: الجدول المقارن والرؤية التّركيبيّة
تظهر المقارنة العرضيّة بين المناطق الثلاث المدروسة أن كلًّا منها يجسّد نموذجًا خاصًا لتفاعل المجتمع الريفي اللبناني مع تراث الزيتون، سواء في الرمزيّة، أو الاقتصاد، أو الحضور المؤسسي، أو التهديدات البيئيّة.
نقدم أدناه جدولًا نوعيًّا مركبًا يوضح أبرز أوجه التقاطع والاختلاف
| المحور | عكّار | الكورة | مرجعيون |
| البنية الرمزية | رمز للبقاء والمقايضة، لكنها لم تعد حاضرة في المخيل المؤسسي أو الإعلامي | شجرة مقدّسة وموروث عائلي حيّ، لكنها تتحول إلى عبء اقتصادي | مرتبطة بالذاكرة المؤلمة والحرب، تُستدعى في الخطاب كرمز للصمود |
| الاقتصاد المحلي | يعتمد على الاقتصاد العائلي والتبادل، مع غياب شبه تام للسوق النظامي | إنتاج وفير، لكن ضعيف الجدوى التجارية بسبب ارتفاع التكاليف | إنتاج محدود، وتسويق ضعيف بسبب الموقع الحدودي ونقص الخدمات |
| الدينامية المجتمعية | مبادرات فردية صامتة، مقاومة ذاتية خارج المؤسسات | مبادرات تعاونية ناشئة ومحدودة النطاق | تعاونيات نسائية نشطة لكن تعاني من التهميش وعدم التمويل |
| الحضور المؤسساتي | غياب كامل للدولة، ولامبالاة رسمية رغم وجود مبادرات محلية أصيلة | بعض الدعم البلدي غير المنظم، ومعاصر شبه خاصة | غياب واضح للدولة، وتحركات خجولة للجمعيات الدولية |
| التهديدات البيئية | الجفاف، وانهيار نظم الريّ التقليدية، ونزوح اليد العاملة | التصحّر التدريجي واختلال دورة القطاف والعصر | ندرة المياه والضغوط الأمنية على البيئة |
هذا الجدول لا يهدف فقط إلى التبويب، بل إلى إبراز الطبيعة التعدديّة للمرونة المجاليّة في لبنان، إذ لا توجد وصفة واحدة أو نموذج جاهز. فكل منطقة تطوّر علاقتها بالتراث استنادًا إلى ظروفها، وذاكرتها، وشبكاتها الاجتماعيّة أو غيابها. ومن هنا تبرز الحاجة إلى نقاش نظري يدمج هذه القراءات الميدانيّة في إطار تحليلي أوسع.
الجزء السّادس: النقاش والتّحليل التّركيبي
أظهرت دراسة الحالات الثلاث (الكورة، مرجعيون، عكّار) أنّ تراث الزيتون في لبنان لا يمكن مقاربته كمعطى ثابت أو مجرد بقايا من الماضي، بل كحقل مجالي ديناميكي تتقاطع فيه الرهانات الاقتصاديّة، والرمزيّة، والاجتماعيّة، والبيئيّة، بشكل معقّد. وهو بذلك يشكّل موقع مقاومة متعدد الأبعاد، وإن بدرجات متفاوتة بين المناطق الثلاث.
. 1التّراث بين التّقديس والوظيفة: من الذّاكرة إلى الاستثمار
بيّنت الدّراسة أن شجرة الزيتون ما زالت تحظى بمكانة وجدانيّة قويّة في المخيل الجماعي، لكن هذه الرمزيّة لا تترجم دائمًا إلى ممارسات اقتصادية مستدامة. ففي الكورة، نجد نوعًا من الحنين الإنتاجي الذي يصطدم بمنطق السوق الخاسر؛ وفي مرجعيون، يرتبط الزيتون بالخوف والنجاة أكثر مما يرتبط بالتنمية؛ أما في عكار، فهو جزء من اقتصاد التّضامن العائلي، لا من منظومة السّوق. هذا ما يؤكد أن ترسيخ “التراث الثقافي المقاوم” يتطلب تحويل الذاكرة إلى فاعليّة مجاليّة، أي ربط الرمزية بالمنفعة دون الوقوع في الابتذال السوقي[19].
. 2الدّولة الغائبة، المجتمع الحاضر: المرونة من القاعدة
في الحالات جميعها ، كان غياب الدولة واضحًا، سواء من حيث البنى التحتيّة، أو دعم سلاسل القيمة، أو توفير التمويل. في المقابل، برزت مبادرات أهليّة وشعبيّة ذات طابع تعاوني، حاولت وإن بوسائل محدودة الحفاظ على استمرارية الموروث. هذا المشهد يتقاطع مع أدبيّات المرونة المجالية التي ترى في المبادرات القاعدية (bottom-up) عنصرًا أساسيًا في بناء قدرة المجتمعات على التكيف[20]. غير أنّ هذه المبادرات تبقى هشّة ومعرضة للتراجع، ما لم تُعزز بتدخلات مؤسساتيّة مرنة تراعي الخصوصيات المحلية.[21]
. 3التّهديد البيئي: بين الانقراض والتّحول
شكّل البعد البيئي، خصوصًا في عكار، عاملًا حاسمًا في مصير زراعة الزيتون، إذ يهدد التغيّر المناخي البنية البيولوجية للتراث. في هذا السّياق، تُطرح ضرورة إعادة تأطير التراث الزراعي ضمن منظور بيئي مستدام، يعتمد على الزراعة العضويّة، وأنظمة الريّ الذكية، والحفاظ على البذور المحلية. فالتراث هنا لا يُحفظ فقط من خلال النوايا، بل من خلال الممارسات المتكيفة مع التحولات المناخية[22].
. 4التراث كأداة لإعادة صياغة الهُويّة المجاليّة
أخيرًا، فإنّ التّراث إذا ما أُدرج ضمن رؤية تنموية نقديّة يمكن أن يكون أداة لإعادة تشكيل الهُويات المجاليّة، ليس عبر العودة إلى الماضي، بل من خلال تحديثه عبر أدوات ذكية، وتعاونيات محليّة، ومنصات رقميّة تسويقيّة، وتدخلات ثقافيّة إبداعيّة. إننا بحاجة إلى تحويل شجرة الزيتون من رمز إلى مشروع، ومن وجدان إلى سياسات[23].
الجزء السّابع: الخاتمة والتوصيات
تكشف هذه الدّراسة، من خلال تحليل ثلاث حالات ميدانيّة في الكورة ومرجعيون وعكّار، أنّ تراث الزّيتون في لبنان لم يعُد مجرد بُعد رمزي جامد، بل تحول إلى مساحة اشتغال ديناميكيّة بين الاستمرارية والقطيعة، بين الهُويّة والمقاومة، بين الأزمة والفرصة. وعلى الرّغم من السّياقات الاقتصاديّة والسياسيّة والبيئيّة الضاغطة، تبيّن أن هناك إمكانيات فعليّة لبناء “مرونة مجاليّة” تنطلق من هذا التراث الزراعي، شريطة توافر بيئة حاضنة، وشبكات دعم، وإرادة ثقافيّة سياسيّة للاعتراف بخصوصيات الأطراف. لقد أظهرت المقاربة الميدانية أن المجتمعات الريفية ليست ضحية فقط، بل فاعلًا قادرًا على إنتاج حلول بديلة، غالبًا بصمت ومن خارج الأطر الرّسميّة. وهذا يتطلب إعادة تموضع السياسات التنموية، بحيث لا تفرض نماذج جاهزة “من فوق”، بل تستلهم من الممارسات اليوميّة المحليّة لبناء استراتيجيات مستدامة “من تحت”[24].
أولاً: إدماج تراث الزيتون في السياسات الثقافيّة والتنمويّة
يجب على السياسات الثقافيّة أن تعترف بأن التراث الزراعي ليس مجرد ماضٍ جميل، بل رافعة اقتصاديّة هوياتيّة إذا ما دُمِج ضمن مشاريع متكاملة تشمل: دعم المعاصر التقليديّة، تشجيع الزراعة العضويّة، ربط المنتج المحلي بالأسواق الحضريّة، وتطوير برامج تعليميّة تُعيد إدماج الأطفال والناشئة في عالم الزيتون.[25]
ثانيًا: دعم التعاونيات الرّيفيّة والاقتصاد التّضامني
تشير التّجارب المحليّة في مرجعيون وعكّار إلى أهمية التّعاونيّات، لا فقط كأداة لتوزيع الأرباح، بل كفضاء لإعادة بناء الثقة والروابط الاجتماعية. لذلك، يجب تفعيل دور التعاونيات عبر إعفائها من الرّسوم، وتوفير منصات بيع إلكترونية، وتسهيل مشاركتها في المعارض المحلية والدولية[26].
ثالثًا: تطوير البحث العلمي حول التراث الزراعي
من الضروري الاستثمار في دراسات علميّة متعدّدة التخصصات تدمج بين الجغرافيا، والأنثروبولوجيا، والاقتصاد الزراعي، والبيئة، من أجل فهم معمّق للرهانات المجالية، ورسم خرائط رقميّة تفاعليّة لتوثيق المعارف المحليّة المتصلة بالزيتون، بما يساهم في نقلها للأجيال القادمة[27].
رابعًا: ربط التراث بالتحول المناخي
لا يمكن لأي مشروع مستقبلي للزيتون أن ينجح من دون التكيّف مع التّغيرات المناخيّة. المطلوب هو إدماج تقنيات الزراعة المستدامة، والتحول إلى سلالات أكثر مقاومة للجفاف، وإعادة النظر في ممارسات الريّ والتخزين بما يتناسب مع الظروف البيئية المتغيرة.[28]
خامسًا: نحو سياسة لامركزية تراثيّة عادلة
إن غياب الدولة المركزيّة، كما كشفت الدّراسة، لا يعني غياب الحاجة إلى سياسة وطنية شاملة. بل على العكس، تبرز الحاجة إلى نموذج لامركزي يُعيد توزيع المسؤوليّة بين البلديات، والهيئات الثقافيّة، والتعاونيات، والمجتمع المدني. سياسة تراثية من هذا النوع يجب أن تكون مبنية على العدالة المجالية، فتمنح للمناطق الطرفية الأدوات والموارد لصون تراثها الخاص، بدلًا من إخضاعه لنماذج جاهزة أو تجارية تستنسخ منطق السياحة الاستهلاكيّة أو التسويق الفلكلوري.
في المحصلة، فإن تراث الزيتون في لبنان ليس مجرد شجرة. إنه مرآة لهُوية مجروحة، وقوة مقاومة ناعمة، وفرصة لصياغة مستقبل أكثر عدلًا وارتباطًا بالأرض. ما بين الكورة المترددة، ومرجعيون المتألمة، وعكار الصامدة، تتشكل ملامح مشروع مجالي جديد، لا يقوم على تصدير الماضي، بل على تأصيل المستقبل.
المراجع
- ألتيري، ميغيل. “علم البيئة الزراعية وتغير المناخ”، مجلة الزراعة المستدامة، المجلد 39، العدد 2، 2015، الصفحات 93–106.
- إسكوبار، أرتورو. مجالات الاختلاف: المكان، الحركات، الحياة، الشبكات، مطبعة جامعة ديوك، 2008.
- بارت، رولان. أساطير، باريس: دار سوي، 1957.
- برونيه-جيي، إيمانويل. “المرونة المجالية والحكم التشاركي: أدوات للتكيف الريفي”، مجلة الدراسات الإقليمية، المجلد 55، العدد 2، 2020، الصفحات 231–248.
- بن سلامة، ناصر. “المرونة من القاعدة: قراءة في دور التعاونيات الريفية”، دفاتر السياسات الاجتماعية، 2022، عدد 9، ص. 73–88.
- بيكّور، برنار. التنمية المجالية: إجابة على العولمة؟، باريس: لارماتان، 2006.
- تيل، تيموثي. “شجرة الزيتون كرمز في شرق المتوسط”، مجلة الجغرافيا الثقافية، المجلد 33، العدد 2، 2016، الصفحات 154–166.
- خالد، نادر. “إعادة تأطير التراث في السياسات الثقافية المعاصرة”، دفاتر الجغرافيا الثقافية، 2022، عدد 8، ص. 66–85.
- خوري، جوزيف. التراث كأداة مقاومة: نحو مقاربة نقدية للهوية الثقافية، بيروت: المؤسسة العربية للدراسات، 2020.
- حمادة، علي. “أزمة الزراعة التقليدية في لبنان المعاصر”، الدفاتر اللبنانية للعلوم الاجتماعية، 2019، مجلد 15، ص. 91–114.
- حجازي، نادر. “إعادة تأطير التراث في السياسات الثقافية المعاصرة”، دفاتر الجغرافيا الثقافية، 2022، عدد 8، ص. 66–85.
- خليفة، سارة. “الثقافة والتنمية: رؤية تكاملية من التراث الزراعي”، مجلة الفكر التنموي العربي، 2020، عدد 22، ص. 51–70.
- دارنهوفر، إيرين. “المرونة ولماذا هي مهمة للأنظمة الزراعية”، مجلة دراسات البيئة والعلوم الاجتماعية، المجلد 4، العدد 1، 2014، الصفحات 13–21.
- سِن، أمارتيا. التنمية كحرية، مطبعة جامعة أكسفورد، 1999.
- فواز، ندى. “التراث الزراعي في لبنان: بين الرمزية والتسليع”، مجلة دراسات التنمية الثقافية، 2021، عدد 14، ص. 101–120.
- فليك، أوليفر. مقدمة في البحث الكيفي، لندن: دار ساج، 2014.
- فاو (منظمة الأغذية والزراعة). إنتاج زيت الزيتون وسبل العيش الريفي في المشرق، روما، 2021.
- فاو (منظمة الأغذية والزراعة). زيت الزيتون وتغير المناخ: استراتيجيات التكيّف، روما، 2021.
- ليكان، ماتيو. “رسم خرائط المعارف المحلية: أداة للمرونة الريفية”، مجلة الأقاليم والمجتمعات، 2018، عدد 11، الصفحات 77–92.
الهوامش
1- أستاذة مساعدة الجامعة اللبنانيّة، كلية الآداب والعلوم الإنسانيّة-قسم الجغرافيا.
Assistant Professor at Lebanese university, Faculty of Letters and Human Sciences.Department of Geography.Email:
Cynthianasr33@hotmail.com
[1] – خوري، جوزيف، التراث كأداة مقاومة: نحو مقاربة نقدية للهوية الثقافية، بيروت: المؤسسة العربية للدراسات، 2020، ص. 42.
[2] – غراهام، براين؛ آشوورث، غريغوري؛ تونبريدج، جون، جغرافيا التراث: السلطة، الثقافة، والاقتصاد، لندن: أرنولد، 2000.
[3] – تيل، تيموثي، “شجرة الزيتون كرمز في شرق المتوسط”، مجلة الجغرافيا الثقافية، المجلد 33، العدد 2، 2016، ص. 154–166
[4] – حمادة، علي، “أزمة الزراعة التقليدية في لبنان المعاصر”، الدفاتر اللبنانية للعلوم الاجتماعية، المجلد 15، 2019، ص. 91–114
[5] – دارنهوفر، إيرين، “المرونة ولماذا هي مهمة للأنظمة الزراعية”، مجلة دراسات البيئة والعلوم الاجتماعية، المجلد 4، العدد 1، 2014، ص. 13–21
[6] -بيكور، برنار، التنمية المجالية: إجابة على العولمة؟، باريس: لارماتان، 2006، ص. 87–10
[7] – هارفي، ديفيد، فضاءات الأمل، مطبعة جامعة كاليفورنيا، 2000، ص. 112–126.
[8] – بارت، رولان، أساطير، باريس: سوي، 1957.
[9] – منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو)، إنتاج زيت الزيتون وسبل العيش الريفي في المشرق، روما، 2021.
[10] -فليك، أوليفر، مقدمة في البحث الكيفي، لندن: دار ساج، 2014.
[11] -إسكوبار، أرتورو، مجالات الاختلاف: المكان، الحركات، الحياة، الشبكات، مطبعة جامعة ديوك، 2008، ص. 84–92
[12] -مقابلة ميدانية مع مزارع في بشمزّين، الكورة، 4 تشرين الثاني 2023.
[13] -ملاحظات الباحث خلال موسم القطاف، الكورة، 2023.
[14] -مقابلة مع رجل مسن في الخيام، مرجعيون، 12 تشرين الثاني 2023
[15] -مقابلة مع عضوة في جمعية نسائية، عديسة، 15 تشرين الثاني 2023.
[16] -مقابلة ميدانية في فنيدق، عكار، 22 تشرين الثاني 2023.
[17] -مقابلة مع مزارع يستخدم معصرة تقليدية، الشيخ طابا، 24 تشرين الثاني 2023
[18] -مقابلة مع شاب مزارع، مشمش، 26 تشرين الثاني 2023.
[19] -فواز، ندى، “التراث الزراعي في لبنان: بين الرمزية والتسليع”، مجلة دراسات التنمية الثقافية، العدد 14، 2021، ص. 101–120.
[20] -رونيه جيي، إيمانويل، “المرونة المجالية والحكم التشاركي: أدوات للتكيف الريفي”، مجلة الدراسات الإقليمية، المجلد 55، العدد 2، 2020، ص. 231–248
[21] -بن سلامة، ناصر، “المرونة من القاعدة: قراءة في دور التعاونيات الريفية”، دفاتر السياسات الاجتماعية، العدد 9، 2022، ص. 73–88.
[22] -ألتيري، ميغيل، “علم البيئة الزراعية وتغير المناخ”، مجلة الزراعة المستدامة، المجلد 39، العدد 2، 2015، ص. 93–106.
[23] -حجازي، نادر، “إعادة تأطير التراث في السياسات الثقافية المعاصرة”، دفاتر الجغرافيا الثقافية، العدد 8، 2022، ص. 66–85.
[24] -سِن، أمارتيا، التنمية كحرية، مطبعة جامعة أكسفورد، 1999، ص. 143–159.
[25] -خليفة، سارة، “الثقافة والتنمية: رؤية تكاملية من التراث الزراعي”، مجلة الفكر التنموي العربي، العدد 22، 2020، ص. 51–70.
[26] -مقابلات ميدانية مع تعاونيات نسائية في مرجعيون وعكار، تشرين الثاني 2023.
[27] -ليكان، ماتيو، “رسم خرائط المعارف المحلية: أداة للمرونة الريفية”، مجلة الأقاليم والمجتمعات، العدد 11، 2018، ص. 77–92
[28] – منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو)، زيت الزيتون وتغير المناخ: استراتيجيات التكيّف، روما، 2021.