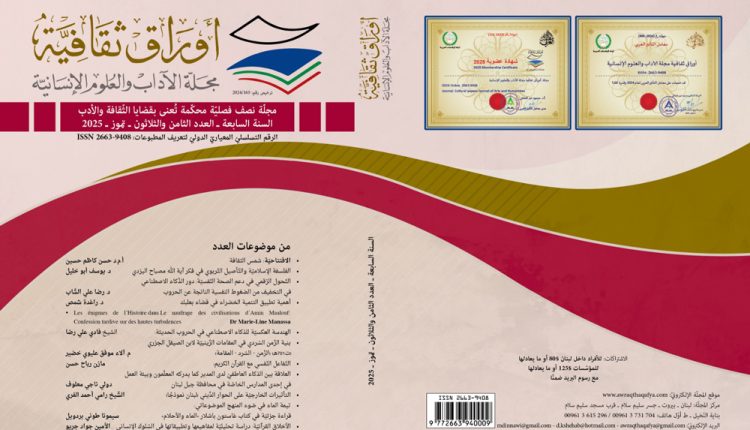عنوان البحث: تجليّات الغرائبيّة في رواية «الملك في بيجامته
اسم الكاتب: م.د. محمد غركان سرحان
تاريخ النشر: 2025/07/16
اسم المجلة: مجلة أوراق ثقافية
تحميل البحث بصيغة PDFADOI: https://aif-doi.org/awraq/013824
تجليّات الغرائبيّة في رواية “الملك في بيجامته”
“Manifestations of the Fantastic in the Novel The King in His Pajamas“
Dr. Mohammed Gharkan Sarhan م.د. محمد غركان سرحان)[1] (
تاريخ الإرسال:24-6-2025 تاريخ القبول:1-7-2025
الملخص
تُعدّ الغرائبيّة إحدى السّمات البارزة في الموروث الشّعبي، ولا سيما في المتون الحكائيّة العربيّة التّقليديّة، غير أنّها في السّرد الرّوائي الحديث والمعاصر، قد اكتسبت دلالات جديدة تجاوزت أطرها التّراثيّة الضيقة، فانفتحت على مصادر متعددة، شملت التّراث العربي القديم، إلى جانب التّراث الغربي بشقيّه الكلاسيكي والحديث. ويمكن القول إنّ الغرائبيّة في الرّواية العربية الحديثة والمعاصرة تنهل من مختلف ينابيع التّراث الإنساني، ما يمنحها طاقات تأويلية متعددة، وأبعادًا قرائية متجددة. وانطلاقًا من هذا الأفق، تم اختيار موضوع: “الغرائبيّة في رواية الملك في بيجامته”، لما ينطوي عليه العنوان من مفارقة دالّة وغرابة سرديّة تستدعي التأمل، إذ يُستثمر الخيال لتوصيف هيئة غير مألوفة للملك، وهو ما يفتح المجال لاستكشاف حضور الغرائبيّة كظاهرة أسلوبيّة ومضمونيّة بارزة في المتن السّردي العربي المعاصر. ويسعى البحث إلى تبيّن الفروق الدّقيقة بين ما هو واقعي وما هو تخييلي يلامس حدود العجائبي والمثير للدهشة، في ضوء تحولات السّرد العربي الحديث واتكائه على مقومات فنيّة وجماليّة جديدة.
الكلمات المفتاحيّة : الغرائبيّة ، الرّواية ، “الملك في بيجامته” .

Abstract
The element of the fantastic (al-ghara’ibiyya) is one of the most prominent features of popular heritage, especially within traditional Arab narrative texts. However, in modern and contemporary narrative discourse, it has acquired new connotations that go beyond its narrow traditional frameworks, opening up to multiple sources, including classical and modern Arab heritage as well as Western traditions. It can be said that the fantastic in modern and contemporary Arabic novels draws from various wells of human heritage, granting it diverse interpretive potentials and renewed reading dimensions. From this perspective, the study focuses on the theme of “The Fantastic in the Novel The King in His Pajamas,” given the title’s suggestive paradox and narrative strangeness that invite critical reflection. The narrative employs imagination to depict an unusual portrayal of the king, offering a space to explore the fantastic as both a stylistic and thematic phenomenon within contemporary Arabic narrative. This study also aims to distinguish the subtle boundaries between realism and imaginative fiction that approach the limits of the marvelous and the uncanny, in light of the transformations in modern Arabic narrative and its reliance on new artistic and aesthetic components.
Keywords: The Fantastic, Novel, The King in His Pajamas.
أولاً: الغرائبيّة: المفهوم والإشكالية
تُعدّ الغرائبيّة من المصطلحات السّردية الحديثة التي برزت بقوة في فضاء الرّواية على الرّغم من امتداد جذورها العميقة في التّراثين العربي والعالمي، إذ تتجلى مظاهرها في مختلف تجليات الحياة، سواء في المعيش اليومي للفرد بما يحمله من خيال وأحلام يقظة، أو في مستوياته الفكرية الأعمق التي تحكمها هواجس وجودية ورغبات استباقية في كسر النسق المألوف، وتحطيم نماذج الإدراك التّقليديّة للواقع (Denis Mellier, 2000, p.4).
ينطلق هذا البحث من محاولة الوقوف عند مفهوم الغرائبيّة في السّياق الأدبي، ولا سيما في الرّواية، بوصفها جنسًا أدبيًا يستعصي على التّحديد الدّقيق حين يتعلق الأمر بالخيال من جهة، أو بتلقي القارئ من جهة أخرى. فالمفارقة تكمن في أنّ الغرائبيّة لا تستقيم كمفهوم إلّا ضمن تفاعلها الجدلي مع الواقع، ومع وعي المتلقي وحدود توقعاته.
ويُعدّ كتاب تزفيتان تودوروف “مدخل إلى الأدب العجائبي” (Introduction à la Littérature Fantastique) من أبرز المراجع النّقدية التي نظّرت للغرائبي والعجائبي، وحددت له أطرًا مفهوميّة ومعايير نظرية وتطبيقيّة واضحة. وفي هذا السّياق، تشير القواميس التّاريخيّة للغة الفرنسيّة إلى أنّ أصل لفظة Fantastique يعود إلى الكلمة اللاتينيّة Phantasticus، بما تحمله من دلالة على ما هو متخيَّل وخارج عن دائرة المعقول (Denis Labbé et Gilbert Millet, 2000, p.5).
وتدلّ الغرائبيّة، في معناها العام، على اختراق حواجز الواقع، ومجاوزة منطق المعقول، والانفتاح على فضاءات التّخييل التي تسبق الواقع أو تُعيد تشكيله. وقد يكون هذا التّشكيل استباقًا سلبيًا عبر الارتحال نحو الشّاذ والغريب، أو إيجابيًا عبر الانفلات من قيود المنطق والعرف. وهي بهذا المعنى تُعدّ فسحة تحرّر إبداعي، يجد فيها الكاتب متنفّسًا للتعبير عن هواجسه وأفكاره، بعيدًا من الأطر المعياريّة الضاغطة (تودوروف، 1994، ص: 44).
ولا تكتمل ملامح الغرائبيّة بوصفها مفهومًا نظريًا من دون الوقوف على الحدّين المرتبطين بها، وهما: العجيب والغريب، اللذان شكّلا محورًا أساسًا في تصوّر تزفيتان تودوروف Tzvetan Todorov للعجائبي. ويُعرّف تودوروف (1994، ص: 44) العجيب أنّه ذلك النّمط السّردي الذي تبدو فيه الأحداث، طيلة النّص، خارقة للطبيعة، لكنها تحظى في نهايته بتفسير عقلاني منطقي، ما يعيدها إلى دائرة الممكن والمقبول.
أمّا الغريب، فيراه تودوروف ذلك الذي يُبقي على الطابع الفوق-طبيعي للحدث، من دون أن يسعى إلى تأويله أو تفسيره تفسيرًا عقلانيًا، بل يتركه قائمًا بذاته، ما يضفي على النّص جوًا من التّوتر والالتباس، ويجعل المتلقي في حالة تردّد وتأرجح بين تفسير عقلاني غريب وبين تسليم تام باللامعقول.
وعلى هذا الأساس، يجعل تودوروف الغرائبي حالة وسطى بين العجيب والغريب، فيقع المتلقي في لحظة بالحيرة، يتأرجح خلالها بين قبول التأويل الطبيعي وبين التّسليم بالخرق الفوق-طبيعي. وهذه اللحظة الفاصلة هي ما يمنح الغرائبيّة خصوصيتها وفرادتها السّرديّة.
ومن خلال هذا التّمييز المفاهيمي، يبدو أن الفروق بين العجيب والغريب تتضاءل أحيانًا إلى درجة التداخل، بل تكاد تصل إلى حدّ الترادف في بعض السّياقات. ويُلاحظ أنّ مصطلح “الغريب” (L’étrange) قد تبلور معالمه في اللغة الفرنسيّة منذ القرن الحادي عشر، وهو مشتق من الأصل اللاتيني Extraneus الذي يشير إلى ما هو “خارجي”، ثم تطوّر لاحقًا ليشمل كل ما هو خارج عن المألوف والمتداول.
أمّا مصطلح “العجيب” (Merveilleux أو Mirabilia)، فترسّخ في السّياقات اللغويّة نفسها خلال المدّة ذاتها، وهو مشتق من الأصل اللاتيني Mirabilia الذي يدل على ما هو مدهش ومثير للذهول، وقد ارتبط في بداياته بمعجزات المسيحيّة اللاتينيّة، قبل أن يتوسع في الدّلالة ليشمل كل ما هو خارق ومثير وغير مألوف.
إنّ مصطلح “العجائبيّة” أو “العجائبي” لا يُعدّ مجرد استعارة لمفهوم وافد من النقد الغربي، بل هو محاولة لإحداث تواطؤ منهجي بين التصوّر الذي قدّمه تزفيتان تودوروف Tzvetan Todorov ضمن إطاره النّظري في الأدب الغربي، وبين المقاربة العربية التي، وإن لم تنضبط تمامًا بمحددات تودوروف الصّارمة، إلّا أنّها تمتلك من الثراء والتنوع في المرجعيّات والرؤى ما يُتيح لها استيعاب ذلك النّموذج الغربي، بل وتجاوزه في كثير من الأحيان.
فبعيدًا من الإرث التّراثي العربي الغني بصوره وأخيلته ومشاهده العجائبيّة المتنوعة، من أساطير ومرويّات شعبيّة وخرافات وسير بطوليّة، فإنّ الرّواية العربيّة المعاصرة لم تكن بمنأى عن هذا التّوظيف العجائبي، بل انخرطت فيه بوعي جديد، يُعيد تشكيل الموروث ضمن رؤى تجريبيّة حداثيّة. وهذا ما يتجلى بوضوح في رواية “الملك في بيجامته”، إذ يُقدّم خضير فليح الزيدي مشاهد غرائبيّة تنزاح عن المألوف الواقعي، وتستثمر عناصر سرديّة غير نمطيّة.
ففي مقطع دالّ من الرّواية، يصف الزيدي وطن البطل بقوله: “وطنه كان خشبة المرقص، والحياة عنده مؤخرة راقصة… حيث تحققت النبوءة بعد أكثر من نصف قرن تقريبًا… حين تفاقمت الجرذان بعد إدانة (قره تبي) وشنقه بحبل لم تمسّه الجرذان… فتمَّ الاتفاق على النّسبة: لكل فرد جرة واحدة لا غير… فإذا كان هناك سبعة ملايين فرد في بغداد، فستكون حصتهم سبعة ملايين من الجرذان السود بالتمام، هي الحصة العادلة” (الزيدي، 2018، ص: 9).
إنّ هذا المشهد، بما يحتويه من توظيف رمزي للجرذان، يُقدّم تمثّلًا غرائبيًا للواقع، يبتعد من العفويّة والتّلقائيّة المعهودة في الموروث الشّعبي، ويتجه نحو تشكيل سردي جديد يتكئ على الرّمز والتكثيف والدلالة العميقة. ففي إطار نزوعه التجريبي، يسعى الروائي المعاصر إلى استلهام عجائب الموروث، لا بوصفها زينة سرديّة، بل بوصفها أدوات فنيّة لإعادة بناء الواقع وتفكيك أنساقه.
وعليه، فإنّ من الضروري ألا يُقارب مفهوم الغرائبيّة ضمن حدود ضيّقة أو تعريفات مغلقة، بل ينبغي النّظر إليه بوصفه فضاءً مرنًا، يتسع لتجليات متعددة ومتنوعة تختلف باختلاف السّياقات الإبداعيّة، وتتماهى مع رؤى الكتّاب وهواجسهم وتخيلاتهم المركبة. فلكل عمل أدبي أسراره وخصوصيته، ولكل تجربة سردية طاقاتها المتجددة التي تستعصي على الحصر والتّصنيف.
سعى عدد من الكتّاب العرب في العقود الأخيرة إلى إعادة تشكيل بنية الرّواية العربيّة، عبر تجديد أسسها الفنيّة وتحديث طرائقها التّعبيريّة، وتأسيس أنماط سرديّة مبتكرة تنأى عن المبنى التّقليدي للمحكي، متحرّرة من القيود الكلاسيكيّة الصّارمة. وفي هذا السّياق، برز العجائبي بوصفه “بؤرة الخيال الخلّاق” التي تمكّن الكاتب من تجاوز حدود المعقول والمنطقيّ والتاريخيّ والواقعيّ، لصالح قوّة مركزيّة واحدة: قوّة الخيال المبدع الذي يتعامل مع الوجود بشعور مطلق بالحريّة، يعيد من خلاله تشكيل العالم وفاق تصورات ذاتيّة لا تخضع للإكراهات الموضوعيّة أو الرغبات العابرة (أبو ديب، 2007، ص: 8).
ويؤكّد ميخائيل باختين Mikhail Bakhtin في هذا السّياق، أنّ الرّواية لا تزال عصيّة على التّعريف، بالنّظر إلى ديناميتها وتطوّرها المستمر، إذ يرى أنّ: “تعريف الرّواية لم يجد جوابًا بعد، بسبب تطورها الدّائم” (باختين، 1982، ص: 66). ومن زاوية مغايرة، يشير لوسيان غولدمان Lucien Goldman إلى أنّ هذا الشّكل الأدبي أعاد النّظر في القوالب كافة والتي استقر فيها سابقًا، إذ غدت الرّواية المعاصرة كيانًا متحوّلًا، يتّسم بالانفتاح على أشكال تعبيريّة متعدّدة، ويستقي مادته من التّراث الإنساني العريق، ومن الأساطير والحكايات التي تضرب بجذورها في أعماق الزّمن.
وقد أفضى هذا الانفتاح إلى تحطيم الحدود الفاصلة بين الأجناس الأدبيّة، ما أضفى على الرّواية طابعًا شموليًا، وجعلها وسيطًا للتفكير في الأسئلة الوجوديّة والفلسفيّة الكبرى، بلغة تجمع بين الشّعريّة والتّأمل، وبين الإبداع والتّحليل. ويذهب الكبير الدّاديسي إلى أنّ الرّواية المعاصرة باتت “تتميّز برؤية عميقة للوجود، وإثارة لمجموعة من الأسئلة والأفكار الكبرى بلغة شعريّة، والانفتاح على التّاريخيّ والفلسفيّ، ومحاورته بأسلوب جديد ومن منظور حداثي محض” (الداديسي، 2018، ص: 13). وقد أدّى هذا التّحول إلى صعود الرّواية على حساب الشّعر، حتى غدت الرّواية هي الشّكل الأدبي الأبرز في المشهد الثقافي العربي، بل وقاطرة الإبداع الأدبي بلا منازع.
لقد قطعت الرّواية العربيّة مسارًا تحويليًا طويلًا، بدأ من التأثر بالأنماط الكلاسيكيّة، وانتهى إلى محاكاة الاتجاهات السّرديّة العالميّة في طروحاتها ومقارباتها، ما أدخلها في مسارات معقدة من التّجريب والتّحديث، يصعب على النقد مواكبتها بكليتها، سواء على مستوى الرؤية أو الشّكل أو البنية الجماليّة.
إنّ صعوبة الإحاطة بهذا الجنس الأدبي (الرّواية) على المستويين التحليلي والنقدي تعود بالأساس إلى طبيعته المتفلّتة والمتغيّرة باستمرار، وهي سمة جعلت منه نوعًا فنيًا عصيًّا على التصنيف، إذ يتميّز – كما يشير عبد المالك أشهبون – بـ”طابع زئبقي منفلت ومتحوّل، يجعله مغايرًا مقارنةً مع غيره من الأجناس الأدبيّة كالقصيدة أو المسرحيّة أو القصة القصيرة” (أشهبون، 2007، ص: 7). ما يعني أنّ هذا الجنس السّردي لم يستكمل بعد بنيته الفنيّة النهائيّة، بل لا يزال في طور التحوّل والانفتاح على آفاق جماليّة وفكرية متجدّدة، ما يمنحه طابعًا إشكاليًّا دائمًا في الزّمان والمكان.
وتكمن إحدى التّحديات في هذا الحقل السّردي في تداخله المفاهيمي، وخصوصًا بين مصطلحي الغرائبي والعجائبي اللذين غالبًا ما يتعذّر التّمييز الدقيق بينهما من دون استحضار دور القارئ وثقافته التّأويليّة. في هذا السّياق، توضح سناء شعلان أنّ: “التّمييز بين السرد الغرائبي والعجائبي يقوم أساسًا على حالة التردّد التي يعيشها القارئ إزاء تصديق الحدث السّردي، فإن قرر القارئ أنّ قوانين العالم الواقعي لا تزال سارية وتفسّر ما يحدث، فهو أمام سرد غرائبي، أمّا إذا اقتنع بضرورة تبنّي قوانين جديدة لفهم الظواهر، فهو قد دخل في السّرد العجائبي” (شعلان، 2002، ص: 11). وهنا، تؤدي الخلفيّة الثقافيّة والتّراثيّة دورًا حاسمًا في هذا التّحديد، فالقبول بوجود “بساط طائر” مثلًا في “ألف ليلة وليلة” يُعدّ أمرًا عاديًّا ضمن السّياق الثقافي العربي، لكنه يُنظر إليه على أنّه حدث عجائبي في ثقافات أخرى.
وتتجلّى هذه الرؤية بوضوح في رواية “الملك في بيجامته”، إذ يعمد السّرد إلى توظيف الحيوان – وتحديدًا الجرذان – في سياقات مغايرة لوظيفتها الاعتياديّة الواقعيّة، متجاوزًا بذلك منطق التّمثيل الطبيعي إلى ما هو رمزيّ وعجائبيّ. إذ يكتب خضير فليح الزيدي: “خرجت الجرذان دفعة واحدة من ساحة الميدان حتى الباب الشّرقي العتيد تهتف للوباء وتنذر بالثورة… نعم، كانت جرذان سود، كلّ واحد منها يزن ما يقارب 5 كغ، فكيف للقطط أن تصمد أمامها؟ إنّها الثورة الكبرى، والعلامة على انهيار الهدنة المعلنة بين الأفراد والجرذان…” (الزيدي، 2018، ص: 11).
هنا، لا تُستخدم الجرذان بوصفها عناصر واقعيّة، بل تُوظَّف كرموز مشحونة بدلالات سياسيّة واجتماعيّة وثقافيّة، تؤسّس لمشهد غرائبي عجائبي في آن، يختلط فيه الواقعي بالمتخيّل، والممكن بالمستبعد، في توليفة سرديّة تعكس انهيار الحدود بين الإنسان والرّمز، بين الواقع والأسطورة.
يمكن تفسير هذا التّوجه نحو الكتابة الغرائبيّة والعجائبيّة بوصفه نزوعًا إلى كسر نماذج الواقعيّة التّقليديّة، والانفتاح على أساليب جديدة للتّرميز وتمرير الرّسائل النقديّة الاجتماعيّة والسياسيّة والدّينيّة، كما أشار تودوروف Todorov في قوله: “الاهتمام بالنّزوع إلى تكسير قالب الواقعيّة الضيّقة، والبحث عن طرائق الترميز وتمرير الانتقادات الاجتماعيّة والسياسيّة والدّينيّة” (تودوروف، تقديم محمد برادة، ص: 5). وهو ما يلتقي مع التّصوّر التّراثي العربي لما هو “غريب”، إذ عرّفه الرّاغب الأصفهاني أنّه: “كل أمر عجيب قليل الوقوع، مخالف للعادات المعهودة والمشاهدات المألوفة” (الأصفهاني، ص: 322).
يؤدي في هذا السّياق حضور العناصر العجائبيّة في النّصوص الروائيّة دورًا مركزيًا في توليد الأثر النّفسي الخاص في المتلقي، سواء من خلال إثارة مشاعر الخوف أو الهول أو الدهشة، وهو ما لا تقدر أجناس أدبيّة أخرى على بلوغه بالدّرجة نفسها. ويشير تودوروف Todorov: “العجائبي يخدم السّرد ويحتفظ بالتوتر، إذًا لحضور العناصر العجائبيّة يتيح تنظيمًا للحبكة، مكثفًا بصورة خاصة” (تودوروف، ص: 95).
وقد كان لتوظيف الغرائبي والعجائبي أثر واضح في تطور البنية السّردية لجنس الرّواية والقصة معًا، خاصة في الأدب الحديث، إذ بات هذا النّوع من الكتابة أحد أبرز الأساليب التي تستقطب كتّابًا وجماهير على حدّ سواء، لما يتيحه من إمكانات سرديّة وجماليّة واسعة، ولقدرته على إعادة تشكيل العالم، والانفلات من قيود المنطق والواقع. وقد أفرز هذا التّوجه مجموعة من الإبداعات العالميّة البارزة التي وظفت هذا الأسلوب بفاعلية، مثل:
- “مئة عام من العزلة” لـ غابرييل غارسيا ماركيز.
- “المسخ” لـ فرانز كافكا.
- “أليس في بلاد العجائب” لـ لويس كارول.
وغيرها من الأعمال التي باتت تشكّل علامات فارقة في الأدب العالمي، لما تحمله من قدرة على استيعاب العجائبي كآلية سرديّة وأداة تأويلية عميقة.
وعلى الصعيد العربي، شهد الأدب الحديث حضورًا متناميًا لهذا الاتجاه، فبرزت أعمال عديدة جعلت من العجائبي والغرائبي محورًا رئيسًا في تشكيل عوالمها السّردية، نذكر منها:
- “السّلحفاة تطير” لـ يحيى حقي.
- “الزّمن الآخر” لـ إدوار الخراط.
- “الملك في بيجامته” لـ خضير فليح الزيدي.
- “بيضة الديك” لـ محمد زفزاف.
وغيرها من النّصوص التي تستثمر هذا النّوع السّردي كأداة لكسر المألوف، وإعادة بناء الواقع من منظور فني رمزي واستعاري.
وقد أشار غاستون باشلار Gaston Bachelard إلى أحد الأبعاد الجوهريّة في التّلقي العجائبي حين قال: “إنّها تعيد للمرء حسن الدّهشة الذي يكتشف به الطفل الحقائق لأوّل مرة”، في حين يرى تزفيتان تودوروف Tzvetan Todorov أنّ العجائبية تمثل: “تردّد كائن لا يعرف سوى القوانين الطبيعية أمام حادث له صبغة فوق طبيعيّة”، بينما يذهب بيسيير Bissière إلى أنّ: “الأدب الغرائبي يضطلع بمزج اللاواقعيّة بواقعية ثانية” (الداديسي، الكبير، 2018، ص: 62). هذا التّداخل بين الواقعي واللامعقول، بين التاريخي والافتراضي، هو ما يشكّل جوهر الكتابة العجائبيّة، ويفتح النّص الروائي على مستويات متعددة من التأويل، ويمنح السرد طاقة تخييليّة غير محدودة.
وفي هذا السّياق، يمكن عدُّ رواية “الملك في بيجامته” للروائي خضير فليح الزيدي نموذجًا لافتًا لهذا النّوع من السّرد، لما تتضمنه من قدرة فنيّة على رصد تحولات الواقع العربي الراهن، والتقاط إيقاع العصر في صيرورته وتحولاته، وذلك من خلال ربط الراهن بالتّاريخي، وتفكيك البنية الرّسميّة للحدث، والانفتاح على توظيف الذّاكرة والمخيال والتوثيق في آنٍ معًا.
فالرّواية تتناول بتقنيات سرديّة متعددة مجزرة قصر الرّحاب (1958) التي راح ضحيتها الملك فيصل الثاني وعدد من رموز العائلة المالكة، إذ يقدّم الزيدي سردًا استقصائيًا مفتوحًا على الاحتمالات، متحررًا من خطيّة الزّمن، معتمدًا على نسق زمني متداخل، يتيح إعادة قراءة الحدث لا بوصفه مجرّد واقعة تاريخيّة، بل بوصفه تيمة فنية قابلة للتشكيل الجمالي وإعادة التّخييل.
إنّ إعادة بناء الحدث التّاريخي وفاق منظور سردي روائي، تمثل فعل تفكيك للخطاب الرسمي، ومحاولة لكشف المسكوت عنه والمُغفَل بفعل خطاب السّلطة التي عادةً ما تعمل على إنتاج تاريخ مؤدلج ومهيمن، محكوم بمنطق التبرير والتّجميل والتّعتيم. وفي هذا الإطار، يمارس الروائي وظيفة مزدوجة: استقصائيّة وفنيّة، تجمع بين التّوثيق المتخيل والقراءة التّأمليّة النّاقدة.
ويظهر هذا المنحى بوضوح في المقطع الذي يقول فيه الزّيدي:
“مع حلول الظلام ثمّة عزف عود منفرد؛ أظنّها مقطوعة (شلالات) الشّائعة والمثيرة للحواس الخاملة للموسيقار العراقي الراحل جميل بشير. هكذا يتحوّل ماضينا على المسرح من سلّة أشواك لا روح فيها، إلى طبق فاكهة لذيذة على الرّغم من سوء لحظته تحت سطوة الإحساس المتدفق…” (الزيدي، 2018، ص: 33).
فالماضي هنا لا يُستعاد بوصفه معطًى ثابتًا، بل بوصفه مادة جماليّة قابلة للتّشكيل الدّرامي، شرط أن تُستعاد وفاق منظور نقدي ـ جمالي حديث، كما ورد في قول إحدى شخصيات الرّواية: “روعة التمثيل الدّرامي تتجسد بتلبّس الشخصية وشدة التقمص، لكن هذا التقمص سيفسد رواية التاريخ مهما كانت دقته، إلّا إذا تبنّى نظرية الاستعادة التّاريخيّة الجديدة للحدث”.
من هنا، تتحول الرّواية إلى فضاء مفتوح لإعادة التفكير بالتّاريخ والواقع، ضمن بنية سرديّة تتقاطع فيها العجائبيّة مع الرؤية النقديّة والخيال الخلّاق، بما يجعل من العمل الفني وثيقة بديلة، ولكن بوسائل فنية تُجابه الوثيقة الرّسميّة لا من باب التوثيق الجامد، بل من باب المساءلة الجماليّة والرّمزيّة.
قبل أن يكشف الزيدي نتائج تحرياته بشأن أحداث الرابع عشر من تموز 1958 التي أنهت العهد الملكي المتمثل بـ”السدارة السوداء”، وفتحت الباب أمام العهد الجمهوري الذي مثّله بـ”البيرية”، يعمل على تشييد فضاء روائي يستعيد تفاصيل الحياة اليوميّة في ظل النّظام الملكي. هذه الحياة، كما يصورها، كانت تتسم بالمدنيّة والبساطة والهدوء النّسبي، وشهدت انفتاحًا ثقافيًا واقتصاديًا تمثّل بوجود المسارح، ودور السّينما، والمقاهي، ومظاهر الفنّ، على الرّغم من الاضطرابات السياسيّة، وانتشار الفقر والأُميّة، وغياب كثير من شروط العيش الكريم لدى قطاعات واسعة من الشّعب.
في ظل هذه الخلفيّة التي تشكّل السّياق التاريخي والمادي لأفكار الرّواية، تصبح مجزرة قصر الرّحاب لحظة فاصلة في الذاكرة العراقيّة، إذ مثّلت نهاية لعهد مدني، وبداية لمرحلة مضطربة غلبت عليها الانقلابات العسكريّة، والعنف الدّموي، والتّصفيات الجسديّة، ونبش القبور، والسّحل في الشّوارع، إضافة إلى تصاعد التوترات القوميّة والطائفيّة والعرقيّة.
وقد نجح الزيدي في استخدام التّمثيل الرّمزي لتجسيد هذا الخراب، من خلال نبوءة شخصيّة “جميل قره تبي” ـ أحد المحاور المركزيّة في الرّواية ـ بظهور “وباء بغداد الأسود” الذي يرمز إلى انفجار الفوضى بعد سقوط “السّدارة” واعتلاء “البيرية”. هذا الوباء تمثّل في اجتياح الجرذان لشوارع بغداد، وفتكها بالفقراء، وكأنّها تجسيد مرعب لانهيار التّوازن الاجتماعي والسياسي.
استعرض الزيدي هذه الأحداث من خلال رموز سرديّة غرائبيّة مشحونة بالتأويل، على غرار حكاية “فواخت” التي فرت من القصر بعد سماع دوي الرصاص، الذي أطلقه “العباسي”، النّقيب المتهم بتصفية العائلة المالكة، بزعم الحماسة الفرديّة لا الأوامر المسبقة، وهي رواية حاول الانقلابيون ترويجها لتبرئة أنفسهم. إلّا أنّ الزّيدي يعيد مساءلة هذه الرّواية من خلال محاكمة رمزيّة لأحد الشّخصيات التي يُفترض أنّها كانت ضمن المتورطين، فيُظهرها تبرر مأساتها بعبارات غرائبيّة مدهشة: “لم أزرها في حياتي. علاقتي الوحيدة بالراقصة فقط. أحبّ الرّقص، هذه جريمتي، حاكموني عليها فقط… لم يأت في الشرائع ما يحرّمه… هذه جريمتي فقط، من أجلها ضاع عمري، سيدي القاضي” (الزيدي، ص: 8).
وبذلك، يمزج الزيدي بين الغرائبي والتّاريخي، ليفضح المقموع والمسكوت عنه، ويُقدّم رؤية سرديّة جديدة تستقصي الماضي لا من أجل تمجيده، بل لتفكيكه وفهم امتداداته الرّاهنة.
تشكل الخطابات الروائيّة العجائبيّة نصوصًا تخيلية تتمايز بين العجيب والغريب، وبين الوهم والواقع، وبين المنطق واللامعقول، وبين الانسجام وعدم الانسجام. تعتمد هذه النّصوص على أحداث غير مألوفة ومدهشة تُثير حالة من التّردد لدى الشّخصيات الرّئيسة وغيرها من الشّخصيات، وتشمل القارئ الذي يجد نفسه في موقف حيرة أمام غموض وغرابة تلك الأحداث، محاولًا إيجاد تفسير لها، سواء أكان طبيعيًا أو خارقًا للطبيعة. ويُعد هذا التّفسير هو العنصر الحاسم الذي يُنهي حالة الغرابة، ويُخرج النّص من دائرة الفانتازيا، وهو ما يتجلى بوضوح في رواية “الملك في بيجامته”.
استند الروائي خضير فليح الزيدي في بناء روايته إلى ثلاث مرويات رئيسة شكّلت أركانًا متينة في الهيكل السّردي للرواية وخطابها الحكائي. تتمثل المرويّة الأولى في سرد الراوي “خالد الشّيخ” الذي يضطلع بدور السّارد العليم والمؤلف الضمني، الباحث والمنقب عن التّفاصيل كلّها المتعلقة بانقلاب 14 تموز 1958 الذي أودى بحياة العائلة الهاشميّة الحاكمة في العراق.
أمّا المروية الثانية فتتعلق بالأحداث التي دارت قبل المسرحية وبعدها والتي جُهِزت لاستعادة ذكرى الانقلاب، بينما تمثل المروية الثالثة السّجل الرّسمي التّوثيقي للوقائع. بناءً على ذلك، توزعت فصول الرّواية بشكل متناوب بين هذه المرويات الثلاث.
وبالإضافة إلى ذلك، تُوزعت الأبواب والمقاطع والمشاهد المتفرقة على امتداد الرّواية التي تبلغ حوالي 280 صفحة من القطع المتوسط، إذ شكّلت هذه الأجزاء الخلفيّة السياسيّة والثقافيّة والأخلاقيّة لتلك المأساة، مقدمة شرحًا وتأهيلًا لفهم أبعاد تلك الأحداث المرعبة والتي صاغت مصير بلد لا يزال يعاني من تبعاتها حتى اليوم.
اعتمد خضير الزيدي في روايته “الملك في بجامته” (الصّادرة عن دار الرافدين، 2018) على تقنية “المخطوطة”، وهي حيلة سرديّة يُعهد فيها إلى إحدى شخصيات العمل بمهمة إكمال رواية غير مكتملة لكاتب مغمور متوفى، وذلك بتحويلها إلى نص مسرحي يتناول واقعة مجزرة قصر الرّحاب وإعدام “القره تبي”، مع إدخال تعديلات وإضافات فنيّة. وتتوزع مهمة السّرد في النّص بين رواة متعددين، منهم راوٍ خارجي يتكفّل برسم معالم الفضاء الرّوائي عبر تقديم تفاصيل دقيقة من يوميات الحياة البغداديّة، تشمل أسماء الشّوارع والأحياء والسّاحات والمقاهي والملاهي، بالإضافة إلى أسماء المغنين والرّاقصات والشّخصيّات السياسيّة، بما يسهم في تجسيد البنية الزّمانيّة والمكانيّة للنص.
ويحيل عنوان الرّواية إلى علاقة سرديّة مع لحظة دراميّة حاسمة في التّاريخ العراقي الحديث، تتمثل في الإطاحة بالنّظام الملكي عبر انقلاب دموي ما تزال الآراء منقسمة بشأنه بين من يراه ثورة وبين من يراه مجزرة سياسيّة. غير أنّ الكاتب يعقد هذه الصّلة التّاريخيّة من خلال أسلوب سردي شاع في الأدب العراقي منذ تسعينيات القرن العشرين، يتمثل في استدعاء “المخطوط” بوصفه وثيقة مفقودة أو منسيّة، تكشف وقائع غير متوقعة، ما يُدخل القارئ في تداخل سردي بين نصّ المخطوط الأصلي الذي دوّنه كاتب مغمور يُدعى “عماد الآغا”، والنصّ الذي يقوم كاتب محترف يُدعى “خالد الشيخ” باستكماله عبر إتمام فصله الأخير.
وبين هذين المستويين من السّرد، تتداخل بنية ثالثة متمثلة في إعداد عمل مسرحي داخل أكاديميّة الفنون، يُستلهم من نصّ الرّواية الأصليّة، ويُكلّف خالد الشّيخ بالإشراف على إعداده. غير أنّ هذا التّداخل بين الرّواية والمخطوط والمسرحيّة، يُفضي في نهاية المطاف إلى تفكك نسبي في الحبكة، إذ يفقد الروائي السّيطرة على خيوط السّرد، ويتحوّل النّص إلى أشبه بتحقيق صحفي أكثر من كونه سردًا روائيًا متماسكًا، لا سيما في عرضه للأحداث التّاريخيّة، ما ينعكس على بنية الحبكة التي تتخذ طابعًا متقطعًا، وتلجأ إلى تقنيات التقديم والتأخير والمراوحة الزّمنيّة، في سبيل ربط الأحداث المتباعدة داخل توليفة سرديّة مركّبة.
تُثار في سياق قراءة رواية “الملك في بجامته” لخضير فليح الزيدي جملة من الإشكاليّات المرتبطة بطبيعة التّخييل الروائي حين يتقاطع مع المادة التّاريخيّة. ولعلّ أبرز هذه الإشكاليّات تتجسد في السؤال المحوري: ما الجدوى من كتابة رواية عن حدث تاريخي إن لم تُضف للرؤية العامة شيئًا جديدًا؟ إنّ الرّواية حينما تتخذ من التاريخ مادة لها، فإنّها تفترض مسبقًا وعيًا عميقًا من الروائي بأنّ التّاريخ وقائع والرّواية تخييل، وأنّ التاريخ علم بينما الرّواية فنٌّ، بحسب ما أشار إليه المفكر جورج لوكاتش Georg Lukacs (1978، ص17). ومن هنا، فإنّ استحضار الحدث التّاريخي داخل البنية الروائيّة لا ينبغي أن يكون تكرارًا لما هو مدوَّن في كتب المؤرخين، بل يُفترض به أن يقدّم مقاربة فنيّة تُنير زوايا معتمة من التّجربة الإنسانيّة المرتبطة بالحدث، وتُدخل القارئ في أفق جديد من الفهم والتأمل.
إلّا أنّ الرّواية، في مقاربتها لحادثة قصر الرّحاب ومجزرة العائلة المالكة، بدت عاجزة عن ملء الفجوات التي تكتنف هذه الواقعة، إذ فقد النّص الرّابط الحيّ بين الحدث التّاريخي ومجريات الواقع الحاضر، كما أخفق في بناء جسر إنساني بين الشّخصيات والقارئ. فقد ظلّ التّناول محصورًا في مستوى خارجي موضوعي، يُركّز على التّفاصيل المحسوسة، متجاهلًا البُعد الذاتي المرتبط بجوهر الشّخصيات الملكيّة، حياتها اليوميّة، تفاعلاتها، مخاوفها، ومواقفها من التّحولات السياسيّة والاجتماعيّة التي كانت تحاصرها.
لقد غابت في الرّواية ملامح العمق الإنساني لشخصيات مثل الملك فيصل الثاني والأميرات، إذ لم يُتح لهن المجال الكافي للتعبير عن ذواتهن، ولم يُوفّر لهن النّص مساحة كافية للحوار أو للتشكّل النّفسي، ما جعل القارئ يقف أمام شخصيّات باهتة لا يتفاعل معها وجدانيًا. كما ظلّ الراوي يدور سرديًا حول أسوار القصر، دون أن يخترقها ليقدم ما يمكن اعتباره إعادة خلقٍ روائيّ لحياة تلك الشّخصيات من الدّاخل، كما فعل مؤرخون معروفون ممن تناولوا هذه الحقبة الحساسة.
ولم تقتصر الملاحظات النقديّة على غياب البعد الإنساني، بل تعدّته إلى وقوع النّص في مغالطات تاريخيّة، من بينها اختزال شخصيّة الأميرة بديعة ـ الناجية الوحيدة من المجزرة ـ في دور المرأة الغاضبة اللاعنة للعراقيين، من دون الرّجوع إلى ما كُتب عنها في المصادر الموثقة، أو الاستفادة من سيرتها الحقيقيّة في بناء شخصية روائيّة متعددة الأبعاد. وفي مقابل ذلك، يُفرد النّص مساحة سرديّة واسعة لتفاصيل غير موثقة عن “الأميرة راجحة”، عبر مشاهد رومانسيّة أقرب إلى التّخييل الرّغائبي منها إلى التّخييل التّاريخي الواعي، مثل لقاءاتها في الحديقة الخلفيّة مع شخصيّة “عبد الجبار ابن الخياطة بدرية”، وهو ما يُثير تساؤلات جديّة حول مصداقيّة التّمثيل التّاريخي.
ومن المفارقات الأخرى أن الرّواية تُضخم حضور شخصيّات ثانوية مثل الخادم “عباس الزنكي” و”جميل القره تبي”، على حساب الملك نفسه، الذي بدا غائبًا عن مركز الحكاية، فاقدًا لمكانته الرمزيّة والتّاريخيّة. الأمر الذي انعكس سلبًا على شعور القارئ بالتعاطف مع العائلة المالكة، على الرّغم من فداحة المصير الذي واجهته في واحدة من أبشع مجازر التّاريخ العراقي الحديث.
كما تتضمن الرّواية معالجة غير دقيقة لدور شخصيّة “السّيدة سعاد” المسؤولة عن السّلامة الفكريّة، إذ تصورها بوصفها حزبيّة بعثيّة تحوّلت لاحقًا إلى شخصيّة إسلاميّة في مرحلة ما بعد 2003، وتُفرد لها الرّواية مسارًا سرديًا طويلًا، على الرّغم من أنّ هذا الدور، كما هو معلوم في الأوساط الأكاديميّة العراقيّة، كان منصبًا رسميًا إبان النّظام البعثي، وتحول لاحقًا إلى ممارسة تطوعيّة يقوم بها بعض الإسلاميين تقربًا من السّلطة، وهو ما لا يستدعي، من منظور فني وتاريخي، منح هذه الشّخصيّة كل ذلك الحضور على حساب سرديّة رئيسة ما زالت موضع التباس وغموض.
في المحصلة، فإنّ “الملك في بجامته” تطرح إشكاليّة العلاقة بين الرّواية والتاريخ، وتكشف مخاطر التّخييل غير المحسوب حين ينفصل عن الوثائق والمصادر، أو حين يُعلي من التفاصيل الثانويّة على حساب القضايا الجوهرية، ما يجعل العمل يخسر قيمته التّوثيقيّة والجماليّة في آن.
تمثّل أبرز ملامح الجمال في رواية “الملك في بجامته” ذلك الوصف الحيّ والدّافق للمكان البغدادي والذي يمكن القول إنّ الزيدي قد تفرد به بشكل لافت، إذ يصعب الوقوف على مثيل له في الروايات العراقيّة الحديثة التي غالبًا ما تركز على انطفاء الحياة في البيئة المحليّة، أو ترسمها بصورة قاتمة وموحشة. على النقيض من ذلك، ينبض المكان في رواية الزيدي بالحيويّة والتّفاصيل اليوميّة الحميمة، ما يمنح النّص طاقة وصفيّة غامرة، كما في المشهد الآتي: “كانت تكبيرة الآذان الأولى كافية لصعود صبايا بغداد بجلابيب مزركشة وموشحة بالدانتيلا لرشّ السّطوح في الماء وتبريد تربتها الفائرة، لتبادل الحكايات فيما بينهن من خلف الأسيجة”.
هذا التّوصيف لا يعكس فقط مهارة سرديّة، بل يكشف شغفًا بالمكان، واستعادة وجدانيّة لعوالم بغداديّة شبه منقرضة، يصوغها الكاتب بلغة شفافة تتسم بسخريّة رقيقة، أضفت على فصول الرّواية الأولى نكهة مفعمة بالحياة والرّوح. وتبرز هذه السّخرية خصوصًا في تناول الزيدي لحال المثقفين العراقيين الذين يجتمعون عند رحيل أحد الأدباء ثم يتوارون، في مشهد يحاكي ما يمكن تسميته بـ “ندابات القدر” على خشبة مسرح عبثي يشبه مسرحيات شكسبير في الطقس والمفارقة.
لقد صاغ الزيدي روايته ضمن إطار محاكاة تهكّميّة لتاريخ العراق السياسي والاجتماعي، مستعينًا بالكوميديا السوداء بوصفها مزاجًا فنيًا قادرًا على النفاذ إلى أعماق التّجربة العراقيّة. فالسّخرية في الرّواية ليست أداة للتسلية، بل أداة نقديّة فاعلة، تعبّر عن اختلال المعايير وتكشف تناقضات الخطاب السياسي والديني والثقافي، كما في هذا المثال:
“كعش الدّبابير انطلقت الجرذان بكل قوتها إلى شوارع بغداد بعد توفير البيئة المناسبة من رطوبة وظلام مناسبين للانتعاش، حاملة على ظهورها ملايين البراغيث تحمل فايروسات الوباء كما قيل ساعتها. نعم، انقلبت الدنيا، بعدما أطلقت صريرها الذي أخاف الجميع. لقد كذب المؤذنون وصدق القره تبي” (الزيدي، 2018، ص 17). في ضوء هذا الطرح، يمكن استحضار مقولة الفيلسوف الفرنسي جيل دولوز Gilles Deleuze: “إنّ كل نص يتوقف في قيمته على مدى قدرته على السّخرية”.
وهي رؤية تتكامل مع مشروع الزيدي السّردي الذي يزعزع اليقينيات الجامدة، ويفضح البُنى السّلطويّة التي تأخذ نفسها على محمل الجد، فتُنتج خطابًا مأزومًا لا يقبل التّهكم ولا يعترف بمساحاته.
لقد غاص الروائي عبر سرده السّاخر في تناقضات الحياة الوطنيّة، وكشف آليات تفكير النخب السياسيّة والاجتماعيّة والدّينيّة، فجاءت السّخرية في نصه لا بوصفها تعليقًا خارجيًا، بل عنصرًا متأصلًا في بنية النصّ ومضمونه، ترصد الزّيف وتعرّي الأقنعة، وتخلخل كل نسق يدّعي الطّهارة أو الجدارة. وهي بهذا المعنى، ليست مجرد تقنية بل رؤية أخلاقيّة وفكريّة تتقاطع مع التّمثيل الإيديولوجي للمجتمع.
إنّها سخرية كاشفة للوجود الزائف، إذ تقف الشّخصيات – كما القارئ – أمام خفة العالم وهشاشته المعلنة، في حركة سردية تتكرر لتقاوم وهم الحقيقة وتزعزع ثباتها الظاهري.
ثانيًا – مصادر الغرائبيّة
أ- المصدر الأسطوري: تُعدّ الأسطورة من أكثر المنابع الغرائبيّة ثراءً وتنوّعًا، نظرًا لما تنطوي عليه من عناصر تتجاوز الواقع المألوف، سواء في الشّخصيات الخارقة، أو الأزمنة الغابرة، أو الأمكنة غير المألوفة. فشخصياتها غالبًا ما تنتمي إلى عوالم الآلهة أو أنصاف الآلهة، وتدور وقائعها في أزمنة بدائيّة مقدّسة تسبق الزّمن البشري، وتتموضع في فضاءات جغرافيّة مغايرة لتضاريس العالم المحسوس. وبهذا المعنى، تتجاوز الأسطورة حدود الزّمان والمكان الماديين، لتؤسس عوالم متخيّلة كثيفة بالدّلالة والمفارقة.
ويكاد لا يخلو أي تعريف علمي للأسطورة من إشارة – صريحة أو ضمنيّة – إلى هذا الطابع الماورائي المتعالي، إذ يرى مؤلفو كتاب “ما قبل الفلسفة” أنّ الإنسان البدائي لم يكن قادرًا على تفسير الظواهر الكونيّة بعيدًا من التّفكير الأسطوري، بل إنّه كان يعدّ الأشكال الخياليّة الحسيّة أساسًا لا غنى عنه لفهم العالم. ويؤكدون أنّ “الفكر في الشّرق الأدنى القديم يبدو ملفوفًا بالخيال، ونحن نعدّه مشوبًا بالوهم والخرافة، غير أنّ الأقدمين ما كانوا ليعترفوا بإمكان استخلاص أيّ شيء مجرّد من الأشكال التّخيليّة المحسوسة التي خلّفوها لنا” (فرانكفورت وآخرون، 1980، ص 13).
وتتجلّى مركزية الزّمن في الأسطورة من خلال كونه زمنًا مقدّسًا خارجًا عن الزّمن التّاريخي، ومع ذلك فإنّ وقائع هذا الزّمن الأسطوري غالبًا ما تُعدّ أصدق لدى المتلقي المؤمن من الرّوايات التّاريخيّة نفسها. فبينما يمكن للمتدين أن يشكّك في رواية تاريخيّة ويتعامل معها بنَفَس نقدي، إلّا أنّه لا يسمح لنفسه بالتّشكيك في صحة الأسطورة التي يؤمن بها؛ فالبابلي، مثلًا، لا يرى غضاضة في الإيمان أنّ الإله مردوخ خلق الكون من أشلاء التّنين الأول، والكنعاني لا يتردد في تصديق أنّ الإله بعل أسّس النظام الكوني بعد أن صرع الإله يمّ وروّض مياه الفوضى الأولى.
وتتجاوز الأسطورة كونها حكاية خرافيّة إلى كونها نسقًا معرفيًا مكثفًا بالرّموز والدّلالات والإشارات الحضارية، ولهذا فإنّ التّعامل معها لا ينبغي أن يكون عفويًا أو سطحيًا، بل يتطلب وعيًا تأويليًا ومعرفيًا لدى أيّ كاتب معاصر يسعى إلى توظيفها داخل النّص الأدبي. فكما يشير يحيى حسب الله، فإنّ غياب هذا الوعي من شأنه أن يُفرغ التّوظيف الأسطوري من مضمونه الجمالي والفكري، ويحوّله من عنصر إثراء إلى خطاب فارغ لا يخدم العمليّة الإبداعيّة، بل يشتّت بنيتها الجماليّة (حسب الله، 2002، ص 157).
يتجلّى بوضوح في هذا المقطع مدى خصوبة المكوّن الغرائبي، وحضوره الكثيف في تشكيل عناصر الوجود داخل النصّ، فلا يقتصر التّوظيف الغرائبي على استدعاء الاستيهام أو اجترار الحكايات الخرافيّة في إطار تقليدي، بل يتجاوز ذلك إلى إعادة بناء الواقع من منظور رمزي موازٍ، يكشف أبعادًا عميقة ومضمرة تتماهى مع العالم الواقعي من دون أن تنفصل عنه، بل تنصهر في تفاصيله وتتلبّس بظواهره.
فالمشهد الذي يصوّر “الأفندي صالح عطوان” في المحكمة، وهو يصرخ ويتّهم من ينعتهم بناكري النّعمة بالسعي إلى قلب نظام الحكم، يقدَّم بأسلوب يزاوج بين الخطاب السّياسي الحادّ، والمناخ المسرحي الساخر الذي يقترب من العبث المنظم، لتغدو القاعة مسرحًا يجمع بين عناصر الجدّ والهزل، بين الواقع التاريخي والتخييل الرمزي، فيُستثمر الحدث الواقعي ليُعاد إنتاجه عبر لغة مشحونة بالانفعال والتهويل والمفارقة، فيتخذ طابعًا غرائبيًا مركّبًا.
لا يهدف هذا التوظيف إلى محاكاة الغرابة لمجرد الإبهار، بل ينزع نحو إنتاج عالم موازٍ للعالم الواقعي، عالم لا يعادي الواقع بل يندمج فيه ويكشف مفارقاته وتناقضاته. فالحقيقة في هذا السّياق لا تُعرض كما هي، بل تُفلتر عبر منظار رمزي وتأويلي، يستند إلى سرديّة تقوم على تأثيث عوالم تُحاكي الواقع وتحاوره من خلال انزياح لغوي ودلالي يضاعف من عمق الرؤية ودهشة التلقي.
وهكذا يصبح الغرائبي في الرّواية ليس عنصرًا شكليًا أو زينة فنيّة، بل مكوّنًا معرفيًا وتأويليًا، يؤسس شبكة سرديّة تتفاعل فيها الطقوس بالواقع، ويُدمج فيها الفعل بالتأمل، والانفعال بالتّحليل، ليُنتج بذلك سجلًا رمزيًا واسعًا يُذكّرنا بالأساطير الطقوسيّة التي لطالما جمعت بين الفكر والممارسة، وبين البنية الرّمزيّة والتّجربة الإنسانيّة.
ب- المصدر الدّيني: يُعد الدين، بوصفه منظومة اعتقاديّة شاملة، من أبرز مصادر الغرائبيّة وأكثرها رسوخًا في الوجدان الجمعي، إذ يقوم على الإيمان المطلق بحقائق تتجاوز حدود المنطق والتّجربة الحسية. ومن هنا، تُسهم العقائد الدّينيّة، عبر طقوسها وتعاليمها وخوارقها، في تشكيل بنيات غرائبيّة كثيفة، طالما كانت موردًا خصبًا للمخيال الأدبي، ولا سيما في الروايات التي تستدعي البُعد الماورائي بوصفه وسيلة لطرح الأسئلة الأخلاقيّة والوجوديّة والميتافيزيقيّة الكبرى.
وقبل الخوض في توظيف الدّين داخل النص الروائي، من الضروري التوقّف عند البُعد الإبستمولوجي لمفهوم “الدين” والذي، كما يذهب بعض المفكرين، يُعد امتدادًا طبيعيًا للفكر الأسطوري، في اعتماده على الإيمان الثابت واليقين المطلق، من دون اشتراط التّحقق التّجريبي أو البرهان العقلي. فكلا المنظومتين (الأسطورة والدّين) تبنيان تصوّرات كونيّة كليّة، يتعامل معها الفرد بوصفها حقائق نهائيّة، مهما بدت بعض تفاصيلها ساذجة أو خارجة عن منطق الواقع.
ويظهر هذا التصوّر الإيماني الغرائبي في رواية الملك في بجامته من خلال مشهد تُعبّر فيه إحدى الشّخصيات، “سعاد بديوي”، عن رفضها لظهور الممثلات على المسرح بملابس النّوم الشّفافة، مُستنكرة ذلك بوصفه فعلًا منكرًا يخالف الشّريعة الإسلاميّة. تقول: “أنا أعترض. لا يجوز شرعًا ظهور الممثلة في ملابس النّوم الشّفافة على المسرح أمام الجمهور؟ حرام ثم حرام، بل هذا هو الفسق. نحن نعيش في دولة إسلامية، وهذا يتعارض مع ثوابتها…” (الزيدي، 2018، ص 31).
يُجسّد هذا المقطع التوتر بين التّمثيل الفني بوصفه فضاءً حرًا، والتّصور الدّيني الذي يضبط السّلوك ضمن أنساق أخلاقيّة صارمة. وبهذا المعنى، لا يُقدَّم الدّين بوصفه منظومة روحيّة محضة، بل كسلطة رقابيّة تتداخل مع فضاءات التّعبير المسرحي والروائي، وهو ما يعزّز التّوتر الدّرامي في النص ويمنحه طابعًا غرائبيًا نابضًا بالتناقضات.
ويُضيء المفكر “جيمس فريزر James Fraser” (كما ينقل عنه فراس السّواح، 2002، ص191) هذا الطابع المركب للدين، موضحًا أنّه يتكوّن من عنصرين: الأول نظري يتمثل بالإيمان بقوى متعالية، والآخر عمليّ يتمثل بمحاولة استرضاء هذه القوى من خلال الطقوس والدّعاء والعبادات. ويستثمر الزيدي هذا التّواشج بين البعدين الإيماني والطقوسي، حين يُجسّد لحظة غرائبيّة فريدة داخل القاعة المسرحية عبر شخصية الراوي “حكّاء التاريخ”، الذي يظهر بهيئة دينيّة محاطة بهالة طقسيّة، ويخاطب الجمهور بصوت أجشّ: “سيداتي سادتي: إذ نُعلّم الناس الدروس في سفك الدم، فإذا ما حفظوها، قاموا بتطبيقها علينا. أعلمكم أنه في ذلك اليوم، أمطرت غمامة الأدعية المترادفة شظايا من سجيل” (الزيدي، 2018، ص 35).
يتماهى في هذا المشهد، الطقس الدّيني بالدّلالة السياسيّة، ويتحول الدّعاء إلى نذير شؤم، إذ تنقلب السّماء من فضاء للرجاء إلى مصدر للعقاب. وهنا تتجلى الوظيفة الغرائبيّة للدّين في النّص، ليس بوصفه مرجعًا أخلاقيًا فحسب، بل كآلية تعبير رمزيّة تُعيد تأويل الواقع وتكثيف معناه، عبر تداخل الخطاب الدّيني بالخطاب الفني، في مشهد أقرب إلى الطقس المسرحي ذي البنية الأسطوريّة.
وهكذا يُقدَّم الدّين في الرّواية بوصفه مكوّنًا سرديًا له طاقة تأويليّة، يتمفصل مع الغرائبي ليصوغ تمثيلات معقدة للعلاقة بين السّلطة والمعنى، بين الطقس والمعاناة، وبين الإيمان والتّحوّلات الاجتماعيّة.
توظيف البُعد الغرائبي في الدّين ما بعد الطقس: لقد كان التديّن في مراحله الأولى متشابكًا مع الخيال الجامح، إذ اندفع الإنسان نحو تفسير الظواهر الطبيعيّة تفسيرًا أسطوريًا، يلجأ فيه إلى الغيب والخوارق والطقوس السّحريّة كوسيلة للتعاطي مع المجهول. ومع تطوّر الفكر وارتقاء الوعي، بدأت هذه النزعة الغرائبيّة بالتّحوّل من التّفسير الأسطوري العفوي إلى شكل أكثر تجريدًا وتماهيًا مع البُعد الماورائي المنظم، إذ لم يعُد العقل الإنساني يسرف في تخييل كل ما يعترضه من ظواهر، بل بات الدّين يحتفظ بجرعته الغيبيّة ضمن حقل محدود يختص بالمعتقد والطقس والشعائر، من دون أن يُلغي كليةً تلك العناصر الخارقة.
يُعيد خضير فليح الزيدي في هذا السّياق، في روايته الملك في بجامته إحياء تلك الوظيفة الغرائبيّة للدين، ولكن من منظور سردي حداثي يتوسّل التوتر الدرامي والمفارقة الرّمزيّة. فالدّين لا يُطرح في النّص بوصفه منظومة لاهوتية مجردة، بل كـحقل دلالي يعجّ بالرّموز المتشابكة مع الأسطورة، والتراجيديا، والنبوءة. ويتجلى هذا في المقطع الذي تصف فيه الرّواية مشهدًا داخليًا بالغ الرمزية:
“بينما هي لم تنم الليل كله، قضته في الدعاء للملك وتلاوة صامتة للقرآن… ثم نهضت لتغتسل وتتوضأ استعدادًا لصلاة الصبح… عندما بدأت نوبة أخرى من عويل الكلاب السلوقية، نواح مبحوح ومفزع… يذكرهم بنواح الأمهات” (الزيدي، 2018، ص 238).
تتماهى هنا، الأصوات النابعة من الطبيعة (عويل الكلاب) مع أجواء الطقس الدّيني (الدّعاء، التهجّد، الوضوء)، ليُنتج الزيدي مشهديّة غرائبية ذات نَفَس جنائزي مقدّس، يُعطي إشارات نذيريّة توحي باقتراب المصير المأساوي، في استعارة دراميّة تُحاكي النبوءات القديمة. وكأنّ الرّواية تريد القول إنّ هناك تواصلًا غير مرئي بين الأرض والسّماء، بين الحاضر والقدر، يُعبَّر عنه من خلال العلامات الطقسيّة والرمزية.
ولا يتوقف الأمر عند ذلك، بل يمتد إلى الخشبة المسرحيّة نفسها، فيُجسَّد الطقس الدّيني كعنصر سردي حيّ يُعيد تمثيل الفاجعة ضمن إطار دراميّ – ديني متداخل. ففي مشهد بالغ الرّمزيّة، تظهر شخصيّة الأميرة بديعة على المسرح، مفجوعة، حافية، تتوسل السّماء من دون أيّ حاجز سوى “سقف المسرح وأضواء السّجيل”. تقول الرّواية: “تبدأ بترتيل (آية) من نصّ الدعاء المتواتر كما ورد في النّص المسرحي في مشهد التعزية هذا: اللهم أرِني في العراقيين يومًا يبكي به عددهم على بلوتهم” (الزيدي، 2018، ص 36).
إنّ هذا التّداخل بين الطقس الدّيني والطقس المسرحي يُنتج بعدًا غرائبيًا مركبًا، تتبدّى فيه العقيدة بوصفها فعلًا تمثيليًا، والتّخييل بوصفه وسيلة نبوئيّة لاستشراف المصير. كما يتحوّل النّص المسرحي إلى ما يشبه “مرثيّة كونيّة” تُلقى في وجه السّماء، تُبرز هشاشة الإنسان، وضآلة مصيره، وعجزه أمام ما يُخطّ له في الغيب، في تماهٍ تراجيدي يشبه الطقوس الجنائزية في المسرح اليوناني القديم.
إنّ حضور الدين في الرّواية – على الرّغم من أنّه قد تحرر من التّفسيرات السّحريّة السّاذجة – لم يُلغِ البعد الماورائي، بل أعاد تركيبه ليظهر بصورة حداثيّة مشحونة بالتوتر النّفسي والرّمزيّة الدّراميّة. وهو بذلك يُعيد تأكيد أنّ العناصر الغرائبيّة لا تزال ضرورة فنيّة ومعرفيّة في صياغة التديّن المعاصر، لا بوصفه يقينًا مغلقًا، بل كحالة جماليّة، فكريّة، وإنسانيّة تسكن النّص وتمنحه عمقًا وجوديًا.
ج ـ المصدر الشّعبي: تتّسم المخيلة الشّعبية بثراء عجائبي وتنوّع دلالي يتجاوز بساطتها الظاهريّة، فهي تنبع من عمق التّجربة الجمعيّة، وتُجسّد توق الإنسان إلى تجاوز الواقع وضغوطه نحو عوالم بديلة تفيض بالدّهشة، والرّمز، والخارق. وتتمظهر هذه المخيلة، في صورها الأكثر كثافة، من خلال الحكايات الشّعبية، والخرافات، والأساطير المحليّة التي تُروى جيلًا بعد جيل في البيوت والأزقة والمقاهي الشّعبيّة، والتي تُعبّر عن عالم غرائبي مكتمل السّمات، يجد فيه المتلقي متنفّسًا للواقع، ومساحة خصبة للهروب من قسوة الحياة صوب عوالم يُمكن فيها للمستحيل أن يتحقق، وللمقموع أن يتحرّر، وللأمل أن يُستعاد.
ويحفل الأدب الشّعبي بهذا النوع من الحكايات التي تتداخل فيها القوى الغيبيّة مع عناصر الواقع، إذ تهيمن الكائنات العجائبيّة، وتُمارس “الخرافة” دورها في نسج سرديات ذات طابع رمزي – نفسي عميق. وفي هذا السّياق، نجد في رواية الملك في بجامته حضورًا واضحًا للمخيال الشّعبي بكل عجائبيته وتناقضاته. يقول السارد: “ترصد العين الطائرة في أولى طباشير غبش اليوم الجديد بعض تجمعات بغدادية هنا أو هناك في الأزقة الضيقة والحارات، ينسجون التنبؤات لسماعهم صوت الرمي القريب، عمّا يحدث في تلك الساعة. كانت أغلب الروايات تختلط بمخيال شعبي وبطولات زائفة” (الزيدي، 2018، ص 56).
تتجلى في هذا المقطع، آلية اشتغال الذّاكرة الجمعيّة حين تُدمج الواقعة السياسيّة بالمتخيل الشّعبي، فتُعاد صياغة الحدث في صورة عجائبيّة تخلط بين النبوءة والخرافة، في مناخ مشبع بالقلق والانتظار، والوعي المضطرب بالمصير.
ويمتد هذا التوظيف إلى فضاءات الطفولة، فتتردد الحكايات الخرافيّة على ألسنة الجدّات، وتشكل جزءًا من الطقس الليلي في الذاكرة الجمعيّة: “لا ينتهي الليل بتدفق الحكايات من الجدات وسحرها في عيون الصغار ودهشتهم. حكايات عن وحشة السّعالي في الأقبيّة المظلمة وعذاباتها، وأخرى عن قصص الطناطلة الخراتيت يعانون من التوحد… في أسفل الزقاق كان شبح الطنطل هو جميل القره تبي ذاته، ملطخًا في الأوحال بوجه مدمى بعد معركة دامية خسرها في الملهى” (الزيدي، 2018، ص 55).
هنا تتداخل الحكاية الشّعبية مع السّرد الواقعي، فتُسقط صفات الكائنات الغرائبيّة (كالطنطل والسّعالي) على شخصيات الرّواية، وتُعاد صياغة الواقع من خلال عدسة رمزيّة، يتخذ فيها الغريب وظيفة تفسيرية تنفذ إلى عمق الوعي الجمعي والموقف النّفسي من السّلطة والاغتراب والموت.
وتكشف المرويات الشّعبيّة، بما تحمله من صور عجائبيّة وخوارق، رؤية مغايرة للواقع، فتُقدَّم الشّخصيّة ضمن شبكة من القوى المتجاوزة للطبيعة، وتُحمَّل بالأمل أو الرّعب أو التهديد، بحسب السّياق. وهو ما يتوافق مع ما ذهب إليه محمد سعيدي، حين رأى أنّ الحكاية الخرافيّة هي “تجربة يقع فيها البطل ضمن سلسلة من المغامرات والمخاطرات تؤدّي فيها الخوارق دورًا بارزًا، تترجم هذا الدّور من خلال حركيّة الجن والعفاريت، والغول، والشّيطان، والمغارات، والوديان، والحيوان المفترس والصديق” (سعيدي، 1998، ص 57).
أمّا لطيف زيتون، فيعرّفها أنّها “حكاية سرديّة قصيرة، تنتمي صراحة إلى عالم الوهم، من خلال اللجوء إلى الشّخصيات الخياليّة والخوارق، وتصوير العالم غير الواقعي (الشعري، الفنتازي، الأسطوري، الخرافي)، والتقيّد بالتصورات الموروثة” (زيتون، 2002، ص 78).
وبين من يربط “الخرافة” بالكذب المنمق كابن الكلبي، ومن يراها تجسيدًا لطيب الكلام كما يذهب عبد الملك مرتاض (1989، ص 12)، فإن جوهر الحكاية الشّعبية يكمن في قدرتها على تجاوز “الواقعي” إلى “الممكن”، وعلى اختراق سطوة اليومي، عبر خيال خصب لا يعترف بثبوتيات المنطق، بل يقدّس الحركة، والتحوّل، والانفلات من القيود.
لا يقتصر حضور المخيال الشّعبي في الرّواية على تقديم مادة مساندة للسرد، بل يشكّل بنيّة دلاليّة أساسية، تعبّر عن رؤية للعالم تُعيد التّوازن للواقع من خلال الحلم، وتمنح الإنسان القدرة على مقاومة الحتمي والفناء عبر الانفتاح على المدهش والخارق. فالحكاية الشّعبيّة، في هذا السّياق، هي تمرين رمزي على البقاء عبر التخييل، ومواجهة عبثيّة العالم بذاكرة تعيد ترتيب الألم وتداويه بالحلم.
ولعلّ هذا ما يُفسّر ذلك الحضور الكثيف والدائم للخيال الشّعبي في الذاكرة الجمعيّة، على امتداد الأزمنة، فتستمر الحكايات والأساطير والخرافات في احتلال موقع مركزي ضمن الوعي الجمعي، بوصفها وسيلة رمزيّة لمواجهة هشاشة الوجود الإنساني، والتّعبير عن القلق الوجودي تجاه عوالم مجهولة ومهدِّدة. فالتّاريخ البشري، كما يرى محمود إبراهيم، هو تاريخٌ للغرائب بامتياز، “قدرها أن توجد دومًا، وإن لم توجد صنعها الإنسان، أو صاغها بطريقة ما لأنه يدرك حدوده البشريّة، ومدى ضآلته في كونٍ يستشعره منطبقًا عليه، مهددًا لحياته…” (إبراهيم، 1998، ص 114–113). وبهذا المعنى، تغدو العجائب، والخوارق، والأساطير، آليات رمزيّة لفهم الإنسان لذاته وحدوده وهشاشته، ولتأكيد إنسانيته في مواجهة ما يتجاوزها.
وتُجسّد رواية الملك في بجامته هذه الرؤية من خلال مشاهد غرائبيّة تتلبّس الواقع بلغة رمزيّة فاقعة، كما في المقطع الذي يصوّر لحظة وجود البطل في مرحاض الأساتذة، فيخضع الفضاء اليومي لتكثيف دلالي شعري، مشحون بالرمز والمفارقة: “دخلت المرحاض وأغلقت الباب، ثم أغمضت عيني كالعادة عند التبول. عادة قديمة للشعور بنشوة الإفراغ… كنت قد ودّعت منذ زمن نشوة الامتلاء، محاولة للتأقلم مع نشوة الإفراغ في خريف العمر… التي يبدو أنها سترافقني إلى القبر” (الزيدي، 2018، ص 30).
تتحول في هذا المشهد، الوظيفة الجسدية اليوميّة إلى أداة تأمليّة وجوديّة، تكشف تحولات الذات وتآكلها مع الزمن، وتعبّر عن انكسار الحلم والاغتراب الجسدي والنّفسي، في مشهد سريالي لا يخلو من حسّ ساخر مرّ. إنّ استخدام هذا النّوع من السّرد القائم على التوتر بين اليومي والمقدّس، بين الواقعي والخرافي، هو أحد وجوه الغرائبيّة الحديثة.
ويتأكد هذا التوظيف الرمزي مع تصاعد الأزمات، واشتداد الإحساس بالعجز وانسداد الأفق، فيلجأ الإنسان – كما يشير مصطفى حجازي – إلى استبدال السببيّة الواقعيّة بمرجعيّة غيبيّة، تُعيد بناء عالم موازٍ يمنحه وهم الطمأنينة وسط فوضى الحياة. يقول: “كلّما طال عهده بالاعتباط ينصبّ عليه من الطبيعة والناس، وضاقت أمامه فرص الخلاص، اندفع إلى التماس النتائج من غير أسبابها، واستبدل السببية المادية بالسببية الغيبية” (حجازي، 2007، ص 139).
وتُجسّد الرّواية هذا التصدّع النّفسي من خلال مشهد مسرحي طقوسي يفيض بالدلالة الغرائبيّة، حيث تختلط الأسطورة بالمأساة الدينية في صورة سريالية كثيفة: “تسقط دمعتان ليزريتان تتعانقان على القماشة البيضاء… تتحرّك كومة الأجساد برعب متجسد مع مسار بقعة الضوء، لتنفلق إلى ثلاث دمعات أخرى وسط المسرح، يرفعن أكفهن في الدعاء… بينما الأصبع المقطوع يقف أمامهم بتجلّد. وحسب تأويلي للمشهد، إن هذا الأصبع هو للأمير عبد الإله المغدور، مثلما تخبرنا الحادثة التاريخية الشهيرة” (الزيدي، 2018، ص 39).
تتداخل في هذا المشهد، الرّموز الدّينيّة (بكاء بنات الرسول، الدّعاء، المظلوميّة) مع الحدث السياسي (مجزرة قصر الرّحاب)، ضمن سرد بصري غرائبي كثيف يذكّر بطقوس الكابالا أو المسارح الطقسية في التراجيديا الإغريقية، إذ يتحوّل التاريخ إلى أسطورة، والشّهادة إلى طقس جماعي للمغفرة أو العتاب.
ولا يتوقّف التوظيف الغرائبي هنا عند المستوى الفني أو الجمالي، بل يتداخل مع السّياق الاجتماعي، من خلال تصوير انجذاب الطبقات المسحوقة نحو الخرافة والغيبيات، بوصفها وسيلة بديلة لفهم عالم لا يوفّر لها عدالة أو خلاصًا. فحين تتهاوى القيم الواقعيّة، وتُجهض إمكانيات التّغيير، يغدو اللجوء إلى العجائبي، كما يرى السّارد، شكلًا من أشكال التمرّد الرمزي على الواقع، ووسيلة للبقاء الروحي والذهني وسط حطام الحياة اليوميّة.
د – المصدر النّفسي: يُعدّ المصدر النّفسي من المرتكزات المهمّة التي تُغذّي الغرائبيّة في السرد الروائي الحديث، وذلك بالنّظر إلى ما كشفته مدرسة التّحليل النّفسي، وعلى رأسها سيغموند فرويد Sigmund Freud ، من تأثيرات لاشعوريّة عميقة تتحكم في سلوك الإنسان، وتوجّه أفكاره وأحلامه، وتكثّف دوافعه المكبوتة، لتظهر في شكل صور متخيلة، أو هلوسات، أو كوابيس، تحمل في طياتها خرقًا للمنطق الظاهري وتهشيمًا لحدود الواقع المتماسك.
ويشكّل هذا الجانب “اللاشعوري” منطقة غائمة وضبابيّة في كيان الإنسان، يتولّد عنها قدر كبير من الغرابة والتناقض والدّهشة. إذ يرى فرويد Freud أنّ النّفس البشريّة لا تتحرك فقط وفاق منطق العقل الواعي، بل بفعل صراعات كامنة تنبثق من مكبوتات جنسيّة، أو رغبات عدوانيّة، أو حالات قلق وجودي، تتجلى في الأحلام، والانفعالات الغامضة، وردود الفعل اللاعقلانيّة.
وتُجسّد رواية الملك في بجامته هذا البُعد النّفسي للغرائبية من خلال مشاهد تتقاطع مع اللاوعي الجمعي والفردي، وتنفذ إلى المساحات العميقة من الرعب والقلق والانتظار، كما في هذا المشهد الرمزي المكثّف: “كانت عقارب الساعة تبتعد عن ميقات الخامسة عندما بدأت نوبة أخرى من عويل الكلاب السلوقية، نواح مبحوح ومفزع، يصيب الأجساد بصعقة من رعشات ترتجف لها القلوب، يذكرهم بنواح الأمهات” (الزيدي، 2018، ص: 222).
يتجلّى في هذا المشهد الخوف الجمعي من المجهول، إذ يتحوّل صوت الكلاب إلى كناية عن نذير شؤم، بينما يُستدعى “نواح الأمهات” كتجسيد للرّعب الغريزي المتأصل في ذاكرة الإنسان، فيتحول الحس الواقعي إلى صورة ذهنية تنتمي إلى عالم اللاوعي.
وقد ناقش فرويد Freud في تفسير الأحلام جملة من الأحلام الغريبة التي تتلاقى فيها المتناقضات وتتماهى فيها الكيانات المستحيلة، كما في الحلم الذي تراه فتاة صغيرة ف “يبدأ الأطفال بالزّحف ثم ينبت لهم جناحان ويطيرون”، أو ما تحلمه امرأة من “حصان يرتدي قميص نوم”، أو صورة “الله” وهو يضع قبعة مدببة. وعلى الرّغم من تفاوت التأويلات لتلك الأحلام، فإنّ القاسم المشترك بينها هو تجسيد رغبات مكبوتة أو رموز داخليّة تظهر في هيئة مفارِقة للواقع، تُدهش وتربك، لكنها تكشف في عمقها صراعًا نفسيًّا باطنيًّا يتجاوز المنطق السّطحي.
ويستثمر الزيدي هذا المنحى النّفسي في إحدى أكثر لحظات الرّواية دراميّة وتكثيفًا:”على فراش الموت، كان يتحدث لزوجته عما حصل بالضبط في اليوم (الوطني) للمجزرة، بعدما بحّ صوته من تدفّق سيل التّحذيرات والرسائل التي كانت تأتي تباعًا، ولا أحد يسمع صياحه. كان يعمل بجد مع فريقه لتحليل محتوى جميع الرسائل. وتحدث عن أول رسالة وردت إلى الملك، وكانت بيتين ركيكين من الشعر:
أيها الخائف الحذر
بماذا سينفعك الحذر
يوم يأتيك القدر
لا ينجو من المقدر الحذر
فكتب الملك بخط يده: ﴿قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا﴾، ثم أمر بنقش هذه الآية على قطعة رخاميّة بطول ثلاثة أمتار لتُثبّت على واجهة قصره الجديد الذي لم يكتمل بناؤه” (الزيدي، 2018، ص: 225).
يعبّر هذا المشهد عن تعقّد البنية النّفسية للملك كشخصيّة تواجه مصيرًا دمويًا محتمًا، ويجسّد لحظة من الاحتدام الوجودي بين الرّغبة في النّجاة والاستسلام للقدر، فتتداخل اللغة الدّينيّة بالشّعر الرّمزي، ويتحول النصّ إلى تعبير عن حالة قلق قصوى، تكشف فشل الصوت الفردي في مقاومة الحتميّة التاريخيّة، ومأساويّة العجز أمام المصير.
ومن خلال هذه المشاهد، يُمكن القول إنّ الغرائبيّة النّفسية في رواية الزيدي لا تقوم على الفنتازيا أو الخرافة السّطحيّة، بل على تفكيك بنية العقل الدّاخلي في لحظات التّصدّع، وكشف عمق القلق الإنساني الذي يتجلّى في صور، ورموز، ومواقف تستعصي على الفهم السّطحي، لكنها تُضيء العتمة الكامنة في أعماق النفس.
د – المصدر النّفسي: الحلم، الهلع، والانفلات من منطق الواقع
يُشكّل المصدر النّفسي واحدًا من أخصب المنابع التي تُغذي الغرائبيّة في الأدب، ذلك أن النزوع الإنساني الفطري نحو التخييل والحلم والاستيهام ينبثق من صميم التّجربة الدّاخليّة للإنسان، فتتكثّف دوافعه المكبوتة ومشاعره المضطربة في صورٍ رمزيّة تتجاوز حدود المنطق وتشقّ طريقها نحو الخارق والمفارق والمبهم. فكلّما توترت العلاقة بين الذّات والعالم، وكلّما انكمش الواقع على الفرد، انفتحت أمامه منافذ اللاشعور، وأطلقت العنان لطاقة التّخييل كي تصوغ عوالم موازية، هي – على ما فيها من هلوسة أو عبث – انعكاس دقيق لحالة نفسيّة داخليّة معقدة.
ولا تتجلى هذه الطّاقة النّفسية المُغرّبة في الحلم أو الكابوس فقط، بل تتبدّى أيضًا في لحظات التأزم القصوى، حين يدخل الإنسان في نفق الرّعب، ويجد نفسه محاصرًا بواقع لا يمكن تفسيره إلا بآليات الهروب والتسامي والرمز.
وفي هذا الإطار، يوظّف خضير فليح الزيدي في الملك في بجامته مجموعة من المشاهد التي تستثمر البنية النّفسية الدّاخليّة لشخصياته في إنتاج بعد غرائبي مركب، كما في هذا المشهد: “في الطابق العلوي الذي تجمعت فيه الأرواح اللائبة من خوف وارتباك يتعاظم كلّما مرّت الدّقائق الثقيلة، وقف الأمير والملك قرب النّافذة المطلة على الحديقة… تبسملت الأميرة هيام بآيات من المصحف، قال الأمير بانزعاج: هذه حركة من الجيش ضدنا، جلالة الملك… مع كل الأسف والله” (الزيدي، 2018، ص 243).
في هذا المقطع، لا تُستمد الغرائبيّة من وجود كائنات أسطوريّة أو وقائع خارقة، بل من تصعيد الحالة النّفسية إلى مستوى من التّوتر الهلوسي، فيتداخل الهلع مع الانتظار مع التباس المصير. إنّ اجتماع الأرواح في الأعلى، واهتزاز الزّمن، واضطراب الشّخصيات، يجعل القارئ في مواجهة مشهد أشبه بـ”الكوابيس الواقعيّة”، فيغدو الرعب ملموسًا، والخوف كثيفًا، والزّمن أشبه بعقوبة ثقيلة.
ويزيد الزيدي من حدّة هذا التوتر النّفسي حين يصف مشهد الانهيار الدّاخلي تحت ضغط الخطر الدّاهم، في تصوير غرائبي كثيف، يُظهر كيف يتحوّل الحدث السياسي إلى دراما وجوديّة: “لم تمر تلك اللحظات سريعة كما في القصص التّاريخيّة، بل كانت الدّقائق أثقل من الجبال الصامتة… ومع كل رشقة من الرّمي، بقر المحاصرون يلوذون إلى الجدران مرعوبين، وأصوات العسكر تصنع مزيدًا من الصّخب، مع رائحة البارود والدخان…” (الزيدي، 2018، ص 244–245).
لا يقدّم هذا المشهد واقعة ماديّة فحسب، بل يُغرق القارئ في دوامة من القلق الحسي والنّفسي، فتتهاوى آليات التّصرف العقلاني، ويستسلم الجميع أمام طوفان الرّعب، في لحظة تجمع بين الواقعيّة الدّقيقة، والتّوتر الغرائبي المستمد من تمزق الذات وفقدان السّيطرة.
وإذا أضفنا إلى ذلك ما أشار إليه العديد من النّقاد من أنّ كثيرًا من الكتّاب يلجؤون إلى السّحر والعجائبيّة ليس فقط كأداة فنيّة، بل كاستجابة نفسيّة عميقة للواقع المأزوم، بدا واضحًا أنّ الحلم، والاستيهام، والخرافة، ليست مجرد عناصر سرديّة، بل تجليات رمزيّة لانفعالات مكبوتة وهواجس وجوديّة.
ومن هنا، تلتقي الغرائبيّة النّفسيّة بالخرافة والحلم، في بنيتها الدّراميّة التي تقوم على العرض، والتّحول، والنتيجة، فضلًا عن تمثيلها لأنماط أصليّة (Archetypes) تنبع من اللاوعي الجمعي، وتُستعاد في أشكال متخيلة ومُرمّزة عبر النّصوص. وهي آليات يراها كارل يونغ Carl Jung ضروريّة لتماسك النّفس البشريّة، خصوصًا في لحظات الانكسار الحضاري والوجودي.
وعليه، فإنّ الرّواية تُجسّد عبر هذه المشاهد ذروة التّداخل بين الواقع واللاشعور، بين الوقائع السياسيّة والمشاعر الدّاخليّة، ما يجعل المصدر النّفسي في الغرائبيّة ليس مجرد أداة زخرفيّة، بل جوهرًا من صلب الرؤية الجماليّة للنصّ، وركيزة لتوليد التوتر الدرامي والانفعال التأويلي.
الخاتمة
ما كتبه الروائي خضير فليح الزيدي في الملك في بجامته لا يمكن قراءته بوصفه سردًا تخييليًا فحسب، بل هو خطاب مركّب يتقاطع فيه التّاريخ بالأسطورة، والدّين بالشّعبيّة، والواقع باللاوعي، في شبكة من الرّموز والمعاني التي تكشف، في جوهرها، أنّ الأدب ليس سوى جهاز معرفي يمارس من خلاله الكاتب سلطته على الذّاكرة، والتأريخ، والتّخييل. فالرّواية هنا تُمارس ما يسميه فوكو Foucault بـ”أركيولوجيا الخطاب”، أي التنقيب في طبقات النصوص والخطابات السّابقة، وتفكيك بنية السّلطة الكامنة خلف التمثيلات السّرديّة.
إنّ الغرائبيّة في هذا السّياق ليست مجرّد ترف فني، أو زخرفة سرديّة، بل هي أداة مقاومة ضد السّلطة المعرفيّة السائدة، سواء أكانت سلطة التاريخ الرسمي، أو السّرديات الكبرى، أو المؤسسات الدّينيّة والسياسيّة. فحين يُستدعى الموروث الشّعبي أو الديني، أو تُوظف الأسطورة أو اللاوعي، فإنّ النّص لا يعيد إنتاجها كما هي، بل يُخضعها لآلية التّعديل، والتّمويه، والتشظية، ليخلق خطابًا جديدًا يزعزع اليقين ويطرح الأسئلة بدل أن يقدّم إجابات.
وهكذا، تتجاوز الغرائبيّة عند الزيدي بعدها الجمالي، لتصبح استراتيجيّة سرديّة لكشف اللا مرئي، واللامفكّر فيه، واللامعقول، في بنية السلطة والواقع والتاريخ. فالأسطورة ليست بريئة، بل محمّلة بدوالّ سلطوية؛ والدين لا يُستدعى إلا بتأويل يتقاطع مع السّياق؛ أمّا الشّعب واللاشعور فهما حقلان مفتوحان لتجريب السّلطة والاختلاف.
لذلك، فإنّ هذه المصادر (الأسطوري، الدّيني، الشّعبي، النّفسي) لا تُستدعى على نحو ساذج أو محايد، بل تدخل في تشكيل خطاب روائي معاصر يتقاطع فيه التخييل مع آليات المعرفة والإخضاع والمقاومة، ويستدعي بالضرورة قارئًا فاعلًا، يمتلك من أدوات التأويل ما يؤهله لتفكيك هذا التشابك الخطابي، وفضح مستوياته المتعددة من السلطة، والمعنى، والإقصاء.
المصادر والمراجع
- أبو ديب، ك. (2007). الأدب العجائبي والعالم الغرائبي في كتاب العظمة وفن السّرد. بيروت: دار الساقي.
- أبو حسن، أ. (1991). المصطلح ونقد النقد. الرباط: كلية الآداب والعلوم الإنسانية.
- أشهبون، ع. (2007). الرّواية العربية (من التأسيس إلى آفاق النص المفتوح). فاس: مطبعة آنفو برانت.
- الأصفهاني، الراغب. (1404هـ). المفردات في غريب القرآن (ط. 2).
- البعبودي، خ. (2011). الخيال والتخييل في الحكي القصصي: دراسة أدبية. الجزائر: دار الخلدونية للنشر والتوزيع.
- باختين، م. (1982). الملحمة والرّواية (ترجمة وتقديم جمال شحيذ). بيروت: كتاب الفكر العربي.
- تزفيتن، ت. (1994). مدخل إلى الأدب العجائبي (ترجمة: الصديق بوعلام). القاهرة: دار شرقيات.
- تنفو، م. (2010). النص العجائبي (مائة ليلة وليلة نموذجًا). سوريا: دار كيوان للطباعة والنشر والتوزيع.
- ثودوروف، ت. (1994). مدخل إلى الأدب العجائبي (ترجمة الصديق بوعلام). القاهرة: دار شرقيات.
- حجازي، م. (2007). التّخلف الاجتماعي: مدخل إلى سيكولوجية الإنسان المقهور (ط. 10). بيروت/الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي.
- حسب الله، ي. (2002). علم الميثولوجيا… والاقتراب من الفن. مجلة الحكمة، (28)، بغداد.
- حليفي، ش. (2009). شعرية الرّواية الفانتاستيكية. بيروت: الدار العربية للعلوم ناشرون.
- الداديسي، ك. (2018). مسارات الرّواية العربية المعاصرة. بيروت: مؤسسة الرحاب الحديثة.
- زيتوني، ل. (2002). معجم مصطلحات نقد الرّواية (عربي – إنجليزي – فرنسي). بيروت: مكتبة لبنان ناشرن، دار النهار للنشر.
- الزبيدي، م. (1994). تاج العروس في جواهر القاموس (تحقيق: علي شيري). بيروت: دار الفكر.
- الزيدي، خ. ف. (2018). الملك في بجامته. بيروت: دار الرافدين.
- شعلان، س. (2007). السرد الغرائبي والعجائبي في الرّواية والقصة القصيرة في الأردن (1970-2002). قطر: نادي الجسرة الثقافي والاجتماعي.
- صبري، ح. (1986). البدايات ووظيفتها في النص القصصي. مجلة الكرمل، (21/22)، نيقوسيا.
- سعيد، ع. (1985). معجم المصطلحات الأدبية المعاصرة. بيروت: دار الكتاب اللبناني.
- سعيدي، م. (1998). الأدب الشّعبي بين النظرية والتطبيق. الجزائر: ديوان المطبوعات الجامعية.
- السواح، ف. (2002). دين الإنسان (ط. 4). دمشق: دار علاء الدين.
- عبد الملك، م. (1989). الميثولوجيا عند العرب. الجزائر/تونس: المؤسسة الوطنية للكتاب، الدار التونسية للنشر.
- فرانكفورت، هـ. وآخرون. (1980). ما قبل الفلسفة: الإنسان في مغامرته الفكرية الأولى (ترجمة: جبرا إبراهيم جبرا) (ط. 2). بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر.
- فرويد، س. (د.ت). تفسير الأحلام (ترجمة: مصطفى صفوان). القاهرة: دار المعارف
- القزويني، ز. م. (2000). عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات (ط. 1). بيروت: منشورات الأعلمي للمطبوعات.
- كمال، أ. (2007). الأدب العجائبي والعالم الغرائبي في كتاب العظمة وفن السرد. بيروت: دار الساقي.
- لوكاتش، ج. (1978). الرّواية التاريخية (ترجمة: صالح جواد كاظم). بيروت: دار الطليعة للطباعة والنشر.
- مسعود، ج. (د.ت). معجم الرائد: معجم لغوي عصري. بيروت: دار العلم للملايين.
- المسدي، ع. (1985). اللسانيات وعلم المصطلح العربي. مجلة اللسانيات، (5)، تونس.
- نعمان، ع. (2009). الحداثة وما الحداثة في السرد الروائي. مجلة الثقافة، (21)، أكتوبر.
- النصير، ي. (1998). الاستهلال: فن البدايات في النص الروائي. القاهرة: الهيئة العامة لقصور الثقافة.
- طرشونة، م. (2003). نقد الرّواية النسائية في تونس. تونس: مركز النشر الجامعي.
- Denis Mellier, La littérature fantastique, Ed Seuil, Paris, 2000
- Denis Labbé et Gilbert Millet, Le fantastique, Ellipses Édition, Paris, 2000, pó
[1] – أستاذ الأدب الحديث في كلية التربية الأساسية/ جامعة واسط وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية.
Professor of Modern Literature, College of Basic Education, University of Wasit, Iraqi Ministry of Higher Education and Scientific Research.Email: : m_aljobory@yahoo.com.