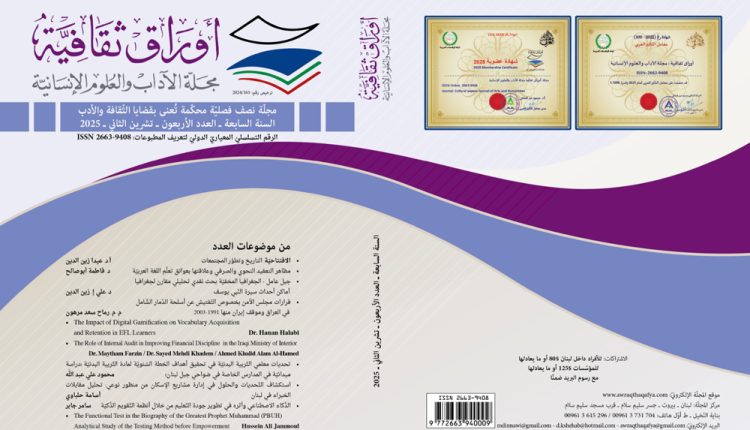عنوان البحث: الذّكاء الاصطناعي والتّفكير النّقدي في التّعليم العالي: دراسة مفاهيميّة في ضوء الأدبيّات المعاصرة
اسم الكاتب: فضل حسين عاصي
تاريخ النشر: 2025/11/14
اسم المجلة: مجلة أوراق ثقافية
عدد المجلة: 40
تحميل البحث بصيغة PDFADOI: https://aif-doi.org/awraq/014010
الذّكاء الاصطناعي والتّفكير النّقدي في التّعليم العالي: دراسة مفاهيميّة في ضوء الأدبيّات المعاصرة
Artificial Intelligence and Critical Thinking in Higher Education: A Conceptual Study Based on Contemporary Literature
Fadel Hussein Assi فضل حسين عاصي([1])
Supervising Professor: Dr. Saher Al-Annan الأستاذ المشرف:د. ساهر العنان([2])
تاريخ الإرسال:11-10-2025 تاريخ القبول:23-10-2025
الملخص turnitin:14%
يهدف هذا المقال المفاهيمي إلى تحليل الدّور النّظري لتقنيات الذّكاء الاصطناعي في تعزيز التّفكير النّقدي والإنتاج العلمي لدى طلبة الدّراسات العليا في مؤسسات التّعليم العالي، مع التّركيز على الوعي بوصفه وسيطًا معرفيًا يسهم في تحويل استخدام التّقنيّة إلى قيمة أكاديميّة مضافة. ويعتمد المقال على تحليل منهجي للأطر النّظريّة والنّماذج التّربويّة المعاصرة التي تناولت العلاقة بين الذّكاء الاصطناعي والمهارات الذّهنيّة العليا، مستندًا إلى مجموعة من الأدبيّات العربيّة والأجنبيّة الحديثة. وقد تبيّن أن الاستخدام الفعّال للذكاء الاصطناعي لا يحقق أثره المعرفي إلّا عندما يرتبط بمستوى مرتفع من الوعي التّحليلي لدى الطالب، فيصبح قادرًا على توظيف الأدوات الرّقميّة ضمن مسار تفكير نقدي يُفضي إلى إنتاج معرفي أصيل. ويقترح المقال نموذجًا مفاهيميًا يعتمد على التفاعل بين أبعاد الاستخدام (التنوع، التكرار، الدّمج، التّطبيق الهادف) وبين آليات الوعي المعرفي والأخلاقي، بوصفها حجر الأساس في تطوير قدرات البحث والإنتاج العلمي.
الكلمات المفتاحيّة: الذّكاء الاصطناعي؛ التّفكير النّقدي؛ الإنتاج العلمي؛ الوعي التّقني؛ طلبة الدّراسات العليا؛ التّعليم العالي.
Abstract
This conceptual article aims to analyze the theoretical role of artificial intelligence (AI) technologies in enhancing critical thinking and scientific production among postgraduate students in higher education institutions. Drawing on a systematic review of recent Arab and international literature, the study highlights that effective use of AI tools only produces intellectual value when accompanied by a high level of analytical awareness. In this sense, students’ ability to employ digital tools within a process of critical reasoning becomes essential for achieving original scientific outcomes.
Furthermore, the article proposes a conceptual model that explains the interaction between the dimensions of AI use (frequency, diversity, integration depth, and purposeful application) and the mechanisms of cognitive and ethical awareness, as key determinants of the development of research and scientific production capabilities. The findings suggest that AI tools can serve as catalysts for critical thinking—as long as they are used consciously—and point to the need for Arab higher education institutions to move beyond mere provision of AI tools toward fostering students’ capacity for thoughtful and ethical use.
Keywords: Artificial Intelligence; Critical Thinking; Scientific Production; Technological Awareness; Postgraduate Students; Higher Education
- المقدمة :يشهد مجال التّعليم العالي في السّنوات الأخيرة تحوّلًا نوعيًا بفعل التّوسع المتسارع في استخدام تقنيات الذّكاء الاصطناعي، إذ انتقلت هذه التقنيات من كونها مجرد أدوات تقنيّة إلى مكوّن بنيوي يعيد تشكيل الدّور المعرفي للطالب الجامعي. ومع هذا التّحول، أصبحت المهارات الذّهنيّة العليا – وفي مقدمتها التّفكير النّقدي – جزءًا من شروط التّفاعل مع البيئة الرّقميّة الجديدة، إذ لم يعد الطالب مجرد مستهلك للمعلومة، بل أصبح مطالبًا بإعادة تنظيمها وتفسيرها وتوظيفها في بناء معرفة جديدة.
وفي هذا السياق، يُعدّ الإنتاج العلمي مؤشرًا مركزيًا يعكس هذا المستوى من التفاعل، فيمثل القدرة على توليد المعرفة وتنظيم النّتائج في شكل أكاديمي قابل للنشر والمناقشة. غير أنّ استخدام أدوات الذّكاء الاصطناعي في البحث العلمي لا يفضي بالضّرورة إلى رفع مستوى هذا الإنتاج، ما لم يرتبط هذا الاستخدام بقدر كافٍ من الوعي النّظري والمعرفي الذي يسمح للطالب بتحويل الأداة إلى مسار تفكير وتحليل.
ولهذا، تركز الأدبيّات التّربويّة الحديثة على مفهوم “الوعي التّقني” كعامل وسيط يفسّر طبيعة العلاقة بين استخدام تقنيات الذّكاء الاصطناعي من جهة، وبين تنمية مهارات التّفكير النّقدي والإنتاج العلمي من جهة أخرى. ومن هنا، تأتي أهمّيّة تناول هذه العلاقة في إطار مفاهيمي تحليلي، يهدف إلى بناء تصور متكامل يوضح شروط التأثير، وحدوده، وآليات تفعيله في بيئات التّعليم العالي المعاصرة.
لقد أظهرت العديد من الدّراسات، العربيّة منها والأجنبيّة، أنّ العلاقة بين الذّكاء الاصطناعي والمهارات الذّهنيّة العليا لا تتحدد فقط بمدى وفرة الأدوات أو بسهولة الوصول إليها، وإنّما تتشكّل ضمن عمليّة إدراكيّة معقّدة تعتمد على مستوى وعي الطالب بطبيعة هذه الأدوات، وقدرته على استثمارها في سياقات بحثيّة ومعرفية تتطلّب التّفكير النّقدي والابتكار العلمي. من هنا، لم يعد التساؤل المطروح مرتبطًا بـ “هل يؤثر الذّكاء الاصطناعي في التّفكير النّقدي؟” بقدر ما أصبح مرتبطًا بـ “كيف يؤثر؟، و”ما ” هي الشروط اللازمة لتحويل التأثير إلى قيمة علمية أصيلة؟
في هذا الإطار، تقدم النّماذج التّربوية المعاصرة عدة مقاربات تساعد على فهم الدّور النّظري للذكاء الاصطناعي في التّعليم العالي، إذ يرى بعض الباحثين إنّ هذه التّقنيات قد تكون حافزًا لتطوير التّفكير النّقدي من خلال تعزيز فرص الاستقصاء وتحليل البيانات، في حين يشير آخرون إلى مخاطر الاستخدام غير الواعي الذي قد يؤدي إلى الاعتماد السّلبي وتراجع النـّزعة التّحليليّة لدى الطالب. وبين هذين الاتجاهين، يبرز الوعي بوصفه المتغيّر الذي يحدد مآل الأثر نحو التّطوير أو التّراجع، الأمر الذي يستوجب تحليل هذه العلاقة ضمن إطار مفاهيمي متكامل.
- إشكالية البحث:على الرّغم من انتشار أدوات الذّكاء الاصطناعي في الجامعات، لا يزال تأثيرها على التّفكير النّقدي والإنتاج العلمي غير محسوم، إذ تتفاوت النّتائج تبعًا لمستوى الوعي التّقني لدى الطلبة. ومن هنا تنبثق الإشكاليّة الرئيسة: كيف يسهم الوعي بتقنيات الذّكاء الاصطناعي في تحويل استخدامها من مجرد أداة تقنية إلى وسيلة لتطوير التّفكير النّقدي وتعزيز الإنتاج العلمي؟
- أهمّيّة البحث: تنبع أهمّيّة هذا البحث من كونه يتناول موضوعًا حديثًا ومعقدًا يشهد تفاعلًا متزايدًا في البيئة الأكاديميّة، ألا وهو العلاقة بين الذّكاء الاصطناعي وتنمية القدرات الذّهنيّة العليا، وخاصة التّفكير النّقدي والإنتاج العلمي. فبينما تركز غالبيّة الدّراسات السّابقة على الأثر المباشر لتقنيات الذّكاء الاصطناعي في تحسين الأداء الأكاديمي، فإنّ هذا البحث يسلّط الضوء على بُعد مهمل نسبيًا يتمثل في الوعي التقني كعامل معرفي وأخلاقي وسيط يفسّر تباين النتائج بين الطلبة.
وتتجلى الأهمّيّة النّظريّة في مساهمة البحث في توسيع الفهم العلمي للعلاقات المعرفيّة بين الإنسان والتّقنية داخل مؤسسات التّعليم العالي، من خلال بناء إطار مفاهيمي يربط بين أبعاد استخدام الذّكاء الاصطناعي (التنوع، التكرار، العمق، التطبيق الهادف) وبين مخرجات التّفكير النّقدي، والإنتاج العلمي عبر الوعي بوصفه وسيطًا معرفيًا وأخلاقيًا. أمّا من الناحية التّطبيقيّة، فيقدّم البحث أساسًا يمكن للجامعات وصنّاع القرار التربوي الاعتماد عليه في تصميم برامج تدريبية، ومقررات متخصصة تُنمّي مهارات الاستخدام الواعي والمسؤول للتقنيات الذّكيّة.
كذلك، يكتسب البحث أهمّيّة خاصة في السّياق العربي، إذ يسعى إلى إثراء الخطاب الأكاديمي حول الذّكاء الاصطناعي بعيدًا من الطّابع الوصفي أو الاحتفائي، نحو مقاربة نقديّة توازن بين الإمكانات والمخاطر، وتؤكد دور الطالب كباحث واعٍ قادر على تحويل الأداة إلى قيمة معرفيّة مضافة. ومن هنا، فإن القيمة المضافة لهذا العمل تكمن في أنّه لا يكتفي بعرض العلاقة النّظريّة بين المتغيرات، بل يقدّم نموذجًا تفسيريًا قابلاً للتطبيق في دراسات لاحقة، ما يجعله إسهامًا أصيلًا في تطوير توجهات تعليميّة أكثر نقديّة وابتكاريّة.
- فرضية البحث: ينطلق البحث من الفرضية الآتية:
إن استخدام تقنيات الذّكاء الاصطناعي لا يؤدي بالضرورة إلى تعزيز التّفكير النّقدي، والإنتاج العلمي إلاّ عندما يكون مقترنًا بوعي معرفي وأخلاقي مرتفع لدى المتعلم.
- أهداف البحث: تأتي أهداف هذا البحث استجابةً للإشكاليّة المطروحة والفرضيّة المبدئيّة التي تؤكد أن تأثير تقنيات الذّكاء الاصطناعي في التّفكير النّقدي والإنتاج العلمي لا يتحقق إلّا من خلال الوعي التّقني والمعرفي لدى المتعلم. ومن هذا المنطلق، يسعى البحث إلى تحقيق مجموعة من الأهداف النّظريّة والتّطبيقيّة التي تمكِّن من بناء تصور مفاهيمي متكامل للعلاقة بين هذه المتغيرات.
- تحليل الجذور النّظريّة للعلاقة بين الذّكاء الاصطناعي والعمليّات الذّهنيّة العليا، مع التركيز على التّفكير النّقدي بوصفه مهارة معرفيّة أساسيّة في التّعليم العالي.
- استكشاف مفهوم الوعي التّقني وأبعاده المعرفيّة والأخلاقيّة والتّطبيقيّة، وتوضيح دوره بوصفه متغيرًا وسيطًا في تحويل استخدام الذّكاء الاصطناعي من ممارسة آلية إلى نشاط فكري منتج.
- مقارنة الاتجاهات البحثيّة العربيّة والأجنبيّة في تناول العلاقة بين الذّكاء الاصطناعي والتّعليم العالي، بغية تحديد الفجوات المفاهيميّة التي يسعى البحث إلى سدّها.
- صياغة نموذج مفاهيمي تفسيري يوضح التّفاعل بين أبعاد استخدام تقنيات الذّكاء الاصطناعي (التكرار، التّنوع، عمق الدمج، التطبيق الهادف) وآليات الوعي التّقني (المعرفي، الأخلاقي، التطبيقي) في التّأثير على التّفكير النّقدي والإنتاج العلمي.
- اقتراح مسارات تطبيقيّة مستقبليّة يمكن أن تسهم في تطوير مناهج جامعيّة، وبرامج تُعزِّز الاستخدام الواعي والمسؤول لتقنيات الذّكاء الاصطناعي في التّعليم والبحث العلمي.
بهذه الأهداف، يسعى البحث إلى تجاوز الطرح الوصفي السّائد نحو بناء رؤية علميّة نقديّة تُبرز أهمّيّة الذّكاء الاصطناعي كأداة معرفية موجَّهة، لا كبديل عن التّفكير الإنساني، بما يدعم تطوير بيئات تعليميّة أكثر وعيًا وابتكارًا في العالم العربي.
- الدّراسات السّابقة: تُعد الدّراسات السّابقة الإطار المرجعي الذي يُثري التحليل النظري، ويوفّر قاعدة معرفيّة لفهم أعمق للموضوع قيد البحث. ومن خلال مراجعة شاملة للأدبيّات الحديثة في السياقين العربي والأجنبي، يمكن استخلاص عدد من الاتجاهات الرئيسة التي توضّح طبيعة العلاقة بين الذّكاء الاصطناعي، التّفكير النّقدي، والوعي التقني في التّعليم العالي.
6.1 الدّراسات الأجنبيّة: تشير الأدبيّات الدّوليّة إلى توافق متزايد حول الدّور الإيجابي للذكاء الاصطناعي في دعم القدرات المعرفيّة العليا لدى الطلبة، وخاصة في مراحل التّعليم العالي. فقد بيّنت دراسة Ruiz-Rojas et al. (2024) أنّ استخدام الأدوات التّوليديّة يسهم في تعزيز مهارات التّحليل الجماعي وإعادة تنظيم الأفكار، من خلال تفاعل الطلبة مع محتوى متجدد يتطلّب تفكيرًا نقديًا مستمرًا. وأكّدت دراسة Silva & Rodríguez (2024) أن توظيف الذّكاء الاصطناعي في البيئات الأكاديميّة يسهم في تطوير مهارات التّفكير المنطقي والاستقصاء العلمي، شريطة أن يكون الاستخدام موجَّهًا ومدعومًا بالوعي الكافي بحدود التقنية.
وفي المقابل، لاحظت مراجعات منهجيّة مثل Saúde et al. (2024) أنّ هذه التّقنيات لا تُنتج بالضّرورة تحسّنًا في الأداء الأكاديمي عندما تُستخدم بصورة آلية أو من دون فهم لمبادئها الخوارزميّة، ما يجعل الوعي بها عاملًا تفسيريًا حاسمًا لاختلاف النتائج بين المتعلمين. وخلصت أبحاث أخرى (Chen & Ramírez, 2025؛ Ventura & Lopez, 2024) إلى أنّ غياب الوعي الأخلاقي والمعرفي قد يحوّل الذّكاء الاصطناعي إلى أداة اعتماد مفرط بدل أن يكون محفّزًا للتفكير التحليلي.
6.2 الدّراسات العربيّة: أمّا في السّياق العربي، فقد تناولت الدّراسات الحديثة العلاقة بين الذّكاء الاصطناعي ومهارات التّفكير النّقدي، والإنتاج العلمي ضمن بيئات تعليميّة تتجه تدريجيًا نحو التّحوّل الرّقمي. أظهرت دراسة العتيبي وآخرون (2022) أنّ تطبيق استراتيجيات تعليميّة قائمة على الذّكاء الاصطناعي في تدريس الفيزياء أسهم في رفع مستوى التّفكير النّاقد والاتجاهات العلميّة لدى الطالبات، ما يعكس أثر التّفاعل النشط مع التّقنيّة. كما بيّنت دراسة الرّفاعي وسعد (2022) أنّ الطالب الذي يمتلك فهمًا واضحًا لأهداف استخدام التقنية يُظهر مستوى أعلى من الإنتاج العلمي مقارنة بمن يستخدمها لأغراض شكليّة أو مكرّرة.
كذلك أشار خير وحالات (2023) إلى أهمّيّة الدّمج بين التّفكير النّقدي والوعي الأخلاقي في استخدام أدوات الذّكاء الاصطناعي، عادّين أن غياب هذا الوعي قد يؤدي إلى تراجع في الأصالة الفكريّة، واستبدال التّحليل الإنساني بالمخرجات الآلية. أمّا دراسة الزهيري وعبد الله (2023) فقد ركزت على إمكانات الذّكاء الاصطناعي في تعزيز التعلم الإلكتروني في الجامعات العربيّة، لكنّها نبّهت إلى أنّ الأثر الحقيقي لا يتحقق إلّا بتكامل الجانب التّقني مع الجانب المعرفي في استخدام الأداة.
6.3 خلاصة الدّراسات السّابقة: من خلال مراجعة هذه الأدبيّات، يمكن استنتاج وجود إجماع نسبي على أن الذّكاء الاصطناعي يمثل فرصة معرفيّة لتعزيز التّفكير النّقدي، لكنّه في الوقت ذاته يطرح تحديات مرتبطة بالوعي والاستخدام المسؤول. فحين يتوافر الوعي المعرفي والأخلاقي لدى الطالب، تتحول الأدوات الذّكيّة إلى وسيلة للتحليل والإبداع؛ أمّا في غيابه، فإنّها قد تؤدي إلى الاتكاليّة الفكريّة وتقليص الأصالة البحثية. وبذلك تتقاطع نتائج هذه الدّراسات مع الفرضيّة المركزية للبحث التي ترى في الوعي التقني الحلقة المفصليّة التي تحدد اتجاه العلاقة بين استخدام الذّكاء الاصطناعي وجودة التّفكير والإنتاج العلمي.
- منهج البحث: يستند هذا البحث إلى المنهج المفاهيمي التّحليلي الذي يهدف إلى بناء تصور نظري متكامل للعلاقة بين استخدام تقنيات الذّكاء الاصطناعي، والوعي التّقني، والتّفكير النّقدي والإنتاج العلمي في التّعليم العالي. ويقوم هذا المنهج على تحليل الأطر النّظريّة والدّراسات السّابقة، واستنباط العلاقات المعرفيّة الكامنة بين المتغيرات من دون الاعتماد على البيانات الميدانيّة المباشرة، إذ تركز البحوث المفاهيميّة على إعادة بناء المفاهيم وصياغة النماذج النّظريّة انطلاقًا من الأدبيّات العلميّة الراسخة.
- الإطار المفاهيمي لتقنيات الذّكاء الاصطناعي في التّعليم العالي
- مفهوم الذّكاء الاصطناعي في السّياق الأكاديمي: ظهر مفهوم الذّكاء الاصطناعي منذ منتصف القرن العشرين، وارتبط في بداياته بمحاولة محاكاة القدرات المعرفيّة البشريّة باستخدام الأنظمة والخوارزميّات الحاسوبيّة (Turing, 1950). ومع تطور هذه النّظم، انتقل الذّكاء الاصطناعي من مرحلة المحاكاة النّظريّة إلى مرحلة التّفاعل التطبيقي، وبدأ يُستخدم في مجالات مختلفة مثل الرعاية الصّحيّة، والصناعة، والتّعليم.
وفي السّياق الأكاديمي تحديدًا، يُعرَّف الذّكاء الاصطناعي بوصفه مجموعة من الأدوات، والتّقنيات الرّقميّة التي تتيح للمتعلمين إعادة تنظيم المادة المعرفيّة، وبناء مسارات تعلم شخصيّة، وتحليل البيانات التّعليميّة بطريقة تتجاوز القدرات التّقليديّة للفرد (Luckin et al., 2016). ويشمل ذلك تطبيقات متنوعة مثل نظم التّعليم التكيفي، والمساعدات الذّكيّة، وتحليل البيانات الضخمة، والنّماذج التّوليديّة مثل ChatGPT وغيرها.
- أبعاد استخدام الذّكاء الاصطناعي في التّعليم العالي: تُشير الأدبيّات الحديثة (Chiu et al., 2023; Kamalov et al., 2023) إلى أن توظيف الذّكاء الاصطناعي في التّعليم لا يمكن فهمه بمعزل عن أربعة أبعاد مترابطة، هي:
جدول (1): أبعاد استخدام تقنيات الذّكاء الاصطناعي في التّعليم العالي
| البعد | الوصف |
| تكرار الاستخدام | مدى الاعتماد المنتظم على أدوات الذّكاء الاصطناعي في الأنشطة الأكاديمية اليومية |
| تنوع الاستخدام | استخدام أكثر من نوع من التقنيات (التّعليم التكيفي، المساعد الافتراضي، التحليل التنبؤي، الخ…) |
| عمق الدمج | درجة دمج التقنية في صلب العملية التّعليمية (وليس استخدامها العرضي أو الهامشي) |
| التطبيق الهادف | ارتباط استخدام الأداة بهدف معرفي محدد، لا بمجرد التجربة أو الاستهلاك التقني |
وتؤكد هذه الأبعاد مجتمعة أنّ الأثر التّعليمي الإيجابي لا يتحقق من خلال الاستخدام السّطحي للأداة، بل من خلال دمجها ضمن إطار معرفي يُسهم في تحفيز التّحليل والتّفكير النّقدي.
- الوعي بتقنيات الذّكاء الاصطناعي كعامل وسيط
- مفهوم الوعي التقني في البيئة الجامعيّة: يشير مفهوم الوعي بتقنيات الذّكاء الاصطناعي إلى قدرة الطالب على إدراك خصائص هذه التّقنيات، وفهم آليات عملها، وتمييز إمكاناتها وحدودها، سواء من الجانب المعرفي أو الأخلاقي (Long & Magerko, 2020). ولا يقتصر هذا الوعي على المعرفة النّظريّة فحسب، بل يشمل أيضًا إدراك مخاطر الاستخدام غير المسؤول، وتقدير أثر الذّكاء الاصطناعي في العمليّة التّعليميّة والبحثيّة.
وفي هذا السياق، يعدُّ الوعي شرطًا معرفيًا أساسيًا يُمكِّن الطالب من الانتقال من الاستخدام الاستهلاكي للأداة، إلى الاستخدام النّقدي الهادف، وهو ما يجعله قادرًا على إنتاج معرفة جديدة وليس مجرد إعادة صياغة محتوى يولده النظام الذكي.
- أبعاد الوعي بتقنيات الذّكاء الاصطناعي: اعتمدت الأدبيّات على تقسيم الوعي التقني إلى ثلاثة أبعاد رئيسة (Ventura & Lopez, 2024):
جدول (2): أبعاد الوعي التقني بتقنيات الذّكاء الاصطناعي لدى طلبة الدّراسات العليا
| البعد | التفسير |
| المعرفة النّظريّة | فهم المبادئ الأساسية والتطبيقات الشائعة للذكاء الاصطناعي |
| الوعي الأخلاقي | إدراك التحديات المرتبطة بالأصالة، والخصوصية، ومصداقية المعلومات |
| القدرة التطبيقية | توظيف التقنيات في سياقات علمية بطريقة نقدية وموجهة نحو هدف علمي |
وقد بيّنت الدّراسات الحديثة (Kumar & Sharma, 2024) أنّ ارتفاع مستوى الوعي بهذه الأبعاد يرتبط إيجابيًا بزيادة قدرة الطالب على ممارسة التّفكير النّقدي وتحقيق إنتاج علمي أكثر أصالة وانضباطًا.
- العلاقة بين الذّكاء الاصطناعي والتّفكير النّقدي والإنتاج العلمي
- الذّكاء الاصطناعي بوصفه محفزًا للتفكير النّقدي: تؤكد دراسات حديثة ((Silva & Rodríguez, 2024؛Ruiz-Rojas et al., 2024)) أنّ الذّكاء الاصطناعي يمكن أن يسهم في تطوير مهارات التّفكير النّقدي لدى طلبة الدّراسات العليا، وذلك من خلال:
- توفير بيانات غنيّة ومتنوعة تجعل الطالب مطالبًا بالتّحليل والمقارنة قبل اعتماد النتائج.
- إثارة التّساؤلات البحثّية الجديدة الناتجة عن استنتاجات أو نماذج يقوم الذّكاء الاصطناعي بتوليدها.
- تعزيز التّعلم القائم على المشكلات (Problem-Based Learning)، إذ تُستخدم الأدوات الذّكيّة في اختبار بدائل متعددة للحل.
لكن هذه الإمكانات لا تتحقق تلقائيًا، بل تتوقف – كما تشير مراجعة Edupij (2023) – إلى قدرة المتعلم على التّعامل مع مخرجات الذّكاء الاصطناعي بوصفها مادة خام للتحليل لا “حلًا جاهزًا”.
- دور الوعي التقني في تشكيل الأثر: أوضحت المراجعات المنهجيّة ((Saúde et al., 2024؛ Chen & Ramírez, 2025)) أنّ علاقة الذّكاء الاصطناعي بالتّفكير النّقدي والإنتاج العلمي ليست علاقة مباشرة، وإنما تمر بوسيط رئيس هو الوعي التقني. فحين يكون مستوى الوعي منخفضًا، تصبح مخرجات الذّكاء الاصطناعي بديلًا عن الجهد العقلي، ويضعف التّفكير النّقدي تدريجيًا. أمّا حين يكون الوعي مرتفعًا، تتحول هذه المخرجات إلى مادة تحليلية تُسهم في تطوير الفهم العلمي، وبالتالي تزيد جودة الإنتاج العلمي.
ويمكن تمثيل هذه العلاقة على النحو الآتي:
استخدام الذّكاء الاصطناعي → (بواسطة الوعي) → تنمية التّفكير النّقدي → تعزيز الإنتاج العلمي
- التأصيل النّظري للعلاق: تستند هذه العلاقة إلى نموذج القدرة – الفرصة – الدّافعيّة (COM-B) الذي قدّمه Michie et al. (2011) والذي يفترض أنّ السّلوك (مثل التّفكير النّقدي أو البحث العلمي) لا يظهر إلا إذا توفرت:
- القدرة → ويُقصد بها هنا الوعي والمهارات التقنيّة.
- الفرصة → وتتمثل في توفر أدوات الذّكاء الاصطناعي في البيئة الجامعيّة.
- الدافعية → أي رغبة الطالب في استخدام هذه الأدوات لتحقيق هدف معرفي.
بناء على ذلك، يُعدّ الوعي التقني عنصر القدرة الذي يحوّل الفرصة (أي الأداة) إلى سلوك معرفي (أي تفكير نقدي وإنتاج علمي).
- النموذج المفاهيمي المقترح وتحليل العلاقة: استنادًا إلى ما سبق عرضه من أطر نظرية ونتائج دراسات حديثة، يمكن صياغة نموذج مفاهيمي يوضح الكيفيّة التي تؤثر بها تقنيات الذّكاء الاصطناعي على التّفكير النّقدي والإنتاج العلمي لدى طلاب الدّراسات العليا، مع إبراز الدور الوسيط للوعي بهذه التقنيات.
جدول (3): المتغيرات الرئيسة في النموذج المفاهيمي وتفسيرها
| العنصر | التفسير |
| المتغير المستقل | استخدام تقنيات الذّكاء الاصطناعي (تكرار – تنوع – عمق – تطبيق هادف) |
| المتغير الوسيط | الوعي بتقنيات الذّكاء الاصطناعي (معرفي – أخلاقي – تطبيقي) |
| المتغير التابع | التّفكير النّقدي والإنتاج العلمي |
- منطق العلاقة: ينطلق النّموذج من فرضيّة أن الذّكاء الاصطناعي لا يُحدث أثرًا مباشرًا بالضرورة على التّفكير النّقدي أو الإنتاج العلمي، بل إن هذا الأثر يتشكل تدريجيًا عبر قناة معرفيّة تتمثل في وعي الطالب بالتقنية وقدرته على توظيفها بصورة نقدية.
وبتعبير تحليلي: كلما زادت درجة الوعي بتقنيات الذّكاء الاصطناعي لدى طلاب الدّراسات العليا، تحوّلت هذه التقنيات من مجرد أدوات مساعدة إلى مدخلات معرفيّة تُثري قدراتهم التّحليليّة، وهو ما ينعكس مباشرةً على جودة التّفكير النّقدي والإنتاج العلمي.”
ويتماشى هذا المنطق مع ما أشار إليه Michie et al. (2011) في نموذج القدرة – الفرصة – الدّافعيّة، حيث لا يكفي توفر الأداة (الفرصة)، بل لا بد من تمكين الطالب بالقدرة المعرفيّة (الوعي) لتتحقق الدّافعيّة نحو الاستخدام العلمي الصحيح.
استخدام تقنيات الذّكاء الاصطناعي
↓
(يُمرّر عبر)
الوعي المعرفي والأخلاقي
↓
تفكير نقدي → إنتاج علمي أصيل
- خاتمة الإطار النّظري: يُظهر التّحليل السّابق أن الذّكاء الاصطناعي لم يعد مجرد ظاهرة تقنيّة عابرة في البيئة الجامعيّة، بل أصبح مكونًا بنيويًا يعيد تشكيل طبيعة النّشاط الأكاديمي ذاته. ومع ذلك، فإنّ تأثيره في تطوير القدرات المعرفيّة العليا – وخاصة التّفكير النّقدي والإنتاج العلمي – لا يتحقق بصورة تلقائية، بل يرتبط ارتباطًا وثيقًا بقدرة الطالب على الوعي بآليات هذه التّقنيات، وبالطريقة التي يُفعّل بها هذه الأدوات ضمن عملية التّفكير والبحث.
وإزاء ذلك، فإن أي مقاربة نظرية جادة لدور الذّكاء الاصطناعي في التّعليم العالي يجب أن تنتقل من فكرة “الاستخدام” إلى فكرة “التّوظيف الواعي”، بمعنى أن الذّكاء الاصطناعي لا يُنظر إليه بوصفه بديلًا عن الجهد العقلي، بل بوصفه أداة تحفيز معرفي يمكن – إذا استُيعب نقديًا – أن يُسهم في بناء نموذج أكاديمي أكثر إنتاجًا وابتكارًا.
وبناءً على هذا الفهم، يقترح المقال الحالي قراءةً مفاهيميّة ترى أن الوعي التقني يمثل نقطة التحول التي من خلالها يصبح الذّكاء الاصطناعي قوة داعمة للتفكير النّقدي ومسرّعًا للإنتاج العلمي.
- مناقشة النتائج في ضوء الأدبيّات والسّياق العربي: تكشف نتائج التحليل المفاهيمي، المدعومة بالأدبيّات التّربويّة المعاصرة، أن العلاقة بين استخدام تقنيات الذّكاء الاصطناعي وتنمية مهارات التّفكير النّقدي والإنتاج العلمي ليست علاقة ميكانيكيّة مباشرة، وإنما علاقة مشروطة بمستوى الوعي التقني لدى المتعلم. وهذا ما ينسجم مع ما أكدته دراسات مثل Ruiz-Rojas et al. (2024) و Saúde et al. (2024) التي أوضحت أن الذّكاء الاصطناعي، قد يتحول إلى عنصر محفّز لقدرات التّحليل والاستنتاج متى ما ارتبط استخدامه بقدرة المتعلم على التمييز بين المعلومة الخام وبين القيمة المعرفيّة التي يمكن استخراجها منها.
غير أنّ هذه النتيجة تتخذ بعدًا أكثر حساسيّة في الواقع العربي، إذ تشير دراسات عربيّة حديثة (الرفاعي وسعد، 2022؛ الصيادي والسالم، 2023) إلى أنّ جزءًا من الطلبة يلجأ إلى أدوات الذّكاء الاصطناعي بغرض تسريع الإنجاز والاختصار، من دون امتلاك وعي نظري كافٍ بطبيعة هذه الأدوات أو التّأطير المعرفي الذي أحاط بتصميمها. وهو ما يفسّر – في كثير من الأحيان – تضارب النتائج بين الطلبة لجودة الإنتاج العلمي، على الرّغم من استخدامهم للأدوات ذاتها.
كما أن بعض الدّراسات العربيّة مثل (خير وحالات، 2023) حذّرت من أن الاستخدام الآلي للذكاء الاصطناعي – من دون بناء إدراك نقدي مسبق – قد يؤدي إلى تراجع مهارات الأصالة والابتكار، وهو ما يظهر أحيانًا في الاعتماد على “الصّياغة الآلية” أو النّقل غير الواعي للمحتوى الذي تولده النّماذج الذّكيّة، وهو ما يتعارض مع متطلبات النزاهة العلميّة. ويعزز ذلك ما أشارت إليه اليونسكو (2023) من ضرورة تنمية الوعي الأخلاقي لدى المتعلمين العرب، كشرط أساسي لتوظيف الذّكاء الاصطناعي في التّعليم العالي على نحو مسؤول وفعّال.
وبذلك، يمكن القول إنّ السّياق العربي يؤكد النتيجة المركزيّة التي توصّلت إليها الأدبيّات الأجنبيّة، وهي أنّ الوعي التقني يمثل العامل الحاسم الذي يحدد ما إذا كانت مخرجات الذّكاء الاصطناعي، ستُستخدم لتعزيز التّفكير النّقدي أو لتعميق النّمط التلقيني. وعلى الرّغم من أن العديد من الجامعات في المنطقة العربيّة بدأت فعليًا في دمج أدوات الذّكاء الاصطناعي في منصاتها التّعليميّة، فإنّ تحدي بناء هذا الوعي لا يزال قائمًا، ولا يمكن تجاوزه إلّا من خلال إدماج مكوّنات “الوعي التّقني النّقدي” ضمن المناهج والبرامج التّدريبيّة الموجهة لطلبة الدّراسات العليا.
ومن ثم، يصبح من الضروري – في ضوء الواقع العربي – الانتقال من مرحلة توفير الأدوات إلى مرحلة تمكين الاستخدام الواعي، بحيث تتولى المؤسسات الجامعية ومراكز البحث العلمي دورًا أكثر فاعليّة في توجيه الطلبة نحو الاستخدام النّقدي والأخلاقي للذكاء الاصطناعي، بما يجعله رافعة حقيقيّة للإنتاج العلمي، وليس مجرد أداة لنسخ المعرفة أو إعادة تدويرها.
- التّوصيات: في ضوء ما سبق من تحليل نظري ومناقشة في سياقه العربي، يمكن صياغة مجموعة من التّوصيات التي من شأنها تعزيز الدّور الإيجابي، لتقنيات الذّكاء الاصطناعي في تنمية التّفكير النّقدي والإنتاج العلمي لدى طلبة الدّراسات العليا، وذلك على النّحو الآتي:
- إدماج مقررات الوعي التّقني في برامج الدّراسات العليا، إذ تتضمن مفاهيم استخدام الذّكاء الاصطناعي من منظور نقدي وأخلاقي، وليس فقط من منظور وظيفي أو تقني.
- تنظيم ورش تدريبية دوريّة داخل الجامعات العربية لتعزيز الاستخدام الواعي لأدوات الذّكاء الاصطناعي في البحث العلمي، وربطها بمفاهيم الأصالة والابتكار العلمي.
- تضمين مبدأ “التحليل النّقدي لمخرجات الذّكاء الاصطناعي” في تقييمات المقررات، إذ لا تُقبل المخرجات الآلية من دون تفسير أو تحليل شخصي من الطالب.
- تعزيز التّعاون بين الكليات التّربويّة والتّقنيّة داخل الجامعات العربيّة من أجل تطوير نماذج تعليميّة مشتركة تجمع بين البعد التكنولوجي والبعد التربوي.
- تطوير آليات رقابية وأخلاقية واضحة للاستخدام التّعليمي لأدوات الذّكاء الاصطناعي، تجنّب إساءة الاستخدام أو الإخلال بمبدأ النزاهة الأكاديمية في إعداد البحوث والرسائل الجامعية.
- الخاتمة: خلص هذا المقال المفاهيمي إلى أنّ تقنيات الذّكاء الاصطناعي تمثل فرصة حقيقيّة لتطوير قدرات التّفكير النّقدي، ودفع عجلة الإنتاج العلمي داخل مؤسسات التّعليم العالي، غير أنّ هذه الفرصة لا تتحقق بصورة آلية، أو نتيجة مجرد توافر الأدوات، وإنما من خلال مستوى الوعي المعرفي والأخلاقي الذي يمتلكه المتعلم تجاه هذه التقنيات.
وقد بيّنت الأدبيّات المعاصرة، وكذلك التّجارب العربيّة، أن الذّكاء الاصطناعي يمكن أن يكون أداة للتحفيز المعرفي إذا وُظِّف نقديًا، كما يمكن – في المقابل – أن يتحول إلى أداة للتكرار والاستسهال إذا غاب هذا الوعي. ومن هنا، يصبح الاستثمار الحقيقي في هذه التكنولوجيات ليس في اقتنائها فقط، بل في تمكين الطلبة من تحليلها وتوجيهها نحو إنتاج علمي أصيل يتوافق مع قيم البحث الأكاديمي.
وفي ضوء ذلك كله، فإن تطوير برامج تعليميّة تقوم على “التوظيف الواعي” للذكاء الاصطناعي يُعدّ شرطًا مسبقًا لبناء جيل من الباحثين القادرين على الابتكار والمشاركة الفاعلة في مجتمع المعرفة الرقمي.
- المراجع
- المراجع باللغة العربيّة
- خير، ر.، & حالات، أ. (2023). تعزيز التّفكير النّقدي والأخلاقي في عصر الذّكاء الاصطناعي: مقاربة عملية. MEPLI. https://tinyurl.com/3k3bdfuc
- الرفاعي، م.، & سعد، ج. (2022). أثر الذّكاء الاصطناعي في تطوير مهارات الطلاب في التّعليم العالي. مجلة البحوث التّعليمية، 34(2)، 112–126.
- الزهيري، ع.، & عبد الله، ف. (2023). استخدام الذّكاء الاصطناعي في تعزيز التعلم الإلكتروني في الجامعات العربية. مجلة التّعليم العالي، 20(1)، 45–60.
- الصيادي، ف.، & السالم، م. (2023). دور الذّكاء الاصطناعي في تطوير مهارات البحث العلمي لدى طالبات كلية التربية بجامعة الملك سعود. مجلة البحوث التربوية، 18(3)، 211–225. https://jeor.journals.ekb.eg/article_310066.html
- العتيبي، ع.، البلوي، م.، الحربي، س.، & القحطاني، ف. (2022). دور الذّكاء الاصطناعي في تنمية مهارات التّفكير الناقد والاتجاهات العلمية لدى طالبات الصف الثاني الثانوي في مقرر الفيزياء. مجلة العلوم التربوية، 45(2). https://tinyurl.com/2fy6ymn5
- غالي، ن. ع. (2021). دور الإعلام التفاعلي في الوعي التربوي للأم المصرية: دراسة ميدانية. المجلة العلمية لبحوث الإذاعة والتلفزيون(21)، 255–275.
- منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو). (2023). الذّكاء الاصطناعي في التّعليم. مسترجع من https://www.unesco.org/en/digital-education/artificial-intelligence
- المراجع باللغة الأجنبية
-8Aggarwal, N., & Jaidev, R. (2007). Teaching effective communication through e-learning. https://core.ac.uk/download/12118629.pdf
-9Almasri, S. (2024). Exploring the impact of artificial intelligence in teaching and learning of science: A systematic review of empirical research. Research in Science & Technological Education. https://link.springer.com/article/10.1007/s11165-024-10176-3
-10Alrabiah, Z., & Al-Rawi, M. B. A. (2023). Assessment of awareness, perceptions, and opinions towards artificial intelligence among healthcare students in Riyadh, Saudi Arabia. Medicina, 59(5), 828. https://doi.org/10.3390/medicina59050828
-11Chen, S., & Ramírez, J. (2025). Artificial intelligence in higher education: Research notes from a systematic review. Technological Forecasting and Social Change, 200, 122116.
-12Chen, S., & Zhang, M. (2023). The role of AI in higher education: A comprehensive review. Educational Technology Research & Development, 71(5), 1075–1090. https://doi.org/10.1007/s11423-023-10016-2
-13Kamalov, M., Liu, Y., & Shih, H. (2023). Measuring AI integration in higher education: A study of purposeful application and depth of integration. International Journal of Educational Technology, 29(3), 267–279. https://arxiv.org/abs/2305.18303
-14Kumar, A., & Sharma, P. (2024). Understanding student awareness and perception towards AI tools in higher education. International Journal of Creative Research Thoughts, 12(4), 210–219. https://ijcrt.org/papers/IJCRT2409210.pdf
-15Michie, S., van Stralen, M. M., & West, R. (2011). The behaviour change wheel: A new method for characterising and designing behaviour change interventions. Implementation Science, 6(1), 42. https://doi.org/10.1186/1748-5908-6-42
-16Ruiz-Rojas, E., Salvador-Ullauri, A., & Acosta-Vargas, A. (2024). Collaborative working and critical thinking: Adoption of generative artificial intelligence tools in higher education. Sustainability, 16(13), 5367. https://doi.org/10.3390/su16135367
-17Saúde, R., Barros, C., & Almeida, M. (2024). Impacts of generative artificial intelligence in higher education: Research trends and students’ perceptions. Social Sciences, 13(8), 410. https://doi.org/10.3390/socsci13080410
-18Silva, D., & Rodríguez, M. (2024). The effect of generative AI on cognitive thinking skills in higher education: A systematic literature review. In M. Mallick (Ed.), Artificial Intelligence in Higher Education (pp. 297–310). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-031-78255-8_21
-19Ventura, A. M. C., & Lopez, L. S. (2024). Unlocking the future of learning: Assessing students’ awareness and usage of AI tools. International Journal of Information and Education Technology, 14(8), 1136–1144. https://doi.org/10.18178/ijiet.2024.14.8.2142
[1] – طالب دكتوراه في اختصاص الموارد البشرية، جامعة آزاد، طهران.
PhD student in Human Resources, Azad University, Tehran.Email:fadelabbaseducation@gmail.com
– أكاديمي وباحث في مجال الإدارة والأعمال، وعضو هيئة تدريس في برامج الدراسات العليا، ويُدرّس حاليًا في الجامعات اللبنانية الخاصة -[2]
Academic and researcher in the field of management and business, faculty member in graduate programs, and currently teaching at private Lebanese universities.Email: sj_annan64@hotmail.com