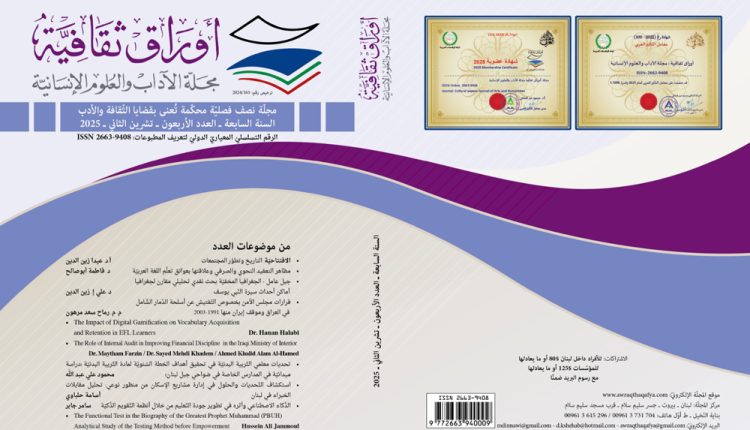عنوان البحث: استكشاف التّحديات والحلول في إدارة مشاريع الإسكان من منظور نوعي: تحليل مقابلات الخبراء في لبنان
اسم الكاتب: أسامة حلباوي
تاريخ النشر: 2025/11/14
اسم المجلة: مجلة أوراق ثقافية
عدد المجلة: 40
تحميل البحث بصيغة PDFADOI: https://aif-doi.org/awraq/014011
استكشاف التّحديات والحلول في إدارة مشاريع الإسكان من منظور نوعي: تحليل مقابلات الخبراء في لبنان
Exploring Challenges and Solutions in Housing Project Management from a Qualitative Perspective: Analysis of Expert Interviews in Lebanon
أسامة حلباوي([1])Osama Halbawi
تاريخ الإرسال:16-10-2025 تاريخ القبول: 28-10-2025
الملخص turnitin:8%
تهدف هذه الدّراسة النّوعيّة إلى استكشاف التّحديات، والفرص المرتبطة بإدارة مشاريع الإسكان في البيئة العربية، مع تركيز خاص على لبنان. ومن خلال إجراء مقابلات شبه منظمة مع 15 مشاركًا من مختلف الجهات الفاعلة—بينهم مسؤولون حكوميون، مطوّرون عقاريون، وخبراء في قطاع الإسكان—اعتمدت الدّراسة “وفق منهج التحليل الموضوع الذي قدمه كلارك وبراون[2] لكشف العوامل الأساسيّة المؤدية إلى أزمة الإسكان، وتقييم فعاليّة الممارسات الإداريّة الحاليّة. أفرز التّحليل 138 كودًا جُمِّعت في خمس موضوعات رئيسة: أسباب الأزمة، ممارسات إدارة المشاريع، توظيف التكنولوجيا الذّكيّة، فعاليّة الشّراكات بين القطاعين، والابتكار في ظل التّحديات التّمويليّة. كشفت النتائج إجماع بين المشاركين حول التّأثير الحاسم للنّمو السكاني، وضعف التّمويل طويل الأمد، وتفتت الأطر الإداريّة في تعميق أزمة السّكن. كما أظهرت الدّراسة أنّ تطبيق أدوات الإدارة الحديثة لا يزال غير منتظم، في حين تبرز تقنيات مثل نمذجة معلومات البناء (BIM) و منصات المراقبة في الوقت الفعلي كفرص واعدة لم يُستفاد منها بالشّكل الكافي. وقد كان تأكيد أنّ نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص تمثل خيارًا واقعيًا في ظل القيود المالية، بشرط توافر إطار تشريعي واضح وحوافز استثمارية مشجعة. خلصت الدّراسة إلى أن تحقيق إدارة إسكانية فعالة ومستدامة يتطلب إصلاحًا مؤسسيًا شاملًا، ودمجًا واسعًا للتقنيات الحديثة، إلى جانب تطوير آليات تمويل مرنة تراعي الخصوصية المحلية.
الكلمات المفتاحيّة: أزمة السّكن، إدارة المشاريع، البحث النّوعي، الشّراكات بين القطاعين، BIM، الحوكمة الحضرية، لبنان، التّحليل الموضوعي.
Abstract
This qualitative study aims to explore the challenges and opportunities associated with housing project management in the Arab context, with a particular focus on Lebanon. Through semi-structured interviews with fifteen participants—including government officials, real estate developers, and housing sector experts—the study employed the thematic analysis approach proposed by Clarke and Braun (2006) to identify the key factors contributing to the housing crisis and to evaluate the effectiveness of current management practices.
The analysis generated 138 codes grouped into five main themes: causes of the crisis, project management practices, the adoption of smart technologies, the effectiveness of public–private partnerships, and innovation under financial constraints.
Findings revealed a consensus among participants regarding the critical impact of population growth, the lack of long-term financing, and the fragmentation of administrative frameworks in exacerbating the housing crisis. The study also showed that the application of modern management tools remains inconsistent, while technologies such as Building Information Modeling (BIM) and real-time monitoring platforms represent promising yet underutilized opportunities.
Furthermore, public–private partnership (PPP) models were identified as a realistic option amid financial constraints, provided that a clear legislative framework and adequate investment incentives are in place. The study concludes that achieving effective and sustainable housing management requires comprehensive institutional reform, the broad integration of modern technologies, and the development of flexible financing mechanisms tailored to local contexts.
Keywords: Housing crisis, project management, qualitative research, public-private partnerships, BIM, urban governance, Lebanon, thematic analysis
المقدّمة
يعتمد فهم أزمة السّكن في السّياقات النّامية على إدراك التّفاعل بين العوامل الاقتصاديّة، والسياسيّة، والاجتماعيّة التي لا يمكن قياسها بالأرقام وحدها. يشير Rogers (2003) إلى أنّ انتشار الابتكار يتوقف على قبول الأطراف المعنيّة واستعدادهم لتغيير ممارساتهم. كما تُظهر دراسات Chetty et al. (2016) أنّ البيئة السكنيّة تؤثر مباشرة على الفرص الاجتماعيّة والاقتصاديّة للأسر. من هذا المنطلق، توفر الأساليب النّوعيّة – ولا سيّما المقابلات شبه المنظمة – منظورًا غنيًا لرصد أصوات الخبراء والممارسين، واستخلاص الدّروس من التّجارب الميدانيّة (Nguyen & Hoang, 2025). تهدف هذه الدّراسة إلى كشف التّحديات البنيويّة التي تعوق مشاريع الإسكان في لبنان، وإبراز الحلول الإبداعيّة المستندة إلى الخبرة العمليّة، مع التركيز على دور التكنولوجيا والشّراكات والحوكمة المحليّة.
الإشكاليّة: على الرّغم من وفرة الخطط والاستراتيجيات الإسكانيّة في الدول النّامية، لا تزال أزمة السكن قائمة بل تتفاقم، نتيجة فجوة واضحة بين التّخطيط النّظري والتّنفيذ الواقعي، أضف إلى القصور في تكييف الحلول العالميّة مع السّياقات المحليّة وان المشاريع العمرانيّة تعاني من ضعف في التّنسيق بين الجهات المعنيّة، وغياب منهجيّة تشاركيّة حقيقيّة مع المجتمع المحلي، إضافة إلى غياب آليات فعّالة لتقييم التّحديات البيئيّة والإداريّة والتّنظيميّة التي تؤدي غالبًا إلى تعثر المشاريع أو تأخرها.
وفي ظل التّحول الرّقمي، والنّمو السكاني، وتغيّر المناخ، تتزايد الحاجة إلى فهم أعمق لكيفيّة إدراك أصحاب المصلحة – من مسؤولين حكوميين وخبراء حضريين ومواطنين – لهذه التّحديات المتراكبة. كما أنّ استكشاف تجارب واقعيّة، سواء لمشاريع إسكانيّة ناجحة أو متعثرة، بات ضرورة بحثيّة ملحّة لفهم السّياق المحلي، وتحليل التّفاعل المعقد بين العوامل الاجتماعيّة، والمؤسسيّة التي تتحكم في نجاح أو فشل المشاريع السّكنيّة (Costa & Garza, 2023; Morrison & Stadelmann, 2024).
وعليه، تنبع مشكلة الدّراسة النّوعيّة من ضرورة إجراء تحليل ميداني معمق لتجارب تنفيذ مشاريع الإسكان، بالاعتماد على آراء وملاحظات أصحاب القرار، والجهات المنفذة، والمستفيدين المباشرين. ويهدف هذا التّحليل إلى كشف العوائق الحقيقيّة الكامنة خلف الأزمات السّكنيّة المتكررة، واستنباط حلول تطبيقيّة متكاملة ومرنة، تستجيب للاحتياجات الفعليّة، وتسهم في الحدّ من أزمة السّكن بشكل مستدام وفعّال (UN-Habitat, 2023; UNEP, 2023).
الأسئلة البحثيّة:
- كيف يدرك أصحاب القرار والخبراء، والمستفيدون التّحديات التي تواجه تنفيذ مشاريع الإسكان؟
- ما هي أبرز العوائق البيئيّة والمؤسسيّة التي تعرقل مشاريع الإسكان في الواقع المحلي؟
- ما السّمات المشتركة بين التّجارب الناجحة والتّجارب المتعثرة في مشاريع الإسكان؟
- كيف يمكن تعزيز التّنسيق بين القطاعات وتحقيق الحوكمة المتكاملة في إدارة مشاريع الإسكان؟
- ما الاستراتيجيات النّوعيّة المقترحة للتغلب على أزمة السكن بشكل مستدام في السّياقات العربيّة؟
أهمية الدّراسة: تكمن أهمّيّة هذه الدّراسة النّوعيّة في قدرتها على تقديم فهم معمّق، وشامل لأزمة السّكن من منظور الفاعلين الأساسيين في الميدان، بما فيهم المسؤولون الحكوميون، الخبراء في التّخطيط العمراني، والمستفيدون من المشاريع السّكنيّة. فهي تتجاوز التّحليل الإحصائي الجامد لتسبر أغوار الواقع الاجتماعي والمؤسسي المرتبط بتنفيذ المشاريع، وتكشف العوائق غير المرئيّة التي لا تظهر في الأرقام (Rajagopal, 2023؛ Hassan, 2024).
على المستوى الأكاديمي، ترفد هذه الدّراسة الأدبيّات المتعلقة بالتّخطيط العمراني، التنمية المستدامة، والمشاركة المجتمعيّة، من خلال توثيق التّجارب الميدانيّة وتحليلها باستخدام منهجيّات نوعيّة متقدمة كدراسة الحالة والتّحليل الموضوعي (Costa & Garza, 2023). كما تسهم في توسيع المفاهيم النّظريّة المرتبطة بالحوكمة الحضريّة، والتّخطيط التّشاركي، والتكيّف المحلي، في سياق التغيرات المناخيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة (UNEP, 2023).
أمّا من النّاحية التّطبيقيّة، فإن نتائج هذه الدّراسة تقدم لصناع القرار توصيات عمليّة قائمة على الواقع، وليست مجرد مقترحات نظريّة. فهي تساعد في فهم أسباب تعثر بعض المشاريع، وتوضح كيف يمكن تفعيل آليات المشاركة، التّنسيق، والتّقييم المرحلي لضمان نجاح تنفيذ مشاريع الإسكان (Purton, 2024؛ Morrison & Stadelmann, 2024).
مراجعة الأدبيات
– في العراق، تضمّنت دراسة السّعدي والمسعودي (2012) فصلًا كاملًا حول المعالجات المقترحة لأزمة السكن. من بين الحلول التي ناقشها الباحثان تفعيل دور القطاع الخاص عبر شراكات فعالة مع الحكومة للمساهمة في إنشاء مشاريع إسكان جديدة. وأشارا إلى أهمّيّة استقطاب الاستثمارات وتمويل المشاريع الإسكانيّة الكبيرة بوساطة صيغ تمويليّة مبتكرة تتجاوز الموازنات الحكوميّة المحدودة. كما أكدت الدّراسة ضرورة إنشاء هيّئة وطنيّة للإسكان أو دعم مكاتب إدارة المشاريع (PMO) لمتابعة تنفيذ الخطط الإسكانيّة وضمان استمراريتها. وشملت المقترحات أيضًا تبسيط الإجراءات البيروقراطيّة، ومنح حوافز وتسهيلات للمطوّرين العقاريين، فيُسرَّع البناء وتُقلَّل تكلفة الوحدة السّكنيّة. بالإضافة لذلك، أوصى الباحثان بوضع خطة استراتيجيّة طويلة المدى تراعي اللامركزيّة، إذ تُنفّذ مشروعات الإسكان في المحافظات بآليات تمويل محليّة وخارجيّة جميعها.
أمّا في الجزائر، فقد شددت دراسة بن حرز الله (2020) على ضرورة رفع كفاءة الإنتاج السّكني كحلّ جذري. ويتحقق ذلك – بحسب الدّراسة – عبر تحديث سياسات الإسكان لتشجيع البناء المنظم والسّريع. أوصى الباحث بدعم المؤسسات المقاولاتيّة، وتمكينها من استخدام تقنيات بناء حديثة تزيد من سرعة الإنجاز وجودته. كما اقترح تحرير قطاع السّكن من القيود الإدارية وإزالة العقبات أمام المطوّرين، بما في ذلك تسهيل إجراءات التّراخيص وتخصيص الأراضي بأسعار مدعومة لمشاريع الإسكان الاجتماعي. وترى الدّراسة أنّه ينبغي وضع خطط تنمويّة متوازنة توزّع المشاريع الإسكانيّة بعدالة بين مختلف المناطق (المدن والبلدات)، لتجنب تركز كل المشروعات في المدن الكبرى وحدها.
إلى جانب ذلك، تناولت بعض البحوث إمكانات الذّكاء الاصطناعي (AI) وإنترنت الأشياء (IoT) في التّخطيط العمراني وإدارة المدن. فمثلًا، في دراسة قدمها الجوهري (2020) تبنيَ نموذج محاكاة افتراضي لمدينة، يستخدم خوارزميّات ذكاء اصطناعي لتحليل أنماط الكثافة السكانيّة وحركة النقل، ثم يقترح التوزيع الأمثل للأحياء السكنيّة بما يقلل الازدحام المروري ويعظّم استفادة السكان من الخدمات. تبيّن من نموذج الجوهري أنّ الدّمج بين بيانات مجسّات الأبنية (IoT) (مثل استهلاك الطاقة والمياه) وبيانات التّخطيط يمكن أن يوجّه المطوّرين لاعتماد تصاميم أكثر كفاءة واستدامة. وأوصت الدّراسة بإنشاء منصات بيانات حضريّة تجمع بيانات الوقت الحقيقي عن المدينة، وتدعم اتخاذ القرار التلقائي أو شبه التلقائي في تطوير الأحياء الجديدة.
ومن الأمثلة التّطبيقيّة على الابتكار التّقني في مجال العمران، مبادرة أجرتها إحدى البلديات الخليجيّة باستخدام الطباعة ثلاثيّة الأبعاد للبناء. أشارت التّقارير إلى أنه أُنشيء مبنى مكتبي كامل في دبي باستخدام طابعة خرسانيّة ثلاثيّة الأبعاد خلال 17 يومًا فقط، وتركيبه خلال يومين، وبكلفة حوالى 140 ألف دولار – أيّ أقل بحوالي 50% من تكاليف البناء التقليدي لمبنى مماثل. وتُظهر هذه التّجربة أن تقنيات البناء الحديثة يمكن أن تكون حلًّا جزئيًا لتسريع توفير الوحدات السّكنيّة، وتقليل الاعتماد على الأيدي العاملة الكثيفة. إلّا أنّ الدّراسات نوّهت إلى ضرورة تكييف هذه التقنيات مع البيئة المحليّة، ومواد البناء المتوفرة محليًا لضمان جدواها الاقتصاديّة.
في السّياق نفسه، تناولت بعض الدّراسات مفهوم “المدن الذكيّة” وكيفيّة توظيفه في تحقيق تنمية عمرانية مستدامة. على سبيل المثال، ناقشت ورقة قُدمت في مؤتمر عربي العام 2022 (جامعة القاهرة) مشروع تطوير حي ذكي ضمن العاصمة الإداريّة الجديدة في مصر، إذ ستتضمَّن المباني والبنية التّحتيّة أجهزة استشعار لمتابعة الاستهلاك والبيئة لحظيًا. وأوضحت الورقة أنّ هذه المنظومات الذّكيّة تساعد في ترشيد استخدام الطاقة والمياه في المجمعات السّكنيّة بنسبة قد تصل إلى 30% عبر أنظمة الإدارة الآلية. كما أنّها تحسّن من جودة الحياة عبر إدارة المرور والإضاءة والنُّفايات بشكل أكثر كفاءة. وأوصت الدّراسة بتبنّي معايير المدن الذّكيّة في مشاريع الإسكان المستقبليّة لضمان كفاءة الأداء على المدى البعيد وتقليل الكلفة التّشغيليّة.
تناولت الأدبيات الأجنبيّة البُعد البيئي والمناخي كأحد مستجدات أزمة السّكن العالميّة. إذ يرى كوستا وغارزا (2023) أنّ تغيّر المناخ بات “يضاعف” أزمة السّكن؛ فمن جهة تدمر الكوارث الطبيعيّة (فيضانات، أعاصير، حرائق غابات) آلاف المساكن سنويًا وتُشرّد ساكنيها، ومن جهة أخرى يؤدي نقص الإسكان الميسّر إلى دفع الفقراء نحو السّكن في مناطق خطرة بيئيًا (كسفوح الجبال أو السّهول الفيضيّة) ما يجعلهم أكثر عرضة لتبعات تغيّر المناخ. ووفاقًا لتقرير المنتدى الاقتصادي العالمي (2023)، فإنّ 10% من قيمة العقارات السّكنيّة حول العالم مهددة بتأثيرات مباشرة للاحترار العالمي. هذا الواقع الجديد جعل الباحثين يشددون على أنّ أية استراتيجيّة لحلّ أزمة السّكن، يجب أن تأخذ في الحسبان معايير الاستدامة والمرونة أمام المناخ.
من منظور سياسات الإسكان، وجدت دراسة أجراها بيرتون وآخرون (2024) أنّ الدّول التي تبنّت سياسات إسكانيّة شموليّة في الماضي (مثل سنغافورة أو فيينا) كانت أقل عرضة لأزمة الإسكان مقارنةً بدول تخلّت تدريجيًا عن دعم الإسكان (مثل الولايات المتحدة بعد الثمانينيات). كما يُشير تحليل حديث لصندوق النقد الدّولي (IMF, 2021) إلى أنّ سياسات التّمويل العقاري السّهلة (كمنح قروض الإسكان بفوائد منخفضة جدًا) ساهمت في رفع الطلب على المساكن، ودفع الأسعار إلى مستويات غير مستدامة في العديد من المدن العالمية، ما خلق فقاعات سُعريّة وزاد من صعوبة حصول الأسر على مسكن ميسر. هذا العامل برز بشكل واضح في مدن كبرى مثل فانكوفر ولندن وملبورن، إذ تدفق المستثمرون الأجانب والمحليون لشراء العقارات كأصول استثماريّة آمنة، فارتفعت الأسعار بعيدًا من متناول السكان المحليين ذوي المداخيل المتوسطة.
أوضحت مراجعة الأدبيات أن أزمة السكن تُعد قضيّة مركبة ومتعددة الأبعاد، وقد تناولتها الدّراسات العربيّة والأجنبيّة من زوايا مختلفة تكمل بعضها البعض. ركزت الدّراسات العربيّة على البعد المحلي التّطبيقي، مسلّطة الضوء على التّحديات الميدانيّة التي تواجه تنفيذ مشاريع الإسكان، مثل البيروقراطيّة، محدوديّة التمويل، وضعف التّنسيق المؤسسي. أمّا الدّراسات الأجنبيّة، فقد انطلقت من منظور عالمي نظري وتجريبي، وقدّمت تحليلات شاملة للاتجاهات الكليّة في السياسات السّكنيّة، إلى جانب استعراض حلول مبتكرة تعتمد على مفاهيم حديثة كالإدارة المرنة، المدن الذّكيّة، واستخدام التكنولوجيا في التّخطيط العمراني. وهكذا، فإن كلٍّ من السّياقين البحثيين أسهم في توضيح جوانب مختلفة من الأزمة، ما يؤكد الحاجة إلى تكامل الرؤيتين لبناء استراتيجيات شاملة وفعالة.
المنهج: تتبنى الدّراسة النّوعيّة منهج استكشافي تفسيري يسعى لاستخراج التّحديات، والحلول المطروحة من واقع خبرات المسؤولين والخبراء والمطورين. لقد صُمِّم دليل مقابلات شبه مهيكلة يشمل 10 أسئلة مفتوحة تغطي محاور الدّراسة. تناولت المقابلات موضوعات مثل أسباب أزمة السّكن، كفاءة ممارسات إدارة المشاريع، ومدى فاعليّة الشّراكات والتكنولوجيا في معالجة الأزمة.
في هذه الدّراسة، صُمِّم دليل مقابلات شبه مهيكلة موجه لعدد من أصحاب المصلحة الأساسيين في قطاع الإسكان، وهم: المسؤولون الحكوميون، الخبراء في إدارة المشاريع والإسكان، والمطورون العقاريون. هدفت هذه المقابلات إلى استكشاف تصورات، وتجارب هؤلاء المشاركين بشكل نوعي حول الاستراتيجيّات المستخدمة في إدارة مشاريع الإسكان، ومدى فاعليّة التكنولوجيا، السياسات، الشّراكات، وأدوات الابتكار في معالجة الأزمة السّكنيّة.
يتألف دليل المقابلة من عشرة أسئلة مفتوحة، صُمّمت بعناية لالتقاط الخبرات العمليّة والآراء المهنيّة للمشاركين. تبدأ المقابلة بسؤال تمهيدي حول واقع أزمة السّكن وأبرز أسبابها، لتوفير خلفيّة سياقيّة تساعد في فهم وجهات نظر المشاركين بشكل أعمق. تلي ذلك مجموعة من الأسئلة التي تتناول محاور الدّراسة السّبعة، مثل كفاءة ممارسات إدارة المشاريع، توظيف التكنولوجيا الذّكيّة كنمذجة معلومات البناء BIM أو أنظمة المتابعة الرّقميّة، وفاعليّة الشّراكات بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب تساؤلات حول السياسات الحكوميّة، وتكييف النّماذج العالميّة، والابتكار الإداري والتّقني.
كما تضمنت المقابلة أسئلة استكشافيّة، بشأن مرونة الإدارة في مواجهة التّغيرات والأزمات المفاجئة، والتّجارب المتعلقة بتنفيذ أو تكييف نماذج إسكانيّة من الخارج مع مراعاة السّياق المحلي، بالإضافة إلى رصد التّحديات والمعوقات التي واجهها المشاركون في مشاريعهم، والحلول التي اتُبِعت. وقد خُتمت المقابلة بسؤال مفتوح لإتاحة المجال أمام المشاركين لتقديم مقترحات عمليّة لتحسين إدارة مشاريع الإسكان في المدى القريب والمتوسط.
جرت المقابلات إمّا وجهًا لوجه أو عبر تطبيق Zoom بحسب ظروف المشاركين، وبلغت مدة كل مقابلة ما بين 30 و45 دقيقة. وقد سُجِّلت المقابلات جميعها بموافقة المشاركين، وفُرِّغت بدقة تمهيدًا لتحليلها لاحقًا باستخدام التّحليل الموضوعي.
أُجريت المقابلات بشكل مباشر، أو من بعد ظرفًا لتوفر المشاركين، وقد سُجِّلت وفُرِّغت لتحليلها من خلال منهج التّحليل الموضوعي (Braun & Clarke, 2006).
تأكد البحث من الالتزام بالاعتبارات الأخلاقيّة، وحصل على موافقة مسبقة من المشاركين كافّة، مع الحرص على سريّة المعلومات وعدم ربط الهويات بالآراء المذكورة.
نتائج المقابلات: انطلق تحليل المقابلات وفاق منهج Clarke & Braun (2006) من قراءة تفريغات الجلسات جميعها أكثر من مرة حتى تشبّع الباحث بالنّصوص، وسجّل ملاحظات أوّلية عن الأفكار المتكرّرة بشأن أزمة السّكن وإدارة المشاريع. بعد ذلك أُجريت مرحلة التكويد المفتوح، فاستُخلصت 138 كودًا أوّليًا غطّت المحاور التّسعة في دليل الأسئلة. ثم جُمعت الأكواد في مجموعات متقاربة، ومُراجَعَت لضمان اتساقها الدّاخلي وتميّزها الخارجي، فاستقرّ التّحليل على خمسة موضوعات رئيسة و11 موضوعًا فرعيًا تعبّر عن التّجربة المشتركة للمسؤولين والخبراء والمطوّرين العقاريين.
الموضوع الأول: العوامل المؤدية لأزمة السّكن.
تقاطعت شهادات المشاركين حول ثلاث علل جوهريّة: النّمو السكاني السّريع، وارتفاع كلفة الأراضي والخدمات، وضعف قنوات التمويل طويل الأجل. أكّد أحد الخبراء أنّ «الهجرة الدّاخليّة نحو المدن تضغط على الطلب أكثر مما تستطيع السّوق تلبيته، فيما تتراجع القدرة الشّرائيّة للأسر»؛ بينما شدّد مطوّر عقاري على أنّ «غياب الحوافز الضّريبيّة يشجّع احتكار الأراضي وارتفاع الأسعار». يظهر من إجابات المسؤولين أنّ الإطار التنظيمي المتشظّي، وفجوات التّنسيق بين الوزارات يفاقمان المشكلة، ما يؤكد التّداخل الوثيق بين الأبعاد الديموغرافيّة والاقتصاديّة والإداريّة للأزمة.
الموضوع الثاني: مستوى تطبيق ممارسات إدارة المشاريع.
أجمع المطوّرون على أنّ أدوات التّخطيط الزّمني، وإدارة المخاطر تُعَدّ «حاضرَة اسميًا» في عقود المقاولات، لكنّها غالبًا لا تُحدّث بعد وقوع صدمات في التّكلفة أو الجدول الزّمني. رأى الخبراء أنّ المشكلة لا تكمن في نقص المعرفة بل في غياب مؤشرات أداء إلزاميّة تراقب الالتزام بالمخططات. بالمقابل، وصف أحد المسؤولين تطبيق تلك الممارسات أنّه «مقبول لكنّه يحتاج رقابة خارجيّة أكثر صرامة»؛ ما يشير إلى فجوة واضحة بين التّخطيط النّظري والتنفيذ الفعلي.
الموضوع الثالث: توظيف التكنولوجيا الذكية في مشاريع الإسكان.
أكد المطوّرون الخمسة استخدام نمذجة معلومات البناء (BIM) و منصات المراقبة في الوقت الفعلي في مشاريع كبرى، مبرزين وفورات ملموسة: «BIM خفّض الهدر الخرساني بنسبة 8 ٪ في أحد مشاريعنا»، كما صرّح مطوّر.1. بينما أبدى بعض المسؤولين تحفّظًا حول جاهزيّة البنية التّحتيّة الرّقميّة لدى البلديات، أوضح الخبراء أنّ اعتماد التّقنيّات الذّكيّة صار شرطًا حتميًا إذا ما أُريد تقليل التّعديلات الميدانيّة المكلفة ورفع دقّة التقديرات المالية.
الموضوع الرابع: فعاليّة الشّراكات بين القطاعين العام والخاص (PPP) وتمويل الإسكان.
اتفق المشاركون على أنّ نموذج PPP هو الأكثر واقعيّة في ظل محدوديّة الموازنات العامة، لكنهم اختلفوا في تقييم فاعليته؛ إذ لفت مسؤول حكومي إلى أنّ «الشراكات تنجح فقط عندما تمنح الدّولة ضمان استرداد كلفة الأرض أو تعيد توجيه عائدات الضرائب للمشروع». من جهتهم، شدّد المطوّرون على ضرورة وجود حوافز استثماريّة كالخصم الضريبي ومنح الأذونات السريعة، بينما دعا الخبراء إلى توحيد عقود المخاطر وتبنّي إطار تشريعي موحد يزيد شفافيّة الإجراءات.
الموضوع الخامس: التحدّيات والابتكار والمرونة.
كشف المطوّرون تحديات تمويليّة حادّة عقب تجميد القروض المصرفيّة، ما اضطر بعضهم إلى اللجوء إلى التّمويل الجماعي المحلي أو إصدار سندات خضراء لجهات استثماريّة صغيرة. أشار الخبراء إلى تجربة ناجحة في تركيا لإطلاق «صندوق دوّار» يموّل مشاريع الإسكان منخفض التكلفة، واقترحوا تكييفه محليًا مع مراعاة السّياق التّشريعي. أمّا المسؤولون فأقرّوا بأنّ الأنظمة الحاليّة تفتقر إلى آليات مرنة تسمح بإعادة تسعير وحدات الإسكان عند تغير الأسعار أو الطلب.
ملخص التّحليل الموضوعي
جدول 1 : تحليل موضوعي لمدخلات المقابلات حول تحديات وإدارة مشاريع الإسكان
| مجموع الأكواد | أمثلة | تكرار الظهور حسب المجموعة | الموضوع الرئيس (Theme) | الموضوعات الفرعيّة (Sub-themes) |
| 32 كود | “الأزمة مرتبطة بالهجرة الداخليّة وانكماش الدخل الحقيقي” – خبير 2 | مسؤولون 10، خبراء 12، مطوّرون 10 | العوامل المؤدية لأزمة السكن | • نمو سكاني سريع • ارتفاع كلفة الأراضي • ضعف التمويل |
| 26 كود | “الجداول الزمنية تُعد لكن قلّما تُحدّث بعد الصدمات” – مطوّر 4 | مسؤولون 7، خبراء 9، مطوّرون 10 | مستوى تطبيق ممارسات إدارة المشاريع | • تخطيط زمني • إدارة مخاطر • مراقبة الأداء |
| 24 كود | “اعتماد BIM خفّض الهدر الخرساني 8 ٪ في مشروعنا الأخير” – مطوّر 1 | مسؤولون 5، خبراء 9، مطوّرون 10 | التكنولوجيا الذكية في المشاريع | • BIM • منصّات متابعة حيّة • نظم إنذار مبكر للتكاليف |
| 29 كود | “الشراكات ناجحة عندما تُمنح ضمانات استرداد تكلفة الأرض” – مسؤول 3 | مسؤولون 12، خبراء 8، مطوّرون 9 | فعالية الشراكات وتمويل الإسكان | • نماذج PPP • تحفيزات ضريبية • توزيع المخاطر |
| 27 كود | “«تجميد القروض أربك التدفقات النقدية، فاعتمدنا تمويلًا جماعيًا محليًا” – مطوّر 2 | مسؤولون 6، خبراء 9، مطوّرون 12 | التحدّيات والابتكار والمرونة | • أزمات اقتصادية مفاجئة • أدوات تمويل مبتكرة • مرونة السياسات |
يوضح الجدول تحليلًا نوعيًا لبيانات المقابلات عبر 138 كودًا موزعة على خمسة موضوعات رئيسة، تغطي العوامل الاقتصاديّة، ممارسات الإدارة، التكنولوجيا، الشّراكات، والابتكار. يتصدر موضوع «العوامل المؤدية لأزمة السكن» (32 كودًا) بقضايا مثل الهجرة الدّاخليّة، النّمو السكاني السّريع، وضعف التّمويل، ما يعكس إدراكًا عميقًا لجذور الأزمة. في المقابل، يبرز «مستوى تطبيق ممارسات إدارة المشاريع» (26 كودًا) بانتقادات مثل عدم تحديث الجداول الزّمنيّة، ما يكشف ثغرات في التخطيط وإدارة المخاطر. يُظهر موضوع «التكنولوجيا الذّكيّة في المشاريع» (24 كودًا) فوائد مثل خفض الهدر عبر BIM، بينما تُبرز الشّراكات (29 كودًا) أهمّيّة ضمانات استرداد التكلفة ونماذج PPP. أخيرًا، يكشف موضوع «التّحديات والابتكار والمرونة» (27 كودًا) عن ردود فعل تكيفيّة مثل التّمويل الجماعي في مواجهة أزمات اقتصاديّة مفاجئة. يعكس هذا التّنوع في المواضيع والأمثلة واقعيّة التّحديات وترابط أبعاد الأزمة، إضافة إلى حلول عمليّة مقترحة من مختلف الفئات المستهدفة في الدّراسة.
مناقشة النّتائج: في ضوء نتائج المقابلات، يمكن ملاحظة تطابق كبير بين المعطيات الميدانيّة، وتحليلات الأدبيّات السّابقة حول أزمة السكن وإدارة المشاريع. فمثلًا، ما أشار إليه المشاركون بشأن النّمو السكاني السّريع والهجرة الدّاخليّة كأحد العوامل الضاغطة على الطلب السّكني، يتفق مع ما أوضحته دراسة UN-Habitat (2021) التي بيّنت أن التحوّلات الدّيموغرافيّة المفاجئة، لا سيما في الدّول النامية، تفرض تحديات كبرى على منظومات الإسكان القائمة، إذ لا تواكب وتيرة البناء تطور الحاجات السّكانيّة. كما يؤكّد ارتفاع كلفة الأراضي وضعف التمويل طويل الأجل على ما ورد في دراسة Marquez & Rodríguez (2019) التي سلّطت الضوء على أنّ افتقار الأسر ذات الدّخل المتوسط، والمنخفض إلى قنوات ائتمان ميسّرة يؤدي إلى تعطّل مشاريع الإسكان المتوسّط.
فيما يتعلق بـممارسات إدارة المشاريع، فقد عكست شهادات المشاركين وجود فجوة بين الخطط النّظريّة والتّطبيق الفعلي، إذ تُعدُّ جداول زمنيّة وخطط مخاطر من دون تحديثها بعد الصّدمات. هذه النتيجة تتناغم مع ما أشارت إليه Kerzner (2017) حول أنّ كثيرًا من مشاريع الإسكان تتعثر بسبب غياب آليات متابعة صارمة ومؤشرات أداء إلزامية. كما يتقاطع ذلك مع ما ذكره Turner (2009) من أن ضعف أنظمة الرقابة يجعل حتى أفضل الخطط عرضة للفشل عند التنفيذ.
أمّا في محور التكنولوجيا الذّكيّة، فقد أشارت المقابلات إلى اعتماد نمذجة معلومات البناء (BIM) ومنصات المتابعة الرّقميّة كأدوات فعالة لخفض الهدر وتحسين الدّقة، وهو ما تؤكده دراسات مثل Azhar (2011) وEastman et al. (2018)، اللتين أثبتتا أن استخدام BIM يقلل من التّعديلات الميدانيّة، ويوفر موارد كبيرة في المواد والوقت. ومع ذلك، فإن التحفّظات التي أبدتها الجهات الحكوميّة حول البنية التّحتيّة الرّقميّة تتفق مع ما ورد في World Bank (2020) بشأن محدوديّة التّحول الرّقمي في بلديات المدن النّاميّة، وضعف تكامل الأنظمة التّكنولوجيّة مع البنى التّقليديّة.
فيما يخص الشّراكات بين القطاعين العام والخاص (PPP)، كشفت المقابلات أنّ فاعليتها مرهونة بتقديم الدّولة لضمانات ماليّة وتحفيزات ضريبيّة، وهو ما شددت عليه Roehrich et al. (2014) حين أكدت أن نماذج الشّراكة لا تنجح إلّا إذا توافرت بيئة تشريعيّة مستقرة وعقود توزيع مخاطر عادلة. كما تدعم هذه النّتيجة ما أشار إليه Yescombe (2017) من أنّ وضوح الأدوار بين الشركاء، وتوحيد العقود يمثلان أساس نجاح أي PPP في قطاع الإسكان.
أخيرًا، فإنّ التّحديات التّمويليّة التي أبرزها المطورون، مثل تجميد القروض ولجوء البعض للتمويل الجماعي، تعبّر عن واقع اقتصادي هشّ، يعززه ما ذكرته UNESCAP (2022) حول أهمّيّة تنويع مصادر التّمويل في مشاريع الإسكان منخفض الكلفة. أمّا تجربة “الصندوق الدوّار” التي أشار إليها الخبراء، فتتوافق مع ما قدمته Turok & Borel-Saladin (2016) حول استخدام آليات تمويل مبتكرة ومستدامة في سياقات شبيهة، مثل جنوب إفريقيا وتركيا.
بناءً عليه، تظهر نتائج المقابلات أنّها ليست فقط منسجمة مع ما ورد في الأدبيّات السّابقة، بل تسهم بإثرائها من خلال عرض أمثلة تطبيقيّة واقعيّة من بيئة الدّراسة، تعكس تقاطعات الاقتصاد، والإدارة، والتكنولوجيا، والتّشريع، وتفتح المجال لتوصيات عمليّة قابلة للتنفيذ في تطوير سياسات الإسكان وإدارة المشاريع بفعاليّة.
الاستنتاج: تكشف نتائج الدّراسة صورة مركبة لأزمة السّكن في السّياق العربي، تجمع بين عوامل اقتصاديّة حادة، وتشريعات غير مرنة، وممارسات إدارية محدودة التأثير، على الرّغم من وجود أدوات تكنولوجيّة فعالة. أظهرت النّتائج الإحصائيّة أهمية التكنولوجيا في تسريع التّنفيذ وتعزيز الإدارة المبتكرة، كما بيّنت دور الشّراكات بين القطاعين العام والخاص في تحسين كفاءة المشاريع. من جهة أخرى، أوضحت نتائج المقابلات أنّ التّحديات الميدانيّة تشمل غياب التّخطيط التّفاعلي، وافتقار السياسات إلى المرونة والتّمويل المستدام، في حين تمثل الأدوات الذّكيّة، والشّراكات المنظمة فرصًا واعدة لإصلاح الوضع القائم.
يتضح أن معالجة أزمة السّكن لا تقتصر على ضخ الأموال أو بناء الوحدات، بل تتطلب تحولًا استراتيجيًا في طريقة التفكير والإدارة، من خلال دمج التكنولوجيا، وتفعيل الشّراكات، وتطوير الأطر المؤسسيّة والتّشريعيّة، ما يعزز استدامة المشاريع ويعيد التوازن بين العرض والطلب.
التّوصيات
- توسيع استخدام التكنولوجيا الذّكيّة في تنفيذ مشاريع الإسكان مثل نمذجة معلومات البناء (BIM) وأنظمة المتابعة الحية، لما لها من دور مثبت في تحسين الكفاءة وتقليل الهدر وزيادة دقة التّقديرات.
- تفعيل مكاتب إدارة المشاريع (PMO) داخل الهيئات العامة والبلديات لضمان الالتزام بالمخططات الزّمنيّة والمالية، واعتماد مؤشرات أداء واضحة وقابلة للقياس.
- تعزيز الشّراكات بين القطاعين العام والخاص (PPP) من خلال وضع أطر تشريعيّة موحدة، وتقديم ضمانات استرداد التكاليف، وتسهيلات ضريبيّة لتشجيع الاستثمار في الإسكان.
- تنويع أدوات التّمويل عبر تشجيع آليات مثل التمويل الجماعي المحلي، والسّندات الخضراء، وصناديق دوارة لدعم مشاريع الإسكان منخفض الكلفة، خاصة في ظل صعوبة الحصول على قروض مصرفيّة.
- إعادة هيكلة السياسات الإسكانيّة بما يتوافق مع النّمو السكاني والهجرة الدّاخليّة، من خلال إنشاء مراكز حضريّة جديدة وتطوير تخطيط عمراني يوازن بين الكثافة وجودة الحياة.
- بناء قدرات الكوادر الهندسيّة والإداريّة عبر برامج تدريب مستمر في إدارة المشاريع، والتّقنيات الحديثة، بما يضمن نقل المعرفة من الإطار النّظري إلى الواقع التطبيقي الفعلي.
المراجع العربيّة
1- بن حرز الله، ع. (2020). سياسات الإسكان في الجزائر: بين التحديات التنموية والحلول البديلة. مجلة البحوث الاقتصادية والمالية، 7(1)، 145–168.
2-جامعة القاهرة. (2022). ورقة بحثية بعنوان “المدن الذكية والتنمية العمرانية المستدامة: دراسة حالة العاصمة الإدارية الجديدة”. وقائع المؤتمر العربي للتخطيط الحضري الذكي. كلية التخطيط العمراني، القاهرة.
3-الجوهري، ن. (2020). استخدام الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء في تخطيط المدن: نموذج محاكاة تطبيقي. مجلة دراسات المدن الذكية والتخطيط العمراني، 2(3)، 55–74.
4-السعدي، ح.، & المسعودي، م. (2012). أزمة السكن في العراق: التحديات والحلول المقترحة. بغداد: المركز العراقي للتنمية.
المراجع الأجنبيّة
-5Azhar, S. (2011). Building Information Modeling (BIM): Trends, benefits, risks, and challenges for the AEC industry. Leadership and Management in Engineering, 11(3), 241–252. https://doi.org/10.1061/(ASCE)LM.1943-5630.0000127
-6Burton, S., Huang, T., & Keller, R. (2024). Housing policies and affordability: A comparative study of global responses. Urban Policy Review, 22(1), 78–101.
-7Chetty, R., Hendren, N., & Katz, L. F. (2016). The effects of exposure to better neighborhoods on children. American Economic Review, 106(4), 855–902.
-8Costa, D., & Garza, M. (2023). Climate and Housing: The Interwoven Crisis. Global Urban Studies Journal, 29(1), 44–59.
-9Costa, M., & Garza, E. (2023). Climate change and the housing crisis: A dual threat to urban resilience. Journal of Urban Climate Policy, 18(2), 115–132.
-10Eastman, C. M., Teicholz, P., Sacks, R., & Liston, K. (2018). BIM Handbook: A Guide to Building Information Modeling for Owners, Designers, Engineers, Contractors, and Facility Managers (3rd ed.). Wiley.
-11International Monetary Fund. (2021). Housing Market Imbalances and Macroprudential Responses: Global Lessons. Washington, D.C.: IMF Publications.
-12Kerzner, H. (2017). Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling (12th ed.). Wiley.
-13Marquez, C., & Rodríguez, A. (2019). Affordable housing finance: Innovations and challenges in low- and middle-income countries. Housing Policy Debate, 29(2), 203–221. https://doi.org/10.1080/10511482.2018.1493807
-14Morrison, J., & Stadelmann, M. (2024). COVID-19 and Affordable Housing Supply Chains: Global Disruptions and Policy Responses. Urban Policy Review, 17(2), 22–35.
-15Nguyen, T., & Hoang, M. (2025). Housing Affordability and Policy Gaps in Vietnam: A National Crisis. Southeast Asian Development Journal, 31(1), 66–81.
-16Nguyen, T. H., & Hoang, L. M. (2025). Adaptive housing strategies in Vietnam. Habitat International, 130, 102640.
-17Osei‑Kyei, R., & Chan, A. P. C. (2015). Review of CSFs for PPP projects. International Journal of Project Management, 33(6), 1335–1346.
-18Purton, B. (2024). The Financialization of Housing: Global Trends and Local Impacts. Housing Studies Quarterly, 38(1), 1–25.
-19Rajagopal, L. (2023). The Right to Housing: Challenges in a Global Context. United Nations Human Rights Council Report.
-20Roehrich, J. K., Lewis, M. A., & George, G. (2014). Are public–private partnerships a healthy option? A systematic literature review. Social Science & Medicine, 113, 110–119.
-21Roehrich, J. K., Lewis, M. A., & George, G. (2014). Are PPPs a healthy option? Social Science & Medicine, 113, 110–119.
-22Rogers, E. M. (2003). Diffusion of Innovations (5th ed.). Free Press.
-23Turner, J. R. (2009). The Handbook of Project-Based Management (3rd ed.). McGraw-Hill.
-24Turok, I., & Borel-Saladin, J. (2016). Backyard shacks, informality and the urban housing crisis in South Africa: Stopgap or prototype solution? Housing Studies, 31(4), 384–409. https://doi.org/10.1080/02673037.2015.1091951
-25UNEP. (2023). 2023 Global Status Report for Buildings and Construction. Nairobi: United Nations Environment Programme.
-26UNESCAP. (2022). Affordable and adequate housing in the Asia-Pacific region: Policy approaches and practices. United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific.
-27UN-Habitat. (2021). Cities and Pandemics: Towards a more just, green and healthy future. United Nations Human Settlements Programme.
-28UN-Habitat. (2023). World Cities Report 2023: Envisaging the Future of Cities. Nairobi: United Nations Human Settlements Programme.
-29World Bank. (2020). Digital Government Readiness Assessment: Lebanon Country Report. World Bank Group.
-30World Economic Forum. (2023). Global Housing and Climate Risk Report 2023. Retrieved from https://www.weforum.org/reports
-31Yescombe, E. R. (2017). Public-Private Partnerships: Principles of Policy and Finance (2nd ed.). Butterworth-Heinemann.
الملاحق
أسئلة المقابلة (للمسؤولين والخبراء والمطورين العقاريين):
- كيف تقيّمون واقع أزمة السّكن في بلدكم؟ وما أبرز العوامل التي ترونها مساهمة في تفاقم هذه الأزمة؟
سؤال تمهيدي لتحديد السّياق العام ورؤية المشارِك - ما مدى اعتماد المؤسسات لديكم على ممارسات إدارة المشاريع الاحترافيّة (مثل التّخطيط الزّمني، إدارة المخاطر، مراقبة الأداء في مشاريع الإسكان؟
- هل تُستخدم التكنولوجيا الذّكيّة، مثل نمذجة معلومات البناء (BIM) أو أنظمة المتابعة الرّقميّة، في مشاريع الإسكان؟ وإن وُجد، فما الأثر الفعلي لهذه التقنيات؟
- ما دور الشّراكات بين القطاعين العام والخاص في تمويل وتنفيذ مشاريع الإسكان؟ وما مدى فاعليتها من وجهة نظركم؟
- هل ترى أنّ السّياسات الحكوميّة الحاليّة تدعم بشكل كافٍ تطوير حلول مستدامة لأزمة السكن؟ وما أبرز أوجه القصور أو القوّة فيها؟
- هل لديكم تجارب في تكييف نماذج أو سياسات إسكانيّة ناجحة من دول أخرى؟ وكيف تعاملتم مع خصوصّيّة السّياق المحلي؟
- ما أبرز التّحديات التي واجهتموها أثناء تنفيذ مشاريع الإسكان (مثل التمويل، الموافقات، البنية التّحتيّة)؟ وكيف تم التعامل معها؟
- ما مدى مرونة الإدارة في التّعامل مع التّغيرات المفاجئة (مثل تغيّر الأسعار، تغيّر الطلب، أو الأزمات الاقتصادية)؟
- هل هناك مبادرات أو أدوات ابتكاريّة (إداريّة أو تمويليّة أو تشريعيّة) استُخدِمت لتحسين جودة أو كفاءة المشاريع؟
- من وجهة نظركم، ما أبرز المقترحات العمليّة لتطوير استراتيجيّات أكثر فعاليّة لإدارة مشاريع الإسكان على المدى القريب والمتوسط؟
– طالب دكتوراه ، جامعة آزاد، طهران – إيران. قسم إدارة الأعمال فرع اتخاذ قرارات ووضع سياسات عامّة. [1]
PhD Student, Azad University, Tehran, Iran, Department of Business Administration, Decision Making and Public Policy Development Branch. E-mail:elhelbawiosama@gmail.com
[2] Clarke & Braun