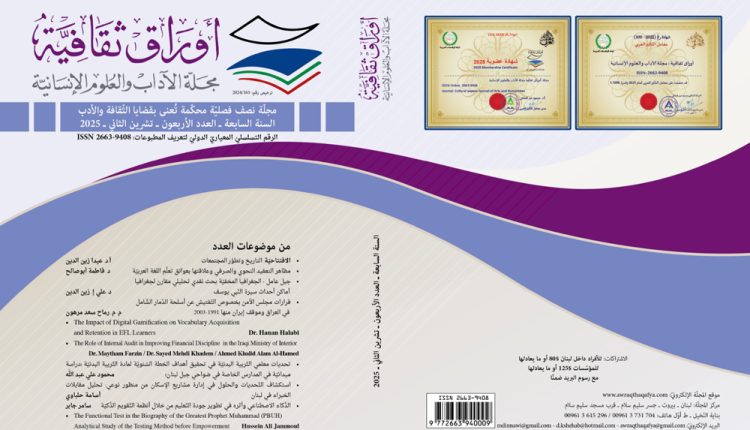عنوان البحث: الأزمات ومعضلة التربية والتّعليم دراسة نظريّة
اسم الكاتب: أ.د. نانسي شريف الموسوي
تاريخ النشر: 2025/11/14
اسم المجلة: مجلة أوراق ثقافية
عدد المجلة: 40
تحميل البحث بصيغة PDFADOI: https://aif-doi.org/awraq/014015
الأزمات ومعضلة التربية والتّعليم
دراسة نظريّة
Crises and the Dilemma of Education
A Theoretical Study
- Nancy Sharif Moussawi أ.د. نانسي شريف الموسوي([1] )
تاريخ الإرسال:2-10- 2025 تاريخ القبول:12-10-2025
الملخص turnitin:20%
هدفت الدّراسة إلى تسليط الضوء على معضلة التربية، والتّعليم في زمن الأزمات من خلال طرح إشكاليّة تتمحور حول إمكانيّة الاهتمام بالبُعد التربوي سيما الشقّ النفس – اجتماعي منه في الوقت نفسه والسّياقات نفسها الخاصّة بالبُعد التعليمي. اعتمدت الدّراسة على المنهج الوصفي التّحليلي استنادًا إلى إجراء مراجعة لمجموعة من الدّراسات والأدبيّات والأطر المرجعيّة التي تساعد على الإجابة عن أسئلة الدّراسة.
أظهرت النّتائج أنّ الأزمات على مختلف أنواعها تترك آثارًا على مستوى الصحّة النفسيّة للأفراد التي تنعكس مباشرة على القدرات المعرفيّة، والاجتماعيّة وبالتالي على التعلّم، مع الأخذ في الحسبان أنّ هذا التأثّر تختلف حدّته باختلاف شدّة الأزمة نفسها والخصائص الشّخصيّة والعوامل الاجتماعيّة المحيطة، وأنّ الصدمات الناتجة عن الأزمات تترك تغييرات فعليّة في بنية الدّماغ والتي يمكن أن تورّث عبر الأجيال. لذا، فإنّ مراعاة المؤسّسات التّعليميّة لبُعدي التربية والتعليم أثناء الأزمات قد يكون أمرًا صعبًا جدًا، لما للأزمات من آثار على الأفراد بل على المجتمعات بأسرها. وقد بيّنت مراجعة الأدبيات ضرورة الاهتمام بالبعد النفس – اجتماعي بداية ومن ثمّ يُصار إلى العمل على الأبعاد التّعليميّة. وقد أوصت الدّراسة بالاهتمام بوضع الخطط لمواجهة الأزمات قبل حدوثها، وتنفيذ البرامج الهادفة إلى تحصين الأفراد وبناء مناعتهم، وتوفير الدّعم الاجتماعي والمساندة والوقت للتعافي في ما لو استلزم الأمر ذلك.
الكلمات المفتاحية: الأزمات، التربية، التعليم، الصّدمات، الأبعاد النفس- اجتماعيّة
Abstract
This study seeks to highlight the challenges of education during times of crisis by posing a key question: can equal attention be given to both the educational dimension especially its psycho-social aspects, while addressing the broader contexts of learning? The research adopts a descriptive analytical approach, drawing on a review of relevant studies, literature, and theoretical frameworks to provide answers.
Findings reveal that crises of all types significantly affect individuals’ mental health, which in turn directly impacts their cognitive and social capacities, and consequently their ability to learn. The severity of these effects varies according to the intensity of the crisis, individual characteristics, and surrounding social conditions. Furthermore, trauma resulting from crises can lead to actual changes in brain structure that may even be transmitted across generations. As such, it becomes extremely challenging for educational institutions to address both pedagogical and academic needs during crises, given the far-reaching impact on individuals and entire communities. The literature review underscores the importance of first prioritizing psycho-social support before moving on to educational concerns.
The study recommends proactive planning for crises, implementing programs that build resilience and strengthen individuals’ coping mechanisms, and ensuring the provision of social support, assistance, and sufficient recovery time when necessary.
Keywords: crises, education, learning, trauma, psycho-social dimensions
أوّلًا: المقدّمة
إنّ المؤسّسات التعليميّة هي بطبيعة الحال جزء لا يتجزأ من النسيج الاجتماعيّ والاقتصاديّ لأيّ مجتمع من المجتمعات، ما يجعلها عرضة للتأثّر المباشر بالأزمات على مختلف أنواعها، من اجتماعيّة أو اقتصادية أو صحيّة أو طبيعيّة وغيرها. وقد بيّنت جائحة كورونا – كحدث عالمي طال الكرة الأرضيّة- عدم استعداد بعض الأنظمة التّعليميّة التّقليديّة أمام التغييرات المفاجئة، وأوضحت الحاجة الماسة إلى وجود منظومات إداريّة للتخطيط للأزمات وللاستجابة لها بفعاليّة. فقد أظهرت مثلًا دراسة أبو خيران والعرجان (2021) أنّ مستوى إدارة مديري المدارس الحكوميّة للأزمات خلال جائحة كورونا كان متوسّطًا، إذ واجهوا تحدّيات في التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، أضف إلى الضّعف في تطبيق خطط طوارئ مدروسة، ما انعكس على سير العملية التّعليميّة خلال الأزمة. ووجد بالقاسمي (2022) أنّ أبعاد واقع إدارة الأزمات في المؤسسات التّعليميّة في مرحلتي التعليم المتوسّط والثانوي في الجزائر تمحورت بالترتيب حول: الاتصال، ومرحلة احتواء الأزمة، والتّنظيم، والتّخطيط (بما في ذلك المجموعات التّربويّة والنّفسيّة والتدخّل الجماعي في الأزمات، وتقديم تدخّلات للصحّة النفسيّة الفردية أكثر منها جماعيّة)، ومرحلة استعادة النشاط بعد الأزمة. ونجد أيضًا نتيجة مشابهة في دراسة الثبيت (2020) التي بيّنت الحاجة إلى تبنّي استراتيجيات تخطيط تشاركيّة تقوم على تحليل المخاطر، وتطوير قدرات العاملين في بناء سيناريوهات استجابة فعّالة، مؤكّدة أنّ غياب هذه المهارات يؤدّي إلى إدارة ارتجاليّة لا ترتكز على أسس علميّة. وتتماشى هذه النتائج مع ما ورد في وثيقة صادرة عن المركز الإقليمي للتخطيط التّربوي ومنظّمة اليونسكو (الشّامي والزنفلي،2021) حول ضرورة الانتقال من التّخطيط التقليدي إلى نماذج مرنة، واستشرافيّة تركّز على استمرارية التّعليم الرّقمي وتمكين الفاعلين المحليين وبناء نظم إنذار مبكر وتعزيز الشراكات. وفي السّياق الجامعي، أظهرت دراسة العتيبي (2024) أنّ جامعة أم القرى استطاعت الحفاظ على جودة التّعليم وخطط الطوارئ مشيرة إلى فعاليّة إدارة الأزمة على الرّغم من قلّة الكوادر البشريّة المؤهّلة سواء على المستوى الإداري، أو الفنّي للعمل في إدارة الأزمات، ولذا كانت التوصيات بالعمل على أن يكون التخطيط لإدارة الأزمات جزء لا يتجزأ من التخطيط الاستراتيجي في مؤسّسات التعليم العالي.
فالتعامل مع الأزمات إذًا وإدارتها أصبحا حاجة ملحة ومطلبًا استراتيجيًا، فكفاءة المنظّمة تقاس بمدى قدرتها على التّعامل مع الأزمات بفعاليّة للحدّ من التهديدات التي تتعرّض لها. فالأمر لا يقتصر على مجرد التعامل مع الظروف الطارئة بل يتمحور حول بناء بيئات تعليميّة قادرة على التكيّف والاستمرار في أداء أدوارها التربوية تحت الضّغوط والظروف غير المستقرّة، ما يتطلّب توفّر مهارات قياديّة وتنظيميّة عالية كالقدرة على اتّخاذ القرار، وتأمين التّواصل مع المعنيين وتوفير الخدمات المناسبة التّعليميّة وغير التّعليميّة للمعلّمين والمتعلّمين على حدّ سواء.
ثانيًا: الإشكاليّة
بمعزل عن كل الأدبيّات والدّراسات التي تناولت موضوع إدارة الأزمات (Baubion, 2013; Crandall, et al., 2014; Dubrovski, 2023; Mitriff & Anagnos, (2005); Rubens, 2023; Ulmer et al., 2007) والتي قد تتقاطع مع بعضها البعض في معظم الأحيان حول المراحل والإجراءات التي ينبغي اتخاذها قبل الأزمة أو خلالها أو عقب انتهائها، كالتوقّع والكشف المبكر والاستعداد والاستجابة والتعافي وإعادة الاستقرار وختامًا التقييم وأخذ العِبر والتعلّم المؤسّساتي، ما يهمنا هو التوقّف عند أحد المعضلات المهمّة المرتبطة بالأزمات والتي تواجه المؤسّسات التعليميّة بمختلف أنواعها، ومستوياتها (الجامعيّة وما قبل الجامعيّة) ألا وهو معضلة التربية والتعليم في أوقات الأزمات.
فعلى قاعدة التّوازن بين التربية والتعليم في أوقات “السِلم” أو اللاأزمة إذا ما صح القول، تنحو المؤسّسات التعليميّة إلى الريادة في زمن الأزمات عبر الحرص على المحافظة على هذا التّوازن حتّى في أحلك الظروف. وإذا ما طرحنا سؤالًا حول المقصود بهذا “التّوازن”، وفي محاولة للوصول إلى المنطق الحاكم له، تكون الإجابة البديهيّة هي محاولة إكساب المتعلّم الأهداف التّعليميّة المطلوبة في المنهاج (المدرسي أو الجامعي) سواء أكانت على مستوى القدرات أو المهارات أو الاتجاهات والمواقف من جهة، مع الأخذ بالحسبان الخصائص النّمائيّة والنّفسيّة – العاطفيّة لهذا المتعلّم أثناء الأزمة من جهة ثانية. إنّ هذه المفاهيم الحاكمة في إدارة الأزمة في المؤسّسات التربوية تؤشّر بالطبع إلى المنطق الكامن وراء كل السياسات وما يتعلّق بها من إجراءات موضع التطبيق.
بناء على ما سبق، وللقيام بمحاولة لفهم عميق لمعضلة الأداء التربوي والتعليمي للمؤسّسات التعليميّة أثناء المرور بأزمة سواء صحيّة أو طبيعيّة أو حروب وغيرها، نطرح السؤال الإشكالي المتمثّل في إمكانية التصدّي لهذين البعدين بشكل متزامن، وهل مراعاة المؤسّسات التّعليميّة للأبعاد النفسيّة للمتعلّم (على فرضية حصول ذلك) هو كاف ويجيز لها الانتقال إلى عمليّة التعليم بمعزل عن كل ما يتعرّض (أو تعرّض له) هذا المتعلّم من صدمات ناتجة عن الأزمات؟.
ثالثًا: الأسئلة
تنطلق الدّراسة من سؤالين اثنين هما:
- ما هي الأطر المرجعيّة والمفاهيميّة التي يمكن من خلالها محاولة التأسيس لمواجهة معضلة التربية والتّعليم في زمن الأزمات؟
- وبناء عليه، إلى أي مدى يمكن مراعاة بُعدي التربية والتعليم في الوقت نفسه، أي بشكل متزامن في زمن الأزمات؟
رابعًا: الأهداف
تسعى الدّراسة الحاليّة إلى تحقيق الأهداف الآتيّة:
- تسليط الضوء على بعض التحدّيات النّفس-اجتماعيّة التي يواجهها الأفراد خلال المرور بالأزمات، وتبيان أثرها على الأداء الأكاديمي والتحصيل العلمي للمتعلّمين.
- توفير أطر معرفيّة ومعطيات علميّة مساعدة في عملية التأسيس لكيفيّة استجابة المؤسّسات التعليميّة في أوقات الأزمات.
- حثّ صنّاع القرار في المؤسّسات التّعليميّة على اعتماد مقاربات تراعي الأوضاع النفسيّة للأفراد خلال أوقات الأزمات.
خامسًا: الأهمّيّة
تتجلّى أهمّيّة الدّراسة في كونها تتناول موضوعًا على تماس بالواقع الذي فرضه التعرّض لعدد من الأزمات المتتالية على النظام التعليمي اللبناني ومؤسّساته، سواء الحروب أو جائحة كوفيد -19 أو غيرها، وهي تقدّم أدلّة علميّة تقع في سياق فهم أثر الأزمات على المتعلّمين وأسرهم والكوادر التعليميّة والتربويّة على حدّ سواء، وتبيّن الحاجة إلى انعكاس هذا الفهم على سياسات المؤسّسات التعليميّة لمقاربة موضوع التوازن بين التربية والتعليم أثناء التصدّي للأزمة وما ينبثق عنها من خطط إجرائيّة. كما توفّر الدّراسة قاعدة معرفيّة لمساعدة صنّاع القرار على بناء خططهم بشكل استباقي قبل حدوث الأزمات، وفي اتّخاذ قراراتهم على أسس علميّة.
سادسًا: المصطلحات
اعتمدنا في الدّراسة الحاليّة على مجموعة من المصطلحات نورد تعريفها كالآتي:
الأزمة Crisis: كلمة “الأزمة” مشتقة من الأصل اليوناني Krisis أي “القرار Decision” أو “نقطة التحوّل Turning point”، إنّها صدمة قوية أو تهديد وشيك له تأثيرات شديدة وواسعة النطاق، ويتطلّب أو يستلزم استجابات عاجلة. وتجدر الإشارة إلى أنّ الأزمات قد تختلف بحدّتها وشموليّتها وأبعادها وتوسّعها، وهي جميعها تستلزم اتخاذ قرارات للانتقال من حالة إلى أخرى أكثر ثبات واتزان. كما تجدر الإشارة أيضًا إلى إمكانيّة تزامن أكثر من أزمة تتميّز كل منها بعوامل وعناصر مختلفة، كما يمكن أن تتعاقب الأزمات أو أن تتراكم ما قد يؤدّي إلى نشوء أزمات متعدّدة ومعقّدة (Yanikkaya, 2025).
الصدمة Trauma: وفق برينكمن وآخرون (2017) فإنّ مصطلح الصدمة Trauma مأخوذ من اللغة اليونانيّة القديمة أي “الجرح أو الإصابة”، ويمكن أن يكون الجرح جسديًا أو نفسيًا. فالصّدمة هي حدث أدّى إلى جرح عميق في النّفس بشكل مفاجئ (يمكن أن يكون متكرّرًا) كأن يشعر بخطر مباشر على حياته أو حياة شخص آخر مقرّب منه وتظهر آثاره وتستمر لمدّة طويلة.
التربية Education: هي عملية تهدف إلى تنمية الفرد من الجوانب النفسيّة والاجتماعيّة والمعرفيّة والجسميّة- الحركيّة بشكل متوازن، ولتهيئته للنهوض والمشاركة في المجتمع. وتشترك في عملية التربية مؤسّسات المجتمع مع العائلة(Slavin, 2014) .
التّعليم Teaching: هي عملية تهدف إلى نقل المعارف والمعلومات إلى المتعلّم أو تطوير مهارته وقدراته في مجالات محدّدة، وتقع في سياق إكسابه مجموعة من الأهداف التّعليميّة بالإستعانة بالوسائل وبالاعتماد على الطرائق المناسبة، فضلًا عن أدوات التقويم وأساليبه للحكم على مدى تحقّق هذه الأهداف(Slavin, 2014) .
سابعًا: المنهج
اعتمدت في الدراسة الحاليّة على المنهج الوصفي التحليلي، كدراسة نظرية، من خلال التركيز على تحليل الأدبيات والدّراسات السّابقة ذات العلاقة بالموضوع. وقد اختيِر هذا المنهج نظرًا لتناسبه مع أهداف الدّراسة التي تندرج ضمن البحوث النّظريّة والتي تقتصر على مراجعة الأدبيات، وتحليلها بهدف بناء إطار نظري متكامل لمعضلة التوازن بين التربية والتّعليم في زمن الأزمات.
وفي محاولة للإجابة عن سؤاليّ الدّراسة، سنتناول ثلاثة عناوين رئيسة، أوّلها أزمة كورونا كأنموذج أزمة، ومن ثمّ سأسلّط الضوء على الأزمات النّاجمة عن الحروب سيما حرب لبنان في مواجهة العدوّ الصهيوني، ونختم بالدّماغ وآليات عمله في أوقات الصّدمات، علّني أستطيع ربطها بالمتعلّمين على وجه الخصوص وتبيان بعض آثارها عليهم، كي تكون لنا دليلًا في التّعاطي أو التّعامل مع الأزمات اللاحقة في ما لو حصلت. فالأزمات السّابقة هي فرصة للتعلّم وللمرونة على المدى الطويل، والتفكّر في الأزمات السابقة يمكن أن يساعد المؤسّسات على تحسين استعدادها وتكييف استراتيجياتها للتعامل المناسب مع الأزمة، مما يعزّز من قدرتها على مواجهة التحدّيات المستقبليّة. فمن خلال الاستعداد لعدد من السناريوات أو الأزمات المحتملة، يمكن للمؤسّسة تحويل نقاط الضعف إلى فرص للنموّ المؤسّساتي والتنمية الاستراتيجيّة (Yanikkaya, 2025, p. 4).
- أزمة كوفيد -19 أنموذجًا
شكّل انتشار وباء كورونا تحدّيًا كبيرًا للمؤسّسات التعليميّة التي اضطرت إلى إقفال أبوابها، والانتقال بشكل سريع وغير مخطّط له من التّعليم الحضوري إلى التعليم من بُعد بمختلف أشكاله، فالاستمرار بنمط التعليم التقليدي لم يعد ممكنًا في ظلّ منع التجمّعات والاختلاط. ومن المؤكّد أنّ الاستجابات لجهة أساليب إدارة هذه الأزمة اختلفت باختلاف المؤسّسات التّعليميّة في مراحل التعليم ما قبل الجامعي أو حتّى في التعليم الجامعي. وغنيّ عن البيان حجم التحدّيات التي واجهتها المؤسّسات التعليميّة سواء على مستوى المنصّات، أو المواد والمصادر الرّقميّة وأساليب التقويم وأدواته وغيرها، ومستوى تمكّن أفراد الهيئة التّعليميّة والإدارية من إدارة هذه العمليّة، وصولًا إلى ضعف البنية التحتيّة للإنترنت وانقطاع الكهرباء وخلافه.
ففي موضوع أثر التّعليم من بُعد أثناء جائحة كورونا أظهرت الدّراسات تداخلًا كبيرًا في نتائجها لجهة فعاليّة التّعليم والتأثيرات النّفسيّة والاجتماعيّة الناتجة عن الأزمة. فدراسة القحطاني (2023) مثلًا سلّطت الضوء على ضرورة الاهتمام بالبرامج التّدريبيّة والإرشاديّة وتكثيفها، أضف إلى التركيز على ما يساعد على تمكّن الطلاب من استخدام التعليم من بُعد بطريقة فعّالة، وتوفير قنوات تواصل تتميّز بالمرونة والاستمرارية بين الطلاب والأساتذة. وفي السّياق نفسه، أبرزت دراسة شاهين (2022) تزايد الضغوط النّفسيّة على الطلبة والمعلّمين، والأسر ما انعكس على جودة التعليم من بُعد الذي ارتبط بارتفاع مستوى القلق والتوتّر الأسري. وتأتي نتائج دراسة قام بها راجيك وآخرون (Rajić & al., 2024) ضمن هذا السّياق، فانطلاقًا من أنّ الأزمة هي أي موقف يتطلّب حكمًا أو قرارًا، وعلى قاعدة أنّ الإنسان معرّض في حياته لأزمات سواء أكانت كبيرة أو صغيرة، واستنادًا إلى بحث نوعيّ مستند إلى أربع مجموعات تركيز شارك بها طلابًا جامعيين من أربع دول أروربية (بلجيكا وكرواتيا وبولندا ورومانيا) تبيّن أنّ التحدّي الأكبر الذي واجهه هؤلاء الطلاب في خلال أزمة Covid-19 تمثّل في غياب الدّعم الاجتماعي. كما ناقش المجتمعون تحدّيات التعلّم من بُعد سيما المكوث أمام الشّاشة. وتجدر الإشارة إلى عدّ الطلاب أنّ هذه الأزمة “كوفيد -19” قد ساهمت في استكشافهم لنقاط قوّتهم والتي يمكّنهم الاستعانة بها في حال تعرّضهم لأزمات مستقبليّة. وتأتي دراسة غنيم (2020) لتقترح تطويرًا لمنصات التّعليم الإلكتروني، وضمان وتسهيل وصول الأسر لخدمات الإنترنت. لذا يمكن القول، إنّ انتقال التّعليم من الحضوري إلى التعليم من بُعد قد ساهم في استمرارية العمليّة الأكاديميّة إلى حدّ ما، ولكنه لم يستطع تحقيق التّفاعل المطلوب بين الأطراف المعنيّة وساهم في زيادة الضغوط النّفسيّة والاجتماعيّة عليهم.
زد على الضغوطات التي يعيشها الأفراد في زمن الأزمات كما سبق الإشارة إليه، الضغوطات الناجمة عن التعلّم من بُعد نتيجة الضّعف في البنية التحتيّة للإنترنت، وما ينتج عنها من عدم الاستطاعة على المتابعة بشكل سليم والتي تحمل في معظم الأحيان الكثير من مشاعر القلق والاكتئاب (Cao et al., 2020; Thandevaraj et al., 2021)، أو نتيجة الغياب عن البيئة التّعليميّة التي تؤمّن للمتعلّم إمكانيّة المتابعة والتّفاعل النفس- اجتماعي مع الآخرين. مع الإشارة إلى أنّ هذه المشاعر (التوتر والقلق والاكتئاب والأرق) وما تتركه من آثار على الصّحّة العقليّة للأفراد يمكن تأكيدها ليس لمن هم في سنّ التعلّم، فحسب وإنّما لدى كل البالغين المتأثّرين بالجائحة (Coco et al., 2023; Rajkumar, 2020)، وقد استُنتِج ذلك من خلال العديد من الدراسات التي تناولت أعراض ما بعد الصّدمة لدى من خبروا جائحة كورونا (Papa et al., 2022; Sun et al., 2023; Xu & Brodszky, 2024).
وإذا ما قمنا بربط نتائج الدّراسات حول كوفيد-19 مع غيرها من الدّراسات النفسيّة، يتّضح لنا أنّ فاعليّة التعليم من بُعد ترتبط بشكل كبير بتداعيات الصحّة النفسيّة، والصّدمات التي عاشتها شريحة واسعة من أفراد المجتمع. إذ تشير دراسة الطلحة (2023) إلى أنّ الحجر الصحّى أحدث آثارًا نفسيّة كالاكتئاب واضطراب ما بعد الصّدمة والقلق، بالإضافة إلى اضطرابات نفسيّة متعدّدة مرتبطة بجائحة كورونا بين طلاب جامعة المنصورة كالقلق والخوف المرضيّ، والاكتئاب واضطراب النوم وفاقًا لدراسة أبو الفضل (2024). ونجد نتيجة مشابهة في دراسة غالفين وآخرون (Galvin et al., 2023) الذين توصّلوا لوجود أثر لجائحة كورونا وأعمال العنف المحليّة على شعور الطلاب الجامعيين بمستوى مرتفع من الخوف، والتوتر نتيجة عدم الشّعور بالأمان والعنف والخوف على سلامة الأحبة. وتؤكّد دومي (2020) على أنّ للحجر الصحّي آثار نفسيّة على الطفل والأسرة على حدّ سواء، نتيجة التغيّر في نمط الحياة، ويتجلّى ذلك من خلال الشّعور بالحزن والضغط والغضب وغيرها من المشاعر التي يمكن أن تؤدّي في أغلب الأحيان إلى اضطرابات في النوم، وتضيف الباحثة أنّ ذلك قد ينعكس بشكل سلبي على المناعة الصحيّة والنفسيّة للأفراد وعلى صحّتهم العقليّة.
وتجدر الإشارة إلى أهمّيّة العمل على تعزيز الصحّة الرّوحيّة، إذ أظهرت دراسة شيفاندي وحسفند (Sheivandi & Hasavand, 2021) الدور الوسيط الذي تؤديه الصحّة الروحيّة في المحافظة على صحّة الأفراد والتّخفيف من آثار القلق العام النّاتج عن أزمة كورونا. وفي السّياق نفسه، ولتسليط الضوء على أهمّيّة البُعد الروحي في الصحّة النّفسيّة، أوضح أسدزندي وآخرون (Asadzandi et al., 2022) أثر التواصل الروحي على إدارة الخدمات الصّحّية لمرضى “كوفيد – 19” في مستشفى بقيّة الله العسكريّة في إيران. فالاستراتيجيّة الرئيسة للمرضى والطّاقم الطبّي تمحورت حول العلاجات الطبّية المناسبة جنبًا إلى جنب مع الوثوق بالخالق عزّ وجلّ والاستعانة بالأئمة(ع). فالتعلّق بالله عزّ وجلّ وتأثير ذلك على العلاقات الأخرى (مع الذّات، والنّاس، والطبيعة) كان له الأثر الكبير على حسن إدارة الخدمات الصّحيّة. كما أنّ التواصل مع الله يسهم في تعزيز التوجّه الروحي، والوعي الذّاتي الرّوحي، والدّافعيّة الرّوحيّة، والمرونة، والقدرة على التكيّف بحسب ما أشار الباحثون. كما يعزّز العلاقات الاجتماعيّة للفريق الطبيّ مع المرضى وعائلاتهم، ويسهم أيضًا في رفع مستوى الالتزام المهنيّ، وشعور التّعاطف، والتعاون، والتضحيّة والشّجاعة في مواجهة الأزمات.
نحن إذًا أمام أزمة أرخت بظلالها على الاستقرار النفسيّ، ما يستوجب التفكير بسبل الدّعم النفسيّ والاجتماعيّ الذي يساعد على التكيّف والتعامل مع الأزمة بالطريقة الملائمة للنموّ. لذا يجب عند تقديم برامج الدّعم النّفس- اجتماعيّ التركيز على أهمّيّة تناول الاحتياجات النفسيّة والاجتماعيّة إلى جانب القضايا الأساسيّة من تأمين الطعام والمأوى والرّعاية الصحيّة (موسى، 2024، ص 155). مع الإشارة إلى أنّني لست في صدد التّطرّق إلى التّقنيات الإرشاديّة، أو الأساليب العلاجيّة التي يمكن من خلالها مساعدة الأفراد على تجاوز الأزمات، وبناء المناعة النفسيّة للسيطرة على الأوضاع الضاغطة، ولكن ما نودّ التركيز عليه هو إيلاء هذه الجوانب أو الأبعاد العناية اللازمة في سواء في ظلّ الأزمات أو قبلها أو حتّى بعدها. إذ تُعدُّ الممر الوحيد لكل ما يمكن أن يحدث بعدها من عمليات معرفيّة أو ما فوق المعرفيّة. هذا يعني توفير الخدمات الإرشاديّة والعلاجيّة، لتعزيز المناعة النفسيّة قبل حصول الأزمات، أضف إلى البرامج أثناء الأزمة وبعدها، وذلك قبل التفكير في البعد التعليميّ. أي التخطيط المسبق وليس على قاعدة الاستجابة اللحظيّة أو الموقفيّة.
- الحروب والصدمات
عديدة هي الدراسات التي تناولت الحرب اللبنانيّة، أذكر بعضًا منها وفق التّسلسل الزمني لتاريخها، ونعرّج بعدها على عدد من الدراسات في العالمين العربيّ والغربيّ.
في السياق اللبنانيّ، توصل صايغ وآخرون (1989) إلى أنّ معدّلات انتشار اضطراب ما بعد الصّدمة PTSD([2]) بين الأطفال اللبنانيين (8-12 سنة) الذين أُحيلوا إلى العلاج بعد سنة أو سنتين من الحرب وصلت إلى 32.5% من أصل من تنطبق عليهم محكّات تشخيص اضطراب ما بعد الصّدمة. وقد لفت صايغ وآخرون (1996) إلى أنّ أوّل التّقارير عن اضطرابات ما بعد الصدمة لدى العديد من الأطفال أشار إلى الحروب بوصفها المسبّب الرئيس.
(يابري وهادي، 2008، ص 11 (Saigh et al., 1989; Saigh et al, 1996, as cited in. وتضيف يابري وهادي (2008) في هذا الصّدد إلى أنّ الأطفال، والرّاشدين يتفاعلون نفسيًا بطرق متشابهة مع الحروب، إذ يتمظهر ذلك من خلال الاكتئاب واضطرابات القلق والتقلّب في المزاج.
وفي السّياق نفسه، أشارت مقصود (Macksoud, 1992) في دراستها التي هدفت إلى تقييم صدمة الحرب لدى عيّنة من الأطفال اللبنانيين في مدينة بيروت والذين خبروا من 5 إلى 6 أشكال مختلفة من صدمات الحروب (المعارك، النّزوح، العنف، الفقر أو العوز) وتراوحت أعمارهم بين 3 و16 سنة، إلى وجود علاقة بين عدد مرات تعرّض الطفل للصدمة وبين اضطراب ما بعد الصدمة وصحّته النفسيّة وقدرته على التكيّف.
وفي دراسة تناولت العدوان الصّهيوني في شهر تموز في العام 2006 على لبنان، توصّلت الباحثتان يابري وهادي (2008) من خلال دراستهما التي هدفت إلى التعرّف إلى مدى انتشار أعراض اضطراب ما بعد الصدمة والقلق والضغط المدرَك بين الأطفال (6-18 سنة) ممن عايشوا هذا العدوان، إذ بيّنت النتائج انتشار أعراض اضطراب ما بعد الصدمة بما يقارب الـ 27% لدى عيّنة الدراسة. وتجاوزت هذه النّسبة الـ 50 % في الأعراض لدى الأطفال واليافعين الذين صرّحوا بأنّهم يواجهون صعوبة في النّوم والاستغراق به، ما يمكن أن ينعكس على الأداء المعرفي والشّعور بالتعب، وصعوبات في التركيز أثناء الدّراسة بطبيعة الحال (ص 125).
ولدى استطلاع غرز الدّين (2008) لـلتلامذة الملتحقين بالمدرسة من الصفّ السادس وحتّى الثاني عشر، أشار إلى معاناة أفراد العيّنة ممن خبروا الحرب من الإكتئاب، والتوتّر العضلي والقلق، والخوف والهمّ، والاندفاعيّة وفقدان التحكّم، والانسحاب الاجتماعي، والنّزاع مع الأهل والأقران. وهذه الاضطرابات تتمظهر في أعراض جسميّة كالآلام والغثيان والدوخة وارتجاف اليدين والتعرّق.
وفي مسح للأوضاع النّفسيّة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و12 سنة بعد عدوان شهر تموز 2006 والوقوف على آثار التعرّض للحرب ودلالاتها العياديّة، أشار أبو شديد (2008) إلى وجود علاقة ارتباطيّة بين نسبة التعرّض ومؤشّر الوضع العيادي (كالانزعاج النّفسي مثلًا، أو القصور في المهارات الاجتماعيّة، وغيرها من المؤشّرات)، أي أنّ التعرّض الأعلى هو الأكثر تأثّرًا بالاضطرابات، ما انعكس في ضعف الأداء المدرسي. وتوصّلت معيكي (2008) إلى نتائج مماثلة لدى أطفال الروضات (3-6 سنوات) إذ بيّنت العلاقة بين مستوى تعرّض الطفل للحرب والقلق والاكتئاب والانسحاب والشكاوى الجسميّة، والمشاكل في النوم والانتباه والسّلوك العدواني، وهذه الأعراض حُدِّدت في غالبية الدّراسات في علم النفس بوصفها نوعًا من استجابة الطفل لحادث ضاغط كما تشير الباحثة. وتضيف إلى أنّ قدرة الأطفال على التّعامل والتكيّف مع المواقف المتأزمة تتوقّف إلى حدّ كبير على قدرة الأهل، أو البالغين على التّماسك والتّعامل مع المواقف الصّعبة فيكونون سندًا للطفل لتجاوز الأزمة (ص، 224-225). وبهدف رصد الأثار النّفسيّة والتّربويّة لحرب تموز 2006 على الأطفال في بيروت وضواحيها بعد مرور تسعة أشهر على انتهائها، أوضحت فواز (2011) ظهور أعراض مشابهة لاضطراب ما بعد الصّدمة، كالشّعور بالخوف والقلق والبكاء واضطرابات في النوم، بالإضافة إلى التأخّر في التّحصيل الدراسي.
في السّياق العربيّ، قام هادي وآخرون (Hadi et al., 2006) بدراسة حول الصّدمات والضّغوط النفسيّة الناتجة عن حرب الخليج – الكويت التي تعرّض لها الأطفال الكويتيون، وأمهاتهم والتي أشارت إلى تفاوت في مستويات أعراض اضطراب ما بعد الصّدمة، والشّعور بالاكتئاب والقلق لدى الأطفال والأمهات على حدّ سواء وذلك نسبة إلى تفاوت خبراتهم في الحرب (فقد الأهل، الأسر، الخ).
وانطلاقًا من أنّ الحروب قد تسبّب اضطراب ما بعد الصّدمة لدى الضحايا الأساسيين والثانويين، قامت النّصر وآخرون (2000) بتقييم اضطراب ما بعد الصّدمة لدى عيّنة مؤلّفة من المواطنين الكويتين بعد 4 سنوات ونصف السنة من الغزو العراقي للكويت، فأشارت النتائج إلى انتشار ما يقارب من 28% من اضطرابات ما بعد الصدمة لدى مجمل العيّنة لترتفع إلى ما يقارب الـ 46% لدى الطلاب.
ومن الدّراسات الحديثة التي تناولت موضوع الحروب وأثرها على الأطفال، دراسة باشكو وآخرون (Pashko et al., 2025) حول الحرب الأوكرانية التي تسبّبت بحسب تعبير الباحثين بأزمة إنسانيّة واسعة النطاق وأثّرت بطبيعة الحال على بنية الأسر ورفاهها، فاضطراب الأدوار الأسريّة واختبار حالات الانفصال المطوّل والصّدمات النّفسيّة، تركت جميعها عواقب طويلة المدى على البالغين والأطفال على حدّ سواء. فمن خلال استطلاع آراء العائلات المتضرّرة من الحرب في أوكرانيا والتي عانت مباشرة من آثار النزوح والفقدان وعدم الاستقرار الاجتماعي. كشفت الدّراسة تغيّرات جوهرية في ديناميكيات الأسرة بما في ذلك اختلال الأدوار نتيجة فقدان العمل، أو الإصابة الجسميّة، والانفصال العاطفي الناجم عن الانفصال المطوّل، وزيادة خطر انهيار العلاقة الزوجيّة- الأسريّة. وُصِف الأطفال أنّهم أكثر عرضة للخطر، إذ ظهرت عليهم أعراض مثل عدم الاستقرار العاطفيّ والتّراجع الأكاديميّ وفي بعض الحالات اضطرابات نفسيّة حادّة. وظهر اضطراب ما بعد الصّدمة كتحدٍّ أساس إذ أثّر على أنماط التواصل، والحضور العاطفيّ والسّلوك في الأسرة. وأوصت الدّراسة باعتماد التّقنيات الفعّالة للتعافي بما في ذلك العلاج الفردي والعائلي، والاستشارات عبر الإنترنت واستخدام أدوات المساعدة الذاتيّة الرقميّة. والحاجة الملحّة لتدخّلات نفسيّة واجتماعيّة موجّهة للأسر المتضرّرة من الحرب.
لقد أشارت هذه الدّراسات (وغيرها الكثير) إلى تأثير الأزمات على فئات المتعلّمين جميعهم، ولدى الأطفال الذين هم الأكثر تأثّرًا بالأحداث والأزمات (الجائحة، الحروب، الكوارث الطبيعيّة وغيرها)، وممن عانوا من اختبارات وتهديدات مباشرة لحياتهم، أو تعرّضوا لإصابات جسميّة، إذ إنّهم بالمقارنة مع الفئات العمريّة الأخرى أكثر عرضة للتأثّر سلبًا من النّاحية النفسيّة بسبب الصّعوبة التي يواجهونها في الإحاطة وفهم هذه التجارب من جهة وعدم نضج مهاراتهم في التعبير عن الذات من جهة ثانية (أبو شديد، 2008؛ موسى، 2024؛ Akat & Karataş, 2020, p.2). ويؤكّد موسى (2024) ضرورة التصدّي لموضوع الأطفال في ظلّ الكوارث، والأزمات لما لهذه الخبرات من تأثير على شخصيّة الطفل وقدراته، فرعاية الصحّة النّفسيّة والجسميّة للطفل تعدّ من المقوّمات الأساسية لمستقبله ولتحديد مستوى الرفاهية في المجتمع. وهو يضيف (ص 153) إنّ الأزمات تؤدّي عادة ليس إلى ظهور اضطراب ما بعد الصّدمة فحسب، بل يمكن أن يتعرّض الطفل لمشاكل أخرى كالقلق واليأس ونوبات الغضب، وفقدان الشّعور بالأمل، وحتّى الشّعور بالذّنب، وكل ذلك يمكن أن يتمظهر على هيئة مشكلات دراسيّة (الذّاكرة ونقص في الانتباه والتّركيز مثلًا)، أو في العلاقات مع الآخرين سيّما في ازدياد نسبة التعلّق بأحد الوالدين أو كليهما خوفًا من الخسارة (الفقد)، أضف إلى المشاكل الصحيّة كالتعرّض للأمراض أو حدوث اضطرابات في النّوم والأكل وغيرها من الوظائف.
إنّ الأزمات تؤدّي إلى حدوث الصدمات Trauma، وبمعزل عن النّظرية التي تفسّر الصّدمة (السّلوكيّة، المعرفيّة، …)، ما يهمنا هو النتيجة أو العوارض التي نستدل من خلالها إلى ضرورة التدخّل.
- الدّماغ وفيزيولوجيا الضغوطات
لست في صدد الوقوف عند تشريح الدّماغ في طيّات هذه الدّراسة، مع أهمّيّة ذلك، ولكنني سأتوقّف عند بعض الآليات الدّاخليّة النّاظمة لكيفيّة عمله للتمكّن من فهم الأسباب والتّفاعلات النّفسيّة والسّلوكيّة والمعرفيّة، أي تغيّر وظائف الدّماغ وتأثّرها نتيجة تعرّض الفرد للصّدمات أو القلق المستمر أو الخوف مثلًا، علّني أستطيع الاستفادة من هذه المعطيات عند التّخطيط لمواجهة الأزمات.
إنّ الخبرات الصادمة قد تؤدّي إلى السلوك الاندفاعي وانفجارات الغضب والعنف والتهيّج لدى بعض الحالات، فهي استجابة وجدانيّة أفرزتها التركيبات العصبيّة في الدماغ بسبب التعرّض الدائم أو المستمر للتهديد النّاجم عن المواقف الصّعبة، وتظهر الاستجابة تلك على شكل استجابة نروهرمونيّة من خلال ارتفاع ضغط الدّم، وسهولة الاستثارة العصبيّة (انفجارات الغضب، والعدوانيّة وغيرها). وفي حال استمرار الضغط أو معاودة الصّدمة تصبح الاستجابات أكثر قوّة. وترتبط الضّغوطات باضطرابات في الذّاكرة والتعلّم التي ترتبط بدورها بتغيّرات في تراكيب، أو بنيات معيّنة في الدّماغ بما في ذلك الفص الجداري Parietal lobe، واللوزة وقرن آمون أو الحصين Hippocampus (عرعار، 2015، ص 95-96). وفي سياق اختبار أثار التّجارب القاسية خلال مدّة الطفولة والبلوغ على بنية الدّماغ والقدرة المعرفيّة والصّحّة العقليّة، قام ماكمانوس وآخرون (MacManus et al., 2022) باستخدام بيانات البنك الوطني البريطاني لأكثر من 500.000 مشارك. وأظهرت النتائج العلاقة بين الضّغوط المرتفعة في مرحلتي الطفولة، والبلوغ وانخفاض مستوى الوظائف التّنفيذيّة والذّاكرة العاملة لدى كل من الإناث والذّكور، كما العلاقة بين الضّغوط المعاشة عبر مراحل النموّ وعدد من مشاكل الصحّة النّفسيّة، فالروابط هي ذات دلالة بين الضّغوط المعاشة والتغيّرات في مقاييس بنية الدّماغ الدّقيقة (Hippocampus) والضّعف في القدرات المعرفيّة والصحّة العقليّة.
ولعله من البديهي التّساؤل حول “حتميّة” تأثير الأزمات على الأفراد، ولماذا بعض الأشخاص قد يكونوا أكثر عرضة من غيرهم لتطوير اضطراب ما بعد الصّدمة لدى تعرّضهم لمستويات متماثلة من الصّدمات أو اختبارهم للأزمات، وفي هذا الصّدد تشير أوكزيميري (Auxéméry, 2012)أنّ اضطراب ما بعد الصّدمة هو نتيجة تفاعل بين الفرد نفسه، والعامل المسبّب للأزمة أو الأزمة نفسها والسّياق الاجتماعي. أي أنّها تفاعل بين الذّات الداخليّة والعوامل الخارجيّة. إنّ شروط حدوث الصّدمة تتأسّس على محدّدات جينيّة ونفسيّة تتفاعل بشكل متكامل في سياق اجتماعي. أضف إلى إمكانيّة ظهور هذا الاضطراب بأشكال سريريّة مختلفة، إلّا أنّه أيضًا يمكن أن يظهر بعد مدّة طويلة من الحدث الصّادم، أي بعد مرحلة كمون قليلة الأعراض والتي يمكن أن تستمر لعدّة سنوات أو حتّى عقود. فالخبرات المبكرة والتأثيرات البيئيّة، يمكن أن تترك بصمة دائمة على الاستعدادات الجينيّة التي تؤثّر على بنية الّدماغ في طور النموّ، والصحّة على المدى الطويل (Shonkoff & Ganer, 2012). إذ ترتبط التحدّيات المبكرة بالضّعف اللاحق في التعلّم والسّلوك والصّحّة البدنيّة والعقليّة.
ومن الطبيعي أن تختلف طريقة استيعاب كل فرد للصّدمة تبعًا لعوامل خاصّة بالفرد نفسه (كالعمر والخبرات السابقة) وأخرى تتعلّق بالعوامل الخارجيّة سواء الصدمة نفسها أو ما تلاها كوجود الدعم أو غيابه، أو ظروف أخرى، فمنهم من يتجاوزها من دون الإصابة باضطراب ما بعد الصّدمة والبعض الآخر قد لا ينحج في ذلك، فتتجلّى من خلال جملة من المظاهر منها: اضطرابات في النموّ، والأكل، والتّركيز والانتباه، والعزلة الاجتماعيّة وإحساس بالعجز والحزن، وحتّى الأمراض النفس-جسدية كالصّداع النّصفي، وارتفاع ضغط الدم، وتقرّحات المعدة، وهي بدورها مظاهر لاضطرابات تحتاج إلى علاج.
وللوقوف عند كيفيّة تأثير الخوف والقلق الناتج عن الصّدمات على الدّماغ والجسم، أشار فاندركولك (Van Der Kolk, 2014) إلى أنّ التعرّض لتجارب وخبرات صادمة يغيّر في بنية الدماغ (الحصين مثلًا Hippocampus)، فتصبح بعض المناطق أكثر نشاطًا استجابة للخطر والخوف كالأميغدالا مثلًا (Amygdala)، ما يترك آثارًا على الحصين فتضعف الذاكرة ويحدث تشويش بين الحاضر والماضي، وتنخفض قدرة القشرة الجبهيّة الأماميّة (Prefrontal Cortex) على التنظيم المنطقيّ والانفعاليّ. ويضيف الكاتب إلى أنّ التّجارب الصّادمة تبقى عالقة في الجسم، إذ تظهر كأعراض جسميّة على قاعدة أنّ الجسم ما زال يتفاعل، ويستجيب كما لو أنّ التهديد ما زال قائمًا. وهو يذهب إلى القول بعدم فعاليّة علاج الصّدمة بالكلام لوحده، كالعلاج المعرفيّ السلوكيّ أو التحليل النفسيّ، إذ يجب أيضًا إشراك الجسم في العلاج كونه هو الذي “يتذكّر” الصدمة بيولوجيًا.
لعل ما يثير القلق في هذه الدّراسات الحديثة في علم الأعصاب والوراثة هو إمكانيّة “توريث الصدمات”، ليس على المستوى الاجتماعيّ السّلوكيّ كما هو معروف، وإنّما على المستوى الجينيّ، فالتغيّر الحاصل هو في تشفير الحمض النّووي لدى الأفراد الذي يؤدي دورًا حاسمًا في ترجمة المثيرات البيئيّة إلى تغييرات عصبيّة بيولوجيّة غير مؤقّتة. فالاضطرابات تعمل على تغيير المسارات العصبيّة والتنظيم العاطفيّ أي تعديل كيفية الاستجابة، ويشير الدّسوقي وآخرون إلى أنّه يمكن لهذه التّعديلات أن تؤثّر بشكل مستمر على كيفيّة تعامل الأفراد مع التّجارب المؤلمة وحتّى كيفيّة التعافي منها (Addisouky et al., 2025, p.2). إنّها وراثة جينيّة مكتسبة Epigenetics تشير إلى دراسة التغيّرات الوراثيّة في الجينات من دون تعديل في السلسلة الجينيّة DNA، وتحدث هذه التغييرات نتيجة العوامل البيئيّة من قبيل الصّدمات النفسيّة والتوتّر ونمط الحياة بشكل عام، وقد تسهم في تطوّر أمراض مختلفة بما في ذلك اضطرابات ما بعد الصدمة. وهذا ما يفسّر كيف يمكن للإساءة أو التعرّض لأحداث صادمة أن تترك آثارًا دائمة على التنظيم الجينيّ، إذ تقوم هذه التجارب بتشكيل أنماط جينيّة ترفع من احتماليّة التعرّض للإصابة باضطرابات لاحقًا في مراحل الحياة (Addisouky et al., 2025, p.7). فالعلاقة هي إذًا متبادلة بين النّظام العصبيّ، والغدديّ، والمناعيّ في مقابل الاستجابة للتوتّر أو القلق (McEwen, 2007; Addisouky et al., 2025). فالهرمونات الناتجة عن الضغوط والتوتّر تحمي الجسم وتساعده على التكيّف مع الموقف على المدى القصير، ولكنّها في المقابل، وعلى المدى الطويل، تزيد من الحِمل على أجهزة الجسم وتتسبّب في تغييرات فسيولوجيّة تؤدّي إلى الإصابة بالأمراض (McEwen & Seeman, 2006; Shin & Liberzon, 2010; Van Der Kolk, 2014)، وتجدر الإشارة إلى أنّ عامل الإجهاد أو الضغط ليس العامل الوحيد في حدوث هذه التغييرات، إذ تؤدي العوامل الفرديّة والاجتماعيّة دورًا مهمًا في هذا المسار كما ذُكر سابقًا.
وقد أشارت في السّياق نفسه ييهودا وليرنر (Lehrner & Yehuda, 2018; Yehuda & Lehrner, 2018) في دراستيهما حول الصدمات الثقافيّة وتناقلها بين الأجيال، إلى أنّ الصّدمات النّفسيّة الشديدة كالتي يتعرّض لها النّاجون من الحروب أو الكوارث، تترك بصمات جينيّة مكتسبة Epigenetic marks من دون تغيير في الشيفرة الوراثيّة نفسها، سيما في الجينات المسؤولة عن تنظيم استجابة الجسم للتوتّر، وقد أظهرت النتائج أنّ أطفال الأمهات اللواتي تعرّضن لاضطراب ما بعد الصّدمة، أظهروا مستويات مختلفة من المَثيَلة([3]) Methylation في هذه الجينات، ما يعني أنّ الجهاز العصبي لدى الأبناء قد تكيّف مسبقًا للتعامل مع الأحداث الخطرة من دون أن يكون قد تعرّض للحدث الصّادم بذاته. فالبعد الاجتماعيّ والثقافيّ للصدمة، والرّموز الجماعيّة والخطاب الجمعي والعادات التربويّة تسهم في تثبيت آثار الصدمة على المستويين النفسيّ والببيولوجيّ معًا. هذا الاتساق بين الأبعاد الاجتماعيّة والبيولوجيا أثبتته دراسة الدسوقي وآخرون (2025)، وقد دعمت أيضًا هذه النتيجة دراسة سفورغوفا (Švorcová, 2023) مشيرة إلى توريث الصّدمة ليس من خلال الخبرة الشخصيّة فحسب، وإنّما أيضًا عبر الخلايا الجنسيّة، ما يساهم في توريثها عبر الأجيال.
تشير هذه النتائج كيف يمكن للدّماغ والصّحّة النفسيّة أن يتشكلا في ظل ذاكرة تُنُقِلت، ولم يخبرها الفرد بشكل مباشر، بل تُنُقِلت عبر بصمات وراثيّة واجتماعيّة، تجعل من التعلّم والانفعال على حدّ سواء محكومَين بتاريخ بيولوجيّ نفسيّ سابق.
ثامنًا: الخاتمة والتوصيات
نحن إذًا أمام كمّ كبير من المعطيات العلميّة التي لا يمكن تجاوزها من دون الوقوف عندها، وبالعودة إلى سؤاليّ الدّراسة المتمحورين حول الأطر المرجعيّة، والمفاهيميّة التي يمكن من خلالها محاولة التأسيس لمواجهة معضلة التربية والتّعليم في زمن الأزمات، ومدى إمكانيّة مراعاة بُعديّ التربية والتعليم في الوقت نفسه، أي بشكل متزامن في زمن الأزمات، والتّوزان بينهما، فإنّ كل ما ورد ضمن صفحات هذه الدّراسة من أدبيّات ودراسات سابقة بما تتضمّنه من معطيات، وأطر مرجعيّة ومفاهيميّة يمكن أن تسهم في إعادة النظر في السياسات الحاكمة عند مواجهة الأزمات، وما يتّصل بها من آليات عمل وخطط إجرائيّة تعليميّة وغير تعليميّة والتي يمكن تلخيصها بالآتي:
- الأزمات على مختلف أنواعها تترك آثارًا على مستوى الصحّة النفسيّة للأفراد مع لحاظ أنّ الصغار هم الأكثر تأثّرًا.
- للحالة النّفسيّة للفرد آثار مباشرة على قدراته المعرفيّة والاجتماعيّة وبالتالي على التعلّم.
- هذا التأثّر تختلف حدّته باختلاف شدّة الأزمة نفسها، واختلاف الخصائص الشّخصيّة والعوامل الاجتماعيّة المحيطة.
- الصّدمات الناتجة عن الأزمات تترك تغييرات فعليّة (في مقابل افتراضيّة) في بنية الدّماغ، وهذه التغيّرات يمكن توارثها عبر الأجيال. بمعنى آخر توريث الصدمات.
وإذا ما عدت إلى موضوع التّوازن بين التربية والتّعليم في زمن الأزمات، فنتائج الدّراسة تشير إلى إمكانيّة حصول ذلك، ولكن على قاعدة “التتابع” وليس “التزامن بينهما”، أيّ عدّ الصّحّة النفسيّة والعقليّة لكل من المتعلّمين والكوادر هي نقطة الانطلاق وبوصلة الريادة، وبناء الخطط الاستباقيّة التي تعزّز المناعة وتدعمها، وتشكيل فرق تخصّصيّة أو الاستعانة بالجهات القادرة على التدخّل بالطريقة والوقت المناسبين. وإعطاء الوقت وتوفير المساعدة للتعافي من الصّدمات، إذ إنّ تجاهلها قد ينظر إليه على أنّه حلّ للمشكلة، ما قد يكون صحيحًا على المدى القصير، ولكن بالنّظر إلى أنّ الصدمات والأزمات هي جزء من تركيبة الحياة نفسها وما تحويه من صراعات ومآزم، فإنّ تراكم المشكلات من دون حلّها يساعد على تفاقم الأعراض على المدى الطويل، ويحمّل الأجيال القادمة تبعات التقصير. فالريادة تتحقّق من خلال التركيز على مستوى تعزيز الذات الإنسانيّة وتحصينها بداية، ولتُبنى الخطط بمستلزماتها كافّة بناء عليها، كي يُعمَل لاحقًا على إيلاء ملف التعليم والتثقيف العناية اللازمة.
أمّا أبرز التوصيات التي نستمدّها من هذه الدّراسة فهي:
- مراعاة الأوضاع النّفسيّة – الاجتماعيّة لكل المتأثرين بالأزمات من متعلّمين وغير متعلّمين.
- بناء الخطط الاستباقيّة التي تساعد الأفراد على احتواء الأزمات وتوفير مستلزمات تطبيقها.
- إدماج استراتيجيات مواجهة المتعلّمين للضغوط في زمن الأزمات في الوحدات التعليميّة والأنشطة الصّفيّة.
- تهيئة المؤسّسات التّعليميّة لكوادرها وتدريبهم على كيفيّة مواجهة الأزمات وإدارتها على مختلف الصعد.
- توفير الخدمات الإرشاديّة والعلاجيّة التي تساعد على تعزيز المناعة النفسيّة لدى الأفراد.
- تقديم جرعات تعليميّة تتناسب مع الأوضاع النفس-اجتماعيّة للمتعلّمين خلال الأزمات.
- توفير المؤسّسات التعليميّة لقنوات تواصل مع المتعلّمين وأسرهم لتقديم الدعم المعنوي والتعليمي في كل الأوقات، وليس في زمن الأزمات فحسب.
- المصادر والمراجع
- أبو شديد، كمال. (2008). الصحّة النفسية للتلامذة استنادًا إلى قائمة الشخصية للأطفال (الصفّ الأوّل إلى الخامس). في الأحوال النفسية للأطفال والشباب في لبنان (ص ص. 181- 221). الهئية اللبنانية للعلوم التربوية والجمعية الكويتية لتقدّم الطفولة العربية.
- أبو الفضل، مروة أحمد محمد. (2024). الاضطرابات النفسية المرتبطة بجائحة كورونا (كوفيد 19) لدى طلاب الجامعة. مجلة كلية التربية بالمنصورة، 124(3)، 1927-1952. Doi:10.21608/MAED.2024.359257
- أبو خيران، أشرف محمد، والعرجان، عاطف محمود. (2021). واقع إدارة الأزمات لدى مديري المدارس الحكومية في محافظة الخليل خلال جائحة كورونا. مجلة العلوم التربوية والنفسية، 5(48)، 20-51 https://doi.org/10.26389/AJSRP.K100621 DOI:
- بالقاسمي، محمد الأزهر. (2022). واقع إدارة الأزمات في المؤسسات التعليمية في ظل جائحة كورونا (كوفيد-19) من وجهة نظر مديري التعليم الثانوي والمتوسط. مجلة الجامع في الدراسات النفسية والعلوم التربوية، 7(2)، 1394-1428
https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/309
- برينكمن، ديفيد، كيميل، أحمد، ونورتون-أريشسن، نادين. (2017). الاضطرابات الناتجة عن الصدمة النفسية والاضطراب المجهد بعد الصدمة النفسية- الأسباب والتداعيات والمساعدات. MIMI ms.niedersachsen.de
- الثبيت، ليون محمد صالح. (2020). أساليب التخطيط لتطزير إدارة الأزمات بمدارس التعليم الأساسي. مجلة للقراءة والمعرفة، 1(228)، 215-241 21608/mrk.2020.137346 doi:
- دومي، كنزة. (2020). الآثار النفسية المترتبة على الحجر الصحّي على الصحّة النفسية للطفل والأسرة وسبل تجنّبها. مجلة دراسات في سيكولوجية الإنحراف 5(1)، 64-71 ISSN: 2602554X-
- سلّام، ذكريات. (2023). واقع إدارة الأزمات التعليمية في المدارس الثانوية الحكومية في محافظة عدن من منظور النوع الاجتماعي. مجلة جامعة السعيد للعلوم الانسانية، 6(5)، 46- 71 https://journal.alsaeeduni.edu.ye
- الشامي، السعيد سعد، والزنفلي، أحمد محمود. (2021). مُوجّعات مستقبلية لتخطيط التعليم في أوقات الأزمات: جائحة كورونا نموذجًا. المركز الإقليمي للتخطيط التربوي ومنظمة الأونيسكو
- شاهين، سهيلة أحمد. (2022). الآثار التربوية والنفسية والاجتماعية للتعلم عن بعد في ظل جائحة كورونا على الطلبة والمعلمين والأسرة. المجلة العربية للتربية النوعية، 6(23)، 159-180. http://jasg.journals.ekb.eg
11- الطلحة، غادة سعد سلمان. (2023). الآثار السلبية للحجر الصحّي على الصحّة النفسية لدى المصابين بفيروس كورونا والمشتبه بإصابتهم. مجلة بحوث ودراسات نفسية، 19(1)، 115-152. Doi:10.21608/JSHP.2023.355123
12-العتيبي، سعد. (2024). واقع إدارة الأزمة في جامعة أم القرى في ظل جائحة كورونا كوفيد 19 وأثر ذلك في خطط إدارة الأزمة بالجامعة. المجلة العربية للإدارة، 44 (4)، 33-50. Doi:10.21608/AJA.2021.88899.1127
13-غرز الدين، مروان. (2008). الصحّة النفسية للتلامذة استنادًا إلى قائمة الشخصية للشباب (الصفّ السادس إلى الثاني عشر). في الأحوال النفسية للأطفال والشباب في لبنان (ص ص. 135-181). الهئية اللبنانية للعلوم التربوية والجمعية الكويتية لتقدّم الطفولة العربية.
14-غنيم، صلاح الدين. (2020). واقع تطبيق التعليم عن بعد خلال جائحة/نازلة كورونا في المدراس المصرية ومقترحات تطويره. مجلة العلوم التربوية، 1(4)، 3-73.
15-فواز، جورية. (2011). صدمة الحرب، آثارها النفسية والتربوية في الأطفال (تجربة حرب تموز أنموذجًا). دار النهضة العربية ISBN 978-614-402-316-7
16-القحطاني، سارة حمود. (2023). أثر التعليم عن بعد في تحقيق فاعلية العملية التعليمية أثناء جائحة كورونا، دراسة حالة على جامعة الأميرة نورة في مدينة الرياض. مجلة العلوم التربوية والنفسية، 7(41)، 47-61. https://doi.org/10.26389/ AJSRP.N280823
17-معيكي، كوزيت. (2008). الصحّة النفسية لأطفال الروضات استنادًا إلى قائمة تدقيق السلوك عند الطفل. في الأحوال النفسية للأطفال والشباب في لبنان (ص ص. 221-261). الهئية اللبنانية للعلوم التربوية والجمعية الكويتية لتقدّم الطفولة العربية.
18-يابري، ماريا، وهادي، فوزية. (2008). أعراض ضغط ما بعد الصدمة، سمة القلق والضغط المدرك. في الأحوال النفسية للأطفال والشباب في لبنان (ص ص. 99- 135). الهئية اللبنانية للعلوم التربوية والجمعية الكويتية لتقدّم الطفولة العربية.
19-Addissouki, T.A., El Sayed, I.E.T,. & Wang, Y. (2025). Epigenic factors in posttraumatic stress disorder resilience and susceptibility. Egyptian Journal of Medical Human Genetics, 26:50. https://doi.org/10.1186/s43042-025-00684-w
20-Akat, M. & Karataş, K. (2020). Psychological effects of Covid-19 Pandemic on society and its reflections on education. Turkish Studies, 15(4), 1-13 https://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.44336
21-Al-Naser, F., Al-khulaifi, I.M.. & Martino, C. (2000). Assessment of posttraumatic stress disorder four and one-half years after the Iraqi invasion. International Journal of Emergency Mental Health, 2(3), 153-156. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11232095/
22-Asadzandi, M., Zoheiri, M., Akbariqomi, M., & Masuodi, O.A. (2022). The role of spiritual communication in management of health services during the biological crisis of Covid-19. Journal of Military Medicine, 24(5), 1279-1286. Doi:10.30491/JMM.24.5.1279
23-Auxéméry, Y. (2012). L’état de stress post-traumatique comme conséquence de l’intéraction entre une susceptibilité individuelle, un évènement traumatogène et un contexte social [Posttraumatic stress disorder (PTSD) as a consequence of the interaction between an individual genetic susceptibility, a traumatogenic event and a social context]. L’Encephale, 38(5), 373- 380. https://doi.org/10.1016/j.encep.2011.12.003
24-Baubion, C. (2013). OECD Risk Management: strategic crisis management. OECD
25-Coco, G.L., Salerno, L., Albano, G., Pazzagli, C., Lagetto, G., Mancinelli, E., Freda, M.F., Bassi, G., Giordano, C., Gullo, A., & Blasi, M.D. (2023).
26-Psychosocial predictors of trajectories of mental health distress during the Covid-19 pandemic: A four-wave panel study. Psychiatry Research, 326, Article ID: 115262 https://doi.org/10.1016/j.psychres.2023.115262
27-Cao, w., Fang, Z., Hou, G., Han, M., Xu, X., Donj, J., & Zheng, J. (2020). The psychological impact of Covid-19 epidemic on college students in China. Psychiatry Research, 287, Article ID: 112934. https://doi.org/10.1016/j.psychres.2020.112934
28-Crandall, W., Parnell, J.A., & Spillan, J.E. (2014). Crisis management: leading in the new strategy landscape. Sage Publications
29-Dubrovski, D. (2023). Condition for a successful elimination of crisis: special competencies and styles of the crisis manager. Journal of Financial Risk Management, 12, 405-424. https://doi.org/10.4236/jfrm.2023.124021
30-Galvin, M., Michel, G., Saintelmond, H-C., Lesorogol, C., Trani, J-F, & Iannotti, L. (2023). International Journal of Mental Health Promotion, 25(2), 173-191. DOI: 10.32604/ijmhp.2023.018800
31-Hadi, F., Liabre, M.M., & Spitzer, S. (2006). Gulf war-related trauma and psychological distress of Kuwaiti children and their mothers. Journal of Traumatic Stress, 19(5), 653-662. https://doi.org/10.1002/jts.20153
32-Lehrner, A., & Yehuda, R. (2018). Cultural trauma and epigenetic inheritance. Development and Psychopathology, 30, 1763-1777. doi:10.1017/S0954579418001153
33-Macksoud, M.S. (1992). Assessing war trauma in children: a case study of Lebanese children. Journal of Refugee Studies, 5 (1), 1-15. https://doi.org/10.1093/jrs/5.1.1
34-MacManus, E., Haroon, H., Duncan, N., Elliott, R., & Muhlert, N. (2022). The effects of stress across the lifespan on the brain, cognition and mental health: A UK biobank study. Neurobiology of Strss, 18: 100447 https://doi.org/10.1016/j.ynstr.2022.100447
35-McEwen, B.S. & Seeman, T. (2006). Protective and damaging effects of mediators of stress: elaborating and testing the concepts of allostasis and allostatic load. Annals of the New York Academy of Sciences, 896(1), 30-47 https://doi.org/10.1111/j.1749-6632.1999.tb08103.x
36-McEwen, B.S. (2007). Physiology and neurobiology of stress and adaptation: central role of the brain. Physiology Revue, 87, 873- 904 doi:10.1152/physrev.00041.2006
37-Mitroff, I, & Anagnos, G. (2005). Managing crises before they happen. Amacom ISBN: 9780814473283
38-Papa, S., Barmparessou, Z., Athanasiou, N., Sakka, E., Eleftheriou, K., Patrinos, S., Sakkas, N., Pappas, A., Kalomenidis, I., & Katsaounou, P. (2022). Depression, insomnia and post-traumatic stress disorder in Covid-19 survivors: role of gender and impact on quality of life. Journal of Personalized Medecine, 12(3), 486 https://doi.org/10.3390/jpm12030486
39-Pashko, T., Tovstukha, o., Chernovska, L., Serhieieva, I., & Chumak, O. (2025). Impact od crisis on the family and technologies of psychosocial support to overcome the consequences. European Journal of Trauma & Dissociation. https://doi.org/10.1016/j.ejtd.2025.100580
40-Rajić, V., Višnjić-Jevtić, A., Odrowaz-Coates, A., Bradt, L., & Simut, C. (2024). 41-Navigating crises: examining the impact on students in four European countries. Journal of education for life, 38(1), 24-36, https://doi.org/10.33308/26674874.2024381661
42-Rajkumar, R.P. (2020). Covid-19 and mental health. Asian Journal of Psychiatry, 52: 102066 https://doi.org/10.1016/j.ajp.2020.102066
43-Rubens, D. (2023). Strategic risk and crisis management. Kogan Page ePubISBN: 9781398609754
44-Sheivandi, K., & Hasavand, F. (2021). Developing a model for the psychological consequences of corona epidemic anxiety and studying the mediation role of spiritual health. Counseling Culture and Psychotherapy Journal, 11(42), 1-36. https://doi.org/10.22054/qccpc.2020.50918.2346
45-Shin, L.M., & Liberzon, I. (2010). The neurocircuitry of fear, stress, and anxiety disorders. Neuropsychopharmacology Reviews, 35, 169-191 doi:10.1038/npp.2009.83
46-Shonkoff, J.P., & Garner, A.S. (2012). The lifelong effects of early childhood adverdity and toxic stress. Pediatrics, 129(1):e232-246. https://doi.org/10.1542/peds.2011-2663
47-Sun, L., Shang, Z., Wu, L., Pan, X., Sun, L., Ouyang, H., Huang, H., Zhan, J., Jia, Y., Zhou, Y., Bai, Y., Xie, W., & Liu, W. (2023). One-quarter of Covid-19 patients developed PTSD symptoms: a one year longitudinal study. Psychiatry Research, 323: 115161 https://doi.org/10.1016/j.psychres.2023.115161
47-Slavin, R.E. (2014). Educational psychology, theory and practice. Pearson
Švorcová, J. (2023). Transgenerational epigenetic inheritance of traumatic experience in mammals. Genes, 14, 120. https://doi.org/10.3390/genes14010120
48-Thandevaraj, E.J., Gani, N.A.N., & Nasir, M.K.M. (2021). A review of psychological impact on students online learning during Covid-19 in Malaysia. Creative Education, 12, 1296-1306. https://doi.org/10.4236/ce.2021.126097
49-Ulmer, R.R., Sellnow, T.L., & Seeger, M.W. (2007). Effective crisis communication: moving from crisis to opportunity. Sage Publications
50-Van Der Kolk, B. (2014). The body keeps the score, brain, mind, and body in the healing of trauma. Viking eBook ISBN 978-1-10160830-2
51-Xu, F., & Brodszky, V. (2024). The impact of Covid-19 on health-related quality of life: a systematic review and evidence-based recommendations. Discover Psycholody, 4(90). https://doi.org/10.1007/s44202-024-00204-8
52-Yanikkaya, B. (2025). Learning and teaching in situations of crisis: needs and support provision. European University Association (EUA). http://www.eua.eu
53-Yehuda, R., & Lehrner, A. (2018). Intergenerational transmission of trauma effects: putative role of epigenetic mechanisms. World Psychiatry, 17, 243-257 DOI: 10.1002/wps.20568
[1]– أستاذة محاضرة في الجامعة اللبنانيّة- بيروت- لبنان -كلية التربية
Lecturer at the Lebanese University – Beirut – Lebanon – Faculty of Education .Email: nancy.moussawi@ul.edu.lb
[2] -Posttraumatic stress disorder
[3] – مثليّة الحمض النووي DNA Methylation هي عملية يُضاف فيها مجموعة ميثيل إلى قاعدة السيتوزين C في سلسلة الحمض النووي. وهذه العمليّة لا تغيّر السلسلة الجينية، لكنّها تؤثّر على كيفية تعبير الجينات، أي تشغيلها أو تعطيلها.