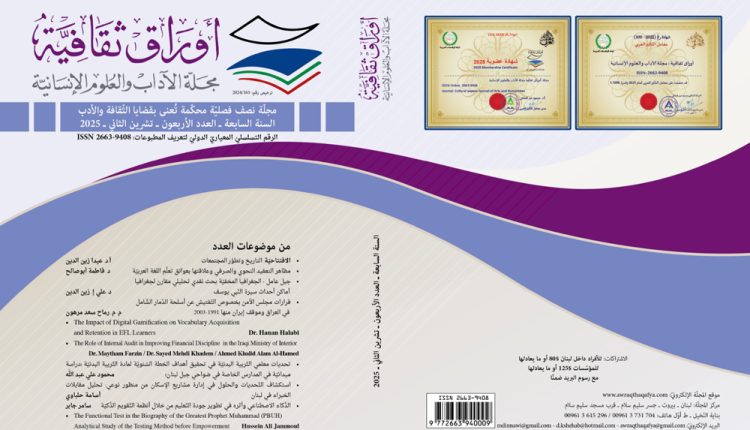عنوان البحث: القصيدة كنظام لغوي مغلق: دراسة في آليّات إنتاج المعنى البنيوي
اسم الكاتب: د. فاطمة أبوصالح
تاريخ النشر: 2025/11/14
اسم المجلة: مجلة أوراق ثقافية
عدد المجلة: 40
تحميل البحث بصيغة PDFADOI: https://aif-doi.org/awraq/014005
القصيدة كنظام لغوي مغلق: دراسة في آليّات إنتاج المعنى البنيوي
The Poem as a Closed Linguistic System: A Study in the Mechanisms of Structural Meaning Production
Dr. Fatme Abou د. فاطمة أبوصالح([1])
تاريخ الإرسال:11-10- 2025 تاريخ القبول:23-10-2025
turnitin:3 % الملخّص
تُعدّ البنيويّة من أبرز المناهج النقديّة التي أعادت تشكيل فهمنا للنصوص الأدبيّة، وبخاصّة القصيدة العربيّة، إذ نقلت مركز الاهتمام من المعنى الجاهز إلى البنية الداخليّة للنص. لم تعد القصيدة انعكاسًا لسياق خارجي أو تجربة شخصيّة للشاعر، بل أصبحت كيانًا لغويًّا مستقلًا، يُنتج المعنى من خلال تفاعل عناصره الداخليّة. هنا يظهر دور البنيويّة في تفكيك شيفرة القصيدة، عبر التّركيز على الأدوات البنيويّة مثل الإيقاع، التكرار، الصّور الشعريّة، الانزياح، والتوازي، بوصفها أنساقًا تُنتج دلالة معقّدة لا تُقرأ من خارج النص، بل من داخله.
في هذا السّياق، تُصبح القصيدة شبكة من العلاقات النّصيّة التي ترتبط ببعضها عضويًّا، وتتفاعل فيما بينها ضمن نسق متكامل، إذ يُصبح كلّ عنصرٍ جزءًا من نظامٍ كُلّيٍّ يُسهم في بناء المعنى. الإيقاع، على سبيل المثال، لا يُفهم كمجرّد عنصر جمالي، بل يُعد بنيةً صوتيّةً تُسهم في تشكيل التوتّر الدّلالي داخل النصّ. كذلك، فإنّ التّكرار لا يُستخدم فقط للإيقاع، بل يعمل على ترسيخ صور محدّدة وتكثيف الشّعور أو الفكرة، بينما يؤدّي التّوازي إلى إبراز العلاقة بين المفاهيم وتوليد توازن داخلي يُعمّق التّجربة الشّعوريّة.
أمّا الصّور الشعريّة، فهي ليست مجرد زينة بلاغيّة، بل أدوات رمزيّة تُعيد تشكيل الواقع داخل القصيدة بلغة كثيفة وإيحائيّة، تُجبر القارئ على قراءة متأنّية. ومع البنيويّة، لم يعد القارئ مستهلكًا للمعنى، بل فاعلًا في إنتاجه، من خلال قدرته على تتبّع العلاقات الداخليّة للنّص وفهم آليّات عمله.
إنّ النص المغلق، كما تفترض البنيويّة، يحمل داخله كلّ المفاتيح اللازمة لفهمه. وبهذا، تغدو القصيدة وحدة مستقلّة يمكن تحليلها علميًّا بعيدًا عن السياق الخارجي أو النوايا المسبقة. هذا التحوّل يُعيد الاعتبار للّغة بوصفها نظامًا رمزيًّا خاضعًا لقوانين يمكن تفكيكها، ويمنح القارئ فرصة لفهم أعمق، وأكثر دقّة، لمعاني الشعر العربي الكلاسيكي والحديث.
الكلمات المفتاحيّة:البنيويّة-البنية الداخليّة- شيفرة- القصيدة- المعنى
Abstract
Structuralism is one of the most prominent critical approaches that reshaped our understanding of literary texts, particularly Arabic poetry. It shifted the focus from predefined meaning to the internal structure of the text. The poem is no longer seen as a reflection of an external context or the poet’s personal experience; instead, it becomes an independent linguistic entity that generates meaning through the interaction of its internal elements. This is where structuralism plays a role in deciphering the poem’s code, by focusing on structural tools such as rhythm, repetition, imagery, deviation, and parallelism, considering them systems that produce complex meanings that are not read from outside the text, but from within it.
In this context, the poem becomes a network of textual relationships that are organically connected, with each element contributing to the formation of a unified system that builds the meaning. For example, rhythm is not understood as a mere aesthetic element, but as a sound structure that contributes to the formation of the semantic tension within the text. Similarly, repetition is not only used for rhythm but also serves to reinforce specific images and intensify feelings or ideas, while parallelism highlights the relationship between concepts, creating an internal balance that deepens the emotional experience.
As for the poetic images, they are not just rhetorical decorations but symbolic tools that reshape reality within the poem using dense and suggestive language, forcing the reader to engage in careful reading. With structuralism, the reader is no longer a passive consumer of meaning but an active participant in its production by tracing the internal relationships of the text and understanding its mechanisms.
The closed text, as structuralism assumes, contains all the necessary keys for its understanding. Thus, the poem becomes an independent unit that can be scientifically analyzed, detached from external context or prior intentions. This transformation restores the significance of language as a symbolic system governed by laws that can be deconstructed, providing the reader with an opportunity for a deeper, more precise understanding of the meanings of both classical and modern Arabic poetry.
Keywords: Structuralism, internal structure, code, poem, meaning.

المقدّمة: في عالم الشّعر، لا يكون المعنى دائمًا واضحًا أو مباشرًا، بل كثيرًا ما يتخفّى خلف الألفاظ، ويعاد إنتاجه عبر تراكيب لغويّة دقيقة، وعلاقات داخليّة معقّدة بين عناصر النص. ومن هنا بزغت الحاجة إلى مناهج نقديّة تعيد النّظر في طرائق الفهم والتّأويل، وتتجاوز القراءة السّطحيّة التي تلاحق “ماذا يُقال”، إلى قراءة تتفحّص “كيف يُقال”. في هذا الإطار، ظهرت البنيويّة بوصفها منهجًا يركّز على بنية النّص بوصفها المصدر الأساسي للمعنى، مقصيًا ما هو خارجُه من سياق تاريخي أو نفسي أو اجتماعي.
البنيويّة لا تنظر إلى القصيدة كمرآة تعكس واقعًا خارجيًا، بل كمركّب لغوي مستقل، تحكمه قوانين داخليّة، وتُنتج دلالته من خلال علاقة الأجزاء بالكُل، وعبر التّوازنات الدّقيقة بين الإيقاع، والصّورة، واللغة، والتركيب. في هذا السّياق، تتحوّل قراءة القصيدة إلى عملية تفكيك لشيفرة رمزيّة؛ إذ لا يُعدّ المعنى هدفًا جاهزًا، بل نتيجةً لسيرورة تأويليّة تستند إلى تحليل البنية ذاتها.
وما “وراء المعنى” لا يُقصد به البعد الميتافيزيقي أو الخفيّ الغامض، بل الإشارة إلى تلك الطبقات البنيويّة التي تُنتج المعنى داخل النّص من دون الحاجة إلى الرجوع لما وراءه. فكلّ ما يلزم القارئ لفهم النص، موجود فيه. وهكذا تُعيد البنيويّة تعريف العلاقة بين القارئ والنص، لا بوصف القارئ متلقّيًا سلبيًا، بل شريكًا في بناء المعنى.
من هنا، تصبح القصيدة كيانًا قائمًا على نظام داخلي دقيق، وتُعدّ البنيويّة أداة منهجيّة لفهم هذا النظام، وتفكيك عناصره، وإعادة تركيب دلالاته ضمن حدود النص ذاته، من دون افتراضات مسبقة أو قراءات خارجة عن بنيته اللغويّة.
أولًا: أهداف البحث
يهدف هذا البحث إلى مقاربة القصيدة العربيّة من زاوية بنيوية تُركّز على العلاقات الدّاخليّة التي تُنتج المعنى، بدلًا من الاعتماد على المرجعيّات الخارجيّة كالسياق التاريخي أو السّيرة الذاتيّة للشاعر. تنطلق الدّراسة من فرضيّة أنّ المعنى ليس جاهزًا أو موروثًا، بل يُصاغ داخل النّص من خلال تفاعلات دقيقة بين العناصر اللغويّة والبنائيّة.
يسعى البحث إلى تحليل البنية الداخليّة للنص الشعري، من خلال أدوات مثل التكرار، التقابل، الإيقاع، الانزياح، والتوازي، بوصفها أنساقًا تولّد الدلالة. على سبيل المثال، في قول الشاعر:
سلامٌ من صَبا بَرَدى أرقُّ
وَدَمعٌ لا يُكَفكفُ يا دمشقُ
فإنّ تكرار الأصوات الرّقيقة كـ”س”، و”ص”، و”ر” في السطر الأول يُسهم في تشكيل جوّ شعري يُعبّر عن الحنين، ويصبح الصوت نفسه جزءًا من البنية الدالّة، لا مجرد وسيلة نقل للمحتوى.
هدف آخر من البحث هو استكشاف كيف تُغيّر البنيوية دور القارئ، فلا يعود القارئ مجرّد مفسّر أو مستقبِل، بل يُصبح مشاركًا فعليًّا في إنتاج المعنى، من خلال قراءته النّشطة للبنية. فعندما يقرأ القارئ قصيدة تُبنى على مفارقة لغويّة أو تفكيك في البناء النحوي، فإنّ فهمه للقصيدة يعتمد على اكتشاف العلاقات المتوتّرة بين الألفاظ، وليس على ما يُفترض أن يقوله الشاعر.
كما يهدف البحث إلى اختبار فعاليّة المنهج البنيوي في التّعامل مع نماذج مختلفة من الشّعر العربي، سواء الكلاسيكي أو الحديث، من أجل كشف البنية العميقة التي تُحرّك النص. ففي قصيدة مثل “أنشودة المطر” لبدر شاكر السياب، لا يكفي تتبّع المعاني الظاهرة، بل ينبغي تتبّع التراكيب المتكرّرة والصور المتداخلة، لفهم كيف يُنتج النص دلالاته من خلال بنية لغويّة مشحونة بالتوتّر الرمزي.
وأخيرًا، يهدف البحث إلى تقديم نموذج قرائي نقدي يُعيد الاعتبار للبنية بوصفها المركز الحقيقي الذي تتحقّق فيه القصيدة، ويقترح مسارًا جديدًا لفهم الشعر العربي بعيدًا من التلقّي التقليدي الذي يربط المعنى بالمرجع فقط.
ثانيًا: أهمّية البحث
تكمُن أهمّية هذا البحث في كونه يُعيد توجيه النّظر في النّص الشّعري العربي، من خلال التركيز على البنية الداخليّة بوصفها المصدر الحقيقي لإنتاج المعنى، بدلًا من الاتّكاء المستمر على المؤثّرات الخارجيّة كالظروف التاريخيّة أو الأبعاد السيكولوجيّة للشاعر. في زمنٍ يشهد تنامي الغموض والتّجريب في الشّعر الحديث، وعودة الاهتمام بالمناهج الشّكلانيّة، تبرز البنيويّة كمنهج قادر على تحليل النصوص بصرامة علميّة، دون الوقوع في الانطباع أو الذاتية.
إنّ هذا البحث يُسهم في تطوير القراءة النقديّة للنصوص من خلال تفعيل دور القارئ في تفكيك بنية القصيدة، وليس فقط استهلاك معناها الظاهري. على سبيل المثال، عندما نقرأ قول المتنبّي:
إذا غامرتَ في شرفٍ مرومِ
فلا تقنعْ بما دونَ النجومِ
لا تكمُن قيمة البيت في معناه المباشر فقط، بل في التوازي الإيقاعيّ، والتكرار التركيبيّ، والتقابل الدّلالي بين “غامرتَ” و”تقنعْ”، وبين “المروم” و”النجوم”. هذه العلاقات البنيويّة تمنح النص قوّته التأثيريّة، وتُسهم في بناء المعنى على مستوى أعمق من التفسير المباشر. في الشّعر الحديث، نجد قصائد محمود درويش مثالًا حيًّا على حضور البنية المركّبة، كما في قوله:
ونحن نحبّ الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلًا
ونرقص بين شهيدين نرفع راية زيتونة
لا يمكن فهم المعنى من دون ملاحظة البناء التكراري “نحن نحبّ”، و”نرقص”، و”نرفع”، الذي يخلق إيقاعًا داخليًا، يربط بين حبّ الحياة وطقوس الموت والنضال، ما يُنتج دلالة مركّبة لا تُدرك من الخارج، بل من داخل النص.
تكمن الأهمّية أيضًا في أنّ هذا البحث يُعيد الاعتبار للبنية بوصفها “الفاعل الحقيقي” في تشكيل المعنى، ويكشف كيف أنّ اللغة ليست مجرّد أداة للتوصيل، بل نظامًا رمزيًا يُنتج الدلالة عبر تراكيب معقّدة. وهذا ما نراه في قصيدة “الكوليرا” لنازك الملائكة التي كسرت نظام الشّطرين، واعتمدت على التكرار البنيوي للجمل القصيرة:
الصوتُ صوتُ إنذارِ
الصوتُ صوتُ إنذارِ
هنا، البنية الصوتيّة والتكرار يخلقان جوًا من الذعر والتوتّر لا يمكن التّعبير عنه بنفس القوّة عبر الشرح أو التحليل الخارجي.
تُسهم هذه المقاربة البنيويّة كذلك في تطوير مناهج تدريس الشّعر، وتحرير القارئ من الاعتماد المطلق على شروح الموروث، ودفعه لاكتشاف القوانين التي تحكم النّص من داخله. كما تُعزّز هذه القراءة استقلاليّة النصّ الشعري، وتجعل من القصيدة وحدة مكتفية بذاتها، قابلة للتحليل العلمي، ومتعدّدة الطبقات الدّلاليّة.
ومن هنا، فإنّ هذا البحث لا يهدف فقط إلى قراءة القصيدة، بل إلى إعادة الاعتبار لمنهج فكّ البنية، وإلى تدريب القارئ العربي على تفكيك الشيفرة الشعرية انطلاقًا من النصّ لا من خارجه
ثالثًا: الفرضيّات
ينطلق هذا البحث من فرضيّة أساسيّة مفادها أنّ القصيدة العربيّة تُنتج معناها من داخلها لا من خارجها، أيّ أنّ البنية الداخليّة للنص هي المسؤولة عن تشكيل الدلالة وتوجيه التأويل، وليس السياق التّاريخي أو الشّخصي أو النّفسي للشّاعر. بناءً على هذا التصوّر، يُفترض أنّ المنهج البنيوي يُمثّل أداة فعّالة لتحليل الشّعر العربي الكلاسيكي والمعاصر على حد سواء، بفضل تركيزه على العلاقة بين العناصر النّصيّة وتفاعلاتها.
الفرضيّة الرئيسة: البنية الداخليّة للقصيدة هي مصدر إنتاج المعنى، وتُعدّ العلاقات بين الألفاظ، والصور، والإيقاع، والتركيب، عناصر حاسمة في فهم النص.
يتجلّى ذلك، مثلًا، في قصيدة إيليا أبو ماضي:
كن جَميلًا ترَ الوجودَ جميلًا
إنّ المعنى البسيط لا يُختزل فقط في العبارة الأخلاقيّة، بل في التكرار الصوتي بين “جميلًا” و”جميلًا”، وفي التوازي البنيوي بين “كن” و”ترَ”، ما يُضفي على النصّ تناغمًا داخليًّا يُعزّز وقعه.
الفرضيّات الفرعيّة
١. البنية اللغويّة في القصيدة تُنتج شبكة من العلاقات تؤسّس المعنى، بصرف النّظر عن المقصد أو السياق الخارجي. نأخذ مثالًا من قصيدة “غريب على الخليج” لبدر شاكر السيّاب:
الليلُ، والميناء، والموجُ، والسفائنُ، والرّفاقُ…
تراكم الصّور، وتكرار العطف، واستخدام ألفاظ تنتمي لحقل بحريّ، يخلق وحدة بنيويّة من خلالها يُبنى الإحساس بالغربة. لا حاجة لتأويل خارجي لفهم التوتّر، فالبنية تفصح عن المعنى.
٢. المعنى ليس جوهرًا ثابتًا بل نتيجة ديناميكيّة تتولّد من تفاعل القارئ مع البنية النّصيّة.
في قصيدة “قالت الأرض” لمحمود درويش:
أنا الأرض، والأرض أنت
البنية القائمة على التّبادل بين المتكلّم والمخاطَب، تنزع الهويّة الفرديّة وتُنتج دلالة سياسيّة وشعريّة تتجاوز المباشر. المعنى لا يُلقى، بل يُستخرج من البناء التركيبي والتبادلي.
٣. المنهج البنيوي يُتيح قراءة محايدة تتجنّب الإسقاطات الشّخصيّة أو التاريخيّة، وتفتح المجال أمام فهمٍ متعدّد المستويات.
وهذا ما نراه في قصيدة “القصيدة الدّمشقيّة” لنزار قبّاني، إذ تتقاطع الألفاظ السياسيّة والرومانسيّة داخل بنية لغويّة واحدة، ما يجعل قراءة النصّ مفتوحة على احتمالات متعدّدة، من دون أن يُلزِم القارئ بمعنى واحد مفروض من الخارج. تُشكّل هذه الفرضيّات الأساس النظري الذي يقوم عليه البحث، وتسعى إلى اختبار صحّتها من خلال تحليل نماذج شعريّة مختلفة تُظهر كيف تعمل البنية بوصفها المحرّك الأساسي للمعنى، وكيف يُمكن للقارئ أن يفكّ شيفرة النص دون الاعتماد على أي مرجعيّات خارجة عن القصيدة ذاتها.
رابعًا: الدّراسات السابقة
على الرغم من انتشار الدّراسات النقديّة التي تعنى بالنّصوص الشعريّة، إلّا أنّ البحث في المنهج البنيوي قد أسهم بشكل كبير في إحداث تحوّل جذري في طريقة قراءة النّصوص الأدبيّة العربيّة وتحليلها، لا سيّما القصائد. وبالنظر إلى أهميّة البنية الداخليّة في كشف المعنى، نجد أنّ العديد من الدّراسات قد اهتمّت بإعادة تعريف دور البنية في تحديد دلالة النّصوص الأدبيّة، خاصّة الشّعرية منها. في هذا السّياق، نستعرض ثلاث دراسات محوريّة في المجال البنيوي، مع تحليل دقيق لدور كل منها في إثراء هذا المجال.
١. صلاح فضل – “أساليب السّرد في الرواية العربيّة” (1984): على الرغم من أنّ دراسة صلاح فضل تركز على السّرد الروائي، فإنّها تعدُّ مرجعًا مهمًا في كيفية تطبيق المنهج البنيوي على النّصوص الأدبيّة بشكل عام. يُركّز فضل في عمله على البنية السرديّة داخل الرواية، فيعرض كيف أنّ العلاقة بين الأحداث والشخصيّات تُحدَّد من خلال النّظام الدّاخلي للنص. تُعدّ هذه الدّراسة مهمّة لأنّ فضل يقدم لنا أدوات يمكن تطبيقها على الشّعر أيضًا، إذ يقوم بتفكيك البنية السّرديّة في الرواية بشكل يسمح لنا بالتركيز على النّظام الداخلي للنّص، وتفاعل العناصر المختلفة داخله.
إحدى النقاط التي يبرزها فضل هي أنّ كلّ نص أدبي يعتمد على بنية خاصّة به لا يمكن فهمه إلّا من خلال التّفاعل بين هذه البنية. يمكننا تطبيق هذا المفهوم على الشّعر العربي بشكل فعّال، كما نرى في قصيدة محمود درويش “على هذه الأرض ما يستحق الحياة” التي تكشف لنا بنية النّص الدّاخليّة من خلال تكرار بعض الألفاظ واستخدام الصور المتتالية. التكرار ليس مجرّد أداة لغويّة، بل جزء من بنية النّص الذي يُنتِج معناً جديدًا داخل القصيدة.
– أهميّة الدّراسة: هذه الدّراسة تضع الأساس لتحليل البنية داخل النص، وتُركّز على تفكيك النصوص الأدبيّة من خلال فهم العلاقات بين مكوناتها المختلفة. وهذه الرؤية تفتح المجال لاستخدام المنهج البنيوي في تحليل الشعر العربي بشكل يعمّق الفهم البُعد اللغوي والجمالي للنصوص.
مثال تطبيقي: في قصيدة محمود درويش “على هذه الأرض ما يستحق الحياة”، تبرز العلاقة بين الكلمات المتكرّرة مثل “الحياة” و”الأرض”، وهذه التكرارات تُنظم البنية اللغويّة التي تُسهم في بناء المعنى النهائي للنص.
٢. كمال أبو ديب – “في البنية الإيقاعية للشعر العربي” (1974): يُعدّ كمال أبو ديب من أبرز النقّاد الذين طوروا مفاهيم نقديّة تعتمد على الإيقاع في فهم الشعر العربي. في هذا الكتاب، يعرض أبو ديب كيف أنّ البنية الإيقاعيّة للشعر لا تقتصر على الشّكل الموسيقي فقط، بل هي جزء أساسي من البنية المعرفيّة للنص، إذ تُساهم في إنتاج المعنى داخل القصيدة. أبو ديب يوضّح كيف أن الإيقاع يرتبط بالبنية اللغويّة بشكل لا يُفصل، ما يخلق شبكة من التّفاعلات بين الصوت والمعنى.
من خلال كتابه، يقدّم أبو ديب تحليلًا معمّقًا لكيفيّة تأثير الإيقاع في بنية القصيدة العربيّة، ويظهر كيف أنّ الإيقاع يشكّل جزءًا من إنتاج المعنى، ويُعدّ وسيلة لتوليد الدلالّة داخل النّص. هذه الرؤية لها تأثير كبير في الشعر العربي الحديث، فيُستخدم الإيقاع كوسيلة لتعزيز المعنى بشكل متكامل مع الشكل واللغة.
– أهميّة الدّراسة: دراسة أبو ديب تعدُّ من الدّراسات الأولى التي تُركّز على العلاقة العضويّة بين الإيقاع والمعنى في الشعر العربي، وتُعدّ مرجعًا أساسيًا لفهم الإيقاع في القصيدة بعيدًا من كونه مجرّد تنسيق موسيقي.
مثال تطبيقي: في قصيدة بدر شاكر السّياب “أنشودة المطر”، يظهر تأثير الإيقاع في توليد معنى مأساوي وحزين، فيُستخدم الإيقاع بشكل متقن لتعزيز صورة الموت والفقدان، وهو ما يعكس علاقة بنيويّة بين الشكل والإحساس العام في النص.
٣. تزفيتان تودوروف – “مدخل إلى الأدب البنيوي” (ترجمة منذر عياشي): تزفيتان تودوروف هو واحد من أبرز النقّاد في مجال النقد البنيوي، وقد قدّم في هذا الكتاب فهمًا نظريًّا للأدب بوصفه نظامًا من العلامات والعلاقات المترابطة. في هذا السّياق، يوضّح تودوروف كيف أنّ النصوص الأدبية لا تُفهم من خلال السّياقات الخارجيّة، بل من خلال فحص البنية الداخليّة للنص ذاته. يقدّم تودوروف مفهوم “الرمز“ وكيفيّة استخدامه داخل النصوص الأدبيّة، ما يُعدُّ أداة أساسيّة لتحليل الشّعر على المستوى البنيوي. هذه الرؤية تفتح المجال لفهم النّص الشّعري على أنّه نظام من الرّموز التي تُنتج المعنى داخل النّص من خلال علاقات بنائيّة معقدّة.
أهميّة الدّراسة: توفّر هذه الدّراسة إطارًا معرفيًّا متكاملًا لفهم البنية النصيّة بعيدًا من تفسيرات خارجيّة مثل التّأويلات السياسيّة أو الاجتماعيّة. يعتمد تودوروف على مفاهيم الرمزيّة والبنية اللغويّة لفهم الشعر، ما يجعله مرجعًا أساسيًّا في تحليل النصوص البنيويّة.
مثال تطبيقي: في قصيدة نازك الملائكة “الكوليرا”، يُمكن تحليل تكرار الرموز، مثل رمز “الموت” و”الخراب”، التي تُعيد إنتاج المعنى عبر فحص العلاقات البنيويّة بين الصور والرموز.
خامسًا: المنهج المعتمد
اعتمد هذا البحث المنهج البنيوي كإطار تحليلي رئيس لفحص القصائد الشّعريّة العربيّة. المنهج البنيوي يعدُّ النّص الأدبي كيانًا لغويًّا مستقلًا يحتوي على بنيته الدّاخليّة التي تُنتج المعنى من خلال تفاعلات العناصر المختلفة مثل اللغة، والإيقاع، والتّركيب اللغوي، والصّورة الشّعريّة. هذا المنهج يُركّز على التحليل الدّاخلي للنّص، إذ يُعدُّ المعنى نتيجة لتركيب النص ذاته، وليس منتجًا خارجيًا ناتجًا عن التّفسير المعياري أو السّياقات التّاريخيّة أو الشّخصيّة.
1.تعريف المنهج البنيوي: المنهج البنيوي هو منهج نقدي أدبي يقوم بتحليل النّصوص الأدبيّة على أساس بنيتها الداخليّة بعيدًا من السّياقات الثقافيّة أو التّاريخيّة المحيطة بها. يعتمد المنهج على فكرة أنّ المعنى لا يُستمد من الخارج (مثل حياة الشّاعر أو الظروف التاريخيّة)، بل يُنتَج من خلال العلاقات بين العناصر اللغويّة داخل النّص مثل الكلمات، والجمل، والأصوات، والصور. ويستند التّحليل إلى الفكرة القائلة أنّ النص الأدبي يجب أن يُفهم كوحدة متكاملة لها قوانينها الخاصّة التي تُحدد كيف ينتج المعنى داخل النص.
- أهداف المنهج البنيوي في هذا البحث: يهدف هذا البحث إلى تطبيق المنهج البنيوي على القصيدة العربيّة لدراسة العناصر الداخليّة التي تتحكّم في إنتاج المعنى. النقاط الأساسيّة التي سيتمّ التركيز عليها هي:
- البنية اللغويّة: ستُدرس كيفيّة تشكيل الكلمات والجمل وتفاعلها مع بعضها البعض، لتوليد المعنى داخل النص.
- الإيقاع: سيُفحَص الدور الذي يؤديه الإيقاع في تشكيل المعنى، إذ يُعدُّ الإيقاع جزءًا لا يتجزّأ من بنية النّص التي تُسهم في خلق التوتر الدّلالي.
- التكرار والتقابل: ستُفحص كيفيّة استخدام التّكرار والتّقابل بين الصور الشعريّة والمعاني، وذلك كأداة لتنظيم النص وإنتاج المعنى.
3 .الأدوات المستخدمة في المنهج البنيوي: بناءً على هذا المنهج، ستُستخدَم عدة أدوات أساسيّة لتحليل النّصوص الشعريّة:
- التّحليل اللغوي: يشمل دراسة تركيب الجمل، والأنماط البلاغيّة مثل الاستعارة، والتكرار، والانزياح، وكيفيّة تفاعل هذه الأنماط لتوليد المعنى داخل النص.
- التّحليل الإيقاعي: يتضمّن دراسة دور الإيقاع الداخلي في النص وكيفيّة ارتباطه بتكوين المعنى العاطفي والموضوعي في القصيدة.
- التّحليل البنائي: من خلال فحص تركيب النص، تُحلَّل كيفيّة تقسيم القصيدة إلى وحدات معنويّة صغيرة (أبيات أو مقاطع) وكيف تتفاعل هذه الوحدات لتكوين المعنى الكلي للنص.
4.تطبيق المنهج البنيوي على النّصوص الشعريّة: لتوضيح كيفيّة تطبيق هذا المنهج، ستُختَار نماذج شعريّة معروفة مثل قصائد محمود درويش، بدر شاكر السياب، ونازك الملائكة. في حالة قصيدة “على هذه الأرض ما يستحقّ الحياة“ لمحمود درويش، سيُفحَص كيف يُنتَج المعنى من خلال التكرار الصوتي، والألفاظ المتقابلة، واستخدام الصور المترابطة التي تخلق بنية شعريّة تسهم في بناء المعنى الثوري والإنساني في القصيدة.
في قصيدة “أنشودة المطر“ لبدر شاكر السياب، سيُركَّز على الإيقاع الداخلي الذي يُسهم في التّعبير عن معاناة الشّاعر الحزينة، وكيف يتناغم الإيقاع مع الصور، والمفردات التي تعكس الطابع الكئيب والخراب.
. 5أهميّة المنهج البنيوي في دراسة الشّعر العربي: يسهم المنهج البنيوي في تحليل النّصوص الشعريّة بطريقة علميّة دقيقة، إذ يسمح بالتّركيز على التّفاعل الداخلي بين مكوّنات النص، ما يعزز من فهم المعنى بعيدًا من السّياقات الخارجيّة التي قد تؤثّر في التأويل. ويساعد هذا المنهج في تطوير أدوات القراءة النقديّة التي تجعل القارئ قادرًا على فكّ شيفرة النّصوص الشّعريّة، وفهم العلاقات الرمزيّة واللغويّة التي تُنتِج المعنى.
يتناسب هذا المنهج تمامًا مع الشّعر العربي الحديث الذي يتسم بتعقيد اللغة والرمزيّة الكثيفة، وهو ما يجعله ملائمًا بشكل خاص لفهم النّصوص التي تعتمد على الرمزيّة والتجريد، مثل قصائد محمود درويش وبدر شاكر السياب.
خلاصة المبحث الأول: اعتماد المنهج البنيوي كأداة رئيسة لفحص القصائد الشعريّة العربيّة يُعدُّ خطوة محوريّة نحو فهم المعنى من خلال النّص نفسه. هذا المنهج يقدّم أدوات تحليليّة قويّة لتفكيك النّصوص، ما يتيح للقارئ فهم العلاقات الرّمزيّة، الصّوتيّة، واللغويّة التي تُنتِج المعنى داخل النّصوص الشعريّة من دون اللجوء إلى السّياقات الخارجيّة.Culler, J. :1975:111))
المبحث الأول: البنية الدّاخليّة للقصيدة: آليات البنيويّة في تشكيل المعنى الشعري
1.1. مقدّمة في مفهوم البنية الشّعرية: في مجال النقد الأدبي، يُعدُّ مفهوم البنية أحد المبادئ الأساسيّة التي ساهمت في تشكيل المنهج البنيوي. هذا المنهج النقدي يعتمد على تحليل النّص الأدبي كوحدة متكاملة ذات علاقات مترابطة بين مكوّناتها الداخليّة، فلا يُفهم المعنى إلّا من خلال تفاعل هذه المكوّنات داخل النّص. في الشّعر، لا يُنظر إلى الكلمات أو الجمل بشكل منفصل عن بعضها البعض، بل كعناصر متشابكة تعمل معًا لخلق دلالة واحدة تكون في غاية التعقيد.
يعتقد النّقد البنيوي أنّ المعنى لا يتشكل من خلال السّياق الخارجي أو الخلفيّة التاريخيّة للنص، بل ينبع من داخل النّص ذاته. يُعدُّ النص الأدبي بمثابة نظام لغوي مغلق، إذ لا تكون هناك حاجة لتفسير خارجي. على سبيل المثال، عند تحليل قصيدة باستخدام المنهج البنيوي، نركّز على كيفيّة ترتيب الكلمات، تراكيب الجمل، واستخدام الأسلوب البلاغي. هذا المنهج يساعدنا على فهم الأنماط الدّلاليّة التي تتحكّم في بناء المعنى داخل النص، ما يعزّز من دقّة التحليل ويفتح آفاقًا متعددة لفهم الشّعر بعيدًا من التّفسيرات التقليديّة التي تركز على التّفسير الشّخصي أو التّاريخي.
1.2. العلاقة بين الألفاظ والصّور الشعريّة في القصيدة: في المنهج البنيوي، لا تُعدُّ الكلمات مجرد وسيلة لنقل المعنى، بل هي عنصر أساسي في بناء المعنى داخل النّص الشعري. الكلمات تعمل في علاقة متشابكة مع بعضها البعض، ما يخلق صورًا شعريّة تتحكّم في فهم المعنى وتوجهه. تُستخدم الصّور الشّعريّة داخل النّصوص الشّعرية لتكوين عالم رمزي يتفاعل فيه القارئ مع المعاني بطريقة حسيّة وعاطفيّة. وبالتالي، لا تقتصر وظيفة الكلمات على نقل الأفكار بشكل مباشر، بل تُسهم أيضًا في توليد صور ذهنيّة تُحرك مشاعر القارئ وتُحمل معانٍ معقّدة.
نرى على سبيل المثال، في قصيدة “في القدس“ لمحمود درويش، أنّ الكلمات مثل “الأرض” و”القدس“ تتحوّل إلى رموز تعكس الهويّة والكرامة الفلسطينيّة. العلاقة بين الكلمات في هذه القصيدة لا تقتصر على التّعبير اللغوي السطحي ، بل تُربط الكلمات لتكوين شبكة من الصور الرمزيّة التي تحمل معاني عميقة تتجاوز المعنى الظاهر.
في هذا الإطار، تسهم الصّور الشعريّة في تفاعل الكلمات بشكل يُنتج معاني رمزيّة، وهذه الصور تُعدّ جزءًا من البنية الداخليّة للقصيدة، إذ تتكامل الألفاظ والصور لتشكيل الدّلالة النّهائيّة. إذًا، الكلمات في القصيدة ليست فقط وسيلة للتّواصل اللغوي، بل هي أداة بنيويّة تُسهم في توليد المعاني العميقة التي يبنيها الشّاعر داخل النص.
1.3 . التّكرار والبنية اللغويّة في القصيدة: يُعد التكرار أداة أساسية في البنية الدّاخليّة للقصيدة، إذ يُسهم في تعزيز المعنى وخلق توازن لغوي في النّص. في الشّعر البنيوي، التكرار لا يُستخدم فقط لأغراض إيقاعيّة، بل هو أداة مهمّة لإعادة تشكيل الصّور والمعاني داخل النص. يسهم التكرار في تثبيت المعنى داخل النص ويُعدّ من آليّات بناء الهويّة الشعريّة.
في قصيدة “أنشودة المطر“ لبدر شاكر السّياب، نلاحظ أنّ التكرار الصوتي للفظ “المطر“ يُساعد في إنشاء إيقاع داخلي يعزّز من صورة الحزن ويعمق المعنى العاطفي للقصيدة. التكرار هنا ليس مجرد تكرار صوتي، بل هو جزء من البنية الدّلاليّة للنّص، إذ يعزز من المعاني الرمزيّة المتعلقة بالحزن والوجع.
يُسهم التكرا أيضًا في إبراز المعنى وتثبيته داخل النّص، إذ يُكثّف التّفاعل بين الكلمات والصّور لخلق تجربة متكاملة للقارئ. على سبيل المثال، تكرار كلمة “المطر“ في القصيدة يجعل من هذه الصّورة رمزًا أساسيًا يرتبط بالكآبة والموت. كما أنّ التكرار يُساعد في ترسيخ المفاهيم داخل النص، ما يجعل القارئ يتفاعل مع كل جزء من القصيدة بطريقة أعمق.
1.4 . التّفاعل بين الجمل والتّراكيب في إنتاج المعنى: لا يُنظر إلى الجمل داخل القصيدة على أنّها وحدات منفصلة، بل يُتَّعامل معها على أنّها عنصر بنائي يسهم في خلق المعنى الكلي للنص. في المنهج البنيوي، التفاعل بين الجمل والتراكيب ليس فقط عمليّة نحوية، بل هو عمليّة دلاليّة أيضًا. يسهم التفاعل بين الجمل في تحديد التّرتيب المنطقي للنص، كما أنّه يعمل على توجيه المعنى ضمن النّص الشّعري.
على سبيل المثال، في قصيدة “الموت“ لأدونيس، تُستخدَم التّراكيب النّحويّة بشكل دقيق لتوجيه القارئ في عمليّة التأمّل، قتتداخل الجمل لتُظهِر التّغيرات الفكريّة التي تطرأ على الشّاعر أثناء تأمّلاته في الموت والحياة. التّفاعل بين الجمل هنا يسهم في خلق التناغم بين الفكرة والصّور داخل القصيدة.
1.5.تطبيقات بنيويّة على بعض القصائد العربيّة: لتوضيح تأثير المنهج البنيوي في دراسة القصيدة العربيّة، يمكن تطبيقه على بعض القصائد المشهورة التي تحتوي على بنية لغويّة معقّدة. على سبيل المثال، في قصيدة “إرادة الحياة“ لأبي القاسم الشابي، يُمكن فحص البنية الإيقاعيّة وكيف تسهم في تعزيز المعنى الفلسفي حول حريّة الشّعوب. في قصيدة “في القدس“ لمحمود درويش، يمكننا دراسة التّفاعل بين الألفاظ والصّور الشعريّة التي تعكس الهويّة الفلسطينيّة والنّضال المستمر.(فضل ،1991 :90 )
خلاصة المبحث الأول: البنية الداخليّة للقصيدة الشعريّة هي الأساس الذي يُنتج المعنى. من خلال فحص العلاقات بين الكلمات، الصّور الشّعريّة، التكرار، والتراكيب النحويّة، نتمكن من فهم كيف تسهم كل هذه العناصر في تشكيل المعنى. المنهج البنيوي يُساعد في تفسير الأنماط اللغويّة ويقدم نظامًا محكمًا لتحليل المعاني العميقة التي تنشأ من تفاعل النصوص الأدبيّة.
المبحث الثاني: الإيقاع واللغة: دراسة بنيويّة في تفاعل العناصر الصوتيّة في القصيدة العربيّة
2.1.مفهوم الإيقاع في الشّعر العربي: الإيقاع هو أحد العناصر الأساسيّة التي تميّز الشّعر العربي من النثر، إذ يؤدي دورًا حيويًّا في بنية القصيدة، ويُعدّ عنصرًا جوهريًا في تعريف القصيدة نفسها. في الشّعر، الإيقاع ليس مجرد تكرار موسيقي أو وزن ثابت، بل يُعدُّ بنية صوتيّة تتفاعل مع اللغة والصّور الشعريّة لتشكيل المعنى وتوجيه المشاعر. الإيقاع في الشّعر العربي يرتبط ارتباطًا وثيقًا بـ الوزن الشعري والقافية، لكن لا تقتصر وظيفته على كونها جزءًا من البنية الشكليّة للقصيدة.
نُركّز من خلال المنهج البنيوي، على أنّ الإيقاع في القصيدة لا يقتصر على توزيع الأصوات بطريقة موسيقيّة فقط، بل يُعدُّ أداة بنيوية تساهم في بناء المعنى الشّعري. فالإيقاع يعمل من خلال تكرار الأصوات والكلمات لخلق تجربة شعوريّة عند القارئ، إذ يصبح الإيقاع جزءًا من عملية إنتاج المعنى الذي لا يمكن فصله عن الأبعاد العاطفيّة للقصيدة.
على سبيل المثال، في قصيدة “في القدس“ لمحمود درويش، يُستخدم الإيقاع السّريع لتسريع وتيرة الأحداث في البداية، ما يعكس حالة التّمرد والمقاومة، بينما يُتبَع ذلك بتحوّلات في الإيقاع البطيء التي تتماشى مع التأمّلات الحزينة والخيبات السياسيّة التي يواجهها الشّعب الفلسطيني.
2.2.دور الإيقاع في بناء المعنى الشّعري:لا يُعدُّ الإيقاع في الشعر البنيوي مجرد عنصر جمالي، بل هو أداة تفاعليّة تربط بين الشّكل والمحتوى. من خلال الإيقاع الموسيقي، يُمكن للمُتلقّي أن يتفاعل مع النّص عاطفيًّا وفكريًّا في وقت واحد. الشّاعر يعتمد على الأنماط الإيقاعيّة لإيصال الرسائل العاطفية العميقة، ويُساعد التّغيير في الإيقاع على إبراز التوتّرات الدّاخليّة بين الأفكار والمشاعر.
في قصيدة “المطر“ لبدر شاكر السياب، يُعد الإيقاع العنصر الأساسي في خلق الجوّ العام للقصيدة. يساهم التكرار الصوتي للكلمات مثل “المطر” و”الريح” في خلق إيقاع يشبه سقوط المطر، ما يضفي على القصيدة طابعًا حسيًّا. يتفاعل الإيقاع الخارجي مع الإيقاع الدّاخلي في القصيدة لتوليد إحساس بالحركة المستمرّة أو التساقط، مما يُغني المعنى العاطفي المُراد نقلُه.
من ناحية أخرى، يعزّز التكرار الصوتي في القصائد مثل قصيدة “في الحب“ لأدونيس من قدرة القارئ على تكرار التجربة العاطفيّة داخل النص، ويزيد من التركيز على الفكرة العاطفيّة الأساسيّة، وهي فكرة التمرّد على الحب.
2.3 .التكرار الصوتي وتأثيره على بناء البنية النّصيّة: يُعد التكرار الصوتي عنصرًا أساسيًا في البنية الصوتية للقصيدة. وهو ليس مجرد تكرار لغوي، بل هو آليّة بنيويّة تسهم في تعميق المعنى وتوسيع نطاقه داخل النّص. يعمل التكرار الصوتي على ربط الأصوات والكلمات مع بعضها، ويُعزّز من التأثير الإيقاعي، مما يُسهم في ترسيخ المفاهيم في ذهن القارئ.
على سبيل المثال، في قصيدة “المطر“ لبدر شاكر السياب، التكرار الصّوتي للكلمات مثل “المطر” و”الحزن” يعزّز من الصّورة الشّعريّة المتكررة التي تربط المطر بـ المشاعر الحزينّة. هنا، لا يُستخدم التكرار الصوتي فقط كأداة لخلق الإيقاع الموسيقي، بل أيضًا لتجسيد الحالة العاطفيّة التي يعيشها الشّاعر في اللحظة.
عند فحص التكرار الصوتي في القصيدة، نجد أنّ التكرار لا يقتصر فقط على الكلمات بل يشمل الصوتيّات أيضًا. مثلًا، التكرار الصوتي لحروف معيّنة يُسهم في خلق إيقاع داخلي يثري الشّكل الصوتي للقصيدة ويُسهم في إبراز المعاني العاطفيّة. (تودوروف،2004 :45 )
2.4 . البنية الصوتيّة: القوافي والطّباق والتوازن الموسيقي
القافية في الشّعر العربي ليست فقط مجرد عنصر موسيقي، بل هي أداة بنيويّة تؤثر بشكل كبير في بناء الترابط بين أجزاء القصيدة. من خلال القوافي، يربط الأبيات ببعضها البعض بطريقة منظّمة، ما يسمح بخلق إيقاع موسيقي منتظم يعزز من تأثير المعنى.
في قصيدة “الأندلس“ لأبي البقاء الرندي، نلاحظ كيف أنّ القوافي المتكررة تعمل على بناء إيقاع موسيقي متناغم يُعبّر عن الحزن والفقد، ويُساعد في خلق حالة شعوريّة تَمتزج فيها الموسيقى بالكلمات. القافية هنا ليست مجرد مراعاة موسيقيّة، بل جزء أساسي من البنية الشعريّة التي تعمل على تعميق المعنى.
من خلال هذه التّراكيب الصوتيّة ، يعمل الشّاعر على تعزيز التّجربة الشّعوريّة للقارئ ، إذ إنّ القوافي تُساعد في خلق ترابط شعوري بين الأفكار العاطفيّة والإيقاع الموسيقي ، وهذا الترابط يُسهم في تفاعل القارئ مع النص بشكل أكبر ، ما يزيد من عمق الفهم العاطفي للنص .
2.5 . دراسة تطبيقيّة: الإيقاع في قصائد مختارة
لتطبيق ما نُوقشَ في هذا المبحث، سأقوم بتحليل قصائد مختارة باستخدام المنهج البنيوي. مثلًا، في قصيدة “إرادة الحياة“ لأبي القاسم الشّابي، نلاحظ أنّ الإيقاع السّريع في بداية القصيدة يُحاكي التمرّد والحريّة، بينما يتباطأ الإيقاع في الجزء الثاني ليمثّل الآمال المحطمة التفاعل بين الإيقاع السّريع والبطيء يُظهر تأثير. الإيقاع في بناء المعنى الشعري في القصيدة(فضل ، 1991 :90 )
خلاصة المبحث الثاني: في هذا المبحث، تناولتُ الإيقاع كعنصر حيوي في بناء البنية الدّاخليّة للقصيدة. من خلال التكرار الصوتي، القوافي، والتوازن الموسيقي، يعزز الإيقاع من إنتاج المعنى الشعري ويُساهم في ترسيخ التجربة العاطفيّة للقارئ. كل عنصر صوتي في القصيدة لا يُعدُّ مجرد تفصيل موسيقي، بل هو جزء من البناء البنيوي الذي يُسهم في توجيه المعنى في النص.
الخاتمة: الدّراسة تتناول المنهج البنيوي في تحليل الشّعر العربي، مشيرة إلى أنّ المعنى لا يُستمدّ من السّياقات الخارجيّة مثل حياة الشّاعر أو الظروف التّاريخيّة، بل يُنتج من البنية الدّاخليّة للنص. تُركّز على الأدوات البنيويّة مثل التكرار، الإيقاع، الصّور الشّعريّة، والانزياح، التي تُساهم في خلق دلالات معقّدة داخل النّص الشعري.
الهدف من البحث هو تحليل القصيدة العربيّة عبر تفاعلات العناصر النصيّة، وتفسير كيفيّة إنتاج المعنى من داخل النّص نفسه. كما يسعى لاختبار المنهج البنيوي في الشعر الكلاسيكي والحديث، ويؤكّد أنّ النّصوص الشّعرية تُفهم بشكل أعمق من خلال دراسة بنيتها الدًاخليّة بدلًا من الاعتماد على المعاني الجاهزة.
في النهاية، يبرز البحث أهميّة المنهج البنيوي في قراءة الشعر بشكل علمي، بعيدًا من التفسير التقليدي، ويُسم في تعزيز قدرة القارئ على فهم المعاني العميقة للشعر العربي.
المصادر والمراجع
- أبو ديب، كمال. (1974). في البنية الإيقاعية للشعر العربي. بيروت: دار الطليعة.
رابط التحميل: من موقع أرشيف - تودوروف، تزفيتان. (2004). مدخل إلى الأدب البنيوي (منذر عياشي، ترجمه). بيروت: المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر.
رابط التحميل: من مكتبة نور
- فضل، صلاح الدين. (1984). أساليب السّرد في الرواية العربيّة. القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب.
رابط التحميل: من موقع المعرفة - فضل، صلاح الدين (1991). البنية النّصيّة في الشّعر العربي المعاصر: قراءة بنيوية. القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب.
- Culler, J. (1975). Structuralist poetics: Structuralism, linguistics and the study of literature. London: Routledge.
– أستاذ محاضر في الجامعة اللبنانيّة – كليّة الآداب والعلوم الإنسانيّة-بيروت لبنان، مدرّبة ومعدّة لأساتذة التعليم الرسمي الأساسي والثانوي في كليّة [1] التربية
Lecturer at the Lebanese University – Faculty of Arts and Humanities – Beirut, Lebanon, trainer and preparer for primary and secondary public education teachers at the Faculty of Education.Email: