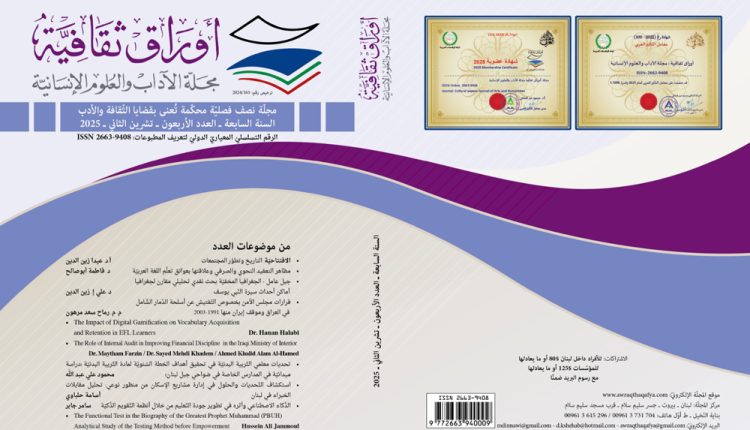عنوان البحث: دراسة مقارنة لشعر الحبسيات في الشعرين العربي والفارسي (من البدايات حتى القرن السابع الهجري)
اسم الكاتب: سيد مجتبی رضوی، د.محبوبة همتيان، د.محسن محمدی فشارکی
تاريخ النشر: 2025/11/14
اسم المجلة: مجلة أوراق ثقافية
عدد المجلة: 40
تحميل البحث بصيغة PDFADOI: https://aif-doi.org/awraq/014006
دراسة مقارنة لشعر الحبسيات في الشعرين العربي والفارسي (من البدايات حتى القرن السابع الهجري)
A Comparative Study of Ḥabsiyyāt Poetry in Arabic and Persian Literature (From the Beginnings to the 7th Century AH)
*سيد مجتبی رضوی Razavi, Seyed Mojtaba
**د.محبوبة همتيان Dr. Mahbouba Hematian
***د.محسن محمدی فشارکی Dr. Mohsenmohammadi fesharaki
* ** ***
تاريخ الإرسال:6-10-2025
تاريخ القبول:18-10-2025
الملخص turnitin:10%
الحبسيات، هي ضرب من الشعر الذي ينظمه الشّاعر في ظلال القيد، ومهاوي السجون، حيث تجسد أوجاع الغربة، ولوعة الفقد، ومرارة الحرمان من الوطن والأحبة، ويفيض فيها لسان الشّاعر بالشّكوى من ظلمة الزنزانة، و وطأة القيد، وسوءمعاملة السجان.
وقد كان أبو فراس الحمداني – صاحب الرّوميات – فارس هذا الميدان، إذ سبق غيره وفتح للآخرين أبواب الإلهام، فغدا أثره واضحًا في الشّعر العربي والفارسي على السّواء. ومن جهة أخرى، يعد مسعود سعد من أوائل الشّعراء الفرس الذين نظموا الحبسية(زنداننامه)، وقد أسس تقاليدها الفنيّة، وظلت أشعاره مرجعا يلهم كل من جاء بعده في باب الحبسيات حتى أيامنا.
يلقي هذا البحث – من منظور مقارن- ضوءه على القصائد الحبسية لشعراء بارزين من تلك الحقبة، ليقف عند القواسم المشتركة في مضامين أشعارهم. وقد خلصت الدراسة إلى أن اللغة والألفاظ، بل والمناخ العام لتلك القصائد، تتبدل بتبدل حال الشّاعر في محبسه، غير أنّ العناصر والموضوعات الكبرى تكاد تكون واحدة.
أما الهيكل الأساس للبحث فيتألف من:
أ ـ مقدمة تمهيديّة في كليّات الدراسة وتاريخ الحبسيّات.
ب ـ تحليل موضوعي وبنيوي لقصائد الحبس عند الشّعراء.
الكلمات المفتاحيّة: المقارنة، الحَبْسيّات، الشعرالعربي والفارسي، من البدايات حتى القرن السّابع.
Abstract:
Ḥabsiyyāt is a poetic genre composed by poets under the shadow of captivity and within the confines of prisons. It embodies the anguish of estrangement, the pain of loss, and the bitterness of deprivation from homeland and loved ones. In such poems, the poet’s voice overflows with lament over the darkness of the cell, the weight of shackles, and the harshness of jailers.
Abū Firās al-Ḥamdānī—the author of the Rūmiyyāt—was a pioneering figure in this field, preceding others and opening the doors of inspiration. His influence became evident in both Arabic and Persian poetry. On the other hand, Masʿūd Saʿd is regarded as one of the earliest Persian poets to compose Ḥabsiyyāt (Zindān-nāmah), establishing its artistic conventions. His works remained a reference point inspiring later poets in the domain of prison poetry up to the present day.
From a comparative perspective, this research sheds light on the Ḥabsiyyāt of prominent poets of that era, highlighting the commonalities in the themes of their poems. The study concludes that the diction, expressions, and even the general atmosphere of these works vary according to the poet’s condition in prison, yet the central motifs and overarching themes remain largely the same.
The structure of the research consists of:
- An introductory overview of the general framework and historical background of prison poetry.
- A thematic and structural analysis of selected prison poems.
Keywords: Comparative study, Ḥabsiyyāt, Arabic and Persian poetry, beginnings to the 7th century AH.

المقدمة:
الحبسيّة،هي القصيدة التي ينظمها الشّاعر وهو في غياهب السّجن، معبّرا فيها عن مأساته ومعاناته،وقد عرّفها اللغوي الفارسي العلامة دهخُدا أنّها:«قصيدة ينظمها الشّاعر في سجنه، وتعد من فنون الشّعر المرتبطة بتجربة الحبس والمعاناة»([1]).
تُعد الحبسيّات في الأدب الفارسي مرتبطة ارتباطا وثيقا باسم مسعود سعد سلمان، الذي يُعد رائدا في توثيق تجربة السّجن شعريا عبر مجموعته “زندان نامه”، التي أصبحت مرجعا أساسيا لهذا اللون الشّعري. وقد أمضى مسعود سعد ما يقارب تسعة عشر عاما في سجون متعددة، أنتج خلالها أشعارا متميزة جعلته علما بارزا في هذا المجال إلى جانب مسعود سعد، برز شعراء آخرون في فن الحبسيات، يأتي في مقدمتهم خاقاني الشيرواني الذي قدم نماذج رفيعة المستوى، بالإضافة إلى مجير الدّين البيلقاني وفلكي الشّرواني الذين عاشوا تجربة السجن وعبروا عنها في أشعارهم، مشكلين معا تيارا أدبيا متميزا في الشعر الفارسي.
اقترنت الحبسية وفي الأدب العربي، باسم أبي فراس الحمداني، أمير الشّعراء في الأسر، وصاحب “الروميات” الشهيرة. كان هذا الشاعر الفذ من أعلام القرن الرابع الهجري، وقد أبدع أثناء أسره في بلاد الروم قصائد خالدة سجّل فيها آلام الغربة، وجراح الفقد، ومرارة الأسر، والحنين إلى الوطن.([2]) وقد اطلق ابن شرف القيرواني عليها اسم «أسريات»([3]).

الحبسية نوع من الشعر الذاتي (الغنائي)، يتجلى فيها الألم الفردي في إطار جماعي، نظمه الشاعر في ظروف نفسيّة وعاطفيّة استثنائيّة، ليعكس تجربةً واقعية حقيقية حيث يخسر الشّاعر حريته، ويسجن ظلمًا أو خلافا في المذهب أو الرأي فعانى من السّجن والاعتقال والأسر، وتجرع مرارة الإهانة والوحدة والبعد من الأهل، وضنك العيش من طعامٍ ردئ ولباس خشن، وغير ذلك. كل هذه العوامل صيغت شعرا، ويتسم بالخصائص الآتية:
أ- الصدق في التعبير عن المشاعر الإنسانية الخالصة.
ب- البساطة في الأسلوب والبعد عن التّكلف.
ج- توظيف التشخيص والصور الذهنية المبتكرة.
د- وحدة الموضوع وتماسك النص([4])

يركز البحث على المقارنة بين مضامين الحبسيّات عند أبرز شعراء هذا الفن حتى القرن السابع الهجري: “مسعود سعد سلمان”، الرائد في الأدب الفارسي، و”أبو فراس الحمداني”، سيّد الحبسيّات في الأدب العربي، إلى جانب أعلام کـ”أبي نؤاس، أبي العتاهية، المتنبي، ناصر خسرو، فلكي الشّرواني، ومجيرالدين البيلقاني”. وقد وجدت بينهم مضامين مشتركة تشير إلى توارد الخواطر أحيانا، أو التأثير والتأثر أحيانا أخرى.
ترصد هذه الدّراسة المضامين المتجانسة في شعر الحبس لدى أبرز الشّعراء، فتتباين اللغة والألفاظ باختلاف ظروف السّجن وشخصية الشّاعر، لكن الجوهر يبقى واحدا. وتكشف النماذج تأثر واضح بـ”روميات أبي فراس”، وقد استلهم منه مسعود سعد سلمان وخاقاني مضامين مشتركة عبر توارد الخواطر، لا بمجرد الاقتباس المباشر. وهذا التأثر لم يقتصر على الأثر العربي فحسب، بل تجلى بين الشّعراء الفرس أنفسهم؛ إذ يستفاد من رواية الدكتور ظفري أن خاقاني – في “زندان نامه” – قد انتحل بعض أفكار مسعود سعد، ثم أودعها حلة تعبيرية جديدة([5]). وعليه، فإن البحثَ سيعكف على تحليل ودراسة بعض المضامينِ المشتركة بين شعراء ذلك العصر، والتي تتمثل في:”التفاخر بالشعر والذات”، و”وصف السجن”، و”الشکوی والبث الوجداني “. وقد جاء هذا البحث ضمن المحاور الآتية:
أ- تمهيد موجز: يلقي الضوء على الإطار العام للدراسة، ويستعرض نبذة تاريخيّة عن فن الحبسيات عبر العصور.
ب-التّحليل الدّاخلي والهيكلي: يتعمق في دراسة مضامين حبسيات الشعراء وبنائها الفني، كاشفا خصائصها الأسلوبية ودلالاتها النفسية والفكرية.
إشکالية البحث: تتمثل إشكالية هذا البحث في كشف أوجه التشابه والاختلاف في مضامين شعر الحبسیات بين الأدبين العربي والفارسي حتى القرن السّابع الهجري، مع التركيز على كيفيّة تمثل تجربة السجن في وعي الشّاعر العربي والفارسي، وهل هي تجربة إنسانيّة مشتركة تنبع من المعاناة ذاتها، أم أنّها انعكاس لخصوصيات ثقافية وحضارية متباينة؟ كما تسعى الدراسة للإجابة عن سؤال محوري: إلى أي مدى يمكن القول إنّ التأثير والتأثر بين الشعر العربي والفارسي في هذا الفن الأدبي كان مباشرًا أو نابعًا من توارد الخواطر؟
أهميّة البحث: تنبع أهميته من كونه يتناول ميدانًا أدبيًّا إنسانيًّا مشتركًا بين ثقافتين عريقتين، في ضوء المقارنة الأدبية. كما تسهم الدّراسة في إبراز البعد النّفسي والاجتماعي لتجربة السّجن في الشّعر، وإضاءة الجوانب الجماليّة والوجدانيّة التي شكلت ملامح فن الحبسيات في كلا الأدبين. ومن جهة أخرى، فإنّها ترفد الدّراسات المقارنة برؤية جديدة تربط بين التجربة الذاتية للشاعر والسياق الحضاري الذي عاش فيه.
فرضية البحث: ينطلق البحث من فرضيّة مفادها أنّ وحدة التّجربة الإنسانيّة في الأسر والمعاناة قد أفرزت تشابهًا ملحوظًا في مضامين شعر الحبسيات عند الشّعراء العرب والفرس، مع اختلاف في اللغة والأسلوب تبعًا لبيئة كل شاعر وثقافته.كما يُفترض أن مسعود سعد سلمان تأثر بصورة غير مباشرة بـ روميات أبي فراس الحمداني من خلال توارد الخواطر أو الاطلاع غير المباشر على الشعر العربي.
بنية القصيدة الحبسية في الثقافتين تشترك في عناصرها الكبرى:”الشكوى، والفخر،وصف السجن، والحنين إلى الحرية والوطن”.
أهداف البحث:
- كشف أبرز المضامين المشتركة في شعر الحبس بين الأدبين العربي والفارسي.
- تحليل البنية الفنية والنفسية لقصائد الحبسيّات عند أبرز شعرائها.
- تتبّع مظاهر التأثير والتأثر بين الشعراء العرب والفرس في هذا الفن الأدبي.
- الإسهام في تطوير منهج المقارنة الأدبية بين الثقافتين العربية والفارسية.
- إبراز القيمة الإنسانية والجمالية لفنّ الحبسيّات بوصفه مرآة لمعاناة الإنسان وحنينه إلى الحرية.
خلفية البحث: وهناك العدید من الدّراسات التي أفادت هذا البحث، و قد تحدثت عن شعر الأسر و السجن بصفة عامة ، لکن –علی حد علمي- لا توجد دراسة تختص بما قدمته هذه الدّراسة، و من هذه الدّراسات السّابقة-علی سبیل المثال لا الحصر- مایلي:
١.تجربة السّجن في شعر أبي فراس الحمداني، والمعتمد بن عباد، رسالة ماجستیر، کلیة الدراسات العلیا-جامعة النجاح الوطنیة-فلسطین، سنة 2004م.
2.كتاب “حبسيه سرايی در ادب عربی از آغاز تا عصر حاضر” (مرضيه آباد، ١٣٨٠ ش) الذي تناول دراسة أشعار الحبسيات منذ بداياتها حتى العصر الحاضر مع ذكر شواهد شعرية.
3.بحث “شعرالسجون في الأدب العربي الحديث والمعاصر” (سالم المعوش، ٢٠٠٣ م)
4.”الحبسيات في الشعر العربي” للباحثة سكينة قدور (جامعة منتوري – قسنطينة، 2007م).
5.مقال “مسعود سعد وأبوفراس وسابقة غزل مستقل” (يحيى طالبيان ومنصور نيكبناه، مجلة أدبيات تطبيقي، 1381ش)
- بحث “روميات أبي فراس الحمداني وحبسيات مسعود سلمان” (محمدهادي مرادي وصحبت الله حسنوند، 1388ش)
منهج البحث: يعتمد البحث المنهج المقارن الذي يقوم على دراسة النّصوص الشّعرية العربيّة والفارسيّة في ضوء وحدة الموضوع (تجربة السجن)، مع تحليل البنية الفنيّة والدّلاليّة لمضامينها. ويستعين الباحث في ذلك بالمناهج التّحليليّة والوصفيّة والنفسية، لكشف الأبعاد الجمالية والوجدانية والفكرية للنصوص، مع توظيف المقارنة لكشف التفاعل الثقافي والاختلاف الأسلوبي بين البيئتين الأدبيتين.
المضامين المشتركة في أدب السّجون:
أولًا: ادعاء الفضل ومفاخرات الخطيب
عندما يشعر الخطيب من «ضيق السجن، ومشقة القيود والأغلال، وقسوة السجان ذي النفس الشيطانية، يطلق صرخة فخر بفضله وعلمه وبلاغته، وبمتانة خلقه وسمو نفسه، وبما أظهره أحيانا من شجاعة وبأس وبذل للنفس»([6]). يتباين فخر شعراء السجون تبعا لخلفياتهم وتجاربهم: فبعضهم يمجد شجاعته الحربية مثل أبي فراس ومسعود سعد، في ما يركز آخرون على العلم والزهد كخاقاني وناصر خسرو.هذا التنوع، إلى جانب ظروف السجن، ينعكس في اختلاف الأساليب والصور والمفردات، مؤثرا في بناء القصيدة ولغتها.
1-مفاخر الأنا الشاعرة: هذا اللون من التّفاخر تتبدى فيه وظيفة الشعر ليس بوصفه تعبيرا عن الحزن أو المرارة فحسب، بل بوصفه سلاحًا مضادًا يشهر في وجه الخصم، تمامًا كما عبّر أبو فراس الحمداني بعد أسره حين قال: إن يمنع الأعداء حد صوارمي لا يمنع الأعداء حد لساني([7])
فهو إذ قيدت يداه، لم تقيد بلاغته، وظل لسانه سيفًا لا يفل، يخترق الدّروع ويزلزل الخصوم، كأنّما البلاغة عنده سيف ماضٍ يثأر للكرامة من وراء القضبان.توازن وتقابل بين “حدّ صوارمي” و”حدّ لساني”، وتكرار “لا يمنع الأعداء” للتأكيد على تفوق سلاح اللسان.
وعلى نهج مشابه، يفتخر مسعود سعد، بسهام قلمه وكأنها سهام الحرب، فيمزج بين أدوات المعركة وأدوات الشعر: ابيات من چون تير است از شست طبع من زيرا يكي كشيده كمانم ز انحنا([8])
يقول:أبياتي کسهام أطلقتها قريحتي بإبهامها،بعد أن شددت قوسا من الانحناء(کناية عن الاستعداد والاتقان)، فاندفعت قوية، کما تنطلق السهام من يد رام ماهر.
في هذه الصورة التخييلية، تتجلى بلاغة الاستعارة والمراوحة بين الحسي والمجرد، إذ تجسد الأبيات سهاما تنطلق من قوس الإبداع، ليحاكي الشاعر عبرها غمار القتال على الرغم من عزلته في السجن. ويمثل مراعاة النظير بين “السهم والقوس والإبهام/الوتر”، فيتحول الخيال البلاغي إلى سلاح رمزي يقارع به القهر.
في منحى آخر، يفخر المتنبي بذاته من خلال تشبيه ضمني، إذ يرى نفسه درة ثمينة لا يعيبها احتجابها في الصدف: لو کان فيك سکنای منقصة لم يکن الدّر ساکن الصّدف([9])
هذا التّشبيه الراقي يعبّر عن مفارقة بلاغية بين المكان الظاهري (السجن) وقيمة الذّات (الدّر) حجة منطقية (نفي النقص عن السجن بنفي سكن الدر في الصدف)، وبالمثل، يتغنى الشّعراء بمفاخر الأنا الشاعرة، فيجعل مسعود سعد من نفسه خاتما للشعراء:
بفزود چو كوه قوت شعر به من شد ختم دگر نبوت شعر به من([10])
يقول:بقوة شعري صرت كالطود راسخًا فختم النبوة بِالشّعر الحصين أنا، تعظيم الذات كآلية مواجهة لوطأة السجن. يعبر عن جرأة في الادعاء، بينما يرى خاقاني نفسه مالك الملك في فن البيان فتفوق كلماته كنوز الملوك: مالک الملک سخن خاقانی ام کز گنج نطق دخل صد خاقان بود يک نکتة غرای من([11]) أنا خاقاني، مالك ملك البيان،ففي كلماتي كنوز تفوق خزائن الخاقان. فاستعارة “ملك الكلام”، مبالغة فاحشة في قيمة كلماته، وتكثيف للفخر بالبراعة اللفظيّة، ويباهي ناصر خسرو بـ”علمه وعقله” اعتزازا:
کان علم و خرد و حکمت يمگانست تا من مرد خردمند به يمگانم([12])
يقول: يَمْکان معدن العلم والحكمة والرشد،فأنا رجل العقل بوادي يمکان. فتحويل مكان النفي (يمکان)إلى مصدر للفخر(يمکان أصبحت مرادفة للعلم والحكمة)، تعزيز الهوية الراسخة، وهذا النّوع من التّفاخر بالذّات يتخذ في شعر مجير الدين بيلقاني طابعًا نبويا مجازيا، حين يقول:
اگر نبوت اهل سخن کنم دعوی بس است معجز من اين قصيده غرّا ([13])
إن ادعيت نبوة أهلِ البيان، ففي قصائدي الغراء المعجزة الباهرة. مقاربة جريئة بين الإبداع والنّبوة، تعكس حاجة ماسة للتميز والتأثير كتعويض عن العزل. يكشف النص تنوع الأساليب تبعًا لظروف السّجن وثقافة الشّاعر، مع إبراز التفاعل الثقافي بين رواد هذا الفن، ما أضفى على هذا النتاج بعدا إنسانيا يتجاوز حدود الزنزانة واللغة.
2- الاستعلاء والتفرد
ثم يصل الفخر ذروته حين يعلن كل شاعر أنّه فريد لا نظير له، كما في قول أبي فراس:
يضيق مكاني عن سواي لأنني علي قمة المجد المؤثل جالس([14])
يؤكد الشّاعر تفرده واستحقاقه للمكانة الرفيعة، مبالغًا في وصف تحدّره على قمة المجد الأصيل بما يعكس اعتزازه بذاته وتفرده، مستخدمًا صورة مكانيّة مكثفة لتجسيد فكرة التفرد والعلو. ويوازيه مسعود سعد الذي يقسم أن لا شاعر يشبهه، ولا مداح يضاهيه:
به خدا ار دگرچو من يابند پس از اين هيچ پادشاه ستاي
نه چو من بود يك ثناگستر نه چو من هست يك سخن پيراي([15])
يقول:والله لن يجد الملوك بعدي مثلي في فن المديح البهي لا مثلي في زينة الكلم ولا كمثلي زين الكلام بلاغة.
تكرار وتوكيد “ليس مثلني”، “لا يوجد مثلي”، جرأة في الادّعاء بالتّفرد المطلق في مدح الملوك وتزيين الكلام. ويُظهر تأثرًا واضحًا بفكرة أبي فراس مع تعبير فارسي. وکذا خاقاني يَدعي العذوبة فِي عالم الكلم ويصف نفسه بـ”ساحر العصر”:
دانم که نيک دانی، ودانند دشمنان هم کاِمروز در جهانِ سخن همسری ندارم
در بابلِ سخن، منم استادِ سحر تازه کَز ساحران عهد کُهَن همبری ندارم([16])
يقول:اعلموا يا أعدائي ويا أحبتي، أني في عالمِ القولِ بلا ند، فأنا ساحر بابل الجديد، ولا أقاس بسحرة الأزمنة الخوالي. إنّ تكرار فكرة عدم النّد(همسری ندارم، همبری ندارم). ربط إبداعه بالسّحر القديم مع تأكيد تجدده وتميزه.
بل وحتى فلکی شروانی، يقر أنه مذ بدأ نظم الشعر، لم يرَ من يضاهيه عيارا ومكانة ويعد نفسه شاعرا نادر المثال: ز اول که سخن به نظم کردم کم بود به شاعری عيارم([17])
يقول: منذ بدأت نظمَ الكلام ، لم أجد في الشّعر من يعادلني. فالمقارنة بالآخرين “قليل من يعادلني” بدلًا من “لا نظير لي”، مع تأكيد تميزه منذ البداية.
ثانيًا: وصف السجن:
أبرز المضامين التي وردت في وصف السّجن الظاهري في “الحبسيات” تتمثل في:ليل السجن، وظلمته، وطول ليله، والقيود والأغلال”. ومع أنّ السجن وما يحيط به من شروط قاسية يعد عائقا أمام انطلاق الخيال والصور الشّعرية([18])، إلّا أنّ “الحبسيات” تحوي صورًا خياليّة تعكس سموّ الشّعراء في عالم الخيال الحرّ. وعلى الرّغم من قلّة المحسنات البلاغيّة فيها بسبب طابعها الذاتي، إلا أن أساليب التشبيه والاستعارة تبرز بشكل لافت، تتشكل وفاقًا لحالة الشّاعر وطبيعة سجنه.
1- ليل السجن: يصور أبو فراس الحمداني طول ليل السّجن بهذا التّصوير الرهيف:
هل تعطفانِ علي العليلِ؟ لا بالأسير ولا القتيل!
باتت تقلبه ألأكـ ف سحابة الليلِ الطويل
يرعي النجوم السائرا ت من الطلوع الي الافول([19])
يوظف النّص الاستفهام الإنكاري والنّفي القاطع لتكثيف شعور اليأس وشدة المعاناة، وتأتي الصور البلاغيّة عبر تشبيه الليل بسحابة ثقيلة، واستعارة السّجين راعيًا للنجوم لتصوير طول السّهر والانتظار.
يستخدم أبو فراس صورًا ملموسة(السّحابة، رعاية النجوم)، ويلجأ خاقاني إلى استعارة ثقافية (يلدا)- أطول ليلة-وإلى التّلميح الدّيني (القيامة) لإضفاء عمقٍ وجودي على طول الليل، فهي صورة مكثفة تستبطن الوجع من دون التصريح به:
هست چون صبح آشکار کاين صبوحی چند را بيمِ صبحِ رستخيز است از شبِ يلدای من([20])
يقول:إن وضوح الصباح ليشهد أنّ هذه الصباحات القليلة، يعتريها خوف صباح القيامة من ليلة يلداي الطويلة.
يعكس النّص القلق الوجودي للسجين، فتمثل “الصباحات القليلة” خوف النهاية المجهولة، ويحول “ليل السجن” إلى “ليل يلدا” بأسلوب أسطوري يرمز للخلاص. كما يبرز التوتر بين الأمل والظلمة من خلال مقابلة ثنائيات الضوء والليل، ويعمق الجناس الصوتي الإيقاع الشّعوري للصراع بينهما.
وفي السّياق ذاته، يرى أبو العتاهية أنَّ الليل طويل على من لا ينام، ويقول:
لکل ما يؤذي، وإن قلَ، ألم ما أطول الليل علی من لم ينم! ([21])
يبدأ بحكمة (لكل مؤذ ألم) لتؤسس للنتيجة.(على من لم ينم) يعمم شدّة العذاب لكل ساهر.إنّ الإيجاز في التّعبير المكثف (ما أطول الليل) ينقل الإحساس بثقل الوقت. أمّا المقابلة: بين عموميّة الحكمة الأولى وخصوصيّة حالة السّاهر المؤلمة في الثانية.
وأمّا مسعود سعد كما وصفه شفيعي كدكني:«تعد أوصافه للنّجوم والليل-وهي المشاهد الطبيعيّة الوحيدة المتاحة له من زنزانته-من أروع الصور، قابلة للمقارنة بأفضل صور الليل في دواوين الشّعراء القدامى»([22]) يعبر عن سهره: ديده همه شب ز خواب خوش بردوزم بر تن گريم چو شمع و از دل سوزم
از آرزوي خيال جان افروزم در آرزوي خواب شبي تا روزم([23])
يقول:أُغلق عيني طول الليل عن نوم هانئ، أبكي على جسدي كشمع وأحترق من قلبي، وأوقد روحي بالأمل، وأرجو نوم ليلة إلى الصباح.
يجسد تزاوج صورة الشّمع المحترق مع الانتظار المتّقد في الفناء الجسدي والنّفسي في آن، ويجعل السّهر احتراقًا داخليًّا متواصلًا.(أبكي كالمصباح): ويأتي تشبيه بكاءه بدموع الشّمع الذائب. (والنّار تضرم): وتأتي استعارة الحزن أو الشّوق الذي يحرقه داخليًّا، أمّا التضاد فجاءبين واقع السهر (أقاسي) وأمل النوم (أرجو).
وأمّا خاقاني الشّرواني هکذا يوحي بظلام ليل السجن و عمقه:
در سيه کاری چو شب، روی سپيد آرم چو صبح پس سپيد آيد سيه خانه بر شب مأوای من([24])
يقول: في سواد الأفعال كالليل،أظهر وجهًا أبيضَ كالصبح؛ غير أنّه ما إن يطلع البياض حتى يعود السّواد، ويغدو الليل مأواي ومسكني. يجسد النّص فكرة انتصار النّور (الأمل) على الظلمة (اليأس)، ولو كان مؤقتًا ثم يحوِّل العدو الى حليف؛ فالمكان الذي كان مصدر شرٍّ يصير مأوى آمنًا له. يستخدم تضادًا بين “السواد/البياض” و”الليل/الصبح” ليعبّر عن حالة التّناقض بين الأمل واليأس.
يصف مجير الدين البيلقاني أرق السجن:
اگر زيادت خون خواب آورد پس چيست؟ مرا دو ديده پر خون ونيست در دل خواب([25])
يقول:إذا كثرة الدّم في العيون تنيِّم، فما بال عيوني دم وليس بقلْبي نعاس؟
يعكس الاستفهام الاستنكاري حيرته من شدة الأرق على الرّغم من البكاء الذي يفترض أن يسبب النّعاس.وتأتي المبالغة: “عيوني دم” صورة قوية للبكاء المستمر. أمّا النّفي المؤكد: “وليس بقلبي نعاس” يؤكد استحالة النوم على الرّغم من الإرهاق.
لم يشكُ ناصر خسرو من الأرق فحسب، بل من اضطراب الروح:
همه شب گرد چشم من نگردد زِ خيل خواب و آرامش خيالی
مرا تا صبح بشکافد دلِ شب نيابد دل ز رنج آرام وهالی([26])
يقول: لا يدور حول عينَي طيف نوم طوال الليل،من جند سبات أو راحة خيال، فالليل يشق فؤادي حتى الصباح،لا يجد القلب من ألم راحة أو هدوءً.
تُظهر المفارقة في “رنج/ الألم و” آرام/ راحة”، تناقضًا بين الألم والراحة، ويجسد “خيل خواب” (جند النوم) النّوم كجيش منظم، وتصوّر الاستعارة المكنيّة في “بشکافد دلِ شب” (يشق قلب الليل) استعارة الليل ككائن حي يعاني. وأمّا “صبح” (الصباح) رمز للأمل في الفكر الإسماعيلي (الذي ينتمي إليه ناصر خسرو) الّذي اعتمد على إيحاءات صوفيّة (شقاء الليل سبيلًا للوصول إلى “صباح” الحكمة).
ويقول الفرزدق في تعبيره الشجي:
أبيت أقاسی الليل والقوم منهم معي ساهر لي ولا ينام و نوم([27])
يقول:أسهر الليالي مكابدًا ألمها، والناس من حولي منهم معي ساهر لي (يرقبني/ يهتم بي) ولا ينام! وفريق نائم (يغط في نومه/يهملني)!
” تعطي المفارقة”بين السّاهرين والنائمين بعدًا اجتماعيًّا للأرق، وتبرز العزلة على الرّغم من وجود الآخرين.
ويشبّه أبو العتاهيّة النوم في ليل السّجن القاسي بطائر يطير من قفص عينيه:
أرقت، وطار عن عيني النعاس ونام السّامرون ولم يؤاسوا
فديتك إنّ ليل السّجن بأس وقد أرسلت «ليس عليك بأس» ([28])
صور الشّاعر النّوم كطائر يهرب من عينيه، معبّرًا عن فقدان السّيطرة والعزلة، مقابل نوم الآخرين بلا مواساته، مستفيدًا من تناص ديني يسخر أو يواسي بطريقة يائسة. لقد آذى “الأرق” في ليالي السّجن الطويلة القاسيّة ابن المعتز الأمير المنعم:
طار نومي، وعاود القلب عيد أبى لي الرّقاد حزن شديد ([29])
يقول:طار نومي، وعاود القلب الهمّ، منعني الرّقاد حزن شديد. يشبه الأمير المنعم في هذا البيت النوم بطائر طار من عينيه، تاركًا إياه للأرق والسهر. ويقول أبو فراس الحمداني الأمير عن ليله المستبد:
إِذا الليل أَضواني بسطت يد الهوى و أذللت دمعًا من خلائقه الكبر
تكاد تضيء النّار بين جوانحي إذا هِي أذكتها الصّبابة والفكر ([30])
يقول:إذا أضعفني الليل بسطت يدي للهوى، وأذللت دمعًا من كبريائي.تكاد تضيء النّار بين جنبي إذا ما أذكاها الشوق والفكر.
يتحدث أبو فراس كشاعر رومانسي عن حزنه مستخدمًا أسلوب الاستفهام البلاغي، إذ يحاور الأسير الآخر ليبثه حسرته ويستثير عطفه. إنّه حوار عاطفي تمتزج فيه المروءة بالقوة. لا يبكي، بل يصبر كالرجال الأشداء على الرّغم من الموجة الحزينة التي تعتصر قلبه.
لاشكّ أن الأرق والسّهر مؤذيان لكل إنسان، لكنهما لا يطاقا للأمراء المنعمين. ويمكن رؤية هذا الفرق بمقارنة أبيات الشّعراء الأمراء كـ”ابن المعتز” و”أبي فراس الحمداني” بشعراء آخرین مثل “الفرزدق” و”أبي العتاهية” و”أبي نواس” وغيرهم من شعراء السّجن.
بسبب آلام السّجن وأحزانه الليليّة، الكواكب قلقة على حال مسعود وهي تبكي عليه:
من آن غريبم و بيكس كه تا به روز سپيد ستارگان ز براي من اضطراب كنند
ز بسكه بر من باران غم زنند، مرا سرشك ديده، صدفوار در ناب كنند([31])
يقول:إنّي أنا ذلك الغريب الوحيد الذي حتى الصباح المنيرِ، تضطرب لأجلي النّجوم وتجزع، ولشدة ما يهطل علي من دجى الغموم والأحزان، فإنّ دموع عيني كالدرّ يصاغ في النّاب من شدّة البكاء.
تشخيص عاطفي في(النّجوم تضطرب من أجلي) أي إضفاء المشاعر على النّجوم، ليبرز تعاطفها مع غربته ومعاناته. ومن خلال تشبيه الدموع باللآلئ التي تتكون في المحار، يظهر اعتقاده بتعاطف الكون، فالنّجوم تضطرب وتشاركه الألم (تمطر غما/باران غم).
ويعود أبو فراس ليُسَائِل نجوم السماء:
ما لنجوم السّماء حائرة! حالها، في بروجها، حالي؟
أبيت حتي الصباح أرقبها مهتديات، في حال ضلال
أما تراها، علي، عاطفة تكاد، من رقة، تبكي لي؟!([32])
يقول:ما للنجوم حائرات؟؟! هل حالها تغير لحالي؟ أسهر أرقبها حتى الصباح، كأنها تضل دربها، ألا تراها تشفق علي، حتى تكاد تبكي من رقتها؟
يحاور الشّاعر في خطابه الدرامي الكون (النجوم) ويحاور إنسانا غائبا (أما تراها؟)، مما يحيي النص بحواريّة تشد القارئ إليه، فالنّجوم: رمز للأمل البعيد، والحرية المستحيلة، والرفقة الوهميّة في العزلة. يظهر أبي فراس كشاعر أرستقراطي يرفض البكاء المباشر، فيستبدله بتشخيص النّجوم الدّامعة – إعلاء للألم عبر الصورة الشعرية بدلًا من الإفصاح عنه. اختلافه عن شعراء السجن (كأبي العتاهية) بتجسيد الكون شريكا في الألم، لا مجرد شاهد عليه. شعر أبي فراس سياج من الفخامة يحيط بجرحه؛ يترجم الألم إلى نجوم حائرة، والدّموع إلى تعاطف سماوي، والسّجن إلى حوار مع الوجود.
يكشف التّحليل المقارن لشعر السّجون في الأدبين العربي، والفارسي أن “ليل السجن” يتجاوز كونه إطارًا زمانيا ليغدو كيانا فاعلًا ومصدرا للعذاب النفسي والجسدي. وقد تنوعت وسائل التعبير عنه بين التّصريح والتّلميح، والتّشبيه والاستعارة والتّشخيص، مصحوبة بصور شعريّة قويّة جسدت الأرق والوحدة وفقدان الأمان. كما يبرز أثر الخلفيّة الاجتماعيّة والنّفسيّة للشّاعر في زاوية النّظر: فالأمراء (أبو فراس، ابن المعتز) جعلوا الألم قضيّة كرامة، والحكماء (خاقاني، أبو العتاهية) صاغوه مأساة كونيّة، في ما صوره المنكسر (مسعود سعد) حوارًا مع الكون كرفيق وحيد. يكشف البناء الشّعري بذلك عن معنى التّجربة: صاحب السّلطة يصهر ألمه في قواف متينة، والضّعيف يذوبه في دموع. ومع ذلك يبقى الألم الإنساني العميق قاسمًا مشتركًا يوحّد هذه الأصوات عبر العصور والثقافات، ما يجعل النّصوص تراثًا إنسانيا ثمينا في تصوير أقسى تجارب النفس البشرية.
2-الأغلال والقيود
إنّ ملازمة الأغلال والقيود غير المحببة للشّاعر، كانت تجعل كل شاعرٍ نظم في الحبس- بحسب قوة خياله – يرسم صورة القيد، والسلاسل بشكل يختلف عن شاعر الحبس الآخر.
نلاحظ في الأبيات الآتية أن الشّعراء الفرس، على عكس الشّعراء العرب، باستخدامهم خيالهم، شبهوا القيود والاغلال بـ “الأفعى”، و”الأفعى ذات الرأسين”، و”الأفعى ذات الرأسين والأربع عيون”، و”التنين”… إلخ. بينما تحدث أبو فراس والفرزدق وغيرهما عن الألم والآثار والعلامات التي تركها القيد والسلاسل على أجسادهم، وذكروا لفظ “القيد والسلاسل” صراحةً، كما في قول أبي فراس:”نحمِل أقيادنا، و ننقلها”، أو قول أبي العتاهية:”ويا ويح ساقي من قروح السلاسل”، وكذلك المتنبي:”أوهن رجلي ثقل الحديد”.
هذا الاختلاف ناجم عن الظروف المحيطة بالشّاعر، وموقعه، ونوع السّجن، والقيد والسّلاسل. مع أن طريقة التعبير عن هذه المعاني تختلف بين الشعراء العرب أنفسهم أو بين الشّعراء الفرس، وليس الأمر أنّ كل الشّعراء العرب أو كل الشّعراء الفرس، استخدموا نهجًا واحدًا للتّعبير عن معنى مشترك.
وكما أشرنا سابقًا، فإنّ السّجن وظروفه السيئة، عامل لعدم بروز خيال الشّاعر وتخيلاته([33]) وهذه الأشعار، مقارنة بغيرها من الأشعار، تتمتع بقدر أقل من المحسنات البديعيّة؛ لأنّها تعبّر عن حال المتكلم، ويكون الشّاعر أقل سعيًا لإظهار قدرته الشّعرية وبراعته، والنماذج المقدمة شاهدة على هذا الادعاء، وبحسب حال الشّاعر والمكان ونوع السجن، تتغير الألفاظ والبنى وصور الخيال.
لذلك، فإن الشّاعر -بسبب ضيق المقام والظروف الصّعبة وانعدام الراحة، وكذلك من أجل التّعبير وإظهار آلامه ومعاناته بأسرع ما يمكن وإيصال مقصوده لمن يسمع صرخته- يستخدم أقل عدد من الألفاظ في عرض مطلبه. كذلك الشّاعر، بحسب موقعه، يحاول استخدام أقل عدد من الألفاظ وأقل قدر من الخيال، كي لا يكون ذلك عائقًا أمّام التّعبير الواضح والسّريع عن مطلبه وإبلاغه لمن يسمع صرخته. ولهذا، بالإضافة إلى الإيجاز في الكلام، يتجنب الخيال الذي يحتاج إلى تأمل ولا يتناسب مع مقتضى الحال.
يخاطب أبو فراس الحمداني متلقيه قائلًا: إنّك لو تأملت جيدًا لرأيت أنّ الزّمن والسّجن والسّلاسل قد غيّروا هيأته؛ حتى تعسر عليك معرفته:
يا راكب الخيل! لو بصرت بنا نحمِل أقيادنا، و ننقلها!
رأيت فی الضر أوجها کرمت فارق فيک الجمال أجملها
قد أثر الدهر فی محاسنها تعرفها، تارة و تجهلها([34])
الحديث عن تشوه الجمال “فارق فيك الجمال” وتغيّر الملامح لدرجة عدم المعرفة “تعرفها، تارة وتجهلها” يكشف أثر السّجن المدمر على الهُويّة والكرامة والأسلوب المباشر الوصفي، يعبِّر عن الألم الملموس والمرئي، والمقابلة بين “كرمت” (الشّرف) و”فارق… الجمال” (فقدان المظهر) لتأكيد التناقض بين جوهرهم الّسابق وحالهم الحالي. يمثل أسلوب أبي فراس النموذج العربي في وصف الأثر المباشر للقيود (الجسدي: حمل القيود، تشوه الوجوه) من دون اللجوء إلى تشبيهات مجازيّة معقدة. اللغة صريحة في ذكر “أقيادنا”.
أما أبو العتاهية، فينوح على قيوده وسلاسله هكذا:
أيا ويح قلبی من نجی البلابل ويا ويح ساقی من قروح السلاسل
ويا ويح نفسی، ويحها،ثم ويحها ألم تنج يوما من شباک الحبائل[35]
يغلب هنا طابع الحسرة واليأس الشّديد، فمثل أبي فراس، يستخدم أبو العتاهية لفظ “السّلاسل” و”الحبائل” صراحة، ويصف أثرها المادي المباشر (الجروح) والنّفسي (الحسرة)، فالانفعاليّة هنا أشد وأكثر بلاغة، والتكرار المكثف لـ “ويح” وخاصة في السّطر الثالث “ويحها، ثم ويحها” يعكس تدفقًا عاطفيًّا هائلًا من الألم والاستسلام، والسؤال البلاغي “ألم تنج يوما”يوحي باليأس من الخلاص، ويركز الأسلوب الانفعالي المباشر على الجرح الجسدي (قروح السلاسل) والجرح النّفسي من تناقض حريّة الطبيعة (نغيم البلابل) مع أَسر الإنسان، وجاءت الاستعارة في “شباك الحبائل” (شباك الشراك) للدّلالة على الخداع والوقوع في الفخ.
والمتنبي، على الرّغم من علوّ نفسه وهمته، يذلّ نفسه أمام الخليفة طلبًا للخلاص من أذى القيد والسّلسلة، ويخبره عن السلسة التي أضعفت قدميه:
دعوتك لما براني البلاء وأَوْهن رجلي ثِقل الحديد
وقد کان مشيهما في النِّعال فقد صار مشيهما في القيود([36])
يصور المتنبي لحظة ذل واضطرار على الرّغم مما عُرف عنه من كبرياء، وكنموذج عربي آخر للوصف المباشر. يذكر “ثقل الحديد” و”القيود” صراحة، ويصف أثرها المادي الملموس (إضعاف الرجلين) والرّمزي (الانتقال من النِّعال إلى القيود)، فالمقارنة بين الماضي “فِي النعال” – حريّة، كرامة والحاضر “في القيود” – عبوديّة، وذل يكشفان عمق المأساة. يعكس الأسلوب المكثف والموجز ضيق الحال الذي ذكره النّص الأصلي. الطباق القوي بين “النّعال” (الحريّة، الرقي) و”القيود”(الأسر، الذّل).
أمّا مسعود سعد، فقد شبّه السّلسلة الحديديّة في مواضع متعددة من حبسيّاته بـ “الأفعى”، مخالفًا بذلك شعراء العرب الذين يذكرون لفظ “الغل” و”السّلسلة” صراحةً:
از آهن بر دو پای ماری دارم ناخوش عمری و روزگاری دارم([37])
يقول:على قدمي أَفعى من حديد وحياة غير سعيدة لي وزمن، وكذلك شبهها بـ “أفعى ذات رأسين”:
نه دشمن آيد زی من نه من روم برِ دوست که اژدهايی دارم نهفته در دامن
دو سر مر او را بر هر سری دهانی باز گرفته هر سر يک ساق پای من به دهن([38])
يقول:لاعدو يأتيني ولا أَنا أَمضي إلى صديق؛ لأنّ لي تنينًا (أو أفعى عظيمة) مختبئا في حجري! له رأسان، ولكل رأْس فم مفتوح، قد أمسك كلّ رأس بساق من ساقي بفمه!.
وكذلك بـ “أفعى ذات رأسين وأربعة أعين”:
مار دو سر چهار چشم است ای دوست کز پای من او گوشت همی خايد و پوست([39])
يقول: أَفْعى بِرأسين وأربع عيون هي يا صديقي! تأكل اللحم والجلد منْ قدمي!.
يسود هنا الخوف والرّهبة من القيد، ويعكس تحويله إلى كائن حي مفترس (أفعى، تنين) الشّعور بالتّهديد الدّائم والألم المستمر (تأْكل اللحم والجلد)، ويضخم وصف الأفعى بتفاصيل مرعبة (رأسان، أربع عيون، أفواه مفتوحة) الشّعور بالشّراسة والقسوة. وتأتي العزلة القسريّة (لا عدو يأتيني ولا أنا أمضي إلى صديق) نتيجة لهذا الوحش، فالأسلوب في هذا السّياق مجازي وخيالي.
يمثل مسعود سعد النّموذج الفارسي في استخدام الخيال المجازي المكثف.لا يذكر “القيد” أو “السلسلة” صراحة، بل يستعيض عنها بصورة مرعبة (الأفعى/التنين) تعبّر عن تجربته الذاتيّة المرعبة للألم والعزلة. هذا يتناقض مع المباشرة العربيّة في وصف الأثر.
أمّا خاقاني،مستعينًا بتشبيهات بديعة، فقد دعا السّلسة في قدمه “تنينا”، و”جبل حديد”، و”أفعى ضحّاك”، معتقدًا أن سلسته الشّبيهة بالأفعى قد أثارت دموعًا تندلق من أجفانه، فصار يحترق كسمكة في مقلاة:
اژدها خفته بود بر پايم نتوانستم آن زمان برخاست
پای من زير کوه آهن بود کوه بر پای چون توان برخاست؟!
مار ضحاک ماند بر پايم وز مژه گنج شايگان برخاست([40])
يقول: كانت أفعوان نائمة على قدمي فلم أقدر أن أنهض، وكأن قدمي تحت جبل من حديد، فكيف تنهض من تحت جبل؟ أفعوان ضحاك-الملك الطاغية في الأسطورة الفارسيّة الذي نبتت أفاعٍ على كتفيه- بقيت على قدمي، ومن عيني تفجّر كنز من الدّموع الغزيرة.
وفي موضع آخر، مستلهمًا شخصية السّيد المسيح، يصف قيده مشبهًا إياه بالإبرة التي – وفاقًا للروايات – حبست السّيد المسيح في السّماء الرابعة، كما يشير في عبارات “ثلاث سلاسل” و”قيود صليب على قدمي” إلى زهد الرّهبان المسيحيين الذين كانوا يربطون أيديهم وأرجلهم وأعناقهم:
من اينجا پای بست رشته مانده چو عيسی پای بست سوزن آنجا
چو قنديلم برآويزند وسوزند سه زنجيرم نهادستند اعدا
مرا از بعد پنجه ساله اسلام نزيبد چون صليبی بند بر پا([41])
يقول: أنا هنا مشدود القدم بخيط، كالمسيح مشدود القدم بالابرة هناك، كالقنديل يعلقونني ويحرقونني، قد وضع الأعداء ثلاث سلاسل لي، أفبعد خمس سنين من الإسلام، يليق بي قيد صليبي على قدمي؟.
قمة التجريد والخيال في النموذج الفارسي. يستخدم خاقاني تشبيهات متعددة ومعقدة (تنين، جبل، أفعى ضحاك، إبرة، صليب) للتعبير عن ثقل القيد وعمق المعاناة الجسدية والنّفسيّة،لا يذكر مباشر للفظ “القيد”، فالتلميح الى الصليب يضيف بعدا فريدا مرتبطا بهويته.
يعبر النص عن عجز الشّاعر، وثقل القيود التي يشبهها بجبل من حديد وأفعوان ضحاك الأسطوري، كما يكشف ألمه وبكائه الغزير. يستحضر صورًا دينيّة كالمسيح، والصّليب ليبرز عمق معاناته الرّوحيّة وجسامة إهانته، خصوصا كونه مسلما يقيد كالمصلوب. أسلوبه غني بالاستعارات والتلميحات، يعكس قسوة السّجن ووحشية السّجانين.
أما مجير الدين، فيشبه السلسلة بالشرك، ويرى نفسه طائرا ذكيا وقع في هذا الشّرك الحديدي:
چو مرغِ زيرک ماندم به هر دو پا در دام کنون چه سود که بر سوزيم بسان زَباب([42])
يقول: كطائر ذكي بقيت بكلا قدمي في شرك، فما الفائدة الآن من احتراقنا مثل الوزغ السام الأبرص أو عضايّة أو الصرصار أي لا معنى للعويل بعد وقوع القضاء كصرصار يحرق نفسه بنار لا تطفأ!.
تصوير مرير للمفارقة، فذكاء الطائر جعله يقع في الفخ من كِلا القدمين، ما يرمز إلى العجز التام على الرّغم من الفطنة. “سوختن مثل زباب” (الاحتراق كالوزغ): مثل فارسي يُعادل في العربية “أَحمق من سام أبرص” أي أشدّ غباء من حيوان يرمي بنفسه في النار. تشبيه نادر يجسد الهلاك العبثي؛ إذ يُروى أن هذا الحيوان يُلقي بنفسه في النار ويحترق من دون فائدة. هو حيوان صغير يسمی وزغة وقيل:من کبار الوزغ([43]) يُضرب به المثل في التهوُّر والعذاب الباطل، كمن يُلقي بنفسه إلى التهلكة، وهو مستوحى من الأدب الجاهلي. الأسلوب مجازي ومكثف. ونرى نموذجًا فارسيا آخر يستخدم التّشبيه (الفخ) للتعبير عن الأسر، فيبرز التضاد بين “اللب” (العقل) و”الشرك” (الغفلة) أي سخريّة القدر.
وأمّا فلكي الشرواني، فباستعارة بديعة، يرى السّلسة في قدمه بحرًا غرق فيه، واستولى على كيانه كله:
غرقه در آهنم چو ديوانه گرچه با ديو کار زارم نيست([44])
يقول:غريق في الحديد كالمجنون، ولو لم يكن لي عمل مع شيطان!.
يستخدم استعارة بحريّة مجردة (غارق فِي الحديد) للتعبير عن شدّة الأسر، وهو أسلوب مجازي بعيد من المباشرة العربية. يوحي تشبيهه بالمجنون بفقدان السّيطرة على الوضع، وتأكيد أنه ليس مع شيطان يبرئ نفسه ويشير إلى أن مصدر عذابه مادي بحت (الحديد/السجن)، ونرى الأسلوب المجازي والمكثف.
يكشف هذا النص المقارن قوة الشعر كسلاح نفسي وأدبي للمقهور. وعلى الرّغم من وحدة الموضوع، ظهرت اختلافات أسلوبيّة تعكس الخصوصية الثقافية لكل أدب(التلميح السياسي/الديني في العربي، المباشرة والقسوة في الصور الفارسيّة لمسعود سعد).
في الواقع إنّ ظروف السّجن الصعبة تحدّ من بروز خيال الشّاعر، وتجعله يلجأ للإيجاز والمباشرة، وهذا يبدو واضحًا جدًا في النّماذج العربيّة (إيجاز المتنبي) وفي اعتراف أبي فراس بضيق الحال. أمّا النماذج الفارسية، على الرّغم من أنّها تستخدم الخيال، فإنها تركّز بشكل مكثف ومتكرر على مصدر الألم نفسه (القيد كوحش مفترس) بطريقة قد تعكس أيضًا “ضيق” رؤية الشّاعر المحبوس وانحصار تفكيره في مصدر عذابه، وإن عبر عنه بصورة مجازيّة معقدة أحيانًا (خاقاني). أي أنّ الخيال موجود، لكن مجاله قد يكون محدودًا بموضوع المعاناة المباشرة وأشكالها المرعبة.
ثالثًا- الشكوی
1- الشكوى من الأعداء والحساد: لقد صور الشّعراء السجناء في أبياتهم المفعمة بالألم والحزن سعاية الحساد وكيد الأعداء. يرى أبو فراس الحمداني أنّ الأعداء هم سبب فراقه عن سيف الدّولة، كما أنّهم كانوا السّبب في أسره: فلما حالت الأعداء دوني وأصبح بيننا بحر ودرب([45])
تجعل الاستعارة المكنيّة (البحر، الطريق) العداوة سدًّا بحجم البحر والطريق/الفراق البعيد مع إيجاز في العبارة مع وضوح المعنى.
يتسم أسلوب أبي فراس بالتّشخيص الحسي للتّفريق (البحر/الدرب)ن يقابلها عند مسعود سعد الإلصاق المباشر للتهمة من دون تصوير مكاني فإنّه يقرُّ بدور الأعداء في أسره:
اين رنگ به جز عدو نياميخت وين بهتان جز حسود ننهاد([46])
يقول: هذا اللون لم يخلطه إلّا العدو، وهذا البهتان لم يضعه إلّا الحاسد. يحمِّل أسلوب القصر بالتّخصيص – “لم… إلا” – العدو والحاسد كامل المسؤوليّة. تقرير مباشر خالٍ من التزيين، يختلف عن أبي فراس في البساطة والوضوح، بعيد من التصوير الرّمزي.
يخشى خاقاني الشرواني بهتان أعدائه، كما باغت أعداء وحساد المسيح عليه السلام:
مرا مُشتی يهودی فعل خصم اند چو عيسی ترسم از طعن مُفاجا([47])
يقول:خصومي قوم على شاكلة اليهود،أخشى كما خشي المسيح من الطعن المفاجئ. يعمّق التشبيه التاريخي – استدعاء قصة المسيح – المعنى ويعطيه بعدًا دينيًّا لإقناع المتلقي، يختلف عن مسعود سعد الذي جاء بالاتهام المباشر، أمّا خاقاني فألبس الخصوم لباسًا تاريخيًّا/مقدسًّا لتضخيم خطرهم.
يسخر في موضع آخر منهم بأسلوب الاستعارة التهكّميّة، فيسميهم “الأعزاء الكرام” وهم في الحقيقة سبب ذلّه: خواری من زِ کينه توزی بخت از عزيزان مهربان برخاست([48])
يقول: ذلي من بغضاء الحظ، نشأ من الأعزاء الكرام. تهكم يجعل الذم في صورة مدح لزيادة الإيلام، أي نبرة سخريّة ممزوجة بالمرارة. يجمع خاقاني بين الجدّ (التّشبيه بعيسى) والسّخريّة (الاستعارة التهكّميّة).
مجير الدين يشكو إلى الملك مكر الحساد:
جهان پناها! من عاجزم زِ مدحتِ تو که هست بر دلم از مکر حاسدان آزار
به بارگاه تو از بنده نقلها کردند کزان نشست بر اطراف خاطر تو غبار([49])
يقول:يا ملاذ العالم! أنا عاجز عن مدحك، إذ على قلبي أذى من مكر الحاسدين، لقد نقلوا عني إلى حضرتك أحاديث، فأثارت في خاطرك الغبار.
فاستعارة “أثاروا الغبار” كناية عن تلويث السمعة، وفي الخطاب المباشر للملك يريد به طلب إنصاف. يباين أسلوب خاقاني الذي اختار التهكم والتهويل، بينما مجير الدين خاطب السّلطان جاء بتضرع مباشر.
ويرى أنّهم السّبب في طرده من بلاط الملك:
اگر چه مادحان داری زِ من بهتر فراوانی يقين دارم که بد گويند پيشت شرحِ حالِ من([50])
يقول: وإن كان لديك مادحون أفضل مني كثيرا، فأنا واثق أنهم يذكرون أمامك حالي بسوء. تقرير مع لمز خفي للمنافسين، خطابه مباشر للسلطان، نغمة التوسل ظاهرة، بخلاف شكوى خاقاني التأملية الساخرة.
ناصر خسرو يشبه أعداءه بـ “الجن والشياطين” الذين حسدوا النّبي سليمان عليه السّلام:
سليمان وار ديوانم براندند سليمانم، سليمانم من آری
به دريا باری افتاد او بدان وقت ز دست ديو و من بر کوهساری([51])
يقول:طردني الجنّ كما طردوا سليمان، وأنا سليمان حقًا، ذاك ألقي في البحر وقتها بيد الشيطان، وأنا أُبعدت إلى الجبل.
تعطي الاستعارة التاريخيّة – الموازاة بين نفسه وسليمان – للشكوى بعدا أسطوريا. فأسلوبيا:تضخيم ذاتي عبر الموازاة الأسطورية. يختلف عن أبي فراس ومسعود في عده نفسه بطلا نبويا يقاوم الشّر. يلتقي مع خاقاني في استدعاء رموز الأنبياء، لكن خاقاني يستبطن خوفا (چو عيسی ترسم از طعن مفاجا)، وناصر خسرو يعلن تحديا وفخرا.
ابن المعتز يصور أثر الدهر في تفرقة الأحباب:
أينَ إخواني الألی کنت أُصفِيــــ هم ودادي، وکلهم لي ودود
شردتهم کف الحوادث و الأيــــ مِ من بعد جمعهم تشريد([52])
الاستعارة في “کفّ الحوادث” حزن متزن من دون انكسار. يتفرد بالتّركيز على الزّمن لا على الأعداء كسبب مباشر، يشبه شكوى أبي فراس في تصوير الانفصال، والفقدان في البيت الأول(فلما حالت الأعداء دوني)،كلاهما يصور قوة خارجيّة مانعة، والفرق أنّ أبو فراس يحمِّل العدو المباشر المسؤوليّة بينما ابن المعتز يلقيها على الزّمان(کف الحوادث).
ويری أبو فراس أن حسد الحساد دليل شرفه:
ومن شرفي أن لا يزال يعيبني حسود علي الأمر الذي هو عائب
فكم يطفئون المجد والله موقد وكم ينقصون الفضل،والله واهب!([53])( [54])
يقيم مقابلة بين “يطفئون المجد / الله موقد”، “ينقصون الفضل / الله واهب”، أي مقابلة بين فعل البشر وفعل الله – تقوية المعنى بالموازنة، فخر ممزوج بالثقة بالله، يختلف عن البيت الأول له (الحزن) إذ يتحوّل هنا إلى الفخر والاعتداد. يشبّه مسعود سعد في البيت الآتي الذي رأى أنّ حسد الأعداء نابع من علو مكانته. الفرق أنّ أبا فراس ينسب الفضل لله، ومسعود سعد يصف مكائدهم أمام السّلطان:
چو پايگاهم ديدند نزد شاهنشه كه داشتم بر او جاه و رتبت و امكان
به پيش شاه نهادند مر مرا تهمت به صد هزاران تلبيس و تُنبْل و دستان
مگر زپايگاه خود بيفكنند مرا به پيش شه همه سود مرا كنند زيان([55])
يقول: لما رأوا منزلتي عند الملك، وما لي عنده من الجاه والمنزلة، وضعوا أمامه تهمة بألف تلبيس وخديعة ومكيدة، لعلهم يوقعونني من مكاني، ويجعلون ما هو نفع لي ضررًا عنده.
تناولت الحبسيّة تصوير المؤامرة بكثرة الألفاظ الدّالة على المكر وأساليب السّرد التّفصيلي، كما عند مسعود سعد، في مقابل الإيجاز عند مجير الدين. وعلى الرّغم من وحدة الفكرة المتمثلة في الحسد والعداوة، اختلف التّعبير بين الشّعراء بين الحزن والتّحدي والسّخريّة والاسترحام والاعتداد والرثاء.
اختلفت أساليب الشّعراء في تناول الحسد والعداوة؛ فأبو فراس ومسعود سعد ربطاه بالمكانة، وخاقاني جمع بين التّشبيه الدّيني والسّخريّة، ومجير الدّين خاطب السلطان بالاسترحام، بينما منح ناصر خسرو شكواه بعدًا ملحميًّا، وحول ابن المعتز شكواه إلى رثاء للأصدقاء والزمان.
2- الشكوى من الأصدقاء والخلان
يشكو أبو فراس الحمداني من الأصحاب قائلًا:
تناساني الأصحاب، الأعصيبَة ستلحق بالأخري، غدا و تحول!
ومن ذا الذي يبقي علي العهد؟انهم وان كثرت دعواهم، لقلِيل!
اقلب طرفي لا أري غير صاحِبِ يميل مع النعماء حيث تميل ([56])
يقول: لقد سلم الأصدقاء أمري للنسيان، إلا فئة قليلة سيلتحقون عمّا قريب بالسابقين. ومن يحفظ العهد؟ على كثرة الدّعاوى فالوفاء قليل. وحين أطالع النّاس لا أرى إلا صاحبا يميل حيث تميل النّعمة.
تشي استعارة “نسيان الأصحاب ” بكسر العهد؛ ثم مقابلة كثرة الدّعاوى/قلة الوفاء؛ وصورة “يميل مع النّعمة”كناية عن انتهازية. تركيب ثلاثي متدرج (نسيان/قلة وفاء/انتهاز)، وتعكس المبالغة والطباق بين الكثرة والقلة خيبة الأمل، يقابلها عند مسعود تصوير حسي للوحدة (ميت/نائم)، بينما عند خاقاني تتضخم إلى غربة مكانيّة )خاقانی غريبم، در تنگنای شروان /أنا خاقاني الغريب في ضيقِ شروان).
يضيق صدر مسعود سعد لأن أصدقاءه أسلموه للنسيان:
نه مرا ياري دهد حري نه با من نامهاي كند ياري
مردهاي ام چو زندهاي امروز خفتهاي ام به سان بيداري([57])
يقول:لا يكاتبني حر يعينني،ولا يواسيني صاحب برسالة، أنا اليوم كالميت حيا، وكالنائم يقظا.
يظهر طباق حي/ميت ونائم/يقظ، اغتراب الوعي، وقد جاء ذلك بنبرة مريرة، جمل خبريّة قصيرة.أصدق مباشرة من رهافة أبو فراس؛ يقترب من فلكي شرواني في التّصريح.
يقول أبو فراس أيضًا عن قلّة الثّقة بالأصدقاء:
بمن يثق الإنسان فيمن ينوبه ومن أين للحرّ الكريمِ صحاب؟([58])
سؤالان إنكاريان يثبتان عدم الثّقة وندرة الخلّص، فخامة جزلة، مفردات قِيميّة (حر، كريم)، يعادل عند ناصر خسرو ثنائيّة “الجاهل/العالم” في (جاهل از تقصير خويش و عالم از بيم شغب) كفشل أخلاقي عام.
يفقد مسعود سعد ثقته بأودائه ويرى نفسه وحيدًا:
كس نيابم كه غمگسار بود كس نبينم كه آشنا باشد
هر چه گويم همي بر اين سر كوه پاسخ من همه صدا باشد([59])
يقول:لا أجد من يداوي همي، ولا أرى من يعرفني،كلما ناديت فوق هذا الجبل كان الجواب صدى صوتي.
استعارة “الجبل/الصدى” لوحشةٍ مطبِقة، واستعارة المكان العالي/الصدى لبلوغ الذروة ثم الردّ بالعدم، ومشهديّة مفردة (الجبل) تزيد الوحشة، يقابل “غربة شروان” عند خاقاني، غير أنّ مسعود يوحد المكان في قمة واحدة، وخاقاني يبسطه مدينة وسياقًا:
روزم فرو شد از غم، هم غمخواری ندارم رازم برآمداز دل، هم دلبری ندارم
بر دشمنان نهم دل چون دوستان نبينم با بدتری بسازم چون بهتری ندارم
خاقانی غريبم، در تنگنای شروان دارم هزار انده و انده بری ندارم([60]) يعبّر عن انعدام النّاصر وكتمان السر وخيبة الرجاء إذ يقول:غابت شمسي من الحزن، ولا مواسي لي
وفاض سرّي من فؤادي، ولا حبيب لي، أُوالف الأعداء إذ لا أرى أصدقاء؛ وأرضى بالأردء إذ لا أملك الأفضل،أنا خاقاني الغريب في ضيق شروان؛ لي ألف همٍّ ولا حامل همي.
رباعيّة الشّكوى (لا مواسي/لا دلبر/ موالفة الأعداء/غربة شروان)، وتقابلات(عدو/صديق، أردأ/أفضل)، وتراكم نفي (لا… لا… لا…) للتكثيف؛ كناية “انفراج السرّ من القلب” عن ضيق الكتمان، نبرة تمثيليّة واسعة (مكان=شروان، هوية=غريب، حال=ألف هم).أكثر تركيبًا من سائر الشواهد؛ يتوسع سردًا على خلاف إيجاز أبي فراس.
يقول فلكي الشرواني في فقد النصير:
چند خواهم ز هر کس ياری؟ که کند ياريم، چو يارم نيست!
زين ديارم نژاد بود وليک هيچ يار اندرين ديارم نيست([61])
يقول:إلى متى أطلب المدد من كل أحد؟ ومن يغيثني إذا كان لا صديق لي!،أنا من هذا البلد أصلًا، ولكن لا صديق لي في هذا البلد، مفارقة الوطن بلا مؤانس، وتكرار النّفي لتقرير الخلو، خطاب استفهامي تقريري، حاد النبرة. يجاور مسعود في الصراحة، ويشارك خاقاني في مفارقة المكان.
ويندب ناصر خسرو تبرم الخلان منه:
جمله گشته ستند بيزار و نفور از صحبتم هم زبان و هم نشين و هم زمين و هم نسب
کس نخواند نامه من کس نگويد نام من جاهل از تقصير خويش و عالم از يم شغب([62])
يقول:صاروا جميعًا يكرهون صحبتي وينفرون: ذو اللسان، والنديم، وابن الأرض، وذو النّسب،لا أحد يقرأ رسالتي، ولا أحد يذكر اسمي؛ الجاهل عن تقصيره، والعالِم خوفًا من الشّغب.
مقابلة “جاهل/عالم” مع اختلاف الدافع، وتكرار “لا أحد…” للتوكيد، تعداد طبقي (لسان/نديم/أرض/نسب) يشي بقطيعةٍ شاملة، مع مقابلة “جاهل/عالم” لاختلاف باعث القطيعة (تقصير/خوف) نبرة أخلاقيّة تأمليّة، وتكرار “لا أحد” كجسر إيقاعي. يماثل حِجاج أبي فراس (قيم الوفاء)، ويستعير من الفرس اتساع المشهد الاجتماعي.
الخلاصة: توصل البحث من خلال التحلیل المقارن للحبسيات في الأدبين العربي والفارسي حتى القرن السابع الهجري إلى النتائج التالية:
أولًا: الوحدة الموضوعيّة للحبسيات
تتفق مضامين الحبسيات، على الرّغم من اختلاف ظروف الشّعراء، على محاور أساسيّة أبرزها: البراءة من التّهم والشكوى من الظلم، تصوير ضيق السجن وآثاره، الحنين إلى الأهل والوطن، والمفاخرة بالشعر والذات، وهذه العناصر تكشف أنّ تجربة السجن تولّد خطابًا إنسانيًّا مشتركًا يتجاوز حدود الزّمان والمكان.
ثانيًّا:التأثير والتأثر بين المدرستين العربيّة والفارسيّة
برز تأثير “روميات أبي فراس الحمداني” كمصدر إلهام رئيس لكلّ من الشّعراء العرب والفارسيين، وقد قام شعراء كمسعود سعد وخاقاني بترجمة بعض أبياتها ترجمة فنيّة ما يدل على الطابع العابر للثقافات في أدب السجون.غير أنّ هذا التأثر لم يكن نقلًا آليًّا، بل كان تفاعلًا إبداعيًّا وتوارد خواطر يظهر وحدة التّجربة الإنسانيّة، ومن هنا يتجلى الطابع العابر للثقافات في أدب السّجون.
ثالثًا: الفروق الأسلوبيّة والبلاغيّة بين العرب والفرس
تباينت أساليب الحبسيّة بين العرب والفرس؛ فالشّعراء العرب مالوا إلى التّعبير المباشر والواقعي(أبو فراس، المتنبي، أبو العتاهية)، بينما اتجه الفرس إلى الرّمزية والخيال(مسعود سعد، خاقاني، ناصر خسرو)، ويرتبط هذا الاختلاف بطبيعة التّجربة: فالأمراء عبروا بمفردات القوة، في حين لجأ المفكرون والزهاد إلى لغة الحكمة والتأمل.
رابعًا: البعد الإنساني المشترك
تشكل الحبسيّة تعبيرًا عن مأساة إنسانية عامة، إذ يتحول الشّعر إلى وسيلة للمقاومة والتّحدي،إثبات للكرامة في وجه القهر وتعبير عن الوعي الجمعي للإنسان.
خامسًا: إسهام البحث:
أبرز البحث أنّ الحبسية تمثل تجربة أدبيّة عابرة للثّقافات، تعكس وحدة الإنسان في مواجهة القيد، ولا تقتصر على الأدب العربي أو الفارسي وحدهما. فهي تسهم في إثراء الأدب المقارن، وكشف الأبعاد النّفسيّة والوجودية التي يتقاطع فيها الأدب مع التاريخ والفكر والإنسان، لتغدو جزءًا من التراث الأدبي العالمي في تصوير آلام الإنسان وآماله.
وخلاصة القول: تتجاوز الحبسيات حدود الزنزانة لتصير صوتًا للحرية وصرخة إنسانيّة خالدة تتردد أصداؤها في الشّعر العربي والفارسي على السواء، وتشكل جزءًا من الذّاكرة الأدبيّة العالميّة.
الهوامش:
* طالب دكتوراه في اللغة والأدب الفارسي، جامعة أصفهان – إيران.
PhD student in Persian Language and Literature, University of Isfahan Email:mojtaba.razavi6183@gmail.com
** أستاذ مساعد في اللغة والأدب الفارسي، جامعة أصفهان- إيران.
Assistant Professor of Persian Language and Literature, University of Isfahan, Iran. Email: m.hematian@ltr.ui.ac.ir
*** أستاذ مشارک في اللغة والأدب الفارسي، جامعة أصفهان- إيران.
Assistant Professor of Persian Language and Literature, University of Isfahan, Iran. Email: m.mohammadi@ltr.ui.ac.ir
[1] -دهخدا، مادة “ح ب س”
[2] -راجع:الثعالبي، 1352هـ: 147
[3] -راجع:القيرواني، 1344ق: 25
[4] -راجع:الزغلول، 2006م: 1-30
[5] -راجع:ظفري، 1380هـ.ش: 252
[6] -نفس المصدر،200.
[7] -الحمداني، 1414هـ، ص 341
[8] -مسعود سعد،1364هـ.ش:ج1/26
[9] – المتنبی،2009م:170
[10] – مسعود سعد،1364ش:ج2/1043
[11] – خاقانی،1387ش:2/1000
[12] – ناصر خسرو،1373ش:196
[13] -مجيرالين،1358ش:20
[14] – الحمداني،1414ق:198
[15] -مسعود سعد،1364،ص685
[16] – خاقانی،1387ش:2/874
[17] -فلکی شروانی،1345ش: 56
[18] -آباد،1380ش:272
[19] -الحمداني،1414ق:273
[20] – خاقانی،1387ش:2/995
[21] – ابوالعتاهية،1431ق:559
[22] – شفيعي كدكني، 1388هـ.ش، ص596
[23] -مسعود سعد،1364،ص104
[24] – خاقانی،1387ش:2/996
[25] – مجيرالدين،1358ش:253
[26] -ناصر خسرو،1373ش:309
[27] – الفرزدق،2009م:2/465
[28] – أبو العتاهية، 1406هـ: 233
[29] – ابن المعتز، د.ت: 154
[30] – أبو فراس الحمداني، 1414هـ: 162
[31] -مسعود سعد،172
[32] -الحمداني،1414ق:275
[33] – آباد، 1380هـ.ش: 272
[34] -الحمداني،1414ق:265
[35] -أبوالعتاهيه،1406ق:384
[36] – المتنبي،1428هـ:2/48
[37] – مسعود سعد،1364،ص1033
[38] – نفس المصدر،619
[39] – نفس المصدر ،985
[40] -خاقانی،1387ش:2/262-263
[41] -نفس المصدر،148-149
[42] -مجيرالدين،1358ه.ش:253
[43] -إبن منظور،1997م:ب ر ص
[44] -فلکي شرواني،ه.ش:24
[45] -الحمداني،1414ق:45
[46] -مسعود سعد،1364ش:1/144
[47] -خاقانی،1387ش:1/150
[48] -نفس المصدر،
[49] -مجيرالدين،1358ش:100
[50] -نفس المصدر،1/246
[51] – ناصر خسرو،1373ش:272
[52] – ابن المعتز،د.ت:154
[53] – تلميح الی الآية المبارکة «يريدون ان يطفئوا نورالله بافواههم و یأبي الله الا ان يتم نوره ولو كره الكافرون» (9/32)
[54]– الحمداني،1414ق:41
[55]– مسعود،1364ش:2/536
[56]– الحمداني،1414ق:253
[57]– نفس المصدر،1/702
[58]– الحمداني،1414ق:45
[59]– مسعود سعد1364ش:1/154
[60]– خاقانی،1387ش:2/869
[61]– فلکی شروانی،1345ش:24
[61] – ناصر خسرو،1373ش:26
المصادر:
- القرآن الكريم.
- آذرنوش،آذرتاش.(1388ه.ش).فرهنگ معاصر عربی_فارسی،ط10،طهران:طباعة نشر نی.
3- ابن المعتز(د.ت). ديوان، شرح کرم البستانی، بيروت: دار صادر.
4-ابن منظور.(1997م).لسان العرب،ط1،بيروت:دارصادر.
5- استعلامی،محمد.(ه.ش).نقد و شرح قصايد خاقانی استنادا لتقارير الأستاد فروزانفر،طهران:انتشارات زوار.
6-آباد،مرضيه.(1380ه.ش).حبسيه سرايی در ادب عربی از آغاز تا عصر حاضر،ط1،مشهد:جامعة فردوسی مشهد.
7- البرزة، د.أحمد مختار.(1405ق). الأسر و السجن فی شعر العرب،ط1،دمشق:مؤسسة علوم القرآن.
8- ابوالعتاهية.(1406ق). ديوان. بيروت:دار بيروت للنشر.
9- ______.(1431ق). ديوان،تحقيق:د.درويش الجويدي، بيروت:المکتبة العصرية.
10- ابونؤاس.(د.ت).ديوان، بيروت: دارصادر.
11-_____.(د.ت).ديوان،احمد عبد المجيد الغزالی،بيروت:دار الکتاب العربی.
12- بيلقانی،مجير الدين.( 1358ش).ديوان،تصحيح دکترمحمدآبادی،تبريز:انتشارات مؤسسة تاريخ وفرهنگ ايران.
13- الثعالبی،ابومنصور.(1931م).يتيمة الدهر فی محاسن أهل العصر، بيروت:دار الکتب العلميه.
14-الحمداني،أبوفراس.(1945م).ديوان،شرح سامی الدهان،بيروت: المطبعة الكاثوليكية.
15- _____________.(1414هـ.ق).يوان ،شرح خليل الدويهی،چاپ3،بيروت:دار الکتاب العربی.
16-خاقانی،بديل بن علی.(1387ه.ش).ديوان،دکتر محمد استعلامی نقد وشرح قصايد خاقانی استنادا الی تقارير فروزانفر،طهران:انتشارات زوّار.
17-دهخدا،علی اکبر.(1385ه.ش).لغت نامه،ط1،طهران:انتشارات جامعة طهران.
18- الزغلول،محمداحمد(2006م).تإثير الأدب العربی فی أشعار الشاعر الفارسی مسعود سعد اللاهوتی،مجله الآداب الأجنبيه، دمشق: اتحاد الکتاب العرب رقم(128)،ص1-30.
19-سلمان،مسعود سعد.(1364ه.ش).ديوان،تصحيح مهدی نوريان، اصفهان: انتشارات كمال.
20- شفيعي كدكني،محمد رضا.(1388ه.ش).صور خيال در شعر فارسي،ط13،طهران: انتشارات آگاه.
21- ظفری،ولی الله.(1388ه.ش).حبسيه در ادب فارسی،ط3،طهران:انتشارات امير کبير.
22-الفرزدق.(2009م).ديوان،شرح إيليا الحاوي،بيروت: دار الکتاب اللبناني.
23- فروزانفر،بديع الزمان.(1350ش).سخن و سخنوران،ط5.طهران: انتشارات خوارزمي.
24-فلکی شروانی،حکيم نجم الدين محمد.(1345ه.ش).ديوان،تصحيح طاهر شهاب، ،ط1،طهران:انتشارات کتابخانه ابن سينا.
25-قباديانی، ناصر خسرو.(ه.ش).ديوان، بإهتمام مجتبی مينوی و مهدی محقق،طهران:انتشارات امير کبير.
26- القيروانی،ابن شرف(1926م).أعلام الکلام،قاهرة:مکتبة الخانجی.
27-المتنبی، أبو الطيب.(2009م). ديوان،شرح الشيخ ناصيف اليازجي،بيروت: دار ومکتبة الهلال.
28-______________.(2007م). ديوان، شرح عبدالرحمن البرقوقی،چاپ2، بيروت:دار الکتب العلمية.
29-محقق،مهدی.(1373ه.ش).شرح سی قصيدة(شرح ثلاثين قصيدة) از حکيم ناصر خسرو قباديانی، طهران:انتشارات توس.
30- وزين پور،نادر.(1357ه.ش).مختصر وشرح ديوان ناصر خسرو،ط1،طهران:انتشارات فرزان.