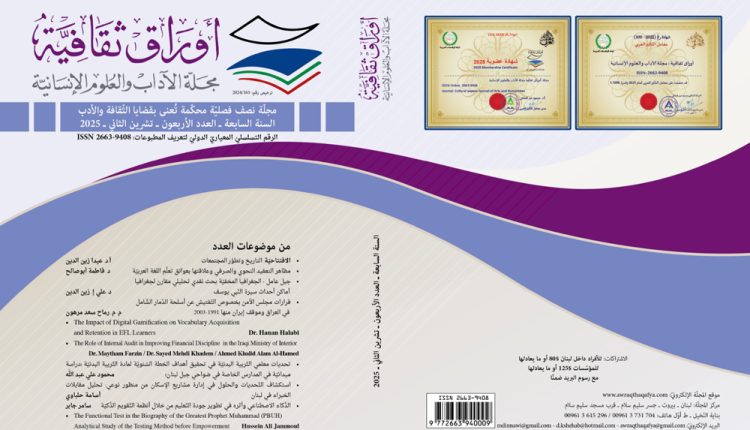الدعم القيادي والذّكاء العاطفي كعوامل محفزة لأداء الموظفين في سياقات الأزمات: إطار مفاهيمي من قطاع الرّعاية الصّحيّة في لبنان
عنوان البحث: الدعم القيادي والذّكاء العاطفي كعوامل محفزة لأداء الموظفين في سياقات الأزمات: إطار مفاهيمي من قطاع الرّعاية الصّحيّة في لبنان
اسم الكاتب: ربى محمد سرور
تاريخ النشر: 2025/11/14
اسم المجلة: مجلة أوراق ثقافية
عدد المجلة: 40
تحميل البحث بصيغة PDFADOI: https://aif-doi.org/awraq/014012
الدعم القيادي والذّكاء العاطفي كعوامل محفزة لأداء الموظفين في سياقات الأزمات: إطار مفاهيمي من قطاع الرّعاية الصّحيّة في لبنان
Leadership support and emotional intelligence as motivating factors for employee performance in crisis contexts: A conceptual framework from the healthcare sector in Lebanon
بحث مستل من أطروحة الدكتوراه بعنوان
The Impact of Organizational Culture on Employee Performance in the Lebanese Healthcare Sector: The Mediating Role of Emotional Intelligence and the Influence of Leadership Support
المعهد العالي للدكتوراه في الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية في جامعة آزاد
Ruba Mohammad Srour ربى محمد سرور([1] )
تاريخ الإرسال:21-10-2025 تاريخ القبول:30-10-2025
الملخص turnitin: 18%
تُصنِّفُ هذه المقالةُ الذّكاء العاطفيَّ كآلية وسيطة مركزية تُحوّل القيم الثقافية إلى سلوكيات إنتاجية، بينما تعمل القيادة كقوة مُعتدلة تُعزز هذا الارتباط. بالاعتماد على نظرية الذّكاء العاطفي (Goleman, 1995)، ونظرية الثقافة التّنظيميّة (Shein, 2010)، وإطار القدرة-الدافع-الفرصة، تُدمج الدراسة المنظورين النفسي والتنظيمي لتفسير مرونة الأداء في ظل الأزمات.
وبجمع هذه العناصر، يشير هذا البحث إلى أن الطريق إلى الصمود في الأنظمة الصّحيّة التي تعاني من الأزمات، مثل لبنان، لا يقتصر على الإمدادات أو التمويل فحسب، بل يتعلق ببناء أماكن عمل تُقدّر الرفاهية العاطفية وتُنمّيها، بدعم من قادة يدعمون موظفيهم.
الكلمات المفتاحيّة: الذّكاء العاطفي، الثقافة التّنظيميّة، دعم القيادة، أداء الموظفين، الرّعاية الصّحيّة، لبنان، إدارة البحوث البشريّة، الإطار المفاهيمي.
Abstract
Lebanon’s healthcare sector, which defied economic collapse, pandemic, the outcome of a devastating port explosion, and the military tensions in the South, still shows undeniable resilience of its professionals, and Lebanon’s healthcare professionals continue to serve, yet the system is facing a widespread burnout and migration of talent. It is agreed that culture and leadership are key to performance, but in such a sustained crisis, what really keeps healthcare employees engaged and effective lies in the emotional intelligence (EI) of its staff. This article positions emotional intelligence as a central mediating mechanism that transforms cultural values into productive behaviors, while leadership functions as a moderating force that strengthens this connection. Drawing on Emotional Intelligence Theory (Goleman, 1995), Organizational Culture Theory (Schein, 2010), and the Ability–Motivation–Opportunity (AMO) framework, the study integrates psychological and organizational perspectives to explain performance resilience under crisis.
In this dynamic, leadership is the essential catalyst. It’s the support, the empathy, the psychological safety, the resources provided by leaders—that amplifies a positive culture and directly builds the team’s emotional capacity.
Pulling these together, this research suggests that for crisis-ridden health systems like Lebanon’s, the path to resilience isn’t just supplies or funding. It’s about building workplaces that value and cultivate emotional well-being, backed by leaders who support their people.
Thus, this perspective shifts the conversation, highlighting that the heart of a resilient healthcare system is its human core. The paper concludes with recommendations for future empirical testing these ideas, hoping to contribute to a more humane and sustainable future for healthcare in crisis settings.
Keywords: Emotional intelligence, organizational culture, leadership support, employee performance, healthcare, Lebanon, human research management, conceptual framework.
مقدمة
لطالما حظي نظام الرّعاية الصّحيّة اللبناني بالتقدير، لا سيما في ظلّ واحدة من أكثر البيئات الاقتصاديّة والبنية التحتيّة تحديًا في الشّرق الأوسط. وكما أوضح فليفل وأبي فراج (2022)، عدّا لبنان في السّابق رائدًا في مجال الرّعاية الصّحيّة في الشّرق الأوسط، بفضل المؤتمرات الدّوليّة التي عُقدت هناك، وسجلها الحافل في التّعليم الطبي والابتكار السّريري.
تُعدُّ إدارة الموارد البشريّة إحدى الركائز الأساسيّة للرعاية الصّحيّة في لبنان، إذ تربط أهداف المؤسسات الصّحيّة بأداء العاملين الأذكياء عاطفيًا. وتُعد القيادة داخل أنظمة إدارة الموارد البشريّة حيويّة بشكل خاص، لأنّها تؤثر بشكل مباشر على الدّافع والاستقرار العاطفي والالتزام المهني.
وفي مجال الرّعاية الصّحيّة على وجه الخصوص، تُعدّ القدرة على إدراك وفهم وإدارة المشاعر لدى الفرد والآخرين ذات أهمية خاصة. وكما أشار جولمان وتشيرنيس (2024) وجولمان (1998)، فإنّ الذّكاء العاطفي يُسهل إدارة الإجهاد بفعاليّة، ويُعزز التّفاعل مع المرضى، ويعزز العمل الجماعي.
لذا، ينبغي دمج تطوير الذّكاء العاطفي في ممارسات إدارة الموارد البشريّة من خلال التدريب المُستهدف والدّعم المستمر. يعزز الذّكاء العاطفي القيادة المتعاطفة، ويقلّل من الصّراع، ويغرس ثقافة التّعلم والتّعاون. كما ذكر روتيا وآخرون (2023) أنّ استراتيجيات إدارة الموارد البشريّة القائمة على الذّكاء العاطفي أكثر قدرة على تحمّل الضّغوط خلال حقبة الأزمات، وأكثر ملاءمة لتحالف عمل دائم. ومع ذلك، لا تزال العلاقة بين الذّكاء العاطفي وأداء الموظف، غير مستكشفة إلى حدٍّ كبير في مؤسسات الرّعاية الصّحيّة اللبنانية.
إشكاليّة البحث: هل للذّكاء العاطفي ور وتأثير على أداء الموظفين في قطاع الرّعاية الصّحيّة اللبناني؟ وهل للقيادة دور داعمٌ وفعّال؟ يتطلب حل هذا التحدي تحليلًا متعدد الأبعاد لسمات بيئة العمل، وأنماط السّلوك، وممارسات القيادة.
أهميّة البحث: لهذا البحث آثار نظريّة وعمليّة، وهي بالغة الأهميّة في سياق النّظام الصّحي اللبناني، من خلال تقديم رؤية حول تأثير الذّكاء العاطفي على الأداء، بالإضافة إلى الدّور الوسيط لدعم القيادة، يُسهم هذا البحث في المناقشات الجارية حول الإدارة الاستراتيجية للموارد البشريّة في أنظمة الرّعاية الصّحيّة المتضررة من الأزمات.
فرضيات البحث
- H1 يؤثر الدّعم القيادي إيجابًا على أداء الموظفين.
- القادة الدّاعمون يعززون دافعيّة الموظفين ومرونتهم وفعاليتهم، خاصةً في ظل الأزمات (Munir et al., 2025).
- H2 يؤثر الدّعم القيادي إيجابًا على الذّكاء العاطفي للموظفين.
يقترح دوان وآخرون (2023) أنّ القادة الداعمين يُعظمون التّأثير الإيجابي للثقافة الجيدة، ما يضمن ترجمتها فعليًا إلى قوة عاطفية لفرقهم.
- H3 للذكاء العاطفي تأثير إيجابي على أداء الموظفين.
الموظفون الأذكياء عاطفيًا يديرون التوتر، ويتكيفون مع عدم اليقين، ويحافظون على الإنتاجيّة في بيئات الأزمات (Goleman and Cherniss,2024).
- H4 يتوسط الذّكاء العاطفي العلاقة بين دعم القيادة وأداء الموظفين.
دعم القيادة يعزز الذّكاء العاطفي، ما يعزز بدوره نتائج الأداء Goleman and Cherniss,2024).
أهداف البحث:هدف الدّراسة هو دراسة دور الذّكاء العاطفي والتأثير المُمكّن لدعم القيادة. ولتحقيق هذا الهدف، فإنّ هذه الدّراسة تسعى إلى تحقيق الأهداف المحددة الآتية:
- دراسة الدّور الذّكاء العاطفي في العلاقة بين الثقافة التّنظيميّة وأداء الموظفين.
- استكشاف كيفيّة تأثير الذّكاء العاطفي على ديناميكيّات العلاقات الشّخصيّة، بما في ذلك التّواصل والعمل الجماعي وحل النّزاعات، داخل فرق الرّعاية الصّحيّة.
- اقتراح استراتيجيّات إدارة الموارد البشريّة القائمة على الأدلة التي تدمج الذّكاء العاطفي ودعم القيادة لتحسين مشاركة الموظفين والاحتفاظ بهم والأداء العام.
الدّراسات السّابقة
الثّقافة التّنظيميّة
تُعدُّ الثقافة التّنظيميّة النسيجَ الرابطَ للمنظمة، وهي شبكةٌ معقدةٌ من المعتقدات والقيم والافتراضات والممارسات المشتركة.
يُقسّم شاين الثقافة التّنظيميّة إلى عناصرَ ماديّة، مثل تصميم المكاتب، وقواعد اللباس، والعمليات الرّسميّة؛ والقيم المُعتنقة، وهي المعايير والفلسفات الواعية والصّريحة للمنظمة، مثل تلك المُفصّلة في بيان الرّسالة أو مدونة الأخلاقيّات؛ والطبقة الأعمق والتي تتكون من الافتراضات الأساسيّة الكامنة.
الذّكاء العاطفي: الأسس والإطار المفاهيمي
يُعدّ الذّكاء العاطفي، وهو القدرة على إدراك المشاعر وفهمها وإدارتها واستخدامها بفعاليّة، عاملًا حاسمًا في النّجاح الشّخصيّ والمؤسسيّ. في الماضي، كان النّجاح المهني يُعتمد على الوظيفة الإدراكيّة، أو معدل الذّكاء. ومع ذلك، تُظهر الدّراسات الحديثة أنّ الذّكاء العاطفي يؤدي دورًا بالغ الأهمية، إن لم يكن أكثر، لا سيما في بيئات العمل التي تشهد تفاعلًا عاطفيًا واجتماعيًا مكثفًا، مثل تلك الموجودة في قطاع الرّعاية الصّحيّة (Goleman, 1995).
للصحة والرفاهيّة نصيبهما من مزايا الذّكاء العاطفي. تؤكد الدّراسات التي ذكرها جولمان وتشيرنيس (2024) أنّ موظفي المديرين ذوي الذّكاء العاطفي لديهم شكاوى أقل بكثير تتعلق بالتوتر، ما يؤثر على الصّحة البدنيّة والعقليّة. وهذا يعني أنّ القيادة الذّكيّة عاطفيًا لا تؤدي فقط إلى تحسين مقاييس الأداء، بل تخفف أيضًا من الإرهاق النّفسي وتساهم في الرّفاهيّة العامّة للموظفين.
يُعدّ الذّكاء العاطفيّ مبدأً أساسيًّا في إدارة الموارد البشريّة في الإدارة المعاصرة وفعاليّة القيادة. ويتراوح تأثيره من الطّريقة التي نتصرف بها كأفراد إلى أداء الفريق والمنظمة وثقافتهما. ومع تزايد الأبحاث المستمدة من الدّراسات النّظريّة والتّجريبيّة. سيظل الذّكاء العاطفي رصيدًا أساسيًّا لكل من القادة والموظفين (Goleman, 1995; Jain, 2021; Cherniss, 2024). يقدّم كل نموذج من نماذج الذّكاء العاطفي منظورًا مفيدًا، وإن كان محدودًا، يمكن من خلاله عرض الكفاءات العاطفيّة للحياة التّنظيميّة واستخدامها. يُعد نموذج جولمان رائعًا للقيادة وتطوير الفريق، ولكنه ليس تجريبيًّا بدرجة كبيرة (Aamir, 2023). أمّا نموذج بار-أون فهو شامل ومتكامل، ويؤكد أهمّيّة التّعامل مع الضّغوط (Soriano-Vázquez et al., 2023). ومع ذلك، لا يزال مدى تشابك مفهوم الذّكاء العاطفي مع الشخصية في هذا النموذج غير واضح. يحقق نموذج ماير-سالوفي-كاروسو أداءً جيدًا في الصلاحية العلميّة، ولكنه ضعيف في التّطبيق العملي (Kafetsios, & Zampetakis, 2008).
دعم القيادة: يُلخص تحليل دعم القيادة في أربعة أبعاد: العاطفيّ، والمهنيّ، والفعّال، والاستراتيجي. يشمل الدّعم العاطفي أنشطةً مثل الاستجابات التّعاطفيّة، والتّشجيع، والوجود في أوقات التّوتر أو الشّك. ويتماشى هذا مع عناصر التدريب والقيادة التشاركيّة، إذ تُفضي الثقة والتواصل المفتوح إلى الانفتاح العاطفي والتّطور الشّخصي Khalid et al., 2023; Aurelia & Musa, 2022)).
يمثل الدّعم الرؤيوي قدرة القائد على وضع أهداف الفريق في مقابل رؤية المنظمة الأوسع، وجعل الموظفين يدركون الأهميّة النسبيّة لمساهمتهم في هذه الأهداف. هذا النوع من الدعم هو جوهر القيادة التّحويليّة، ولا سيما من خلال ما يمكن أن يفعله في تعزيز الشّعور بالهدف المشترك، وتحفيز الفرق بما يتجاوز التّوقعات الأساسيّة (Iszatt-White & Saunders, 2023; Ghai & Dhiman, 2024). إن القادة الذين يوضحون الاستراتيجيّة بوضوح ويحثّون الفريق على المساهمة في صياغة الأهداف (كما هو الحال في القيادة التّشاركيّة، (Arief & Sulastri, 2021) يوفرون التوجيه ويثبتون الأهمّيّة على المستويين الفردي والجماعي.
في نهاية المطاف، فإنّ إضفاء الطابع المؤسسيّ على دعم القيادة من خلال الموارد البشريّة، والتطوير التّنظيمي هو انتقال من القادة الأفراد المتميزين إلى قيادة النظام المتساوية، إذ يختبر كل عضو في الفريق، بصرف النّظر عن الفريق أو الموقع أو الوظيفة المصفوفة، الآثار الإيجابيّة للقيادة الدّاعمة. هذا التّحول أساسي لتمكين الحوكمة للذكاء العاطفي في أنحاء القوى العاملة جميعها، بالإضافة إلى بناء منظمات مرنة وقابلة للتكيف وتركز على الإنسان يمكنها النّجاح في التعقيد. الأدلة من العديد من الدّراسات، مثل Asbari (2020)، وNurlina (2022)، وUdin et al. (2023)، وHatchett and Steinkruger (2024)، يوضحان أنه عندما يُدمَج الدّعم على مستوى النظام، فإنّ التأثيرات على أداء المنظمات ورفاهية الموظفين والابتكار تستمر وتتوسع.
الإطار النّظري وتطوير الفرضيات:يتناول هذا الإطار منظارين متكاملين؛ أولًا، نظرية الذّكاء العاطفي (Goleman, 1995; Mayer et al., 2022) التي تشرح كيف يُعزز الوعي الذاتي والتعاطف والتنظيم العاطفي الأداء الشخصي والمرونة. ثانيًا، نظرية القيادة (Bass, 1990) تُسلط الضوء على دور القائد في التأثير على دوافع الموظفين ورفاهيتهم وثقافتهم. يُمكّن دمج هذه النّظريات من فهم كيفية تأثير دعم القيادة على الذّكاء العاطفي، وبالتالي على أداء الموظفين.
نظرية الذّكاء العاطفي: يُعدّ الذّكاء العاطفي محور تركيز متزايد في السّلوك التنظيمي، لا سيما في بيئات العمل المُتطلبة عاطفيًا إذ تكون المخاطر عالية، كما هو الحال في قطاع الرّعاية الصّحيّة. استُخدم في هذه الدّراسة الإطار النّظري للذكاء العاطفي وهو النّموذج القائم على القدرة (Mayer et al., 2022)، والذي يُقدم وصفًا معرفيًا لكيفيّة إدراك الأفراد للمشاعر واستخدامهم لها وفهمهم لها. وعلى عكس النّماذج القائمة على السّمات أو النطاقات التي تعتمد على سمات شخصيّة عامة أو عوامل تحفيزيّة، يُعرّف نموذج القدرة الذّكاء العاطفي أنّه مجموعة من القدرات المعرفيّة المحددة والقابلة للقياس والتي ارتبطت ارتباطًا مباشرًا بمساعدة الأفراد على تفسير المشاعر وتنظيمها.
يتمتع نموذج جولمان بدعم تجريبي، ما يُضفي مصداقيّة على تطبيقه في مختلف أنواع المؤسسات. على سبيل المثال، بحث عامر (2023) في العلاقة بين الذّكاء العاطفي والالتزام التّنظيمي في سياق المنظمات غير الحكوميّة في المملكة العربيّة السّعوديّة. ووجد أن مجالي إدارة الذات وإدارة العلاقات كانا مؤشرين مهمين على الالتزام التّنظيمي. في المقابل، كانت العلاقات بين الوعي الذاتي والاجتماعي أضعف، ما يشير إلى أنّ الأهميّة العمّليّة لكل من هذه المكونات من الذّكاء العاطفي، قد تختلف باختلاف السياقات والنتائج التّنظيميّة. وبالمثل، قام فيرسيل وآخرون (2023) بتقييم برنامج تدريبي على مرونة الذّكاء العاطفي بين طلاب السنة الثانية في كلية الطبّ. حقق هذا التّدخل الذي شمل تقنيات تأمليّة إلى جانب علم النّفس الإيجابي مثل الامتنان وإعادة صياغة الإدراك، مكاسب كبيرة في المجالات الأربعة جميعها، للذكاء العاطفي وفقًا لتقييم بار-أون EQ-i 2.0. تُظهر هذه النتائج الفائدة العمليّة لبرنامج تدريبي في الذّكاء العاطفي في تعزيز المرونة والتحكم العاطفي.
وظيفة الذّكاء العاطفي الوسيطة وثيقة الصلة بالمهن التي تُشكل تحديًا عاطفيًّا، مثل تلك الموجودة في قطاع الرّعاية الصّحيّة، لأنها تنطوي على التّعرض المتكرر لمواقف مُقلقة للمرضى، ومخاوف أخلاقيّة، وصراعات اجتماعيّة، وضغوط تنظيميّة. على سبيل المثال، لا يساعد الذّكاء العاطفي الأفراد على تجاوز هذه التّحديات فحسب، بل يساعدهم أيضًا على النمو داخل أنفسهم من خلال إدارة عواطفهم، وفهم الآخرين، والتّعافي من النكسات.
نظريّة الدّعم التنظيمي المُدرَك (POS):أصول نظريّة الدّعم التّنظيمي المُدرَك: طرحَ نظريّة الدّعم التّنظيمي المُدرَك (POS) لأول مرة آيزنبرغر وفاسولو وديفيس، وتُمثل حجر الزاويّة في دراسة قضية دعم القيادة في المؤسسات. وتتمحور هذه النّظريّة حول فكرة أنّ الموظفين يُكَوِّنون تصورات عالميّة حول مدى تقدير المؤسسة لمساهماتهم واهتمامها برفاهيتهم. ولا تتبلور هذه التّصورات في فراغ، بل تُبنى بمرور الوقت من خلال التّفاعلات مع ممثلي المؤسسة، وتحديدًا المشرفين والقادة الذين تعكس سلوكياتهم مستوى الدّعم العالي الذي تُقدِّمه المؤسسة لأعضائها. وتستند نظرية الدّعم التنظيمي المُدرَك إلى نظريّة التّبادل الاجتماعي، إذ يُبادل الموظفون ذلك بالتزام عاطفي أعلى، وسلوكيات مواطنة تنظيميّة، وأداء مُحسَّن مقابل الحصول على معاملة داعمة (Arshadi, 2011).
يُنظر في هذا البحث، إلى دعم القيادة كعامل مُيسِّر سياقي حاسم في العلاقة بين ثقافة المؤسسة، والذّكاء العاطفي، وأداء الموظفين. لا يخضع دعم القيادة للاعتدال الإحصائي بالمعنى الدّقيق للكلمة، بل يعمل كحالة بيئيّة تُقلل أو تُعزز المسار الذي يُؤثر من خلاله الذّكاء العاطفي (EI) على التّأثيرات الثقافيّة على الأداء. ويُلقي المنطق المفاهيمي لنظريّة نقاط القوة والضعف (POS) الضوء على التّأثير غير المباشر، وإن كان مؤثرًا. فعندما يُقدم القادة كلًا من الدّعم العملي – أي من خلال توفير فرص الحصول على التّدريب والمشورة السليمة، بالإضافة إلى توزيع أعباء العمل بشكل عادل – والدّعم العاطفي، أي من خلال التّعاطف والتّقدير ومناخ من الأمان النّفسي، فإنهم ينجحون في خلق مناخ من الثّقة وتعزيز مهارات المشاركة. ومن المرجح أن تؤثر هذه القيادة على تصورات الموظفين (القيم التّنظيميّة)، والجهد التقديري، والكفاءات العاطفية التكيفيّة لديهم (Caesens & Stinglhamber, 2020).
نظريّة القدرة-الدافع-الفرصة (AMO): تُقدم نظريّة القدرة-الدّافع-الفرصة (AMO) للأداء التي اقترحها هاريل-كوك (Bos-Nehles et al., 2023) في البداية، نموذجًا قابلًا للتعميم لتفسير العوامل المُمهدة لأداء الفرد في السّياقات التّنظيميّة، وهو نموذج يتميز بالقوة والمرونة في مواجهة التغيير. ووفق هذه النّظريّة، فإنّ أداء الموظف هو دالة لثلاثة عوامل أساسيّة ومترابطة: القدرة، والدافع، والفرصة. يتميز كل بُعد بآلية فريدة تُكمل الآخر للتأثير على كيفيّة مساهمة الأفراد في الأداء التنظيمي.
يمثل عنصر “القدرة” المعرفة والمهارات والكفاءات التي يُضيفها الموظفون إلى المنظمة، بما في ذلك القدرات التقنيّة والاجتماعيّة-العاطفيّة. وكجزء من هذا التّحليل، يُدرج الذّكاء العاطفي أيضًا ضمن هذا البعد، مُعترفًا بمكانته ككفاءة مرتبطة بالمهارات تُمكّن الموظفين من تنظيم العمل العاطفي، والعلاقات الشّخصيّة، والضغط في سياقات العمل عالية الكثافة، مثل الرّعاية الصّحيّة. في سياق الرّعاية الصّحيّة، إذ يُعد التعاطف والهدوء والتّواصل الفعال أمرًا بالغ الأهمّيّة للحفاظ على رعاية عالية الجودة للمرضى ووحدة الفريق، فإنّ القدرة على إدراك المشاعر وتنظيمها والاستجابة لها تُعد ذات أهميّة بالغة (Kellner, Cafferkey, & Townsend, 2019). أمّا العامل الثاني، وهو الدّافع، فيشمل العمليّات التّحفيزيّة الدّاخليّة، والمحفزات التّحفيزيّة الخارجيّة التي تحفز الأفراد على بذل الجهد والمثابرة في أدائهم، وكذلك في مهامهم التّعليميّة (على سبيل المثال، دورنيي، 2005). وكلاهما جوهري، مثل الرّضا الشّخصي والفخر المهني والارتباط العاطفي، ومكافآت خارجيّة، مثل التّقدير والمكافأة وآفاق التّطور الوظيفي.
يشير البعد الأخير في نموذج AMO، وهو فرصة الأداء، إلى مدى سماح المناخ التّنظيمي للموظفين باستغلال قدراتهم ودوافعهم. ويشمل ذلك المكونات الهيكليّة والعلائقيّة لبيئة العمل (مثل: الوصول إلى الموارد، والمشاركة في صنع القرار، ودعم القيادة، وسير العمل التّعاوني) التي تُمكّن الأفراد من أداء أدوارهم بفعالية. وفي هذا الصدد، تؤدي الثقافة التّنظيميّة دورًا تسهيليًّا، إذ يمكنها توفير أو تقييد فرص الموظفين لتقديم مساهمة فعّالة. بشكل عام، يتوافق نموذج AMO بشكل وثيق مع المتغيرات الأساسية في هذا البحث، لا سيما تركيزه على بيئة الرّعاية الصّحيّة اللبنانية، حيث غالبًا ما تُعدُّ ضغوط النظام، والإرهاق المهني، والانفصال الثقافي تهديدات جسيمة للأداء. يُسهّل تطبيق نظرية AMO فهمًا متعدد الجوانب للأداء، يشمل كلًّا من الخصائص والسّلوكيات الفرديّة ضمن نطاق السّلطة، مع التركيز أيضًا على الأسس التّنظيميّة والعاطفيّة اللازمة لدعم تحقيق نتائج عالية الجودة في مجال الرّعاية الصّحيّة.
النّموذج المفاهيمي: يُصنّف الإطار المفاهيمي الذّكاء العاطفي كآليّة مركزيّة تُترجم قيم الثقافة التّنظيميّة إلى أداء الموظفين. ويتعزز هذا المسار بشكل كبير بدعم القيادة الذي يُشكّل حافزًا يُعزز مسار الارتقاء من الثقافة إلى الأداء.
تطوير الفرضيات
يُبرز مستند 1 تطوير الفرضيّات والنموذج المفاهيمي للمتغيرات.
التوجه المنهجي (المنهج المفاهيمي)
تتميز هذه المقالة بطابعها المفاهيمي. ولا تهدف إلى تقديم بيانات جديدة، بل إلى تجميع النّظريات القائمة في إطار عمل مبتكر يشرح كيفيّة تفاعل الذّكاء العاطفي والقيادة لتعزيز الأداء في مجال الرّعاية الصّحيّة.
بدأت العمليّة بجمع النظريات، والبحث عن الروابط التي تربط الثقافة التّنظيميّة بأداء الموظفين. وكان الرابط الإنساني الحاسم الذي حُدِّد هو الذّكاء العاطفي – القدرة التي تُمكّن الموظفين من ترجمة القيم الثقافيّة إلى أفعال فعّالة. ثم تمحور السؤال التالي حول ما الذي يُعزز هذا الرابط، وأشار التحليل إلى القيادة كمحفز أساسي.
مع أنّ هذا النموذج نظري، إلّا أنّه مُصمم للاختبار. لذلك، صُمم إطار الدّراسة باستخدام أدوات عمليّة راسخة، إذ يُمكن التّحقق من صحته من خلال أبحاث مستقبليّة. يمكن للباحثين استخدام مخزون الحاصل العاطفي (EQ-i) لقياس الذّكاء العاطفي، واستبيان القيادة متعدد العوامل (MLQ) لتقييم القيادة، وبطاقة الأداء المتوازن (BSC) لتتبع الأداء.
من خلال ترسيخ هذه النّظرية في هذه الأدوات المُجرّبة، تُقدّم الدّراسة أكثر من مجرد فكرة، بل تُقدّم نموذجًا قابلًا للاختبار يُعيد صياغة الأداء كنتيجة للقيم المشتركة، والمهارات العاطفيّة، والقيادة الدّاعمة، ما يُمهّد الطريق لبناء أنظمة رعاية صحية مرنة في سياقات صعبة مثل لبنان.
المناقشة والآثار النّظريّة
يُظهر هذا البحث أنّه في البيئات عالية الضغط، مثل قطاع الرّعاية الصّحيّة، ينشأ الأداء من خلال الذّكاء العاطفيّ لموظفيها، والدعم الذي يقدمه القادة. وينبع هذا الأداء نسبيًا من: ثقافة داعمة تُحسّن الذّكاء العاطفي، وهذا بدوره يُحسّن أداء الموظفين ذوي المهارات العاطفية. يُقدم هذا الفهم صورةً كاملةً عن عوامل نجاح المؤسسات.
تُدرس القيادة غالبًا كعامل مستقل، وفي هذا النّموذج، تُعدُّ العنصر الذي يُعزز النّظام بأكمله. لا يُدير القادة المهام فحسب؛ بل يُشكلون البيئة العاطفية بنشاط. لذا، عندما يُظهرون التعاطف، ويعززون الثقة، ويخلقون الأمان النفسي، فإنّهم يُمكّنون الموظفين من استيعاب الجوانب الإيجابيّة لثقافة المؤسسة بشكل كامل. وبالتالي، تعمل القيادة كجسر يربط قيم المؤسسة الرّسميّة بالتّجارب والسّلوكيات اليوميّة لموظفيها.
علاوةً على ذلك، تُبرز هذه الدّراسة أهمية الذّكاء العاطفي من مهارة شخصيّة إلى مورد جماعي. يُعد هذا الأمر بالغ الأهميّة في بيئة هشة كقطاع الرّعاية الصّحيّة في لبنان، إذ تُعدّ الأزمات المستمرة ونقص الموارد أمرًا طبيعيًّا. وبالتالي، فإنّ قدرة الفريق على إدارة التّوتر والتّواصل تحت الضغط والتّعافي من النكسات ليست بالأمر الهيّن، بل هي ضرورة استراتيجيّة أيضًا. يشير هذا الإطار إلى أنّ الذّكاء العاطفي، عندما تُعززه القيادة وتُغرسه في ثقافة المؤسسة، يُصبح شكلًا من أشكال المرونة التّنظيميّة. إنه القدرة التي تُمكّن النظام بأكمله من تحمّل الصّدمات من دون انهيار.
بالنسبة إلى مديري الرّعاية الصّحيّة، تُؤدي هذه الأفكار إلى إجراءات واضحة وعمليّة: أولًا، يجب إعادة تصميم ممارسات الموارد البشريّة لتقدير الذّكاء العاطفي. ثانيًا، يجب أن تُصبح برامج تطوير القيادة عنصرًا أساسيًّا في التدريب والترقية.
باختصار، يُوفر هذا الإطار منظورًا جديدًا لفهم الأداء. ويُخبرنا أنّ الطريق إلى نظام رعاية صحيّة مرن لا يكمن فقط في المزيد من التكنولوجيا أو ضوابط أكثر صرامة، ولكن أيضًا في بناء بيئة أكثر تركيزًا على الإنسان. من خلال إعطاء الأولويّة للفهم العاطفي والقيادة الدّاعمة، يمكن للمنظمات إنشاء الأساس للأداء المستدام حتى في أكثر الظروف تحديًا.
التّطبيقات العمليّة
تقدم الرؤى المستخلصة من هذه الدّراسة خارطة طريق واضحة، وقابلة للتنفيذ للقادة وصانعي السياسات الملتزمين بمعالجة نظام الرّعاية الصّحيّة في لبنان من الدّاخل إلى الخارج. في ظل بيئة تتسم بالضّغوط، فإن تعزيز الكفاءات البشريّة في مستشفياتنا ليس مبادرة اختياريّة، بل أولوية استراتيجيّة ملحة. إليكم ما يمكن فعله:
أولًا– دمج الذّكاء العاطفي في بنية الموارد البشريّة.
- تجاوز النّظرة النّمطيّة للذكاء العاطفي كمهارة شخصيّة، يجب على إدارات الموارد البشريّة جعله كفاءة عمليّة. وهذا يعني:
- التّوظيف بدافع الشّغف: دمج تقييمات الذّكاء العاطفي في عمليّة التّوظيف لتحديد المرشحين الذين يتمتعون بالتّعاطف والمرونة اللازمتين لهذه الأدوار الصّعبة.
- التدريب على المتانة: تحويل ميزانيّات التّدريب من المهارات التقنيّة البحتة إلى ورش عمل إلزاميّة حول الوعي الذاتي، وإدارة التّوتر، والتّواصل المتعاطف. لا يتعلق الأمر بتمارين حسّاسة؛ بل بتزويد الموظفين بالأدوات النّفسيّة اللازمة لمنع الإرهاق وبناء فرق أقوى.
ثانيًا– تعزيز قادة مدربين، لا مجرد قادة.
- في الأزمات، لا يحتاج الموظفون إلى رؤساء بعيدين؛ بل يحتاجون إلى مدربين متعاطفين يسهل الوصول إليهم. يجب إعادة تصميم تطوير القيادة جذريًّا للتركيز على:
- القيادة بالتّعاطف: تدريب القادة على تمييز علامات الإرهاق والصّدمات النّفسيّة لدى فرقهم والاستجابة لها بالدّعم، وليس فقط بالضّغط.
- تعزيز السّلامة النّفسيّة: تمكين المديرين من تهيئة بيئات يشعر فيها الموظفون بالأمان للتّحدث عن أخطائهم، وطلب المساعدة، واقتراح أفكار جديدة من دون خوف. هذا هو أساس الثقة والابتكار في البيئات عالية المخاطر.
ثالثًا– بناء أنظمة دعم تُظهر، لا تُخبر فقط.
تُبنى ثقافة الدّعم من خلال أفعال متسقة، وليس مجرد ملصقات تحفيزيّة. هذا يعني إنشاء أنظمة ملموسة تُشعر الموظفين بالتقدير:
- قنوات مفتوحة: إنشاء حلقات تغذية راجعة منتظمة ومجهولة المصدر، والتأكد من أنّ مساهمات الموظفين تُؤدي إلى تغييرات ملحوظة.
- الإرشاد والتّقدير: تطبيق برامج إرشاد مُهيكلة وإنشاء أنظمة تقدير لا تُحتفي بالنتائج فحسب، بل تُحتفي أيضًا بالسلوكيّات الرّحيمة والتعاونيّة التي تُؤدي إليها.
من خلال اتخاذ هذه الخطوات؛ دمج الذّكاء العاطفي في إدارة الموارد البشريّة، وتطوير قادة داعمين، وبناء أنظمة دعم قوية، يُمكننا إحداث تحول جذري في مؤسسات الرّعاية الصّحيّة في لبنان. الهدف هو إنشاء مؤسسات ليست أكثر فعاليّة فحسب، بل أيضًا أكثر إنسانيّة، وقادرة على التكيف، ومرنة بما يكفي لمواجهة التحديات المُقبلة.
اتجاهات البحث المستقبليّة
هذا الإطار هو نقطة انطلاق، وليس غاية. والخطوة الآتية هي الانتقال من النّظريّة إلى البيانات. يمكن للباحثين استخدام أساليب إحصائيّة متقدمة لقياس هذه العلاقات في المستشفيات الفعليّة، والإجابة عن أسئلة جوهريّة: ما مدى قوة الرابط بين الدعم والذّكاء العاطفي؟ هل القيادة هي حقًا المحفز القوي الذي نفترضه؟
لتعميق فهمنا، يجب علينا أيضًا البحث عن جوانب أخرى من اللغز. قد تُمثل عوامل مثل الأمان النّفسي – هل يشعر الموظفون بالأمان في التعبير عن آرائهم؟ – أو الرّضا الوظيفي العام، جوانب مفقودة أساسية تُفسر كيف تُترجم البيئة الإيجابيّة إلى أداء مرن.
لا تكفي نظرة سريعة إلى الماضي. يكمن الاختبار الحقيقي للمرونة في مدى صمودها مع مرور الوقت. تُظهر لنا الدّراسات الطوليّة التي تتابع فرق الرّعاية الصّحيّة لأشهر أو سنوات كيف يتطور الذّكاء العاطفي والثقافة. هل يتآكلان تحت الضغط المستمر، أم يمكنهما أن يزدادا قوة؟ هذه هي الأسئلة التي ستساعدنا حقًا في بناء أنظمة رعاية صحيّة قادرة على البقاء، بل والتعلم والتكيّف أيضًا.
مساهمات نظرية
في خضم أزمات لبنان التي لا تنتهي، يُعدّ العاملون في مجال الرّعاية الصّحيّة دليلًا على المرونة البشريّة. ولكن كيف يمكنهم الاستمرار عندما يقترب النّظام من الإرهاق والانهيار؟
يشير هذا البحث إلى أنّ الإجابة لا تكمن في مجرد زيادة المال أو الإمدادات، بل في شيء أكثر إنسانيّة. وقد وجد أن ثقافة العمل الدّاعمة ترفع الأداء من خلال تعزيز عنصر أساسي لدى الموظفين: ذكائهم العاطفي. وهو القدرة على إدارة التوتر، والتّواصل الوثيق مع المرضى، والتّعاون حتى تحت الضغط الشديد.
وأين يقع دور القيادة؟ القادة ليسوا مجرد رؤساء في هذه القصّة؛ بل هم المحفزون الأساسيون. من خلال تقديم التّعاطف الصادق، والأمان النّفسي، والدّعم المستمر، فإنّهم يخلقون بيئة يزدهر فيها الذّكاء العاطفي. إنهم يحوّلون القيم الثقافية إلى ممارسات يومية.
الخلاصة: في النّهاية، يقودنا هذا البحث إلى حقيقة بسيطة ولكنها مُقلقة: إن إنقاذ نظام الرّعاية الصّحيّة في لبنان يبدأ بدعم شعبه. لن ينجح أي إصلاح للسياسات أو تمويل إذا تجاهلنا المبدأ الإنساني لهذه المؤسسات.
يُظهر هذا الإطار أن طريق المرونة لا يكمن في جدول بيانات أو جهاز جديد، بل يُبنى من خلال الأفعال البشريّة اليوميّة المتمثلة في التّعاطف والثّقة والدّعم. يتطلب الأمر قادة لا يرون دورهم كمديرين فحسب، بل كراعٍ للرفاهية والسّلامة النّفسيّة. يعتمد الأمر على ثقافة تُقدّر الذّكاء العاطفي بقدر ما تُقدّر الذّكاء السريري.
التّحدي الآن هو جعل هذا الفهم واقعًا ملموسًا. يجب أن تنتقل أفكار الذّكاء العاطفي والقيادة الدّاعمة من صفحات هذه الدّراسة إلى أروقة المستشفيات، وتصميم سياسات الموارد البشريّة، وأولويات كل مدير. من خلال هذا التّحول، يُمكننا تحقيق أكثر من مجرد إعادة بناء نظام؛ بإمكاننا أن نخلق بيئة رعاية صحيّة تعامل المرضى ومقدمي الرّعاية على قدم المساواة، ما يساهم في مستقبل ليس فقط أكثر فعاليّة، بل وأكثر إنسانيّة بشكل أساسي.
المصادر والمراجع الأجنبيّة
1- Aamir, A. (2023). Emotional Intelligence and Organizational Commitment: Application of Goleman’s Model of Emotional Intelligence. International Journal of Intellectual Human Resource Management (IJIHRM), 4(1), 1–6. doi:10.46988/IJIHRM.04.01.2023.001
2- Arshadi, N. (2011). The relationships of perceived organizational support (POS) with employee diligence, commitment, and innovation. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 30, 743–748. doi:https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2011.10.215
3- Asbari, M. (2020). Is Transformational Leadership Suitable for Future Organizational Needs? International Journal of Sociology, Policy and Law, 51–55.
4- Aurelia, I., & Musa, S. (2022). The Roles of Organizational Culture, Participative Leadership, Employee Satisfaction & Work Motivation Towards Organizational Capabilities. Proceedings of the 27th International Scientific Conference on Strategic Management and Decision Support Systems in Strategic Management. doi:https://doi.org/10.46541/978-86-7233-406-7_233
5- Bar-On, R. (2006). The Bar-On Model of Emotional-Social Intelligence (ESI). Psicothema, 18, 13–25. Retrieved from www.psicothema.com
6- Bass, B. M. (1990). From Transactional to Transformational Leadership: Learning to Share the Vision. Organizational Dynamics, 18(3), 19–31. doi:https://doi.org/10.1016/0090-2616(90)90061-S
7- Bos-Nehles, A., Townsend, K., Cafferkey, K., & Trullen, J. (2023). Examining the Ability, Motivation and Opportunity (AMO) framework in HRM research: Conceptualization, measurement and interactions. International Journal of Management Reviews, 25(4), 725-739. https://doi.org/10.1111/ijmr.12332
8- Caesens, G., & Stinglhamber, F. (2020). Toward a more nuanced view on organizational support theory. Frontiers in Psychology, 11, Article 476. doi: 10.3389/fpsyg.2020.00476
9- Duan, W.H., Asif, M., & Nik Mahmood, N.H. (2023). Their study explores how emotional intelligence mediates the relationship between organizational constructs (like culture) and performance outcomes, particularly in leadership contexts. It supports the inclusion of emotional intelligence as a bridge between organizational context and employee outcomes.
10- Fleifel, M., & Abi Farraj, K. (2022, May 26). The Lebanese Healthcare Crisis: An Infinite Calamity. Cureus, 14. doi:10.7759/cureus 25367
11- Ghai, R. K., & Dhiman, A. (2024, July). Enhancing Employee Performance through Transformational Leadership: A Study. International Journal of Innovative Science and Research Technology (IJISRT), 9(7), 74-82. doi:https://doi.org/10.38124/ijisrt/IJISRT24JUL025
12- Goleman, D. (1995). Emotional Intelligence: Why It Can Matter More Than IQ. New York: Bantam Dell.
13-Goleman, D. (1998). Working with Emotional Intelligence. New York: Bantam Dell. Retrieved from https://www.academia.edu/44384606/WORKING_WITH_EMOTIONAL_INTELLIGENCE
14- Goleman, D., & Cherniss, C. (2024). Optimal Leadership And Emotional Intelligence. Leader to Leader. Leader to Leader, 7-12. doi:https://doi.org/10.1002/ltl.20813
15- Hatchett, L., & Steinkruger, K. (2024). Application of the Organizational Culture Inventory in a Shared Leadership Nonprofit. CORALS’ Journal of Applied Research, 2(2). doi:https://doi.org/10.58593/cjar.v2i2.30
16- Iszatt-White, M., & Saunders, C. (2023, August 31). Transformational and charismatic leadership: Vision and values at the top? doi:https://doi.org/10.1093/hebz/9780198834298.003.0008
17- Jain, A. K. (2021). The Science and Philosophy of Emotional Intelligence: A Pragmatic Perspective. In S. George Taukeni, The Science of Emotional Intelligence.
18- Kafetsios, K., & Zampetakis, L. A. (2008). Emotional Intelligence and Job Satisfaction: Testing the mediatory Role of Positive and Negative Affect at Work. Personality and Individual Differences, 44, 712-722.
19- Kellner, A., Cafferkey, K., & Townsend, K. (2019). Ability, Motivation and Opportunity theory: A formula for employee performance? In K. Townsend, K. Cafferkey, T. Dundon, & A. McDermott (Eds.), The Edward Elgar introduction to theories of human resource management and employment relations (pp. 311–323). Edward Elgar Publishing. https://doi.org/10.4337/9781786439017.00029
20- Khalid, K., Munir, S., Haider, S., & Kanwal, M. (2023). Relationship Between Coaching Leadership Style and Follower’s Job Performance: Role of Involvement and Consistency as Moderator. Journal of Policy Research, 9(4), 295–302. doi:https://doi.org/10.61506/02.00152
21- Mayer, C., Schirmer, M., Sivatheerthan, T., Mütze-Niewöhner, S., & Nitsch, V. (2022). Participative Leadership in Healthcare: Which Situational Contextual Factors Influence Managers’ Decision to Involve Employees? Human Factors in Management and Leadership, 55, 53-60. doi:https://doi.org/10.54941/ahfe1002232
22- Munir, S., Anser, M.K., Shah, S.T.H., Islam, T., & Zaman, K. (2025). This research explicitly integrates organizational culture, emotional intelligence, and supportive leadership in a moderated mediation model, showing how leadership support intensifies the effectiveness of emotional intelligence on decision-making and performance outcomes in academic and public sectors.
23- Nurlina, N. (2022). Examining Linkage Between Transactional Leadership, Organizational Culture, Commitment, and Compensation on Work Satisfaction and Performance. Golden Ratio of Human Resource Management, 2(2), 108–122. doi:https://doi.org/10.52970/grhrm.v2i2.182
24- Rotea, C. C., Ploscaru, A.-N., Bocean, C. G., Vărzaru, A., Mangra, M., & Mangra, G. L. (2023, April 26). The Link between HRM Practices and Performance in Healthcare: The Mediating Role of the Organizational Change Process. Healthcare, 11(9). doi:https://doi.org/10.3390/healthcare11091236
25- Shein, E. H. (2010). Organizational Culture and Leadership. San Francisco, CA: Jossey-Bass, Wiley Imprint.
26- Soriano-Vázquez, I., Cajachagua Castro, M., & Morales-García, W. C. (2023). Emotional Intelligence as a Predictor of Job Satisfaction Among Nurses. Frontiers Public Health.
27- Udin, U., Dharma, R. D., Dananjoyo, R., & Shaikh, M. (2023). The Role of Transformational Leadership on Employee Performance Through Organizational Learning Culture and Intrinsic Work Motivation. International Journal of Sustainable Development and Planning, 18(1), 237-246. doi:https://doi.org/10.18280/ijsdp.180125
28- Versel, J. L., Plezia, A., Jenning, L., Sontag-Milobsky, I., Adams, W., & Shahid, R. (2023, November 20). Emotional Intelligence and Resilience “PROGRAM” Improves Wellbeing and Stress Management Skills in Preclinical Medical Students. Advances in Medical Education and Practice, 14, 1309-1316. doi:https://doi.org/10.2147/AMEP.S437053
1- طالبة دكتوراه في جامعة آزاد – طهران – إيران – فرع العلوم والأبحاث.
PhD student at Azad University, Tehran, Iran, Department of Science and Research.E-mail: rubasrour@hotmail.com