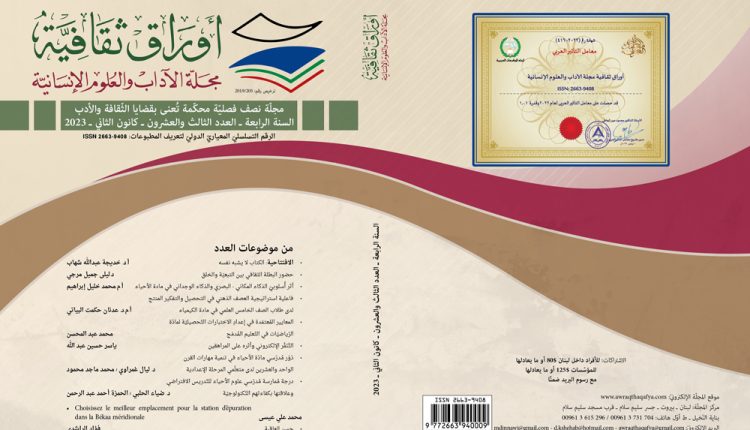الرابع من آب …السّاعة الخامسة مساء …
زينب حسين شهاب([1])
إنها بيروت الهادئة كما العادة، السيارات العالقة في الزّحمة، متسمّرة على طريق صيدا_ بيروت، مشهد العائلات وهم يتنزهون على الشاطئ ، رائحة السّمك، السّوق القديم المكتظ بالناس والتّجار…ابتسمتُ، نعم إنّها بيروت. كنت أشاهد ذلك الفيلم اليوميّ من نافذة السيارة، التي كانت تقلني الى بيروت بعد أن قضيت عطلة نهاية الأسبوع في الجنوب. مشهد متكرر كل يوم.
وصلت الى المنزل، جلستُ بالقرب من الباب الزجاجيّ أطالع رواية “الأسود يليق بك” للكاتبة أحلام مستغانمي، على ضوء الغروب المتبقي وسط أزمة الكهرباء في لبنان، ولم تكن أيّة حركة تشير الى حصول كارثة دموية أو ما شابه، ولكن…!
الخامسة وخمسون دقيقة…
كنت قد وصلت الى الصفحة المئة والثلاثين، ولم أشعر سوى بهزّة ارضية ! وقفت لأنادي أمي لأسألها، _علّني كنت أتخيّل _ لم تكد أصابعي تلامس الأرض حتى “بوووووف” الضربة الثانية!
لقد كانت أقوى بكثير، وقد تسبّبت في كسر الباب الزجاجيّ، وتحويله إلى قطع صغيرة انغرست في لحم يدي اليمنى وملأتها دمًا. صرخت، صرخت بقوة ليسمعني أحد والدايّ، لا أدري حتى كيف استطعت أن أقف لأذهب اليهم وأرى إذا ما زالوا على قيد الحياة !
رميت بجسدي بين أحضان والدتي واجهشت بالبكاء. رأيت أبي يركض متجهًا نحو نافذة المطبخ الكبيرة ، سارعتُ وإخواني ووالدتي لنرى ما حدث، فصاح والدي :
- جهزوا أنفسكم لنذهب ونختبئ في أحد الملاجئ، لقد استهدفنا العدو الإسرائيلي!
ما إن سمعت تلك الجملة، ارتسمت في ذهني صورة الحرب، وبدأ شريط حرب تموز التي ولدتُ فيها ينساب في أفكاري.
يا لهذا القدر! ولدت في الحرب قبل خمسة عشر عامًا ، وسأموت فيها أيضًا…؟!
نعم لقد كنتُ متشائمة إلى أقصى حد.
فتح أبي هاتفه على مجموعة الأخبار، وأعلمنا أنه لم يكن سوى انفجار لإهراءات القمح في المرفأ، وليست حربًا إسرائيليّة جديدة على لبنان، هدّأنا من روعنا جميعًا وارتحنا لإدراكنا أن لا وجود لضربات أخرى، ما عدى والدتي التي هرعت مسرعة نحو الهاتف الأرضي لتتصل بعائلة خالي، وتطمئن عليه، فهو يعمل في المرفأ، وكم بكت حين رُن الهاتف بلا جدوى.
جلسنا جميعًا على أعصابنا نتخيل ما قد يمكن أن يحدث أيضًا، “ننتظر الموت جالسين” كما عبّر أخي الأصغر، فقاطعنا صوت رنين الهاتف، ركضت والدتي مسرعة وردت، فإذا هي زوجة خالي تطمئننا عليه:
_ لم يذهب الى العمل اليوم ، لقد كان في إجازته الأسبوعيّة .
فارتاحت والدتي وطلبت أن تكلّم أخاها لتسمع صوته، ولكنها لم تسمع سوى صوت الأنين الدّاخلي، خالي يبكي على زملائه السّتة. لقد استشهدوا !
يا لذلك الحزن الذي انتابني، وتخيلت لو أنهم كانوا زملائي أنا، ما كنت بفاعلة ؟
في تلك الأثناء حدثت معجزة ورأينا نور الكهرباء، الساعة السادسة والربع، لقد مرت تلك الأحداث بسرعة…
أسرعتُ وشغلت التلفاز ورحت أتابع الأخبار لأول مرة في حياتي .
وكم هي مؤلمة تلك المشاهد الدّموية التي رأيتها!
هنا من فقد ابنه أو ابنته، وهنا من قطعت يده أو رجله، وهناك الأطفال تحت الحطام. تألمتُ فكريًّا، فأنستني كل تلك المشاهد ألم يدي، فآلمني قلبي…
لم نستطع النوم في المنزل ذلك اليوم، خصوصًا أنّ المسافة، التي تبعد بينه وبين المرفأ لا تتجاوز القليل من الأمتار. أمّا والدي الذي يعمل ليلًا ، فقد أصر أن يذهب الى عمله على الرّغم ن محاولاتنا الفاشلة في منعه.
قررنا وبعد تفكير، أن نبيت عن خالتي في منطقة “بئر حسن”، فالمكان هناك أبعد قليلًا، كما أنّ وجود أحد معنا راحة من دون سبب.
منذ ذلك اليوم ونحن تصلنا رسائل اطمئنان من الجميع، هاتف والدتي لم يهدأ، وكذلك هاتف أبي..
استيقظتُ صباحًا في توتر وما زال الألم في قلبي عامرٌ، والآجاع في تزايد، احتجتُ الى بضع دقائق لاستيعاب ما حدث البارحة، علّه كان حلمًا، ولكنني سمعت صوت المذيعة في التلفاز تزفّ لنا خبر أعداد المفقودين الذي تعدى الألفين، والمستشهدين والجرحى…فأدركت صحة ما حدث..
مرت الأسابيع ، والأشهر، والسنين، وأنا ما زلت حتى الآن أهتم بمتابعة الأخبار، وقصة كل بطل من هؤلاء الأبطال. لقد صنعوا مني أنثى قوية ، أنثى مناضلة ومدافعة.
اقتديتُ بسحر _ إحدى نساء الأطفاء_ التي أفنت حياتها فداءً لوطنها، هدمت عائلتها التي لم تكد تُبنى، ليعيش أبناء وطنها في أحضان عائلاتهم. يا لكِ من أنثى! لقد أثبتِ للجميع أن للأنثى دورًا فاعلًا لا يفنى في المجتمع، أبثتِ كم هي قوية، ذلك الكائن اللطيف ظاهريًّا، شجاع وقوي باطنيًّا.
علّني أبكي وأنا أكتب نصي هذا، إلا أنّني فخورة بكل بطل مستشهد ومتضرر، أثبت أن ّالحياة ستُكْمل، ولو فقدنا أعز ما لدينا، وسنعوضه مرة أخرى…
فإن أردنا… نستطيع!
– طالبة في الثانوي أول علمي في ثانوية رياض الصلح الرّسميّة، تشق طريقها إلى عالم الأدب والقصة[1]